رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
1241
محمد الجواديإساءة استعمال مصطلح الديمقراطية في الفكر السياسي العربي
مع أن تعريف الديمقراطية معروف وملامحها الفكرية والعملية لا خلاف عليها في الأدبيات العالمية؛ إلا أن الفكر السياسي العربي تعمد إساءة استعمال المصطلح على نحو غير مسبوق في التجارب السياسية الدولية.
ومن باب إحقاق الحق؛ فإننا نلاحظ أن الجماعات الأيديولوجية لم تشارك على الإطلاق في إساءة استعمال مصطلح الديمقراطية، حتى وإن كانت قد تجنبتها تماما. وينطبق هذا على معظم جماعات ما يُعرف بجماعات الإسلام السياسي، وعلى حركة البعث العربي وحركة القوميين العرب، وكثير من حركات التحرير الفلسطينية وغير الفلسطينية.
وفي المقابل؛ فإن إساءة استعمال مصطلح الديمقراطية وما يرتبط به قد حدثت على يد ما يُعرف بالنُّظم الثورية المتولدة عن وصول العسكر للسلطة، وتقديمهم لأنفسهم على أنهم ديمقراطيون؛ بما في ذلك ما حدث مرات من النص في اسم الدولة على صفة الديمقراطية، ثم محاربة الديمقراطية نفسها حربا شعواء تحت هذه المظلة.
وليس من شك في أنه كانت هناك أكثر من تجربة سياسية عربية اشتبكت بقسوة مع الديمقراطية وأثخنتها جراحاً، مع حرصها على نسبة تصرفاتها للديمقراطية. لكن أبرز هذه التجارب في هذه المعركة المريرة والمحبِطة كانت التجربة الناصرية. ومن المدهش -بل المذهل- أن أكثر من ساهم في إضفاء هذا التحول القاسي على الناصرية هي الولايات المتحدة الأميركية. ومن المدهش -بل المذهل- مرة أخرى أن هذا هو موطن العِبرة من التجربة التي تتكرر الآن في أكثر من موقع بمحيطنا العربي، من دون انتباه كافٍ من الساسة والمنظرين.
وليس من قبيل المبالغة القول بأن أولى سمات الفكر السياسي في شخصية الرئيس جمال عبد الناصر كانت كفره التام بالديمقراطية وعداءه الصريح لها، ونحن نفهم أن هذا هو الطابع المسيطر على العسكريين في كل زمان ومكان؛ لكن الرئيس جمال عبد الناصر كان مبالغا في هذا الكفر وهذا العداء لأسباب جوهرية وأخرى مرحلية.
بل إنه من العجيب أن الأسباب التي كان يُحتمل أن تجعله يُكنّ قدرا من الحب والتقدير للديمقراطية لعبت ببراعة ضد الديمقراطية وضد حبها على طول الخط، ذلك أنه بدأ نشاطه السياسي في تنظيمات الأقلية التي ترفع شعار الديمقراطية بينما هي تعاديها وتكفر بها تماما، بل وتعمل على القضاء عليها انطلاقا من أهداف تبدو نبيلة الغاية والمعتقد.
والمثل في ذلك هو جماعة «مصر الفتاة» التي شكلت الوعي السياسي لعبد الناصر، وحين آثر أن يترك «مصر الفتاة» فإنه ترك الأشخاص ولم يترك الفكرة الفاشية، بل إنه -شأن كل شاب من أمثاله- ازداد اعتصاما بالفكرة ليدين بها الأشخاص أو الزعامات التي رآها أقل من أن تحمل روح الفكرة.
وهكذا فإن الرئيس جمال عبد الناصر -شأنه شأن كل المنشقين عن «مصر الفتاة» من الشباب- كان فاشيا أكثر من المتعقلين، الذين بقوا في «مصر الفتاة» ليحافظوا للحركة -ثم للحزب- على مكانة ما في الشارع السياسي.
وإذا بحثت فيما انتقد به عبد الناصر قياداته السابقة في «مصر الفتاة» مبررا به خروجه عليهم؛ فستجده لا يتحدث إلا عن تجاوزات مالية، أما الفكرة الفاشية نفسها فكانت لا تزال حتى مماته تأخذ بلبه وتشغل فؤاده، بل وتزداد تألقا ولمعانا في ذهنه وذائقته على حد سواء.
وهكذا فقد أضاف الرئيس جمال عبد الناصر كره الفاشية للديمقراطية إلى كره العسكرية للديمقراطية، ثم تبلورت قمة كراهيته للديمقراطية في مرحلة ما بعد نجاح حركة الجيش، عبر ما كان يخرج به من مناقشاته ومناقشات زملائه مع الأميركيين (الذين كان يلتقيهم منذ ما قبل الثورة وفي أعقابها مباشرة).
فقد فهم من هؤلاء الأميركيين -بكل وضوح- أنهم لا يثقون في إمكان التعاون مع حزب الوفد لسبب جوهري، هو أن الوفد كان يفوز في الانتخابات بسهولة، ومن ثم فإنه كان يؤمن بالشعب ويحرص على أصوات الناخبين.
ولهذا السبب فإن الأميركيين كانوا يصرحون لعبد الناصر بأنهم لا يرحبون بالانتخابات لأنها ستأتي بالوفد، بل وأكثر من هذا فإنه فهِم -بكل وضوح- أن تأييدهم له مرتبط بقدرته على تأجيل الانتخابات والتسويف بها، حتى لا يعود الوفد إلى الحكم واتخاذ القرار. نحن نفهم -من برجنا العاجي الآن- جوهر السبب في أن الأميركيين لم يكونوا على استعداد للتعامل مع قوة وطنية تستند إلى صندوق الاقتراع، لكننا سنكون متجنّين على عبد الناصر إذا طالبناه بأن يكون واعيا لهذا العداء الأميركي لإرادة الشعوب، حين كان في المرحلة السنية التي كان لا يزال فيها حين تناقش مع الأميركيين.
ونحن نعرف ونفهم أن الأميركيين كانوا يشغلون الوقت بما يتحدثون به عن الإنجاز التنموي، وعن إلحاح الحاجة إلى الإنجاز من أجل رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ونعرف بالطبع أنهم كانوا يعزفون السيمفونية القائلة بأن الإنجاز لا يمكن أن يتحقق في ظل روح الحزبية التي تنتقد جهود الآخرين، ولا في ظل الديمقراطية التي تتطلب التصويت وموافقة البرلمان، ولا في ظل بقاء هذه الزعامات الليبرالية القديمة وما تمثله من صراعات على المصالح.
هكذا أصبح الرئيس عبد الناصر -بشبابه وبقلة خبرته وبفهمه المتأثر بتوجهه الثوري (اليميني أو الفاشي)- أسيرا للفكرة التي مؤداها أن الإنجاز التنموي يتطلب -بل يحتم- التضحية بالديمقراطية، وكان هذا في الواقع هو قمة نجاح الأميركيين في تشكيل وعيه عبر مناقشات مستفيضة، كان معروفا لهم أنها لابد أن تنتهي إلى هذه النتيجة.
وخد مثلا موضوعا أو إنجازا كالإصلاح الزراعي بكل ما عُرف به في الأدبيات التاريخية والعالمية من مزايا وعيوب، وتأمل معي صورة الرئيس جمال عبد الناصر حين يستمع في الصباح إلى علي ماهر باشا وهو يشرح له عيوب مثل هذا القانون، فإذا به يكتشف أنها هي نفسها العيوب التي قالها له الأميركان في الليلة السابقة.
إن أي زعيم من المخضرمين (من طبقة علي ماهر باشا) سيبديها له، ثم إنه سيستمع إلى الإخوان المسلمين فيذكرون له حكم الشرع تجاه حقوق الملكية، فإذا هو نفسه ما ذكره له الأميركان في الليلة السابقة، وهم يصورون له موقف ما يطلقون عليه مصطلح الرجعية الدينية؛ على حد تعبيرات الاقتصاديين الحريصين على التظاهر باليسارية.
وهكذا استطاع الأميركان أن يؤكدوا ما كانت عقلية الرئيس جمال عبد الناصر قد مضت إلى بلورته، بالسير في الاتجاه الذي يحارب الديمقراطية بلا هوادة من أجل الإنجاز.
وأنت إذا كنت من هواة المسرح، وتسارعت دقات قلبك إحساسا بالخوف عليه وهو تحت هذا التأثير المعرفي المزيف؛ فإنك ستحس أيضا بالتعاطف التام معه مهما كانت تجاوزاته في سبيل ما ظنه واجبا عليه، ولن تُلقي بالاً لمن يقول لك إنه أحب التسلط لأنه متسلط بطبعه، ولا لأنه عاجز عن العدل أو الفهم أو الاستيعاب.
وهكذا تشكل وعي الرئيس جمال عبد الناصر بعد أن قامت ونجحت حركة 1952 ليكون دكتاتورا مطلقا، غير قابل للعودة إلى أية درجة من درجات الديمقراطية بأية صورة من الصور.
وفي مقابل أزمة غياب الديمقراطية وما ترتب عليها؛ فقد كان أسوأ ما ابتُلي به عبد الناصر هو تنظيماته السرية التي تبدو في بعض الكتابات التاريخية محل إعجاب المراقبين، دون أن يكون لها الحق في الاستحواذ على هذا الإعجاب.
لقد كانت متاعبها أكثر بكثير من فوائدها، لكن عبد الناصر ظل مقتنعا بضرورة هذه التنظيمات بحكم انتمائه السابق وانتماء أقرانه للعمل السري (في النظام الخاص للإخوان أو في الحرس الحديدي أو في التنظيمات الشيوعية... إلخ)، أو بحكم إعجابه بهذه النماذج من التنظيم الهادف المحكم، أي إنه تنظيم ذو هدف محدد وطبيعة محكمة.
ومن عجائب الحياة -التي لا يندهش لها المشتغلون بالأدب- أن كل المصاعب والانتقادات التي وُجهت إلى الرئيس جمال عبد الناصر وتجربته -في حياته وبعد مماته- جاءت ممن انضووا تحت راية هذه التنظيمات ونظائرها، وفي مقدمتها التنظيم الطليعي ومنظمة الشباب الاشتراكي.
صحيح أن هذه التنظيمات لم تصبح تنظيمات معارضة للرئيس عبد الناصر ونظامه، لكنها أصبحت بمثابة المورد والمعين الذي وفّر الأدبيات والحركيات التي كانت ضرورية لتشريح ونقد ثم تمزيق صورة التجربة الناصرية.
اقرأ المزيد
 هل ينجح أعداء أمتنا في تقسيم دولنا؟
هل ينجح أعداء أمتنا في تقسيم دولنا؟
نعيش جميعا منعرجا تاريخيا يتمثل لدينا فيما نراه يوميا من تقسيم دولنا أعراقا وقبائل وفرقا وهو ما يسعى... اقرأ المزيد
132
| 16 يناير 2026
 السيكودراما وذوو الإعاقة
السيكودراما وذوو الإعاقة
السيكودراما (Psychodrama) هي طريقة علاجية جماعية تعتمد على التمثيل الإيجابي والتجسيد الدورى للمشاهد الداخلية والعلاقات بين الناس. اخترعها... اقرأ المزيد
72
| 16 يناير 2026
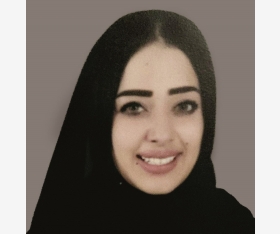 خطورة التربية غير الصحية
خطورة التربية غير الصحية
هناك فرق كبير بين التركيز على الجهد وليس النتيجة في التربية وتلبية الاحتياجات الأساسية وليس كل الرغبات والرفاهيات... اقرأ المزيد
69
| 16 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
هل الدوحة الوجهة المناسبة للعائلة الخليجية؟

د. عائشة جاسم الكواري
-
قطر والسعودية وعمان ركائز الاستقرار الإقليمي

رأي الشرق
-
غرينلاند.. القنبلة العالمية!

جاسم الشمري
-
هل ينجح أعداء أمتنا في تقسيم دولنا؟

د. أحمد القديدي
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 أهمية الدعم الخليجي لاستقرار اليمن
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1554
| 14 يناير 2026
- 2 لومومبا.. التمثال الحي الذي سحر العالم
اعتدنا خلال كل البطولات الأممية أو العالمية لكرة القدم أن نرى العدسات تتجه إلى مواقع المشاهدين في المدرجات، تسلط الضوء على الوافدين من كل حدب وصوب بكل تقاليدهم في الملبس والهيئة والسلوك. لكن أتت النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا والمقامة في المغرب، لتكشف عن حالة جديدة فريدة خطفت الأضواء، وأصبحت محط أنظار وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي. ففي جميع المباريات التي كان أحد طرفيها فريق الكونغو، كان أحد مشجعي هذا الفريق يقف طيلة وقت المباريات كتمثال جامد بلا حراك، بجسد مشدود ويد يرفعها أمامه كمن يلقي التحية، دون أن يهتف، ودون أن يتكلم، ودون أن يصفق، فقط هي تلك الهيئة الجامدة. لم يكن هذا التمثال البشري يثير الدهشة والانتباه فقط بهيئته، بل بالشخص الذي اتخذ هيئته، فقد كان يجسد بهذه الوضعية تمثالا للزعيم الكونغولي باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية عقب الاستقلال عام 1960م. «كوكا مبولادينغا»، هو اسم ذلك المشجع الكونغولي الذي تقمص هيئة الزعيم الاستقلالي لومومبا، وخطف أنظار الجماهير وعدسات التصوير، ليتحول إلى أيقونة وطنية تعبر عن رموز بلده وربط تاريخها بحاضرها، واستدعى رمزية الاستقلال ممثلًا في شخصية ذلك الزعيم الذي قاد الحركة الوطنية الكونغولية ولعب دورًا محوريًا في استقلال الكونغو بعد أن كانت مستعمرة بلجيكية، وعُرف بخطبه ومقالاته النارية التي شرح خلالها للأوساط المحلية والإقليمية والدولية جرائم البلجيك ضد الشعب الكونغولي وتورطهم في تهريب ثروات البلاد، وخاض مظاهرات شعبية ومواجهات ضد الاحتلال، وتعرض للسجن، إلى أن استقلت بلاده وشغل منصب رئيس الوزراء، إلى أن قام الانقلاب العسكري الذي أدى إلى اعتقاله وتعذيبه وإعدامه بعد عام واحد من الاستقلال. لم يختر المشجع مبولادينغا رفع العلم أو دهن وجهه بألوانه، أو أداء رقصة شعبية كونغولية، أو أي من هذه المظاهر المعتادة لتمثيل بلاده، بل اختار ذلك السكون والجمود على مدى 438 دقيقة، هي زمن المباريات التي خاضها فريقه. كان مشهدًا مؤثرًا لكل من طالعه، ولم يتوقف هذا التأثير عند حد الإعجاب بالرجل، ولكن تعداه إلى ما هو أبعد بكثير من ذلك، إذ إنه أقام جسرًا ممتدًا للتعريف ببلاده ورموزها، فقد تدفق اللجوء إلى محركات البحث عن الكونغو واستقلالها وزعيمها، فنقل رجل واحد – بذلك السلوك- وطنه إلى حيز الاهتمام العالمي، وعرّف ببلاده بشكل أقوى وأسرع وأكثر كثافة من كل ما يكتب عن الكونغو وتاريخها وحاضرها ورموزها. لقد اتضح لي من البحث أن هذا الرجل يسير على نفس النهج من التشجيع بهذه الهيئة، منذ قرابة اثني عشر عاما، بما يعني أن الرجل صاحب قضية، وصاحب رسالة وحس وطني، ويحمل بين جنباته حب وطنه وقضاياه، يرغب في أن يتعرف العالم على تاريخ بلاده المنسية ورموزها، بما ينفي عنه تهمة السعي وراء (التريندات). لقد صار الرجل أبرز رموز كأس الأمم بالمغرب، وأصبح أيقونة وطنية معبرة عن الكونغو، ما جعله محل اهتمام رسمي قوي، فقد التقط رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي صورة تذكارية معه خلال مباراة الجزائر والكونغو، وقام وزير الرياضة الكونغولي بتكريمه لتشريفه بلاده وتمثيلها خير تمثيل، وأهداه عربة دفع رباعي «جيب»، وأهداه الاتحاد الجزائري لكرة القدم قمصان المنتخب الجزائري بعدما أبكاه خروج منتخب بلاده أمام الجزائر، ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة رسمية له لحضور المباراة النهائية، إضافة إلى أنه كان لا يستطيع أن يخرج من غرفة فندقه بسبب تدافع الناس لالتقاط الصور معه والتحدث إليه. المشجع الكونغولي الذي أحيا قصة الاستقلال، كان بصمته وجموده يؤدي طقسًا وطنيًا ويجسد شكلا من أشكال الانتماء للوطن، وغدا كجندي يحرس ذاكرة بلاده وشاهد على تاريخ يجمع بين الألم والأمل. أمثال هذا الرجل هم القوة الناعمة الحقيقية لأي دولة، أولئك هم السفراء الذين يجسدون معاني الوطنية والاعتزاز بالوطن والدعاية له والتعريف به وشرح قضاياه. إننا مطالبون كذلك كلما تخطينا حدود بلادنا أن نكون سفراء لها، ندرك أننا في أسفارنا نرسم الصورة الذهنية للآخرين عن بلادنا، فالفرد هو جزء من مجتمعه، من وطنه، سوف ينقل ثقافته وقضاياه إلى الشعوب لا بالشعارات والأغاني، إنما بالسلوك والقيم.
831
| 11 يناير 2026
- 3 توثيق اللحظة... حين ننسى أن نعيشها
للأسف، جميعنا نمرّ بلحظات جميلة في حياتنا، لحظات كان من المفترض أن تترك أثرًا دافئًا في قلوبنا، لكننا كثيرًا ما نمرّ بها مرور العابرين. لا لأن اللحظة لم تكن جميلة، بل لأننا لم نمنحها انتباهنا الكامل، وانشغلنا بتوثيقها أكثر من عيشها. نعيش زمنًا غريبًا؛ نرفع الهاتف قبل أن نرفع رؤوسنا، ونوثّق اللحظة قبل أن نشعر بها، ونلتقط الصورة قبل أن يلتقطنا الإحساس. لم نعد نعيش اللحظة كما هي، بل كما ستبدو على الشاشات. كأن وجودنا الحقيقي مؤجّل، مرتبط بعدسة كاميرا، أو فيديو قصير، أو منشور ننتظر صداه. نخشى أن تمر اللحظة دون أن نُثبتها، وكأنها لا تكتمل إلا إذا شاهدها الآخرون وتفاعلوا معها. كم مرة حضرنا مناسبة جميلة؛ فرحًا، لقاءً عائليًا، أو جلسة بسيطة مع من نحب، لكن عيوننا كانت في الشاشة، وأصابعنا تبحث عن الزاوية الأفضل والإضاءة الأجمل، بينما القلب كان غائبًا عن المشهد؟ نضحك، لكن بوعيٍ ناقص، ونبتسم ونحن نفكر: هل التُقطت الصورة؟ هل وثّقنا اللحظة كما ينبغي؟ نذهب إلى المطعم، أو نسافر إلى مكان انتظرناه طويلًا، فننشغل بالتصوير أكثر من التذوّق، وبالتوثيق أكثر من الدهشة. نرتّب الأطباق لا لنستمتع بطعمها، بل لتبدو جميلة على صفحاتنا، ونصوّر الطريق والمنظر والغرفة، بينما الإحساس الحقيقي يمرّ بجانبنا بصمت. نملأ صفحاتنا بالصور، لكننا نفرّغ اللحظة من معناها، ونغادر المكان وقد وثّقناه جيدًا… دون أن نكون قد عِشناه حقًا. صرنا نعيش الحدث لنُريه للآخرين، لا لنعيشه لأنفسنا. نقيس جمال اللحظة بعدد الإعجابات، وقيمتها بعدد المشاهدات، ونشعر أحيانًا بخيبة إن لم تلقَ ما توقعناه من تفاعل. وكأن اللحظة خذلتنا، لا لأننا لم نشعر بها، بل لأن الآخرين لم يصفّقوا لها كما أردنا. ونسينا أن بعض اللحظات لا تُقاس بالأرقام، بل تُحَسّ في القلب. توثيق اللحظات ليس خطأ، فالذاكرة تخون أحيانًا، والسنوات تمضي، والصورة قد تحفظ ملامح ووجوهًا وأماكن نحب العودة إليها. لكن الخطأ حين تصبح الكاميرا حاجزًا بيننا وبين الشعور، وحين نغادر اللحظة قبل أن نصل إليها، وحين ينشغل عقلنا بالشكل بينما يفوتنا الجوهر. الأجمل أن نعيش أولًا. أن نضحك بعمق دون التفكير كيف ستبدو الضحكة في الصورة، أن نتأمل بصدق دون استعجال، وأن نشعر بكامل حضورنا. ثم – إن شئنا – نلتقط صورة للذكرى، لا أن نختصر الذكرى في صورة. بعض اللحظات خُلقت لتُعاش لا لتُوثّق، لتسكن القلب لا الذاكرة الرقمية. فلنمنح أنفسنا حق الاستمتاع، وحق الغياب المؤقت عن الشاشات، فالعمر ليس ألبوم صور، بل إحساس يتراكم… وإن فات، لا تُعيده ألف صورة.
816
| 13 يناير 2026




