رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
1667
د. وائل مرزاالعلمانيون إذ يُرسخون (العلمانوفوبيا)
غالباً ما يشعر الكاتب في مثل هذا الموضوع بنوعٍ من (التردد) النفسي والفكري. فالتسطيحُ البالغ في الخطاب السائد، حتى بين كثيرٍ من المثقفين الذين يعتبرون أنفسهم (تقدميين) بمعنى أو آخر، يضع الكاتب وكلماته في خانة التصنيف منذ اللحظة الأولى لقراءة العنوان.
"آها.." يقول هؤلاء في أنفسهم. "ها قد أمسكناهُ بالجُرم المشهود، وحَكَمنا عليه بأنه مُعادٍ للعلمانية" والأغلب أن يُضيفوا "ومُعادٍ لليبرالية". لا فرق أن يحصل هذا بلسان المقال أو أن يكون بلسان الحال.
والحقيقة أن التردد المذكور أعلاه لا ينبع من رهبةٍ قد تصيب البعض بسبب هذا الموقف على المستوى الشخصي، فالتعامل مع هذه القضايا لا يأتي "رغَباً أو رَهَباً"، والمرءُ لا يبحث في هذا المقام عن رضا أحدٍ أو سخطه فيما يطرح، فهذا أهونُ من أن يكون مقياساً للحسابات في الرأي والعمل.
وإنما ينبثق التردد من خوفٍ يصيب المرء من المساهمة في خلط الأوراق، وزيادة الفوضى الفكرية التي تملأ ساحتنا، العربية عموماً، والسورية تحديداً، خاصةً بسبب التسطيح الذي نتحدث عنه. وأكثر من هذا، بسبب عمليات الفرز والتصنيف الحادة السائدة في ثقافتنا الراهنة، والتي تتمحور بشكلٍ كبير حول الموقف من الإسلام ودوره في الحياة.
فمنذ سنوات طويلة، أشهر عزيز العظمة سيف الترهيب بالوقوع في عقلية النزعات التوفيقية أو التلفيقية على كل من حاول أن يجد لـ (التراث) مكاناً في واقع العرب ومستقبلهم. وحتى ندرك حجم المفارقة، يجب أن نتذكر أن السيف المذكور لم يطل (إسلاميين) بالمعنى المألوف لهذا التوصيف، وإنما مثقفين من أمثال الجابري وزكي نجيب محمود وحسن حنفي وحتى غالي شكري!
لقد كتبنا مقالاً سابقاً بعنوان (الثورة السورية إذ تكشف المستور). والحقيقة أن هذه الثورة تبقى في جوهرها عملية تعريةٍ هائلة لكل عيوب المجتمع السوري وثقافته، ربما قبل أن تكون حركة انعتاقٍ من الطغيان السياسي. والواقع أن في هذا خيراً كبيراً، لأن تحطيم أغلال الطغيان الثقافي بكل ألوانه ومصادره هو في النهاية الطريق الوحيد لامتلاك الحرية والكرامة، وإزالة منظومة الطاغوت السياسية مرةً واحدة وإلى الأبد.
ونحن حين نتحدث عن الطغيان الثقافي هنا فإن معانيه لاتنحصر في الظلم العملي المباشر، وإنما تمتد لتشمل محاولات القفز على كل ما له علاقة بالهوية الحضارية الإسلامية التاريخية للمجتمع السوري، وخاصةً حين يحصل هذا من قبل مثقفين (تنويريين) ليبراليين وعلمانيين يُفترض بهم أن يكونوا طليعة المجتمع ووعيهُ المتقدﱢم.
والواضح أن مآلات الثورة، و(شُبهة أسلَمتها) تحديداً، وضعت الغالبية العظمى من هؤلاء في موقفٍ حرج ثقافياً وسياسياً. ونحن إذ نتأمل حالهم مع نهايات العام الثالث للثورة فإننا نرى كيف يُصبحون بشكلٍ مضطرد جزءاً من المشكلة بدل أن يكونوا جزءاً من الحل.
ما من شكٍ أن الثورة كشفت عوار الفكر الإسلامي التقليدي بأشكاله المتنوعة. لكننا نعترف فوق ذلك، وهذا رأيُنا على الأقل، أن الإسلاميين في سوريا كانوا فقراء قبل الثورة في صنعة الثقافة، وأنهم لم يكونوا قادرين على تقديم رموز ثقافية بالمعنى الأصيل للكلمة. من هنا، بقيت ساحة الثقافة حكراً (حلالاً) على من عمل فيها ممن كانوا يوصفون عادةً علمانيين أو ليبراليين.
لكن هذه الحقيقة بحد ذاتها تضع على هؤلاء مسؤوليةً كبيرة.
فلئن كان الزهدُ في استيعاب الرؤية الإسلامية وتأثيرها في المجتمع السوري ترفاً ممكناً قبل الثورة. إلا أن استمرار تلك الممارسة في واقعها الراهن يعني في أقل الأحوال تجاهلاً مُعيباً للدور الطليعي للمثقف. أسوأ من هذا أن يصبح هاجسُ بعضهم، خاصةً ممن انتقلوا إلى عالم السياسة، معارضةً وموالاة، العملَ بكل طريقةٍ ممكنة لمحاصرة أي صفةٍ إسلامية للثورة.
ليس غريباً إذاً أن نرى كيف يُكرسُ العلمانيون أنفسهم ظاهرة العلمانوفوبيا.
وها نحن اليوم بإزاء ظاهرةٍ فريدة في سوريا، حيث خسرت الثقافة بعضاً من كبار رموزها دون أن تربحهم السياسة.
ثمة مائة مأخذٍ ومأخذ على ممارسات كثيرٍ من الإسلاميين الذين أصبحوا القوة الأكبر في الواقع السوري. وعندنا أن هذه المآخذ تنبثق من رؤيةٍ شموليةٍ للإسلام نفسه قبل أن تكون صادرةً عن أي رؤيةٍ أخرى.
لكن طريقة تعامل الغالبية العظمى من المثقفين العلمانيين والليبراليين مع الموضوع بأسره يبقى غريباً وغير مفهوم، إذا أخذنا بعين الاعتبار مقتضيات دور المثقف الحقيقي في عدم إنكار الواقع أولاً، ثم في فهمه بدقة، والإحاطة بمتغيراته، وصولاً إلى امتلاك اليقين بالقدرة على التأثير فيه إذا توفرت شروط العدل والموضوعية في القراءة والتحليل.
الأرجح أن الأمل بات مفقوداً فيمن اقتحم ساحة السياسة ودهاليزها من أولئك المثقفين، ولئن كان هناك بصيص أملٍ في قلةٍ كان يبدو أنها تحاول إلى أمدٍ قريب، إلا أن بعض الوقائع تجعل المرء يخشى من فقدان الأمل نهائياً بدورهم أيضاً. وهذه أزمةٌ مؤلمة لسوريا، فضلاً عن كونها مؤلمة على غياب الكمون المأمول لهم ولمنظوماتهم الفكرية في تقوية منظومة التعددية الثقافية والاجتماعية والسياسية لسوريا المستقبل.
أخشى ما نخشاه أن يصدُقَ في زملائنا تحليل المثقف السعودي الليبرالي تركي الحمد منذ سنوات حين قال: ".. بوضوحٍ أكبر، يمكن القول أن الليبرالية هي ايديولوجيا واعية بذاتها الأيديولوجية، وهنا تكمن قوتها من حيث وعي القائلين بها أن كل شيء ممكن. وبإيجاز العبارة، فإن الليبرالية في النهاية هي تحرير الأيديولوجيا من الأيديولوجيا، وهذا ليس تلاعباً بالألفاظ بقدر ما هو تقرير حالةٍ تاريخية معينة بأقل قدرٍ من الإسهاب. نقطة الضعف الرئيسية في الأيديولوجيا الليبرالية لا تكمن في نسقها المفتوح، ولا في أفكارها الفلسفية، بقدر ما تكمن في المعبرين عنها، دولاً أو أفراداً أوجماعات، حين يمنحون مفاهيمها معاني مطلقة وفق ظروفهم ومحيطهم هم دون غيرهم، وبذلك يُغلقون ما هو مفتوحٌ أصلاً، ويزعزعون فكرة التعددية والتسامح والتعايش التي لا ليبرالية دونها. بمثل هذا الفعل، تتحول الليبرالية إلى أيديولوجيا بنصٍ مُغلق، مثلها مثل غيرها من أيديولوجيات، ويغيب الوعي عن معتنقيها من أنهم يُمارسون فعلاً أيديولوجيا في النهاية مهما بلغ عمق الإيمان بالمقولات المطروحة، وبذلك تحكم على نفسها بالفناء في النهاية".
اقرأ المزيد
 زيتونتي ماتت.. وبقيت أنا !
زيتونتي ماتت.. وبقيت أنا !
الهوينا كان يمشي، هنا فوق رمشي، اقتلوه بهدوءٍ، وأنا أهديه نعشي...... صدق القائل ومِنَ الحُبِ ما قَتل، هذا... اقرأ المزيد
219
| 31 أكتوبر 2025
 بيد الوالدين تُرسم ملامح الغد
بيد الوالدين تُرسم ملامح الغد
تُعتبر الأسرة الخلية الأولى في المجتمع وأحد أهم العوامل المؤثرة في بناء شخصية الطفل، حيث تُسهم في تكوين... اقرأ المزيد
210
| 31 أكتوبر 2025
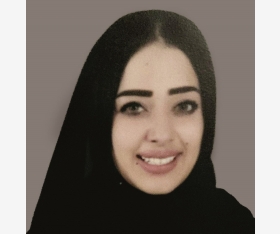 الخطأ في تشخيص حالات التوحد (ASD)
الخطأ في تشخيص حالات التوحد (ASD)
ظهرت للأسف من قبل أخصائيين غير مدربين على كفاءة وضمير مهني التجارة بمسمى العلاج وعدم الإدراك والفهم والوعي... اقرأ المزيد
168
| 31 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

رأي الشرق
-
إعدام الكلمة واغتيال الكاميرا !

جاسم الشمري
-
التلوث الكيميائي والإشعاعي الخطير في قابس بعد تشيرنوبيل

د. أحمد القديدي
-
زيتونتي ماتت.. وبقيت أنا !

غادة عايش خضر
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 جريمة صامتة.. الاتّجار بالمعرفة
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6654
| 27 أكتوبر 2025
- 2 طيورٌ من حديد
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2742
| 28 أكتوبر 2025
- 3 المدرجات تبكي فراق الجماهير
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2334
| 30 أكتوبر 2025




