رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
343
العزب الطيب الطاهرإشارات الانتفاضة الثالثة
تلوح في الأفق بقوة إشارات انتفاضة فلسطينية ثالثة. رغم حرص كل من السلطة الوطنية. بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن وسلطة الاحتلال الصهيوني على تجنبها. بيد أن عدوانية السلطة الأخيرة واستمرائها القتل الممنهج. ضد الفلسطينيين على نحو ينطوي على كافة ألوان الاستهانة بهم كبشر وكمواطنين. فضلا عن استمرارها في تدنيس مقدساتهم وفي مقدمتها قدس الأقداس - المسجد الأقصى -الذي لم تفتر همة قطعان المستوطنين مدعومين بقوات الأمن والجيش. عن اقتحامه بصورة يومية في تحد سافر للمشاعر الدينية تدفع الأمور دفعا. إلى تبني خيار الانتفاضة والتي ستكون هذه المرة أكثر اندفاعا. وربما تتجه إلى تعميق فعل العسكرة. بحسبان أن منهجية الخيارات السلمية التي اتبعت على مدى العقد والنصف الفائتين. لم تفض إلا إلى المزيد من عدوانية الكيان وقطعان مستوطنيه. والتهام المزيد من الأراضي ضمن مشروعه الاستيطاني الاستعماري الذي تطبقه حكوماته المتعاقبة. والذي اتسع نطاقه في زمن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الأشد تطرفا من فرط تشكلها من عتاة المستوطنين. الذين باتوا يفرضون معادلتهم التلمودية على المشهد الصهيوني الداخلي برمته. خشية انفراط عقد التحالف الذي يربطهم بالإرهابي الأكبر نتنياهو.
واللافت أن موجات الغضب الفلسطيني باتت تنطلق من كل أنحاء فلسطين. سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو داخل الأراضي التي احتلت في العام 1948. فتوحد الفلسطينيون ربما للمرة الأولى منذ عقود في مواجهة النزوع العدواني الصهيوني. الذي لا يترك المقدس أو البشر أو الحجر. دون أن يطاله بشراسته التي تؤكد أنه ما زال سادرا في غيه وماضيا في مشروعه. لإنهاء كل ما هو فلسطيني وتكريس وجوده الغاصب. بصرف النظر عن كل ما يتردد عبثا من حلول ومبادرات وخيارات سلام. لأنها لم تعد قادرة على ردع المعتدي. وإنما تكتفي فقط بتوجيه فوهاتها إلى الطرف المعتدى الضحية المحتل. والذي قدم على مدى ثلاثة عقود كل ما يمكن اعتباره محفزا للطرف الآخر. لكي يقبل بمعادلة سلام تقوم على انسحابه من الأراضي المحتلة في يونيو من العام 1967. مقابل القبول بإقامة علاقات طبيعية معه. بل إن ثمة دولتين عربيتين هما مصر والأردن وقعتا معه بالفعل على اتفاقيتي سلام معه ورغم ذلك لم يتخل مطلقا عن منظوره العدواني للدولتين وشعبهما.
ووفق قناعتي أنه لم يعد خيار أمام الفلسطينيين سوى الانخراط في انتفاضة ثالثة. على الرغم مما يبدو من كلفة عالية قد تصل إلى حد قيام جيش الاحتلال الصهيوني. بعملية اجتياح واسعة لمدن الضفة الغربية وربما قطاع غزة. بعد مشاركة شبابه بقوة في موجة الغضب الراهنة. والأثمان الباهظة التي تدفعها الشعوب من أجل نيل حريتها واستقلالها هي واحدة من حقائق التاريخ والذي حفل بتضحيات الشعوب خلال مقاومتها للمحتل والغاصب وبعضها تجاوز مداه الزمني أكثر من 130 عاما مثل الشعب الجزائري الذي قدم مليون شهيد من شعبه لكنه في الأخير استعادة هويته التي كادت فرنسا الاستعمارية أن تمحوها من الحضور، ورفل في أثواب استقلاله. ومن ثم فإنه ينبغي أن يتوقف المرجفون والرافضون للانخراط في المقاومة بكل أشكالها ضد العدو الصهيوني الشديد الشعور بغطرسة القوة التي يمتلك بالفعل مقوماتها من جراء الإسناد الأمريكي والذي بلغ منذ سنوات مستوى التحالف الإستراتيجي معه وتبنى عقيدة تقوم على ضمان أمنه وضمان تفوقه العسكري على كافة جيرانه من العرب وغير العرب.
إن عبارة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي قالها في أعقاب هزيمة يونيو 1967 والتي أكد فيها أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة ما زالت صالحة وقابلة للتطبيق في فلسطين على الرغم مما يبدو من ميل ميزان القوة لصالح العدو الصهيوني على نحو يتجاوز بكثير إمكانات الشعب الفلسطيني. غير أن الروح القتالية والنضالية لهذا الشعب بمقدورها أن تتغلب على هذا العامل. وقد تحقق ذلك في أمثلة تفوق الكيان المدعوم بالأساس من قوى خارجية فالشعب الفيتنامي أنجز انتصاراته على الولايات المتحدة الأمريكية - القوة العالمية الأولى - في سبعينيات القرن الفائت والشعب الأفغاني أجبر الاتحاد السوفييتي – القوة العالمية الثانية- على الانسحاب من أراضيه ثمانينات القرن نفسه.
ولكن تجسيد هذه الحقيقة على الأرض. ولضمان انتفاضة قوية على الأرض يمكنها أن تسفر عن تغيير المعادلة السائدة في الأراضي المحتلة. لصالح حقوق الشعب الفلسطيني يتعين تحقيق جملة من المطالب:
أولا: الإسراع بتوحيد جهود كل الفصائل الفلسطينية والسعي إلى تجاوز كل خلافاتها لاسيَّما فتح وحماس. واللتان تمتلكان المساحة الشعبية الأوسع والقدرات التنظيمية الأكثر رسوخا. فمعادلة الخلاف التي ظلت سائدة منذ يونيو 2007 يجب أن تنتهي فورا وأن تتم إزالة كل مخلفاتها التي أضرمت نيران الكراهية والتناقض بين مشروعين. هما في الأساس موجهان للتحرير وليس لإشعال فتيل الحرب بينهما. إن القدس والأقصى والشهداء الذين رحلوا خلال الأيام القليلة الماضية ومن قبل ومن بعد. وكل الحقوق المغتصبة والأسرى الذين ما زالوا قابعين في سجون الاحتلال. والأطفال والأسر الذين قتلوا حرقا وبالرصاص الحي والمطاطي. يستحقون أن تتوحد من أجلهم كل الإمكانات النضالية للقوى الحية الفلسطينية.
ففي ظل استمرار الخلافات والتناقضات والانتهاكات المتبادلة فرض العدو معادلاته الاستيطانية والاستعمارية. وتمدد إلى القدس لتهويدها وأقصاها لتقسيمه زمانيا ومكانيا. تكفي كل هذه السنوات من غياب المصالحة.
ثانيا: إن النظام الإقليمي العربي مطالب بالتخلي عن دبلوماسيته الهادئة والناعمة. في التعاطي مع الكيان المحتل والعدو الذي ما زال يحتل الأرض.
إن لغة خطاب جديدة مطلوبة في المرحلة الراهنة. فلم تعد عبارة "السلام خيارنا الإستراتيجي" ملائمة للتعامل مع عدوانية قطعان بني صهيون. بالطبع لا أدعو إلى إعلان حالة الحرب من قبل الدول العربية. فذلك أدرك مدى صعوبته إلى حد الاستحالة في المرحلة الراهنة على الأقل. بفعل سيطرة حالة اضطراب غير مسبوقة على الأمة ودولها. والتي دفعتها دفعا إلى إزاحة القضية الفلسطينية من مرتبة القضية المركزية الأولى. إلى خانة القضية العادية النمطية اليومية التي لم تعد تلهم حماسا أو تحظى بتأييد مثلما كان الحال عليه قبل ثورات الربيع العربي. وفي الوقت نفسه فإن انتفاضة الشعب الفلسطيني المرتقبة. في حاجة إلى شبكة أمان مالية عربية وثمة قرارات صدرت في هذا الاتجاه منذ قمة بغداد في 2012. قضت بتوفير مائة مليون دولار للسلطة الوطنية شهريا مازالت بمنأى عن التزام أغلبية الدول العربية - ما عدا قلة قليلة - وبالتالي فإن تفعيل هذا الالتزام. فضلا عن دفع الدول العربية لمستحقاتها في صندوقي الأقصى والانتفاضة. والمقررة منذ قمة سرت في العام 2010 ضروري في هذه المرحلة بإلحاح. حتى يكون ذلك رافدا للمرحلة الجديدة لنضال الشعب الفسطيني. الذي يتساءل رجاله وشبابه ونساؤه دوما عن العرب.
ثالثا: إن تحركا فلسطينيا وعربيا على المستويين الإقليمي والدولي. متزامنا مع انطلاق الانتفاضة الجديدة أو حتى موجات الغضب الراهنة. من شأنه أن يشكل عنصر إسناد فاعلا لاسيَّما لدى النخب الثقافية بالذات داخل الجامعات والنخب السياسية والقوى الحزبية والبرلمانية. وذلك حتى يمكن تغيير توجهاتها لصالح نضال الشعب الفلسطيني. والذي تحركت قوى عديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وحتى داخل الولايات المتحدة باتجاه تأييد حقوقه. بعد ما ترسخت لديها عدوانية الكيان وشراسة حكامه. المهم الاستمرار في هذا المنحى. ما يتطلب بالتأكيد تمويلا يمكن لبعض المؤسسات ورجال المال العرب أن يلعبوا دورا إيجابيا في توفيره.
اقرأ المزيد
 «ومن طلب العلا رقد الليالي.. !»
«ومن طلب العلا رقد الليالي.. !»
مثل كثيرين غيري، كنت أعتقد أن تقليل ساعات النوم قدر الإمكان علامة على الإنتاجية والطموح، وطريق مختصر للتميّز... اقرأ المزيد
18
| 06 فبراير 2026
 تبسّم ...!
تبسّم ...!
التبسم بلسم للهموم والأحزان، وله طاقة مذهلة في بثّ الفرح في القلوب والأفئدة، كان الرسول صلى الله عليه... اقرأ المزيد
24
| 06 فبراير 2026
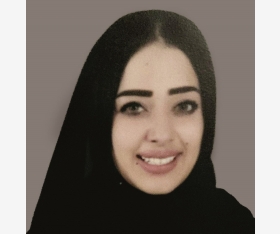 دور الشرطة المجتمعية في المدارس
دور الشرطة المجتمعية في المدارس
دور الشرطة المجتمعية هام في تحقيق الأمان لأولياء أمور الطلاب والمراهقين بالأخص، نظراً إلى بعض الحالات الاجتماعية المتعددة،... اقرأ المزيد
30
| 06 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
قطر وألمانيا.. تعاون إستراتيجي مثمر

رأي الشرق
-
الذكاء الاصطناعي في الميزان!

جاسم الشمري
-
الارتباط الوثيق بين الأزمات وعملات الدول

د. أحمد القديدي
-
«ومن طلب العلا رقد الليالي.. !»

تنصيح الرحمن الوافي
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 الشمال يتألق وأم صلال يتراجع
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2028
| 04 فبراير 2026
- 2 فريدريك ما زال حياً
حين وصل الملك فريدريك الثاني الشام سنة 1228م، لم تُسجَّل له معركة كبرى أمام القدس ولم يُحاصرها بجيش يزلزل الأرض. ومع ذلك تسلم مفاتيح بيت المقدس، وذلك باتفاق مع السلطان الأيوبي الذي ليس له من اسمه نصيب (الملك الكامل). هذا الحاكم سلّم بموجب اتفاق مفاتيح القدس. لم تكن هزيمة عسكرية، بل تنازلًا سياسيًا مُخزيًا ووصمة عار في جبين الأمة حتى يومنا هذا، ولتصحيح هذا الخطأ مات الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يقف السؤال في وجه التاريخ: لماذا أُعطيت القدس بهذه السهولة؟ الجواب المؤلم يبدأ من داخل الدولة الأيوبية آنذاك لأنها كانت تعيش انقسامات. والكامل هذا كان في صراع مع إخوته وأقاربه على النفوذ في الشام، ويخشى تحالفهم ضده. فاختار أن يجعل الدولة الصليبية حائط صد بينه وبين إخوته، فماذا فعل؟! أعطى لفريدريك مفاتيح أقدس مقدسات المسلمين بلا مقابل، فقط ليأمن على سلطانه في مصر. صارت القدس ورقة في لعبة توازنات داخلية. لم تُبع في سوق، لكنها استُخدمت لتثبيت كرسي. بمعنى أوضح، مدينة بقدسيتها، بتاريخها، بدماء من سقطوا دفاعًا عنها، تحولت إلى بند في معاهدة. وهنا تكمن المرارة لأن القدس لم تكن أرضًا عادية، بل رمزًا دينيًا وحضاريًا استعادها قبل عقود صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين، وما أدراك ما حطين مشروع طويل من الإعداد والوحدة والتضحية. يومها لم تكن المسألة كرسي حكم، بل قضية أمة. صحيح أن بعض الروايات تبالغ في تقليل عدد من رافق فريدريك إلى أقل من 1000 مقاتل فقط لأنه كان مطرودًا من البابوية وغير مرغوب فيه في أوروبا وليس له وزن، ومع ذلك يتسلم هذا المطرود المنبوذ مفاتيح أولى القبلتين. وهنا الدرس الذي لا يشيخ: حين تنقسم الصفوف، يصبح الخصم أقل كلفة. لا يحتاج أن ينتصر، يكفيه أن يراقب وينتظر. هذا الفريدريك قام بمجازر ضد المسلمين في صقلية، وأرسل إليه الكامل يطلب منه التوقف لِظن هذا الناقص أن فريدريك سيحفظ له فضل وجميل إعطاء القدس كهدية، ولكن فريدريك مزّق المسلمين وفعل بهم الأعاجيب. وليس اليوم ببعيد عن أمس، فمن يظن أن الغرب يهتمون بدماء وأعراض المسلمين هو ناقص كهذا الذي نتحدث عنه. والتاريخ الإسلامي نفسه مليء بأمثلة معاكسة. رجال ضحّوا بالملك من أجل المبدأ، وفضلوا الثبات على المكسب العاجل. من زمن الصحابة الذين خرجوا يواجهون إمبراطوريات تفوقهم عددًا وعدة، إلى قادة مثل عمر المختار الذي اختار المقاومة على الخضوع، ودفع حياته ثمنًا، لكنه لم يبع كرامته. هؤلاء لم ينظروا إلى القضية كورقة تفاوض، بل كأمانة أمة. ما أريد قوله من هذه الواقعة التي مر عليها أكثر من ثمانمائة عام، وما زال صداها في الذاكرة، أن أخطر ما يضعف الدول المسلمة ليس قوة الخارج، بل خلاف الداخل، والخضوع لا يبدأ دائمًا برغبة في الاستسلام، بل أحيانًا بخوف من فقدان منصب، أو حرص على تثبيت حكم هو أصلًا زائل. ألا يكفي أن نرى النتيجة؟ حين تُقدَّم التنازلات لتجاوز أزمة داخلية أو مصلحة شخصية، قد تتحول تلك التنازلات إلى أزمات أكبر وأعمق وأشد إذلالًا. الهيبة لا تُبنى بالخطابات، بل بوحدة القرار، وبوضوح الخطوط التي لا تُمس. فالأوطان والمقدسات والثروات ليست ملكًا خاصًا للحُكام، ولا هدية تُقدَّم طلبًا لرضا القوى العظمى. الأصل: (إن تنصروا الله ينصركم). تسليم القدس سنة 1229م لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل علامة على أن الذل والخنوع والخيانة قد يفتح ما لا تفتحه الجيوش الجرارة والطائرات المسيّرة. ومن لا يتعظ بما مضى، قد يجد نفسه يعيد المشهد ذاته بأسماء جديدة.
822
| 04 فبراير 2026
- 3 هل قتل «السور» روح «الفريج»؟
امشِ في أحد أحيائنا القديمة التي بقيت على حالها، إن وجدتَها. ستلاحظ شيئاً غريباً في التصميم: الجدران قصيرة، والأبواب تكاد تكون متقابلة، و»السكيك» ضيقة وكأنها صُممت لتجعل الناس يصطدمون ببعضهم البعض فيلقون السلام. كان العمران هناك «خادماً» للوصل. وكانت روح الفريج حاضرة في كل تفصيلة معمارية. كان الحجر يُجبر البشر على التلاقي. ثم انتقل بسيارتك إلى أحيائنا السكنية الحديثة. شوارع فسيحة، وفلل تشبه القلاع الحصينة. كل بيت يحيط نفسه بسور عالٍ، وبوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة. لقد حصلنا على «الخصوصية» التي كنا نحلم بها، ولكن، هل سألنا أنفسنا عن الثمن؟ المعادلة بسيطة ومؤلمة: كلما ارتفعت الجدران الإسمنتية بين البيوت، ارتفعت معها الجدران النفسية بين القلوب، وتآكلت روح الفريج شيئًا فشيئًا. في زمن «الفريج»، كان الجار هو «خط الدفاع الأول»، وهو «الأهل» الأقرب. كانت الأمهات يتبادلن الأطباق، والأطفال يركضون من بيت لآخر وكأن الحي كله بيت واحد كبير. كانت «عين الجار» حماية، وصوته أنساً. لم يكن الفريج مجرد مكان للسكن، بل كان «نظاماً اجتماعياً» متكاملاً للتكافل والتربية المشتركة. اليوم، تحت ذريعة «الخصوصية» و»الاستقلالية»، عزلنا أنفسنا. أصبحنا نعيش لسنوات بجانب شخص لا نعرف إلا نوع سيارته. قد يمرض الجار، أو يحزن، أو يفرح، ولا نعلم عنه شيئاً إلا إذا رأينا خيام العزاء أو الزفاف صدفةً عند الباب. تحول الجار من «سند» إلى «غريب»، وأحياناً إلى مصدر إزعاج نشتكي منه إذا أوقف سيارته أمام سورنا. لقد قتلنا «روح الفريج» بدم بارد، واستبدلناها بـ «ثقافة العزلة». نحن لا ننكر أن التطور العمراني ضرورة، وأن الخصوصية حق. لا أحد يطالب بالعودة إلى بيوت الطين وضيق المكان. ولكننا نطالب بـ «أنسنة» مدننا الحديثة. المشكلة ليست في «الحجر» وحده، بل في «البشر» الذين سمحوا لهذه الأسوار أن تتسلل إلى نفوسهم. لقد استوردنا تصاميم هندسية غربية تقدس الفردية، ونسينا أننا مجتمع «جمعي» يتنفس الوصل. صممنا مدناً للسيارات لا للمشاة، وللأبواب المغلقة لا المشرعة. هل يمكننا استعادة ما فقدناه؟ نعم، ولكن البداية ليست بـ «هدم الأسوار» الإسمنتية، بل بهدم «الأسوار النفسية». أن نمتلك الشجاعة لنطرق باب الجار ومعنا «طبق حلو» وابتسامة، بلا مناسبة. أن نُحيي «مجلس الحي» ولو مرة في الشهر. أن نعلم أطفالنا أن «حق الجار» ليس مجرد كف الأذى، بل هو بذل الندى، والسؤال، والاهتمام. وهو جوهر روح الفريج. إن «الوحشة» التي نشعر بها في أحيائنا الفارهة لا يعالجها المزيد من الرخام والزجاج، بل يعالجها «دفء» القلوب المتواصلة. فلنجعل بيوتنا قلاعاً تحمينا من الخارج، نعم، ولكن لا تجعلها سجوناً تعزلنا عمن هم أقرب الناس إلينا جغرافياً، وأبعدهم عنا شعورياً.
690
| 04 فبراير 2026




