رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
2475
البروفيسور د. أحمد أويصالمدارس الأئمة والخطباء.. نموذج تركي فريد بين التقليد والحداثة
يعود تاريخ مدارس الأئمة والخطباء (الإمام والخطيب)، التي نراها اليوم كتجربة مثيرة للاهتمام تجمع بين التقليد والحداثة في العالم الإسلامي إلى العصر العثماني، لكنه لم يشهد مصيرا مماثلا لمعظم المدارس التعليمية الأخرى. وذلك جراء زيادة الضغط على الدين نتيجة لرؤية مؤسسي الجمهورية التركية للإسلام على أنه عائق أمام الحداثة والتطور.
بواسطة قانون «توحيد التعليم» الصادر في 3 مارس 1924، أرادت الحكومة التركية توحيد النظام التعليمي وتحديد الهيكلية التعليمية بشكل موحد، مما أدى إلى تحويل مدارس دار الخلافة إلى مدارس الإمام والخطيب. وكنتيجة لذلك، شهد التعليم الديني تراجعًا ملحوظًا في الفترة اللاحقة.
ولأجل تدريب الأئمة والدعاة المحدثين، قامت الحكومة العلمانية بإدراج مواد أخرى إلى جانب الدروس الإسلامية مثل اللغة الفرنسية، والتاريخ، والجغرافيا، والرياضيات، والبيولوجيا، والفيزيولوجيا، والموسيقى، وعلم النفس، وعلم الاجتماع. وعلى الرغم من قلة الدعم الحكومي، إلا أن هذه المدارس استمرت في لفت الانتباه بشكل كبير. ومع ذلك، لم يتم تعيين الخريجين بصفة رسمية كأئمة أو وعاظ، وتم إغلاق هذه المدارس في عام 1930 بذرائع مختلفة. خلال الفترة من عام 1930 إلى 1945، عانى الشعب التركي بشكل كبير من الصعوبات الاقتصادية، ومن نقص الخدمات الدينية من الناحية الأخرى.
بعد عام 1945 وفي مرحلة انتقال البلاد إلى الديمقراطية، كانت نقطة جدلية بين الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الشعب الجمهوري القائم هي نقص الأئمة والحاجة إلى مدارس الأئمة والخطباء. ففي عام 1948، قامت حكومة حزب الشعب الجمهوري بفتح دورات تدريب الأئمة في 10 مدن. وضمت برامج الدورات دروسًا دينية أساسية، بالإضافة إلى اللغة التركية، والتاريخ، والجغرافيا، والثقافة، ولم يتم تضمين دروس في الفقه بسبب المخاوف من الشريعة، ولم تكن هناك دروس في الرياضيات والعلوم التقنية. فتح الدورات بدلاً من إنشاء مدارس يظهر أن هذا القرار كان بدافع سياسي ولم يكن جادًا في تلبية الحاجة الحقيقية للأئمة.
في عام 1950، قررت حكومة الحزب الديمقراطي الفائز في الانتخابات فتح مدارس لتأهيل الأئمة والوعاظ في سبع محافظات في العام التالي. وفي عام 1955، بدأ تدريس المرحلة الثانوية في هذه المدارس، حيث كان نصف المنهج مكونا من دروس دينية والنصف الآخر من دروس ثقافية وتقنية. ومع زيادة الطلب الاجتماعي في الستينيات، زاد عدد هذه المدارس إلى أكثر من 70 مدرسة. وعندما أثار الطلب المتزايد انزعاج النخب العلمانية، تمت إزالة دروس الدين من المنهاج الأساسي وصعّبت عملية الانتقال إلى المرحلة الثانوية في مدارس الأئمة والخطباء، كما تم تعقيد دخول خريجي مدارس الأئمة والخطباء إلى الجامعة. ولكن العديد من الخرجين مثل رجب طيب أردوغان تمكنوا من الالتحاق بالجامعة بشهادة الدراسة الثانوية العادية من خلال حضور دورات إضافية لتحقيق ذلك.
قبل مدارس الأئمة والخطباء، كان الشعب التركي المحافظ يقاطع التعليم الرسمي خوفا من الإلحاد. هذه المدارس جامع بين التعلم والتدين. عندما انضم حزب الرفاه الإسلامي، بزعامة نجم الدين أربكان، إلى حكومة ائتلافية في عام 1974، فُتحت أبواب مدارس الإمام والخطيب. وتمت إعادة إدخال دروس القرآن واللغة العربية في المرحلة الإعدادية، وتأسيس العديد من المدارس الجديدة. وبفضل دعم حكومات ديميرال، زاد عدد هذه المدارس إلى 374 مدرسة حتى عام 1980، عندما وقع انقلاب عسكري، شهد عدد الطلاب زيادة بنسبة 9 أضعاف بين عامي 1973 و1978. على الرغم من تأكيد النخب العلمانية على أهمية المرأة، إلا أنها عارضت بشدة فكرة دراسة الفتيات في مدارس الإمام والخطيب، حيث كان من المعتقد أنهن لا يمكنهن أن يصبحن أئمة. ومع ذلك، تخرجت الفتيات في هذه المدارس وعملن بعد ذلك كمدرسات وواعظات في دورات تعليم القرآن.
على الرغم من محاولة الإدارة العسكرية لانقلاب 1980 منع افتتاح مدارس الأئمة والخطباء الثانوية، إلا أن حكومة تورغوت أوزال تغلبت على هذه العقبة من خلال فتح فروع جانبية. ومع زيادة الهجرة إلى المدينة والطلب على التعليم في الثمانينيات في تركيا، زاد عدد المدارس وتحسنت جودة هذه المدارس.
وبفضل اجتياز العديد من الأطفال لامتحان القبول، تمكن الأطفال الأكثر ذكاءً من الالتحاق بتلك المدارس. وعندما بدأ الشباب الدارسون للمعرفة الدينية والدنيوية يحتلون المرتبة الأولى في امتحانات القبول بالجامعات في التسعينيات، ازدادت جاذبية المدارس. ومع القلق من انتشار التدين والوعي الإسلامي في تركيا، قام الانقلاب العسكري عام 1997 بإغلاق القسم المتوسط من مدارس الأئمة والخطباء وجعل من الصعب عليهم الانتقال إلى الجامعات.
حين تولى حزب العدالة والتنمية الحكم في عام 2002، تم رفع هذه العقبات، وتسهيل دخول خريجي مدارس الإمام والخطيب إلى الجامعات، وأُتيح للطالبات ارتداء الحجاب بحرية. ورأى الشعب التركي في مدارس الأئمة والخطباء مكانًا يمكن لأبنائهم أن يحصلوا فيه على تعليم ديني ودنيوي متكامل. وعلى الرغم من أن منهاج المدارس أكثر صعوبة مقارنة بالمدارس العادية، إلا أن خريجيها حققوا نجاحًا أكبر في الالتحاق بجامعات قوية خاصة في التخصصات الاجتماعية والتقنية. تم بناء معظم مدارس الإمام والخطيب بتبرعات من الشعب، وبعد ذلك قامت الحكومة بتعيين المعلمين فيها. وتستحق هذه المدارس اهتمامًا أكبر كنموذج فريد يجمع بين العلوم الحديثة والعلوم الإسلامية لإبراز الهوية الإسلامية بشكل متكامل.
اقرأ المزيد
 زيتونتي ماتت.. وبقيت أنا !
زيتونتي ماتت.. وبقيت أنا !
الهوينا كان يمشي، هنا فوق رمشي، اقتلوه بهدوءٍ، وأنا أهديه نعشي...... صدق القائل ومِنَ الحُبِ ما قَتل، هذا... اقرأ المزيد
87
| 31 أكتوبر 2025
 بيد الوالدين تُرسم ملامح الغد
بيد الوالدين تُرسم ملامح الغد
تُعتبر الأسرة الخلية الأولى في المجتمع وأحد أهم العوامل المؤثرة في بناء شخصية الطفل، حيث تُسهم في تكوين... اقرأ المزيد
114
| 31 أكتوبر 2025
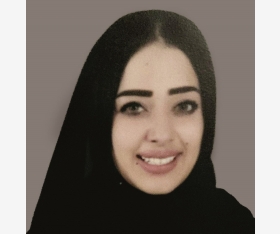 الخطأ في تشخيص حالات التوحد (ASD)
الخطأ في تشخيص حالات التوحد (ASD)
ظهرت للأسف من قبل أخصائيين غير مدربين على كفاءة وضمير مهني التجارة بمسمى العلاج وعدم الإدراك والفهم والوعي... اقرأ المزيد
45
| 31 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
البروفيسور د. أحمد أويصال
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

رأي الشرق
-
إعدام الكلمة واغتيال الكاميرا !

جاسم الشمري
-
التلوث الكيميائي والإشعاعي الخطير في قابس بعد تشيرنوبيل

د. أحمد القديدي
-
زيتونتي ماتت.. وبقيت أنا !

غادة عايش خضر
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 جريمة صامتة.. الاتّجار بالمعرفة
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6621
| 27 أكتوبر 2025
- 2 من يُعلن حالة الطوارئ المجتمعية؟
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتصارع فيه المفاهيم، باتت القيم المجتمعية في كثيرٍ من المجتمعات العربية أقرب إلى «غرفة الإنعاش» منها إلى الحياة الطبيعية. القيم التي كانت نبض الأسرة، وعماد التعليم، وسقف الخطاب الإعلامي، أصبحت اليوم غائبة أو في أحسن الأحوال موجودة بلا ممارسة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يُعلن حالة الطوارئ لإنقاذ القيم قبل أن تستفحل الأزمات؟ أولاً: التشخيص: القيم تختنق بين ضجيج المظاهر وسرعة التحول: لم يعد ضعف القيم مجرد ظاهرة تربوية؛ بل أزمة مجتمعية شاملة فنحن أمام جيلٍ محاط بالإعلانات والمحتوى السريع، لكنه يفتقد النماذج التي تجسّد القيم في السلوك الواقعي. ثانياً: الأدوار المتداخلة: من المسؤول؟ إنها مسؤولية تكاملية: - وزارة التربية والتعليم: إعادة بناء المناهج والأنشطة اللاصفية على قيم العمل والانتماء والمسؤولية، وربط المعرفة بالسلوك. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: تجديد الخطاب الديني بلغة العصر وتحويل المساجد إلى منصات توعية مجتمعية. - وزارة الثقافة: تحويل الفنون والمهرجانات إلى رسائل تُنعش الوعي وتُعيد تعريف الجمال بالقيمة لا بالمظهر. - وزارة الإعلام: ضبط المحتوى المرئي والرقمي بما يرسّخ الوعي الجمعي ويقدّم نماذج حقيقية. - وزارة التنمية الاجتماعية: تمكين المجتمع المدني، ودعم المبادرات التطوعية، وترسيخ احترام التنوع الثقافي باعتباره قيمة لا تهديدًا. ثالثاً: الحلول: نحو حاضنات وطنية للقيم: إن مواجهة التراجع القيمي لا تكون بالشعارات، بل بإنشاء حاضنات للقيم الوطنية تعمل مثل حاضنات الأعمال، لكنها تستثمر في الإنسان لا في المال. هذه الحاضنات تجمع التربويين والإعلاميين والمثقفين وخبراء التنمية لتصميم برامج عملية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب تُترجم القيم إلى ممارسات يومية، وتنتج مواد تعليمية وإعلامية قابلة للتكرار والقياس. كما يمكن إطلاق مؤشر وطني للقيم يُقاس عبر استطلاعات وسلوكيات مجتمعية، لتصبح القيم جزءًا من تقييم الأداء الوطني مثل الاقتصاد والتعليم. رابعا: تكامل الوزارات:غرفة عمليات مشتركة للقيم: لا بد من إطار حوكمة ؛ • إنشاء مجلس وطني للقيم يُمثّل الوزارات والجهات الأهلية، يضع سياسة موحّدة وخطة سنوية ملزِمة. مؤشرات أداء مشتركة • تُدرج في اتفاقيات الأداء لكل وزارة • منصة بيانات موحّدة لتبادل المحتوى والنتائج تُعلن للناس لتعزيز الشفافية. • حملات وطنية متزامنة تُبث في المدارس والمساجد والمنصات الرقمية والفنون، بشعار واحد ورسائل متناسقة. • عقود شراكة مع القطاع الخاص لرعاية حاضنات القيم وبرامج القدوة، وربط الحوافز الضريبية أو التفضيلية بحجم الإسهام القيمي. الختام..... من يُعلن حالة الطوارئ؟ إنقاذ القيم لا يحتاج خطابًا جديدًا بقدر ما يحتاج إرادة جماعية وإدارة محترفة. المطلوب اليوم حاضنات قيم، ومجلس تنسيقي، ومؤشرات قياس، وتمويل مستدام. عندها فقط سننقل القيم من شعارات تُرفع إلى سلوك يُمارس، ومن دروس تُتلى إلى واقع يُعاش؛ فيحيا المجتمع، وتموت الأزمات قبل أن تولد.
6492
| 24 أكتوبر 2025
- 3 طيورٌ من حديد
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2676
| 28 أكتوبر 2025




