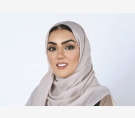رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
886
د. وائل مرزافي نَقدِ واقِعنا.. والشكوى من نَقدِه
هل يمكن أن تكون هناك مُبالغةٌ في نقدِ واقعنا، بحيث تفقد عملية النقد معناها الحقيقي، وتتحول إلى هدفٍ بحد ذاتها، وفق مقولة النقد لمجرد النقد؟ هذا ممكنٌ دوماً على مستوى بعض الأفراد الذين يُمارسون تلك العملية، والأسباب المُحتملة وراءه عديدة، تتراوحُ من غَلَبة التفكير السلبي على أصحابها شخصياً، إلى افتقادهم القدرة العِلمية والفكرية على تجاوز النقد إلى تقديم ملامح الإجابات والحلول.
ثمة مُشكلة في الظاهرة السابقة.
لكن المشكلة الأكبر، بكثير، تكمنُ في التعامل مع عمليات النقد، كآليةٍ للمراجعات والتصحيح في المجتمعات، بناءً على وجود تلك الظاهرة. بمعنى، أن يتم تسليط أشعة الحرمان على ممارسة النقد بدعوى أننا "شبعنا من النقد"، وأننا "نعرف أن في واقعنا سيئات كثيرة"، وأنه "كفى تنظيراً وأعطونا حلولاً"، وما إلى ذلك من مقولات.
فهذا الطرحُ يَغفل عن حقيقةٍ تقوم عليها المجتمعات الأكثر تقدماً في هذا العصر، حيث يُعتبر النقد عمليةً مستمرةً لا تقفُ عند حدٍ أو زمن، ولا تنحصر في مسألة، ولا تقتصر على جهةٍ دون أخرى. بل توجد شرائح كاملة من العلماء والباحثين تنحصر صِفتُهُم في أنهم (نُقاد)، ونَقدهم يمتد من مجالات الفن والأدب إلى السياسة والاقتصاد، مروراً بكل مجالات الحياة البشرية الأخرى. والأغلب أن تكون هذه صِفتهم المِهَنية، بمعنى أن (النقد) هو حِرفتُهم في الحياة. ولا يخطرُ في بال أحد أن يشكوَ من (إنتاجهم) ويتبرﱠمَ من استمرار ممارستهم النقدية، فضلاً عن أن يستهين بما يقومون به، ويُصنفهُ بأنه عملُ من لاعملَ له.
أكثر من هذا، هناك مدرسةٌ كاملة في عالم الأكاديميا هي (المدرسة النقدية)، وهي تُغطي أيضاً كل فعاليات الواقع الذي تعيشه الدول والمجتمعات، وتأثيرُها لايقف عند حدود معاهد البحث والتعليم، وإنما يتجاوزُها ليدخل إلى صُلب الواقع العملي، ويُلامس عناصر الحياة اليومية للمجتمعات بآليات التحليل والتفكيك والشك والمُساءَلة، بحثاً عن أسباب المشكلات، وتقصياً لعوامل الخلل والخطأ، واستشرافاً لمداخل الحلول.
والمفارقة، التي يجب أن ينتبه إليها أهلُ المقولات المذكورة أعلاه، أن يحصلَ هذا في مجتمعات مستقرة ومتطورة لديها الكثير من الإجابات على أسئلتها، ومن الحلول لمشكلاتها، دون أن يدفع ذلك أهلَها إلى اختزال الموضوع في جُمل تُعبِّر عن (الاكتفاء من عمليات النقد)، وتَحملُ في طياتها ادعاء (معرفة أن في واقعنا مُشكلات).
الواضحُ أن هذه الطريقة في التفكير، بحدﱢ ذاتها، مظهرٌ رئيس من مظاهر مشكلتنا الثقافية في مجتمعات العرب والمسلمين، وهي المُشكلة التي تُعتبر أصل مشكلاتنا الأخرى، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها.
فَمع تَحكُّم عقلية الاختزال والتعميم والاستعجال في الثقافة السائدة، يُعتقدُ أن بضعةُ مقالات أو كتب أو دراسات كافيةً لتغطية المساحات الواسعة المهترئة في طرق التفكير والعمل والحياة.. وبإدراك بعض عناوين المشكلات والإقرار ببعض مظاهرها، يسود الشعور بأننا، حقاً، نعرف سلبياتنا وأخطاءنا. وفي ظل الاعتقاد بكفاية النقد الموجود وقدرته على كشف جذور السلبيات الاجتماعية، يُصبح الاستعجالُ في طلب الحلول والإجابات طبيعياً، وكذلك الاستمرارُ في اعتبار النقد (ترفاً) أو (تضييع وقت) لاطائل من ورائه.
ما من شكٍ في الحاجة إلى تقديم حلول للمشكلات وطرح إجابات على أسئلة الواقع، لكن هذا ليس مهمة (الناقد) بالضرورة. فهذا الأخير يُشير إلى مكمن الخلل في ظاهرةٍ معينة، ويُحاول تبيان جذورها وأسبابها. وهو، بذلك، يعطي إشارات تتعلق بمداخل تصحيح الخلل، ويكون دورُ أصحاب العلاقة الانتباهُ إلى تلك الإشارات ودراستها، وصولاً إلى صياغةٍ تفصيليةٍ للحلول هم الأقدرُ على تقديمها.
هذه، إذاً، عمليةُ توزيع أدوار فيما يتعلق بالوظائف الثقافية التي تهدف للإصلاح الاجتماعي والسياسي، وحين يُنظرُ إليها بتلك الطريقة ترتفع درجة الفعالية في أداء الوظائف المختلفة جميعاً، ويمكن لعملية التطوير في المجتمعات أن تبدأ بشكلٍ حقيقي.
قد يكتب أحدهم، مثلاً، أكثرَ من مرة، في نقد الطريقة السائدة في إصدار الفتاوى، ويُشير إلى ضرورة استصحاب تخصصات العلوم الاجتماعية في فهم الظواهر والتعامل معها، وعدم الاكتفاء بـ (العلم الشرعي) في معالجة الواقع، وإلى خطورة (الاعتماد) المُبالغ فيه على أقوال السابقين، وهو ما يُرسخ معنى (الآبائية) التي يرفضها القرآن نفسه.
هذا نقدٌ يحمل في طياته إشارات إلى آليات تطوير منهجية الفتوى وطريقتها، لكن الأمر يُصبح، بعدَها، مسؤوليةَ أصحاب العلاقة المباشَرين ممن يتصدون لعملية الفتوى. وحين يتكرر الأمر مرةً تلو أخرى بنفس الطريقة، فهذا يُعلَّلُ بواحدٍ من تفسيرين: ألا تكون هناك قناعةٌ، أصلاً، بوجود مشكلة، أو أن الشعور بها موجودٌ، لكن التغيير صعب لأسباب عديدة، ليس هذا مقامَ البحث فيها، والأرجحُ أنها باتت معروفة.
وفي الحالتين، يكون النقد قد أدﱠى دوره، ويبقى الأمر مُعلقاً بإرادة أصحاب العلاقة وقدرتهم على رؤية المشكلة وعلى حلها. المفارقةُ أن تكون لدى بعض أصحاب المقولات المذكورة أعلاه قدرةٌ على التأثير في أهل العلاقة المباشرة بإصلاح الظاهرة، وأن يقتصر دورهم، رغم ذلك، في لَومِ النقد والنقاد، بدلاً من المبادرة الإيجابية لدى من يُمكنُ له القيام بالإصلاح عملياً.
ورغم أن الحالة التي نتحدث عنها لاتختص بشريحةٍ مُحددة في المجتمعات العربية والإسلامية، إلا أنها بارزةٌ بوضوح لدى (الإسلاميين) أكثر من غيرهم، وخاصةً منهم المُنتظمين في مؤسسات أو تجمعات سياسية أو دَعَوية، أو مَن لهم علاقة بتلك الهياكل وأفرادها.
والمشكلة هنا، كما ذكرنا سابقاً، أن كثيراً من هؤلاء يقرؤون "كل نقدٍ على أنه هجومٌ وطعن، ويَرون في كل محاولة للإشارة إلى أخطائهم تَجنّياً وتشكيكاً، ويُرجِعون، بسرعةٍ وحسم، كل دعوةٍ للمراجعة إلى أحد سببين: انحرافُ صاحب الدعوة أو مشاركتهُ في مؤامرةٍ ما عليهم.. ومن النادر أن يظهر في ردود أفعالهم (حُسنُ الظن)، مع أن هذا يُعتبرُ من المعاني التي يتغنونَ بها في أدبياتهم.. وأكثرُ نُدرةً أن تجدَ القابلية عندهم للحوار مع الأفكار، ومحاولةَ قراءتها بدرجةٍ من الحياد، والتفكيرَ في دلالتها بشيءٍ من الموضوعية. أما أن تسمع عبارةً فيها اعترافٌ واضحٌ وصريحٌ بالخطأ، فهذا أمرٌ بعيد الاحتمال إجمالاً".
مرةً أخرى، ثمة أفرادٌ يمارسون النقد لمجرد النقد، تغلبُ عليهم السلبية في رؤية الواقع، ويصعبُ عليهم إبصارُ كمون الإيجابيات فيه. والحالُ مع هؤلاء، أياً كانوا، أن يُتركُ إنتاجهم ليحكم التاريخ فيه. أما الخطورة فتكمنُ في التعامل مع عملية النقد، بشكلها المنهجي، بناءً على وجود هؤلاء، وطبيعة عطائهم. والأصلُ ألا تتوقف تلك العملية، خاصةً في مجتمعات هي أحوج ما تكون إلى استمرارها فيها، كما هو الحال مع مجتمعات العرب والمسلمين.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
مؤتمر الدوحة للتدريب والتطوير.. منصة للارتقاء وبناء المستقبل

طارق ماجد بورسلي
-
من المسؤول؟

د. هلا السعيد
-
المدرجات تبكي فراق الجماهير

إبراهيم فلامرزي
-
التدريب ليس رقماً في سجل بل استثمار في الموظفين

سلوى حسين الباكر
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 جريمة صامتة.. الاتّجار بالمعرفة
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6600
| 27 أكتوبر 2025
- 2 من يُعلن حالة الطوارئ المجتمعية؟
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتصارع فيه المفاهيم، باتت القيم المجتمعية في كثيرٍ من المجتمعات العربية أقرب إلى «غرفة الإنعاش» منها إلى الحياة الطبيعية. القيم التي كانت نبض الأسرة، وعماد التعليم، وسقف الخطاب الإعلامي، أصبحت اليوم غائبة أو في أحسن الأحوال موجودة بلا ممارسة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يُعلن حالة الطوارئ لإنقاذ القيم قبل أن تستفحل الأزمات؟ أولاً: التشخيص: القيم تختنق بين ضجيج المظاهر وسرعة التحول: لم يعد ضعف القيم مجرد ظاهرة تربوية؛ بل أزمة مجتمعية شاملة فنحن أمام جيلٍ محاط بالإعلانات والمحتوى السريع، لكنه يفتقد النماذج التي تجسّد القيم في السلوك الواقعي. ثانياً: الأدوار المتداخلة: من المسؤول؟ إنها مسؤولية تكاملية: - وزارة التربية والتعليم: إعادة بناء المناهج والأنشطة اللاصفية على قيم العمل والانتماء والمسؤولية، وربط المعرفة بالسلوك. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: تجديد الخطاب الديني بلغة العصر وتحويل المساجد إلى منصات توعية مجتمعية. - وزارة الثقافة: تحويل الفنون والمهرجانات إلى رسائل تُنعش الوعي وتُعيد تعريف الجمال بالقيمة لا بالمظهر. - وزارة الإعلام: ضبط المحتوى المرئي والرقمي بما يرسّخ الوعي الجمعي ويقدّم نماذج حقيقية. - وزارة التنمية الاجتماعية: تمكين المجتمع المدني، ودعم المبادرات التطوعية، وترسيخ احترام التنوع الثقافي باعتباره قيمة لا تهديدًا. ثالثاً: الحلول: نحو حاضنات وطنية للقيم: إن مواجهة التراجع القيمي لا تكون بالشعارات، بل بإنشاء حاضنات للقيم الوطنية تعمل مثل حاضنات الأعمال، لكنها تستثمر في الإنسان لا في المال. هذه الحاضنات تجمع التربويين والإعلاميين والمثقفين وخبراء التنمية لتصميم برامج عملية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب تُترجم القيم إلى ممارسات يومية، وتنتج مواد تعليمية وإعلامية قابلة للتكرار والقياس. كما يمكن إطلاق مؤشر وطني للقيم يُقاس عبر استطلاعات وسلوكيات مجتمعية، لتصبح القيم جزءًا من تقييم الأداء الوطني مثل الاقتصاد والتعليم. رابعا: تكامل الوزارات:غرفة عمليات مشتركة للقيم: لا بد من إطار حوكمة ؛ • إنشاء مجلس وطني للقيم يُمثّل الوزارات والجهات الأهلية، يضع سياسة موحّدة وخطة سنوية ملزِمة. مؤشرات أداء مشتركة • تُدرج في اتفاقيات الأداء لكل وزارة • منصة بيانات موحّدة لتبادل المحتوى والنتائج تُعلن للناس لتعزيز الشفافية. • حملات وطنية متزامنة تُبث في المدارس والمساجد والمنصات الرقمية والفنون، بشعار واحد ورسائل متناسقة. • عقود شراكة مع القطاع الخاص لرعاية حاضنات القيم وبرامج القدوة، وربط الحوافز الضريبية أو التفضيلية بحجم الإسهام القيمي. الختام..... من يُعلن حالة الطوارئ؟ إنقاذ القيم لا يحتاج خطابًا جديدًا بقدر ما يحتاج إرادة جماعية وإدارة محترفة. المطلوب اليوم حاضنات قيم، ومجلس تنسيقي، ومؤشرات قياس، وتمويل مستدام. عندها فقط سننقل القيم من شعارات تُرفع إلى سلوك يُمارس، ومن دروس تُتلى إلى واقع يُعاش؛ فيحيا المجتمع، وتموت الأزمات قبل أن تولد.
6480
| 24 أكتوبر 2025
- 3 غياب الروح القتالية
تُخلّف بعض اللحظات أثرًا لا يُمحى، لأنها تزرع في القلب وجعًا عميقًا يصعب نسيانه.. في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كانت الصفعة مدوية! الغرافة تلقى هزيمة ثقيلة برباعية أمام الأهلي السعودي، دون أي رد فعل يُذكر. ثم جاء الدور على الدحيل، الذي سقط أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة ٣-١، ليظهر الفريق وكأنه تائه، بلا هوية. وأخيرًا، السد ينهار أمام الهلال السعودي بنفس النتيجة، في مشهد يوجع القلب قبل العين. الأداء كان مخيبًا بكل ما تحمله الكلمة من وجع. لا روح، لا قتال، لا التزام داخل المستطيل الأخضر. اللاعبون المحترفون الذين تُصرف عليهم الملايين كانوا مجرد ظلال تتحرك بلا هدف و لا حس، ولا بصمة، ولا وعي! أما الأجهزة الفنية، فبدت عاجزة عن قراءة مجريات المباريات أو توظيف اللاعبين بما يناسب قدراتهم. لاعبون يملكون قدرات هائلة ولكن يُزج بهم في أدوار تُطفئ طاقتهم وتشل حركتهم داخل المستطيل الأخضر، وكأنهم لا يُعرفون إلا بالاسم فقط، أما الموهبة فمدفونة تحت قرارات فنية عقيمة. ما جرى لا يُحتمل. نحن لا نتحدث عن مباراة أو جولة، بل عن انهيار في الروح، وتلاشي في الغيرة، وكأن القميص لم يعد له وزن ولا معنى. كم كنا ننتظر من لاعبينا أن يقاتلوا، أن يردّوا الاعتبار، أن يُسكتوا كل من شكك فيهم، لكنهم خذلونا، بصمت قاسٍ وأداء بارد لا يشبه ألوان الوطن. نملك أدوات النجاح: المواهب موجودة، البنية التحتية متقدمة، والدعم لا حدود له. ما ينقصنا هو استحضار الوعي بالمسؤولية، الالتزام الكامل، والقدرة على التكيّف الذهني والبدني مع حجم التحديات. نحن لا نفقد الأمل، بل نطالب بأن نرى بشكل مختلف، أن يعود اللاعبون إلى جوهرهم الحقيقي، ويستشعروا معنى التمثيل القاري بما يحمله من شرف وواجب. لا نحتاج استعراضًا، بل احترافًا ناضجًا يليق باسم قطر، وبثقافة رياضية تعرف كيف تنهض من العثرات لتعود أقوى. آخر الكلام: هذه الجولة ليست سوى بداية لإشراقة جديدة، وحان الوقت لنصنع مجدًا يستحقه وطننا، ويظل محفورًا في ذاكرته للأجيال القادمة.
3198
| 23 أكتوبر 2025