رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
1378
توفيق المدينيالديمقراطية ليست صناديق الاقتراع فقط
منذ أن استلمت حركة النهضة السلطة في تونس، رفعت في وجه المعارضة الليبرالية واليسارية وتكوينات المجتمع المدني الحديث شرعية الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وأنها هي الحركة التي حازت على الشرعية الانتخابية بواسطة الديمقراطية التي عبدت لها الطريق للوصول إلى السلطة. وإذا كانت صناديق الاقتراع منحت حركة النهضة فوزاً كبيراً في الانتخابات، فإنه لا يجوز للإسلاميين أن يعتبروا الديمقراطية بأنها مجرّد صناديق الاقتراع فقط، وبالتالي يسمحون لأنفسهم التبجح بأنهم أصبحوا حائزين على الشرعية المطلقة أو الشرعية المقدسة، وينسون، بالطبع، شرعية الثورة على حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، التي أتاحت لهم السيطرة على مفاتيح السلطة، رغم أن دورهم في الثورة كان هامشياً، بل إنهم ركبوا موجات هذه الثورة.
وكان واضحاً منذ بداية الثورة على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أن هناك قوى ثلاثاً نجح تناغمها في إنهاء عهده: الحركة الشبابية، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب اليسارية والقومية، والاتحاد العام التونسي للشغل، والجيش. وكان دور الجيش إيجابياً، في انحيازه للشعب رغم دعوات ابن علي إلى التدخل ضد ثورة الشعب، أما دور الإسلاميين، فاتسم بالانتهازية. والحال هذه، كانت الشرعية الثورية في معظمها من نصيب الحركة الشبابية التي لم تكن مؤطرة لا أيديولوجيا ولا سياسياً ولا تنظيمياً، لكن المشكلة كانت عدم التناسب بين قوة الحركة الشبابية الثورية وقوتها الانتخابية، لاسيَّما في ظل ضعف وتشتت أحزاب المعارضة الليبرالية واليسارية. ولكل هذا، فإن آخر من يحق له الحديث عن الشرعية والديمقراطية والانتخابات والصناديق هم إسلاميو حركة النهضة في تونس.
ولكن حتى بمقاييس موازين القوى بين مكونات الثورة، فإن الانتخابات التي جرت في 23 أكتوبر2011 التي شكلت أساس الشرعية لحركة النهضة الإسلامية، لاحقا، لم تفز فيها النهضة في وجه معارضيها سوى بنحو 20في المائة، حيث إن 80 في المائة من الشعب التونسي ليسوا مع النهضة، من هنا فإن الحديث عن الشرعية الانتخابية لحركة النهضة في وجه المعارضة الليبرالية واليسارية، وحركة الشبيبة الثورية، والاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات المجتمع المدني، يفقد الكثير من شرعيته.
بالتالي، فإن ما يحدّد الديمقراطية لا يقتصر على صناديق الاقتراع، أو الشرعية الانتخابية فقط، كما تروج لذلك حركة النهضة الإسلامية، بل إنه يقوم بالدرجة الرئيسية على احترام المشاريع والتطلعات الفردية والجماعية التي تقرن بين التأكيد على الحرية الشخصية وبين الحق بالتماهي مع الشعب التونسي، من أجل تحقيق أهداف ثورته: بناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونصرة القضايا العربية، وفي مقدمتها تحرير الأرض العربية السليبة في فلسطين.
لقد كان من الواضح في ذهن الإسلاميين الذين ينتمون لحركة النهضة، أنهم يستغلون لحظة تاريخية لن تتكرر، ليس لإرساء نظام ديمقراطي جديد في تونس باعتباره مطلباً ثورياً، وإنما لبناء دولة إسلامية بالتدرج، بعد أن تكون حركة النهضة قد «تمكنت » من السيطرة على مفاصل الدولة، وضرب القضاء، والإعلام، والصحافة، والاتحاد العام التونسي للشغل، والمنظمات النسائية الديمقراطية، لتعود بعدها إلى تصفية الحساب مع الجيش.
بيد أن قبول حركة النهضة الإسلامية لنتائج الانتخابات التي فازت فيها، قد لا يتعدى فهمها الشكلي للديمقراطية بوصفها صناديق الاقتراع، ولم تع جيدّاً أن النظام الديمقراطي الجديد الذي تسعى الثورة التونسية إلى إرسائه هو كل متكامل، وصناديق الاقتراع واحدة من هذا الكل، لكن النظام الديمقراطي الذي يصبو إليه الشعب التونسي هو صيغة الحياة السياسية القائمة على الثقافة الديمقراطية، التي تزود العدد الأكبر من المواطنين بأكبر قسط من الحرّية، وهو الصيغة التي تحمي أوسع تنوع ممكن وتعترف به.
لقد واجهت الديمقراطية الناشئة في تونس، تهديداً أولا من قبل سلطة حركة النهضة التي استخدمت نتائج صناديق الاقتراع لفرض إطاحتها بكل الانتماءات المجتمعية والثقافية، قاضية بذلك على الثقافة الديمقراطية التي تحترم الحريات العامة، والشخصية، والتنوع المجتمعي، قاضية بذلك على كل رديف أو عديل لسلطة الإسلاميين. وأصيبت الديمقراطية الناشئة بالانحطاط من خلال ممارسة الإسلاميين الانحراف الديمقراطي الذي يُعرِّفُ بالاستبداد المنتخب أو الانتخابي، عبر اعتقادهم بأنهم يمتلكون الشرعية الانتخابية، وأنهم يشكلون الغالبية المطلقة، وعلى أنهم يمثلون كل «الشعب»، وهم يحكمون باسمه، ويعتبرون المعارضة الليبرالية واليسارية، وتكوينات المجتمع المدني الحديث، والنقابات العمالية، أعداء وهامشيين من غير المواطنين، وأنهم منساقون وراء أفكار أجنبية أو رعاة للغرب. ثم هاجم الإسلاميون الديمقراطية الناشئة على جبهة ثالثة، من قبل نزعة ثقافية أصولية إقصائية تدفع إلى عدم احترام الأقليات السياسية إلى حدّ إلغاء فكرة الأكثرية ذاتها، وإلى حدّ الاختزال لفكرة الديمقراطية إلى شكلية صناديق الاقتراع، والعمل على تعزيز نشأة السلطة الإسلامية البديلة، وصوغ دستور يناسب أو بالأحرى على مقاس حركة النهضة الإسلامية.
ولو كانت حركة النهضة الإسلامية راغبة فعلاً في إقامة نظام ديمقراطي ينقلها من مرحلة حركة نزلاء السجون إلى الحركة الشريك في السلطة، أو في المعارضة، كان عليها أن تتبنى برنامج الحد الأدنى للقاء القوى الليبرالية، والثورية، والنقابات العمالية، لتجسيد القطيعة المنهجية مع العنف السياسي، وحل ميلشيات «رابطات الثورة »، والكشف عن الجهة التي اتخذت قرار اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتوجه الصادق نحو صوغ دستور ديمقراطي توافقي، والعمل على إرساء نظام ديمقراطي جديد، ولا يشمل ذلك إطلاقاً أن تكون الجمعية التأسيسية وكراً للإسلاميين، لإعادة إنتاج نظام ديكتاتوري جديد في ثوب إسلامي، وبالتالي تنفيذ مخططاتهم المعادية لتطلعات الشعب التونسي في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
هذه التوجهات غير الصادقة من جانب الإسلاميين، وغير المؤمنة بالثقافة الديمقراطية في أبعادها المختلفة، التي تؤكد على الإيمان بالتعددية، والتداول السلمي للسلطة، واحترام الرأي والرأي الآخر المعارض، وتبني وجهات نظر الآخرين، والاستعداد لتقبل الحلول الوسط والتوفيقية، هي التي أوجدت جوّاً من عدم الثقة والشك المتبادل بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، وأحزاب المعارضة الليبرالية واليسارية والقومية، الأمر الذي يجعل نتائج عملية التحول الديمقراطي في تونس، محلّ صراع، وعدم قبول من جانب المعارضة ومكونات المجتمع المدني.
يستعير إسلاميو حركة النهضة من الديمقراطيات الغربية الراسخة تقديسها للانتخابات، مثلما يستعيرون حزمها مع أي قوة تريد قلب الأوضاع من خارج «اللعبة الديمقراطية». لكنهم يتجاهلون أمرين: المسار التاريخي الذي أدّى إلى هذا «التقديس» للعملية الانتخابية، والقواسم المشتركة للقوى السياسية التي تتداول السلطة فيما بينها، منذ أن استقرت هذه الديمقراطيات. لكن الإسلاميين لم يعوا جيداّ، أنه كل ما لجأوا إلى بناء الدولة الإسلامية وتنكروا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، كلما أدّى هذا اللجوء باسم أيديولوجيا إسلامية ما إلى تعزيز سلطة حركة النهضة، وبالتالي كل ما أدّى إلى القضاء على استقلالية النظام الديمقراطي الوليد وإلى فرض علاقة مباشرة بين سلطة حركة النهضة وأيديولوجيتها الإسلامية الإخوانية، وعلى الأخص على فرض العلاقة بين الدولة التونسية والدين، كل هذا يقضي على الديمقراطية الناشئة.
والأمر الذي لا يقبل الجدل هو أنه لا يجوز إطلاق صفة الديمقراطية على حركة النهضة الإسلامية لمجرّد أنها وصلت إلى السلطة بوساطة صناديق الاقتراع، لأنها حوّلت الشرعية الانتخابية إلى قناع لفرض ديكتاتورية دينية جديدة في تونس، مثلما لا يجوز إطلاق صفة الديمقراطية على ستالين "باني النظام التوتاليتاري" لمجرّد أنه كان « ثورياً»، أو على هتلر"باني النظام النازي" لمجرّد أنه فاز في الانتخابات عام 1933.
لذلك قبل أن تستقر في تونس الديمقراطية الراسخة، التي تشتمل على قواعد التداول السلمي للسلطة، والفصل الحقيقي بين السلطات، ينبغي أن تظهر المساحة المشتركة بين الإسلاميين من حركة النهضة وباقي أطراف المعارضة الليبرالية واليسارية والقومية، لجهة الإيمان الحقيقي بصوغ دستور ديمقراطي جديد يليق بالثورة التونسية، والتوجه الحقيقي نحو باء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تلك هي المساحة المشتركة التي يمكن اعتبارها الشرعية الحقيقية للنظام الديمقراطي الجديد الناشئ.
وعلى هذا الصعيد، لا يَنْفَع «لإخوان » تونس من حركة النهضة، نَعْتَ المعارضة التونسية بأنها مجرّد قوى متشرذمة وضعيفة تنظيمياً. فهي تمتلك قوة جماهيرية، ونخبوية، غير منظمة، بل إنها تمتلك الشرعية الشعبية، هذا ما أكدته جنازة الشهيد شكري بلعيد. وهذا ما يفسر الاضطراب الذي تلاقيه محاولات النهضة لفرض حكم إسلامي على تونس.
أمام حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم، خياران مكلفان: إما التوجه نحو فرض شرعية إسلامية جديدة على الطريقة الإيرانية، وهذا من باب المحال في واقع تونس، وإما القبول بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تجعل خصومهم يقبلون بالاحتكام لصناديق الاقتراع.
اقرأ المزيد
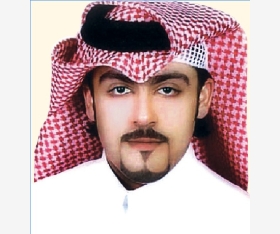 الرياضة نبض الوطن الحي
الرياضة نبض الوطن الحي
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة... اقرأ المزيد
1122
| 10 فبراير 2026
 دعم إنساني للشعب السوداني لتخطي الأزمة الراهنة
دعم إنساني للشعب السوداني لتخطي الأزمة الراهنة
مع الاستعداد لدخول شهر رمضان المبارك يجيء اطلاق صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، قافلة مساعدات... اقرأ المزيد
150
| 10 فبراير 2026
 «لعبة الحبّار».. لسنا خيولاً ولسنا أرقاماً
«لعبة الحبّار».. لسنا خيولاً ولسنا أرقاماً
«لعبة الحبّار» ليست موتًا بقدر ما هي حياةٌ بحقيقة واحدة: لا مكان يتسع للجميع. لعبٌ يصير محكمةً، وحاجة... اقرأ المزيد
120
| 10 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
زوايا رياضية

إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
الصحة في قبضة الخوارزميات

د. خالد وليد محمود
-
شهر شعبان والتهيئة لرمضان

نعيمة عبدالوهاب المطاوعة
-
الرياضة نبض الوطن الحي

إبراهيم فلامرزي
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 وثائق إبستين ووهْم التفوق الأخلاقي
عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية، وجعل لنفسه حق التدخل في شؤون الدول التي لا تساير تلك المنظومة المُعلنة. بيد أن وثائق جيفري إبستين التي كشف عنها وأحدثت زلزالًا تتجاوز آثاره كونها حالة جنائية، إلى النظر إليها والتعامل معها على أنها جرائم سياسية وأخلاقية، تزاوجت في تنفيذها السلطة والمال والنفوذ. تلك الوثائق قد نسفت ادعاءات الغرب في تفوقه الأخلاقي، وأبرزت أن هذه القيم التي يترنم بها قيم نسبية مرهونة بالمصالح والنفوذ، ذلك لأنها ليست خطيئة فردية، بل هي جريمة منظمة ممنهجة ممتدة متشابكة. أظهرت الوثائق أن القيم تتبدد أمام إغراءات المال والسلطة، ولم يكن إبستين مجرد رجل يستغل النظام القضائي والإعلامي والسياسي من أجل تحقيق أطماعه في استعباد النساء والأطفال، بل هو صنيعة ونتاج منظومة الفساد الأخلاقي والقيمي. سيكون من السطحية والسخف أن تختزل هذه الفضيحة في شخص إبستين، فهو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي شهدها الغرب، ولذا جرى التهاون القضائي مع الرجل لأنه يعلم جيدًا أن من كان في مثل موضعه من السلطة والمال لن يُحاكم بنفس المعايير التي يحاكم بها غيره. لم يتجل السقوط الأخلاقي للغرب من خلال الفضيحة ذاتها وما ارتبطت به من أسماء ما يمكن أن نسميه «إدارة العالم» فحسب، بل من خلال تأخير الكشف عنها، فلم تكن هذه الحقائق مجهولة، بل كانت مؤجلة، فأصبحت هذه الحقيقة مجرد توثيق لحسابات النهاية، فالعدالة الحقيقية هي تلك التي تأتي في الوقت المناسب، فلماذا لم يتم الكشف عنها حينها؟ كأن الحقيقة قد سمح لها بالظهور فقط بعدما أصبحت فاقدة للقدرة على التغيير.ثم لنا أن نتساءل عن سر التهاون القضائي مع إبستين، وما تفسير حادث موته في السجن بكل ما يتعلق به من سلوكيات مريبة كتعطيل الكاميرات وغياب المراقبة لشخصية من المفترض أن تحظى بالرقابة الصارمة؟ الوثائق كشفت أن العدالة طبقية وانتقائية في النموذج الغربي، وليست سوى عمليات تفاوضية على الصياغة، وعلى ما يقال وما يترك، تجلى ذلك في الصفقات القانونية التي أبرمت، والتخفيف غير المبرر في الأحكام القضائية الصادرة، وتأجيل المحاسبة، بما يجعلنا نقول إن القانون يفسر وفقا لموقع المتهم لا حجم الجريمة، وهذا يؤكد انهيار ركيزة المساواة أمام القانون التي هي إحدى أهم ركائز أية منظومة قيمية. الوثائق كذلك عرّت الإعلام الغربي الذي يفاخر بالحرية والاستقلالية والشفافية والموضوعية وأظهرت ضلوعه في التواطؤ لخدمة السلطة والمال، وذلك بالتغطية على الجريمة، وأبرز طبيعته الاستهلاكية التي يقاس نجاحها بالمشاهدات وعوائد الإعلانات، كما أظهرت كذلك خضوع هذا الإعلام لنفوذ المال والسياسة وتمحوره حول حماية الأقوياء.. حتى في التناول الإعلامي للقضية، جرى التعامل الانتقائي الطبقي، حيث تم تهميش الضحايا وكأنهم مجرد أرقام تُذكر في السياق العام للجريمة، أو خلفية حزينة للأسماء اللامعة. من دواعي السخرية أن هذه الإدارة العالمية التي ضربت بحقوق الإنسان عرض الحائط، هي نفسها التي نصّبت نفسها مراقبًا على حقوق المرأة والطفل والحريات في عالمنا العربي والإسلامي، هي نفسها التي تتدخل في تربية أطفالنا وتسعى لتجريم تأديب الأبناء، وتؤجج الحركات النسوية لدفعها للتمرد على قيم وثقافات المجتمعات، وتبتز الحكومات بملفات الحرية وحقوق الإنسان، بما يؤكد أن الغرب يتعامل مع القيم باعتبارها سلاحًا سياسيًا. فصل الأخلاق عن السلطة، والفصل بين الخطاب السياسي والممارسة، يقوض الثقة الداخلية في الغرب ذاته، فأنّى لمجتمع يؤمن بتلك المنظومة وهو يراها تتهاوى أمام السلطة والمال، ويوقفه حائرًا أمام ذلك الثراء الذي يهب الحصانة. لعل هذا الحدث الجلل يجعل المُختطفين ببريق الغرب ويترنمون بتفوقه القيمي يراجعون أنفسهم، ويفصلون في الدعوة إلى السير على خطى الغرب بين ما يمكن أن نأخذه عنه من تقدم علمي وتكنولوجي ونحوهما، وما لسنا بحاجة إليه من قيم وأخلاقيات لنا السبق والسمو فيها، فالغرب إنما تقدم بسبب الأخذ بأسباب القوة والتقدم، لا من خلال منظومته القيمية والأخلاقية النسبية.
8454
| 08 فبراير 2026
- 2 الشمال يتألق وأم صلال يتراجع
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2163
| 04 فبراير 2026
- 3 الرياضة نبض الوطن الحي
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1122
| 10 فبراير 2026




