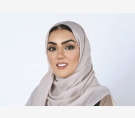رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
6097
أحمد بن سالم الفلاحي"كروة" و"ميرة" .. تستحضرهما الذاكرة الشعبية
سألت الراكب بجانبي عندما نزلت سيارتنا من فوق جسر العذيبة في اتجاه ولاية السيب عن معنى الـ"ميرة"، حيث لمحت على الطريق الموازي لسيرنا المجمع التجاري الكبير الذي تغيرت علامته التجارية فجأة، ووضعت عليه اللائحة الجديدة "ميرة"؛عن معنى هذه الكلمة، وكيف جاءت على واجهة هذا المجمع، ومن صاحبه الذي تحمل لائحته هذا الاسم، فرد علي ان هذا المجمع التجاري الكبير صاحبه مستثمر من دولة قطر الشقيقة، فاستوعبت المعنى حينها وظللت كلما امر بشارع "السلطان قابوس" حيث يقع هذا المجمع موازيا لهذا الشارع المتجه الى عمق مسقط عاصمة السلطنة، ذهابا وايابا تبصر أعيننا هذه اللوحة الكبيرة التي تزين المحل، ومع مرور الأيام اتوقع أن الذاكرة الصغيرة لدى الجيل الجديد هذا الاسم، واصبح جزءا من المعلومات المخزنة، وهو بالنسبة لي ليس جديدا كمفردة متفردة وسط هذا العالم الذي يعج بالعولمة، حيث تستدعي الذاكرة هذا الاسم من معنى قديم عندنا في سلطنة عمان، فعندما كنا صغارا كنا نسمع من والدينا هذه المفردة فالوالد سيذهب الى السوق ليشتري ميرة يوم، أو اكثر، واستوعبتها الذاكرة في حينها على ان الـ "ميرة" هي كمية من الطعام، وعادة ما تكون لعدد ايام كثيرة.
هذه المفردة لم تعد اليوم متداولة حيث اكتسحتها العولمة بمفردات كثيرة، ولذلك اسقطتها الذاكرة الحديثة لدى الاجيال، واستعاظت عنها كما هو متوقع ومعروف بمفردات كثيرة، ولعل اقربها مسميات الوجبات السريعة – دون ذكر اسمائها – وهي معروفة، والتي تغزو العالم على امتداد الكرة الأرضية، والاجيال الحديثة، يقينا، غير ملامة على ذلك فهذا واقعهم، وعليهم ان يعيشونه بكامل مفرداته، وما تحمله هذه المفردات من حداثة وتقنية، فذاكرة الانسان عموما كما تشير الكثير من التقارير الطبية ترتبط ارتباطا وثيقا بمخه، وان أية تأثيرات جانبية على هذا الجهاز المهم من شأنه أن يربك الذاكرة، وقد يفقدها أرصدتها من المعلومات السابقة، ومن الرصيد المعرفي الممتد منذ عمر الطفولة وحتى العمر المتأخر، فكيف الحال اذا كانت هذه الذاكرة تبنى على مفردات مختلفة جدا عما كان عليه الجيل السابق، على سبيل المثال، ومن هذه النقطة بالذات فالذين يهتمون بمثل هذه المفردات، ويؤصلون بقاءها عبر وسائل عديدة، ومنها المثال الذي ذكرته في صدر المقال هم يقينا لم يأت هذا التأصيل صدفة، فوراءه اهتمام غير عادي بمفهوم هذا التأصيل، ولذلك احي حقيقة هذا المستثمر الذي اصل بقاء كلمة "ميرة" وهي المفردة الشعبية التي عايشتها الاجيال دهورا من الزمان، وها هو يكتب لها شهادة البقاء من جديد، وتعود لتترسخ في ذهن الذاكرة من جديد، صحيح ان الجيل اليوم يجد فيها من الغرابة الشيء الكثير، ولكنه يتعامل معها كعلامة تجارية فقط سوف تستوعبها الذاكرة شيئا فشيئا لتبقى جزءا من ذاكرة شعبية، بالاضافة الى تجدد بقائها في الذاكرة الشعبية لدى كبار السن الذين توحي اليهم بالشيء الكثير.
ما جعلني اتحدث عن هذه المفردة بالذات هو اصطدامي من جديد بمفردة أخرى غيبتها الذاكرة الشعبيية لذات الاسباب التي ذكرتها في صدر المقال وهي مفردة "كروة" حيث قرأتها أول ما خرجت من مطار حمد الدولي على سيارات الأجرة هنا في قطر الخير، وعلى باصات النقل المتعددة، ولأن المفردة ليست غريبة علي كرصيد معرفي قديم، حيث اعي معنى هذه المفردة فقد كان لي شرف المعرفة منذ البدايات الأولى للمعرفة عندما كنت صغيرا، كان كبار السن يرددون هذه المفردة "كروة"، و"يكاري"، و "كاراه"، وكلها في معنى الاجرة والاستئجرا، ويستأجر، ولكنها كحال شقيقتها "ميرة" اختفت هي الأخرى من سوق التداول المفردي لدى المجتمع، ومع مرور الايام تناستها الذاكرة الى حين، ولم تعد موجودة مطلقا في الذاكرة الشعبية لدى الجيل الحالي الذي استبدلها بالاجرة، ويؤجر، وغربها بمفردة "تاكسي"، و "يتكس"، وهكذا تستمر الذاكرة الشعبية في استيعاب الفمردات والغائها، وذلك وفق مجريات الزمن واحداثه، وما يولده من مفردات مستوحاة من البيئة في حينها، او من الوسيلة المتداولة بين الناس.
ومن هنا تستدعي الحاجة او الضرورة على المحافظة على ارث المجتمع ان يسعى افراد المجتمع الى تخليد هذه المفردات، او المسميات، سواء كانت مسميات متعلقة بالفرد، او بالمادة المتداولة بين افراد المجتمع ان يوجد المجتع لها مقارا آمنة للحفظ، لأن حفظها معناه البقاء على هوية المجتمع وعدم تغربه، وعدم تماهيه في عوالم الآخرين من حوله، خاصة العوالم التي لاتحصنها القيم، والعادات، وليس معنى هذا ان نكفكف على كل القيم صالحها وطالحها، أبدا، فنحن نعيش في عالم متحرك ديناميكي لا يهدأ وعلينا ان نتجاوب معه بما ييسر لنا الحياة، والوسيلة، على ان لا نفقد هويتنا، وأصالتنا، فالعولمة اليوم قضت على كل أخضر ويابس، كما يقال، وغربت الشعوب عن انتماءاتها الاجتماعية، والجغرافية، وعمقت فيها الاستقلالية الممقوته، وافرزت نتائج تتصادم مع تاريخ اجتماعي جميل، فقوضت فيه التماسك، والتآزر، وجاء مفهوم الأسرة النووية، فزاد الطين بلة – كما يقال – فبعد ان كانت الاسرة التقليدية المحافظة، ومتأزرة، حيث الجدين، والابوين، ومجموعة الابناء وزوجاتهم، وابنائهم، تصدرت الاسرة النووية لتنفرد من هذا التجمع كله على الرجل وزوجته، بيت كبير وضخم يضم روحين بين اربعة جدران فقط، في حي متطور لا يعرف الجار جاره، ولا القريب قريبه، وتناسخت هذه الصورة المجتمعية واستحسنتها الاجيال كنوع من الاستقلالية، ولكنها في المقابل غيبت اهم شيء، وهو اللحمة الاجتماعية الرائعة التي كانت بمثابة القفل الصلد لمكونات المجتمع الانساني من الترهل، والتشتت.
احي حقيقة المعنيين في دولة قطر الشقيقة على هذا التوجه الجميل، في توظيف هذه المفردات مثال (ميرة وكروة) في مختلف وسائل الحياة العامة، واعطائها عمرا جديدا للبقاء، وهذا يعكس بما لا يدع مجالا للشك ان هناك من لا يزال يرى في هذه المفردات وغيرها السبيل للمحافظة على قيم المجتمع، وعاداته، وتقاليده، وما هذا التوظيف الجميل لفمردتي "كروة، وميرة" الا مثالا رائعا لهذا الاستحضار الجميل لتاريخ اصبح في حكم الموات، كما هو ديدن الحياة دائما؛ حيث لا تنتظر المتأخر كثيرا، فالركب مسرعا، والزمن يجري بسرعة البرق، في الوقت الذي ارى فيه ايضا ان العصر الحديث يتيح لنا الكثير من الفرص لتخليد شيئا من الذاكرة الشبعية حيث تتعدد اليوم وسائل الحفظ للمحافظة على اشيائنا التي لا تصطدم مع الواقع بشيء، والطرح هنا ايضا يحاول تبسيط الصورة الغائبة عن أجندة الاهتمامات اليومية لدينا، وذلك بسبب أن هناك الكثير من الموروث الاجتماعي، على سبيل المثال، يأتي عليه التقادم بسبب تقدم العمر عند كبار السن، والكثير منه غير مدون، وغير منقول، ومعنى ذلك برحيل من تبقى من كبار السن، تفقد الأجيال تراثا جميلا ومهما يتعلق بالكثير من مناح الحياة اليومية، وان كان هذا التراث لا يضيف شيئا للحياة اليومية لدى أجيال اليوم، ولكنه يسجل مرحلة مهمة يجب ألا تلغى من قاموس الحياة الاجتماعية، ويسدل عليها الستار لتذهب مع الزمن خاصة بعد أن بدأت الذاكرة الشعبية تختزل نشاطها إلى الحد الذي لم يعد الإنسان يحتفظ فيه الا بالشيء اليسير من أحداث الحياة، أو ما توثقه له الكتب والمراجع، وذلك بسبب التقنية الحديثة.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
مؤتمر الدوحة للتدريب والتطوير.. منصة للارتقاء وبناء المستقبل

طارق ماجد بورسلي
-
من المسؤول؟

د. هلا السعيد
-
المدرجات تبكي فراق الجماهير

إبراهيم فلامرزي
-
التدريب ليس رقماً في سجل بل استثمار في الموظفين

سلوى حسين الباكر
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 جريمة صامتة.. الاتّجار بالمعرفة
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6600
| 27 أكتوبر 2025
- 2 من يُعلن حالة الطوارئ المجتمعية؟
في زمنٍ تتسارع فيه التكنولوجيا وتتصارع فيه المفاهيم، باتت القيم المجتمعية في كثيرٍ من المجتمعات العربية أقرب إلى «غرفة الإنعاش» منها إلى الحياة الطبيعية. القيم التي كانت نبض الأسرة، وعماد التعليم، وسقف الخطاب الإعلامي، أصبحت اليوم غائبة أو في أحسن الأحوال موجودة بلا ممارسة. والسؤال الذي يفرض نفسه: من يُعلن حالة الطوارئ لإنقاذ القيم قبل أن تستفحل الأزمات؟ أولاً: التشخيص: القيم تختنق بين ضجيج المظاهر وسرعة التحول: لم يعد ضعف القيم مجرد ظاهرة تربوية؛ بل أزمة مجتمعية شاملة فنحن أمام جيلٍ محاط بالإعلانات والمحتوى السريع، لكنه يفتقد النماذج التي تجسّد القيم في السلوك الواقعي. ثانياً: الأدوار المتداخلة: من المسؤول؟ إنها مسؤولية تكاملية: - وزارة التربية والتعليم: إعادة بناء المناهج والأنشطة اللاصفية على قيم العمل والانتماء والمسؤولية، وربط المعرفة بالسلوك. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: تجديد الخطاب الديني بلغة العصر وتحويل المساجد إلى منصات توعية مجتمعية. - وزارة الثقافة: تحويل الفنون والمهرجانات إلى رسائل تُنعش الوعي وتُعيد تعريف الجمال بالقيمة لا بالمظهر. - وزارة الإعلام: ضبط المحتوى المرئي والرقمي بما يرسّخ الوعي الجمعي ويقدّم نماذج حقيقية. - وزارة التنمية الاجتماعية: تمكين المجتمع المدني، ودعم المبادرات التطوعية، وترسيخ احترام التنوع الثقافي باعتباره قيمة لا تهديدًا. ثالثاً: الحلول: نحو حاضنات وطنية للقيم: إن مواجهة التراجع القيمي لا تكون بالشعارات، بل بإنشاء حاضنات للقيم الوطنية تعمل مثل حاضنات الأعمال، لكنها تستثمر في الإنسان لا في المال. هذه الحاضنات تجمع التربويين والإعلاميين والمثقفين وخبراء التنمية لتصميم برامج عملية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب تُترجم القيم إلى ممارسات يومية، وتنتج مواد تعليمية وإعلامية قابلة للتكرار والقياس. كما يمكن إطلاق مؤشر وطني للقيم يُقاس عبر استطلاعات وسلوكيات مجتمعية، لتصبح القيم جزءًا من تقييم الأداء الوطني مثل الاقتصاد والتعليم. رابعا: تكامل الوزارات:غرفة عمليات مشتركة للقيم: لا بد من إطار حوكمة ؛ • إنشاء مجلس وطني للقيم يُمثّل الوزارات والجهات الأهلية، يضع سياسة موحّدة وخطة سنوية ملزِمة. مؤشرات أداء مشتركة • تُدرج في اتفاقيات الأداء لكل وزارة • منصة بيانات موحّدة لتبادل المحتوى والنتائج تُعلن للناس لتعزيز الشفافية. • حملات وطنية متزامنة تُبث في المدارس والمساجد والمنصات الرقمية والفنون، بشعار واحد ورسائل متناسقة. • عقود شراكة مع القطاع الخاص لرعاية حاضنات القيم وبرامج القدوة، وربط الحوافز الضريبية أو التفضيلية بحجم الإسهام القيمي. الختام..... من يُعلن حالة الطوارئ؟ إنقاذ القيم لا يحتاج خطابًا جديدًا بقدر ما يحتاج إرادة جماعية وإدارة محترفة. المطلوب اليوم حاضنات قيم، ومجلس تنسيقي، ومؤشرات قياس، وتمويل مستدام. عندها فقط سننقل القيم من شعارات تُرفع إلى سلوك يُمارس، ومن دروس تُتلى إلى واقع يُعاش؛ فيحيا المجتمع، وتموت الأزمات قبل أن تولد.
6480
| 24 أكتوبر 2025
- 3 غياب الروح القتالية
تُخلّف بعض اللحظات أثرًا لا يُمحى، لأنها تزرع في القلب وجعًا عميقًا يصعب نسيانه.. في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كانت الصفعة مدوية! الغرافة تلقى هزيمة ثقيلة برباعية أمام الأهلي السعودي، دون أي رد فعل يُذكر. ثم جاء الدور على الدحيل، الذي سقط أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة ٣-١، ليظهر الفريق وكأنه تائه، بلا هوية. وأخيرًا، السد ينهار أمام الهلال السعودي بنفس النتيجة، في مشهد يوجع القلب قبل العين. الأداء كان مخيبًا بكل ما تحمله الكلمة من وجع. لا روح، لا قتال، لا التزام داخل المستطيل الأخضر. اللاعبون المحترفون الذين تُصرف عليهم الملايين كانوا مجرد ظلال تتحرك بلا هدف و لا حس، ولا بصمة، ولا وعي! أما الأجهزة الفنية، فبدت عاجزة عن قراءة مجريات المباريات أو توظيف اللاعبين بما يناسب قدراتهم. لاعبون يملكون قدرات هائلة ولكن يُزج بهم في أدوار تُطفئ طاقتهم وتشل حركتهم داخل المستطيل الأخضر، وكأنهم لا يُعرفون إلا بالاسم فقط، أما الموهبة فمدفونة تحت قرارات فنية عقيمة. ما جرى لا يُحتمل. نحن لا نتحدث عن مباراة أو جولة، بل عن انهيار في الروح، وتلاشي في الغيرة، وكأن القميص لم يعد له وزن ولا معنى. كم كنا ننتظر من لاعبينا أن يقاتلوا، أن يردّوا الاعتبار، أن يُسكتوا كل من شكك فيهم، لكنهم خذلونا، بصمت قاسٍ وأداء بارد لا يشبه ألوان الوطن. نملك أدوات النجاح: المواهب موجودة، البنية التحتية متقدمة، والدعم لا حدود له. ما ينقصنا هو استحضار الوعي بالمسؤولية، الالتزام الكامل، والقدرة على التكيّف الذهني والبدني مع حجم التحديات. نحن لا نفقد الأمل، بل نطالب بأن نرى بشكل مختلف، أن يعود اللاعبون إلى جوهرهم الحقيقي، ويستشعروا معنى التمثيل القاري بما يحمله من شرف وواجب. لا نحتاج استعراضًا، بل احترافًا ناضجًا يليق باسم قطر، وبثقافة رياضية تعرف كيف تنهض من العثرات لتعود أقوى. آخر الكلام: هذه الجولة ليست سوى بداية لإشراقة جديدة، وحان الوقت لنصنع مجدًا يستحقه وطننا، ويظل محفورًا في ذاكرته للأجيال القادمة.
3198
| 23 أكتوبر 2025