رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
3632
حمد البوعينين(الأتمتة) ومستقبل الإنسان
يمثل عصرنا الحالي الذي نعيشه عصر التقدم التكنولوجي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد شهد العالم خلال العصر الحديث نقلات نوعية كبيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. نقلات لم يكن الإنسان ليتصورها خلال مراحل حياته السابقة على هذا العصر، وبعقد مقارنة سريعة بين تصورات الإنسان في الأزمان الغابرة وما آلت إليه حياته الآن، يمكننا تلمس الإخفاق في استشراف مستقبل العصر الحديث، ولا تزال تصوراتنا قاصرة عن إدراك المستقبل قياساً على الحاضر، لا سيما وأن التكنولوجيا لا تزال تحقق قفزات هائلة قد نعجز معها عن تصور ما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.
من القضايا التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة خلال العصر الصناعي قضية "الأتمتة" والتي تُعرّف بأنها عملية استبدال العمل البشري وإحلال الآلة عوضاً عنه، وهو ما شهد زيادة مضطردة خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد الإنسان كما في السابق عنصراً محورياً في عملية الإنتاج، فقد حلت الآلة مكان العمل البشري واقتصر دور الإنسان على برمجتها ومراقبتها والإشراف عليها. وبالنظر لما تقدمه لنا الأتمتة من مزايا كبيرة كمضاعفة الإنتاج وتقليل الجهد وتحقيق الدقة وتقليص التكفلة، ينبغي علينا أن لا نغفل عن الجوانب السلبية لتلك القضية ونهملها.
تشير التقديرات إلى أن انتشار الأتمتة وإحلال الآلة مكان العمل البشري وتقسيم الأدوار بين الآلة والإنسان، سيؤديان إلى زوال نحو 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025، وهو الأمر الذي يطرح قضية البطالة في صدارة القضايا المؤرقة مع ما يرافقها من إشكالات اجتماعية وأمنية وتنموية ملحة، كما تطرح تلك القضية سؤالاً جوهريا حول أولويات التقدم التكنولوجي وأهدافه على المدى البعيد وعن مدى استعداد المجتمعات الإنسانية لسيطرة الآلة على كافة مفاصل عملية الإنتاج.
وقد كشف تقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي أن الأتمتة سوف تتطلب أن يغير مابين 3 الى 13% من عمال العالم " بحسب مستوى التنمية في البلد" مهنهم أو أن يقوموا بترقية مهاراتهم بحلول عام 2030. وبالنظر للخطط الاستراتيجية للتنمية التي تضعها الدول، نجد أن خطط تأهيل الكادر البشري فيها تصاغ في غالبها وفق تصورات آنيّة دون الأخذ بالاعتبار القفزات الصادمة وغير المتوقعة التي تحققها التكنولوجيا يومياً، الأمر الذي يولد إشكالية تتمثل في جدوى آليات التخطيط الوظيفي ونوعية التخصصات الأكاديمية المبنية على حاجة سوق العمل، وبرامج التأهيل المهني ومدى صمود تلك البرامج ومسايرتها واستيعابها لمستقبل الأتمتة.
من جهة أخرى لا بد لنا من التعريج على جانب آخر من هذه القضية والمتعلق بالملكات التي يتفوق بها الإنسان على الآلة والمتمثلة في "الوعي" وما يرتبط به من مشاعر وإدراك للذات والقدرة على الإحساس والتعاطف، وأهمية إعادة النظر في أولويات التحصيل الأكاديمي المبني على احتياجات سوق العمل، فمتطلبات التنمية تركز في الوقت الراهن وبإفراط على تدريس المعارف التي يتطلبها اقتصاد السوق وآلته الإنتاجية وبما يضمن استمرار عجلة التقدم في الدوران، مع إغفال كبير للجوانب الفكرية والعقلية ودراسة المنطق والفلسفة والفنون والعلوم الاجتماعية عموماً. وفي الغالب يعزى ذلك الإهمال إلى أن تلك المجالات غير ذات مردود مادي، أو انها ذات إسهام متواضع في مساعي التنمية، إلا أنه وكما أشرنا آنفاً فإن رهان المستقبل متوقف على تلك المجالات والحقول الأكاديمية تحديدا التي يتفوق بها الإنسان على غريمته "الآلة".
إن مستقبل الأتمتة يطرح أسئلة كثيرة وكبيرة وإشكاليات أخلاقية تزعج راحتنا وتزعزع أركان الاستقرار الذي وفرته لنا، ومن تلك الإشكاليات قضية الانحياز للآلة أو مايدعى "Automation bias"، والمتمثل في ميل الإنسان لاتخاذ القرارات وترجيح الاقتراحات التي تقدمها له أنظمة صنع القرار الآلية وتجاهل المعلومات التي تناقض اقتراحات تلك الأنظمة حتى وإن كانت صحيحة. بمعنى أن الدقة التي توفرها لنا الآلة والتكنولوجيا جعلت منا أسرى لها وبذلك تخلينا عن ملكة النقد أمام هيمنة الآلات، وهي إشكالية يطلق عليها " إساءة استخدام الأتمتة" والتي قد تؤدي بنا في نهاية المطاف إلى عواقب وخيمة لا تحمد نتائجها.
تمثل تلك القضية تحديداً فضلاً عن قضية تنامي الاعتماد على التكنولوجيا بوجه عام، بدءًا بحفظ أرقام الهواتف إلى القيادة الآلية للطائرات، تحديا كبيراً وتضعنا في مواجهة أسئلة وجودية كبرى تتعلق بتطور العقل البشري، الذي استطاع خلال مسيرته المضنية أن يحقق قفزات هائلة بسبب التحديات التي واجهها والمشكلات التي تطلبت منه إعمالا للملكات العقلية، فتمكن من صنع الأدوات وابتكر الحلول التي حققت للبشرية قفزات كبيرة، إلا أن التكنولوجيا الحديثة، أسهمت بشكل أو بآخر في تعطيل تلك الملكات، فالعقل عندما يستخدم وسائل تكنولوجية هو غير معني بكيفية عملها، ثم تغنيه تلك الوسائل عن إعمال ملكاته في مسائل عديدة سيؤدي ذلك لا محالة إلى اضمحلال تلك الملكات وقد تترتب على تلك المعضلة سلبيات تنسحب على الجنس البشري برمته. ويحق لنا هنا التخوف كذلك من السلبيات التي ستنعكس على عقول الأطفال تحديداً عندما يستخدمون وسائل التكنولوجيا، فبحسب ما توصل له علم الأعصاب فإن للتذكر دورا محوريا في تشكيل بنية الدماغ وإنشاء الروابط العصبية داخل تلك البنية، كما أن التذكر يعد ركيزة أساسية للعملية التعليمية والنمو لدى الطفل وبناءً على ذلك يكون التخوف من سلبيات التكنولوجيا الحديثة امرا مشروعا ومطروحا بلا شك.
إن الجوانب الغامضة التي تكتنف مستقبل الأتمتة كثيرة ولا يسعنا معالجتها بإسهاب في هذا المقال، في الوقت ذاته لايمكننا غض الطرف كليا عنها. عندما تسهم الأتمتة في زيادة الإنتاج وتقليص التكلفة سيؤدي ذلك لا محالة إلى توفير السلع والخدمات بأسعار زهيدة، ولكننا قد نفاجأ بأن غالبية الناس لا تستطيع اقتناء تلك المنتجات بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتقليص الوظائف والاستغناء عن العنصر البشري، وهو الوجه الآخر للأتمتة، كما أننا لا نعلم "كما أشرنا سابقا" أي منحى سيسلك مستقبل التكنولوجيا وإلى أي مدى ستسيطر فيه الآلة على البشر، سواء كانت تلك السيطرة كما تصورها لنا أفلام الخيال العلمي عبر امتلاك الآلة للوعي وتمردها على الإنسان! " وهناك من العلماء من أبدى قلقه من هذا السيناريو" أو عبر ما يطلق عليه الانحياز للآلة وسيطرة القرار التقني وسطوته على القرار البشري.
تلك التساؤلات تطلق العنان للخيال ليتصور شكل المستقبل.. فهل سيعيش الإنسان بفضل التكنولوجيا وحلولها محل الإنسان حياة رغيدة يسخّر فيها الجنس البشري الآلات لخدمته وتتغير موازين عجلة التنمية فلا يحتاج إنسان المستقبل للعمل من الأساس وسيكتفي بالخدمات الجليلة التي ستقدمها له التكنولوجيا، بينما يتفرغ هو للتأمل والاهتمام بالفنون والتفكر فيما حوله، أم أن المستقبل أقل إشراقا وربما تنقسم مجتمعات المستقبل إلى طبقات يسيطر فيها أصحاب رؤوس الأموال بمساعدة الآلات على الطبقات الأضعف، ولكن كيف ستكون تلك السيطرة وهم ليسوا في حاجة للعمال أساسا؟ هل ستخلق حاجات جديدة؟ أم سيكون هناك نوع جديد من البطالة المقنعة يتقاضى في ظلها الناس رواتب زهيدة دون مقابل من العمل ليدعموا فقط مسيرة الإنتاج المؤتمتة بالكامل ويشترون إنتاجها الزهيد واللا إنساني؟
فضلا عما سبق فإنه من الضرورة بمكان إعادة النظر في أهداف التنمية بعيدة المدى، وتخطيط الموارد البشرية ووضع أهدافها وفق نظرة بعيدة تأخذ بعين الاعتبار سيطرة الآلة وتمكنها من كافة مناحي الحياة. فوفقاً لقانون مور، "وهو القانون الذي وضعه غوردون مور أحد مؤسسي شركة (إنتل) في عام 1965، بعد أن لاحظ أن عدد الترانزستورات على شريح المعالج يتضاعف كل عامين دون أن يطرأ على سعر الشريحة أي تغيير"، فإن التكنولوجيا الحديثة وقدرة الحواسيب تشهد تضاعفا أسياً كل عامين!! ولنا أن نتخيل القدرة الفائقة لمستقبل تلك التكنولوجيا، فهل نحن مستعدون لذلك اليوم؟، وهل التخصصات الأكاديمية والتأهيل التقني والتدريب المهني المرسوم للمستقبل لرفد سوق العمل بالطاقات البشرية المؤهلة سيكون له موقع من الإعراب، وهل سنفاجأ عندما تلغي الأتمتة الحاجة لكثير من تلك التخصصات والمجالات المهنية؟ وهل سيأتي علينا يوم ستقول لنا الآلة عندما نحصل على مؤهلنا الأكاديمي" أنقعه واشرب ماءه".
اقرأ المزيد
 «ومن طلب العلا رقد الليالي.. !»
«ومن طلب العلا رقد الليالي.. !»
مثل كثيرين غيري، كنت أعتقد أن تقليل ساعات النوم قدر الإمكان علامة على الإنتاجية والطموح، وطريق مختصر للتميّز... اقرأ المزيد
108
| 06 فبراير 2026
 تبسّم ...!
تبسّم ...!
التبسم بلسم للهموم والأحزان، وله طاقة مذهلة في بثّ الفرح في القلوب والأفئدة، كان الرسول صلى الله عليه... اقرأ المزيد
48
| 06 فبراير 2026
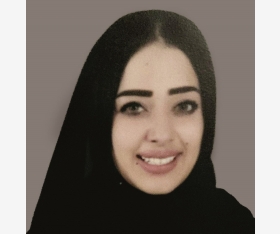 دور الشرطة المجتمعية في المدارس
دور الشرطة المجتمعية في المدارس
دور الشرطة المجتمعية هام في تحقيق الأمان لأولياء أمور الطلاب والمراهقين بالأخص، نظراً إلى بعض الحالات الاجتماعية المتعددة،... اقرأ المزيد
57
| 06 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
قطر وألمانيا.. تعاون إستراتيجي مثمر

رأي الشرق
-
الذكاء الاصطناعي في الميزان!

جاسم الشمري
-
الارتباط الوثيق بين الأزمات وعملات الدول

د. أحمد القديدي
-
«ومن طلب العلا رقد الليالي.. !»

تنصيح الرحمن الوافي
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 الشمال يتألق وأم صلال يتراجع
عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله في تفاصيل فنية أو نتائج آنية، بل يجب النظر إلى البنية الكاملة للفريق، بدءًا من الإدارة، مرورًا بالجهاز الفني، وانتهاءً بروح اللاعبين داخل الملعب. ومن هذا المنطلق، يبرز الشمال كنموذج متكامل لفريق يعرف ماذا يريد، وكيف يصل إليه. إدارة الشمال تقدم مثالًا واضحًا في الحزم والوضوح والاستقرار. القرارات تصدر بثقة، والرؤية واضحة، والدعم متواصل، ما ينعكس مباشرة على حالة الفريق داخل الملعب. هذا الاستقرار الإداري منح المدرب المساحة الكاملة للعمل، فظهر حضوره قويًا، واضح الشخصية، قادرًا على فرض الانضباط وبناء مجموعة تؤمن به وتقاتل من أجله. المدرب في الشمال ليس مجرد اسم، بل قائد فعلي، يزرع الثقة، ويخلق الانتماء، ويحول اللاعبين إلى وحدة واحدة. أما اللاعبون، فيمثلون جوهر هذا التفوق. يتميز الشمال بلاعبين يمتلكون المهارة، لكن الأهم أنهم يمتلكون العقلية. روح جماعية عالية، التزام، استعداد للتضحية، وقتالية واضحة في كل مواجهة. الفريق يلعب بشراسة إيجابية، لا تعرف الاستسلام، ويقاتل على كل كرة، وكأن كل مباراة معركة إثبات جديدة. هذه الروح لا تُشترى، بل تُبنى، والشمال نجح في بنائها بامتياز. في المقابل، يفتقد أم صلال لهذه المنظومة المتكاملة. غياب الاستقرار الفني، وتراجع الحضور القيادي، وانعدام الروح الجماعية، جعل الفريق يبدو بلا هوية واضحة. اللاعبون يدخلون المباريات دون تلك الشراسة المطلوبة، ودون الإحساس بالمسؤولية الجماعية، ما ينعكس على الأداء العام ويكرّس صورة فريق يفتقر إلى الشخصية والقتال. الفارق بين الفريقين ليس في المهارة فقط، بل في الذهنية. الشمال فريق يؤمن بنفسه، بإدارته، بمدربه، وبقدرته على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. أم صلال، في المقابل، يعاني من غياب هذه القيم الأساسية. كلمة أخيرة: يتألق فريق الشمال بانتصاراته الساحقة، مما يبرز براعته الإستراتيجية وقوة إرادته، بينما يعاني فريق أم صلال من إخفاقات متكررة، لتتكشف أمام الجميع الفجوة بين العزم والضعف، مسجّلة درسًا حقيقيًا في مجريات المنافسة الرياضية.
2028
| 04 فبراير 2026
- 2 فريدريك ما زال حياً
حين وصل الملك فريدريك الثاني الشام سنة 1228م، لم تُسجَّل له معركة كبرى أمام القدس ولم يُحاصرها بجيش يزلزل الأرض. ومع ذلك تسلم مفاتيح بيت المقدس، وذلك باتفاق مع السلطان الأيوبي الذي ليس له من اسمه نصيب (الملك الكامل). هذا الحاكم سلّم بموجب اتفاق مفاتيح القدس. لم تكن هزيمة عسكرية، بل تنازلًا سياسيًا مُخزيًا ووصمة عار في جبين الأمة حتى يومنا هذا، ولتصحيح هذا الخطأ مات الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يقف السؤال في وجه التاريخ: لماذا أُعطيت القدس بهذه السهولة؟ الجواب المؤلم يبدأ من داخل الدولة الأيوبية آنذاك لأنها كانت تعيش انقسامات. والكامل هذا كان في صراع مع إخوته وأقاربه على النفوذ في الشام، ويخشى تحالفهم ضده. فاختار أن يجعل الدولة الصليبية حائط صد بينه وبين إخوته، فماذا فعل؟! أعطى لفريدريك مفاتيح أقدس مقدسات المسلمين بلا مقابل، فقط ليأمن على سلطانه في مصر. صارت القدس ورقة في لعبة توازنات داخلية. لم تُبع في سوق، لكنها استُخدمت لتثبيت كرسي. بمعنى أوضح، مدينة بقدسيتها، بتاريخها، بدماء من سقطوا دفاعًا عنها، تحولت إلى بند في معاهدة. وهنا تكمن المرارة لأن القدس لم تكن أرضًا عادية، بل رمزًا دينيًا وحضاريًا استعادها قبل عقود صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين، وما أدراك ما حطين مشروع طويل من الإعداد والوحدة والتضحية. يومها لم تكن المسألة كرسي حكم، بل قضية أمة. صحيح أن بعض الروايات تبالغ في تقليل عدد من رافق فريدريك إلى أقل من 1000 مقاتل فقط لأنه كان مطرودًا من البابوية وغير مرغوب فيه في أوروبا وليس له وزن، ومع ذلك يتسلم هذا المطرود المنبوذ مفاتيح أولى القبلتين. وهنا الدرس الذي لا يشيخ: حين تنقسم الصفوف، يصبح الخصم أقل كلفة. لا يحتاج أن ينتصر، يكفيه أن يراقب وينتظر. هذا الفريدريك قام بمجازر ضد المسلمين في صقلية، وأرسل إليه الكامل يطلب منه التوقف لِظن هذا الناقص أن فريدريك سيحفظ له فضل وجميل إعطاء القدس كهدية، ولكن فريدريك مزّق المسلمين وفعل بهم الأعاجيب. وليس اليوم ببعيد عن أمس، فمن يظن أن الغرب يهتمون بدماء وأعراض المسلمين هو ناقص كهذا الذي نتحدث عنه. والتاريخ الإسلامي نفسه مليء بأمثلة معاكسة. رجال ضحّوا بالملك من أجل المبدأ، وفضلوا الثبات على المكسب العاجل. من زمن الصحابة الذين خرجوا يواجهون إمبراطوريات تفوقهم عددًا وعدة، إلى قادة مثل عمر المختار الذي اختار المقاومة على الخضوع، ودفع حياته ثمنًا، لكنه لم يبع كرامته. هؤلاء لم ينظروا إلى القضية كورقة تفاوض، بل كأمانة أمة. ما أريد قوله من هذه الواقعة التي مر عليها أكثر من ثمانمائة عام، وما زال صداها في الذاكرة، أن أخطر ما يضعف الدول المسلمة ليس قوة الخارج، بل خلاف الداخل، والخضوع لا يبدأ دائمًا برغبة في الاستسلام، بل أحيانًا بخوف من فقدان منصب، أو حرص على تثبيت حكم هو أصلًا زائل. ألا يكفي أن نرى النتيجة؟ حين تُقدَّم التنازلات لتجاوز أزمة داخلية أو مصلحة شخصية، قد تتحول تلك التنازلات إلى أزمات أكبر وأعمق وأشد إذلالًا. الهيبة لا تُبنى بالخطابات، بل بوحدة القرار، وبوضوح الخطوط التي لا تُمس. فالأوطان والمقدسات والثروات ليست ملكًا خاصًا للحُكام، ولا هدية تُقدَّم طلبًا لرضا القوى العظمى. الأصل: (إن تنصروا الله ينصركم). تسليم القدس سنة 1229م لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل علامة على أن الذل والخنوع والخيانة قد يفتح ما لا تفتحه الجيوش الجرارة والطائرات المسيّرة. ومن لا يتعظ بما مضى، قد يجد نفسه يعيد المشهد ذاته بأسماء جديدة.
834
| 04 فبراير 2026
- 3 هل قتل «السور» روح «الفريج»؟
امشِ في أحد أحيائنا القديمة التي بقيت على حالها، إن وجدتَها. ستلاحظ شيئاً غريباً في التصميم: الجدران قصيرة، والأبواب تكاد تكون متقابلة، و»السكيك» ضيقة وكأنها صُممت لتجعل الناس يصطدمون ببعضهم البعض فيلقون السلام. كان العمران هناك «خادماً» للوصل. وكانت روح الفريج حاضرة في كل تفصيلة معمارية. كان الحجر يُجبر البشر على التلاقي. ثم انتقل بسيارتك إلى أحيائنا السكنية الحديثة. شوارع فسيحة، وفلل تشبه القلاع الحصينة. كل بيت يحيط نفسه بسور عالٍ، وبوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة. لقد حصلنا على «الخصوصية» التي كنا نحلم بها، ولكن، هل سألنا أنفسنا عن الثمن؟ المعادلة بسيطة ومؤلمة: كلما ارتفعت الجدران الإسمنتية بين البيوت، ارتفعت معها الجدران النفسية بين القلوب، وتآكلت روح الفريج شيئًا فشيئًا. في زمن «الفريج»، كان الجار هو «خط الدفاع الأول»، وهو «الأهل» الأقرب. كانت الأمهات يتبادلن الأطباق، والأطفال يركضون من بيت لآخر وكأن الحي كله بيت واحد كبير. كانت «عين الجار» حماية، وصوته أنساً. لم يكن الفريج مجرد مكان للسكن، بل كان «نظاماً اجتماعياً» متكاملاً للتكافل والتربية المشتركة. اليوم، تحت ذريعة «الخصوصية» و»الاستقلالية»، عزلنا أنفسنا. أصبحنا نعيش لسنوات بجانب شخص لا نعرف إلا نوع سيارته. قد يمرض الجار، أو يحزن، أو يفرح، ولا نعلم عنه شيئاً إلا إذا رأينا خيام العزاء أو الزفاف صدفةً عند الباب. تحول الجار من «سند» إلى «غريب»، وأحياناً إلى مصدر إزعاج نشتكي منه إذا أوقف سيارته أمام سورنا. لقد قتلنا «روح الفريج» بدم بارد، واستبدلناها بـ «ثقافة العزلة». نحن لا ننكر أن التطور العمراني ضرورة، وأن الخصوصية حق. لا أحد يطالب بالعودة إلى بيوت الطين وضيق المكان. ولكننا نطالب بـ «أنسنة» مدننا الحديثة. المشكلة ليست في «الحجر» وحده، بل في «البشر» الذين سمحوا لهذه الأسوار أن تتسلل إلى نفوسهم. لقد استوردنا تصاميم هندسية غربية تقدس الفردية، ونسينا أننا مجتمع «جمعي» يتنفس الوصل. صممنا مدناً للسيارات لا للمشاة، وللأبواب المغلقة لا المشرعة. هل يمكننا استعادة ما فقدناه؟ نعم، ولكن البداية ليست بـ «هدم الأسوار» الإسمنتية، بل بهدم «الأسوار النفسية». أن نمتلك الشجاعة لنطرق باب الجار ومعنا «طبق حلو» وابتسامة، بلا مناسبة. أن نُحيي «مجلس الحي» ولو مرة في الشهر. أن نعلم أطفالنا أن «حق الجار» ليس مجرد كف الأذى، بل هو بذل الندى، والسؤال، والاهتمام. وهو جوهر روح الفريج. إن «الوحشة» التي نشعر بها في أحيائنا الفارهة لا يعالجها المزيد من الرخام والزجاج، بل يعالجها «دفء» القلوب المتواصلة. فلنجعل بيوتنا قلاعاً تحمينا من الخارج، نعم، ولكن لا تجعلها سجوناً تعزلنا عمن هم أقرب الناس إلينا جغرافياً، وأبعدهم عنا شعورياً.
690
| 04 فبراير 2026




