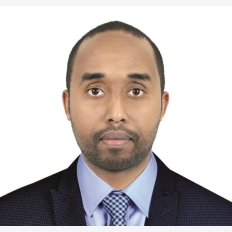رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
189
د. عبد الله محمد فارحنظرية فن الاحتواء.. الواقع الجديد في الصومال
دخلت الصومال مرحلة سياسية حساسة بعد إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «صوماليالاند»، وهي خطوة لم تأتِ في فراغ سياسي، بل إنها جاءت نتيجة تراكمات طويلة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي. وعلى الرغم من أن الاعتراف يمثل انتهاكاً واضحاً لوحدة الأراضي الصومالية، فإن التعامل معه يحتاج إلى قراءة هادئة وواعية للظروف التي جعلت «صوماليالاند» تجرؤ على اتخاذ هذا المسار، وللخيارات الواقعية المتاحة أمام الصومال والدول العربية والأفريقية في هذه اللحظة. ولا سيما أن «صوماليالاند» نالت إقليم إدارة ذاتية منذ عام 1991م، وترسخ ذلك في الدستور الوطني للصومال الفيدرالية عام 2012م، كفيدرالية سياسية لديها مؤسسات متكاملة. وهنا يبرز «فنّ الاحتواء» كإطار نظري وعملي لفهم الوضع الجديد وإدارته بعيداً عن ردود الفعل العاطفية أو المقاربات العقابية التي لا تنتج استقراراً ولا تحفظ الوحدة.
فالخطوة التي أقدمت عليها «صوماليالاند» لم تكن حدثاً مفاجئاً لمن يتابع مسار تطوّرها السياسي والإداري والقانوني التاريخي. فمنذ أكثر من ثلاثة عقود، تبني المنطقة مؤسساتها وتبحث عن اعتراف دولي لم يتحقق، لكنها خلال السنوات الأخيرة شعرت بأن تجاهل الدول العربية والأفريقية لها، وتراجع اهتمام الحكومة الصومالية بملفها، جعل الفراغ السياسي والدبلوماسي يتّسع حولها. وهذا التجاهل، سواء كان مقصوداً أو ناتجاً عن انشغال مقديشو بالتحديات الأمنية والاقتصادية والمعيشية، فتح الباب أمام أطراف دولية للعب دور مباشر في ملء هذا الفراغ، وفي مقدمتها إسرائيل التي رأت في «صوماليالاند» نقطة دخول جديدة إلى منطقة البحر الأحمر وممراته الحساسة على طرق التجارة العالمية.
ولا يمكن تحميل «صوماليالاند» المسؤولية وحدها؛ إذ تتحمل الحكومة الصومالية نفسها جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الوصول إلى هذه اللحظة. فسنوات من الإهمال السياسي، وضعف التواصل الدبلوماسي، وغياب البرامج التنموية المتوازنة بين المقاطعات، ساهمت في تعزيز شعور الانفصال والبحث عن بدائل خارجية. ولم تُقدّم الدولة المركزية نموذجاً جاذباً لوحدة سياسية واقتصادية، ولم تُدَر مسألة «صوماليالاند» برؤية طويلة الأمد، بل اكتفت بالرهان على الزمن وعلى الرفض الدولي للانفصال، دون معالجة الأسباب الداخلية التي تدفع المنطقة إلى الاعتقاد بأن الاعتراف الخارجي أقرب من المصالحة الوطنية.
لكن مقابل النقد، هناك مسار آخر ضروري: وهو التفكير في الخيارات الواقعية المتاحة اليوم. فالدعوات العربية والأفريقية التي ظهرت في شكل بيانات تنديد أو استنكار، لن تُغيّر في الموقف شيئاً، ولن تردع «صوماليالاند» عن مواصلة مسارها في تحقيق أي انفتاح مع تل أبيب طالما البدائل غير موجودة، لأن المشكلة ليست داخلية بنيوية. ولذلك يصبح فنّ الاحتواء ضرورياً ليس للصومال وحدها، بل للدول العربية والأفريقية جميعاً. فالاحتواء يعني الاعتراف بأن مقاربة الهجوم والضغط ليست مجدية، وأن المرحلة تحتاج إلى مبادرات في اتجاه آخر: مبادرات اقتصادية، وتنموية، واجتماعية، وتعليمية وصحية، تُعيد بناء الثقة بين المركز و«صوماليالاند» والأقاليم الأخرى، وتقدّم نموذجاً واقعياً للوحدة بدل الاكتفاء بالدفاع اللفظي عنها.
إن الصومال تعيش حالياً واحدة من أقسى أزماتها المالية منذ سنوات. فالعجز المالي، وتراجع الإنتاج المحلي، وتضرر الموارد بفعل التقلبات الأمنية، كلها تجعل من الصعب على الدولة تقديم نموذج جذاب لجميع الولايات. وهذا الواقع يجب ألا يكون لحظة إلقاء اللوم، بل نقطة انطلاق لحوار عربي وإسلامي وأفريقي حول كيفية دعم الصومال مالياً وتنموياً، بدل تركها وحيدة في مواجهة فراغ سياسي تجد فيه القوى الدولية مساحة للتدخل. فالحلول التي تحتاجها الصومال لا تقوم على الأمن فقط، بل على خلق وظائف، وبناء مدارس، وتطوير الموانئ، وتحسين القطاع الصحي، ودعم الجامعات، وتوفير بنى تحتية قادرة على دمج الولايات والمجتمعات في نموذج دولة واحدة.
وفي هذا السياق، على الدول العربية أن تدرك أن «صوماليالاند» لم تنجذب للاعتراف الإسرائيلي بسبب دوافع سياسية فقط، بل لأن المنطقة شعرت بأن العالم العربي والأفريقي لم يقدم لها بديلاً اقتصادياً وتنموياً حقيقياً. فالدعم الذي لا يتجاوز الإطار الخطابي لا يبني ولاءً سياسياً، ولا يعزز الوحدة الوطنية. وإذا أرادت الدول العربية حماية وحدة الصومال، فلا بد من انتقالها من مرحلة «الاستنكار» إلى مرحلة «الاستثمار»، ومن مرحلة «التنديد» إلى مرحلة «التنمية المشتركة». والدور نفسه ينطبق على المنظمات الأفريقية والإسلامية التي تحتاج إلى التعامل مع الملف بعمق سياسي وتنموي، وليس عبر ردود فعل مؤقتة.
ومن هذا المنطلق، يصبح فنّ الاحتواء مرادفاً سياسياً وتأطيرياً لفنّ بناء الثقة ومد جسور التواصل الدبلوماسي. فهو يدعو إلى امتصاص نتائج الاعتراف الإسرائيلي دون اندفاع وردات فعل غير مؤثرة، وإلى إطلاق مبادرات تنموية تضمن استعادة الثقة بين الصومال و«صوماليالاند»، وإلى إنتاج خطاب سياسي جديد أكثر عقلانية وواقعية؛ يعترف بالأخطاء ولا يكررها، ويُعيد رسم الأولويات على أساس ما يحتاجه الواقع لا ما تمليه الانفعالات. وهذه هي الخطوة الأولى نحو تحول الأزمة الراهنة إلى فرصة جديدة، وإلى جعل القرن الأفريقي منطقة استقرار دائم بدلاً من أن تبقى مسرحاً للنزاع الأهلي، والتدخل الإقليمي، وللتجاذبات والصراعات الدولية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
سياسة قطر الوطنية للرياضة

رأي الشرق
-
فصول اجتماعية

إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا
د. عبدالله العمادي
-
خطف رئيس فنزويلا بين السينما والسياسة

إبراهيم عبد المجيد
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 غدًا نرفع الهتاف لمصر الفؤاد
غدًا، لن نخوض مجرد مباراة في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بل سنقف على حافة حلم لا يحتمل السقوط. منتخب مصر على موعد مع اختبار قاسٍ، تسعين دقيقة قد تُعيد الروح أو تُعمّق الجرح، حين يواجه بنين في مواجهة مصيرية لا تحتمل أي خطأ. غدًا، ستكون القمصان الحمراء مثقلة بآمال شعب كامل، والقلوب معلّقة بكل تمريرة وكل التحام. مباراة خروج مغلوب، لا مجال فيها للحسابات ولا للأعذار، ولا مكان للتردد أو التهاون. بنين خصم عنيد، يعرف كيف يغلق المساحات وينتظر الخطأ، لكن مصر لا تُهزم عندما تلعب بقلبها قبل قدمها. نريد أن تكون الشراسة والقتالية حاضرة على أرضية الملعب حتى الرمق الأخير من عمر المباراة، نريد روح القتال التي تُعرف بها الكرة المصرية. الأنظار كلها على محمد صلاح، القائد الذي يعرف طريق المواعيد الكبرى، حيث سيشكل محورًا أساسيًا في صناعة اللعب وتهديد المرمى بقيادته الهجومية، إلى جانب الحيوية والسرعة التي سيضيفها عمر مرموش في التحركات الأمامية، مانحًا الفريق خيارات متعددة وخطورة مستمرة نحو مرمى الخصم. وهنا يأتي دور حسام حسن، الرجل الذي يعرف جيدًا ماذا يعني اسم مصر. غدًا، نطالب حسام حسن بأن يكون المدرب القارئ للمباراة، القادر على استثمار طاقات لاعبيه، وتوظيفهم توظيفًا سليمًا على أرضية الملعب. نريده أن يقود الفريق بعقل هادئ وقلب مشتعل، وأن يتحكم في مجريات المباراة منذ البداية وحتى صافرة النهاية. أما على صعيد اللاعبين، فالرسالة واضحة: نريد منكم تركيزًا كاملًا وحضورًا ذهنيًا لا يغيب طوال التسعين دقيقة. لا نريد لحظة استهتار، ولا ثانية غفلة. كل كرة معركة، وكل قرار قد يصنع الفارق بين الفرح والحسرة. كلمة أخيرة: غدًا، نريد منتخبًا يقاتل حتى آخر لحظة، منتخبًا يحمل روحنا وعشقنا القديم للكرة المصرية بكل قوة وإصرار. نريد فوزًا يملأ المدرجات فخرًا ويُعيد الثقة لكل من يحمل القميص الأحمر ويؤمن بالكرة المصرية، ويُثبت لكل العالم أن مصر حين تخوض المواعيد الكبرى لا تعرف إلا الانتصار.
1671
| 04 يناير 2026
- 2 العرب يتألقون في إفريقيا
في نسخة استثنائية من كأس الأمم الإفريقية، أثبتت الكرة العربية حضورها بقوة بعدما بلغ كل من المغرب، ومصر، والجزائر الدور ربع النهائي، في مشهد يعكس تطور الأداء والانضباط التكتيكي للمنتخبات العربية وقدرتها على المنافسة على أعلى مستوى. هذا النجاح لم يأتِ بالصدفة، بل كان نتيجة تخطيط واضح، وعقلية محترفة، وروح تنافسية جعلت الفرق العربية قوة لا يمكن تجاهلها في البطولة. الروح التي تتحلى بها هذه المنتخبات تتجاوز مجرد الأداء البدني أو التكتيكي، فهي روح الانتماء والفخر بالعلم والهوية. يظهر ذلك في كل مباراة، حيث يتحد اللاعبون من أجل هدف واحد، ويقدمون أقصى ما لديهم، حتى في أصعب اللحظات. هذه الروح الجماعية تمنح المغرب، ومصر، والجزائر القدرة على الصمود أمام المنافسين الأقوياء، وتحويل التحديات إلى فرص لإظهار الإبداع والقوة على أرض الملعب. أما الشراسة، فهي السمة الأبرز لهذه الفرق. على أرض الملعب، يقاتل اللاعبون على كل كرة، بعزيمة وإصرار لا يلين، كأن كل لحظة من عُمْر المباراة هي الفرصة الأخيرة. هذه الشراسة ليست مجرد قوة، بل تعبير عن الانضباط والالتزام بالاستراتيجية، وحرصهم على الدفاع عن سمعة الكرة العربية. مع كل تدخل، وكل هجمة مرتدة، يظهر أن هذه الفرق لا تعرف الاستسلام، وقادرة على قلب الموازين مهما كانت صعوبة المنافس. أما الطموح فهو المحرك الحقيقي لهذه الفرق. الطموح لا يقتصر على الوصول إلى ربع النهائي، بل يمتد إلى حلم أكبر، وهو رفع الكأس وإثبات أن الكرة العربية قادرة على منافسة عمالقة القارة. ويظهر في التحضير الشامل، والاستراتيجية المحكمة، وجهود كل لاعب لإتقان مهاراته والمساهمة بانسجام مع الفريق. ويتجسد هذا الطموح أيضًا في حضور نجوم صنعوا الفارق داخل المستطيل الأخضر؛ حيث قاد إبراهيم دياز المنتخب المغربي بلمسته الحاسمة وتألقه اللافت كهداف للبطولة، بينما جسّد محمد صلاح مع منتخب مصر روح القيادة والخبرة والحسم في اللحظات المفصلية، وفي الجزائر يظهر عادل بولبينة كعنصر هجومي فعّال، يمنح الفريق سرعة وجرأة في التقدّم، ويترجم حضوره بأهداف استثنائية على أعلى مستوى، وهو ما يؤكّد أن النجومية الحقيقية لا تكتمل إلا داخل منظومة جماعية متماسكة. كلمة أخيرة: النجاح العربي في البطولة ليس مجرد نتيجة مباريات، بل انعكاس للروح، للشراسة، وللطموح المستمر نحو القمة. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن المغرب، ومصر، والجزائر لم تعد مجرد فرق مشاركة، بل قوة لا يمكن تجاهلها، تحمل رسالة واضحة لكل منافس: نحن هنا لننافس، لنلهم، ولننتصر.
1191
| 08 يناير 2026
- 3 «الكشخة» ليست في السعر.. فخ الاستعراض الذي أهلكنا
امشِ في الرواق الفاخر لأي مجمع تجاري حديث في مدننا، ستلاحظ شيئاً غريباً، الهدوء هنا مختلف، والرائحة مختلفة، وحتى طريقة المشي تتغير، أنت لست في سوق تشتري منه حاجاتك، بل أنت في «معبد» جديد تغذيه ثقافة الاستعراض، طقوسه الماركات، وقرابينه البطاقات الائتمانية. في الماضي القريب، كنا نشتري السيارة لتوصلنا، والساعة لتعرفنا الوقت، والثوب ليسترنا ويجملنا، كانت الأشياء تخدمنا. كنا أسياداً، وهي مجرد أدوات، لكن شيئاً ما تغير في نظام تشغيل حياتنا اليومية. لقد تحولنا، بوعي أو بدونه، من مستهلكين للحاجات، إلى ممثلين على خشبة مسرح مفتوح اسمه وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا لا نشتري الشيء لنستمتع به، بل لنصوره. أصبح السؤال الأول قبل أن نطلب القهوة أو نشتري الحقيبة: «هل شكلها حلو في التصوير؟». هذه «الثقافة الاستعراضية» قلبت المعادلة، لم تعد الأشياء تخدمنا، بل أصبحنا نحن موظفين عند هذه الماركات، ندفع دم قلوبنا ونستدين من البنوك، لنقوم نحن بالدعاية المجانية لشعار شركة عالمية، فقط لنقول للناس: «أنا موجود.. أنا ناجح.. أنا أنتمي لهذه الطبقة». لقد أصبحنا نعيش «حياة الفاترينات». المشكلة ليست في الرفاهية، باقتصاد، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، المشكلة هي حين تتحول الرفاهية من متعة إلى قيد، حين تشعر بضيق في صدرك لأنك لا تملك «الترند» الجديد. حين يضغط الشاب على والده المتقاعد، أو تستدين الفتاة، لشراء كماليات هي في الحقيقة أغلال ذهبية. لقد تم صناعة رغباتنا بذكاء، حتى نسينا تعريف الوجاهة الحقيقي. في مجالسنا القديمة، كانت قيمتك بعلومك الغانمة، بأخلاقك، بوقفتك مع الصديق، ورجاحة عقلك. لم يكن أحد يسأل عن ماركة نعالك أو سعر ساعتك ليعرف «من أنت». أما اليوم، فتحاول الإعلانات والمؤثرون إقناعنا بأن قيمتك تساوي ما تلبس وما تركب. وأن الخروج من ثقافة الاستعراض يعني أنك متأخر عن الركب. نحن بحاجة لوقفة صادقة مع النفس، نحتاج أن نتحرر من هذا السباق الذي لا خط نهاية له. السباق الذي يجعلك تلهث خلف كل جديد، ولا تصل أبداً للرضا. القيمة الحقيقية للإنسان تنبع من الداخل، لا من الخارج، «الرزة» الحقيقية هي عزة النفس، والثقة، والقناعة. جرب أن تعيش يوماً لنفسك، لا لعدسة الكاميرا، اشرب قهوتك وهي ساخنة قبل أن تبرد وأنت تبحث عن زاوية التصوير، البس ما يريحك لا ما يبهرهم. كن أنت سيد أشيائك، ولا تجعل الأشياء سيدة عليك، ففي النهاية، كل هذه الماركات ستبلى وتتغير، ولن يبقى إلا أنت ومعدنك الأصيل.
960
| 07 يناير 2026