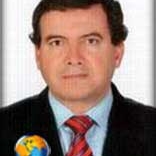رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
704
توفيق المدينيالثورات العربية والقطيعة مع النظام القديم (1)
لاتزال الثورات الديمقراطية العربية في بداياتها، رغم سقوط عدد من الأنظمة الديكتاتورية العربية في كل من تونس، ومصر، وليبيا، وككل الثورات التي شهدها عالمنا المعاصر منذ القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا، تعرف الثورات الديمقراطية العربية حالة من المد والجزر، وحتى من «الخيانة» لا سيما من جانب الدول الغربية التي تحدد مواقفها بدلالة مصالحها النفطية، وحسابات الربح والخسارة، وأمن إسرائيل، لا بدلالة القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وهي لا تكترث أبداً لتطلعات وطموحات الشعوب العربية في تحقيق حريتها وكرامتها الإنسانية.
ويتساءل المحللون الغربيون، هل ثمة تشابه بين ربيع الثورات العربية في سنة 2011، وربيع الثورات الأوروبية في عام 1848؟ هناك رأي يقول إن ثمة فرقاً بيّناً بين الثورات العربية، والثورات التي حصلت في أوروبا الشرقية عقب سقوط جدار برلين، ونهاية الحرب الباردة في سنة 1989، حيث إن تلك الثورات التي أسقطت الأنظمة الشيوعية الشمولية وأفضت إلى طي الشيوعية، والانعتاق في خيار العولمة الليبرالية، ولدت من رحم حادثة سياسية واحدة هي سحب السوفيات دعمهم الديكتاتوريين المحليين. وعلى خلاف ثورات 1989 الأوروبية، وهذه تشابهت مساراتها ومطالبها، الثورات العربية هي من بنات عوامل متشعبة وكثيرة، منها الاقتصادي والتكنولوجي والسكاني. وخطت الثورة في كل من المناطق العربية مساراً خاصاً بها. وعليه، الثورات العربية هي أقرب إلى ثورات أوروبا في 1848 منها إلى ثورات 1989.
ففي ثورات أوروبا 1848، منيت معظمها بالإخفاق. فالمجريون طردوا النمسويين. ولكن هؤلاء سرعان ما عادوا أدراجهم. وأخفق الألمان في الاتحاد. وأنشأ الفرنسيون جمهورية انهارت بعد أعوام قليلة. وصيغت دساتير لم تنفذ، وأهملت، وبقيت في الأدراج. وأطيحت ممالك، ثم أرسيت من جديد. ويقول المؤرخ أ.ب.جي تايلور عن لحظة 1848 الأوروبية إن «التاريخ بلغ منعطفاً ولكنه لم ينعطف».ولكن الأفكار التي كانت متداولة في 1848 ترسخت في الثقافة والمجتمع، وبلغــت بـعض أهداف الثـــورات هذه لاحقاً. ففي نهاية القرن التاسع عشر، أفلح المـسـتـشار بيــسمارك في توحيد ألمـانيا. وأبـصرت الجمهورية الثالثة النور في فرنسا. واستقلت الأمم التي حكمتها إمبراطورية الهابسبورغ بعد الحرب العالمية الأولى. وفي 1849، بدا أن معظم ثورات العام السابق أخفق، وأنه انتهى إلى كارثة. ولكن تقويم الثورات هذه بعد نحو خمسة عقود في 1899 أو بعد الحرب العالمية الأولى في 1919 اختلف. وبدا يومها أن 1848 هي بداية مرحلة تغيير مثمرة. وفي العالم العربي اليوم، وفي مرآة 2012 قد يبدو أن بعض هذه الثورات العربية أخفق. فالأنظمة الديكتاتورية المطاحة قد تنبعث، وتكتب لها حياة جديدة. وقد تخفق الديمقراطية، وقد تنقلب النزاعات الإثنية حرباً اثنية. وعلى ما تظهر تجارب 1848، تغير الأنظمة السياسية هو سيرورة طويلة تحتاج إلى الوقت. وقد لا يكون التغيير وليد ثورة، بل ثمرة التفاوض والتنازل عن السلطة. وقد يلجأ بعض ديكتاتوريي المنطقة إلى هذا الحل.
لكن بشهادة كبار المحللين العرب والغربيين، يشهد العالم العربي يقظة جديدة من الثورات الديمقراطية، تقودها حركات شبابية جامعية نزلت إلى شوارع العواصم والمدن الكبرى العربية، ووصلت إلى سنّ الوعي، وتستخدم أرقى ما توصلت إليه ثورة الإنترنت، وثقافة الفيسبوك من أجل توعية المواطنين العرب بقيم الحرية والكرامة، والمواطنة، والمشاركة السياسية والتعددية الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، لإحداث التغيير السياسي الذي طال انتظاره في معظم البلدان العربية.
وإذا كانت هذه الديناميكية الشبابية التي طرحت معركة «إسقاط النظام» باعتبارها المعركة الرمزيّة الأولى لإثبات القدرة والوعي أن كلّ شيء سيتغير في العالم العربي، وحققت نجاحات مهمة في ثلاث بلدان عربية هي تونس، ومصر، وليبيا، فإنها لا تزال تشق طريقها في ظل تضاريس وعرة في كل سوريا، وغيرها من البلدان العربية. وفي المنظور السوسيولوجي القيمي، تخوض الحركات الشبابية العربية إلى جانب مطالباتها السياسية التي ليست معركتها الوحيدة، ثورة أخرى لا تقل أهمية هي ثورة على القيم التقليدية الموروثة من الأب والعائلة والعشيرة والمدينة، تذكرنا بثورة الشباب (مايو 1968) التي هزت البلدان الأوروبية، وتصادمت في ذلك الوقت مع القيم البرجوازية التي كانت مسيطرة، في المجتمعات الغربية الرأسمالية، وهو ما أفسح في المجال لولادة تنظيمات اليسار الجديد لاحقاً.
إن أهم خاصية للثورات الديمقراطية العربية، أنها حطمت ما يسمى في علم الاجتماع الحديث بالسلم الاجتماعية، لأن الدول العربية التي يغلب عليها الطابع الريعي سواء النفطية أو غير النفطية مثل مصر، التي تعيش على السياحة، ومن تحويلات عائدات المهاجرين المصريين في الخارج، ومن عائدات قناة السويس، ومن المساعدات الأميركية، هذه الدول جميعها عجز ت عن إيجاد حلول واقعية للبطالة لا سيما بطالة الخريجين من الجامعات.
الثورة التونسية التي فجرت ما يسمى اليوم بـ «الربيع العربي»، ودشنت دورة جديدة في التاريخ السياسي العربي، كانت متناقضة كلياً مع أيديولوجية العنف وعقيدة التدمير التي تتبناها «القاعدة» وأخواتها من تنظيمات «أنصار الشريعة» المنتشرة في تونس وليبيا واليمن، والداعية إلى كراهية أمريكا وإلى العنف والتدمير كوسيلة للتغيير. وتبنت الثورة التونسية نظرية البناء عقيدة لا التدمير والعنف، واختارت القطع الثوري مع النظام القديم. الثورة قطيعة، وتجاوز ديالكتيكي للواقع القائم، وهي تطمح إلى تشييد، نظام جديد يقوم على المبادئ التي ترتكز عليها المجتمعات الديمقراطية المعاصرة والمتطورة.
هذه الثورة لم تكن موجهة ضد عدو خارجي، بل كانت موجهة ضد نظام الاستبداد الذي استقر لعقود من الزمن منذ رحيل الاستعمار عن البلدان العربي، نظام الاستبداد بشقيه المستنير والأبوي أو نظام الاستبداد الطاغي والنهاب. والرهام لم يعد مقتصرا على مفاوضات مع فاعلين خارجيين أصدقاء كانوا أو أعداء، وإنما على التطورات الداخلية بالأساس لهذه المجتمعات العربية التي أصبحت ضرورية، تحت ضغط القوى الاجتماعية نفسها.
لاشك أن الذي يحدد هذه التطورات في آن معاً، قوى القطيعة الثورية، وقوى الاستمرارية، وقوى التجديد. فلا يوجد نظام ثوري جاهز، فالمجتمع هو الذي يحدد وبشكل سيادي ما يجب أن يتحرر منه، ويتمسك به، وما يترتب عليه من بناء نظام ديمقراطي جديد يكون الجواب التاريخي لإدراكه الدخول فيما يسمى حضارة العصر والمجتمعات الديمقراطية. وإذا كانت هذه التطورات منوطة بالإرادة الشعبية، فإنها مع ذلك تصطدم بعدة عوائق كبيرة من أجل بناء نظام ديمقراطي جديد.
فالتحول الديمقراطي يستهدف إجراء إصلاحات جذرية على جميع المستويات من أجل إرساء نظام ديمقراطي جديد، يتسم بالرسوخ، ويؤسس لدولة المؤسسات والقانون.
أولاً: ضرورة وجود الديمقراطية التعددية، التي تتطلب إنشاء أحزاب معارضة كعملية طبيعية لحرية الفرد في إبداء رأيه، وحرية انتقاد الحكومة، وحرية الشعب في إعادة إقامة حكومة يختارها عن طريق الاقتراع السري. فالتحول الديمقراطي، يقتضي التحرر كليا من نظام الحزب الواحد القابض على زمام السلطة، ووجود معارضة منظمة كخلف احتياطي محتمل وفي استطاعتها أن تحل محل الحكومة.
إن الديمقراطية التعددية هي التي تضمن المشاركة الشعبية الواسعة النطاق، ورضاء من جانب المحكومين، ونوع من الرقابة العامة على هؤلاء الذين يتولون السلطة. ولاشك أن الديمقراطية التعددية قد تتخذ أشكالاً وترتيبات سياسية متنوعة طبقاً للظروف والحلول التاريخية المرتبطة بكل بلد.
ثانياً: إن التحول الديمقراطي الحقيقي مرتبط بالتنمية الاقتصادية، وهو يقوم على دعامتين أساسيتين: الدعامة الأولى تتمثل في أن الديمقراطية تعني تنظيم الأفراد في جماعات تنافسية من خلال نظام تعددية حزبية بهدف السيطرة على سلطة الدولة. والدعامة الثانية، إن الديمقراطية شرط أساسي لبناء الدولة الوطنية التي تستطيع مقاومة الضغوط السلبية النابعة من النظام الدولي الجديد الذي تتحكم فيه القوى الدولية الغربية، والمؤسسات المالية المانحة، وكذلك ما يترتب عليها داخليا من آثار وعواقب.
اقرأ المزيد
 المشهور الذي لم يعد مشهوراً
المشهور الذي لم يعد مشهوراً
(ترويج «مشاهير التواصل» للسلع الرديئة يفقدهم المصداقية) جذبني هذا العنوان لدى تصفُّحي اليومي لموقع صحيفة الشرق القطرية وهو... اقرأ المزيد
174
| 25 نوفمبر 2025
 معايير الجمال
معايير الجمال
منذ صغرنا ونحن نشاهد الأفلام والدعايات التي رسخت في عقولنا الشكل والجسم الذي يجب أن نظهر عليه. أتحدث... اقرأ المزيد
177
| 25 نوفمبر 2025
 ارتفاع الإيجارات.. أزمة متنامية تستدعي حلولًا واقعية
ارتفاع الإيجارات.. أزمة متنامية تستدعي حلولًا واقعية
يشهد سوق العقارات في دولة قطر ارتفاعاً متواصلاً في الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، حتى أصبحت الإيجارات... اقرأ المزيد
330
| 25 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
قمة «وايز».. الإنسان أولا

رأي الشرق
-
اتساقات الحياة!

خولة البوعينين
-
شيء من الخوف!

عصام بيومي
-
المشهور الذي لم يعد مشهوراً

ابتسام آل سعد
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 وزارة التربية.. خارج السرب
هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور الكرام… لحظات تُعلن فيها مؤسسات الدولة أنها انتقلت من مرحلة “تسيير الأمور” إلى مرحلة صناعة التغيير ونقل الجيل من مرحلة كان إلى مرحلة يكون. وهذا بالضبط ما فعلته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في السنوات الأخيرة. الأسرة أولاً… بُعدٌ لا يفهمه إلا من يعي أهمية المجتمع ومكوناته، مجتمعٌ يدرس فيه أكثر من 300 ألف طالب وطالبة ويسند هذه المنظومة أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب آلاف الإداريين والمتخصصين العاملين في الوزارة ومؤسساتها المختلفة. لذلك حين قررت الوزارة أن تضع الأسرة في قلب العملية التعليمية هي فعلاً وضعت قلب الوطن ونبضه بين يديها ونصب عينيها. فقد كان إعلانًا واضحًا أن المدرسة ليست مبنى، بل هي امتداد للبيت وبيت المستقبل القريب، وهذا ليس فقط في المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة أيضًا تسجل قفزات واضحة وتنافس وتقدم يداً بيد مع المدارس الحكومية. فمثلاً دور الحضانة داخل رياض الأطفال للمعلمات، خطوة جريئة وقفزة للأمام لم تقدّمها كثير من الأنظمة التعليمية في العالم والمنطقة. خطوة تقول للأم المعلمة: طفلك في حضن مدرستك… ومدرستك أمانة لديك فأنتِ المدرسة الحقيقية. إنها سياسة تُعيد تعريف “بيئة العمل” بمعناها الإنساني والحقيقي. المعلم… لم يعد جنديًا مُرهقًا بل عقلاً مُنطلقًا وفكرًا وقادًا وهكذا يجب أن يكون. لأول مرة منذ سنوات يشعر المُعلم أن هناك من يرفع عنه الحِمل بدل أن يضيف عليه. فالوزارة لم تُخفف الأعباء لمجرد التخفيف… بل لأنها تريد للمعلم أن يقوم بأهم وظيفة. المدرس المُرهق لا يصنع جيلاً، والوزارة أدركت ذلك، وأعادت تنظيم يومه المدرسي وساعاته ومهامه ليعود لجوهر رسالته. هو لا يُعلّم (أمة اقرأ) كيف تقرأ فقط، بل يعلمها كيف تحترم الكبير وتقدر المعلم وتعطي المكانة للمربي لأن التربية قبل العلم، فما حاجتنا لمتعلم بلا أدب؟ ومثقف بلا اخلاق؟ فنحن نحتاج القدوة ونحتاج الضمير ونحتاج الإخلاص، وكل هذه تأتي من القيم والتربية الدينية والأخلاق الحميدة. فحين يصدر في الدولة مرسوم أميري يؤكد على تعزيز حضور اللغة العربية، فهذا ليس قرارًا تعليميًا فحسب ولا قرارًا إلزاميًا وانتهى، وليس قانونًا تشريعيًا وكفى. لا، هذا قرار هوية. قرار دولة تعرف من أين وكيف تبدأ وإلى أين تتجه. فالبوصلة لديها واضحة معروفة لا غبار عليها ولا غشاوة. وبينما كانت المدارس تتهيأ للتنفيذ وترتب الصفوف لأننا في معركة فعلية مع الهوية والحفاظ عليها حتى لا تُسلب من لصوص الهوية والمستعمرين الجدد، ظهرت لنا ثمار هذا التوجه الوطني في مشاهد عظيمة مثل مسابقة “فصاحة” في نسختها الأولى التي تكشف لنا حرص إدارة المدارس الخاصة على التميز خمس وثلاثون مدرسة… جيش من المعلمين والمربين… أطفال في المرحلة المتوسطة يتحدثون بالعربية الفصحى أفضل منّا نحن الكبار. ومني أنا شخصيًا والله. وهذا نتيجة عمل بعد العمل لأن من يحمل هذا المشعل له غاية وعنده هدف، وهذا هو أصل التربية والتعليم، حين لا يعُدّ المربي والمعلم الدقيقة متى تبدأ ومتى ينصرف، هنا يُصنع الفرق. ولم تكتفِ المدارس الخاصة بهذا، فهي منذ سنوات تنظم مسابقة اقرأ وارتقِ ورتّل، ولحقت بها المدارس الحكومية مؤخراً وهذا دليل التسابق على الخير. من الروضات إلى المدارس الخاصة إلى التعليم الحكومي، كل خطوة تُدار من مختصين يعرفون ماذا يريدون، وإلى أين الوجهة وما هو الهدف. في النهاية… شكرًا لأنكم رأيتم المعلم إنسانًا، والطفل أمانة، والأسرة شريكًا، واللغة والقرآن هوية. وشكرًا لأنكم جعلتمونا: نفخر بكم… ونثق بكم… ونمضي معكم نحو تعليم يبني المستقبل.
13596
| 20 نوفمبر 2025
- 2 صبر المؤمن على أذى الخلق
في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به المؤمن أذى الناس، ليس كضعفٍ أو استسلام، بل كقوة روحية ولحمة أخلاقية. من منظور قرآني، الصبر على أذى الخلق هو تجلٍّ من مفهوم الصبر الأوسع (الصبر على الابتلاءات والطاعة)، لكنه هنا يختصّ بالصبر في مواجهة الناس — سواء بالكلام المؤذي أو المعاملة الجارحة. يحثّنا القرآن على هذا النوع من الصبر في آيات سامية؛ يقول الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: 10). هذا الهجر «الجميل» يعني الانسحاب بكرامة، دون جدال أو صراع، بل بهدوء وثقة. كما يذكر القرآن صفات من هم من أهل التقوى: ﴿… وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ … وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: 134). إن كظم الغيظ والعفو عن الناس ليس تهاونًا، بل خلق كريم يدل على الاتزان النفسي ومستوى رفيع من الإيمان. وقد أبرز العلماء أن هذا الصبر يُعدُّ من أرقى الفضائل. يقول البعض إن كظم الغيظ يعكس عظمة النفس، فالشخص الذي يمسك غضبه رغم القدرة على الردّ، يظهر عزمًا راسخًا وإخلاصًا في عبادته لله. كما أن العفو والكظم معًا يؤدّيان إلى بناء السلم الاجتماعي، ويطفئان نيران الخصام، ويمنحان ساحة العلاقات الإنسانية سلامًا. من السنة النبوية، ورد عن النبي ﷺ أن من كظم غيظه وهو قادر على الانتقام، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فكم هو عظيم جزاء من يضبط نفسه لصالح رضا الله. كما تبيّن المروءة الحقيقية في قوله ﷺ: ليس الشديد في الإسلام من يملك يده، بل من يملك نفسه وقت الغضب. أهمية هذا الصبر لم تذهب سدى في حياة المسلم. في مواجهة الأذى، يكون الصبر وسيلة للارتقاء الروحي، مظهراً لثقته بتقدير الله وعدله، ومعبّراً عن تطلع حقيقي للأجر العظيم عنده. ولكي ينمّي الإنسان هذا الخلق، يُنصح بأن يربّي نفسه على ضبط الغضب، أن يعرف الثواب العظيم للكاظمين الغيظ، وأن يدعو الله ليساعده على ذلك. خلاصة القول، الصبر على أذى الخلق ليس مجرد تحمل، بل هو خلق كرامة: كظم الغيظ، والعفو، والهجر الجميل حين لا فائدة من الجدال. ومن خلال ذلك، يرتقي المؤمن في نظر ربه، ويَحرز لذاته راحة وسموًا، ويحقّق ما وصفه الله من مكارم الأخلاق.
1797
| 21 نوفمبر 2025
- 3 المغرب يحطم الصعاب
في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17 عاماً إلى أسمى آفاق الإنجاز، حين حجزوا مقعدهم بين عمالقة كرة القدم العالمية، متأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم في قطر 2025. لم يكن هذا التأهل مجرد نتيجة، بل سيمفونية من الإرادة والانضباط والإبداع، أبدعها أسود الأطلس في كل حركة، وفي كل لمسة للكرة. المغرب قدم عرضاً كروياً يعكس التميز الفني الراقي والجاهزية الذهنية للاعبين الصغار، الذين جمعوا بين براعة الأداء وروح التحدي، ليحولوا الملعب إلى مسرح للإصرار والابتكار. كل هجمة كانت تحفة فنية تروي قصة عزيمتهم، وكل هدف كان شاهداً على موهبة نادرة وذكاء تكتيكي بالغ، مؤكدين أن الكرة المغربية لا تعرف حدوداً، وأن مستقبلها مزدهر بالنجوم الذين يشقون طريقهم نحو المجد بخطوات ثابتة وواثقة. هذا الإنجاز يعكس رؤية واضحة في تطوير الفئات العمرية، حيث استثمر الاتحاد المغربي لكرة القدم في صقل مهارات اللاعبين منذ الصغر، ليصبحوا اليوم قادرين على مواجهة أقوى المنتخبات العالمية ورفع اسم بلادهم عالياً في سماء البطولة. وليس الفوز وحده، بل القدرة على فرض أسلوب اللعب وإدارة اللحظات الحرجة والتحلي بالهدوء أمام الضغوط، ويجعل هذا التأهل لحظة فارقة تُخلّد في التاريخ الرياضي المغربي. أسود الأطلس الصغار اليوم ليسوا لاعبين فحسب، بل رموز لإصرار أمة وعزيمة شعب، حاملين معهم آمال ملايين المغاربة الذين تابعوا كل لحظة من مغامرتهم بفخر لا ينضب. واليوم، يبقى السؤال الأعمق: هل سيستطيع هؤلاء الأبطال أن يحولوا التحديات القادمة إلى ملحمة تاريخية تخلّد اسم الكرة المغربية؟ كل المؤشرات تقول نعم، فهم بالفعل قادرون على تحويل المستحيل إلى حقيقة، وإثبات أن كرة القدم المغربية قادرة على صناعة المعجزات. كلمة أخيرة: المغرب ليس مجرد منتخب، بل ظاهرة تتألق بالفخر والإبداع، وبرهان حي على أن الإرادة تصنع التاريخ، وأن أسود الأطلس يسيرون نحو المجد الذي يليق بعظمة إرادتهم ومهارتهم.
1173
| 20 نوفمبر 2025