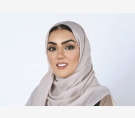رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
738
صالحة أحمدبالأمس قد كان المسرح
على الرغم من تراكم الهموم الخاصة والعامة على ذات الرف المدعو (حياتي)، وعلى الرغم من ضياع ملامح هذه الأخيرة بعد أن اختلط الماضي بالحاضر؛ بسبب ذاك الزحام الذي تسبب فيه اضطراب الظروف، إلا أن هناك ما يصر على إثبات وجوده ولفت الأنظار إليه رغم أنف كل ما قد سبق ذكره، فهو ما لا يُنسى وإن أُجبر الزمان على ذلك، وأشعر بأني لن أحرمه من تحقيق غايته، كما أني لن أحرمكم من التعرف عليه؛ لذا إليكم التالي.
في لحظة حسبتها عابرة ولن تتمسك بذيل الحاضر؛ كي تلحق به وبي، لاحت في سماء حياتي بعض الذكريات الجميلة التي لم تنتظر طويلاً، إذ سرعان ما لوحت وبكل حب؛ كي تُعلن عن رحيلها، الذي لم ألتفت إليه، خاصة حين بدت وكأنها غريبة عليّ، ولكن وحين وقفت أمامي والشوق يُكللها أدركت أني أعرفها، فهي تلك التي يمتد نسبها لذاك الذي عشت معه أجمل فصول حياتي التي كنت قد كرستها؛ لتغيير ما حولي للأفضل، وما أتحدث عنه هو المسرح، الذي شغل كل عشاقه به منذ أعوام مضت، حين كنا نجتمع من أجله؛ كي نُفرغ ما في الجيوب من كل ما قد حصلنا عليه في حياتنا ونضعه على الخشبة؛ تعبيراً عن حبنا له، وحرصاً منا على تحقيق غايته التي تدور حول الإصلاح والتغيير.
"أعطني خبزاً ومسرحاً أعطيك شعباً مثقفاً"
للمسرح دوره العظيم في تنمية المجتمع، على اعتبار أنه من القواعد الأساسية التي تستند إليها مهمة تنمية الحياة وتطويرها، وكي نخرج بمجتمع صالح ينعم بحياة طيبة، فنحن بحاجة ماسة إلى توفير الغذاء المناسب له، فيكون منه ما يُغذي الجسد، ومنه أيضاً ما يُغذي الفكر، ولكن ما يفرضه علينا الواقع (الواقع) يرفض التركيز على الشق الثاني من الشرط، فما يهم هو الجسد، أما الفكر وما يحتاج إليه من غذاء يوفره المسرح، فهو وعلى ما يبدو من آخر الاهتمامات، التي وإن حصلت على فرصة العيش، إلا أنها لن تكون كافية بالنسبة لها؛ كي تحقق ما تريده؛ ليصبح بذلك المسرح على هامش الحياة، يطل عليه من يملك من الوقت ما يملكه؛ كي يفعل فيفعل.
منذ أعوام مضت كنا نحتفل بالمسرح في يومه -27 مارس من كل عام، أي يوم (أمس)- وتحديداً حين كتبت هذا المقال واحتفلت بهذه المناسبة بصمت مزق كبد الصمت من شدة الوحشة، فما كان يحدث في الماضي قد كان رائعاً وبكل المقاييس؛ لأنه قد صور لنا الحياة من زوايا مختلفة اعتمدت على عيون عُشاق المسرح، ممن اجتهدوا على تقديم أفضل ما لديهم على خشبته في مهرجان مسرحي، لم تكن المشاركة فيه من أجل المنافسة على جائزة (ما)، ولكن من أجل التعبير عما يحدث في الخارج بلمسات تلامس الداخل، فتخرج من الأعماق لتصل إلى الأعماق، فيكون التأثر، ومن ثم ما يلحق به من أثر لا شك أنه سيُحدث الفرق الذي نبحث عنه.
إن ما يتمتع به المسرح من قدرة على محاكاة التفاصيل الخاصة بحياة الفرد على خشبة تُلخص الحياة للحياة وتسعى بعد ذلك إلى تقديمها للمتلقي؛ كي يدرك ما كان منه وله، يفرض علينا التفكير ملياً بشأن تأكيد دوره؛ كي ينتعش طوال العام، وليس في فترات معينة يعود من بعدها إلى عالم الغياب، حيث لا شيء يُذكرنا به سوى حفنة من الذكريات الصامتة، التي تخجل من التواجد بيننا كل الوقت؛ لذا تفضل الابتعاد أكثر، مع أننا نحتاج إليها وبشدة، فهي تخص المسرح الذي يُطور ملكة كل من ينتمي إليه، ويُنمي وعي المتلقي؛ ليتجاوز حدوده فلا يكتفي بدوره كمتفرج صامت بل ثائر يُقدم على ما يجدر به فعله مما كان بحاجة لمُحفز يحُثه عليه، ولكم ساهم المسرح بتحقيق تلك الغاية من قبل وإن لم يفصح البعض بتلك الحقيقة؛ لأسباب تخصه ولن ننشغل بها، فما يهمنا هو التأكيد على دور المسرح في معالجة قضايا المجتمع، التي تُفرقعها الأحداث، فننشغل بتلك الفرقعة دون أن نجد الوقت الكافي؛ للتركيز على التفاصيل التي تسقط من حساباتنا؛ ليلتقطها المسرح ويُسلط الضوء عليها؛ كي نراها من جديد ونُدرك معها نقاط الضعف فنهتم بها أكثر، ونتمكن من سد أبواب النقص، ومعالجة ما يستحق المعالجة، فننهض من بعد ذلك من جديد.
وأخيراً
يطول ويطول الحديث عن المسرح، فمن يعشقه يعشق التحدث عنه كل الوقت، وهو ما يرتطم بطبيعة المساحة المتاحة لي من خلال هذا العمود؛ لذا وكي أتجنب تلك المأساة يجدر بي تلخيص ما أريده، وهو التالي: كل ما يحتاج إليه المسرح؛ ليُعطينا المزيد هو بذل المزيد من الجهد من أجله، وتغذيته بتجارب ناضجة تمنحه قيمة عظيمة تنهض بالمجتمع أكثر وأكثر، وحتى يكون ذلك، لك مني أيها المسرح أصدق الأمنيات بحياة سعيدة وتجارب جديدة يدرك معها الجميع حقيقة ما أنت عليه.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
كوكبة جديدة من حماة الوطن

رأي الشرق
-
اختصروا لهم المسافة

إبراهيم عبدالرزاق آل إبراهيم
-
قد أوتيت سؤلك يا موسى
د. عبدالله العمادي
-
الحوافز.. الطريق الأقصر لصناعة أداء قوي

سلوى حسين الباكر
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 إبراهيم دياز قتل طموحنا
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
2862
| 20 يناير 2026
- 2 ضحكة تتلألأ ودمعة تختبئ
بين فرحة الشارع المغربي وحسرة خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، جاءت ليلة نصف النهائي لتؤكد أن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والقتال على أرض الملعب. قدمت مصر أداءً مشرفًا وأظهرت روحًا قتالية عالية، بينما كتب المغرب فصولًا جديدة من مسيرته القارية، مؤكدًا تأهله إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية مع نيجيريا امتدت إلى الأشواط الإضافية وحسمت بركلات الترجيح. المباراة حملت طابعًا تكتيكيًا معقدًا، اتسم بسرعة الإيقاع والالتحامات القوية، حيث فرض الطرفان ضغطًا متواصلًا طوال 120 دقيقة. المنتخب المغربي تعامل مع هذا الإيقاع بذكاء، فحافظ على تماسكه وتحكم في فترات الضغط العالي دون ارتباك. لم يكن التفوق المغربي قائمًا على الاستحواذ وحده، بل على إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى. تجلّى هذا التوازن في الجمع بين التنظيم الدفاعي والقدرة على الهجوم المنظم. لم يغامر المغرب دون حساب، ولم يتراجع بما يفقده زمام المبادرة. أغلق اللاعبون المساحات وحدّوا من خطورة نيجيريا، وفي المقابل استثمروا فترات امتلاك الكرة لبناء الهجمات بهدوء وصناعة الفرص، ما منحهم أفضلية ذهنية امتدت حتى ركلات الجزاء. في لحظة الحسم، تألق ياسين بونو، الذي تصدى لركلتي جزاء حاسمتين بتركيز وثقة، وهو ما منح المغرب بطاقة العبور إلى النهائي وأثبت حضوره في اللحظات المصيرية. على الصعيد الفني، يواصل وليد الركراكي تقديم نموذج المدرب القارئ للمباريات بإدارة متقنة، ما يعكس مشروعًا قائمًا على الانضباط والواقعية الإيجابية. هذا الأسلوب أسهم في تناغم الفريق، حيث أضاف إبراهيم دياز لمسات فنية ومهارات فردية ساعدت على تنويع الهجمات وصناعة الفرص، بينما برز أشرف حكيمي كقائد ميداني يجمع بين الصلابة والانضباط، مانحًا الفريق القدرة على مواجهة أصعب اللحظات بثقة وهدوء، وخلق الانسجام التكتيكي الذي ساعد المغرب على التقدم نحو ركلات الجزاء بأفضلية ذهنية واضحة. ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن الجمهور المغربي، الذي شكّل سندًا نفسيًا هائلًا، محولًا المدرجات إلى مصدر طاقة ودافع مستمر. كلمة أخيرة: الآن يستعد المغرب لمواجهة السنغال في النهائي، اختبار أخير لنضج هذا المنتخب وقدرته على تحويل الأداء المتزن والطموح المشروع إلى تتويج يليق بطموحات أمة كروية كاملة.
1455
| 16 يناير 2026
- 3 رسالة عميقة عن قطر!
في رحلتي من مطار حمد الدولي إلى منزلي، دار بيني وبين سائق الليموزين – وهو عامل من الجنسية الهندية – حوار بسيط في شكله، عميق في مضمونه. بدأته بدافع الفضول: سألته متى قدم إلى قطر؟ فقال: منذ عام 2018 وحتى اليوم. ثم استرسل في الحديث بعفوية وصدق، حتى وجدت أن مجمل ما قاله يمكن اختصاره في ثلاث نقاط أساسية، لكنها كفيلة بأن تقول الكثير عن هذا الوطن. أولًا: أهل قطر… السمعة قبل الكلام تحدث الرجل عن أهل قطر بإعجاب واضح، قائلاً إنهم ناس محترمون، متحضرون، لا تصدر منهم إساءة، ويحترمون الكبير والصغير والغريب قبل القريب. وأضاف عبارة لافتة: أحيانًا يفتعل بعض الناس مشاكل ويقولون إنهم من أهل قطر، لكننا نعرف أن هؤلاء ليسوا قطريين… لأن القطري معروف ولا يقول عن نفسه أنا قطري !، ثم ان أهل قطر معروفون بأخلاقهم. وأكد أنه لا يتحدث عن نفسه فقط، بل عن انطباعٍ عام لدى كثير من العمالة الآسيوية. اعتراف صادق فجّر في صدري شعورًا بالفخر، لأن السمعة الطيبة لا تُصنع بالإعلام، بل بالسلوك اليومي. ثانيًا: الأمن والأمان… سبب البقاء انتقل للحديث عن قطر كدولة، فوصفها بأنها منظمة، نظيفة، هادئة، وآمنة. وقال إنه تلقى عروض عمل في دول عربية وأجنبية، قريبة وبعيدة، لكنه فضّل البقاء في قطر، لا لشيء إلا لأنه يشعر بالأمان والطمأنينة. المدينة – كما قال – هادئة، والقيادة فيها ممتعة، والمسؤولون محترمون. وهنا لا تتحدث لغة الأرقام، بل يتكلم الإحساس. ثالثًا: الشرطة… القانون يحمي الجميع أما النقطة الأهم – في رأيه – فكانت حديثه عن تعامل رجال الشرطة. قال إن الشرطة في قطر تحترم الجميع، مهما كانت الوظيفة أو الجنسية، وإنها حريفة في أخذ الحقوق. وأضاف: إذا حدثت أي مشكلة، أنصح أي شخص بالذهاب إلى مركز الشرطة… الشرطة في قطر تستمع بهدوء واحترام، وتأخذ الحق وفق القانون، سواء كان الخصم مواطنًا أو غير مواطن. كلام يحسب لوزارة الداخلية، ويؤكد أن العدالة حين تُمارس بعدل، تصبح مصدر أمان لا خوف. خلاصة الحوار هذه النقاط الثلاث – كما قال السائق – هي ما جعله يحب العيش في قطر، ويشعر بالأمان، ويستمتع بالحياة فيها. أما بالنسبة لي، فقد كان هذا الحديث البسيط ردًا عمليًا، هادئًا، صادقًا، على كثير من التقارير والادعاءات التي تتحدث باسم حقوق الإنسان، بينما الحقيقة ينطق بها من عاش التجربة. تحية لقطر شعبًا، وتحية لوزارة الداخلية، وتحية لكل سلوكٍ يومي يصنع صورة وطن… دون ضجيج.
774
| 15 يناير 2026