رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
765
أ.د. نظام عبدالكريم الشافعيجيران في عالم واحد
عنوان لكتاب مترجم إلى العربية من قبل مجموعة من المترجمين، ومراجعة عبدالسلام رضوان، نشره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت في سلسلة عالم المعرفة، سبتمبر 1995. والكتاب يحوي النص الإنجليزي لتقرير إدارة شؤون المجتمع العالمي، أعدته لجنة مستقلة من 28 خبيرا ومسؤولاً تنفيذيا من مجموعة من الدول، تتنوع خبراتهم وتخصصاتهم والمسؤوليات التي تولوها عالميا او إقليميا او وطنيا، ومن بينهم الكويتي عبداللطيف الحمد والإندونيسي علي العطاس. وفي التقرير رسم لأمل جديد في بدء حقبة جديدة من تاريخ الإنسانية أكثر أمنا وانصافا وتضامنا في منظمة الأمم المتحدة ذات الأهداف النبيلة عند تأسيسها، بأن تعود إلى مسارها الذي أنشئت من أجله قبل خمسة عقود (1945-1995).
وجاء في مقدمة التقرير «بأن الجهد يهدف لرسم معالم طريق يقودنا الى القرن الحادي والعشرين بطرح رؤية خصبة لعالم ينصب فيه الاهتمام على البشر وتتأكد الحاجة الى قيم مشتركة ونظام اخلاقي مدني عالمي وقيادة مستنيرة تقود شعوب العالم والأمم في جوار عالمي واحد».
فكانت 1989 عند سقوط سور برلين وانتهاء الحرب الباردة، الفرصة السانحة ليبادر مفكرو العالم الذين يستشعرون الخطر، بان عهدا جديدا قد بدأ يلزمهم بعدم التردد في دعوة إصلاح المنظومة الأممية. ولا بد من الإقدام على عصر جديد لمستقبل يستجيب للقانون وللإرادة الجماعية وللمسؤولية المشتركة لأمن البشر وكوكبهم. وتقييد ممارسات الأمم المتحدة السلبية التي ابتعدت بها عن الأهداف الكبرى الأساسية في تجمع يحقق اهداف البشرية جمعاء، مهما اختلفت اجناسهم ودياناتهم ولغاتهم وشرعياتهم السياسية، سواء كانوا أهل شمال أو جنوب.
وتاريخياً، فبعد الحرب العالمية الثانية دعت الولايات المتحدة الامريكية وهي المنتصرة الأكبر فيها الى تكوين هيئة اممية جديدة، بعد فشل عصبة الأمم 1920، باسم الأمم المتحدة بمفاوضات أولية من قبلها والاتحاد السوفييتي والصين وبريطانيا، وانتهاء بالاجتماع في مدينة سان فرانسيسكو في الغرب الأمريكي بإعلان الميثاق الأممي في 24 أكتوبر 1945 بتوقيع 51 دولة مستقلة عليه، من بينها عدة دول عربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والعراق وسوريا ولبنان.
والأمم المتحدة تعتبر ملاذا للدول المتوسطة والصغيرة في المحافظة على سيادتها، وهي التي دعت لتحريرها وتسريع نيل استقلالها كهدف سام لها. وكان هذا شأن دولة قطر والتي انضمت اليها في 21 سبتمبر1971عندما قبلت عضوا في الجمعية العمومية بطلب من قيادة الدولة، تقدم به سعادة السيد علي بن احمد الانصاري وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وشارك في رفع علمها. ومن يومها وقطر تتفاعل مع ميثاق الأمم المتحدة وترقي تعاونها مع جميع منظماتها ولا تتردد في تقديم الدعم المعنوي والمادي السخي، ويعد بيت الأمم المتحدة الذي تأسس في العام الماضي في الدوحة مركزا لتوجهات قطر الفعلية بدعم هيئات الأمم المتحدة ومبادراتها في تحقيق أهدافها النبيلة في تضامن دولها، وقد كان موقف المنظمة ودولها منها مكان إشادة.
ويتفق الكثيرون بأن الأمم المتحدة حققت في مسيرتها إنجازات تحسب لها في التعاون الدولي في المجال الاجتماعي من تعليم وصحة وحقوق الانسان والدفاع عن الحريات عبر منظماتها كاليونسكو والصحة العالمية والعمل الدولي. إضافة إلى التعاون الدولي في حماية البيئة من التلوث والتغير المناخي، وقوانين الحدود وأعالي البحار، ودور محكمة العدل الدولية في حل كثير من مشكلات الحدود. وما التحولات الإيجابية بتمكين الشعوب في دول العالم الثالث إلا مثال ملموس لتلك النجاحات.
ولكن معظم فشلها كان في المجال السياسي لتضارب مصالح الدول الكبرى صاحبة حق الفيتو، وقضية فلسطين هي الواضحة في هذا الصدد في عجزها الوصول الى تسوية لها على الرغم من مرور أكثر من سبعين عاما، وهي المتسببة في خلقها في الأساس، عندما صوتت الجمعية العامة لصالح مشروع التقسيم في عام 1947. ومنذ ذلك الحين، لم يستطع مجلس الأمن إجبار دولة الكيان الصهيوني على تنفيذ قراراته، وكانت الدولة الوحيدة التي تضرب بعشرات القرارات عرض الحائط ولا تبالي، مدعومة من معظم الدول الكبرى والتي أدت بالقضية إلى تفاقمها، انتهاء بعدم رضوخها بمقترح حل الدولتين، واستمرار توسعها في إقامة المستوطنات غير المشروعة في الضفة الغربية من أرض فلسطين.
ومما يؤسف له أنه في العقود الأخيرة، شهدت المنظمة تدخلات تنادي بقيم مستغربة، لم تكن في الأصل بنودا في ميثاقها، انكرتها الغالبية العظمى من الأعضاء الـ 194، مثل العولمة التي تبنتها الهيئة والتي قللت من سيطرة الدول على شؤونها الداخلية. كما كانت الاعتراضات والتحفظات على ميثاق سيداو حول التطرف في حقوق المرأة. ويعد مجلس الأمن من جانب آخر أكبر نقاط الضعف الرئيسية، والذي عن طريق قراراته تتحقق مصالح الدول الكبرى، والتفرد بسلطة اتخاذ القرار (الفيتو) من قبل أعضائه الدائمين، والذين من المفترض أن يكونوا الداعمين للسلام والامن الدوليين والمدافعين عنه.
وللتذكير، لم تستطع عصبة الأمم أثناء وجودها والمنشأة بعد الحرب العالمية الأولى من تحقيق أهدافها بسبب عدم تنازل الدول الكبرى من الرغبة بالهيمنة وإحكام سيطرتها على مستعمراتها، كاليابان مع دول جنوب شرق آسيا، وإيطاليا مع مستعمراتها وخاصة في الحبشة، وبريطانيا في قضيتها مع العراق، وفرنسا في علاقتها مع موارد مستعمراتها في أفريقيا، فسرعان ما انهارت الفكرة وبدأت الحرب العالمية الثانية تلوح في الأفق. فهل المصير نفسه ينتظر هيئة الأمم المتحدة في نهاية الأمر، بإرادة الدول الكبرى أن تكون المنظمة لعبة بالأمم أو تركيعها أو خداعها تحت اسم جميل.
اقرأ المزيد
 هل نعرف هذا المصطلح؟
هل نعرف هذا المصطلح؟
ليست كل إشكالية في قطاع التدريب ناتجة عن ضعف المحتوى أو هشاشة الطرح، فبعض الأزمات تبدأ من العنوان،... اقرأ المزيد
384
| 03 فبراير 2026
 العطاء الخالد.. إنفاقٌ من سعتك
العطاء الخالد.. إنفاقٌ من سعتك
من أبهى العطاءات أن يكون الإنسان سيّالاً في بذله، متدفقاً في عطائه، كالنهر الصافي الزلال، يمضي في سكينته،... اقرأ المزيد
165
| 03 فبراير 2026
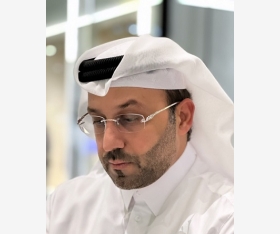 سلم مكسور !
سلم مكسور !
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي تُعدّ اليوم من أهم الطرق والوسائل الحديثة للوصول إلى الأفراد والمجتمعات من التثقيف والتعليم... اقرأ المزيد
210
| 03 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أ.د. نظام عبدالكريم الشافعي
أستاذ الجغرافيا غير المتفرغ
جامعة قطر
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
عاصمة الغاز الطبيعي المسال في العالم

رأي الشرق
-
الهيمنة الدولية وتفكك النظام العالمي المعاصر

د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
-
قطاع الغاز.. هل يسقط في فخ «سيناريو النفط والفحم»؟

م. حسن الراشد
-
هل نعرف هذا المصطلح؟

الدكتورة حصة حامد المرواني
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي
يمثّل فوز الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي لحظة تتجاوز منطق التغيير الإداري إلى أفق أوسع من المعنى والمسؤولية. فالمجلس، بوصفه المظلة الأعلى للحركة الأولمبية في آسيا، ليس مؤسسة رياضية فحسب، بل هو كيان يعكس توازنات القارة، وتحدياتها، وقدرتها على تحويل الرياضة إلى لغة تعاون لا صراع، وإلى مساحة بناء لا تنافس سلبي. آسيا، بتنوعها الجغرافي والثقافي والسياسي، تضع رئيس المجلس أمام مهمة دقيقة: الحفاظ على وحدة رياضية لقارة تتباين فيها الإمكانات، وتختلف فيها الرؤى، وتتقاطع فيها المصالح. ومن هنا، فإن الثقة التي مُنحت للشيخ جوعان ليست ثقة بمنصب، بل ثقة بقدرة على الإصغاء، وإدارة الاختلاف، وبناء مساحات مشتركة تضمن عدالة الفرص وتكافؤ الحضور. التجربة القطرية في المجال الرياضي، والتي كان الشيخ جوعان أحد أبرز مهندسيها، تقدّم مؤشراً مهماً على فهم العلاقة بين الرياضة والتنمية، وبين التنظيم والحوكمة، وبين الاستثمار في الإنسان قبل المنشأة. هذا الفهم يُنتظر أن ينعكس على عمل المجلس، ليس عبر قرارات سريعة أو شعارات واسعة، بل من خلال تراكم هادئ لإصلاحات مؤسسية، وبرامج مستدامة، وشراكات تحترم خصوصية كل دولة آسيوية دون أن تعزلها عن المشروع القاري. الأمل معقود على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إعادة تعريف للدور الآسيوي في الحركة الأولمبية العالمية؛ ليس من حيث عدد الميداليات فقط، بل من حيث جودة التنظيم، ونزاهة المنافسة، وتمكين الرياضيين، ودعم الرياضة النسائية، وتوسيع قاعدة الممارسة في الدول الأقل حظاً. فالقوة الحقيقية للمجلس لا تقاس بقمته، بل بقدرته على رفع أطرافه. إن الثقة بالشيخ جوعان تنبع من هدوئه الإداري، ومن ميله إلى العمل بعيداً عن الاستعراض، ومن إدراكه أن الرياضة، حين تُدار بحكمة، يمكن أن تكون جسراً سياسياً ناعماً، وأداة تنمية، ورسالة سلام. والتمنّي الأكبر أن ينجح في تحويل المجلس الأولمبي الآسيوي إلى منصة توازن بين الطموح والواقع، وبين المنافسة والإنصاف، وبين الحلم الأولمبي والالتزام الأخلاقي.
3147
| 28 يناير 2026
- 2 «السنع».. ذكاؤنا العاطفي الذي لا يُدرّس في هارفارد
تخيل معي هذا المشهد المتكرر: شركة كبرى ترسل موظفيها ومديريها في دورات تدريبية باهظة التكلفة لتعلم «المهارات الناعمة» (Soft Skills)، و»الذكاء العاطفي»، و»فن الإتيكيت». يجلسون في قاعات مكيفة، يستمعون لمدرب يشرح لهم بلغة أجنبية ومصطلحات معقدة كيف يبتسمون، وكيف ينصتون، وكيف يقرأون لغة الجسد ليكونوا قادة ناجحين. إنه مشهد يدل على الرغبة في التطور، بلا شك. ولكن، ألا تشعر ببعض المرارة وأنت تراه؟ ألا يخطر ببالك أن كل هذه النظريات التي ندفع الملايين لتعلمها، كانت تُوزع «مجاناً» وبجودة أعلى في مجالس آبائنا وأجدادنا تحت اسم واحد يختصر كل تلك الكتب: «السنع الخليجي»؟ مشكلتنا اليوم أننا نقع في فخ كبير حين نظن أن «السنع الخليجي» مجرد كلمة عامية دارجة، أو تقاليد قديمة لصب القهوة. نحن نختزله في «شكليات»، بينما هو في الحقيقة «نظام تشغيل» اجتماعي وإداري فائق التطور، وله جذور لغوية تكشف عن عمقه الفلسفي. السنع.. جمال الروح لا الجسد المفاجأة التي يجهلها الكثيرون هي أن كلمة «السنع» ليست عامية دخيلة، بل هي فصحى قحة. ففي قواميس العرب، الجذر (س ن ع) يدور حول معاني «الجمال» و «الارتفاع». كان العرب يقولون «امرأة سَنعاء» أي جميلة القوام، ويقولون للنبت إذا طال وحسن شكله «أسْنع». وهنا تتجلى عبقرية العقل الخليجي؛ فقد أخذ أجدادنا هذه الكلمة التي تصف «جمال الشكل»، ونقلوها بذكاء لوصف «جمال الفعل». فأصبح «السنع» عندهم هو: «فن صناعة الجمال في السلوك». فالشاب الذي يوقر الكبير، ويخدم الضيف، ويثمن الكلمة، هو في الحقيقة يرسم «لوحة جمالية» بأخلاقه توازي جمال الخِلقة. ذكاء عاطفي.. بلهجة محلية إذن، السنع الخليجي هو «الجمال السلوكي»، وهو ما يطلق عليه الغرب اليوم «الذكاء العاطفي». عندما يعلمك والدك أن «المجالس مدارس»، وأنك لا تقاطع الكبير، هو يعلمك «أدبيات الحوار والتفاوض». وعندما تتعلم أن «الضيف في حكم المَضيف»، وأنك تقوم لخدمته بنفسك مهما علا شأنك، أنت تمارس «القيادة بالخدمة» (Servant Leadership) التي تتغنى بها كتب الإدارة الحديثة. وعندما تتعلم «الفزعة» والوقوف مع ابن عمك أو جارك في مصيبته دون أن يطلب، أنت تمارس «المسؤولية الاجتماعية» و «بناء روح الفريق» في أنقى صورها. المأساة اليوم أننا أصبحنا نستورد «المسميات» وننسى «المعاني» التي تجري في عروقنا. بتنا نرى جيلاً من الشباب يحملون أعلى الشهادات الأكاديمية، يتحدثون لغات العالم بطلاقة، لكنهم «أمّيون» اجتماعياً. يدخل أحدهم المجلس فلا يعرف كيف يُحيّي،.... ولا أين يجلس، ولمن يقوم..، وإذا تكلم «جرّح» دون أن يشعر، لأنه لم يتعلم مهارة «وزن الكلام» التي هي جوهر السنع الخليجي. خاتمة: العودة إلى «جامعتنا» نحن لسنا ضد العلم الحديث، ولا ضد كتب «هارفارد». ولكننا بحاجة ماسة لأن نعود إلى «جامعتنا» المحلية. نحتاج أن نعيد الاعتبار لمفهوم «السنع» ليس كتراث فلكلوري، بل كمنظومة قيم وسلوك حضاري تعبر عن «الجمال المعنوي». أن تكون «متطوراً» لا يعني أن تنسلخ من جلدك. قمة التطور هي أن تجمع بين «كفاءة» الإدارة الحديثة، و»أصالة» السنع الخليجي. فالشهادة قد تجعلك «مديراً» ناجحاً، لكن السنع وحده -بما يحمله من جمال وتواضع وذكاء- هو الذي يجعلك «قائداً» يأسر القلوب، ويفرض الاحترام بلا سطوة. فلنعلم أبناءنا أن «السنع» هو الإتيكيت الخاص بهويتنا، وأنه الجمال الباقي حين يذوي جمال الوجوه.
2172
| 28 يناير 2026
- 3 الشيخ جوعان.. قامة وقيمة و«قيم أولمبية»
-«الأولمبي الآسيوي».. موعد مع المجد في عهد «بوحمد» - صفات الرئيس.. سمو التفكير والشغف الكثير.. والطموح الكبير المحفز على التطوير - رئيس الرياضة الآسيوية يمثل الجيل الجديد من القادة برؤية عصرية وإستراتيجية قطرية -القائد القطري الأولمبي يواصل مسيرة الإنجاز الرياضي والنجاح الإداري هو قامة قطرية، ذات قيمة رياضية، تمتزج في شخصيته القيم الأولمبية، وتختلط في مواقفه الصفات الإدارية، وتتمحور في رؤاه المواصفات القيادية. وهذه السمات الشخصية كلها، تشكل شخصية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الفائز برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، الذي تأسس في السادس عشر من نوفمبر (1982). وبهذا الفوز المستحق، يتربع «بوحمد»، على رأس الهرم القيادي، لهذا الكيان القاري، ويصبح الرئيس الخامس، لهذا المجلس الرياضي، الذي يعتبر الهيكل التنظيمي الجامع، لكل اللجان الأولمبية الآسيوية، وعددها (45) لجنة وطنية. وها هو القيادي القطري الناجح، يواصل مسيرة الإنجاز الرياضي، والنجاح الإداري، والعمل الأولمبي الفالح، التي بدأها عام (2015)، بعد توليه رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية، التي تأسست في الرابع من مارس عام (1979)، وأصبحت عضواً فاعلاً، ومكوناً متفاعلاً في أنشطة اللجنة الأولمبية الدولية، منذ عام (1980). وها هو يتبوأ أعلى منصب رياضي في القارة الآسيوية، ويصبح رئيساً لمنظومة الرياضة الأولمبية القارية، بدعم واسع من لجانها الوطنية، التي تتطلع لترسيخ قيم التميز الرياضي، وتطوير الأداء الأولمبي، بما يحقق تطلعات القواعد الجماهيرية، ويعزز مكانة القارة الآسيوية، وأبطالها ونجومها في الرياضة العالمية. والحكاية بدأت هناك وأكررها هناك، في طشقند، عاصمة أوزبكستان، كان الحدث، وكان تقليد الشيخ جوعان بوسام التفوق الرياضي، بمبادرة رئاسية، من فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، الذي حضر اجتماعات الجمعية العمومية السادسة والأربعين، للمجلس الأولمبي الآسيوي. وهناك، في العاصمة الأوزبكية، صوتت (44) دولة، من أصل (45)، لصالح «بوحمد»، في موقف قاري، يعكس ثقة اللجان الأولمبية الوطنية، بالإدارة القطرية، والإرادة الشبابية، ممثلة في قدرات الشيخ جوعان القيادية. وهنا في الدوحة، وسائر العواصم الآسيوية، يتواصل الحديث عن ذلك الحدث، وتتوالى التهاني للرئيس الجديد، لأكبر منظمة رياضية قارية، على مستوى الكرة الأرضية، وأهمها تهنئة مجلس الوزراء لسعادته بمناسبة تزكيته رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك في إنجاز جديد للرياضة القطرية، يعكس مكانة دولة قطر وما تتمتع به من ثقة وتقدير إقليمي ودولي، ولدورها الفعال وإسهامها الإيجابي وإنجازاتها المبهرة في المجال الرياضي. وهذا ليس بغريب على سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، القيادي القطري الطموح والحريص على تعزيز الروح الأولمبية، في بطولات وملاعب ومسابقات القارة الآسيوية، وإطلاق القوة المحركة، للمنافسة الرياضية الشريفة، والمحفزة لملايين الرياضيين، والإداريين والمشجعين، والمتابعين في القارة الصفراء، التي تعتبر أكبر القارات تعداداً سكانياً، وأكثرها تنوعاً بشرياً وثقافياً وإنسانياً. ومن خلال كل هذا التنوع البشري، يسعى «بوحمد» إلى إسعاد الجماهير، وجعلهم سعداء، بأن تكون قارتهم الآسيوية، رقماً ذهبياً لامعاً، وليس دامعاً، في البطولات العالمية، لا يمكن لأي قارة أخرى تجاوزه، في المعادلة الأولمبية الدولية. ويمثل الشيخ جوعان، الجيل الجديد الشاب، من القادة الرياضيين، في القارة الآسيوية، الذين يتصدرون المشهد الأولمبي، ويملكون رؤية إدارية عصرية، تتجاوز المصلحة الذاتية، وتعمل لتحقيق المصلحة الجماعية، والمجتمعية. ويتبنى قائد الرياضة الآسيوية الجديد، استراتيجية إصلاحية، وفق رؤية قطرية، يسعى من خلالها لترتيب وتنظيم أوضاع البيت الأولمبي الآسيوي، وعلاجه من حالة «التأكسد»، ودفعه إلى مرحلة التجدد، والانطلاق بقوة لتحقيق المجد. ولعل ما يميز الشيخ جوعان، وهو الرئيس الأولمبي المجدد، أنه يملك سمو التفكير، والشغف الكثير، والطموح الكبير، المحفز على التطوير. ناهيك عن الحرص على توفير، بيئة تنافسية عادلة ومعدلة، تدفع إلى التغيير، وتعمل على الارتقاء، بأنشطة، أكبر منظمة رياضية قارية، عبر تعزيز الروح الأولمبية في عروقها، وتفعيلها في أروقتها، وتنشيطها في بطولاتها ومسابقاتها. وهذا يتحقق، من خلال مواكبة التكنولوجيا الحديثة، في قطاع الرياضة، والنهوض بالأنشطة الرياضية، عبر استخدام أحدث الأساليب العلمية، وتنظيم البطولات بطريقة مبتكرة، من خلال الاستعانة بأحدث السبل التكنولوجية. ولا أستثني من ذلك، استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في التنظيم الرياضي، والتنسيق الإداري. ويكفي أن سعادته، حقق على مدى سنوات العقد الماضي، ما لم يحققه أي قائد أولمبي من أبناء جيله. ومن بين إنجازاته، تعزيز دور قطر، كقوة رياضية متنامية على الساحة الدولية، وترسيخ مكانتها، ومكانها كنموذج عالمي، في الاستضافة الرياضية. وفي عهده وعهدته، نالت الرياضة القطرية، شرف استضافة العديد من البطولات العالمية، أذكر منها على سبيل المثال، وليس الحصر، كأس العالم لكرة السلة (2027)، وكأس العالم لكرة الطائرة (2029)، وقبلها بطولة العالم لألعاب القوى (2019)، وبطولة العالم لكرة الطاولة (2025). ولا أنسى فوز قطر، بالذهب العالمي، تحت مظلة رئاسته اللجنة الأولمبية القطرية، بعد تتويج البطل القطري معتز برشم ببطولة العالم، في الوثب العالي، خلال (3) بطولات عالمية متتالية. وكانت البداية في لندن عام (2017)، والدوحة عام (2019)، ويوجين عام (2022). ووسط كل هذا، الإنجاز الرياضي القطري، وكل هذا المجد العالمي، يبقى سجل الشيخ جوعان مضيئاً، وسيظل ساطعاً، وسيستمر براقاً، خصوصاً أنه يتولى رئاسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية، التي ستحتضنها الدوحة مجدداً عام (2030)، بعد نجاحها في استضافتها عام (2006). ولكل هذه النجاحات الرياضية المتتالية، وبسبب تلك الإنجازات القطرية المتوالية، يشكل فوز الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، إنجازاً كبيراً، لا يحسب لشخصه فحسب، بل هو انتصار للرياضة القطرية، بكل شخوصها وشخصياتها وإنجازاتها وانتصاراتها، وبطولاتها. وهو إنجاز قاري، لكل رياضي وإداري قطري، ساهم في تأسيس اللجنة الأولمبية القطرية، ولكل الأجيال، التي أعقبت هذا التأسيس، وتعاقبت جيلاً بعد جيل، من الرياضيين والمدربين والإداريين والقياديين. وهو إنجاز إداري غير مسبوق لكل الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية. وكل هؤلاء يحق لهم أن يفخروا بأن القيادي القطري الشاب «ابن الوطن»، أصبح رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي. وعندما أقول ذلك، لا أنسى الدور التاريخي والتأسيسي والقيادي، الذي لعبه الشيخ فهد الأحمد، باعتباره الأب الروحي لهذا المجلس. وهو أول من تولى رئاسته عام (1982)، وتميزت فترته الرئاسية، بوضع القواعد الأساسية، واللبنات التنظيمية، بعد إشهار هذا الكيان الرياضي القاري. ومن خلال شخصيته القيادية الفذة، منح القارة هوية رياضية مستقلة ومستقرة، حتى رحيله عام (1990). وقد عايشته رياضياً، وعاصرته إنسانياً، وحاورته صحفياً، ومنها حوار أجريته معه عام (1984)، خلال بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في سنغافورة، وشهدت انطلاقة منتخبنا العنابي، على المستوى القاري. وأشهد، على كل صعيد، أن الراحل الشهيد فهد الأحمد، كان قيادياً رياضياً، من الطراز الفريد، وكان محنكاً في مؤتمراته الصحفية، وحكيماً في تصريحاته الإعلامية. وهذه الصفات، وغيرها، يمتاز بها الرئيس الجديد، للمجلس الأولمبي الآسيوي، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، الذي أثار إعجابي الشديد، في مؤتمره الصحفي الأول، بعد فوزه بالرئاسة. ولعل ما أثار اهتمامي، كمتابع إعلامي، ومشجع رياضي، وصحفي قطري، صاحب تجربة عتيقة وخبرة عميقة، في تغطية الأحداث الرياضية، والبطولات الآسيوية، في بداية مسيرتي الصحفية، ما أعلنه سعادته، وأكده في مؤتمره الصحفي قائلاً: «لسنا هنا للبحث عن الأضواء، التي هي من حق الرياضيين، وما أريده في المجلس الأولمبي الآسيوي، أن يتحدث عملنا عن نفسه». وفي هذا التصريح، تأكيد صريح، على نكران الذات، والحرص على المصلحة الجماعية، على حساب البهرجة الشخصية. وهذا يعني، فيما يعني، أن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الجديد، يريد التأكيد، أنه لا يكبر بأضواء هذا المنصب. ويؤكد أيضاً، الحقيقة الثابتة، والراسخة والساطعة، أن المنصب الرئاسي، يكبر لشخصية صاحبه، وأن الرئاسة، تتطور بأعمال رئيسها، وتزدان بحسن إدارته. وفي إطار هذه الثوابت الإدارية، ينطلق من هنا، من قطر، شعار المرحلة الجديدة، في المجلس الأولمبي الآسيوي، برئاسة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ويتلخص هذا الشعار، في عبارة براقة، تعكس معاني التعاون والشراكة، وتتشكل مفرداتها، في الكلمات التالية: «معاً نعمل من أجل آسيا». وبطبيعة الحال، سيعمل بوحمد، على ترجمة هذا الشعار إلى واقع، يتأكد بالأفعال، وليس الأقوال، ويتجسد بأعمال الرجال، ويتحقق بإنجازات الأبطال، وقطر لها تجربة ناجحة في صناعتهم، والتفوق في انتشارهم، والتألق في إبرازهم، والأمثلة كثيرة، لا تستطيع هذه الكلمات تحديدهم، ولا يمكن لهذه هذه المقالة حصرهم.
1167
| 29 يناير 2026




