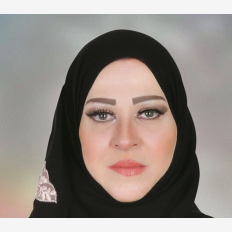رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
438
د. هلا السعيداليوم العالمي للإعاقة.. من الرعاية إلى الريادة
اليوم العالمي للإعاقة 3 ديسمبر 2026: من الرعاية إلى الريادة
ويتم الاحتفال به سنويًا منذ عام 1992 بهدف دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع
وهذا العام سيكون شعاري....،
كيف نصنع جيلاً يقود لا جيلاً يُقاد؟
اليوم العالمي للإعاقة… لحظة للتفكير
هو اليوم الذي نتذكر فيه أننا جميعًا بحاجة إلى من يرى جمالنا قبل احتياجنا.
في كل عام نحتفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم هو:
هل نريد لهم حياة “جيدة”… أم حياة “عظيمة”؟
لسنوات طويلة ركّزت المجتمعات على الرعاية والخدمات، لكن العالم الآن يتغير.
لم يعد التحول الحقيقي في عدد المراكز أو الأجهزة، بل في صناعة الفرص،
وفي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أصحاب قرار، مبتكرين، قادة رأي، وروّاد أعمال.
حكايات بصمت
أحيانًا أجلس مع نفسي وأسأل: هل نحتاج يومًا عالميًا كي نلتفت لقلوب كان يجب أن نلتفت لها كل يوم؟
قلوب تعبر بصمت، وتحب بصمت، وتكبر رغم كل شيء… بصمت.
في هذا اليوم، لا أتحدث عن الإعاقة كملف أو قضية أو ورقة عمل.
أريد أن أتحدث عنها كحكايات… كوجوه أعرفها… كأيدٍ صغيرة تمسكت بأصابعي وهي تبحث عن طمأنينة،
وكعيون كبار رأيت فيها قوة تفوق كل التحديات.
الإعاقة لم تعد قضية “عطف”، بل أصبحت قضية ابتكار وتنمية.
سر من القلب
وفي خضم كل هذا، أسمح لقلبي أن يبوح بسرٍ صغير:
3 ديسمبر بالنسبة لي ليس مجرد يوم عالمي.
إنه يوم ميلاد ابنتي دانيا… ملهمتي الأولى، التي علمتني أن القدرة قد تكون أعمق من الكلام، وأن القوة تظهر في أبسط التفاصيل، وأن الاحتواء ليس شعارًا… بل طريقة حياة.
وفي اليوم نفسه، وُلد مركز الدوحة العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة،
وكأن القدر أراد أن يخبرني بأن رسالتي لن تكون مجرد مهنة، بل امتدادًا لنبض دانيا… ومسارًا ستقوده كل خطوة قبل أن أدركه أنا.
3 ديسمبر بالنسبة لي… ميلادان: ميلاد روح وميلاد رسالة.
القوة والتمكين
في هذا اليوم، لا أحتفل بالإنجازات فقط، بل أحتفل بالفكرة التي تغيّر العالم:
أن كل إنسان يحمل في داخله قوة… تحتاج فقط من يصدقها.
لسنا هنا لنمنحهم صوتًا—فهم يملكون أصواتًا عالية—بل لنمنحهم منبرًا.
لسنا هنا لنسير عنهم، بل لنمهد الطريق ليقودوا هم أنفسهم.
هناك حقيقة لا نقولها كثيرًا:
أقسى إعاقات البشر ليست في الجسد… بل في القلوب التي لا ترى، والعقول التي لا تفهم، والنفوس التي لا تحتضن.
الأشخاص ذوو الإعاقة لم يطلبوا يومًا معاملة خاصة،
هم فقط يريدون مساحة يتنفسون فيها بكرامتهم.
يريدون أن نقابل قدراتهم قبل إعاقاتهم، وأن نسمع أصواتهم قبل أن نتحدث بالنيابة عنهم.
الشكر للأمهات والآباء والأخصائيين
قلبي يميل إلى الأمهات…
إلى تلك التي تخبّئ دمعتها لتستيقظ أقوى، وتبتسم رغم خوفها، وتصبح مدرسة وممرضة ومعلمة حياة في آن واحد.
وإلى الآباء… أولئك الذين يخفون تعبهم في الجيب الخلفي للصلابة.
وإلى الأخصائيين الذين يزرعون بذورًا صغيرة من الأمل كل يوم،
وإلى المراكز التي تحتضن وتعمل جاهدة من أجل التطوير،
وإلى المجتمعات التي بدأت—أخيرًا—تفهم أن الدمج ليس بابًا يُفتح… بل قلب يُفتح.
يوم للتذكير بأننا بحاجة للتغيير
اليوم العالمي للإعاقة ليس يومًا لنذكرهم بما ينقصهم،
بل يوم لنتذكر نحن ما ينقصنا نحن:
الصبر، والاحترام، والذوق، والرحمة، والإنسانية.
هو يوم نسأل فيه أنفسنا:
هل نعاملهم كأفراد كاملين؟
هل نسألهم رأيهم؟
هل نعطيهم فرصة؟
هل نصنع لهم طريقًا… أم نكتفي بالكلام؟
الاحتواء أسلوب حياة
أكتب وكأن قلبي يقول لي:
“أجمل ما في الإعاقة… أنها تكشف أجمل ما في الإنسان.”
تكشف الرحمة، والصبر، والقوة، وتُظهر أن النجاح ليس سباقًا بين من يصل أولًا…
بل بين من لا يتوقف رغم كل شيء.
العالم لا يحتاج مزيدًا من الشعارات، بل يحتاج مزيدًا من الإنسان.
الدول تتقدم عندما تنتقل من سؤال: كيف نساعد؟ إلى سؤال: كيف نمكّن؟
وفي قطر… تعلمنا أن الدمج ليس قانونًا يُكتب، بل ثقافة تُمارس، وحياة تُبنى، وفرص تُمنح.
وفي اليوم العالمي للإعاقة، نعيد الوعد: لن نصنع مستقبلًا للناس… بل معهم.
وفي هذا اليوم… أتعهد لنفسي قبل أن أتعهد للعالم:
أن أرى القدرة قبل الإعاقة،
والقلب قبل التحدي،
والإنسان قبل كل مسمياته.
هذا وعد… من قلب يفضفض، ويدرك أن الاحتواء ليس مناسبة…
الاحتواء أسلوب حياة.
مقالات ذات صلة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
التميز الحكومي من «فرحة الفوز» إلى «استدامة الأثر»

فاطمة العتوم
-
جهود قطرية لخفض التصعيد

رأي الشرق
-
جزيرة الشيطان

محمد صالح البدراني
-
رمضان قطر.. قيم تتجدد

وجيدة القحطاني
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 هل سلبتنا مواقع التواصل الاجتماعي سلامنا النفسي؟
ربما كان الجيل الذي سبق غزو الرقمنة ومواقع التواصل الاجتماعي هو الأكثر إدراكًا لحجم التباين بين الزمنين فيما يتعلق بالسلام النفسي، بين زمن كان الإنسان يقترب من حقيقة نفسه بلا زينة مصطنعة، وزمن تصطاد هذه الشبكة روحه ووقته وسكينته وتبعده عن ذاته كما بين المشرقين. على الرغم من محاسنها التي لا يستطيع أحد إنكارها، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عالمًا بديلًا للإنسان، فالحياة فيها، والرضا من خلالها، والتعاسة أيضًا، والإشباع الروحي يتحقق بعلامات الإعجاب ويُستجدى بتعليقات المتابعين. لقد أصبحت صفحات المرء وعدد متابعيه هي هويته المعبرة عنه، بطاقته التعريفية بصرف النظر عن تقييم المحتوى الذي يقدمه، فانقلب تعريف الإنسان من جوهره إلى ظاهره. مواقع التواصل آخر عهده بالليل، وأول عهده بالصباح، وبينهما نوم قد يعرض له انعكاساتها على نفسه التعسة، تتدفق فيه الأسئلة: كيف أبدو أمامهم، كيف أرضي أذواقهم، كيف أزيد من الإعجابات والتعليقات، كيف أبرز نفسي وألمعها، كيف أتخطى بأعداد المتابعين فلانًا وفلانًا، بل ويجعل تفاعل الجماهير هي الميزان الذي يزن بها نفسه، فإن قل اضطرب قلبه وتوهم النقص في قيمته وأنه خسر شيئًا من ذاته. أصبح هناك ولع غير مبرر بعرض التفاصيل اليومية من المطبخ، وبيئة العمل، والمواصلات، وأماكن التنزه والسفر، واللحظات الرومانسية بين الأزواج كأنهم يقومون بتمثيل عمل درامي، وقد يكون بينهما من الأزمات ما الله به عليم. غدت تلك الصفحات سوقًا للمتاجرة بالأحزان والأزمات، وأضحت ميدانًا للنقاشات والجدل العقيم الذي لا يراد من خلاله إلا إثبات الذات. مواقع التواصل الاجتماعي خلقت للإنسان بيئة صورية يصنع مفرداتها كما يحب، على حساب الانسحاب من بيئته في الواقع، فأصبح تواصله محصورًا مع عناصر هذه البيئة الجديدة، في الوقت الذي ينقطع عن أهل وذويه في البيت الواحد. وإن من المشاهد المضحكة المبكية، أن ترى أفراد الأسرة كل منهم يجلس على هاتفه دون أن يشعر بالآخر على مدى ساعات، بينما تجده غارقا في عالمه الافتراضي يتفاعل مع المتابعين بعلامات الإعجاب والتعليقات. ومن أشد مثالبها استلاب الرضا من القلوب، فعندما يعرض الناس أجمل لحظاتهم وألوان النعم التي يعيشون فيها وأحسن ما في حياتهم، يرى الناظر هذه الصورة البراقة، فيحسب أن الناس جميعا سعداء إلا هو، وأنهم بلغوا القمم بينما لا يزال هو قابعًا في السفح، فتولد لديه هذه المقارنة شعورًا بالمرارة ومنها ينبت الحسد أو اليأس، وكلاهما نار تأكل السلام النفسي أكلًا. مواقع التواصل عودت النفس على العجلة، فالإيقاع سريع، وكل شيء فيها يجري جريًا، الخبر، الصورة، والرأي، لا تدع للإنسان فرصة للتأمل الذي يستلزم حضوره السكون، فالسلام النفسي لا يولد في الضجيج والصخب والزحام، بل ينشأ في لحظات الصمت عندما يجلس المرء مع نفسه للمصارحة والمكاشفة. لقد جعلت هذه المواقع الإنسان في حال دائم من التمثيل والتصنع والتكلف، يختار كلماته وصوره وأطروحاته ليس على أساس الصدق والفائدة المرجوة، بل على أساس تحقيق القبول لدى الناس، فيطول عليه الأمد فينسى وجهه الأول، ويعيش بشخصيتين إحداهما على الشاشة والأخرى في الخفاء، وهذا الانشطار لا شك يصيبه بالاضطراب. الرضا لا ينال بالتصفيق ولا يشترى بعدد المتابعين، لكنه ثمرة معرفة الإنسان لنفسه وقبوله بعيوبها ومحاسنها، وسعيه إلى إصلاحها لا تجميل صورتها. وأنا ها هنا لا أرمي إلى إظهار مواقع التواصل كآلة آثمة، لأن العيب في اليد التي تسيء استخدامها، فهي كالسيف يكون أداة عدل أو أداة ظلم، بحسب من يحمله. وحتى يسترد المرء سلامه النفسي في زمن الشاشات، فعليه أولًا أن يدرك أن ما يراه ليس كل الحقيقة، وأن الحياة أوسع بكثير من هذه الصورة، وأعمق من سطر في منشور. عليه أن يفتش عن قيمته الحقيقية في إنجازه الحقيقي لا في حضوره الافتراضي. عليه أن يدرك أنها مجال لا حياة، حيّز للزيارة لا للإقامة، فمن ثم يضع لها حدًا معلومًا من وقته، فلا يتركها تأكل يومه، ويقتل لهفته تجاه التعرف على الإعجابات والتعليقات الجديدة كل دقيقة، فيجدر به أن يدرب نفسه على الفصام الجزئي مع هذه المواقع، ويصغي إلى نفسه حتى لا تذوب في أصوات الخارج.
3972
| 15 فبراير 2026
- 2 «تعهيد» التربية.. حين يُربينا «الغرباء» في عقر دارنا!
راقب المشهد في أي مجمع تجاري في عطلة نهاية الأسبوع. ستري عائلة خليجية صغيرة تتمشى. الأب والأم يمشيان في الأمام بكامل أناقتهما، وخلفهما بمسافة مترين تمشي «المربية» وهي تحمل الطفل، وتدفع العربة، وتحمل حقيبة الحفاضات. وإذا بكى الطفل، لمن يمد يده؟ إلى المربية. وإذا نطق كلماته الأولى، بأي لغة (أو لهجة مكسرة) يتحدث؟ بلغة المربية. هذا المشهد، رغم تكراره حتى أصبح مألوفاً، هو «جرح» غائر في كرامة الأسرة الخليجية. نحن، وبدافع الحاجة والرفاهية وانشغالنا في وظائفنا، لم نستقدم عمالة لتساعدنا في «أعمال المنزل» فحسب، بل ارتكبنا خطأً استراتيجياً فادحاً: لقد قمنا بـ «تعهيد» (Outsourcing) مهمة التربية. لقد سلمنا «مفاتيح» عقول وقلوب أطفالنا لأشخاص غرباء. المشكلة ليست في وجود المساعدة، فالدين والواقع يبيحان ذلك. المشكلة تكمن في «تداخل الأدوار»..... «الدريول» (السائق) لم يعد مجرد سائق يوصل الأبناء، بل أصبح هو «الأب البديل» في السيارة، يسمع أحاديثهم، ويختار موسيقاهم، وربما يغطّي على أخطائهم. و»المربية» لم تعد منظفة، بل أصبحت «الأم البديلة» التي تطعم، وتناغي، وتمسح الدمعة، وتلقن القيم (أو غيابها). نحن نشتكي اليوم من أن أبناءنا «تغيروا»، وأن لغتهم العربية ركيكة، وأن «السنع» عندهم ضعيف. ولكن، كيف نلومهم ومعلمهم الأول في سنوات التأسيس (من 0 إلى 7 سنوات) لا يملك أياً من هذه القيم؟ كيف نطلب من طفل أن يكون «ابن قبيلة» أو «ابن عائلة» وهو يتربى على يد ثقافة مختلفة تماماً في الدين واللغة والعادات؟ إن «السيادة» لا تكون فقط على الحدود الجغرافية للدولة، بل تبدأ من «السيادة على المنزل». هناك مناطق «محرمة» لا يجب أن يدخلها الغريب مهما كنا مشغولين. أن تروي قصة قبل النوم، هذا «مفتاح» لا يُسلم للمربية. أن توصل ابنتك المراهقة وتستمع لثرثرتها في السيارة، هذه «فرصة ذهبية» لا تتركها للسائق. وإذا كنا نتفق جميعاً على أن القيم هي أول الهرم التربوي، فلا خلاف على أن القرآن الكريم يتربع على قمة هذا الهرم بلا منازع. وهنا، يجب أن نتوقف للمصارحة: هل يكفي أن نوكل مهمة ربط أبنائنا بكتاب الله إلى «المحفّظ» أو «المحفّظة» فقط؟ نحن لا ندعو -بالتأكيد- لترك حلقات التحفيظ، ولكن العقد لا يكتمل في صدور أبنائنا إلا إذا وضعنا نحن لمساته. كيف تهون علينا أنفسنا أن يسبقنا غريبٌ إلى تعليم فلذة أكبادنا «سورة الفاتحة»؟ هذه السورة هي «أم الكتاب»، وهي الأساس في حياة كل مسلم، ولا تجوز الصلاة إلا بها. ألا تطمع أن يكون لك أنت «أجر» كل مرة يقرأها ابنك طوال حياته؟ ألا تغار أن يكون هذا الحبل السري الروحي موصولاً بغيرك؟ لن يكتمل «عقد القرآن» في صدور أبنائنا ما لم نضع نحن، الآباء والأمهات، لبناته الأولى. فلتكن أصواتنا هي أول ما يتردد في آذانهم بآيات الله، ليكبروا وهم يحملون «القرآن» في صدورهم، و»صوت الوالدين» في ذاكرتهم. الرفاهية الحقيقية ليست في أن يخدمك الناس، بل في أن تملك الوقت والجهد لتخدم أهل بيتك، وتصنع ذكرياتهم. الطفل لن يتذكر نظافة الأرضية التي مسحتها الخادمة، لكنه سيتذكر طوال عمره «لمسة يدك» وأنت تمسح على رأسه، وصوتك وأنت تعلمه «المرجلة» أو «الحياء» أو «الفاتحة». دعونا نستعيد «مفاتيح» بيوتنا. لتبقَ المساعدة للمساعدة في «شؤون البيت» (التنظيف، الغسيل)، أما «شؤون القلب» و»شؤون العقل» و»شؤون الروح»، فهذه مملكتكم الخاصة التي لا تقبل الشراكة. لا تجعلوا أطفالكم «أيتاماً» والوالدان على قيد الحياة.
1938
| 12 فبراير 2026
- 3 الرياضة نبض الوطن الحي
يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة، إذ إن تحديد موقعه الوظيفي داخل البنية المجتمعية يسبق بالضرورة أي حديث عن أشكاله التنظيمية أو مظاهره الظاهرة. فإدراجه ضمن منطق الفعالية الزمنية المحدودة يُفرغه من قيمته، بينما يقتضي الفهم الرشيد التعامل معه كأداة توجيهية لإعادة بناء الثقافة الرياضية على أسس واعية ومستدامة. على مستوى الفرد، لا يمكن اختزال دور اليوم الرياضي في المشاركة الشكلية أو الامتثال المؤقت. بل يفترض أن يشكّل لحظة وعي نقدي تُعيد تعريف العلاقة بين الجسد والمسؤولية الذاتية. فالنشاط البدني، في هذا الإطار، لا يُنظر إليه كخيار ترفيهي، بل كواجب مرتبط بالصحة العامة، والانضباط الشخصي، والقدرة على الإنتاج والاستمرار. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لليوم الرياضي تتجلى في قدرة الفرد على تحويله من تجربة عابرة إلى التزام سلوكي طويل الأمد، وإلا تحوّل إلى ممارسة رمزية فاقدة للأثر. أما الأندية الرياضية، فيقع على عاتقها دور بنيوي يتجاوز التنظيم اللوجستي إلى الدور التنويري. فهي مطالبة بأن تكون وسيطًا معرفيًا يربط بين الممارسة الرياضية وبناء الشخصية، وبين التدريب والوعي، لا أن تكتفي بتوفير النشاط دون تنظيم فكري. كما ينبغي أن تتحمل الأندية مسؤولية استيعاب المجتمع خارج دائرة النخبة، عبر برامج مستمرة تستهدف الفئات غير النشطة، وتحوّل اليوم الرياضي إلى بوابة انخراط لا إلى ذروة موسمية. كلمة أخيرة: إن اليوم الرياضي يستمد قيمته من كونه لحظة تأسيس وعي لا لحظة استهلاك نشاط، ومن قدرته على إعادة توجيه الأدوار الفردية والمؤسسية نحو ممارسة رياضية واعية، مستمرة، ومتصلة بأهداف المجتمع الكبرى، لا من مظاهره الآنية أو زخمه المؤقت.
1668
| 10 فبراير 2026