رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مقالات
2136
د. عبدالله العماديما المزعج في حياة الماعز !؟
ليس حديثنا اليوم عن حيوان الماعز – أعزكم الله – ولا لي دراية بحياتها وكيف تعيش حتى أتحدث عنها. لكن بالطبع أزعجني وربما الكثير منكم، ذلكم الضجيج المثار حول الفيلم الهندي السينمائي «حياة الماعـز» الذي تم إنتاجه بناء على رواية صدرت قبل سنوات عدة لم ينتبه لها كثيرون إلا بعد أن تحولت إلى فيلم درامي سينمائي، وخصوصاً بعد أن تم عرض نسخة مترجمة منه على منصة « نتفليكس « فجذب الاهتمام والأنظار، بل زاد من شعبيته!. الفيلم، وإن حكى قصة حقيقية وقعت بالسعودية قبل سنوات مضت لا تخلو أرقى المجتمعات منها، لم أجد أنه يحتاج لكل هذا التفاعل من الجانب العربي المسلم، سوى ما كان بالشكل الذي يتم عبره توضيح حقائق وخفايا أمور، لكن دون رفض محتوى الفيلم جملة وتفصيلاً في الوقت نفسه، باعتبار أن الجانب الإنساني في الفيلم والمتعلق بظلم الإنسان لأخيه الإنسان، قضية أزلية مستمرة منذ قصة قابيل وهابيل، وبالتالي لابد من الوقوف ضد الظلم في كل زمان ومكان. هذه نقطة أولى.
نقطة ثانية مهمة في هذه المقدمة وهي أن الفيلم، وإن أظهر الجوانب الإنسانية في مشاهد العامل وهو بالصحراء، تناسى عن عمد وقصد، جوانب إنسانية لدى أهالي حفر الباطن، حيث جرت أحداث القصة بجزء بعيد في عمق صحرائها، الذين تكاتفوا وسعوا إلى جمع مبلغ 170 ألف ريال دية المقتول، وهو ها هنا الظالم، أو الكفيل كما سماه الفيلم، وذلك بعد أن تم اعتقال العامل وسجنه لخمس سنوات بسبب القتل الخطأ. ولم يتطرق الفيلم كذلك إلى إنسانية أبناء الظالم، وتنازلهم عن الدية، بل ومنحها للعامل كاملة مع عشرين ألفا أخرى، كنوع من التعويض على سنوات عشر أمضاها العامل في السعودية بدون أجر. إضافة إلى ما سبق، لم يتم التطرق في الفيلم عن قصد أيضاً، إلى العامل غير المسلم وهو يرى إنسانية الأهالي، ومن ضمنهم أبناء ظالمه الجاهل، وتأثره بتلك الأخلاقيات الإسلامية، ما دفعه إلى إعلان إسلامه بعد أن رأى وعاين بنفسه سماحة هذا الدين التي ظهرت في سلوكيات الأهالي، والذين أظهرهم الفيلم على أنهم عديمو رحمة وقساة غلاظ في أحد مشاهد العامل وهو داخل المدينة، مع خلفية لصوت مؤذن ينادي الله أكبر، مع لقطة خاطفة لمئذنة مسجد، من أجل ترسيخ وربط فكرة القسوة والغلظة بالإسلام في ذهنية المشاهد!.
لو نظرنا كنقطة ثالثة مهمة في هذه المقدمة، وبشكل أوسع إلى مسألة الظلم كما يريد الفيلم أن يظهرها، ودققنا النظر في الواقع نحو ما يجري في الهند نفسها من اعتداءات الهندوس الممنهجة والمستمرة على المسلمين، فربما احتجنا مئات الأفلام وآلاف الروايات للحديث عنها، هذا بفرضية رغبتنا الدخول في سباق مع الآخر وبيان ما عنده من مساوئ ومظالم وشرور أيضاً. لكن ما هكذا تورد الإبل - كما تقول العرب - لأن المسألة تحتاج منهجية وعملا واضحا منظما لا يعتمد على ردود أفعال، وهذا هو محور حديثنا اليوم. لكن قبل أن نتعمق أكثر، هناك نقطة أخرى أخيرة مهمة في هذه المقدمة الطويلة، ومن باب تأكيد المؤكد ليس أكثر، هي أنه لا يوجد مجتمع ملائكي الصفات بين البشر، والظلم بأنواعه موجود في أرقى المجتمعات والأمم، وليس عند العرب فقط كما يريد أن يقول هذا الفيلم، كواحدة من رسائله غير المباشرة. ثم إن الفيلم لن يكون آخر الأفلام في سلسلة الإنتاجات الفنية الموجهة والمغرضة، سواء الهندية أو غيرها من تلك التي تسير على درب هوليوود، والتي فعلت بنا أكثر من بوليوود ونظيراتها آلاف المرات.
صناعة السينما
ليس المهم ها هنا الحديث عن الفيلم بقدر أهمية تأمل السؤال الذي يفرض نفسه دوماً في مثل هذه المناسبات والأحوال:
أين السينما العربية؟
وأين الإنتاج الفني الإعلامي العربي المسلم الذي يكشف الحقائق دون مبالغات أو إساءات؟ ستجد أنه لا أثر أو إجابة مقنعة، وإن وجدت بعض أعمال فنية هنا وهناك، فهي غالباً لا تجد ذلكم الدعم الذي يوصلها للعالمية أو إلى الساحات التي يمكن عبرها توصيل رسالتنا للعالم، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل المستمر أو المتكرر في كل حين: لماذا لا تنشط المؤسسات الفنية والإعلامية في إنتاج دراما فنية هادفة تخدم قضايا الأمة، ولماذا لا تنشط في الوثائقيات وتكشف المستور في تلك المجتمعات التي تتفنن منذ عقود طويلة في الإساءة لنا كعرب ومسلمين، كالمجتمع الأمريكي أو الغربي بشكل عام، ومعهم الآن المجتمع الهندوسي والصهيوني وغيرها من مجتمعات معادية؟ الفن السينمائي أو إن صح التعبير، صناعة السينما، تحتاج إلى كثير رعاية واهتمام في عالمنا الإسلامي. لا أقصد بالسينما الترفيهية العبثية، إنما تلك التي تحمل رسالة واضحة، وتسير وفق رؤى ومنهجية محددة ضمن عمل إعلامي واسع. هذا الفن الإعلامي ما زال مدار بحث ونقاش طويل مفصل يتجدد بين الحين والحين في أوساط علماء الشرع، منذ أن عرف العالم الإسلامي فن التمثيل وإنتاج المسلسلات والأفلام. وما خرجنا من نقاش تلك المسألة بإجماع أو على أقل تقدير، برأي يتفق عليه عدد لا بأس به من العلماء، يكون موجهاً أو معياراً لهذا العمل المهم في زمن الإعلام والمعلومات.
التخلف السينمائي غير مقبول
نعود للموضوع مدار البحث، ونحن نعيش عصراً متسارعاً في أفكاره وعلومه وتقنياته، والفن السينمائي واحد من المجالات التي اختلفنا عليه فتأخرنا، لنؤكد أن التخلف في هذا المجال أمر غير مقبول البتة - ونحن كما أسلفنا - نعيش زمن الإعلام والمعلومات ومنها السينما، فيما غيرنا مستمر في إبداعاته وإتقانه في هذا المجال حتى ساروا بعيداً بعيدا. وصار هذا الفن سلاحاً فاعلاً بأيديهم لا يقل فعالية وكفاءة وأثراً عن الأسلحة العسكرية والاقتصادية وغيرها. هذا الفن أو هذه الصناعة، إيجابياتها تفوق سلبياتها. وليس لأن البعض يستخدمها في الشر فهي بالتالي شر كلها، فنترك جلها. لا، الأمر أوسع من هذا بكثير. إن الكاميرات السينمائية التي تصور الأفلام الهابطة، هي نفسها التي تصور أفلام الاستقامة. إنها آلات صماء تأتمر بأمرك، وأنت من يحركها ويديرها كما تريد وليس العكس. إنها هي نفسها الكاميرات التي قام المخرج السينمائي مصطفى العقاد - رحمه الله - باستخدامها لتصوير فيلمي الرسالة وعمر المختار، واستخدمها تلفزيون قطر لإنتاج أروع المسلسلات التاريخية مثل مسلسل عمر الفاروق والإمام ابن حنبل وغيرهما الكثير النافع.
السينما سلاح مؤثر
ختام القول إنه لا شيء يمنع في استخدام فن السينما في تحقيق المقاصد الطيبة والأهداف الإنسانية النبيلة، وأن نقدم أنفسنا للعالمين بالصورة التي أرادها الله وأرادها رسوله الكريم محمد ﷺ. هذا فن وصناعة، ونحن من يسيطر ويحدد الأطر والضوابط لها، أو هكذا المفترض أن يكون. إن إنتاجاً فنياً على غرار مسلسل عمر، أو فيلم الرسالة وعمر المختار ومحمد الفاتح كأبرز نماذج سينمائية مسلمة، يمكنها فعل الكثير من التأثير في الآخرين. ومطلوب بالتالي على غرارها، أن يستمر الإنتاج السينمائي أو صناعة السينما بذلكم المستوى وأفضل، وفق رؤى واضحة وأهداف محددة. وبها كذلك يمكننا أن نواجه المخالف الراغب في التشويه والإساءة بنفس السلاح الذي يستخدمه، ليس بالتشويه طبعاً، لكن عبر إنتاج أعمال راقية بديعة تكون قادرة على كشف رداءة بضاعة المهاجم حين يأتي وقت المقارنة.
بمثل هذا التفكير وهذه المنهجية نخدم ديننا، دون أن نشتت ونهدر مواردنا وجهودنا على شكل ردود أفعال قد تصيب، أو تخيب غالب الأحيان. والله دوماً كفيل بكل جميل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
اقرأ المزيد
 هل ينجح أعداء أمتنا في تقسيم دولنا؟
هل ينجح أعداء أمتنا في تقسيم دولنا؟
نعيش جميعا منعرجا تاريخيا يتمثل لدينا فيما نراه يوميا من تقسيم دولنا أعراقا وقبائل وفرقا وهو ما يسعى... اقرأ المزيد
117
| 16 يناير 2026
 السيكودراما وذوو الإعاقة
السيكودراما وذوو الإعاقة
السيكودراما (Psychodrama) هي طريقة علاجية جماعية تعتمد على التمثيل الإيجابي والتجسيد الدورى للمشاهد الداخلية والعلاقات بين الناس. اخترعها... اقرأ المزيد
72
| 16 يناير 2026
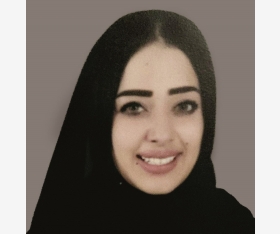 خطورة التربية غير الصحية
خطورة التربية غير الصحية
هناك فرق كبير بين التركيز على الجهد وليس النتيجة في التربية وتلبية الاحتياجات الأساسية وليس كل الرغبات والرفاهيات... اقرأ المزيد
66
| 16 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
د. عبدالله العمادي
د. عـبــدالله العـمـادي
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
هل الدوحة الوجهة المناسبة للعائلة الخليجية؟

د. عائشة جاسم الكواري
-
قطر والسعودية وعمان ركائز الاستقرار الإقليمي

رأي الشرق
-
غرينلاند.. القنبلة العالمية!

جاسم الشمري
-
هل ينجح أعداء أمتنا في تقسيم دولنا؟

د. أحمد القديدي
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 أهمية الدعم الخليجي لاستقرار اليمن
بعد أسابيع عصيبة عاشتها بلادنا على وقع الأزمة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما رافقها من إجراءات أحادية قام بها المجلس الانتقالي ( المنحل ) أربكت المشهد السياسي والأمني، ومن الواضح أن اليمن يتجه اليوم بعزم وإرادة، نحو مرحلة أكثر هدوءا واستقرارا.هذه الفترة رغم قصر مدتها إلا أنها كانت حافلة بالأحداث التي شكلت اختبارا صعبا لتماسك الدولة وقدرتها على الصمود، وأيضا لحكمة القيادة السياسية في إدارة لحظة شديدة الحساسية، داخليا وإقليميا.إن خطورة ما جرى في محافظتي حضرموت والمهرة لم يكن مقتصرا على تعميق الانقسام الاجتماعي أو إثارة الحساسيات المحلية، بل تجاوزت ذلك إلى تهديد وحدة البلد ووحدة مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، وإضعاف جبهة الشرعية برمتها في لحظة لا تحتمل فيها البلاد أي تصدّعات إضافية. هذا الوضع الصعب مثل تحديا حقيقيا كاد أن ينعكس سلبا على المسار السياسي العام، وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوجودية التي لا تزال قائمة وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي وانقلاب جماعة الحوثي. وخلال هذه الأزمة، برز بوضوح مدى أهمية الموقف الدولي، الذي ظل رغم كل التعقيدات قائما على مقاربات موضوعية ومسؤولة تجاه الملف اليمني. فقد حافظ المجتمع الدولي على موقف موحد داعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، وهو مكسب سياسي ودبلوماسي بالغ الأهمية كان مهددا بالتآكل نتيجة تداعيات الأزمة الأخيرة. ومن المهم التأكيد على أن الحفاظ على هذا الدعم والزخم الدولي المساند للحكومة لم يكن نتاج صدفة عابرة، بل هو ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي منظم وواع، أدرك حساسية المرحلة وخطورة أي انزلاق غير محسوب نحو الصراع داخل مظلة الحكومة، مرسخا قناعة دولية بضرورة دعم الشرعية باعتبارها الإطار الوحيد القادر على استعادة الدولة وصون الاستقرار. اليوم تمضي القيادة السياسية والحكومة في مسار تصحيحي شامل، يستهدف احتواء تداعيات الأزمة ومعالجة جذورها، وهو مسار يحظى بتأييد شعبي واسع، ودعم كامل وواضح من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وبالحديث عن دعم أشقائنا في مجلس التعاون بقيادة السعودية فإنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره مساندة ظرفية مرتبطة بأحداث معينة، بقدر ما هو ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن الإقليمي والاستقرار السياسي، وتشابك المصالح بين اليمن ومحيطه الخليجي. نعم، إن أهمية الدعم الخليجي لليمن تتجاوز بطبيعتها البعد الاقتصادي أو الإنساني، لتتصل مباشرة بجوهر المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة. فاستقرار اليمن والاستثمار في دعم مؤسساته الشرعية يظل الخيار الأكثر حكمة لضمان أمن جماعي مستدام، قائم على الشراكة والمسؤولية المشتركة. ولكي تتمكن الحكومة ومجلس القيادة من استعادة زمام المبادرة، وتعزيز حضور الدولة، فإن اليمن أحوج ما يكون اليوم إلى موقف خليجي داعم على مختلف المستويات، سياسيا، واقتصاديا، وأمنيا، لأن هذا الدعم يشكّل الطريق الأكثر واقعية لضمان استقرار الأوضاع، واستعادة الثقة، وانتشال اليمن من أزماته المتراكمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المعالجات التي لا تنفذ إلى جوهر المشكلات التي تعاني منها بلادنا. وعلى المستوى الداخلي، شكلت الأزمة الأخيرة فرصة لإعادة تذكير جميع المكونات والقوى السياسية بأولويات اليمن الحقيقية، وبالمخاطر الأساسية المحدقة به. فالصراع الجانبي، وتغليب الحسابات الضيقة، لا يخدم سوى مشاريع التقسيم والإنفلات ومشروع الحوثي، الذي لا يزال التهديد الأكبر لمستقبل اليمن، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع للتحرك وفق برنامج واضح، يعيد ترتيب الأولويات، ويضع إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في صدارة الأهداف، وصولا إلى مرحلة لا يكون فيها اليمن رهينة للسلاح أو المشاريع الخارجة عن الدولة، وإنما دولة مستقرة، شريكة لمحيطها، وقادرة على إدارة شؤونها بإرادة وطنية جامعة.
1527
| 14 يناير 2026
- 2 لومومبا.. التمثال الحي الذي سحر العالم
اعتدنا خلال كل البطولات الأممية أو العالمية لكرة القدم أن نرى العدسات تتجه إلى مواقع المشاهدين في المدرجات، تسلط الضوء على الوافدين من كل حدب وصوب بكل تقاليدهم في الملبس والهيئة والسلوك. لكن أتت النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا والمقامة في المغرب، لتكشف عن حالة جديدة فريدة خطفت الأضواء، وأصبحت محط أنظار وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي. ففي جميع المباريات التي كان أحد طرفيها فريق الكونغو، كان أحد مشجعي هذا الفريق يقف طيلة وقت المباريات كتمثال جامد بلا حراك، بجسد مشدود ويد يرفعها أمامه كمن يلقي التحية، دون أن يهتف، ودون أن يتكلم، ودون أن يصفق، فقط هي تلك الهيئة الجامدة. لم يكن هذا التمثال البشري يثير الدهشة والانتباه فقط بهيئته، بل بالشخص الذي اتخذ هيئته، فقد كان يجسد بهذه الوضعية تمثالا للزعيم الكونغولي باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء لجمهورية الكونغو الديمقراطية عقب الاستقلال عام 1960م. «كوكا مبولادينغا»، هو اسم ذلك المشجع الكونغولي الذي تقمص هيئة الزعيم الاستقلالي لومومبا، وخطف أنظار الجماهير وعدسات التصوير، ليتحول إلى أيقونة وطنية تعبر عن رموز بلده وربط تاريخها بحاضرها، واستدعى رمزية الاستقلال ممثلًا في شخصية ذلك الزعيم الذي قاد الحركة الوطنية الكونغولية ولعب دورًا محوريًا في استقلال الكونغو بعد أن كانت مستعمرة بلجيكية، وعُرف بخطبه ومقالاته النارية التي شرح خلالها للأوساط المحلية والإقليمية والدولية جرائم البلجيك ضد الشعب الكونغولي وتورطهم في تهريب ثروات البلاد، وخاض مظاهرات شعبية ومواجهات ضد الاحتلال، وتعرض للسجن، إلى أن استقلت بلاده وشغل منصب رئيس الوزراء، إلى أن قام الانقلاب العسكري الذي أدى إلى اعتقاله وتعذيبه وإعدامه بعد عام واحد من الاستقلال. لم يختر المشجع مبولادينغا رفع العلم أو دهن وجهه بألوانه، أو أداء رقصة شعبية كونغولية، أو أي من هذه المظاهر المعتادة لتمثيل بلاده، بل اختار ذلك السكون والجمود على مدى 438 دقيقة، هي زمن المباريات التي خاضها فريقه. كان مشهدًا مؤثرًا لكل من طالعه، ولم يتوقف هذا التأثير عند حد الإعجاب بالرجل، ولكن تعداه إلى ما هو أبعد بكثير من ذلك، إذ إنه أقام جسرًا ممتدًا للتعريف ببلاده ورموزها، فقد تدفق اللجوء إلى محركات البحث عن الكونغو واستقلالها وزعيمها، فنقل رجل واحد – بذلك السلوك- وطنه إلى حيز الاهتمام العالمي، وعرّف ببلاده بشكل أقوى وأسرع وأكثر كثافة من كل ما يكتب عن الكونغو وتاريخها وحاضرها ورموزها. لقد اتضح لي من البحث أن هذا الرجل يسير على نفس النهج من التشجيع بهذه الهيئة، منذ قرابة اثني عشر عاما، بما يعني أن الرجل صاحب قضية، وصاحب رسالة وحس وطني، ويحمل بين جنباته حب وطنه وقضاياه، يرغب في أن يتعرف العالم على تاريخ بلاده المنسية ورموزها، بما ينفي عنه تهمة السعي وراء (التريندات). لقد صار الرجل أبرز رموز كأس الأمم بالمغرب، وأصبح أيقونة وطنية معبرة عن الكونغو، ما جعله محل اهتمام رسمي قوي، فقد التقط رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي صورة تذكارية معه خلال مباراة الجزائر والكونغو، وقام وزير الرياضة الكونغولي بتكريمه لتشريفه بلاده وتمثيلها خير تمثيل، وأهداه عربة دفع رباعي «جيب»، وأهداه الاتحاد الجزائري لكرة القدم قمصان المنتخب الجزائري بعدما أبكاه خروج منتخب بلاده أمام الجزائر، ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة دعوة رسمية له لحضور المباراة النهائية، إضافة إلى أنه كان لا يستطيع أن يخرج من غرفة فندقه بسبب تدافع الناس لالتقاط الصور معه والتحدث إليه. المشجع الكونغولي الذي أحيا قصة الاستقلال، كان بصمته وجموده يؤدي طقسًا وطنيًا ويجسد شكلا من أشكال الانتماء للوطن، وغدا كجندي يحرس ذاكرة بلاده وشاهد على تاريخ يجمع بين الألم والأمل. أمثال هذا الرجل هم القوة الناعمة الحقيقية لأي دولة، أولئك هم السفراء الذين يجسدون معاني الوطنية والاعتزاز بالوطن والدعاية له والتعريف به وشرح قضاياه. إننا مطالبون كذلك كلما تخطينا حدود بلادنا أن نكون سفراء لها، ندرك أننا في أسفارنا نرسم الصورة الذهنية للآخرين عن بلادنا، فالفرد هو جزء من مجتمعه، من وطنه، سوف ينقل ثقافته وقضاياه إلى الشعوب لا بالشعارات والأغاني، إنما بالسلوك والقيم.
828
| 11 يناير 2026
- 3 توثيق اللحظة... حين ننسى أن نعيشها
للأسف، جميعنا نمرّ بلحظات جميلة في حياتنا، لحظات كان من المفترض أن تترك أثرًا دافئًا في قلوبنا، لكننا كثيرًا ما نمرّ بها مرور العابرين. لا لأن اللحظة لم تكن جميلة، بل لأننا لم نمنحها انتباهنا الكامل، وانشغلنا بتوثيقها أكثر من عيشها. نعيش زمنًا غريبًا؛ نرفع الهاتف قبل أن نرفع رؤوسنا، ونوثّق اللحظة قبل أن نشعر بها، ونلتقط الصورة قبل أن يلتقطنا الإحساس. لم نعد نعيش اللحظة كما هي، بل كما ستبدو على الشاشات. كأن وجودنا الحقيقي مؤجّل، مرتبط بعدسة كاميرا، أو فيديو قصير، أو منشور ننتظر صداه. نخشى أن تمر اللحظة دون أن نُثبتها، وكأنها لا تكتمل إلا إذا شاهدها الآخرون وتفاعلوا معها. كم مرة حضرنا مناسبة جميلة؛ فرحًا، لقاءً عائليًا، أو جلسة بسيطة مع من نحب، لكن عيوننا كانت في الشاشة، وأصابعنا تبحث عن الزاوية الأفضل والإضاءة الأجمل، بينما القلب كان غائبًا عن المشهد؟ نضحك، لكن بوعيٍ ناقص، ونبتسم ونحن نفكر: هل التُقطت الصورة؟ هل وثّقنا اللحظة كما ينبغي؟ نذهب إلى المطعم، أو نسافر إلى مكان انتظرناه طويلًا، فننشغل بالتصوير أكثر من التذوّق، وبالتوثيق أكثر من الدهشة. نرتّب الأطباق لا لنستمتع بطعمها، بل لتبدو جميلة على صفحاتنا، ونصوّر الطريق والمنظر والغرفة، بينما الإحساس الحقيقي يمرّ بجانبنا بصمت. نملأ صفحاتنا بالصور، لكننا نفرّغ اللحظة من معناها، ونغادر المكان وقد وثّقناه جيدًا… دون أن نكون قد عِشناه حقًا. صرنا نعيش الحدث لنُريه للآخرين، لا لنعيشه لأنفسنا. نقيس جمال اللحظة بعدد الإعجابات، وقيمتها بعدد المشاهدات، ونشعر أحيانًا بخيبة إن لم تلقَ ما توقعناه من تفاعل. وكأن اللحظة خذلتنا، لا لأننا لم نشعر بها، بل لأن الآخرين لم يصفّقوا لها كما أردنا. ونسينا أن بعض اللحظات لا تُقاس بالأرقام، بل تُحَسّ في القلب. توثيق اللحظات ليس خطأ، فالذاكرة تخون أحيانًا، والسنوات تمضي، والصورة قد تحفظ ملامح ووجوهًا وأماكن نحب العودة إليها. لكن الخطأ حين تصبح الكاميرا حاجزًا بيننا وبين الشعور، وحين نغادر اللحظة قبل أن نصل إليها، وحين ينشغل عقلنا بالشكل بينما يفوتنا الجوهر. الأجمل أن نعيش أولًا. أن نضحك بعمق دون التفكير كيف ستبدو الضحكة في الصورة، أن نتأمل بصدق دون استعجال، وأن نشعر بكامل حضورنا. ثم – إن شئنا – نلتقط صورة للذكرى، لا أن نختصر الذكرى في صورة. بعض اللحظات خُلقت لتُعاش لا لتُوثّق، لتسكن القلب لا الذاكرة الرقمية. فلنمنح أنفسنا حق الاستمتاع، وحق الغياب المؤقت عن الشاشات، فالعمر ليس ألبوم صور، بل إحساس يتراكم… وإن فات، لا تُعيده ألف صورة.
816
| 13 يناير 2026



