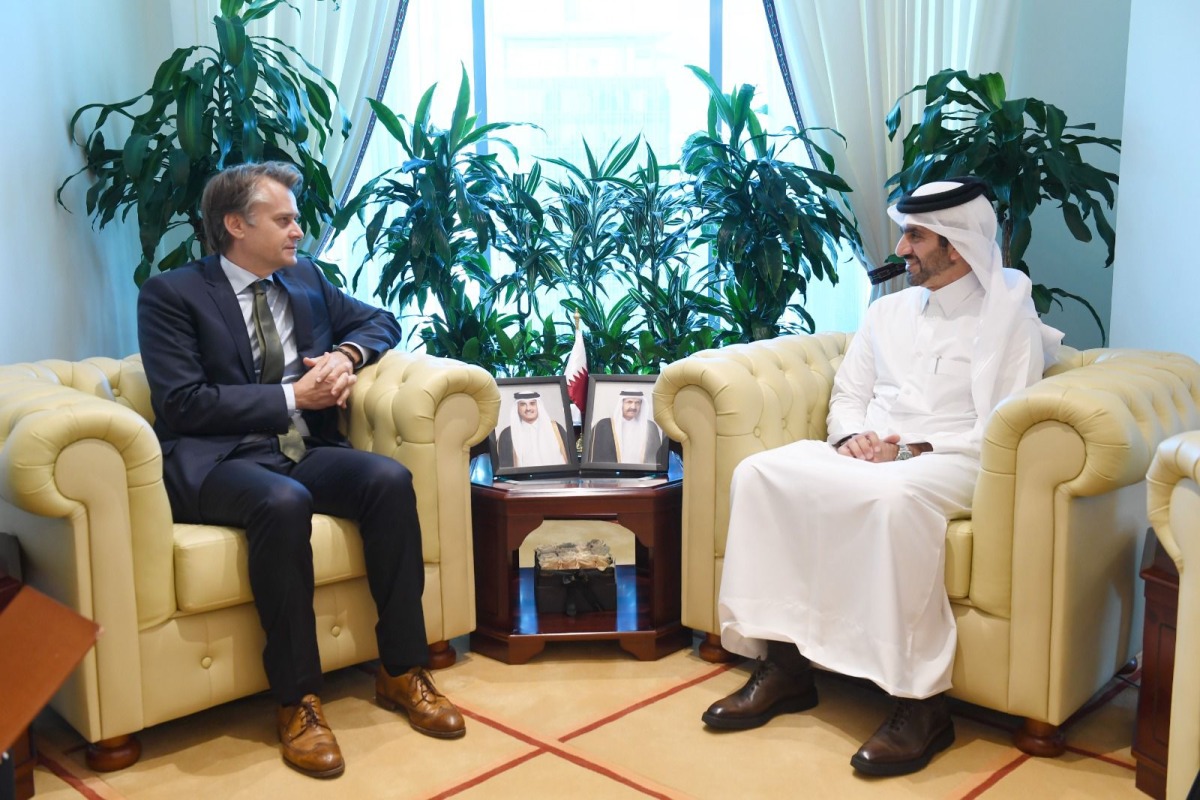رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نظام يتجه نحو إعادة إنتاج نفسه ورئاسيات بطعم العهدة الخامسة، ضاربة بإرادة الحراك وطموحات عشرات الملايين من الجزائريين عرض الحائط، رئاسيات هندستها المؤسسة العسكرية بمترشحين من صلب النظام السابق. الحراك يتساءل أين هو بوشاشي وحمروش وأحمد طالب الإبراهيمي وبن بيتور ورحابي؟، شخصيات سياسية نظيفة ونزيهة كان يتمنى أن تكون مرشحة للرئاسيات، كان الحراك يحلم أن يكون أحد هؤلاء من يحكم جزائر الجمهورية الثانية جزائر القطيعة مع الماضي والقطيعة مع الاستبداد والفساد، مع الأسف الشديد أماني الحراك تبخرت ورئاسيات العهدة الخامسة على الأبواب، إذن هل نحن في طريق التطور نحو الوراء، أم العودة لنقطة الصفر، أم إصرار النظام على تجاهل مطالب الحراك وإعادة إنتاج نفسه من خلال الحل الدستوري وتطبيق المادة 102 من دستور تم تفصيله حسب مقاس الرئيس السابق بوتفليقة الذي عبث به كما شاء، الكثير من المحللين رأوا أن استقالة بوتفليقة لا تعني الكثير، حيث إن ذهاب بوتفليقة ومجيء بن صالح هو تبادل أدوار بطريقة تحافظ على النظام واستمراره، الشعب الجزائري في الواقع لا يريد استبدال بوتفليقة ببن صالح ابن النظام الذي صال وجال في الوسط السياسي الجزائري لمدة تزيد على الثلاثين سنة، بن صالح الذي ترأس مجلس الأمة لأكثر من أربع مرات وترأس حزب التجمع الديمقراطي الذي يعتبر من آليات النظام الفعالة، بن صالح الرئيس المؤقت للجزائر بموجب المادة 102 هو من المتحمسين الكبار والفعالين الذين أصروا على العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة والذين كانوا من الأوفياء والمخلصين لنظام اتسم بالفساد وبتبذير المال العام على مدار عشرين سنة، نظام اتسم بانتشار الصفقات المشبوهة والقضايا التي أسالت الكثير من الأحبار والأخبار كقضية الكوكايين والخليفة وسوناطراك وغيرها كثير. ما يعني أن بن صالح هو رمز من رموز النظام والذي سيعمل جاهدا ويبذل قصارى جهوده لإعادة إنتاج هذا النظام الذي ترعرع وكبر وهرم في ضلوعه، ما يعني أن المسيرات المليونية التي شهدتها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي لم تأت بشيء يذكر ما عدا اعتراف العالم بسلميتها وتنظيمها المحكم ونضجها السياسي. فمن شعار "خواة- خواة" أي إخوة إخوة إلى حالة يبدو فيها أن الجيش تخلى عن الحراك ونسي المادة 7 و8، والمأزق الذي يواجهه الحراك بعد استقالة بوتفليقة هو أن دستور 2016 لم يأخذ بعين الاعتبار ما تمر به الجزائر هذه الأيام، فالدستور الذي فصله نظام بوتفليقة وتلاعب به ثلاث مرات لا يستطيع بأي حال من الأحوال حل الأزمة الجزائرية حاليا دستورياً، فالحل إذن سياسي بالدرجة الأولى. فالمادة 102 لا تستجيب نهائياً لمطالب الحراك بل تسمح بطريقة شرعية ودستورية لرئيس مجلس الأمة ليترأس البلاد مؤقتاً، وحتى تمديد فترة رئاسة بن صالح للجزائر يعتبر تمديدا غير دستوري وخارج القانون. فإذا انحاز أحمد قايد صالح للحراك في المرحلة الأولى وفرض على السعيد بوتفليقة والجناح العسكري الموالي له استقالة الرئيس بوتفليقة وتنحيه نلاحظ أنه بعد تنصيب بن صالح في 9 أبريل 2019 رئيسا مؤقتا للبلاد بموجب المادة 102 أن قائد الأركان انحاز للنظام في عملية إعادة إنتاج نفسه. وأصبح القايد صالح، يصف بين عشية وضحاها، مطالب الحراك بالمطالب التعجيزية ما يحتم ضرورة الالتزام بالدستور وفجأة نلاحظ أن الكلام عن المادة 7 و8 قد اختفى نهائيا من خطاب القايد كاختفاء الملح في الماء. الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا لا تحلها المادة 102، وهذه المادة تصلح في ظروف عادية وليس في ظروف خرج فيها 20 مليون جزائري يطالبون بالتغيير، وحتى الدستور لا يصلح في الظروف الحالية لأنه اخترق من قبل الرئيس المستقيل 3 مرات واخترق عندما وافق الرئيس السابق على حكومة لا ترقى لأن تكون حكومة تسير شؤون البلاد في مثل هذه الظروف. فالمسار الدستوري الذي تريده قيادة الجيش وتهدف من خلاله إلى الحفاظ على النظام يعتبر التفافاً على مطالب الشعب ولا يفي بالغرض بل يكرس الوضع الراهن ويستبدل بوتفليقة ببن صالح، والاثنان من نفس النظام ويمثلان عقدين من تسيير سياسي وإداري واقتصادي فاشل بكل المعايير والمقاييس وما بن صالح إلا امتداد لنظام بوتفليقة ما يعني أن مسيرات ملايين الجزائريين لمدة 9 شهور ذهبت أدراج الرياح وأن نظام بوتفليقة بقي قائما برجالاته وأيديولوجيته وبجيشه.. المسار الدستوري يكرس ويدعم الوضع الراهن وإعادة إنتاج النظام بامتياز، حيث يخدم أحزاب النظام أكثر من أحزاب المعارضة كونها تملك من الموارد والخبرة ما يمكنها من التحضير للانتخابات، كما أن الحركة الاحتجاجية ما زالت غير منظمة وغير قادرة على إنتاج كيانات سياسية قادرة على منافسة أحزاب وهياكل سياسية منظمة ومتمرسة منذ عقود من الزمان، هذا ما يقودنا للكلام عن المادة 7 و8 التي تفتقر لأية آليات واضحة لتطبيقها من أجل تجسيد محتواها على أرض الواقع وهو الإقرار بأن الشعب هو مصدر السلطة. لكن بتنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد فهذا يعني أن السلطة الحقيقية هي بيد النظام الذي بدأ جاهدا في عملية إعادة إنتاج نفسه من خلال دعوة الهيئة الانتخابية للانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر 2019. وهنا نلاحظ استبعاد المسار السياسي لمعالجة الأزمة التي تمر بها الجزائر هذه الأيام، ومنطقيا المسار السياسي هو النهج السليم لبداية مرحلة البناء للجمهورية الثانية والتخلص من النظام الفاسد. فالمسار السياسي هو الأمثل للاستجابة لمطالب الحراك وتطبيق المادة 7 و8 على أرض الواقع. المسار السياسي الذي يطالب به الشارع يهدف إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي وليس مجرد تغيير بوتفليقة بأحد الخمسة المرشحين لانتخابات 12 ديسمبر 2019. فالخروج من الأزمة والانتقال الديمقراطي السلس والهادئ والمنهجي والمنظم، طريق التخلص من النظام الفاسد في الجزائر ما زال طويلا ويحتاج إلى عمل ومثابرة ورؤية وإستراتيجية، مرة أخرى، تفوت الجزائر فرصة ذهبية للتخلص من 57 سنة من الاستبداد والطغيان والفساد وسوء الإدارة والتسيير لشؤون البلاد والعباد، فمحاولة الوصول إلى الديمقراطية بطرق غير ديمقراطية وغير نزيهة وغير شفافة لا تفرز بأي حال من الأحوال الحكم الراشد ولا تلبي مطالب الملايين التي خرجت إلى الشارع منذ 22 فبراير الماضي وحتى هذه اللحظة. فانتخابات 12 ديسمبر 2019 ما هي إلا هروب إلى الأمام وعدم احترام مسيرات سلمية حضرية أثبتت أن الشعب في الجزائر أنضج ممن يحكمونه. صحيح أن القايد صالح أستطاع أن يتخلص من سعيد بوتفليقة وعصابته لكنه بقي وفيا للمؤسسة العسكرية التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال من وراء الكواليس، فالقايد صالح اختار من سيحكم الجزائر منذ مدة وهو متأكد من أن الجيش يبقى دائما المعادلة الصعبة والفاعل رقم واحد في الشأن السياسي الجزائري.
967
| 16 نوفمبر 2019
لماذا لا تكون المؤسسة الإعلامية في الوطن العربي مؤسسة مسؤولة وحرة وفاعلة تساهم في البناء من خلال الكشف عن الحقائق وتوفير منابر للرأي والرأي الآخر؟ لماذا لا تُعطى المؤسسة الإعلامية الإمكانيات اللازمة حتى تلعب دورها الإستراتيجي والفعال في المجتمع؟ لماذا يُنظر دائما للمؤسسة الإعلامية على أنها خطر ومصدر مشاكل عديدة ومتنوعة للسلطة؟ لماذا لا يحظى الصحافي بالثقة ولا يعطى الوسائل والظروف اللازمة حتى يؤدي رسالته على أحسن ما يرام ويقوم بمهمة الإعلام والإخبار والتحقيق والكشف عن المساوئ والسلبيات والأمراض الاجتماعية بمختلف أنواعها وأشكالها ومهما كان صاحبها ومصدرها بكل حرية ومسؤولية وشجاعة؟. والغريب في كل هذا أن في الكثير من الدول العربية نجد القادة وكبار السياسيين وأصحاب السلطة والنفوذ يتغنون بحرية الصحافة ويطالبون بالحاجة الماسة إليها ودورها الاستراتيجي في المجتمع وهم من الأوائل الذين يعملون على تكميم وتقييد المؤسسات الإعلامية والسيطرة عليها بمختلف الطرق والوسائل والأساليب والآليات. يقف أهل المهنة والمهتمون بشؤونها والدارسون والباحثون في علاقة السلطة بوسائل الإعلام وحرية الصحافة عند المشكلات والعراقيل والتصفيات الجسدية والاغتيالات وغيرها من المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون في مختلف دول العالم، لتحديد بؤس حرية الصحافة وانعدامها في معظم الدول العربية. مراجعة الذات وتقييم الوضع في الوطن العربي تستوقفنا عند أوضاع الصحفي وما آلت إليه الممارسة الإعلامية، وهل تغيّرت الأحوال والظروف وهل تحسنت أوضاع حرية الصحافة بعد الوعود بالحرية والديمقراطية وتحسين قوانين وتشريعات المهنة والقائمين بالاتصال؟ أم بقيت على حالها أم إنها زادت سوءا وتدهورا. من دون أدنى شك، العالم العربي بحاجة إلى إعلام حر قوي وفعال وبحاجة إلى إعلاميين أكفاء ومؤهلين للقيام بدورهم الاستراتيجي في المجتمع على أحسن وجه. هذا يعني أن المؤسسة الإعلامية والصحافي بحاجة إلى مناخ ديمقراطي وإلى قوانين شفافة وواضحة تحمي المهنة والصحفيين من المتطفلين والانتهازيين الذين يستعملون المنابر الإعلامية لتشكيل الرأي وتكييف وفبركة الحقيقة حسب مصالحهم وأهدافهم. تعتبر حرية الصحافة والديمقراطية وجهين لعملة واحدة، فلا نظام ديمقراطيا بدون منظومة إعلامية قوية وفاعلة ومشاركة في الحياة السياسية وعملية اتخاذ القرار. وأهم العراقيل التي تقف حاجزا أمام حرية الصحافة في معظم الدول العربية والدول النامية القوانين الجائرة والصارمة التي تحد من إبداع الصحافي ومن عطائه، أضف إلى ذلك أن معظم قوانين النشر والمطبوعات وتشريعات الصحافة تفرض على القائم بالاتصال ممارسة الرقابة الذاتية أو الحذف الذاتي وهكذا تصبح الآلة الإعلامية عالة على المجتمع بدلا من أن تكون عنصرا فعالا تسهم في محاربة الآفات الاجتماعية وتشارك في تنوير الرأي العام وإشراكه في الحسم في القضايا المهمة والعديدة في المجتمع، وهكذا تصبح المؤسسة الإعلامية حبيسة مكبلة في يد القلة الحاكمة التي تجعل منها المنظر لشرعيتها ولقراراتها وسياساتها سواء كانت صائبة أم مخطئة والمشرع لبقائها واستمرارها. حرية الصحافة ترتبط كذلك بالكثير من المعطيات والمستلزمات التي يجب أن تتوفر في المجتمع ومن هذه المستلزمات فلسفة ونظرة السلطة والمجتمع لوسائل الإعلام، كذلك النضج السياسي والممارسة السياسية لدى الشعب، وكذلك وجود الجمعيات السياسية القوية وجماعات الضغط والمجتمع المدني والفصل بين السلطات وسيادة القانون. تكمن جدلية حرية الصحافة والديمقراطية أساسا في أن الأخيرة تقوم أساسا على الاتصال السياسي وحرية التعبير والفكر وصناعة الرأي العام التي تقوم على التدفق الحر للآراء والمعلومات والمعطيات، الأمر الذي لا يتحقق إلا بوجود إعلام يراقب وينتقد ويكشف ويحقق. فالأطراف الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بحاجة إلى وسائط إعلامية ومنابر للمعارضة والاختلاف في الرأي، والتعبير عن وجهات النظر المختلفة... الخ. إن أي تراجع في حرية الصحافة يعني تراجعا في الديمقراطية وتاريخ حرية الصحافة في العالم يؤكد فكرة التأثير المتبادل بين الديمقراطية والصحافة. فالأنظمة السياسية الديكتاتورية أو السلطوية لا يمكنها أن تفرز صحافة قوية تعكس نبض الشارع وهموم ومشاكل الجماهير، بل تنتج صحافة تكون بعيدة كل البعد عن الشارع وعن واقع الجماهير العريضة في المجتمع. ونفس الشيء يمكن قوله عن تلك الأنظمة التي لا تؤمن بالتعددية الحزبية والتداول على السلطة وحرية الرأي والتعبير. فصحافة هذه الأنظمة تكون دائما أحادية الاتجاه تخدم من يشرف عليها ويمولها ويسيطر عليها وتتفنن في التملق والمدح والتسبيح. إلى متى تبقى قوانين النشر والمطبوعات وقوانين الإعلام في الوطن العربي جائرة ومستبدة؟ إلى متى تبقى هذه القوانين والتشريعات قوانين عقوبات وإجراءات تعسفية ضد الصحافي الذي لا حول ولا قوة له؟ فهذه القوانين كان من المفروض أن تنظر في الجهات التي تحتكر الكلمة والصوت والصورة للاستغلال والتزييف والتملق والتهميش وتعاقبها، هذه القوانين كان من المفروض أن تضع الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تتجاوزها السلطة السياسية والمالية في التحكم والتلاعب بالمؤسسات الإعلامية كما تشاء ووفق مصالحها وأهدافها. ما زالت السلطة في الدول العربية تنظر إلى المنظومة الإعلامية والمؤسسة الإعلامية على أنها أداة لتثبيت شرعيتها وبسط نفوذها وتمرير خطابها السياسي بعيدا عن طموحات الجماهير ومطالبهم. السلطة في الوطن العربي فشلت في بناء المؤسسات اللازمة لضمان المشاركة السياسية الفاعلة ولضمان رأي عام قوي وفعّال. وكنتيجة حتمية لكل هذا فإنها فشلت كذلك في بناء نظام إعلامي إيجابي وفعال وليس سلبيا ومفعولا به، نظام إعلامي يؤمن بالاتصال الأفقي ويعمل على إشراك مختلف الشرائح الاجتماعية في العملية السياسية وفي اتخاذ القرار، نظام إعلامي همّه الوحيد هو كشف الأخطاء والعيوب وتقديم الحقيقة للرأي العام وليس التلميع والتملق والتنظير للسلطة السياسية والمالية. وما دامت ثقافة الرقابة والرقابة الذاتية ما زالت سائدة ومنتشرة في ربوع الوطن العربي فلا مجال للكلام عن حرية الصحافة وعن السلطة الرابعة. يحتاج النظام الإعلامي العربي الراهن إلى نظرة نقدية جادة مع نفسه كما يحتاج إلى مراجعة مع الذات وهذا للوقوف على السلبيات والتعلم من الأخطاء والهفوات السابقة للانطلاق بخطى قوية وإيجابية نحو مستقبل لا يكون فيه الإعلام وسيلة للسيطرة والتحكم والتلميع والتملق والتنظير وإنما وسيلة للحرية والعلم والمعرفة والتفكير والإبداع والاختلاف في الرأي ومنبرا لسوق حرة للأفكار. تحديات الألفية الثالثة كبيرة وجسيمة وتتطلب إعلاما قويا وصناعات إعلامية وثقافية قوية وفاعلة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فحرية الصحافة هي أساس كل الحريات وهي حجر الأساس لأي بناء ديمقراطي في المجتمع. mkirat@qu.edu.qa
2649
| 09 نوفمبر 2019
يجد المواطن الجزائري نفسه في حيرة ودهشة وهو يشاهد النشرة الرئيسية للأخبار عند الساعة الثامنة مساءً. تقارير عن انتخابات 12 ديسمبر وشهادات لمواطنين من مختلف الأعمار تؤكد أهمية الانتخابات وواجب التصويت والذهاب إلى صناديق الاقتراع، حيرة ودهشة لأن ما شاهده في النشرة ويشاهده كل مساء خلال الأسابيع الماضية شيء، وواقع الحراك كل يوم جمعة ومسيرات الطلبة كل يوم ثلاثاء شيء آخر. مئات الآلاف من الجزائريين ترفض الذهاب للانتخاب يوم 12 ديسمبر وتطالب بالتخلص من بقايا نظام بوتفليقة، والتلفزيون الرسمي الجزائري يصر على أن الجميع مع الانتخابات والحل الوحيد للأزمة هو تنفيذ تعليمات قائد الأركان أحمد قايد صالح الذي سكن التلفزيون واصبح هو الآمر والناهي والمدبر والحاكم في البلاد. ما يعيشه المشاهد الجزائري هذه الأيام مع التلفزيون الرسمي تعيشه مئات الملايين من المشاهدين في أرجاء المعمورة: الواقع شيء وما تقدمه وسائل الإعلام شيء آخر. لا يتلقى الجمهور صورة كاملة في غالب الأحيان عن المشهد السياسي، بل يحصل بدلا عن ذلك على سلسلة منتقاة للغاية من الومضات أو اللمحات وتكون النتيجة في النهاية تشويه الواقع، وحسب والتر ليبرمان هناك تضارب بين الديمقراطية والممارسة الإعلامية اليومية، حيث إن وسائل الإعلام لا تقدر على تأدية وظيفة التنوير العام، لا تستطيع وسائط الإعلام تقديم الحقيقة بموضوعية، لأن الحقيقة شخصية وتستوجب الكثير من الدقة والتمحيص والتفسير والتأكد، الأمر الذي لا تسمح به صناعة الأخبار التي تتطلب السرعة الكبيرة والمواعيد الدقيقة التي لا ترحم. فحسب والتر ليبرمان، الجمهور لا يحصل على صورة كاملة ووافية وشاملة للمشهد السياسي؛ بل يتلقى بدلا من ذلك مجموعة أو سلسلة من الومضات أو اللمحات التي تفبرك هذا المشهد السياسي أكثر مما تعكسه. وبذلك يفبرك الواقع ويُقدم للرأي العام بالتناغم والتناسق مع مصالح القوى السياسية والاقتصادية في المجتمع، يستنتج ليبرمان أن وسائل الإعلام تعيق الديمقراطية أكثر مما تخدمها لأن الديمقراطية تقوم على السوق الحرة للأفكار وعلى الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي فشلت وتفشل وسائل الإعلام في تحقيقه على أرض الواقع. بالنسبة لرجال السياسة تعتبر وسائل الإعلام الوسيط المحوري والإستراتيجي للوصول إلى الجماهير العريضة للتأثير فيها وتكوين وتشكيل الرأي العام الذي يتبنى آراءهم وأفكارهم ووجهات نظرهم وبذلك برامجهم. فالسياسي الناجح هو ذلك الذي يحسن التعامل مع وسائل الإعلام والذي يعرف كيف يمرر خطابه السياسي عبر وسائل الإعلام بلباقة وبمهنية عالية، فالعلاقة بين وسائل الإعلام والحياة السياسية تشكل عنصراً هاماً من عناصر فهم الرهانات المرتبطة بتطور الديمقراطيات العصرية. تؤثر وسائل الإعلام في الحكام والمحكومين، فوسائل الإعلام تغير القوانين التقليدية للعبة الديمقراطية. فسمعة السياسي تحددها بدرجة كبيرة الصورة التي يكونها ويصنعها لنفسه من خلال وسائل الإعلام، هذه الصورة يجب أن تكون متناغمة ومتناسقة مع الصورة المقدمة والصورة التي تدركها الحشود والجماهير، فإدارة الصورة تعتبر ظاهرة رئيسية ومحورية في جعل الحياة السياسية ظاهرة إعلامية، أي تتناولها وتناقشها وسائل الإعلام باهتمام بالغ وبتركيز كبير، من جهة أخرى نلاحظ أن التغطية الإعلامية لنشاط السياسيين وعملهم اليومي تترك آثاراً كبيرة على الجماهير والمتتبعين للفعل السياسي الذين يقومون بمتابعة نشاط السياسيين ومدى تطابق أقوالهم مع أفعالهم. وحسب ليبرمان Lippmann فإن الأخبار لا تعكس الحقيقة بل تفبرك الواقع: الأخبار والحقيقة ليسا نفس الشيء، ولابد من التمييز بينهما، فوظيفة الأخبار هي الإشارة إلى حادثة، ووظيفة الحقيقة هي إظهار الحقائق المخفية وربط الواحدة منها بالأخرى، ورسم صورة للحقيقة يستطيع الناس أن يتصرفوا بناء عليها. إن دراسة علاقة وسائل الإعلام بالسياسة تقودنا إلى مساءلة علاقة تطور وسائل الاتصال بتشكيل الرأي العام، وإلى أي مدى تساهم وسائل الإعلام في إيجاد فضاء عام لمناقشة الأفكار والآراء والأطروحات من قبل الجميع؟ أم أن هناك قوى محدودة جدا تسيطر على الفضاء العام وتحتكره لنفسها لتمرير أفكارها ووجهات نظرها. ما هي العلاقة بين وسائل الإعلام واستطلاع الرأي العام؟ بالنسبة لبيار بورديو Pierre Bourdieu الرأي العام لا يوجد وأن الرأي العام الذي يدعيه أصحاب مراكز سبر الآراء والصحافيون ما هو إلا إشكاليات متعلقة بمصالح سياسية تقوم أساسا على عدد معين من المسلمات المغلوطة والخاطئة. أولا باستطاعة أي شخص أن يكوّن رأيا حول موضوع؛ ثانيا كل الآراء تكتسي نفس القيمة؛ وأن هناك تفاهما حول الأسئلة التي تستحق الطرح، فنتائج سبر الآراء التي تبثها وتنشرها وسائل الإعلام، ما هي في حقيقة الأمر، سوى فبركة اصطناعية لمنتج تم استخراجه من حسابات إحصائية لجمع آراء أشخاص لفرض وهم اسمه الرأي العام، تثير أطروحة بوردي تساؤلاً كبيراً جداً وخطيراً في نفس الوقت، يتعلق بالمصداقية العلمية لاستطلاعات الرأي العام وبثباتها وبمفهوم الرأي العام كمصطلح وكظاهرة اجتماعية وسياسية. أصبحت وسائل الإعلام، على حد قول بوردي وشابان، محكمة الرأي حيث أصبح الواقع يتحدد ويتلخص فيما تنقله وسائل الإعلام وتناقشه وتحلله وفق ما يراه الصحافيون ومحترفو صناعة الرأي العام صالحا ومؤهلا لأن ينقل إلى عيون ومسامع القراء والمشاهدين والمستمعين. وحسب نظرية تحديد الأولويات Agenda Setting فإن وسائل الإعلام من جرائد ومجلات ومحطات إذاعية وتلفزيونية تحدد للجمهور ماذا يقرأ ويسمع ويشاهد ليس هذا فقط وإنما تحدد له كذلك كيف ينظر ويحلل وفي أي إطار يدرك ويفهم الأحداث والوقائع التي تُقدم له. توجد علاقة متبادلة بين الرأي العام والفضاء العام، فالرأي العام كمصطلح ظهر في القرن الثامن عشر. من جهة أخرى أدت التغييرات السياسية المترتبة على نهاية الملكية المطلقة إلى ظهور مصطلح الفضاء العام. نشأ الفضاء العام إذن في القرن الثامن عشر في الصالونات والمقاهي والنوادي والدوريات التي كانت تمثل حلقة الوصل بين القراء والمؤلفين والمستمعين أي بعبارة أخرى النخبة المثقفة القادرة على الحوار والنقاش. وبهذا المنطق كان الشعب مقصى من الفضاء العام نظرا لعدم قدرته على مناقشة المسائل الأدبية والفنية والسياسية والاقتصادية وغيرها. هذا الفضاء بدأ ينهار شيئا فشيئا في القرن العشرين، حيث انتقل الأمر من جمهور يناقش الثقافة إلى جمهور يستهلكها، إن تطور ثقافة الاستهلاك والتسويق والإعلان وبعد ذلك العلاقات العامة أدى إلى تدهور وتفكك وانهيار الفضاء العام المعاصر. أدى المجتمع الجماهيري والصبغة المركنتيلية التجارية والتسويقية لوسائل الإعلام وكذلك النموذج العصري للعلاقات العامة إلى تغيير الفضاء العام. ما هو دور وسائل الإعلام؟ هل هو دعم الفضاء العام حيث يتبادل أفراد المجتمع أفكاراً وأحكاماً وحججاً رشيدة وعقلانية ومنطقية من أجل الصالح العام، أم أن دور وسائط الإعلام، كما يرى "هابرماس" هو تذويب القيم الديمقراطية والقضاء عليها؟. mkirat@qu.edu.qa
1501
| 02 نوفمبر 2019
بعد مرور أكثر من 7 شهور على الحراك يتساءل المواطن الجزائري عن مصير الانتخابات الرئاسية التي تأجلت مرتين ومبرمجة يوم 12 ديسمبر 2019 رغم أن الحراك ما زال مستمرا الجمعة تلو الأخرى وما زال رافضا لتعليمات السلطة المتمثلة في قائد الأركان أحمد قايد صالح. فإذا استمرت الأمور على هذه الحال فهذا يعني أن المسار الديمقراطي في الجزائر لم يأخذ النهج الصحيح وكأن التاريخ يعيد نفسه. فمعظم الشخصيات التي كان يعول عليها الشارع لتترشح لرئاسيات 2019 رفضت الترشح نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة وهذا ما يذكرنا بانتخابات 1999 عندما انسحب 6 مترشحين للرئاسيات عشية الانتخابات وتركوا المجال لمرشح الجيش آنذاك عبد العزيز بوتفليقة الذي خاض الانتخابات بمفرده واستلم الحكم واستمر فيه لمدة 20 سنة. هل التاريخ يعيد نفسه؟ وهل عدم تطابق رؤية وأطروحات السلطة والحراك سيعرقل المسار الديمقراطي في الجزائر. قراءة نقدية لتصرف السلطة في الأسابيع الأخيرة يبرز عدة مؤشرات تتناقض جملة وتفصيلا مع الديمقراطية واحترام الحريات الفردية والرأي والرأي الآخر كاعتقال المشاركين في الحراك وسجن بعض من رموزه واستخدام المؤسسات الإعلامية العامة لفرض أجندة السلطة والمؤسسة العسكرية. أما بالنسبة لأحداث 5 أكتوبر 1988 فرغم أنها أفرزت التعددية السياسية والتعددية الإعلامية فإنها جاءت بالعشرية السوداء التي راح ضحيتها 200 ألف شخص ناهيك عن خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات. وفي الأخير جاء العسكر ببوتفليقة ليحكم لمدة عشرين سنة ولتعيش الجزائر في عهدته شتى أنواع الاختلاسات والفساد والتجاوزات. فبدلا من أن تفرز أحداث أكتوبر الحكم الراشد والديمقراطية والعدالة الاجتماعية جاءت بأسوأ رئيس عرفته البلاد منذ استقلالها. فبعد مرور 31 سنة على أحداث الخامس من أكتوبر 1988 يستحضر الجزائريون هذه الأيام في هذه المناسبة وكلهم أسئلة وفضول عما تحقق من مطالبهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تحقق من فرص عمل وعدالة اجتماعية وديمقراطية وممارسة سياسية ومشاركة في صناعة القرار. شباب 1988 علق آمالا كبيرة على تحسين ظروف معيشته من خلال منصب عمل ومسكن. لا يستطيع أحد إنكار أن أحداث 1988 أدخلت الجزائر عهد التعددية السياسية والتعددية الإعلامية. فأصبح هناك أكثر من 60 حزبا تمثل أقصى اليمين وأقصى اليسار مرورا بالأحزاب الإسلامية. أحداث 5 أكتوبر 1988 ما زالت عالقة في أذهان معظم الجزائريين. بداية الأحداث وتداعياتها ماثلة إلى اليوم في أذهان الشعب الجزائري. تظاهر الآلاف من الجزائريين آنذاك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بسبب تدهور أسعار النفط التي شهدها العالم سنة 1986. وأجبرت الأحداث الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك على التعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية، توجت بدستور23 فبراير 1989، مما سمح بتأسيس أكثر من ستين حزبا سياسيا، وإنهاء حكم الحزب الواحد. ورغم أن هذه الأحداث توجت بإصلاحات غير مسبوقة، فقد تم الالتفاف على الإصلاحات من طرف السلطة تدريجيا، ولم تستطع المعارضة تغيير طبيعة ومكونات النظام الحاكم، حيث بقيت رموز الحزب الواحد ضمن أهم مكوناته. الذكرى 31 من أحداث الخامس أكتوبر ألف وتسع مائة وثمانية وثمانين تعتبر أول انتفاضة شعبية شهدتها الجزائر منذ الاستقلال. 5 أكتوبر شهد سقوط العديد من القتلى وإصابة الآلاف من الجزائريين واعتقال آخرين وقد مهدت هذه الأحداث بتعديل دستور جديد أقر التعددية الديمقراطية. بداية الثمانيات تهاوت أسعار النفط من 37 دولارا وصولا عند 14 دولارا للبرميل سنة 1986، سنتان بعدها كانت كافية للجزائريين ليعلنوا عدم قدرتهم الاحتمال، بفعل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي عاشوها، أيام فقط سقط فيها 200 شخص أو أكثر نتيجة المواجهات بين المحتجين والشرطة. إن الأسباب التي دفعت الشباب للانتفاضة قبل 31 عاما لا تزال قائمة لحد الساعة مع الأسف الشديد، فمعدلات البطالة والفقر ومرارة الظلم والقهر الذي يشعر به المواطن الجزائري ما زالت قائمة بل تعددت وتنوعت وزادت أما النظام السياسي فتمكن من الالتفاف على مكتسبات انتفاضة أكتوبر، والتكيف مع التحولات الإقليمية والعالمية، مع استمراره في الممارسات ذاتها التي كانت قبل أحداث أكتوبر 1988. لكن رغم تشابه الأوضاع فانتفاضة جديدة في الجزائر مستبعدة هذه الأيام لعدة اعتبارات من أهمها: تجربة العشرية السوداء التي أدت إلى مقتل 200 ألف شخص، تضرر منها تقريبا كل بيت جزائري أما الاعتبار الثاني فيتمثل فيما آلت إليها الأوضاع في دول الربيع العربي من حروب وأزمات بدون تحقيق رغبات الشباب والطبقات المحرومة. فالتغيير في الجزائر يجب أن يحدث من الداخل ولا يتم إلا عن طريق معارضة قوية أي أحزاب سياسية قوية ومجتمع مدني نشط وفعال. النظام ما زال يراوح نفسه وما زال يكرر آليات السيطرة والحكم التي آلفها منذ الاستقلال. من جهة أخرى استفاد النظام من الشرعية الأمنية في مكافحة الإرهاب والنجاح في التصدي لاختراقات التنظيمات الإرهابية للبقاء والاستمرار. مرت 31سنة على أحداث 5 أكتوبر هذه الأحداث، التي خلفت مئات القتلى ومئات الجرحى والموقوفين والتي شكلت نقطة تحول في تاريخ الجزائر. وخرج في ذلك اليوم الشباب الجزائري إلى شوارع العاصمة للمطالبة بالحرية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والسياسية، ليتزعزع النظام من داخله. وفي فبراير 1989 تم اعتماد دستور جديد أقر بالتعددية السياسية. فهل كانت ثورة عربية قبل الأوان؟ حسب المختصين، الربيع الجزائري لم يحدث بعد غير أن مؤشراته بادية للعيان، وحجمه سيكون أكثر بكثير مما عرفته الجزائر في تسعينيات القرن الماضي أو ما عاشته تونس أو مصر أو ليبيا مؤخرا. الجزائر تعيش منذ أحداث أكتوبر ما يشبه تلك الأحداث مما يؤكد أن النظام في جوهره لم يتغير قيد أنملة وأن أسباب الانفجار قائمة أكثر من أي وقت مضى. وفي خطة للتقليل من شأن الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، لم يفوّت الساسة الجزائريون أي فرصة لوصف أحداث 5 أكتوبر الدموية بأنها «ربيع عربي» سابق لأوانه. لكن ربيع عربي جاء بنظام حكم أقل ما يقال عنه أنه لا علاقة له بالحكم الراشد والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هل ستكون نتائج الحراك الذي تشهده الجزائر منذ أكثر من 7 شهور هي نفس نتائج 5 أكتوبر 1988؟ المؤسسة العسكرية التي جاءت ببوتفليقة سنة 1999 هي نفسها التي تدير وتأمر وتحكم سواء علنا أو من وراء الكواليس. mkirat@qu.edu.qa
2637
| 12 أكتوبر 2019
يمثل الفضاء العام حركة إدماج وتمجيد الحريات الفردية والتعبير عن الآراء وتمكين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والدينيين والثقافيين من الحوار والنقاش والاختلاف أمام الجميع وأمام الملأ. فالصحافة والإذاعة والتلفزيون والانترنت ما هي إلا منابر ووسائل لتبادل الأفكار والآراء بين أفراد المجتمع وهي بذلك القنوات الإستراتيجية للفضاء العام. حسب برنار مياج Bernard Miege مرت المجتمعات الديمقراطية منذ القرن الثامن عشر بأربعة نماذج للاتصال. تمثل النموذج الأول في صحافة الرأي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أما النموذج الثاني فمثلته الصحافة التجارية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. انفصلت هذه الصحافة عن الآداب وفرض الإعلان نفسه كقوة فاعلة في الصناعة الإعلامية، وأصبحت الصحافة حلقة وصل بين الطبقة السياسية والجماهير مشكّلة بذلك الرأي العام. أما النموذج الثالث فظهر في منتصف القرن العشرين متمثلا في الوسائل السمعية البصرية. اعتمد هذا النموذج التسلية والتشويق وطرق التسويق والترفيه و"الشو بيز" على حساب الجدال والنقاش والحوار المقنع. أما النموذج الأخير فظهر في السبعينيات من القرن الماضي مع الانتشار الواسع للعلاقات العامة التي أصبحت جزءا إستراتيجيا من المؤسسات والإدارات والجمعيات حيث تقوم على فنون ومهارات اقناع واغراء المستهلكين. هذه النماذج ساهمت بطرق مختلفة في اتساع رقعة الجماهير في الفضاء العام وابتعادهم عن مراكز اتخاذ القرار. أصبحت وسائل الإعلام تتحكم في نشر التباين وعدم العدالة في الوصول إلى النقاش العام: حيث نجد أقلية من صناع القرار وصناع الرأي والقائمين بالاتصال يسيطرون على فضاءات الاتصال والتعبير عن آرائهم وطروحاتهم وأغلبية ساحقة تجد صعوبات كبيرة في اسماع صوتها وايصاله إلى وسائل الإعلام ومن ثم إلى الفضاء العام. إن دراسة علاقة وسائل الإعلام بالسياسة تقودنا إلى مساءلة علاقة تطور وسائل الاتصال بتشكيل الرأي العام. والى أي مدى تساهم وسائل الإعلام في ايجاد فضاء عام لمناقشة الأفكار والآراء والأطروحات من قبل الجميع؟ أم أن هناك قوى محدودة جدا تسيطر على الفضاء العام وتحتكره لنفسها لتمرير أفكارها ووجهات نظرها. ما هي العلاقة بين وسائل الاعلام واستطلاع الرأي العام، والرأي العام؟ بالنسبة لبيار بورديوPierre Bourdieu الرأي العام لا يوجد وان الرأي العام الذي يدعيه أصحاب مراكز سبر الآراء والصحفيون ما هو إلا إشكاليات متعلقة بمصالح سياسية تقوم أساسا على عدد معين من المسلمات المغلوطة والخاطئة. أولا باستطاعة أي شخص أن يكوّن رأيا حول موضوع؛ ثانيا كل الآراء تكتسي نفس القيمة؛ وأن هناك تفاهما حول الأسئلة التي تستحق الطرح. فنتائج سبر الآراء التي تبثها وتنشرها وسائل الاعلام، ما هي في حقيقة الأمر، سوى فبركة اصطناعية لمنتج تم استخراجه من حسابات احصائية لجمع آراء أشخاص لفرض وهم اسمه الرأي العام. تثير أطروحة بورديو تساؤلا كبيرا جدا وخطيرا في نفس الوقت، يتعلق بالمصداقية العلمية لاستطلاعات الرأي العام وبثباتها وبمفهوم الرأي العام كمصطلح وكظاهرة اجتماعية وسياسية. أصبحت وسائل الاعلام، على حد قول بورديو وشامبان، محكمة الرأي حيث أصبح الواقع يتحدد ويتلخص فيما تنقله وسائل الاعلام وتناقشه وتحلله وفق ما يراه الصحفيون ومحترفو صناعة الرأي العام صالحا ومؤهلا لأن ينقل إلى عيون ومسامع القراء والمشاهدين والمستمعين. وحسب نظرية تحديد الأولويات Agenda Setting فان وسائل الاعلام من جرائد ومجلات ومحطات اذاعية وتلفزيونية تحدد للجمهور ماذا يقرأ ويسمع ويشاهد ليس هذا فقط وإنما تحدد له كذلك كيف ينظر ويحلل وفي أي إطار يدرك ويفهم الأحداث والوقائع التي تُقدم له. توجد علاقة جدلية بين الرأي العام والفضاء العام. فالرأي العام كمصطلح ظهر في القرن الثامن عشر. من جهة أخرى أدت التغييرات السياسية المترتبة على نهاية الملكية المطلقة الى ظهور مصطلح الفضاء العام. نشأ الفضاء العام إذن في القرن الثامن عشر في الصالونات والمقاهي والنوادي والدوريات التي كانت تمثل حلقة الوصل بين القراء والمؤلفين والمستمعين أي بعبارة أخرى النخبة المثقفة القادرة على الحوار والنقاش. وبهذا المنطق فالشعب مقصى من الفضاء العام نظرا لعدم قدرته على مناقشة المسائل الأدبية والفنية والسياسية والاقتصادية وغيرها. هذا الفضاء بدأ ينهار شيئا فشيئا في القرن العشرين حيث انتقل الأمر من جمهور يناقش الثقافة الى جمهور يستهلكها. ان تطور ثقافة الاستهلاك والتسويق والاعلان وبعد ذلك العلاقات العامة أدى الى تدهور وتفكك وانهيار الفضاء العام المعاصر. أدى المجتمع الجماهيري والصبغة المركنتيلية التجارية والتسويقية لوسائل الاعلام وكذلك النموذج العصري للعلاقات العامة الى تغيير الفضاء العام. ما هو دور وسائل الإعلام؟ هل هو دعم الفضاء العام حيث يتبادل أفراد المجتمع أفكارا وأحكاما وحججا رشيدة وعقلانية ومنطقية من أجل الصالح العام، أم أن دور وسائط الاعلام، كما يرى "هابرماس" هو تذويب القيم الديمقراطية والقضاء عليها؟ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو إلى أي مدى ساهمت وتساهم تكنولوجيا وسائل الاعلام والاتصال في اتساع واثراء الفضاء العام وما هي تأثيراتها سواء كانت ايجابية أم سلبية على ادماج الجميع في هذا الفضاء؟ أدت تكنولوجيا وسائل الاعلام والاتصال بصفة عامة الى تأثيرات أربعة تمثلت فيما يلي: "تقنية" العلاقات تقوم على استخدام الآلات والأجهزة حيث أصبحت العلاقات تقوم عن طريق الهاتف النقال أو الانترنت بصفة سريعة وعملية جدا ؛ "تسليع" جعل الاتصال سلعة وتجارة تقوم على مبدأ العرض والطلب والاغراء ومختلف تقنيات التسويق والاعلان والبيع والشراء؛ "تجزئة" الجمهور حيث أصبحت هناك وسائل اتصالية جد متخصصة تهدف الى تلبية الاحتياجات الخاصة بكل فئة محددة من فئات الجمهور العريض؛ وأخيرا "عولمة" الإعلام التي أدت الى توحيد الخطاب والقيم والمعايير على حساب خصوصيات الدول والثقافات والحضارات. يبقى أن نقول إنه بفضل وسائل الاتصال التفاعلية التي تتمثل في التليفون النقال والإنترنت نستطيع أن نستبشر خيرا بغدٍ أفضل للاتصال الديمقراطي رغم التحفظات الكبيرة والمتعلقة بالفجوة الكبيرة بين الشمال والجنوب وبين الذين يملكون والذين لا يملكون على المستوى العالمي وعلى مستوى كل دولة. من جهة أخرى يرى النقاد أن استخدامات الانترنت تميل نحو الاستهلاك وثقافة التهميش والتسطيح والانسلاخ والانجراف والذوبان في ثقافة الآخر أكثر منها نحو الأمور الجادة والمشاركة السياسية والمساهمة في صناعة القرار. mkirat@qu.edu.qa
2012
| 28 سبتمبر 2019
يتساءل الكثيرون عن واقعية وموضوعية مخرجات الوسائل الإعلامية وإلى أي مدى تعكس هذه الرسائل الواقع كما هو أم أنها تشكله وتبنيه و"تفبركه" وفق أطر ومرجعيات واتفاقيات محددة، ففي بعض الأحيان يقدم الحدث من زوايا مختلفة وبرؤى متناقضة وكأن الأمر يتعلق بحدثين مختلفين تماما، تعامل وسائل الإعلام مع الحروب يثير عدة تساؤلات وملاحظات، من أهمها أن الإعلام بصفة عامة والصورة بصفة خاصة أصبحا جزءاً لا يتجزأ من الحرب نفسها، ما قدمته وسائل الإعلام أثناء الاعتداء الصهيوني على لبنان لا يخرج عن هذه القاعدة. وحسب إدوارد سعيد فإن التشويه والتضليل والانحياز في تغطية الحرب من قبل وسائل الإعلام الغربية يعود بالدرجة الأولى إلى الصراع الحضاري والثقافي بين الغرب والإسلام، وقد ظهر هذا الصراع جليا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانهيار القطبية الثنائية، حيث ظهر النظام الدولي الجديد وتحديه للثقافات المختلفة في العالم وخاصة الإسلام، وجاء مصطلح "الإسلاموفوبيا" للتعبير عن الهستيريا التي أصيب بها الغرب ضد الإسلام بعد انهيار الشيوعية، حيث أصبح هذا الأخير يتصدر قائمة أعداء أوروبا وأمريكا، وأكدت دراسات تحليل المضمون أن كتب التاريخ المدرسية وكتب الاجتماعيات في المدارس الأمريكية أسهمت بدورها في إيجاد فكر باطني معادٍ لكل ما هو إسلام وعرب، وكانت النتيجة أن الأمريكي يتعرض منذ نعومة أظافره إلى جملة من الصور النمطية ومن الأفكار المضللة والمزيفة ضد كل ما هو عربي ومسلم. في ظل هذا التزييف والتشويه والتغطية السلبية للعرب من قبل الإعلام الغربي نلاحظ أزمة في الإعلام العربي في عملية تسويق صورة إيجابية وصورة تصّحح هذا الخلل، فالإعلام العربي لم يحدد إستراتيجية يستطيع من خلالها تقويم هذا الخطأ وتقديم البديل أو البدائل للرأي العام الغربي والدولي، فالصناعات الثقافية العربية ما زالت ضعيفة جدا لم ترقِ إلى العالمية ولم تعرف كيف توّظف اللغات العالمية للوصول إلى الآخرين. والإعلام العربي كما لا يخفى على أحد يتخبط في دوامة من المشاكل والضغوط قد لا تؤهله للقيام بدور فعّال على الصعيد الدولي، أضف إلى ذلك أن الأنظمة العربية ركّزت جهودها في استخدام الإعلام كوسيلة للسلطة وتثبيت الشرعية والتحكم والمراقبة، ولم تولِ أي اهتمام للبعد الخارجي أو الدولي الذي من المفروض أن يكون من المهام الإستراتيجية للنظام الإعلامي في كل دولة عربية. شهدت الساحة العربية والعالمية خلال السنوات القليلة الماضية أحداثاً مهمة تفاعلت معها وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم بطرق مختلفة وفي بعض الأحيان يتبادر للقارئ أو المشاهد أن الحدث مختلف رغم أنه نفسه، لكن عملية النظر إلى الحدث ومعالجته وتحليله وتقديمه للجمهور هي التي اختلفت، وبذلك يكاد الحدث نفسه يختلف رغم أنه واحد، وسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين أصبحت "تفبرك" الواقع أكثر مما تقدمه للجمهور كما هو. وفي الصناعة الإعلامية الكلام عن الموضوعية و البراءة وتقديم الأشياء والأحداث والحروب والأزمات كما هي يعتبر ضرباً من الخيال، وسائل الإعلام وبفضل المكانة الإستراتيجية التي تحتلها في المجتمع وبفضل قوتها في تشكيل الرأي العام وفي إعلام وإخبار الجماهير بما يحدث ويجري من حولهم وفي العالم بأسره أصبحت مؤسسات تستقطب اهتمام القوى الفاعلة – السياسية، الاقتصادية، الدينية، جماعات الضغط، المجتمع المدني - في المجتمع سواء كان محلياً أو دولياً. فوسائل الإعلام في أي مجتمع لا يحركها المال فحسب، بل هناك قوى أخرى تتنافس فيما بينها للاستحواذ والسيطرة عليها من أجل إعلاء كلمتها ووجهة نظرها وإيصالها للرأي العام، لأن في نهاية المطاف السلطة الحقيقة في أي مجتمع يؤمن بالديمقراطية والشفافية هي سلطة الشعب أي الرأي العام، والقوى الإستراتيجية التي تشكل الرأي العام في أي مجتمع هي وسائل الإعلام، حيث أكدت معظم الدراسات، حسب ثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر، أصبحت الثقافة في القرن العشرين صناعة مثلها مثل الصناعات الأخرى تخضع لقوانين العرض والطلب وبذلك قوانين السوق. فالمنتجات الثقافية أصبحت منتجات معلبة تُصنع وفق معايير الإنتاج المتسلسل ووفق أنماط معينة تؤدي في النهاية إلى أحادية الأسلوب والمحتوى، وبذلك اٌختصرت الثقافة في التسلية والاستهلاك العابر - الذي يعمر لفترة زمنية محدودة ثم يزول للأبد، فالصناعات الثقافية أصبحت مرادفة للتلاعب بأذواق الأفراد وحسهم، كما أصبحت نموذجاً للتعليب والتنميط والتسطيح وإفراغ الثقافة من محتواها الحقيقي ومن بعدها الجمالي والإنساني. أفرزت العولمة الليبرالية تداعيات وانعكاسات كبيرة على المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم وأفرغتها من دور الرقابة والسلطة الرابعة والدفاع عن مصالح المحرومين والضعفاء والمساكين في المجتمع من خلال إبراز الحقيقة والبحث عنها بدون هوادة، فالسلطة الحقيقية في المجتمع أصبحت في أيدي حفنة من المجموعات الاقتصادية العالمية وهذه الشركات الكونية يزيد حجمها الاقتصادي أحيانا عن ميزانيات بعض الدول والحكومات، بل مجموعة من الدول والحكومات. فالتطور الجيواقتصادي الذي شهده العالم خلال العقود الأخيرة أدى إلى تغييرات وتطورات حاسمة في الصناعات الإعلامية والثقافية على المستوى العالمي، وبذلك أصبحت وسائل الإعلام الذائعة الانتشار كالصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والشبكات التلفزيونية والإنترنت تتمركز أكثر فأكثر في يد شركات عملاقة مثل "فياكوم" و"نيوزكورب" و"مايكروسوفت" و"برتلسمان"و"يونايتد غلوبال كوم" و"ديزني" و"تلفونيكا" و"آ أو أل تايم وارنر" وجنيرال إليكتريك" وغيرها، هذه الشركات العملاقة أصبحت تملك، وبفضل التوسع الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والمعرفة إمكانات وقدرات هائلة، فالثورة الرقمية قضت على الحدود الكلاسيكية لأشكال الاتصال التقليدية – الكتابة،-الصوت - الصورة وفتحت المجال أمام الإنترنت والوسائط المتعددة والثورة الرقمية التي جسدت مفهوم القرية العالمية في أرض الواقع، وبهذا أصبحت الاحتكارات الإعلامية العملاقة أو المجموعات الإعلامية تهتم بمختلف أشكال المكتوب والمرئي والمسموع، ومستعملة لبث ونشر ذلك، قنوات متعددة ومتنوعة من صحف ومجلات وإذاعات وقنوات تلفزيونية وكوابل وبث فضائي وشبكات البث الرقمي عبر الألياف البصرية والإنترنت. كما تتميز هذه المجموعات ببعدها الكوني العالمي، حيث إنها تتخطى الحدود والدول والجنسيات والثقافات، فهي كونية و عالمية الطابع. وبذلك أصبحت هذه الشركات العملاقة ومن خلال آليات الهيمنة والتمركز تسيطر على مختلف القطاعات الإعلامية في العديد من الدول والقارات وتصبح بذلك الرافد الفكري والأيديولوجي للعولمة الليبرالية، فلا عولمة بدون عولمة وسائل الإعلام الجماهيرية وعولمة الصناعات الإعلامية والثقافية. ويرى إغناسيو راموني، رئيس تحرير "لو موند ديبلوماتيك" في هذا الشأن ما يلي: "فالعولمة هي أيضا وسائل الإعلام الجماهيرية ووسائل الاتصال والأخبار، وفي سياق اهتمامها بتضخيم حجمها واضطرارها لمغازلة السلطات الأخرى فإن هذه الشركات الكبيرة لا تضع نصب أعينها هدفا مدنيا يجعل منها "السلطة الرابعة" المعنية بتصحيح التجاوزات على القانون واختلال العمل بالنظام الديمقراطي سعيا إلى تحسين النظام السياسي وتلميعه. فلا رغبة لهذه الشركات في التحول إلى "سلطة رابعة" أو التصرف كسلطة مضادة". mkirat@qu.edu.qa
1224
| 29 يونيو 2019
أسباب الإرهاب تتحدد في عوامل سياسية، أيديولوجية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية. فالمشاكل التي ظهرت على هذه المستويات مجتمعة أدت إلى ظهور التطرف والإرهاب ورفض الآخر، هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الدولي فهنالك بعض الدول تعمل على إيواء الإرهابيين والبعض الآخر يعمل على استعمال الإرهاب لإضعاف بعض الدول النامية والقضاء على معنوياتها ونشاطاتها حتى يتحكم في مصيرها كما يشاء، أما النوع الثالث فهي تلك الدول التي تمارس إرهاب الدولة مثل الكيان الصهيوني وهذا حتى يضمن بقاءه ويقضي على كل من يقف في طريقه. فالأسباب إذا عديدة ومتشابكة منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي ومنها ما هو أيديولوجي ديني ومنها ما هو اقتصادي، ويمكننا تلخيصها فيما يلي: الأسباب السياسية: أن الإقصاء السياسي وضعف الحريات السياسية وعدم المشاركة السياسية من قبل فئات عريضة من المجتمع والناجمة عن انتشار وسيادة النظم السياسية السلطوية أدت إلى فجوة كبيرة جدًا بين الحاكم والمحكوم وأصبح بذلك المجتمع المدني محرومًا من أدنى حقوقه للتعبير عن مطالب ومشاكل واهتمامات الجماهير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وانعدام المشاركة السياسية للغالبية العظمى للجماهير يؤدي إلى الإقصاء والتهميش ويفتح المجال أمام المؤسسات الحكومية للتلاعب في الفضاء السياسي كما تشاء ومن أجل خدمة حفنة من السياسيين وأصحاب النفوذ والمصالح. الأسباب الأيديولوجية: وترتبط كثيرًا بالأسباب السياسية وتتمحور أساسًا في الخلاف الجذري لرؤية الأمور وغياب مشروع المجتمع أو المشروع القومي، فهنالك العلمانيون الذين يؤكدون على ضرورة فصل الدين عن الدولة، وهنالك من يتسترون وراء الدين ويؤكدون على رؤية كل شيء من منظار ديني لكن بدون تقديم مشروع متكامل لمعالجة القضايا وبناء المجتمع. والفئة الثانية لا تؤمن بالنظام القائم ولا بمؤسساته ولا بسلطته وهذا ما دفع بها للقيام بعمليات إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة وكل رموزها وبعد ذلك ضد أفراد المجتمع. ومما زاد في خطورة الوضع انه في بعض الأحيان ردّ العلمانيون بالإرهاب على العمليات الإرهابية وأصبح المجتمع يدور في حلقة مفرغة خطيرة. الأسباب الاقتصادية: إن فشل المشاريع التنموية في معظم الدول النامية أدى إلى تفشي الفقر والجهل والمشاكل الاقتصادية في المجتمع وهذا نظرًا للزيادة المطردة في عدد السكان وفي احتياجاتهم المتزايدة من مأكل ومشرب وبنية تحتية ومدارس ومستشفيات… الخ، هذه الأمور كلها أدت إلى تفاقم البطالة ومشاكل أخرى تزداد تعقيدا يوما بعد يوم كما أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها معظم الدول النامية من الاقتصاد الموّجه إلى الاقتصاد الحر أدت إلى العديد من المشاكل كتسريح العمال واللجوء إلى الخصخصة التي لا ترحم، إلى غير ذلك من المشاكل. فالفجوة الطبقية الضخمة التي توجد في غالبية الدول النامية تزيد يومًا بعد يوم من غنى الأغنياء وفقر الفقراء وزيادة عدد المهمشين وانعدام الحد الأدنى للحياة الكريمة عند نسبة كبيرة من السكان. فالشباب المهمّش في معظم دول العالم الثالث فقد كل أمل في الحياة وهو المتعلم الجامعي الذي لم يحصل على منصب شغل ولذلك لا يستطيع الحلم لا بمسكن ولا بحياة كريمة ولا بحياة زوجية ونظرًا للعولمة ولعالمية الصور والأنماط الاستهلاكية الغربية ومعيشة وحياة الوفرة والثراء التي تقدمها المسلسلات والأفلام الغربية يصبح المهّمش في العالم الثالث قاب قوسين أو أدنى من التطرف، وإلغاء الآخر وبذلك الإرهاب والثورة ضد كل ما هو قائم في المجتمع. الأسباب الثقافية: تعاني الكثير من الدول النامية من الانفصام الثقافي، والتبعية الثقافية وفي بعض الأحيان من أزمة هوية. وهذه الأمور كلها مجتمعة تؤدي إلى صراع داخل المجتمع إذا لم يكن مبنيًا على التسامح والتفاهم واحترام الرأي الآخر وانعدام المجتمع المدني تكون نتيجته الحتمية تصفية الآخر والتخلص منه. ومن مخلفات الاستعمار وجود نخبة من المثقفين وأشباه المثقفين والتابعين في الدول النامية منسلخة تمامًا تدافع وتمثل مصالح دول المركز، والصراع الثقافي هذا أدى في الكثير من الدول النامية إلى وجود دويلات داخل دولة وهويات ثقافية مختلفة، الأمر الذي انعكس بالسلب على الإنتاج الثقافي وعلى هوية الصناعات الثقافية المختلفة وعلى مخرجات وسائل الإعلام. وهكذا أصبح الخطاب الثقافي يعكس عدة اتجاهات متناحرة ومتناقضة تمثل مختلف التيارات الأيديولوجية والعقائدية والتي لا يربط بينها قاسم مشترك واحد، وهذا ما من شأنه أن يغذي التطرف والحركات الإرهابية حيث إن هذه التيارات الثقافية المختلفة لا تؤمن ببعضها البعض لكن كل واحد منها يعمل على إقصاء الآخر بشتى الطرق والوسائل. ونلاحظ هنا الغياب الكلي للمؤسسة الإسلامية حيث تركت فراغا كبيرًا وأصبح مما هبّ ودبّ يفتي حسب هواياته ومعتقداته ومصالحه الخاصة ضاربا عرض الحائط كل من لا يرى العالم كما يراه هو. الأسباب الاجتماعية: أن فشل المشاريع والخطط التنموية في معظم الدول النامية، والخلل الذي نجم عن هجرة الأرياف إلى المدن، وعدم الاهتمام بتطوير البنية التحية في المناطق الريفية والنائية نجم عنه ظهور الأحياء العشوائية و»الغيتوهات» وتدهور حالة المدن حيث انعدمت فيها مقومات الحياة الكريمة وتفشت فيها الأمراض والأوبئة وتفاقمت فيها أزمة السكن وانعدمت فيها الراحة والطمأنينة والأمان والشروط الأساسية للمدينة الحديثة. أضف إلى ذلك أن الأسباب السالفة الذكر اقتصادية، سياسية، أيديولوجية وثقافية- كلها أدت إلى انتشار وتفشي أمراض اجتماعية خطيرة قضت على مفهوم الأسرة والعائلة والتلاحم الاجتماعي… الخ. هذه الأمور كلها هيأت الظروف لظهور جيل من الشباب حاقد على المجتمع وعلى الدولة والسلطة ومختلف مؤسساتها، جيل مهيأ للعنف والتطرف وإقصاء الآخر في غياب الوسائل والإمكانيات. إن غياب البرامج الاجتماعية في الدول النامية أو استغلالها من قبل الفئات التي ليست بحاجة إليها في واقع الأمر زاد في تفاقم أوضاع الفئات المحرومة في معظم الدول النامية. إفلاس النظام الدولي: يتصف النظام الدولي بسيطرة القوى الفاعلة فيه على باقي البشرية وبذلك فإنه يفتقد القيم والأخلاق والعدالة في العلاقات السياسية الدولية والعلاقات الاقتصادية الدولية. ومع انهيار الثنائية القطبية وبروز الولايات المتحدة كقوة وحيدة على الساحة الدولية وبدون منازع جعل النظام الجديد أو العولمة تثير عدة مشاكل وعدة ردود أفعال مناهضة ومناوئة سواء في الدول النامية أو الدول المتقدمة أو حتى في داخل الولايات المتحدة نفسها. وما يشير إلى خطورة الوضع هو تفاقم الهوة يوما بعد يوم ما بين الأغنياء والفقراء وتراجع مستوى المعيشة في غالبية دول العالم. أصبح الإرهاب في هذا القرن الشغل الشاغل للكثير من الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، والإرهاب قد يهم الغالبية العظمي من الدول وهذا نظرًا لخطورته وسرعة انتشاره وتشابك أسبابه ودواعيه وصعوبة التحكم فيه والسيطرة عليه. إن المنظومة الدولية بأسرها ليست عن منأى عن الإرهاب وانعكاساته الخطيرة، فالإرهاب ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين أصبح يستعمل وسائل تكنولوجية متطورة وأصبح ظاهرة عالمية تمتد خيوطه وقنواته في عدد كبير من العواصم العالمية، كما أصبح الإرهاب جزءا من المافيا العالمية التي تعتمد على المتاجرة في المخدرات وتهريب الأسلحة وغسل الأموال وتزوير الهويات والوثائق وغير ذلك، ولذلك ما يحدث من عمليات إرهابية في دولة ما قد يحدث في أي دولة في العالم وفي أي لحظة، والدليل على ذلك حادثة أوكلاهوما، وحادثة المركز التجاري العالمي بنيويورك، وحادثة مترو باريس، ومترو طوكيو، وأحداث نيويورك وواشنطن الأخيرة والقائمة ما زالت طويلة. وما يعّقد من خطورة ظاهرة الإرهاب سواء على الصعيد المحلي أو الدولي هو تعامل وسائل الإعلام معه، فنلاحظ الاستغلال الكبير للإرهابيين لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها وأشكالها وما من عملية إرهابية إلا وتتصدر نشرات الأخبار التلفزيونية، والصفحات الأولى في الجرائد وهذا من شأنه أن يخدم الإرهابيين بالدرجة الأولى حيث إنهم يصلون بكل سهولة إلى أهدافهم ويتواصلون مع الرأي العام مباشرة وعلى الهواء. وفي غالب الأحيان تخدم وسائل الإعلام الإرهاب أكثر من خدمتها للحقيقة والكشف عن الواقع حيث إن معظمها يعتمد على الإثارة والتسطيح والتبسيط ويتجاهل التعمق في المشكلة وإبراز أسبابها وانعكاساتها وخباياها المختلفة وفي غالب الأحيان يبقى الرأي العام تائها بين الواقع والخيال وبين الحقيقة والواقع. mkirat@qu.edu.qa
1356
| 22 يونيو 2019
الإرهاب ظاهرة القرن الحادي والعشرين بامتياز. أصبح سلاحا مهما يستعمل في السياسة الدولية كما في المطالب الداخلية على مستوى كل دولة، ومن أشهر الأمثلة على ذلك منظمة الباسك في اسبانيا وجبهة تحرير كورسيكا في فرنسا والجيش الإيرلندي الجمهوري في إيرلندا، والقائمة طويلة. وبذلك أصبحت قوى عديدة ومختلفة تستعمل الإرهاب وتمارسه لتحقيق أهدافها ومطالبها ومما زاد الأمر خطورة ما يلي: أن العناصر الإرهابية تستغل مبادئ حقوق الإنسان واللجوء السياسي وتستعمل بعض الدول وخاصة الأوروبية منها كقواعد خلفية لجمع المال وتهريب الأسلحة المختلفة، وتبييض الأموال وبيع المخدرات وغيرها وهذا لجمع الوسائل اللوجيستية للقيام بأعمالها الإرهابية والتخريبية أضف إلى أن وسائل إعلام هذه الدول- وخاصة الغربية منها- تفتح قنواتها الإعلامية المختلفة لهؤلاء الإرهابيين للتجريح والشتم والقذف في بلدانهم باسم الحرية وحقوق الإنسان. ففي السنوات الأخيرة نجد دولا عريقة في الديمقراطية وعانت الكثير من ويلات الإرهاب تؤوي الإرهابيين باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان واللجوء السياسي. وهكذا أصبحت لندن وباريس وبروكسل وبون وواشنطن من العواصم المحبذة للشبكات الإرهابية تأخذ منها قواعد خلفية من أجل تجميع الأموال والسلاح وكل الوسائل الضرورية واللازمة لتنفيذ عملياتها. ونلاحظ هنا أن العديد من الأفغان العرب استقبل بالأحضان في هذه العواصم وغيرها رغم الاحتجاجات المتكررة لدول مثل مصر والجزائر التي عانت الكثير من ويلات الارهاب خلال السنوات الأخيرة. أما بالنسبة لمعايير تصنيف الإرهاب، فنجد الولايات المتحدة الأمريكية تتفنن كل سنة في إصدار قائمة بالدول الإرهابية مثل السودان وسوريا وليبيا واليمن وإيران… الخ، وتتجاهل الربيبة إسرائيل التي تتفنن دائما وتبدع فيما يسمى بإرهاب الدولة وإسرائيل كما لا يخفى على أحد انها تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وضد كل ما هوعربي وإسلامي خارج فلسطين. وهنا نلاحظ دائما انحياز الغرب وإعلامه لإسرائيل ولكل ما هوغربي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هوعلى أي أساس يتم تصنيف الدول بأنها إرهابية وتساند الإرهاب وما هي المقاييس التي تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول في الحكم على هذه الظاهرة. الدول العظمى الفاعلة في النظام الدولى تستعمل الإرهاب علنا سواء ضد الحركات المناهضة والرافضة للنظام داخل الدولة نفسها ويستحضرنا هنا اغتيالات الزعماء الأمريكيين السود أمثال «مالكم إكس» و»مارتن لوثركينج» وغيرهما من زعماء « البلاك بانترز» أو على المستوى الدولى حيث انها تحاصر وتضايق الدول التي تخرج عن طاعتها وتقف أمام مصالحها وهنا نلاحظ التناقض الصارخ على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية، حيث الكيل بمكيالين واستعمال الإرهاب كوسيلة من وسائل الدبلوماسية والتواصل وتجدر الإشارة هنا الى أن « الأفغان العرب « قد تدربوا في أفغانستان بإشراف وكالة المخابرات الأمريكية وبتزكية من بعض الدول وبقيادة تنظيم إرهابي لمحاربة الشيوعية والإطاحة بالاتحاد السوفييتي باسم الإسلام، وعندما انتهت مهمتهم وكللت بالنجاح أرسلوا إلى دولهم للجهاد والإطاحة بالأنظمة القائمة لتأسيس الجمهوريات الإسلامية. والعديد من المختصين والباحثين يتساءلون اليوم/ من وراء القاعدة والنصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها. أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية يمارس داخليا ودوليا للضغط على الرأي العام المحلى والعالمي لتبني مطالب الفئات المهمشة والمحرومة والمضطهدة. فأمريكا التي تعد العدة هذه الأيام لمحاربة الإرهاب الدولى توجد بها أكثر من 150 منظمة متطرفة. وقد يتساءل الفرد هنا ما هي أسباب الإرهاب؟ ولماذا يلجأ الأفراد أو الجماعات إلى استعمال الإرهاب كوسيلة للتفاوض ووسيلة للعمل السياسي والدبلوماسي. ان استعراض الأسباب والعوامل التي تفرز الإرهاب لا يعني محاولة تبريره وإيجاد حجج لانتشاره وتوسعه في العديد من المجتمعات وإنما الهدف تحدد طبيعة الظاهرة التي لم توجد هكذا من العدم وإنما هناك دائما أسباب وآليات لأي ظاهرة من الظواهر سواء كانت اجتماعية أم سياسية أم غير ذلك. تتعدد أسباب الإرهاب وتختلف حسب ظروف وطبيعة كل مجتمع، وظاهرة الإرهاب ظاهرة معقدة ومتشعبة، الوقوف عند أسبابها وأبعادها ليس بالعملية السهلة. فالإرهاب ظاهرة تعكس وضعا غير سوي في المجتمع يكون في معظم الأحيان تعبيرًا عن الاستياء والتهميش والاقصاء والتنكر للواقع وللقيم السائدة في المجتمع. فهو إذا ظاهرة لا تؤمن بالاخر ولا تؤمن بالحوار ولا حتى بالقيم الإنسانية. الإرهاب يكون بعيدا كل البعد عن المنطق والبصيرة ويؤمن بالنفي الكامل لجميع القيم الأخلاقية. فالعقلية الإرهابية إذا تجد مصدرها في رفض ما هو موجود في المجتمع والثورة عليه، وتتسم بالكراهية والحقد والإنكار الأخلاقي لكافة القيم. ومما زاد في تعقيد الظاهرة وتشابك أطرافها استعمال الإرهاب من قبل بعض الدول للإطاحة بدول أخرى أو تقويض عمليتها التنموية وتطورها والحد من عملها الدبلوماسي ونشاطها السياسي على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الدولي… إلى آخر ذلك. وقبل التطرق إلى أسباب الإرهاب يجب الوقوف عند أهدافه، ففي غالب الأحيان تلجأ الجماعات السياسية التي تفشل في الوصول الى الحكم والسلطة والتأثير في القرار السياسي بالطرق السياسية المعروفة إلى استعمال العنف والتطرف للتعبير عن استيائها وعدم قبولها بالأمر الواقع. فالإرهاب إذا أصبح نوعًا من التعبير السياسي الذي يعكس فشل تنظيم معين في التأقلم والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته. وتعود أسباب الإرهاب إلى عوامل عدة داخلية وخارجية. فبالنسبة للعوامل الداخلية تمر العديد من دول العالم بتغيرات جذرية ومهمة فرضتها الظروف التي تمر بها المنظومة الدولية مثل انهيار الشيوعية والكتلة الاشتراكية وبذلك زوال القطبية الثنائية وظهور مؤشرات نظام عالمي جديد لم تتحدد معالمه بعد لكن تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمقاومة شديدة وصراع كبير من قبل المجتمع المدني العالمي ومعظم الدول في العالم حتى بعض الدول الفاعلة على الساحة الدولية. أضف إلى ذلك أن معظم التجارب التنموية في العالم الثالث الذي يضم أكثر من 75% من سكان العالم فشلت ولم تحقق الأهداف المرجوة منها مما عمق الهوة ما بين الدول المتقدمة، المستعمرة ( بكسر الميم) سابقا والدول المتخلفة، المستعمرة ( بفتح الميم )، كما أدى فشل المشاريع التنموية داخل دول العالم الثالث إلى اتساع الهوة بين الفئة القليلة جدًا التي تتقاسم ثروات البلاد وعامة الجماهير التي تعاني يومًا بعد يوم من الفقر وصعوبة تأمين لقمة العيش اليومي. فأسباب الإرهاب في الدول النامية تتحدد في عوامل سياسية، ايديولوجية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية. فالمشاكل التي ظهرت على هذه المستويات مجتمعة أدت إلى ظهور التطرف والإرهاب ورفض الاخر، هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الدولى فهنالك بعض الدول تعمل على إيواء الإرهابيين والبعض الاخر يعمل على استعمال الإرهاب لإضعاف بعض الدول النامية والقضاء على معنوياتها ونشاطاتها حتى يتحكم في مصيرها كما يشاء، أما النوع الثالث فهي تلك الدول التي تمارس إرهاب الدولة مثل الكيان الصهيوني وهذا حتى يضمن بقاءه ويقضي على كل من يقف في طريقه. فالأسباب إذا عديدة ومتشابكة منها ما هو محلى ومنها ما هو دولى ومنها ما هو ايديولوجي ديني ومنها ما هو اقتصادي. في مقال الأسبوع القادم سنستعرض بمشيئة الله هذه الأسباب. mkirat@qu.edu.qa
1576
| 15 يونيو 2019
من واجب كل مؤسسة إعلامية أن تعمل على "أخلقة" العمل الإعلامي وجعل ميثاق الشرف بوصلة للممارسة الإعلامية النزيهة والشريفة والهادفة، فكل مؤسسة إعلامية مطالبة بأن تحدد بكل وضوح ودقة المحرمات والممنوعات، واجبات القائم بالاتصال وحقوقه، وعادة تتحدد المحاور الرئيسية لميثاق الشرف الإعلامي فيما يلي: المسؤولية، الأخلاق، الدقة والموضوعية، احترام شعور وديانات ومقدسات الآخرين، احترام الحياة الخصوصية لأفراد المجتمع، حق الجمهور في الأخبار والمعرفة والمعلومات، الالتزام باحترام المهنة والدفاع عنها وحمايتها من كل من يحاول المتاجرة بها أو استعمالها لأغراض غير المصلحة العامة وأغراض المجتمع، الالتزام بحماية الصحافي وحصانته والدفاع عنه عندما تتوجب الضرورة. إذا انعدمت الأخلاق وسيطرت النزوات الشخصية أو الحزبية أو المالية التجارية ابتعدت المؤسسة الإعلامية عن خدمة المصلحة العامة وهذا يعني أنها بدلا من أن تكون المراقب العام في المجتمع والمدافع عن الطبقات المحرومة تصبح في يد فئة محددة تستعملها وتسخرها لخدمة مصالحها وحتى لو كانت على حساب المصلحة العامة، وهذا ما يؤدي إلى انعدام المصداقية وتدهور العلاقة بين الشرائح الاجتماعية العريضة في المجتمع والمؤسسة الإعلامية. بعبارة أخرى المؤسسة الإعلامية تعمل في فراغ تام وعملية التأثير والتأثر تنعدم من أساسها وفي غالب الأحيان يتوجه الجمهور المستقبل نحو وسائل ورسائل إعلامية أخرى ليجد ما لم يجده في الرسالة المحلية. وفقدان المصداقية في العملية الإعلامية يعتبر فشل العملية الإعلامية في مهدها. أكثر من أي وقت مضى تحتاج المؤسسة الإعلامية إلى ميثاق شرف وهي كذلك مسؤولة عن تكوين صحافييها ونشر ثقافة المسؤولية والأخلاق واحترام المهنة والمجتمع والحقيقة، وهنا يجب التأكيد على أن المواثيق لا تكفي، فعلى الصحافي أن يؤمن برسالته في المجتمع والمسؤولية الملقاة على عاتقه كما من واجبه أن يعمل على تكوين نفسه وترقية أدائه وصقل مواهبه ومتابعة آخر التطورات في المهنة محليا وإقليميا ودوليا. من جهة أخرى لا نستطيع أن نتكلم عن أخلاقيات المهنة بدون المهنية وعندما نتكلم عن المهنية فهذا يعني التكوين الجامعي والتخصص والاشتراك في الجمعيات المهنية والنقابات وكذلك التعليم المستمر، فالمهنية تعني احترام المهنة والدفاع عنها، وبذلك احترام أخلاقياتها ومبادئها. مع الأسف الشديد يعاني الإعلام العربي من غياب جمعيات مهنية قوية تعمل على حماية المهنة من المتطفلين وتطوير أداء الصحفيين من خلال التعليم المستمر والدورات التدريبية، حيث نلاحظ غياب المجالس الصحفية وجمعيات الناشرين ومجالس القراء وانعدام دور المجتمع المدني. وهنا يجب الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين أخلاقيات الصحافة وحرية الصحافة وحرية الفرد في المجتمع والفصل بين السلطات. الإعلام بدون أخلاقيات لا يستطيع أن يقدم رسالته النبيلة وبدلا من أن يكون في خدمة الحقيقة والمصلحة العامة نجده في موقع لا يُحسد عليه، تتقاذفه أمواج المال والسياسة على حساب الرسالة النبيلة لمهنة شريفة، التحديات كبيرة ما يتوجب تكاثف جهود الجميع -المؤسسة الإعلامية، الصحافيون- النقابات والجمعيات الصحفية - المجالس الإعلامية – سلطات الضبط - المجتمع المدني- لحماية المهنة والقائمين عليها والجمهور من سطو وتكالب قوى عديدة في المجتمع تعمل جاهدة لتوظيف الإعلام لتحقيق مصالحها مستعملة كل الطرق والوسائل من تلاعب وتضليل وتزييف وتشويه وتعتيم. وتنعدم المصداقية في العملية الإعلامية عندما تكثر الضغوط بمختلف أنواعها وأشكالها على القائم بالاتصال، وعندما تكثر التدخلات في عمل المؤسسة الإعلامية من قبل جهات وأطراف ليس لديها أي حق في التدخل في العمل الإعلامي. وفي عالمنا العربي مع الأسف الشديد تعاني المؤسسة الإعلامية من ضغوط ومن تدخلات ومن تحكم وتوجيه تجعلها مؤسسة تبتعد كل البعد عن جمهورها وعن خدمة المصلحة العامة لصالح هؤلاء المتطفلين - نظرا لنفوذهم السياسي أو المالي … الخ. ويصعب هنا الكلام عن الأخلاق أو ميثاق الشرف أو المصلحة العامة إذا كانت المؤسسة الإعلامية تحت رحمة حفنة من أصحاب الجاه والمال والنفوذ. إن تحديد مهام ومسؤولية المؤسسة الإعلامية وتحديد مهام ومسؤولية القائم بالاتصال في ضوء ميثاق شرف شامل وواضح المعالم يعني أننا قضينا على الكثير من الملابسات ومن المناطق الغامضة التي قد تؤدي إلى سوء التفسير والاستخدام، والمؤسسة الإعلامية في المجتمع مثلها مثل القائم بالاتصال الذي يصنع الرسالة التي تقدم للجمهور يجب أن تكون لديها رسالة نبيلة تعمل من أجلها ليل نهار للدفاع عنها وتحقيقها، المؤسسة الإعلامية يجب أن تبذل قصارى جهودها لإبراز الحق وتبيان الباطل، فإذا كان الهدف النبيل موجودا والنية موجودة والمستلزمات متوافرة (قوانين، تشريعات، نقابات مهنية، مواثيق أخلاقية) وكذلك المناخ الديمقراطي وحرية التعبير والرأي، في هذه الحالة نستطيع أن نتكلم عن مؤسسات إعلامية فاعلة في وطننا العربي. الممارسة الإعلامية مهنة نبيلة يجب أن تُمارس وفق المعايير والمقاييس الأخلاقية والقانونية والتشريعية والمهنية، فالمؤسسة الإعلامية مسؤولة أمام المجتمع وأمام الرأي العام، ومسؤولة مسؤولية أخلاقية كبيرة جدا عندما تضّخم أشياء وتحجب أشياء أخرى، وعندما تركّز على عناصر معينة في الخبر دون غيرها. وجريمة التضليل والتزييف والمغالطة والكذب والدعاية والتشويه والتلاعب أخطر بكثير من أي جريمة أخرى، لأن المؤسسة الإعلامية عندما تزّيف أو تضلّل فإنها كذبت على ملايين البشر وليس على شخص واحد، وهنا تكمن أهمية الأخلاق والالتزام والنزاهة التامة في العمل الإعلامي لضمان السوق الحرة للأفكار. في أخلاقيات العمل الإعلامي يجب على القائم بالاتصال الرجوع دائما إلى المنطق وأن يسأل السؤال التالي دائما "ما هو دوره في المجتمع وما هي مسؤوليته أمام قرائه ومستمعيه ومشاهديه، وما هو هدف العملية الإعلامية؟ أهو التشهير أم القذف؟ أم خدمة المصلحة العامة أم إلحاق الضرر بالآخرين، أم التضليل والتزييف و التشويه؟" أم أن رسالته في المجتمع هي رسالة نبيلة تتمثل في الكشف عن الحقيقة بكل موضوعية ونزاهة والتزام، فالتحلي بالأخلاق والامتثال للقانون وللصالح العام ولمواثيق الشرف من المميزات الرئيسية للعمل الإعلامي الناجح والمسؤول والهادف والملتزم. ما يؤسفنا قوله عن واقع أخلاقيات الممارسة الإعلامية في الوطن العربي هو غياب الكثير من مستلزمات الممارسة المسؤولة والنزيهة والملتزمة، حيث نلاحظ غياب مواثيق الشرف في الكثير من المؤسسات الإعلامية وكذلك غياب الجمعيات والنقابات والاتحادات الإعلامية وإن وجدت فتكون شكلية فارغة من محتواها الحقيقي، بالإضافة إلى أن الضغوط المختلفة على المؤسسة الإعلامية وعلى الصحافي نفسه وكذلك غياب حرية الصحافة في الكثير من الأحيان وضعف القوانين والتشريعات الإعلامية – سواء ما يتعلق بالنص أو ما يتعلق بالتطبيق والممارسة - كلها عوامل تؤثر سلبا على البعد الأخلاقي في معادلة الممارسة الإعلامية. الخاسر في كل هذا هو كلمة الحق، هو الرأي العام المستنير، هو السوق الحرة للأفكار، بدون حرية رأي وحرية تعبير وحرية صحافة لا وجود للقرار الرشيد ولا للإبداع والابتكار ولا للحوار والنقاش والرأي والرأي الآخر. mkirat@qu.edu.qa
4809
| 18 مايو 2019
ما يدور في العالم هذه الأيام، عالم مضطرب تسيطر عليه الأزمات والحروب والنزاعات والخلافات والمكائد وما شهده العالم بأسره من تداعيات وانعكاسات 11 سبتمبر 2001 يشير إلى تطورات خطيرة قد تعصف بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة حتى في أعتق ديمقراطيات العالم. ما كان متعارفا عليه في الأوساط الإعلامية والسياسية بالسلطة الرابعة -أي سلطة الإعلام التي تراقب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية- أصبح في خانة التاريخ وأدبيات الماضي، حيث إن ما يحدث هذه الأيام في الأوساط الإعلامية العالمية أصبح بعيدا كل البعد عن أطروحة وسائل الإعلام كقوة مضادة أو سلطة تراقب تجار الحروب والأسلحة وصقور البيت الأبيض. فالإعلام الذي يغطي أحداث ومجازر ومذابح بؤر توتر عديدة في العالم أصبح يطبل للحرب أكثر مما يعبر عن بشاعتها وعدم شرعيتها وقانونيتها وإنسانيتها وعن خسائرها وتداعياتها وانعكاساتها السلبية الكبيرة. الإعلام كسلطة رابعة أصبح أسطورة وأصبح نظرية جوفاء لا أساس لها من الصحة في أرض الواقع. وسائل الإعلام أصبحت جزءا من القوى الفاعلة في المجتمع وأصبحت جزءا من البنية الفوقية التي تتحكم فيها قوى المال والأعمال والسياسة. فالإعلام الذي كان من المفروض أي يكشف العيوب والتجاوزات والمغالطات الكبيرة والتلاعبات الخطيرة بالرأي العام أصبح جزءا من اللعبة يبرر ويفسر ويضلل ويعتم لصالح الوضع الراهن ولصالح القوى الفاعلة في المجتمع على حساب غالبية الشعب وعلى حساب الموضوعية والحرية والحقيقة. تكمن جدلية حرية الصحافة والديمقراطية في أن الأخيرة تقوم أساسا على الاتصال السياسي وحرية التعبير والفكر وبطبيعة الحال هذه الأمور لا تتحقق إلا بوجود إعلام يراقب وينتقد ويكشف ويحقق. فالأطراف الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بحاجة إلى وسائط إعلامية ومنابر للمعارضة والاختلاف في الرأي، والتعبير عن وجهات النظر المختلفة... الخ. إن أي تراجع في حرية الصحافة يعني تراجعا في الديمقراطية، وتاريخ حرية الصحافة في العالم يؤكد فكرة التأثير المتبادل بين الديمقراطية والصحافة. فالأنظمة السياسية الدكتاتورية أو السلطوية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحلم بصحافة حرة وقوية ونفس الشيء يمكننا قوله عن تلك الأنظمة التي لا تؤمن بالتعددية الحزبية وبحرية الرأي والتعبير. فصحافة هذه الأنظمة تكون دائما أحادية الاتجاه تخدم من يشرف عليها ويمولها ويسيطر عليها وتهمش وتتجاهل غالبية المجتمع ومن لا حول ولا قوة لهم. فالآلة الإعلامية أصبحت هي المنظر والمبرر والمفسر لما هو عليه العالم اليوم، عالم تحتكره وتسيطر عليه حفنة من أباطرة المال والسياسة. فالإعلام في عالمنا اليوم يتميز، على حسب قول "إغناءي رأموني"، بالتلوث والتسمم بكل أنواع الأكاذيب والإشاعات والتضليل والتشويه والتلاعب. والمطلوب بكل بساطة هو تطهير هذا الإعلام من كل هذه الشوائب والملوثات. ومن هنا يتوجب على المنظومة العالمية التفكير في إنشاء مرصد عالمي للإعلام لمراقبة التجاوزات والألاعيب، كما يتوجب على المجتمع المدني في كل دولة أن يشكل مرصدا على المستوى الوطني لمراقبة التضليل والتعتيم والتلاعب بالحقيقة لصالح حفنة من أصحاب النفوذ المالي والسياسي. إن المجمعات الإعلامية العظمى أصبحت تفضل مصالحها بالدرجة الأولى على حساب مصالح الشعوب والدول والأمم والإنسانية جمعاء. التجارب في الميدان أكدت أن الصناعات الإعلامية الضخمة سرقت ونهبت حرية التعبير وحرية الصحافة من أصحابها الحقيقيين وهم الشعوب لصالح أصحاب المال والنفوذ السياسي وهذا الموقف يتناقض جملة وتفصيلا مع مبدأ الديمقراطية ومبدأ السوق الحرة للأفكار ومبدأ المسؤولية الإعلامية. التعديل الأول في الدستور الأمريكي على سبيل المثال يضع قيودا أمام الحكومة الأمريكية لعدم التدخل والتطفل على الصحافة وحتى رئيس الدولة نفسه لا يستطيع أن يقوم بضغوط على المؤسسة الإعلامية والقائم بالاتصال. الرئيس كلينتون رئيس أقوى دولة في العالم بقي مكتوف الأيدي أمام التغطيات الصحفية والتحقيقات والتقارير المختلفة التي تفننت فيها مختلف وسائل الإعلام الأمريكية لكشف تصرفاته اللاأخلاقية والتي خرجت عن الآداب العامة. أين نحن من كل هذا وإلى متى تبقى صحافتنا في الوطن العربي تلمّع وتصنع الديكورات والأطر المزخرفة بالورود والزهور؟. السلطة في الوطن العربي ومع الأسف الشديد ما زالت تنظر إلى المنظومة الإعلامية والمؤسسة الإعلامية على أنها أداة لتثبيت شرعيتها وبسط نفوذها وتمرير خطابها السياسي بعيدا عن طموحات الجماهير ومطالبهم، السلطة في الوطن العربي ما زالت بعد لم تستطع بناء المؤسسات اللازمة لضمان المشاركة السياسية الفاعلة ولضمان رأي عام قوي وفعال. ونتيجة لكل هذا فإنها فشلت كذلك في بناء نظام إعلامي إيجابي وفعال وليس سلبيا يستقبل ويؤمر، نظام إعلامي يؤمن بالاتصال الأفقي ويعمل على إشراك مختلف الشرائح الاجتماعية في العملية السياسية وفي اتخاذ القرار، نظام إعلامي همه الوحيد هو كشف الأخطاء والعيوب وليس التلميع والتلوين. قد يسأل سائل ويقول: هل فعلا وظفت الدول العربية جهازها الإعلامي أحسن توظيف؟ وهل استفادت حقيقة من هذه الوسائل الاستراتيجية والهامة التي تنفق عليها سنويا مئات الملايين من الدولارات بل مليارات من الدولارات؟. وبكل بساطة نقول إن نظرة الدول العربية لإعلامها نظرة خاطئة وسلبية تقوم على البعد البراغماتي النفعي بدون مراعاة إمكانية استغلال الجهاز الإعلامي بطريقة أرشد وأحسن يستفيد منها المجتمع ككل، السلطة والشعب بشرائحه المختلفة. والنظرة الضيقة هذه للإعلام من قبل الأنظمة العربية ليست نتيجة الصدفة ولكنها نتيجة حتمية لانعدام مستلزمات وشروط الإعلام التنموي الذي يراقب وينتقد ويشارك في صناعة القرار ويشرك الجماهير الشعبية في العملية التنموية وفي البناء والتشييد. من أهم مستلزمات الإعلام القوي والفعال في أي مجتمع حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الوصول إلى المعلومات، هذه المستلزمات يجب أن نعمل على توفيرها وعلى اكتسابها كسلطة وكقائمين بالاتصال وكمثقفين وباحثين ووسطاء ثقافيين... الخ، وبدون هذه المستلزمات فإنه لا يحق لنا الكلام عن المجتمع المعلوماتي والثورة الاتصالية والعولمة الثقافية وغيرها من التحديات العديدة والمختلفة التي نعيشها اليوم وبصورة فائقة. فالنظام الإعلامي العربي الراهن يحتاج إلى نظرة نقدية جادة مع نفسه كما يحتاج إلى مراجعة مع الذات وهذا للوقوف على السلبيات والتعلم من الأخطاء والهفوات السابقة للانطلاق بخطى قوية وإيجابية نحو مستقبل لا يكون فيه الإعلام وسيلة للسيطرة والتحكم والتلميع والتملق وإنما وسيلة للحرية والعلم والمعرفة والتفكير والإبداع والاختلاف في الرأي من أجل رفاهية الإنسان وكرامته. mkirat@qu.edu.qa
1354
| 11 مايو 2019
يحتفل العالم في الثالث من مايو من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، وعادة ما يكون هذا اليوم فرصة لتقييم الذات والوقوف على أهم الإنجازات وأهم المشاكل والعراقيل والتصفيات الجسدية وغيرها التي يتعرض لها الصحفيون في مختلف دول العالم. مراجعة الذات هنا تستوقفنا عن أهم الإنجازات وهل تغيرت دار لقمان أم بقيت على حالها أم أنها زادت سوءا وتدهورا. تجدر الإشارة هنا أن دراسات عديدة أكدت في نتائجها أن الصحفي يعمل في المعدل أكثر من 50 ساعة في الأسبوع وبعض الأحيان يصل عدد الساعات إلى أكثر من 60 ساعة. الصحفي إذا هو مرآة المجتمع وهو شاهد عيان يومي لما يجري وما يحدث في المجتمع في العلن أو في الخفاء أو في الكواليس. الصحفي أو القائم بالاتصال مطالب في المجتمع بالتأريخ اليومي لمجريات الأحداث والأمور، مطالب بالوقوف عند كل كبيرة وصغيرة، مطالب بكشف الحقائق وإبراز الإيجابيات والسلبيات وخاصة التركيز على السلبيات، لأن السلبيات هي التي تضر بالمجتمع وخاصة بالمحرومين والمهمشين. الصحفي هو حلقة الوصل بين الحاكم والمحكوم بين المشّرع والمنفذ، بين السلطة والشعب وهذا ما يجعل من دوره دورا إستراتيجيا وحساسا في أي مجتمع. دراسات وتقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم و "مراسلون بلا حدود" والاتحاد العالمي للصحف والمنظمة العالمية للصحفيين وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية تبعث على التشاؤم، والحسرة والحزن العميقين للمشاكل والمتاعب والخطورة التي تكتنف مهنة الصحافة. ففي كل سنة هناك عشرات الصحفيين يموتون قتلا ويغتالون، ومئات منهم يسجنون، ومئات يحاكمون ومئات يتعرضون لمضايقات ولإهانات هذا لا لشيء إلا لأنهم حاولوا القيام بواجبهم وبرسالتهم على أحسن وجه، حاولوا أن يكشفوا الحقيقة ويحاربوا الرشوة والمحسوبية والوساطة والعمولة وتبييض الأموال وتهريب المخدرات … إلى غير ذلك من الآفات والأمراض التي يدفع ضريبتها وفاتورتها الغالبية العظمى ممن لا حول لهم ولا قوة. المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على حرية الرأي والتعبير لكن في معظم دول العالم "مافيا " المال والسياسة لا تؤمن بهذا المبدأ وبهذا الحق، وأصبح من يملك المال والنفوذ والسلطة له حق التعبير والرأي أما باقي شرائح المجتمع فتكتفي باستهلاك ما يقدم إليها بدون مساءلة و لا استفسار. إخبار الرأي العام وإيجاد سوق حرة للأفكار أصبحت من المهام الصعبة في معظم دول العالم. والقائم بالاتصال يجد نفسه في هذه المعادلة بين المطرقة والسندان، فهو أخلاقيا ومهنيا وعمليا مطالب بإعلام وإخبار الرأي العام ومن جهة أخرى يجد نفسه تحت ضغوط لا ترحم ولا تشفق لإرضاء أصحاب النفوذ والمال وأصحاب السلطة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا وخاصة بالنسبة لنا في الوطن العربي وأمام كل هذه المهام والمسؤوليات هل يتمتع الصحفي في دولنا العربية بالحصانة الكافية؟ هل يتمتع بحماية قانونية وبتشريعات تحميه من جبروت السلطة والمال؟ هل ظروف عمل الصحفي في دولنا مهيأة ومواتية للقيام بالعمل الصحفي على أحسن وجه، ماذا بالنسبة للرضا عن العمل والعلاقة بمصادر الأخبار؟ ماذا عن الراتب؟ والحوافز و الامتيازات؟ هل في نهاية الأمر نطلب من الصحفي الكثير ونقدم له القليل. في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يجب علينا كعرب أن نتوقف لحظة من الوقت ونحاول أن نجيب على هذه التساؤلات وغيرها، أما الجهات المؤهلة للإجابة على هذه الأسئلة فهي وزارات الإعلام والثقافة ووزارات الداخلية والهيئات التشريعية والقضائية. مع الأسف الشديد وفي معظم الدول العربية مازال ينظر للصحافة - والمقصود بالصحافة هنا المهنة بصفة عامة سواء بالنسبة للإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة المطبوعة من جرائد ومجلات ودوريات - على أنها وسيلة في يد السلطة تتصرف فيها كما تشاء ووفق خطها السياسي والمسار الذي تحدده لها. وهكذا بدلا من أن تكون الصحافة في الوطن العربي نعمة للشعوب وللرأي العام جاءت نقمة وعلة تزيّف الواقع وتلمّع كل ما تقبل عليه. فلماذا يا ترى في الوطن العربي لا نجعل من المؤسسة الإعلامية مؤسسة مسؤولة وحرة ولا نثق فيها، ولا نعطيها الإمكانيات اللازمة حتى تلعب دورها الإستراتيجي والفعال في المجتمع، لماذا ننظر دائما للمؤسسة الإعلامية على أنها خطر وبإمكانها أن تسبب مشاكل عديدة ومتنوعة للسلطة؟ لماذا لا نثق في الصحفي ونتركه عند ضميره يقوم بمهمة الإعلام والإخبار والتحقيق والكشف عن المساوئ والتناقضات والأمراض الاجتماعية بمختلف أنواعها وأشكالها ومهما كان صاحبها ومصدرها، بكل حرية ومسؤولية وشجاعة. ينعم الصحفي في أي مجتمع بمكانة مرموقة وإستراتيجية يحسد عليها بحيث يستطيع أن يصل إلى الرأي العام بكل سهولة وبسرعة فائقة كما يستطيع أن يصل إلى صاحب القرار ومصدر الخبر وأي إدارة أو مؤسسة في المجتمع دون عناء، هذه الامتيازات بطبيعة الحال تقابلها مسؤولية كبيرة يجب أن يتحلى بها القائم بالاتصال ويضع في ذهنه أنه مسؤول على كشف الحقائق ومحاربة الفساد والرشوة. وفي الدول النامية تبرز أهمية المؤسسة الإعلامية ومسؤوليتها الاجتماعية أكثر من أي مجتمع آخر وهذا نظرا للدور الإستراتيجي والفعال الذي تلعبه وسائل الاتصال الجماهيري في مجتمعات بحاجة إلى تعليم وتوعية صحية وبيئية وسياسية وغيرها من المهام الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والخروج من التخلف والفقر والجهل وغير ذلك من المشاكل العديدة والمتنوعة في مثل هذه الدول. mkirat@qu.edu.qa
1123
| 04 مايو 2019
تتوالى الجمعات وتتوالى المسيرات والمظاهرات والحراك يزيد قوة وعزيمة الجمعة تلو الأخرى، لكن الانسداد ما زال يفرض نفسه حيث إن السلطة متمثلة في بن صالح وحكومته وإلى جانبها قائد الأركان الذي انحاز للحل الدستوري، يصران على المضي قدما في تنظيم الانتخابات وإجرائها يوم 4 يوليو 2019. بينما الحراك يصر على ذهاب تنحية "الباءات" الثلاثة وتسليم أمور المرحلة الانتقالية إلى هيئة تشرف على الانتخابات. المشهد السياسي في الجزائر هذه الأيام يسيطر عليه الحراك من جهة الذي صمم ويصر على التغيير الشامل وذهاب كل من كان متورطا مع النظام السابق. من جهة أخرى نجد قائد الأركان القايد صالح الذي أصبح هو الرقم واحد في صناعة القرار السياسي وتصويب البوصلة في الاتجاه الذي يراه سليما، والذي مع الأسف الشديد، أصبح لا يتناغم مع طموحات الحراك. قائد الأركان مصر على الحل الدستوري الذي لا يستجيب بأي حال من الأحوال مع مطالب ملايين الجزائريين التي تخرج في مسيرات مليونية كل يوم جمعة. الجزائر وصلت إلى مرحلة الانسداد بسبب دستور لم يضع في الحسبان الوضعية التي وصلت إليها. فالمادة 102 لا تستجيب للطموحات الحالية للشارع الجزائري بل تكرس نظام بوتفليقة فذهاب رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز فتح المجال لأحد أعضاء المجلس ليخلفه مما يعني أن الأمور بقيت على حالها. وتعويض بوتفليقة بـ بن صالح لم يرق لطموحات ومطالب الحراك حيث ان الأمور لم تتغير قيد أنملة خاصة وأن حكومة بدوي جاءت بأسماء وشخصيات النظام القديم والبعض منها لا يتوافر على الكفاءة اللازمة ليكون وزيرا. أكثر من ذلك وزير مالية حكومة بدوي مطالب في المحكمة، أما بدوي نفسه فهو مهندس ورجل التزوير في مختلف الانتخابات التي شهدتها الجزائر في عهد بوتفليقة. ما تعيشه الجزائر هذه الأيام هو حراك نشط وديناميكي ومستمر في مساعيه ومطالبه في وسط معارضة سياسية ضعيفة لم تستطع إلى حد الآن أن تقوم بالدور المنوط بها. فالنخبة السياسية لم توفق في وضع خطة طريق وحلول عملية لكسر الانسداد والانطلاق في عملية التغيير. من جهة أخرى نلاحظ وجود مؤسسة عسكرية قوية أرغمت الرئيس على الاستقالة وأجبرت الرئاسة على تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري لكنها مع الأسف الشديد تخلت عن المادة 7 و8. فقائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح أصبح في المرحلة السياسية الحالية التي تعيشها الجزائر قائد اركان برتبة رئيس دولة ينتظره الجزائريون كل يوم ثلاثاء للتعبير عن المستجدات وما هي الإجراءات القادمة. هذه الوضعية، مع الأسف الشديد لا تخدم المرحلة الانتقالية ولا طموحات ومطالب الشعب. ففي الفترة الاخيرة شهدت الجزائر حملة من محاكمة كبار رجال الأعمال الذين تورطوا في قضايا فساد ونهب المال العام على غرار الإخوة كونيناف ورجل الأعمال الشهير ربراب وغيرهم. كما أمر القايد صالح بضرورة استقلالية القضاء وإعطاء الحرية الكاملة للمحاكم والمدعين العامين للقيام بدورهم كما ينبغي. هذا شيء جميل ويُحب لمكاسب الحراك، لكن المهم من هذا هو وضع خريطة طريق واضحة للخروج من الانسداد والشروع في التغيير الذي يقود الجزائر والجزائريين إلى التحول الديمقراطي والجمهورية الثانية. إلى حد الساعة لا جديد في الأفق وهناك تعنت من قبل بن صالح والمؤسسة العسكرية في عدم استخدام السبيل السياسي لحلحلة الاوضاع. فالندوة التي دعا إليها بن صالح ولم يحضرها كانت فاشلة بكل المعايير حيث ان عدد الصحفيين فاق أولئك الذين حضروا من أحزاب سياسية وشخصيات لها باع في العمل السياسي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن بن صالح لا يستطيع أن ينجح في تنظيم الانتخابات وفى إجرائها يوم 4 يوليو 2019. فالمنطق يقول إن هناك أزيد من 20 مليون جزائري يتظاهرون كل يوم جمعة ضد بن صالح وبدوي وإدارتهما وتسييرهما للمرحلة الانتقالية مما يعني ان 20 مليونا يقاطعون الانتخابات يوم 4 يوليو هذا إلى جانب 88 بلدية أعلنت عن عدم تنظيمها وإشرافها على الانتخابات الرئاسية القادمة. ففشل ندوة بن صالح مؤشر صريح على أن بن صالح يقود السفينة في الاتجاه المعاكس حيث ان الأحزاب السياسية الفاعلة والشخصيات الفاعلة في المشهد السياسي الجزائري رفضت التعامل مع بن صالح والتشاور معه لقيادة المرحلة الانتقالية. من جهة أخرى نلاحظ أن المعارضة ما زالت تراوح نفسها ولم تأت بأي جديد يذكر حتى الساعة. اجتماعها الأخير كان فاشلا مثل فشل ندوة بن صالح حيث لم يحضرها العديد من الشخصيات السياسية على غرار علي بن فليس رئيس حزب طلائع الأحرار ولويزة حنون رئيس حزب العمال. إن الإجراءات التي شرع فيها بن صالح في تغيير بعض الولاة ومحاكمة كبار رجال الأعمال الفاسدين إجراءات قد تسعد الحراك لكن المطلوب في هذه المرحلة العصيبة هو أكثر من ذلك بكثير. الحراك مصمم على التغيير، التغيير الجذري الذي ينقل الجزائر من مرحلة تراكمات 57 سنة من الفساد وسوء الإدارة إلى مرحلة تسودها الديمقراطية والشفافية والحكم الراشد. الجمعات تتوالى وملايين الجزائريين تنزل للشارع لتؤكد انها لا ترضى إلا بالتغيير الشامل الذي يضمن لها مطالبها وحقوقها. حالة الانسداد تسيطر على الوضع حاليا خاصة أن الرئاسة متشبثة بموقعها للمضي قدوما في تحضير الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو 2019 وقائد الأركان برتبة رئيس الدولة الذي يمسك بزمام الأمور حاليا مصر على الحل الدستوري بدلا من الحل السياسي. إلى أين تتجه الجزائر؟ سؤال يطرحه الكثير ممن يراهنون على الجمهورية الثانية والطلاق بالثلاث مع النظام القديم. mkirat@qu.edu.qa
1195
| 27 أبريل 2019
مساحة إعلانية

في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول...
3873
| 05 ديسمبر 2025

بات الذكاء الاصطناعي اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله...
2664
| 30 نوفمبر 2025

فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين...
1707
| 04 ديسمبر 2025

في كل يوم، ينظر الإنسان إلى ما ينقصه...
1563
| 02 ديسمبر 2025

لم يدخل المنتخب الفلسطيني الميدان كفريق عابر، بل...
1401
| 06 ديسمبر 2025

ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة الانطلاق المنتظرة لبطولة...
1185
| 01 ديسمبر 2025

تتجه أنظار الجماهير القطرية والعربية إلى استاد خليفة...
1155
| 04 ديسمبر 2025

مواجهات مثيرة تنطلق اليوم ضمن منافسات كأس العرب،...
1146
| 03 ديسمبر 2025
لم تعد الدوحة مجرد مدينة عربية عادية، بل...
867
| 03 ديسمبر 2025

-«المتنبي» حاضراً في افتتاح «كأس العرب» - «أبو...
813
| 07 ديسمبر 2025

أحياناً نمر بأسابيع تبدو عادية جداً، نكرر فيها...
648
| 05 ديسمبر 2025

يحكي العالم الموسوعي عبد الوهاب المسيري في أحد...
630
| 30 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية