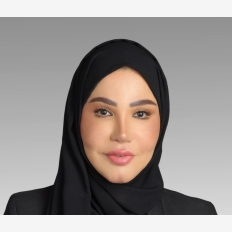رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس كل من ارتفع صوته في بيئة العمل ترك أثرًا، وليس كل من صمت غاب حضوره. في الحياة، هناك من يُتقن فن الظهور، وهناك من يُتقن فن التأثير. والسؤال الذي يستحق أن يُطرح بصدق: بعد سنوات من العمل، ماذا بقي منك؟ أثرٌ حقيقي… أم مجرد ضجيج عابر؟ كثيرون يفاخرون بعدد سنوات الخدمة، بعدد الاجتماعات، بعدد المناصب التي شغلوها، أو بعدد الصور التي التُقطت لهم في الصفوف الأولى. لكن المؤسسات لا تُبنى بالأعوام، ولا تُقاس باللقطات، ولا تُدار بالتصفيق. المؤسسات تُقاس بما تغيّر فيها لأنك كنت حاضرًا. حين يتقدّم الصوت على الإنجاز: في كل قطاع، وفي كل إدارة، نرى النموذجين بوضوح. هناك من يتقن فن الكلام أكثر مما يتقن فن الإنجاز، يرفع صوته في الاجتماعات، ويكثر من الوعود… لكن الواقع لا يتغير. هذا نموذج واضح لـ «ضجيج بلا أثر». وفي المقابل، هناك من لا يكثر من الظهور، لا يتصدر المنصات، لكنه أعاد بناء فريقه، طوّر آليات العمل، خفّض نسب الأخطاء، وصنع بيئة صحية للعمل، هذا هو «أثر بلا ضجيج». الأثر الذي لا يحتاج إعلاناً: الأثر الحقيقي لا يحتاج إلى إعلان. يُرى في تحسّن الأداء، في استقرار الفريق، في نمو الكفاءات، وفي استمرار النتائج حتى بعد مغادرتك الموقع. أما الضجيج، فغالبًا ما يختفي بانطفاء الأضواء، ولا يترك خلفه سوى ملفات معلّقة ووعودًا لم تكتمل. نماذج من الواقع الوظيفي: في أحد القطاعات الخدمية، تحكي موظفة عن مسؤول غادر موقعه منذ سنوات، وما زال اسمه يتردد حتى اليوم. لم يكن كثير الظهور، ولا عالي الصوت، لكنه كان يستثمر في الناس، يعلّمهم، يحميهم من التعقيد، ويمنحهم الثقة. تقول: بعد خروجه، بقينا نعمل على نظامه، ونستفيد من أفكاره. هذا هو الأثر الذي لا تلتقطه الكاميرات، لكنه يعيش طويلًا. وفي قطاع آخر، نرى شخصية كان حضورها الإعلامي لافتًا، صوته الأعلى في الاجتماعات، قراراته سريعة ومعلنة… لكن بعد انتقاله، لم يبقَ شيء يُذكر. الملفات عادت إلى نقطة الصفر، والفريق احتاج وقتًا طويلًا لإصلاح ما تعطل. هنا نفهم أن الضجيج قد يسبق الإنجاز، لكنه لا يصنع بقاءه. الأثر ليس حكرًا على القيادات: الأثر لا يخص القيادات وحدها، حتى الموظف في موقعه البسيط يصنع أثرًا حين يطوّر إجراءً، يختصر وقتًا، يسهّل خدمة، أو يترك خلفه نظامًا أفضل مما استلمه. كثير من الموظفين لا يحملون ألقابًا كبيرة، لكن أسماءهم تُذكر باحترام لأنهم غيّروا طريقة العمل، أو أنقذوا مشروعًا، أو صنعوا فرقًا في تجربة المستفيد. السؤال الذي لا نحب مواجهته: والسؤال الأخطر الذي يجب أن يواجهه كل موظف، وكل مسؤول، وكل صاحب قرار بصدق: لو غادرتُ مكاني غدًا… ماذا سيتغير؟ هل ستسير الأمور كما هي؟ أم سيظهر الفراغ؟ أم سيكتشف الجميع أن وجودي كان مجرد حضور شكلي؟ في معنى أن تترك أثرًا: في ثقافة العمل الحديثة، لم يعد المهم كم تتكلم، بل كم تُنجز. لم يعد المهم كم تظهر، بل ماذا تترك. المؤسسات الذكية لا تبحث عن أصحاب الأصوات العالية، بل عن صانعي الأثر الهادئ، أولئك الذين يغيّرون من الداخل، ويتركون الأنظمة أفضل، والفرق أقوى، والخدمات أجود. الخاتمة: ما الذي يبقى؟ لذلك، حين نراجع مسيرتنا المهنية، لا نحتاج أن نحصي السنوات، بل أن نحاسب أنفسنا على الإضافة. ما المشروع الذي ترك بصمة؟ ما الفريق الذي كبر معنا؟ ما الإجراء الذي تحسّن لأننا كنا هنا؟ هذه هي الأسئلة التي تصنع سيرة مهنية حقيقية. في النهاية، المناصب تزول، والعناوين تتغير، والضجيج يخفت سريعًا… لكن الأثر وحده هو ما يبقى. فاختر لنفسك أن تكون أثرًا بلا ضجيج… لا ضجيجًا بلا أثر.
576
| 26 يناير 2026
حين يرحل الكبار،لا يغيب شخص واحد فقط، بل يغيب معه جزء من ذاكرة المهنة، وطبقة كاملة من الحكمة، ونبرة نادرة من الاتزان لم تعد تتكرر كثيرًا في مشهد الإعلام اليوم. بعض الرحيل لا يُقاس بفقد إنسان، بل بفقد مرحلة كاملة من الوعي، وبانطفاء مدرسة كانت تُعلّم قبل أن تكتب، وتربّي قبل أن تنتقد. رحيل الدكتور أحمد عبدالملك ليس خبرًا عابرًا في شريط الأحداث، بل علامة فارقة في تاريخ إعلامي طويل علّمنا أن الكلمة موقف، وأن الرأي مسؤولية، وأن الصحافة لا تُقاس بسرعة الانتشار، بل بعمق الأثر. كان واحدًا من أولئك الذين لم يلهثوا خلف العناوين، بل جعلوا العناوين تليق بهم، ولم يبحثوا عن الضوء، بل تركوا الضوء يبحث عنهم. في زمن ازدحمت فيه المنصات وخفّ فيه الوزن النوعي للكلمة، ظل صوته مختلفًا؛ هادئًا من غير ضعف، حازمًا من غير صخب، ناقدًا من غير إساءة، ومخلصًا للمعنى قبل أي اعتبار آخر. لم يكن يكتب ليُدهش، بل ليُقوّم، ولم يكن يلاحق الحدث، بل يضعه في سياقه، ويعيد للخبر إنسانيته، وللرأي أخلاقه. رحيل أمثاله يكشف لنا فجأة حجم الفراغ الذي لا ننتبه إليه إلا حين يقع. ندرك متأخرين أن بعض القامات كانت تمسك بتوازن المشهد دون أن تُعلن ذلك، وأن وجودها كان صمام أمان صامتًا، يحفظ للإعلام وقاره، وللمهنة هيبتها، وللرأي حدوده الرفيعة بين الجرأة والانفلات. ليس الحزن هنا على رجل غادر فحسب، بل على قيمة بدأت تتوارى، وعلى نموذج مهني نادر، وعلى زمن كانت فيه الكلمة تُصاغ بضمير قبل أن تُنشر بحبر. فبعض الغياب لا يؤلم لأنه قريب، بل لأنه يكشف هشاشة ما تبقى، وحاجتنا الماسّة إلى أمثال هؤلاء في زمن تتسارع فيه الأصوات وتتباطأ فيه المعاني. يبقى أن القامات الحقيقية لا تُختصر في تواريخ ولا تُطوى برحيل. تبقى في الذاكرة المهنية، وفي وعي الأجيال، وفي تلك اللحظات التي نبحث فيها عن صوت عاقل وسط الضجيج، فنستحضر أسماء علّمتنا أن الإعلام ليس سباقًا، بل مسؤولية. وليس منصة، بل رسالة. رحم الله الدكتور أحمد عبدالملك، وجعل ما قدّم شاهدًا له لا عليه، وجعل من سيرته درسًا مفتوحًا لكل من يظن أن الكلمة مجرّد مهنة، بينما هي في حقيقتها أمانة عمر.
171
| 20 يناير 2026
لم تعد ظاهرة العمل دون ترخيص مجرد مخالفات فردية يمكن التغاضي عنها، بل تحولت إلى تهديد حقيقي لبنية الدولة، ولهيبتها، ولثقة المجتمع في مؤسساته. ما يُعرف شعبياً بـ (أصحاب الشنطة) ليسوا فقط خارجين عن القانون، بل هم نتاج ثقافة مجتمعية سمحت للفوضى أن تتسلل إلى المهنة، والسوق، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية. التحرك الحازم الذي قامت به وزارة الصحة العامة في ضبط ممارسين غير مرخصين وإحالتهم للقضاء ليس إجراءً إدارياً، بل رسالة سيادية: لا أحد فوق القانون، ولا مهنة خارج القانون. لكنه في الوقت نفسه يضع المجتمع أمام سؤال صريح ومحرج: كيف سمحنا لهذا العبث أن ينتشر؟ ومن الذي صنع لهذا السوق غير النظامي زبائنه وشرعيته؟ الخطر الحقيقي لم يعد في وجود المخالفة، بل في تطبيعها اجتماعياً. حين يبرر الناس التعامل مع غير المرخص لأنه أرخص، أسرع، أو بدون إجراءات، فإنهم لا يبحثون عن حل، بل يشاركون فعلياً في بناء اقتصاد ظل، ومجتمع ظل، ومهنة ظل... بلا ضمانات، بلا حقوق، وبلا محاسبة. هنا لا يكون المواطن أو المستهلك متفرجاً بريئاً، بل طرفاً في الفوضى، يتصرف وكأن القوانين لا تعنيه وكأن بعض الناس أصبحوا فوق القانون. أما قطاع التدريب والتطوير البشري، فقد تحول إلى مسرح لمدّعي الخبرة. أفراد بلا اعتماد ولا تأهيل يبيعون الوهم تحت عناوين براقة، وتُمنح لهم المنصات لأن الجمهور لا يسأل: هل أنت مرخص؟ هل أنت معتمد؟ هل ما تقدمه علم أم استعراض؟ حين يقبل الناس بذلك، فإنهم لا يُضلَّلون فقط، بل يساهمون في تدمير قيمة المهنة نفسها. وفي قطاع التعليم، تستمر ظاهرة الدروس الخصوصية غير المرخصة ومدرسي الشنطة، ورغم أن وزارة التعليم بدأت تنظيماً جاداً، إلا أن المجتمع ما زال يتواطأ بالصمت والتعامل. حين يسلم أولياء الأمور مستقبل أبنائهم لممارسين غير مؤهلين لأنهم أقرب أو أرخص، فهم لا يخالفون نظاماً فقط، بل يفرطون في حق أبنائهم وفي مصلحة الوطن التعليمية. وفي قطاع التجميل، تُمارس أخطر الانتهاكات للجسد الإنساني داخل «عيادات الظل» و«كوافيرات الشنطة»، حيث تُجرى إجراءات في منازل وغرف مغلقة بلا رقابة صحية ولا مسؤولية قانونية. لكن من الذي يذهب إليهم؟ من الذي يغامر بجسده لأنه أرخص أو أسرع أو «من باب التجربة»؟ هنا لا يكون الضرر نتيجة فعل فردي، بل نتيجة قرار اجتماعي يستهين بالسلامة ويكافئ العبث. وفي قطاع الصيانة والخدمات الفنية، تنتشر عمالة غير نظامية تُستدعى لأنها أرخص أو بدون فاتورة. النتيجة: حرائق، أعطال، خسائر، ونزاعات بلا جهة تُحاسَب. ومع كل حادثة، يتكرر السؤال: لماذا لا يوجد تنظيم؟ بينما الحقيقة أن المجتمع اختار الطريق الأسهل لا الطريق الصحيح. أما قطاع العقار، فـ (سماسرة الشنطة) يعبثون بالسوق عبر صفقات غير موثقة، ووعود بلا ضمانات. ومع ذلك، يتعامل الناس معهم لأن الإجراءات الرسمية تأخذ وقتاً. هكذا تُبنى سوق بلا شفافية، بلا حماية، وبلا استقرار، وكأن بعض الوسطاء باتوا فوق القانون. ما يجمع كل هذه القطاعات حقيقة واحدة: العمل دون ترخيص ليس (شطارة)، بل تقويض مباشر لهيبة الدولة، لكنه أيضاً نتيجة مسؤولية مجتمعية مهملة. المخالف لا يعيش في فراغ، بل في سوق صنعه له المجتمع بتعامله، وتبريره، وصمته، حتى بدا وكأن من يعمل بلا ترخيص يتصرف فوق القانون دون مساءلة. القانون بلا وعي مجتمعي يبقى ناقص الأثر، كل فرد يختار التعامل مع غير المرخص لأنه أرخص أو أسرع، يشارك عملياً في تخريب النظام العام، كل من يتغاضى عن الترخيص، يتواطأ مع الفوضى. العمل من تحت الطاولة ليس مجرد مخالفة، بل خيانة لمعنى الدولة الحديثة التي تقوم على النظام، العدالة، وحماية الإنسان. والترخيص ليس ورقة شكلية، بل عقد أخلاقي بين المهنة والوطن. الرسالة يجب أن تكون قاطعة: لا مهنة بلا ترخيص. ولا سوق بلا قانون. ولا مجتمع واعٍ يساهم في صناعة الفوضى ثم يشتكي منها.
357
| 13 يناير 2026
في عالم يتغيّر بإيقاع غير مسبوق، ما زال نظامنا التعليمي يتعامل مع الزمن كأنه ثابت، وكأن عدد السنوات هو الضامن الوحيد للنضج والمعرفة. نحن نحسن عدّ السنوات، لكننا لا نراجع كفاءتها. نُطيل المراحل، لا لأن المعرفة تحتاج هذا الطول، بل لأن النظام لم يُسأل منذ زمن: هل ما زال توقيتنا مناسبًا لعصر يتسارع في كل شيء؟ الطفل اليوم يمتلك قدرة حقيقية على التعلّم والفهم والربط واكتساب المهارات الأساسية. ومع ذلك، نؤجّل بداية التعليم الجاد باسم الحذر، ثم نضيف سنوات لاحقة باسم التنظيم، ثم نقف أمام سوق العمل متسائلين: لماذا تتسع الفجوة بين التعليم والوظيفة؟ ولماذا يحتاج الخريج إلى تدريب إضافي قبل أن يصبح منتجًا؟ نتحدّث كثيرًا عن الفجوة بين التعليم وسوق العمل لكن قليلين فقط يطرحون السؤال الجوهري: ماذا لو لم تكن هذه الفجوة في نهاية المسار… بل في طوله؟ هل فعلا نحتاج جميع سنوات المراحل الدراسية بعدد سنواتها المقررة من أجيال مضت ؟ التعليم ليس عدد سنوات، بل كفاءة زمن. ليس المهم كم نُدرّس، بل متى وكيف ولماذا. حين نُطيل الطريق دون مراجعة أثره، لا ننتج معرفة أعمق بالضرورة، بل نؤجّل الإنتاج، ونؤخر الاستقلال المهني، ونضيف عبئًا زمنيًا على رأس المال البشري. ماذا لو أن جزءًا كبيرًا مما نحاول تعويضه عبر التدريب بعد التخرّج يمكن اختصاره أصلًا من سنوات دراسية مهدرة، لا تضيف كفاءة حقيقية، ولا تُعجّل النضج المهني، بل تؤجّل دخول الشباب إلى دورة الإنتاج. وهنا تظهر المفارقة الأهم: حين يلتحق الخريج مهنيًا في سن أصغر، لا يعني ذلك نقصًا في النضج، بل بداية مبكرة لتكوينه الحقيقي. النضج المعرفي والمهاري يتسارع في بيئة العمل. كلما دخل الشاب إلى السوق أبكر وهو يمتلك أساسًا علميًا ومهاريًا منضبطًا، بدأت قدرته على تحمّل أعباء العمل، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، والعمل تحت الضغط في التكوّن مبكرًا. التجربة المهنية لا تنتظر اكتمال العمر، بل تصنع النضج نفسه. وهكذا، فإن خريجًا يبدأ مساره في سن أصغر لا يصبح فقط منتجًا أسرع، بل يصل إلى مستويات أعلى من الكفاءة في وقت أقصر، لأن سنوات الخبرة تتراكم مبكرًا، وتتحول المهارات النظرية إلى ممارسة عملية في مرحلة عمرية أكثر مرونة وقدرة على التعلّم والتكيّف في الاقتصاد الحديث، الزمن ليس عنصرًا محايدًا. كل سنة إضافية خارج سوق العمل هي تكلفة غير منظورة على الفرد والأسرة والدولة. وكل سنة تأخير في التخرّج هي سنة تأخير في الإسهام والابتكار والإحلال الوظيفي وتراكم الخبرة الوطنية. ومع ذلك، ما زلنا نتعامل مع سنوات التعليم كأنها مُسلّمات لا تُمسّ ولا تُراجع؟ حين نبدأ التعليم مبكرًا، ونضغط المراحل دون المساس بالجودة، ونحوّل جزءًا من المحتوى النظري إلى مهارات عملية متدرجة، فإننا لا نختصر الوقت فحسب، بل نغيّر طبيعة العلاقة بين التعليم والإنتاج. الطالب لا يصل إلى الجامعة بعد سنوات طويلة من التلقين، بل بعد مسار أكثر تركيزًا، وأكثر ارتباطًا بالواقع، وأكثر قابلية للتحويل إلى مهارة سوقية. هذا ليس تقليصًا للتعليم، بل إعادة هندسة له حيث تتراكم المهارات في وقت أبكر، ويبدأ الاندماج المهني في مرحلة أقرب، وتُختصر تلك السنوات الرمادية التي لاتضيف كثيرا إلى الجاهزية المهنية. تسريع عجلة الإنتاجية لا يتحقق فقط عبر التكنولوجيا أو الاستثمارات، بل عبر إدارة الزمن البشري بذكاء. حين يدخل الشاب إلى سوق العمل أبكر وهو يمتلك أساسًا معرفيًا ومهاريًا متينًا، تبدأ دورة الإنتاج أسرع، ويبدأ التعلّم الحقيقي في الميدان مبكرًا، وتتحول سنوات الخبرة من عبء مؤجّل إلى رصيد متراكم. أما الإحلال في رأس المال البشري وهو أحد أكبر تحديات الاقتصادات الحديثة فلا يمكن تسريعه إذا ظلّت بوابة الدخول إلى السوق طويلة وممتدة. كل سنة إضافية في المسار التعليمي هي تأخير في ضخّ الدماء الجديدة إلى القطاعات، وتأخير في نقل الخبرة بين الأجيال، وتأخير في تمكين الكفاءات الوطنية من تولّي أدوارها. لسنا بحاجة إلى خريجين أكبر سنًا، بل إلى خريجين أكثر جاهزية. ولا نحتاج مسارًا أطول، بل مسارًا أذكى. كما لا نحتاج إلى ترميم الفجوة بعد أن تتشكّل، بل إلى منع تشكّلها من الأصل عبر إعادة النظر في زمن التعليم نفسه. حين لا يكون الوقت في صالح التعليم، يصبح الانتظار قرارًا لا ضرورة. ويغدو السؤال الحقيقي ليس: كم نُدرّس؟ بل: هل ما زال توقيتنا يخدم الإنسان والاقتصاد والمستقبل؟ التاريخ لا يتذكّر من حافظ على المدة، بل من امتلك الجرأة على مراجعتها.
1083
| 07 يناير 2026
حين تتكلم اللغة، فإنها لا تفعل ذلك طلبًا للاحتفاء، بل إعلانًا للسيادة. لا تتحدث من باب العاطفة، بل من موقع الوعي والقوة والمعرفة. ومع اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، لم تُنجز قطر كتابًا، بل أرست موقفًا حضاريًا واضحًا يقول إن اللغة ليست هامشًا ثقافيًا، بل ركيزة وجود، وأداة وعي، وعنوان ثقة لقد تلاقت الدلالة مع الزمن؛ يوم عالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر، ويوم وطني لدولة جعلت من الهوية مشروعًا، ومن الثقافة قرارًا، ومن اللغة استثمارًا استراتيجيًا وكأن التاريخ نفسه يتكلم، ليقول بوضوح لا يحتمل التأويل: هذا إنتاجنا، وهذه لغتنا، وهذه ثقتنا بأنفسنا وبمكاننا في العالم. هنا، لا تُصان العربية بالحنين، ولا تُرفع بالشعارات، بل تُبنى بالمشاريع، وتُحفظ بالعلم، وتُؤرَّخ بمنهج يليق بحضارتها من معجم إلى موقف حضاري: إن اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية لا يمكن قراءته بوصفه إنجازًا لغويًا معزولًا، بل هو تعبير عن رؤية دولة تدرك أن القوة الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن الحضور العالمي لا يُبنى فقط بالاقتصاد والسياسة، بل باللغة، والهوية، والعمق الثقافي. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن اكتمال هذا المعجم يمثل مظهرًا من مظاهر التكامل العربي المثمر، ويعزز تمسك الشعوب بهويتها مع انفتاحها الواثق على العصر. فالمعجم لا يعرّف الكلمات، بل يؤرخها، ولا يشرح الألفاظ، بل يكشف مسيرتها وتحولاتها وسياقاتها. إنه ينقل العربية من كونها لغة استعمال إلى لغة وعي، ومن كونها تراثًا محفوظًا إلى معرفة مُحلَّلة، ومن كونها لغة ماضٍ مجيد إلى لغة زمن ممتد يصل الماضي بالحاضر ويفتح أبواب المستقبل اللغة كقوة ناعمة في زمن العولمة: في عالم اليوم، لم تعد القوة تقاس فقط بما تملكه الدول من اقتصاد أو نفوذ، بل بما تملكه من سردية ثقافية قادرة على العبور والتأثير. وهنا تتجلى أهمية معجم الدوحة بوصفه أداة من أدوات القوة الناعمة. فتوثيق اللغة العربية تاريخيًا، وفق منهج علمي صارم، يمنحها قابلية أوسع للحضور في المنصات العالمية، والجامعات، ومراكز البحث، والتقنيات الرقمية. كما أنه يضع العربية في موقع الندّية مع لغات كبرى سبقتها في مشاريع التأريخ اللغوي، ويكسر الصورة النمطية التي تحصرها في إطار التراث أو القداسة وحدها، دون الاعتراف بديناميكيتها وقدرتها على التفاعل مع الحداثة. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة معجم الدوحة كجزء من استراتيجية ثقافية أوسع تعيد تعريف علاقة العرب بلغتهم، وعلاقة العالم بالعربية، ليس كلغة “آخر”، بل كلغة معرفة وشراكة إنسانية. انعكاسات الحدث… من الدوحة إلى العالم: هنا تبدأ الانعكاسات الكبرى. فمعجم الدوحة ليس مشروعًا عربيًا داخليًا فحسب، بل رسالة ثقافية عالمية. إنه يضع اللغة العربية على خريطة البحث اللغوي العالمي بوصفها لغة موثقة تاريخيًا وفق أعلى المعايير العلمية، وقابلة للاندماج في مشاريع الترجمة، والدراسات المقارنة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة المعرفة الرقمية. كما يعيد هذا المشروع تقديم العربية للعالم لا كلغة مقدسة فقط، بل كلغة إنسانية حيّة، ساهمت في تشكيل الفكر الإنساني، وشاركت في بناء الحضارة، وما زالت قادرة على الإسهام في خطاب العصر. ومن هنا، تتحول قطر عبر هذا المعجم إلى فاعل ثقافي عالمي، يمارس عولمة لغوية مختلفة،عولمة تقوم على المعنى لا الهيمنة، وعلى الهوية لا الذوبان، وعلى الشراكة المعرفية لا الاستهلاك الثقافي. العربية… لغة قرآن ولغة مستقبل ولا يمكن فصل هذا الإنجاز عن مكانة اللغة العربية في القرآن الكريم؛ فهي لغة الوحي، ولغة المعنى العميق، ولغة القيم. والعناية بتاريخها هي في جوهرها عناية بالرسالة التي تحملها، وبالإنسان الذي خُوطب بها. ومعجم الدوحة يعيد الربط بين قداسة اللغة وحيويتها، بين ثبات النص ومرونة اللفظ، بين الجذور العميقة وآفاق العصر. عولمة قطر اللغوية… حين تتكلم اللغة إن ما فعلته قطر عبر معجم الدوحة هو أنها قدّمت نموذجًا جديدًا للحضور العالمي: حضور لا يفرض نفسه بالقوة، بل بالمعرفة؛ لا يذوب في العولمة، بل يعيد تعريفها؛ ولا ينسخ تجارب الآخرين، بل يقدّم تجربته الخاصة بثقة ووضوح. وهكذا، حين تتكلم اللغة من الدوحة، فهي لا تخاطب العرب وحدهم، بل تخاطب العالم كله، قائلة: هذه لغة لها تاريخ، وهذه دولة تعرف وزن لغتها، وهذه أمة قادرة على أن تكون جزءًا من العالم… دون أن تفقد نفسها.
525
| 24 ديسمبر 2025
هناك ظاهرة متنامية في بعض بيئات العمل تجعل التطوير مجرد عنوان جميل يتكرر على الورق، لكنه لا يعيش على الأرض (غياب النضج المهني) لدى القيادات. وهذا الغياب لا يبقى وحيدًا؛ بل ينمو ويتحوّل تدريجيًا إلى ما يمكن وصفه بالتحوّذ المؤسسي، حالة تبتلع القرار، وتحدّ من المشاركة، وتقصي العقول التي يُفترض أن تقود التطوير. تبدأ القصة من نقطة صغيرة: مدير يطلب المقترحات، يجمع الآراء، يفتح الباب للنقاش… ثم يُغلقه فجأة. يُسلَّم له كل شيء، لكنه لا يعيد شيئًا، مقترحات لا يُرد عليها، أفكار لا تُناقش، وملاحظات تُسجَّل فقط لتكملة المشهد، لا لتطبيقها. هذا السلوك ليس مجرد إهمال، بل علامة واضحة على غياب النضج المهني في إدارة الحوار والمسؤولية. ومع الوقت، يصبح هذا النمط قاعدة: يُطلب من المختصين أن يقدموا رؤاهم، لكن دون أن يكونوا جزءًا من القرار. يُستدعون في مرحلة السماع، ويُستبعدون في مرحلة الفعل. ثم تتساءل القيادات لاحقًا: لماذا لا يتغير شيء؟ الجواب بسيط: التطوير لا يتحقق بقرارات تُصاغ في غرف مغلقة، بل بمنظومة تشاركية حقيقية. أحد أكثر المظاهر خطورة هو إصدار أنظمة تطوير بلا آلية تنفيذ، تظهر اللوائح كأحلام مشرقة، لكنها تُترك دون أدوات تطبيق، ودون تدريب، ودون خط سير واضح. تُلزم بها الجهات، لكن لا أحد يعرف “كيف”، ولا “من”، ولا “متى”. وهنا، يتحول النظام إلى حِمل إضافي بدل أن يكون حلاً تنظيميًا. في كثير من الحالات، تُنشر أنظمة جديدة، ثم يُترك فريق العمل ليخمن طريقة تطبيقها، وعندما يتعثر التطبيق، يُحمَّل المنفذون المسؤولية وتصاغ خطابات الإنذار. هذا المشهد لا يدل فقط على غياب النضج المهني، بل على عدم فهم عميق لطبيعة التطوير المؤسسي الحقيقي. ثم يأتي الوجه الأوضح للخلل: المركزية المفرطة، مركزية لا تُعلن، لكنها تُمارس بصمت. كل خطوة تحتاج موافقة عليا، كل فكرة يجب أن تُصفّى، وكل مقترح يمر عبر «فلترة» شخصية، لا منهجية. في هذا المناخ، يفقد الناس الرغبة في المبادرة، لأن المبادرة تصبح مخاطرة، لا قيمة. وهنا تتحول المركزية تدريجيًا إلى تحوّذ مؤسسي كامل. القرار محتكر. المبادرات محجوزة. المعرفة مقيّدة. والنظام الإداري يُدار بعقلية الاستحواذ، لا بعقلية التمكين. التحوّذ المؤسسي هو الفخ الذي تقع فيه الإدارات حين يغيب عنها النضج. يبدأ من عقلية مدير، ثم ينتقل إلى أسلوب إدارة، ثم يتحول إلى ثقافة صامتة في المؤسسة. والنتيجة؟ - تجميد للأفكار. - هروب للعقول. - فقدان للروح المهنية. - تطوير شكلي لا يترك أثرًا. أخطر ما في التحوّذ أنه يرتدي ثياب التنظيم والجودة واللوائح، بينما هو في جوهره خوف مؤسسي من المشاركة، ومن نجاح الآخرين، ومن توزيع الصلاحيات. القيادة غير الناضجة ترى الأفكار تهديدًا، وترى الكفاءات منافسة، وترى التغيير خطرًا، لذلك تفضّل أن تُبقي كل شيء في يدها حتى لو تعطلت المؤسسة بأكملها. القيادة الناضجة لا تعمل بهذه الطريقة. القيادة الناضجة تستنير بالعقول، لا تستبعدها. تسأل لتبني، لا لتجمّل المشهد. تُصدر القرار بعد فهم كامل لآلية تطبيقه. وتعرف أن التطوير المؤسسي الحقيقي لا يقوم على السيطرة، بل على الثقة، والتفويض، والوضوح، وبناء أنظمة تعيش بعد القائد لا معه فقط. ويبقى السؤال الذي يجب أن يُطرح بصراحة لا تخلو من الجرأة: هل ما نراه هو تطوير مؤسسي حقيقي… أم تحوّذ إداري مغطّى بشعارات التطوير؟ المؤسسات التي تريد أن ترتقي عليها أن تراجع النضج المهني لقياداتها قبل أن تراجع خططها، لأن الخطط يمكن تعديلها… لكن العقليات هي التي تُبقي المؤسسات في مكانها أو تنهض بها.
798
| 11 ديسمبر 2025
في زمن تتسارع فيه المتغيرات، وتتوسع فيه متطلبات التنمية، لم يعد العمل الحكومي التقليدي قادرًا على مواكبة حجم التحديات وتعقيدات التحول. اليوم، أصبحت الحاجة ملحّة إلى نماذج عمل أكثر مرونة، وأعلى تركيزًا، وأكثر قدرة على صناعة أثر سريع وملموس. ومن بين أكثر الأدوات التي أثبتت جدواها عالميًا، اللجان التركيزية داخل الوزارات؛ وهي لجان صغيرة محددة المهام، تُشكَّل لدراسة ملف أو تطوير جانب محدد بعمق، لتقدم حلولًا سريعة وواقعية، بدل الخطط المكتبية التي قد تبقى حبيسة الأدراج. هذه اللجان ليست مجرد هياكل إدارية، بل منصات تفكير مركّزة تتبنى ثقافة «العقل الجماعي»، حيث تتداخل الخبرات الوطنية من أكاديميين، متقاعدين، وقيادات تعمل على رأس مؤسسات أخرى أثبتت جدارتها، لتشكل روافد فكرية تغذّي هذه اللجان بوعي تجريبي لا يقدّره إلا من عاش بيئة العمل على حقيقتها. فمن غير المقبول أن تُهدر ثروة معرفية تراكمت لعقود لدى مبدعين خرجوا إلى التقاعد أو لدى قيادات أثبتت نجاحًا في جهات أخرى، بينما الوزارات بحاجة إلى تجاربهم داخل غرف القرار. وزارة التعليم: يمكن تشكيل لجنة تطوير منظومة التعليم العالي والتدريب المستمر، تكون مسؤولة عن مواءمة البرامج الأكاديمية مع سوق العمل، وتطوير رأس المال البشري الوطني. وزارة الصحة: تتشكل لجنة تُعنى بالخدمات الصحية الرقمية، لتقود ملف السجلات الطبية الموحدة، والمواعيد الذكية، وربط المنظومة وفق أعلى المعايير العالمية. وزارة البيئة والتغير المناخي: تتولى لجنة التحول الأخضر مهمة صياغة سياسات تقلل الانبعاثات وتعزز مشاريع الطاقة المستدامة. وزارة التنمية الاجتماعية: تُشكّل لجنة التمكين المجتمعي عبر استثمار خبرات المتقاعدين والاختصاصيين في التدريب والحوكمة والتنمية البشرية، ودمجهم في مبادرات تعزز المشاركة الوطنية. وزارة الداخلية: لجنة ابتكار خدمات الأمن الذكي، تستثمر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لصناعة تجربة خدمات أكثر سلاسة وفاعلية. وزارة المواصلات: لجنة متخصصة في النقل المستدام والأنظمة الذكية. وزارة التجارة والصناعة: لجنة تطوير البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات وتعزيز فرص الاستثمار الوطني والأجنبي. هذه اللجان تمثل عقلًا وطنيًا موجّهًا، يتكامل مع طموحات الدولة ويجسّد مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية. ومن عمق الرؤية تبرز فكرة تشكيل لجنة تركيزية متخصصة في كل وزارة، بحيث تُعنى كل وزارة بجانب إستراتيجي واحد تشرف عليه بتركيز كامل حتى يتحول إلى علامة فارقة وطنية في مجالها. محليًا، ظهرت ملامح هذه التجربة في لجان التحول الرقمي التي قادت تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وتبسيط الإجراءات، وأثبتت أن فرقًا صغيرة متخصصة تستطيع تحويل ملفات معقدة إلى قصص نجاح في وقت قياسي. وإقليميًا، جسدت رؤية السعودية 2030 نموذجًا حيًا عبر لجان تركيز طورت قطاعات حيوية مثل التخصيص، القدرات البشرية، والقطاع اللوجستي، لتصبح السعودية أحد أسرع الاقتصادات نموًا. عالميًا، يمكن استحضار تجربة سنغافورة في تطوير التعليم، وفنلندا في سياسات الرعاية الصحية، واليابان في الصناعة الذكية. جميعها اعتمدت لجان تركيز مصغرة، جمعت العقول، ودرست الفجوات بتركيز، ثم قدمت حلولًا عملية شكلت ثورة في مسار النهضة. إن أهم قيمة لهذه اللجان أنها تقلص البيروقراطية، وتُسرّع القرار، وتعمل بمؤشرات أداء واضحة ترتبط مباشرة بالرؤية الوطنية والتنمية المستدامة. كما أنها قادرة على خفض الهدر المالي، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات، وتعزيز التكامل بين الوزارات والجامعات والقطاع الخاص. آن الأوان لأن نتبنى في وزاراتنا نموذج اللجان التركيزية كمنهج عمل مستدام، يمنح صلاحيات للتحليل والتشخيص ووضع الحلول ومتابعة الأثر. فصناعة النهضة ليست شعارات، بل لجان تفكر، وخبرات تُستثمر، وقرارات تتحرر من القيود. ومن هنا، يصبح تشكيل لجان تركيزية داخل الوزارات قصة تحول وطني تليق برؤية 2030… وتليق بقطر.
444
| 02 ديسمبر 2025
في زمن تتسارع فيه المفاهيم وتتباين فيه مصادر التأثير، لم يعد سؤال (من يصنع القيم في المجتمع سؤالًا فلسفيًا، بل سؤال دولة تبحث عن تماسكها وهويتها وسط عولمة جارفة. فالقيم اليوم لا تُلقَّن… بل تُدار، وتُحكم، وتُصنع عبر منظومة متشابكة من الجهات. وهنا يظهر مفهوم الحوكمة المجتمعية بوصفه (الإطار الذي ينظم هذه المنظومة) ويمنحها الاتجاه الصحيح لضمان أن يبقى المجتمع ثابتًا رغم تغيّر العالم من حوله. الحوكمة الأسرية: الأسرة ليست مؤسسة صغيرة كما تبدو، بل هي أوّل نظام حوكمة يواجهه الإنسان في حياته. فيها يتعلم الاحترام، حدود الحرية، معنى المسؤولية، وكيف يُدار الخلاف. لكن المؤثرات الحديثة من الإعلام الرقمي إلى الألعاب الإلكترونية جعلت دور الأسرة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. لذلك تأتي الحوكمة هنا عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التي يقع على عاتقها بناء برامج دعم للأسرة، وتطوير سياسات للحماية الرقمية، وتقديم إرشادات عملية تعيد للوالدين القدرة على قيادة السلوك، فالأسرة المحكومة بوعي، تنتج مجتمعًا محكومًا بالقيم. الحوكمة التعليمية: المدرسة والجامعة مصانع لإعادة تشكيل العقل والقيم والانتماء. تتمثل الحوكمة التعليمية في إدماج القيم في المناهج عبر تجارب تطبيقية، وتدريب المعلمين على أن يكونوا قدوات قبل أن يكونوا ناقلي معرفة، وتقييم الأنشطة المدرسية والجامعية كأدوات لبناء السلوك. ويظهر دور مجلس الشورى هنا كجهة تشريعية تراقب سياسات التعليم، وتضمن أن مخرجاته تتوافق مع الاحتياجات الوطنية ومعايير الهوية. الحوكمة الإعلامية: الإعلام لم يعد ناقلًا للخبر، بل صانعًا للاتجاهات والقيم الجديدة. وتحتاج حوكمة الإعلام إلى سياسات تحمي المجتمع من المحتوى الهادم والهش، وآليات لمراقبة الانحرافات الرقمية، وتشجيع الابتكار الإيجابي في صناعة المحتوى. وهذا ما يقع ضمن مسؤوليات وزارة الإعلام التي تقود التوازن بين الحرية والهوية، وبين الإبداع وضبط التأثير. الحوكمة الدينية: القيم الدينية هي الأساس الذي يقوم عليه الضمير الأخلاقي للمجتمع. وتتجلى حوكمة الأوقاف في خطب معاصرة تربط القيم بالواقع، وبرامج شبابية تمنح روح الدين بُعدًا إيجابيًا، وإعداد كوادر دينية قادرة على التأثير بلغة يفهمها الجيل الجديد. الدين حين يُحكم بوعي… يصبح عامل وحدة لا عامل خوف. الحوكمة الثقافية: الثقافة ليست فعاليات أو احتفالات، بل هي الذاكرة الجمعية للمجتمع. وتقود وزارة الثقافة حوكمتها عبر دعم التراث واللغة العربية، وإنتاج محتوى ثقافي ينافس عالميًا، وأنشطة تعزز الانتماء وتعيد الاعتزاز بالهوية القطرية. الحوكمة التشريعية: لا يمكن لأي منظومة قيم أن تستمر دون تشريعات. ومجلس الشورى هو الضامن لوجود قوانين تحمي الأسرة، وتنظم التعليم والإعلام، وتدعم الثقافة، وتراقب تنفيذ السياسات. إنه الحارس التشريعي للهوية والقيم واستدامتها. القيم لا تُصنع بجهة واحدة، ولا تُدار بالعاطفة. إنها مشروع وطني وعندما تعمل هذه المنظومة بتناغم… ينهض المجتمع بقيمه، ويواجه العالم بثقة، ويحمي هويته من التشتت والذوبان.
939
| 25 نوفمبر 2025
تحمل كلمة «الحوكمة» في المخيال الشعبي العربي قدراً من الغموض والالتباس. يربطها كثيرون بالبيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ويختزلونها في لوائح جامدة تعطل الإنجاز. لكن تعريف الحوكمة يوضح أنها مجموعة من القواعد والمعايير والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المنظمة والعاملين فيها وأصحاب المصلحة لتحقيق العدالة، والشفافية، والمصداقية، والاستدامة. الهدف إذن ليس تقييد المؤسسات، بل تحريرها من الفوضى وتحويلها إلى كيانات مسؤولة تستجيب لمطالب المجتمع. يعود جزء من سوء الفهم إلى التركيز على الجانب التنظيمي وإهمال روح الحوكمة. في قطاع التدريب مثلاً يعتقد البعض أن الحوكمة تعني تشديد الرقابة على الدورات وحصرها في قوالب جامدة. غير أن الخبراء يوضحون أن حوكمة التدريب لا تقتصر على ضبط السياسات والإجراءات، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تعزز المساءلة، وتربط أهداف التدريب مباشرة بالرؤية المؤسسية، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد التدريبية. إن تبني إطار متكامل يربط التدريب بالأهداف الإستراتيجية، ويقيس أثره على الأداء، يحوّل التدريب من نشاط تكميلي إلى أداة لتحسين الأداء وتطوير الكفاءات. وفي التعليم، يُعد تطبيق الحوكمة أساساً للنهوض بالمدارس والجامعات. إذ تعرف بأنها النظام الذي يوجّه ويُدير ويُراقب القطاع التعليمي لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة وشفافية ومساءلة. تتضمن الحوكمة التعليمية عناصر مثل الشفافية والمشاركة والمحاسبة والكفاءة. فهي تتيح لأولياء الأمور والطلاب والإداريين المشاركة في صنع القرار، وتضمن أن الموارد تُستخدم بفعالية، وأن النتائج التعليمية تُقاس وتُعلَن بشفافية. تكشف الدراسات أن الأنظمة التعليمية التي تبنت حوكمة فعالة شهدت تحسناً في جودة المخرجات وتقليصاً للهدر والفساد. أما القطاع الصحي، فبعض العاملين فيه يرون الحوكمة عبئاً إضافياً على العمل الطبي. لكن الحقيقة أن الحوكمة الصحية تعني ضمان إدارة الخدمات الصحية بشفافية ومسؤولية وعدالة. تقوم على مبادئ المساءلة والشفافية والكفاءة والعدالة، وتستخدم أدوات تقنية مثل أنظمة المعلومات الصحية لتسجيل البيانات وتحليلها وتحسين الأداء. بتطبيقها، يمكن تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين توزيع الموارد، وضمان حصول جميع المرضى على رعاية عادلة، بعيداً عن الولاءات والمحسوبية. وفي البيئة، تشير الحوكمة إلى مجموعة الإجراءات التي ترشد تعامل الإنسان مع بيئته للحفاظ على الموارد الطبيعية. فهي تتخطى الإدارة التقليدية التي تركز فقط على حماية الطبيعة، لتشمل الأبعاد الإنتاجية والاجتماعية وتحفّز المشاركة والمسؤولية المشتركة. هذه الحوكمة تدعو إلى صياغة سياسات واضحة لإدارة المياه والطاقة والنفايات، وإشراك المجتمع المدني في مراقبة تنفيذها. عندما تصبح حماية البيئة جزءاً من ثقافة المجتمع ومنظومة المؤسسات، يتحول الحديث من منع التلوث إلى تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. القطاع الاجتماعي أو غير الربحي يقدم مثالاً آخر لكيفية تحرير الحوكمة للعمل الخيري. فالقواعد المعتمدة لتنظيم الجمعيات والمؤسسات الأهلية تهدف إلى تطوير أدائها وتعزيز مساهمة الأفراد والداعمين ورفع كفاءة الشفافية والإفصاح. وهي تضمن أن التبرعات تُستخدم كما ينبغي، وأن القرارات تُتخذ بشكل تشاركي، ما يعزز ثقة المجتمع في العمل الخيري ويشجع المزيد من العطاء. إن الحوكمة إذن ليست قيداً، بل أداة تمكين. فهي تحرر المؤسسات من الشخصنة والفوضى، وتمنح أصحاب المصلحة الحق في الشفافية والمساءلة. من التعليم إلى التدريب، ومن الصحة إلى البيئة والقطاع الاجتماعي، تبرهن الحوكمة على قدرتها في تحسين الأداء وتعزيز العدالة. والمطلوب منا اليوم تغيير ثقافتنا، والانفتاح على هذا المفهوم باعتباره مدخلاً لتطوير مؤسساتنا وفتح آفاق جديدة للتنمية، لا كعبء بيروقراطي يرهقها.
213
| 20 نوفمبر 2025
على مدى أكثر من ستة عقود، تستثمر الدولة في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها. تستثمر في صحته ليكون معافى قادرًا على العطاء، وفي تعليمه ليكون وعيه أساس البناء، وفي تأهيله المهني ليقود عجلة الإنتاج، وفي دعمه النفسي والاجتماعي ليبقى متوازنًا فاعلًا في مسيرة الوطن. لقد كان - وما زال - الاستثمار في الإنسان هو الخيار الإستراتيجي الأذكى الذي صاغ ملامح النهضة الحديثة للدولة، ورسّخ مكانتها بين الأمم من خلال الإيمان بأن التنمية تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه. غير أن مرحلة التقاعد، على أهميتها، تحوّلت لدى كثير من الأفراد إلى نقطة توقف لا انتقال. فبعد سنوات طويلة من الخبرة والعطاء، يُحال الموظف إلى التقاعد لينسحب بهدوء من المشهد العملي والمجتمعي، فتُطوى معه خبرات ميدانية متراكمة وذاكرة وطنية غنية بالتجارب. إن ما نملكه اليوم من طاقات بشرية متقاعدة يشكّل رصيدًا وطنيًا غير مستثمر يحتاج إلى آلية منهجية لإعادة دمجه في دورة التنمية. وفي خطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أُشير بوضوح إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الضمانة الأولى لمستقبل الدولة. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة استثمار طاقات المتقاعدين لا تُعد ترفًا اجتماعيًا، بل ركيزة من ركائز التنمية البشرية المستدامة. التقاعد في جوهره ليس نهاية الخدمة، بل بداية مرحلة جديدة من العطاء، غير أن كثيرًا من المتقاعدين يواجهون تحديات معقدة في هذه المرحلة. فمنهم من يشعر بفقدان الهوية المهنية بعد أن كان اسمه مرتبطًا بوظيفة أو منصب رسمي، ومنهم من يعيش فراغًا يوميًا بعد عقود من الالتزام والانضباط، ومنهم من يواجه تراجعًا في المكانة الاجتماعية أو شعورًا بانقطاع الدور. وهذه التحديات لا تمس المتقاعد وحده، بل تمتد آثارها إلى المجتمع، إذ يخسر المجتمع خبرة تراكمية ضخمة. اتجاهات مقترحة لإعادة توظيف المتقاعدين: 1. مبادرة “المدرب المجتمعي”: تأهيل المتقاعدين ليكونوا مدربين في مجالات القيم، والهوية الوطنية، والتنمية الشخصية والمهنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ليصبحوا جسورًا تربط الأجيال وتغذي المجتمع بخبرات حقيقية. 2. مراكز “حاضنة القيم”: إنشاء حاضنات مجتمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تعمل على استثمار المتقاعدين كموجهين ومرشدين للأسر والشباب، بما يعزز الترابط الاجتماعي وينقل الخبرة الإنسانية إلى المجال التطبيقي. 3. العمل التطوعي المؤسسي: إدماج المتقاعدين ضمن المنظومة الوطنية للتطوع ببرامج نوعية، بحيث يتم توظيف خبراتهم في المبادرات المجتمعية والتنموية، مما يمنحهم قيمة إضافية ويعزز رأس المال الاجتماعي للوطن. إن التقاعد لا يعني نهاية الدور، بل بداية فصل جديد من العطاء، والدولة التي تستثمر في الإنسان منذ أكثر من ستين عامًا قادرة على أن تحوّل هذه الخبرات إلى قوة تنموية ناعمة ترفد المجتمع بخبرة، وتثري الأجيال الجديدة بوعي وتجربة. إن إعادة استثمار المتقاعدين ليست مسألة إنسانية بل خيار تنموي إستراتيجي ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويؤكد أن الإنسان القطري يظلّ شريكًا في التنمية مهما تقدّم به العمر.
5028
| 11 نوفمبر 2025
من الطرائف العجيبة أن تجد اسمك يتصدر أجندة مؤتمر لم تُدعَ إليه أصلًا، وتكتشف أنك فجأة “قصة نجاح ملهمة” ضمن برنامج لم تسمع عنه. نعم، نحن في زمنٍ صار فيه (الاستعارة) أسلوب إدارة، و(الانتحال) وسيلة للتنظيم، والسطو على الأسماء أقصر طريق لرفع مستوى حدثٍ بائس لا يجد ما يقدمه سوى الظلال. لكن الأكثر غرابة أن تفاجأ بعد انتهاء الملتقى بأن اسمك كان في أجندة اليوم الأول، وأن الحضور كانوا ينتظرونك! يتصل البعض مستفسرًا “ليش ما التزمتِ بالحضور؟ كنا نبي نسمع قصة نجاحج ؟ وها أنا أمام مشهدٍ عبثي: ملتقيات تنشر اسمك دون إذن، ثم تُحمّلك مسؤولية الغياب! أي عبث هذا الذي يحوّل غياب الدعوة إلى (تقصير شخصي) ويجعل من الضحية موضع تساؤل؟ إنه ليس مجرد سوء تنظيم، بل تشويه للسمعة تحت غطاء الاحتفاء. ما حدث ليس خطأ بروتوكوليًا عابرًا، بل فوضى مهنية تُمارس بلباقة شكلية، خلفها عقل تنظيمي يعتقد أن وضع اسم معروف على غلاف الملتقى يكفي لتلميعه. هذه ليست شراكة، بل قرصنة ناعمة على الرصيد المهني للآخرين. هل يعقل أن يصبح اسم المتحدث جزءًا من الديكور الإعلامي؟ يوضع إلى جانب الشعار والموسيقى الافتتاحية؟! وكأن الحضور مجرد ديكور شرفي لحدثٍ لا يعرف معنى التنظيم، ولا يفرّق بين التكريم والاستغلال. الغريب أن هذه الجهات نفسها تتحدث في بياناتها عن تمكين الكفاءات، والتميز المهني والقيم المؤسسية، بينما تفشل في أبسط مظاهر الاحترافية: التواصل الرسمي والدعوة الصريحة. كيف نثق بملتقى لا يعرف كيف يرسل دعوة؟ كيف نقنع الجيل الجديد أن النزاهة هي أساس العمل، وهم يرون بعض المؤسسات تقتبس النجاحات وتلصقها بلا خجل؟ المؤتمرات لا تُقاس بعدد الأسماء اللامعة في جدولها، بل بصدق الفكرة، ودقة التنظيم، واحترام العقول. فالمشكلة ليست في الحدث نفسه، بل في العقلية التسويقية التي تعتقد أن النجاح يمكن استعارته مثل صورة من الإنترنت. كلمة “ملتقى” يجب أن تعني التقاء الفكر لا التقاء الشعارات. والتنظيم لا يعني تكديس فقرات وكلمات وتصفيقات، بل إدارة واعية تعرف متى تدعو، ومتى تعتذر، ومتى تصمت. رسالتي إليهم: إذا كنتم تبحثون عن الحضور الإعلامي، فابنوه بأنفسكم. لا تستوردوا قصص نجاح الآخرين لتلميع فعالياتكم. فالنجاح لا يُستعار، ولا يُستنسخ، ولا يُستخدم لتغطية سوء التنظيم. وشكرًا على المشاهدة… حتى وإن لم أحضر!.
1494
| 04 نوفمبر 2025
نعم، أصبحنا نعيش زمنًا يُتاجر فيه بالفكر كما يُتاجر بالبضائع، تُباع فيه الشهادات كما تُباع السلع، وتُؤجّر فيه المنصات التدريبية كما تُؤجّر القاعات لحفلات المناسبات. هو زمنٌ تحوّلت فيه «المعرفة إلى سلعة» تُسعَّر، لا رسالة تُؤدَّى. تتجلّى مظاهر «الاتّجار المعرفي» اليوم في صور عديدة، لعلّ أبرزها «المؤتمرات والملتقيات التدريبية والأكاديمية» التي تُقام بأسماء لامعة وشعارات براقة، يدفع فيها الحضور مبالغ طائلة تحت وعودٍ بالمحتوى النوعي والتبادل العلمي، ثم لا يخرج منها المشاركون إلا بأوراق تذكارية وصورٍ للمنصات! وهنا «العجيب من ذلك، والأغرب من ذلك»، أنك حين تتأمل هذه الملتقيات، تجدها تحمل أربعة أو خمسة شعارات لمؤسساتٍ وجهاتٍ مختلفة، لكنها في الحقيقة «تعود إلى نفس المالك أو الجهة التجارية ذاتها»، تُدار بأسماء متعدّدة لتُعطي انطباعًا بالتنوّع والمصداقية، بينما الهدف الحقيقي هو «تكرار الاستفادة المادية من الجمهور نفسه». هذه الفعاليات كثير منها أصبح سوقًا مفتوحًا للربح السريع، لا للعلم الراسخ؛ تُوزَّع فيها الجوائز بلا معايير، وتُمنح فيها الألقاب بلا استحقاق، وتُقدَّم فيها أوراق بحثية أو عروض تدريبية «مكرّرة، منسوخة، أو بلا أثرٍ معرفي حقيقي». وهذا الشكل من الاتّجار لا يقل خطورة عن سرقة البيانات أو بيع الحقائب التدريبية، لأنه يُفرغ الفضاء الأكاديمي من جوهره، ويُحوّل «الجهد العلمي إلى طقسٍ استعراضي» لا يصنع معرفة ولا يضيف قيمة. فالمعرفة الحقيقية لا تُشترى بتذكرة حضور، ولا تُختزل في شعار مؤتمر، ولا تُقاس بعدد الصور المنشورة في مواقع التواصل. من جهةٍ أخرى، يتخذ الاتّجار بالمعرفة اليوم وجهًا «رقميًا سيبرانيًا أكثر تعقيدًا»؛ إذ تُباع البيانات البحثية والمقررات الإلكترونية في «الأسواق السوداء للمعلومات»، وتُسرق الأفكار عبر المنصات المفتوحة، ويُعاد تسويقها تحت أسماء جديدة دون وعيٍ أو مساءلة. لقد دخلنا مرحلة جديدة من الاتّجار لا تقوم على الجسد، بل على «استغلال العقول»، حيث يُسرق الفكر ويُباع الإبداع تحت غطاء “التعاون الأكاديمي” أو “الفرص البحثية”. ولذلك، فإن الحديث عن «أمن المعرفة» و»السلامة السيبرانية في التعليم والتدريب» لم يعد ترفًا، بل ضرورة وجودية لحماية رأس المال الفكري للأمم. على الجامعات ومراكز التدريب أن تنتقل من مرحلة التباهي بعدد المؤتمرات إلى مرحلة «قياس الأثر المعرفي الحقيقي»، وأن تُحاكم جودة المحتوى لا عدد المشاركين. الاتّجار بالمعرفة جريمة صامتة، لكنها أخطر من كل أشكال الاتّجار الأخرى، لأنها «تسرق الإنسان من داخله»، وتقتل ضميره المهني قبل أن تمس جيبه. وحين تتحوّل الفكرة إلى تجارة، والمعرفة إلى وسيلة للشهرة، يفقد العلم قدسيته، ويصبح المتعلم مستهلكًا للوهم لا حاملًا للنور.
6858
| 27 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية

المتأمِّل الفَطِن في المسار العام للسياسة السعودية اليوم...
690
| 21 يناير 2026

برحيل والدي الدكتور والروائي والإعلامي أحمد عبدالملك، فقدت...
672
| 25 يناير 2026

يُعدّ مبدأ العطاء أحد الثوابت الإنسانية التي تقوم...
627
| 22 يناير 2026

ليس كل من ارتفع صوته في بيئة العمل...
576
| 26 يناير 2026

بحكم أنني متقاعدة، وبحكم أكبر أنني ما زلت...
549
| 25 يناير 2026

لا أكتب هذه السطور بصفتي أكاديميًا، ولا متخصصًا...
534
| 22 يناير 2026

«التعليم هو حجر الزاوية للتنمية… ولا وجود لأي...
459
| 21 يناير 2026

لم يعد الزواج عند كثيرين لحظة بناء بيت...
447
| 25 يناير 2026

لم أكتب عن النّاقة مصادفة، ولكن؛ لأنها علّمتني...
417
| 27 يناير 2026

سوريا ليست بلدًا قاحلًا، أو منزويًا في الخريطة...
411
| 23 يناير 2026

لا تدخر دولة قطر جهدا في العمل الدؤوب...
402
| 21 يناير 2026

في عالم تتسارع فيه الهموم وتتشابك فيه الأزمات،...
363
| 23 يناير 2026
مساحة إعلانية