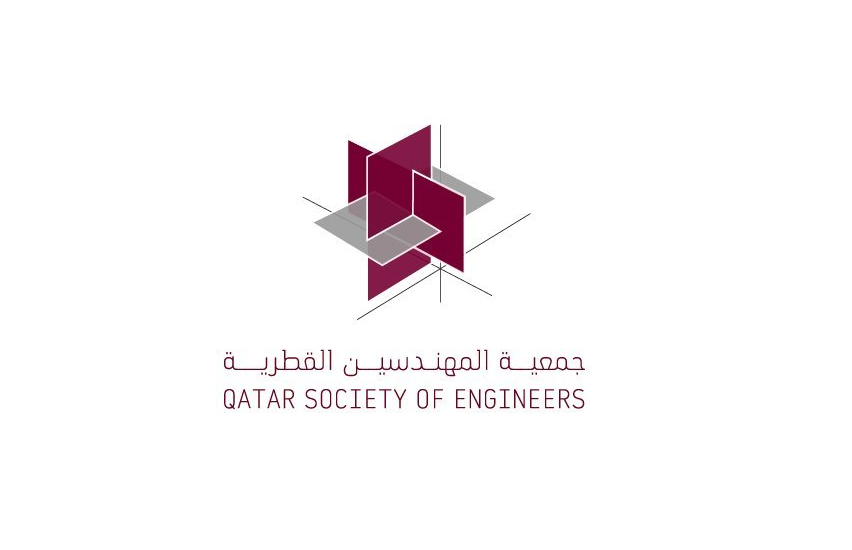رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا أكتب هذه السطور بصفتي أكاديميًا، ولا متخصصًا في المناهج التعليمية، ولا أدّعي امتلاك ناصية العلوم التربوية أو أدواتها؛ بل أعترف ـ بكل تواضع ـ بأن سموَّ مهنة التعليم وعمقها يتجاوزان حدود إمكاناتي المتواضعة. غير أن ما يدفعني للكتابة هو حصيلة تجربة حياتية ومهنية امتدت لثلاثة عقودٍ ونيف في مجالات الإدارة والمشاريع والصناعة داخل الوطن وخارجه، تخللها احتكاك مباشر بقيادات ومسؤولين في شركات عالمية. ويُضاف إلى ذلك معايشة واقعية لنظامين تعليميين مختلفين: نظامٍ قديمٍ عاصرته بكل صرامته وشحّ إمكاناته، ونظامٍ حديثٍ أعايشه اليوم من خلال رحلة أبنائي التعليمية، وصولًا إلى تخرّجهم وانخراطهم في معترك الحياة العملية وتحدياتها. لقد كان النظام التعليمي القديم ـ رغم محدودية أدواته ـ نظامًا صارمًا ومُثقلاً بالمناهج، يرتكز على الحفظ المكثف وتكديس المعلومات؛ حتى غدت الحقيبة المدرسية عبئًا ماديًا وفكريًا، وسادت ثقافة «النجاح والرسوب» على حساب الفهم والتحليل والتعبير. أما النظام الحديث، فقد جنح في كثير من نماذجه إلى «النجاح المضمون»، والمبالغة في الدرجات المرتفعة والشهادات التقديرية، دون رؤية واضحة للأهداف التعليمية أو المخرجات القابلة للقياس. وكانت النتيجة في الحالتين ـ من وجهة نظري ـ مخرجاتٍ لا ترتقي إلى حجم الطموحات، ولا توازي الموازنات المالية الضخمة المخصصة لها؛ وهو ما تتجلى آثاره لاحقًا في المرحلة الجامعية، ثم تظهر الفجوة بشكلٍ أعمق عند مواجهة متطلبات سوق العمل. وفي هذا السياق، أطرح مجموعة من التساؤلات لعلها تكون مشروعة، كنوعٍ ـ كما يُقال ـ من «التفكير خارج الصندوق (Thinking outside the box)»: 1. هل الامتحانات الفصلية بجميع أشكالها ضرورة حقيقية تعكس مستوى وقدرات الطالب العلمية والإبداعية، أم أنها أصبحت غاية بحد ذاتها؟ 2. هل الحضور والغياب اليومي الروتيني يضمن التحصيل والانضباط، أم أنه إجراء شكلي لا علاقة له بالتحصيل العلمي وبناء الثقة والإبداع؟ 3. هل لا يزال الاعتماد على الورق (كتبًا ودفاتر) ضرورة مُلحّة في عصر التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي؟ وهل نحن مستعدون لمستقبلٍ ـ ليس ببعيد ـ قد يصبح فيه المعلم «روبوتًا ذكيًا» أو نظامًا برمجيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة العملية التعليمية؟ 4. لماذا يُحصر التعليم داخل أربعة جدران إسمنتية صمّاء؟ ولماذا لا يمتد إلى المكتبات العامة، والمساجد، والرحلات، والمنشآت الرياضية؛ بحيث تصبح المدرسة «مركزًا تعليميًا مجتمعيًا» (Community Hub)، ومنارةً ثقافيةً وتعليميةً ورياضيةً للحي (الفريج) بأكمله؟ 5. لماذا تُفرض على الطالب مواد لا تتناسب مع ميوله وقدراته وشغفه وطموحه؟ ولماذا لا يُمنح مساحة حقيقية لاختيار مواده بما يتوافق مع ميوله وقدراته ضمن مسارات واضحة؟ 6. هل تضمن المناهج الحالية بناء شخصية متوازنة تعتز بثقافتها ودينها ولغتها وهويتها؟ 7. لماذا لا يُمنح الطالب حق اختيار معلمه، كما هو معمول به ـ على سبيل المثال ـ في كثير من الجامعات؟ 8. هل ما زالت المدرسة هي المصدر الرئيس للتحصيل العلمي؟ أم أصبح المدرس الخصوصي هو الوعاء الحقيقي للتحصيل؟ 9. على أي معايير تُبنى المناهج التعليمية؟ وهل لا تزال تُصاغ بعقلية «التوظيف الحكومي» التقليدية؟ إن حصر مخرجات التعليم في هذا الإطار الضيق لا يؤدي فقط إلى تكدّس الخريجين، بل يُحوِّل الكادر البشري إلى عبء يُرهق كاهل الموازنة العامة للدولة، ويُعمّق فجوة العزوف عن القطاع الخاص. 10. هل عزوفنا عن زيارة المكتبات العامة مرتبط بالنظام التعليمي؟ ولماذا لا تُنشأ مكتبات داخل المجمعات التجارية أو الفضاءات المجتمعية؟ 11. هل أصبح دور المدرسة مجرد ملء وظائف إدارية، أم أنها منارة لنشر الثقافة والعلم والمعرفة؟ 12. هل يُعدّ الرفاه الاقتصادي و«بحبوحة العيش» للمجتمع عائقًا غير مباشر أمام تطوير المناهج التعليمية؟ 13. لماذا لا يتم التنسيق مع القطاع الخاص والشركات والهيئات لتخصيص زوايا تعليمية للأطفال في المجمعات التجارية والحدائق، كجزء من المسؤولية الاجتماعية (Corporate Social Responsibility)؟ 14. لماذا لا تتبنى وزارة التربية والتعليم إستراتيجيةً أسوةً بالنماذج الناجحة في «قطر للطاقة» ووزارة الداخلية؟ وذلك عبر استقطاب المتفوقين من أبنائها واحتضانهم مبكرًا من خلال برامج الرعاية والابتعاث (Sponsorship)، بما لا يضمن فقط سد الفجوة المهنية والإدارية، بل يمثل أداة عملية وفعّالة لتوطين مهنة التدريس في شتى التخصصات؟ 15. هل يخضع مديرو المدارس ـ ممن لا يملكون خبرة إدارية أو حتى مالية ـ لبرامج تأهيلية، وفترة «تسليم وتسلم» مبرمجة قبل مباشرتهم العمل؟ إن إدارة المدرسة ـ في نظري ـ أصعب وأعقد بكثير من إدارة الشركات والمصانع؛ لذا يجب ضمان استدامة العمل بحرفية عالية، وتجنب العثرات والأخطاء الناتجة عن نقص الخبرة الإدارية. «إننا بلا شك نُثمن ونقدّر كافة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم، ولكن ما أطرحه هنا ليس انتقادًا، بل دعوةٌ لإعادة صياغة العلاقة مع الطالب؛ ليكون هو «محور العملية التعليمية» وهدفها الأسمى. فنحن لا نعدّ طالبًا لمقاعد الدراسة فحسب، بل نُهيئ إنسانًا سيكون غدًا المسؤول والقائد، ورب الأسرة أو ربة البيت، والعنصر الفاعل في نهضة المجتمع؛ لذا فهو يستحق بيئةً قوامها الاحتواء والثقة والدعم، لا الإكراه والضغط والتلقين». إن إصلاح التعليم يبدأ بتغيير فلسفته الكلية؛ ليصبح الشعار: «التعلّم من أجل التفكير والتعبير والتدبير… لا من أجل رصد الحضور وتجاوز الاختبار». وختامًا: فإن أي تطوير للمناهج يجب ألا يظل حبيس الغرف المغلقة للأكاديميين والتربويين وحدهم؛ بل لا بد من بناء «شراكة إستراتيجية» تشمل أولياء الأمور وخبراء سوق العمل، وبالأخص القطاعين الصناعي والخاص؛ لضمان صياغة منظومة تعليمية متكاملة تلبّي احتياجات سوق العمل وتستشرف آفاق المستقبل.
543
| 22 يناير 2026
منذ انطلاقته الأولى عام 2013 كسباقٍ لنصف الماراثون، لم يتوقف "ماراثون أوريدو الدوحة" عن التطور، حتى غدا اليوم أحد أكبر الفعاليات الرياضية، وموعدًا سنويًا يترقبه آلاف المشاركين من الداخل والخارج. وقد نجح الحدث في خلق حالة من الزخم الرياضي والمجتمعي، محوّلًا الدوحة إلى وجهةٍ مفضّلة للعدّائين، ومثبتًا أقدامه كأحد أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى الخليج والشرق الأوسط. ورغم قِصر عمره الزمني مقارنةً بالماراثونات العالمية العريقة - كماراثونات نيويورك ولندن وباريس وبرلين، بل وحتى ببعض الماراثونات الإقليمية كماراثون دبي - إلا أن "ماراثون أوريدو الدوحة 2026" استطاع بلمسات تنظيمية واعدة أن يحجز لنفسه مكانًا متقدمًا بين السباقات المتميزة في المنطقة. وبذلك، لم يعد الماراثون مجرد سباقٍ عابر، بل تحوّل إلى واجهةٍ سياحية وثقافية تعكس صورة قطر الحديثة، وفرصةٍ استراتيجية لتعزيز السياحة الرياضية عبر فعاليات مرافقة تُبرز الهوية القطرية، وتُرسّخ مكانة الدوحة كعاصمةٍ رياضية نابضة بالحياة، ومنصةٍ عالمية للفعاليات الكبرى. غير أن من الأهمية بمكان - من وجهة نظري - إدراك أن ماراثون الدوحة يجمع اليوم بين بُعدين متكاملين: بُعد "مهرجان الجري المجتمعي" بفعالياته المتنوعة، وبُعد "الماراثون التنافسي الاحترافي" الذي يستهدف نخبة العدّائين. وإذا كان الطموح هو المنافسة على الساحة العالمية، فلا بد من تعزيز البعد الثاني بصورةٍ أكبر؛ ذلك أن شريحة واسعة من العدّائين المحترفين المصنفين دوليًا تتنقل بين العواصم بحثًا عن المنافسة الجادة وتحسين أرقامهم الشخصية، وهؤلاء يشكّلون المحرك الحقيقي لسمعة الماراثونات عالميًا. لذا، ينبغي أن يظل ماراثون الدوحة - جنبًا إلى جنب مع طابعه المجتمعي - ماراثونًا تنافسيًا مرموقًا بمعايير فنية دولية، لضمان استقطاب نخبة العدّائين العالميين. وفي سياق رصد الآراء الميدانية، فقد جمعني حديثٌ مع أحد الأشقاء الخليجيين من المشاركين المخضرمين في كبرى الماراثونات العالمية والخليجية، حيث أبدى إعجابه بالتنظيم الحالي وأثنى على جودة الترتيبات. وعند سؤاله عن أبرز مقترحات التطوير، طرح رؤيةً عملية تهدف إلى الارتقاء بالماراثون ليكون ضمن أفضل عشرة سباقات عالميًا. ومن أهم ما أشار إليه: ضرورة رفع الطاقة الاستيعابية عبر توسعة القرية الرياضية وتطوير مسارات خط النهاية لتفادي الازدحام، مع زيادة المرافق الخدمية مثل دورات المياه ونقاط حفظ الأمتعة بما يضمن انسيابية الحركة وسلاسة التجربة، فضلًا عن تعزيز الجانب التجاري عبر توفير مستلزمات رياضية متنوعة بأسعار تحفيزية للمشاركين، بما يضيف بُعدًا اقتصاديًا وتسويقيًا يليق بحجم الحدث. إن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة جهود تنظيمية دؤوبة. كما أن معالجة هذه الملاحظات التطويرية ستُسهم بلا شك في رفع جودة التجربة، وتعزيز قدرة الماراثون على استقطاب النخبة عالميًا، وترسيخ مكانة الدوحة كمركزٍ ريادي للسباقات الطويلة. ومع استمرار هذا التطور، يبقى الطموح مشروعًا في أن يصبح "ماراثون الدوحة" علامةً فارقة في أجندة الرياضة العالمية.
204
| 19 يناير 2026
يُعَدّ مطار حمد الدولي أحد أبرز الصروح والإنجازات في قطاع الطيران العالمي والخدمات اللوجستية التي نفخر بها جميعًا؛ فمنذ انطلاقته، نجح في إعادة صياغة معايير التميز، محتلاً مكانةً ريادية بين نخبة مطارات العالم، سواء من حيث التصميم المعماري، أو الكفاءة التشغيلية العالية، أو جودة الخدمات المقدَّمة للمسافرين. ويُجسِّد المطار بوابةً وواجهةً رائعة ومشرّفة لجميع الزوّار والسياح، حيث يعكس صورة حضارية متقدمة منذ اللحظة الأولى، ويُعد مثالاً يُحتذى به في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية. ونُثمن جهود الإدارات والقيادات السابقة التي أرست قواعد هذا النجاح، ونتمنى التوفيق للإدارة الحالية لمواصلة مسيرة التطوير والبناء، بما يعزّز قيم الابتكار والاستدامة والإبداع، ويواكب تطلعات المستقبل، ويرتقي بتجربة المسافرين إلى مستويات أكثر تميزًا. وبشكل عام، تُصنَّف خدمات المطارات ضمن «الخدمات العامة ذات المنفعة الاجتماعية» (Public Services Merit Goods)، حيث تُقدَّم جودة الخدمة، ومعايير السلامة، وكفاءة التشغيل على مبدأ الربحية الضيقة. فالهدف الجوهري لهذه المرافق لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية مباشرة، بل يمتد لضمان انسيابية الحركة، والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين. ورغم وجود أنشطة تجارية ربحية كالأسواق الحرة والمطاعم، إلا أن «الخدمات التشغيلية الأساسية» تظل أولوية قصوى لا يجوز المساس بجودتها تحت أي ظرف. ومن خلال التجربة الميدانية، لوحظ أن بعض الأنظمة التقنية المخصصة لتسريع إجراءات الدخول (Self Service Kiosk) لا تعمل أحيانًا بالكفاءة المرجوة عند استخدام البطاقة الشخصية، كما أن بعض أنظمة الحاسب الآلي في منصات تسجيل المسافرين «الكونتر» (Check-in) قد تتسبب في تأخير محدود للسبب ذاته. وهذا يشير لربما إلى حاجة ملحّة لإعادة تقييم «تكامل الأنظمة» وتحديث البرمجيات، بما يضمن سرعة الاستجابة، ويعزّز ثقة المسافر في الاعتماد على البطاقة الشخصية كخيار ذكي موازٍ لجواز السفر، انسجامًا مع الهوية الرقمية المتقدمة. ونظرًا لاتساع مساحة المطار وضخامة مرافقه، قد يواجه بعض المسافرين تحديًا في تقدير الوقت اللازم للوصول إلى بوابات الصعود، ولا ننسى مسافري «الترانزيت» المرتبطين بجدول زمني ضيق. ومن هنا، تبرز أهمية توفير معلومات زمنية دقيقة حول «المسافة والوقت التقريبي» للوصول إلى بوابات المغادرة، عبر الإشارة إليها في بطاقات الصعود الرقمية أو الشاشات الإرشادية التفاعلية. إن هذا الإجراء – من وجهة نظري – يحدّ من ارتباك المسافرين، ويُسهم في الالتزام بمواعيد الإقلاع، مما يقلّل من تأخر الرحلات ويعزّز الكفاءة العامة. إنّ الربط بين هذه الملاحظات التشغيلية وبين «مؤشرات الأداء الرئيسية» (KPIs) يُعدّ ركيزةً أساسية لضمان استدامة التميز؛ فقياس «متوسط زمن إنهاء الإجراءات» وكفاءة «الأنظمة التقنية» ليس مجرد أرقام إحصائية، بل هو المرآة التي تعكس كفاءة الفلسفة التشغيلية وقدرتها على التكيف مع التحديات اللحظية. كما يُستحسن أن تتضمن تجربة المطار بُعدًا ثقافيًا أعمق يعكس الهوية القطرية بروح عصرية حضارية؛ فمسافرو «الترانزيت» يشكّلون شريحة واسعة، واعتماد وسائل مبتكرة لعرض الثقافة القطرية بصورة تفاعلية يسهم في تعزيز الصورة الذهنية للبلد وأهلها، ويحوّل المطار من مجرد محطة عبور إلى منصة سياحية تعريفية تشجّع المسافر على العودة لزيارة قطر كوجهة سياحية مستقبلًا. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن فلسفة بعض المطارات العالمية في مجال الكفاءة التشغيلية لا تقتصر على سرعة الإجراءات أو جودة المرافق فحسب، بل تمتد لتشمل أدق التفاصيل التشغيلية المرتبطة بتجربة المسافر. ففي نماذج متقدمة، تصل هذه الفلسفة إلى تقديم خدمات استثنائية تعكس أقصى درجات العناية والرقي، مثل الاهتمام بالأمتعة وتنظيف الحقائب قبل تسليمها للمسافر عند الوصول، بما يُحوّل الرحلة من إجراءٍ روتيني إلى تجربة راقية تعزّز ولاء المسافر وترسّخ انطباعًا إيجابيًا مستداماً. وفي إطار التطوير المستدام، يمكن للمطار توسيع الشراكة مع الجامعات المحلية عبر مشاريع تطبيقية تُنفَّذ تحت إشراف أكاديمي وخبرات ميدانية، لتقديم دراسات تحليلية لآراء المسافرين مبنية على معايير علمية. ويُعد هذا التوجه نموذجًا مبتكرًا يربط المخرجات الأكاديمية بالواقع العملي، ويزوّد المطار ببيانات دقيقة ترصد التحديات التشغيلية بمرونة واستباقية، وبتكلفة اقتصادية مدروسة. ختامًا، تنبع أهمية الكفاءة التشغيلية من كونها منظومة متكاملة لا تقتصر على الجوانب الفنية فحسب، بل تبدأ منذ اللحظة الأولى لوصول المسافر، عبر إدارة زمن الانتظار وسلاسة الحركة، وصولًا إلى جاهزية الكوادر البشرية وكفاءتها. ويُعدّ المطار الواجهة الحقيقية والأولى للبلد، والعنصر الأهم في تشكيل الانطباع الأول لدى السياح والزائرين. ومن هذا المنطلق، فإن التركيز على «تجربة المسافر ورضاه» يُمثّل جوهر فلسفة التشغيل الحديثة، والركيزة الأساسية للحفاظ على التميّز وترسيخ الريادة العالمية.
333
| 12 يناير 2026
لا شكّ أن الجهود المبذولة لإبراز الوجه الحضاري والسياحي هي جهودٌ مقدَّرة ومحلّ اعتزاز، ونأمل أن تبلغ أسمى درجات التميّز والإبداع من خلال التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات، وبمشاركة أطياف المجتمع كافة؛ بما يعكس الصورة المشرّفة للبلد، وثقافتها، وقيمها، ورُقيّ أهلها. وبحكم كوني من روّاد كورنيش الدوحة، فقد استوقفتني بعض الممارسات التي -من وجهة نظري- قد تؤثّر سلبًا في المشهد العام وجودة التجربة السياحية التي نطمح جميعًا إلى الارتقاء بها. إذ إن لهذه الممارسات انعكاساتٍ مباشرة على سمعة القطاع السياحي، وعلى جودة الخدمات المرتبطة به. ومن أبرز هذه الملاحظات انتشار مجموعات من الأشخاص الذين يمارسون الإرشاد السياحي دون ترخيص أو تأهيل مهني، يتمركزون في نقاط معيّنة على الكورنيش والمواقع الحيوية، ويعمدون إلى استقطاب السياح بصورة عشوائية تفتقر إلى التنظيم. وأشير هنا -من باب رصد الواقع لا التعميم- إلى بعض العمالة، ولا سيما الآسيوية منها، التي تفتقر إلى أبسط أدوات الإرشاد السياحي السليم، وإلى الوعي والبعد التاريخي والثقافي للمكان. وهنا يبرز تساؤلٌ مشروع: هل يحمل هؤلاء تصاريح رسمية تخوّلهم مزاولة هذه المهنة؟ وهل يمتلكون التأهيل المعرفي اللازم لنقل المعلومة الدقيقة عن التاريخ، والعادات، وقيم المجتمع؟ فالإرشاد السياحي ليس مجرّد مرافقة عابرة، بل هو تمثيلٌ حيّ، وصورة واقعية تُنقل إلى العالم عبر التواصل الإنساني المباشر، وتترك أثرًا دائمًا في ذاكرة الزائر والسائح. وتبرز ملاحظةٌ أخرى تتعلّق بالقوارب الخشبية السياحية التقليدية، حيث تظهر على بعضها علامات التهالك، وتدنّي معايير السلامة والنظافة، فضلًا عن غياب الأسلوب الاحترافي السياحي في التعامل مع الزوّار والسائحين، وهو ما يثير تساؤلًا حول مدى توافق هذه المشاهد مع الصورة العصرية والحضارية التي نحرص على تقديمها في أحد أبرز معالمنا السياحية. إن إعادة تأهيل هذه القوارب السياحية والارتقاء بجاهزيتها، من خلال تحسين معايير الأمان، وتوفير سبل الراحة، والالتزام الصارم بمعايير السلامة والنظافة، واعتماد أسلوب احترافي في الخدمة، من شأنه أن يجعلها أكثر جاذبية للسياح، ويحوّلها من وسيلة نقل عشوائية إلى عنصر سياحي فعّال يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية على الكورنيش. إن كورنيش الدوحة ليس مجرّد معلمٍ عابر، بل لوحة نابضة تروي قصة وطن؛ فعن يمين الزائر تتجلّى الأبراج الشاهقة رمزًا للحداثة، وعن يساره يستحضر عبق التاريخ المرتبط بالبحر والغوص والبادية. وفي هذا التلاقي الفريد، يلتقي الماضي بالحاضر ليجسّدا رحلة بلدٍ حافظ على هويته وهو يعانق المستقبل. ومن هنا تكمن المفارقة في وجود بنية تحتية عالمية المستوى، يقابلها ضعف في جودة بعض التفاصيل الميدانية التي قد تبدو بسيطة، لكنها عميقة الأثر في جوهر التجربة السياحية. وفي المقابل، تمثّل مهنة الإرشاد السياحي فرصةً حقيقية وواعدة لأبناء الوطن من الجنسين، لما تتطلّبه من مخزون ثقافي ومعرفي واعتزاز بالهوية. وقد أثبت الشباب القطري كفاءته في شتى المجالات، وهو الأقدر على تقديم تجربة سياحية أصيلة تعكس القيم والتاريخ بصورة مشرّفة. إن اختيار الدوحة عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2026 هو إنجازٌ يفخر به الجميع، لكنه في الوقت ذاته يضع الجميع أمام مسؤوليةٍ مضاعفة لترجمة هذا اللقب إلى واقعٍ ملموس، يتجلّى في جودة التنظيم، وسلامة المرافق، ورُقيّ مستوى الخدمة. خلاصة القول.. تظلّ التجربة السياحية ناقصة ما لم يُرافقها محتوى إنساني وثقافي مؤهَّل يعكس روح المكان. إن الاستثمار في تنظيم وضبط معايير الخدمات الميدانية هو استثمارٌ في سمعة القطاع السياحي واستدامته؛ إذ لا يدوم التميّز إلا حين يلمسه الزائر والسائح واقعًا في كل تفاصيلها.
810
| 04 يناير 2026
شكّلت دار الإفتاء ركنًا أساسيًا في المجتمعات الإسلامية، بوصفها المرجع الديني الذي يُبيّن الأحكام الشرعية ويُوجّه المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم. وقد حظي المفتي عبر التاريخ بمكانةٍ مرموقة، استمدّها من سعة علمه، ورجاحة عقله، وطول ملازمته لأهل العلم، إلى جانب ما عُرف عنه من ورعٍ وأمانة وخبرة وحكمة؛ فكان الناس يقصدونه في القضايا والنوازل، ويحتكمون إلى رأيه. ولم يقتصر دوره على الإرشاد الفردي فحسب، بل أسهم أيضًا في حفظ التراث الفقهي الشرعي، وتدوينه، وتطويره. ومع تطوّر العصر وظهور قنوات ووسائل ومنصّات إعلامية لا تُعدّ ولا تُحصى، كان من المفترض أن تصبح العملية الإفتائية أكثر دقّةً وتمحيصًا وتنظيمًا، بما يضمن سلامة الأحكام الشرعية وانضباطها. غير أنّ الواقع المعاصر وتعقيداته يكشفان عن انتشار ما يُعرف بـ «فوضى الإفتاء والاجتهاد»، وهي ظاهرة نتجت عن عوامل متعددة، أبرزها سهولة الوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية الخاصة، بما تحمله أحيانًا من محتوى غير دقيق، أو مجهول المصدر، أو مُضلِّل، فضلًا عن توظيف بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى ديني غير منضبط. وقد أتاح هذا الواقع لأي شخص أن ينشر رأيه أو يُقدّم ما يُسمّى بـ «فتوى» دون امتلاك التأهيل العلمي أو الشرعي اللازم، في ظل غياب المرجعية الموحّدة، وضعف التنسيق بين أهل العلم، ووجود دوافع شخصية، أو سياسية، أو إعلامية لدى بعض المتصدّرين للمشهد الديني، كالسعي إلى الشهرة أو التأثير أو الارتزاق المالي تحت غطاءٍ دينيٍّ ظاهري. ويُسهم ضعف الثقافة الدينية لدى المتلقّي في تفاقم هذه الظاهرة، وهو ضعفٌ يعود إلى متغيّرات متعددة، من بينها مناهج التعليم الحديثة التي لم تعد تُولي التربية الدينية العناية الكافية، مما يجعل بعض الأفراد، ولا سيما الجيل الحالي، أكثر قابلية للتأثّر والانقياد خلف المضلّلين وأصحاب المصالح والأجندات الخفية. ولا تقتصر آثار فوضى الإفتاء على الفرد وحده، بل تمتدّ إلى المجتمع بأسره؛ إذ تُحدث بلبلةً وتشويشًا، وقد تقود إمّا إلى التطرّف والغلوّ المرفوضين شرعًا، أو إلى التساهل المفرط المخالف لمقاصد الشريعة وجوهر الإسلام الوسطي المعتدل. كما تُسهم هذه الفوضى في تشويه صورة الإسلام السمح، وإضعاف الثقة في المؤسسات الدينية الرسمية والمرجعيات العلمية المعتمدة، بما يهدّد استقرار الوعي الديني ويُعمّق حالة الارتباك والانقسام. ويزداد أثر هذه الفوضى وضوحًا عند تناول القضايا المعاصرة ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وعلى سبيل المثال لا الحصر مسألة التعامل مع البنوك التقليدية أو الإسلامية، حيث يظهر تباينٌ حادٌّ بين من يُجيز بعض صور التعامل بدعوى الضرورة أو تعقيدات الواقع المعاصر، وبين من يذهب إلى التحريم الشرعي الصريح اعتمادًا على نصوصٍ قطعية واجتهاداتٍ فقهية مستقرة. وفي هذا السياق، ومن وجهة نظري، فإن مقولة «اختلاف العلماء رحمة» لا تُطلق على الأحكام الشرعية الواضحة أو القطعية، وإنما تُفهم في إطار مسائل الاجتهاد الظنية التي تحتمل تعدّد الآراء؛ أمّا توظيفها لتبرير التناقض في القضايا ذات النصوص الصريحة أو الإجماع المستقر، فهو خلطٌ غير منضبط يُعمّق فوضى الإفتاء بدلًا من أن يُسهم في احتوائها. ويُضاف إلى ذلك تفريغ بعض الألقاب الدينية من مضامينها العلمية والشرعية، وفي مقدّمتها لقب «الشيخ»، الذي بات يُمنح لكل من تصدّر المشهد الإعلامي أو كثر متابعوه، بعد أن كان يُطلق تاريخيًا على أهل العلم الراسخين المعروفين بالتحصيل والتزكية وطول الملازمة. وقد أسهم هذا التسيّب في تضليل العامة، ومنح شرعيةٍ شكلية لأصوات غير مؤهّلة، مما زاد من حدّة الاضطراب في فهم الدين، وكرّس حالة الخلط بين الرأي الشخصي والفتوى والاجتهادات الشرعية المعتبرة. إن فوضى الإفتاء تمثّل تحدّيًا حقيقيًا يواجه المجتمعات الإسلامية اليوم، ولا سيّما الأجيال القادمة، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز دور المؤسسات الإفتائية الرسمية بوصفها المرجعية الأساس، وتوعية المجتمع بأهمية الرجوع إلى أهل الاختصاص، والتصدّي للفتاوى الشاذة والمتطرّفة تفنيدًا علميًا رصينًا، إلى جانب تطوير آليات الإفتاء بالاستفادة من التقنيات الحديثة، ولكن تحت إشراف جهات رسمية موثوقة بعلمها وورعها وخبرتها، وتعزيز الثقافة الدينية العامة بما يُمكّن الأفراد من الفهم والتمييز. فتنظيم الإفتاء ليس مسألةً إجرائية فحسب، بل ضرورةٌ شرعية ومجتمعية لحماية الدين، وصون وعي المجتمع، وضمان سلامة الأجيال القادمة من التشتّت والبلبلة والانقسام والشك. ويُطرح هنا سؤالٌ يراودني: هل نحن بحاجةٍ ضرورية إلى إنشاء معجمٍ للإفتاء الشرعي، على غرار معجم الدوحة اللغوي، أم نكتفي بترديد مقولة «اختلاف العلماء رحمة»؟ وبناءً على ذلك، هل تُعدّ فتاوى «فضيلة الشيخ الذكاء الاصطناعي» اجتهادًا واختلافًا ورحمةً في القضايا الدينية الشائكة مستقبلًا؟ وهل تبرز ضرورة وضع شروطٍ ومعايير واضحة لمنح لقب المشيخة الدينية، «الشيخ» سواء للخطيب أو لطالب العلم، أو المجتهد! وأخيرًا: «لا يحلّ لأحدٍ أن يُفتي في دين الله إلا رجلٌ عارفٌ بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتنزيله وتأويله…» الإمام الشافعي
516
| 28 ديسمبر 2025
شهدت بلادُنا الغالية خلال العقد الأخير سلسلةً من التحدّيات الكبرى التي عصفت بالمنطقة، بدءًا من الأزمة الخليجية، مرورًا بـجائحة كورونا العالمية، وما تبعها من تشابكاتٍ إقليميةٍ معقّدةٍ ألقت بظلالها على دول الخليج العربي، وصولًا إلى الحرب على غزة، وما كان لقطر من دورٍ فاعلٍ ومحوريٍّ في السعي لوقف تلك الحرب الهمجية الإرهابية غير المتكافئة، ثم التوترات الإقليمية المتصاعدة، والصواريخ الإيرانية، وانتهاءً بـالاعتداء الإسرائيلي الإرهابي الغادر الذي مثّل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. ورغم هذه العواصف السياسية والاقتصادية والإنسانية، أثبت الإنسان القطري بطبيعته الطيبة المسالمة، ووعيه العميق، وولائه لوطنه وقيادته، أن السمو لا يُقاس باتساع الرقعة الجغرافية ولا بكثرة التعداد، بل بثبات الموقف، وصدق الانتماء، وقوة الإيمان بالوطن. لقد برهنت قطر أن الشدائد مهما عظُمت لا تزيدها إلا صلابة، ولا تزيد أبناءها إلا إصراراً على بناء وطنٍ متماسك يقف شامخاً، حاملاً رسالة السلام والتنمية ونصرة المظلوم أينما كان. لقد تحوّلت تلك الظروف القاسية، بفضل الله ثم بحكمة القيادة ووعي الشعب، إلى دروسٍ وتجارب ثرية رسّخت قيم الصمود، وأكدت أن التفوق الحقيقي يولد من رحم المعاناة، وأن إدارة الأزمات بعقلانية واتزان قادرة على تحويل المحن إلى فرصٍ للنهوض والابتكار. وفي خضم ضغوطٍ إقليمية ودولية غير مسبوقة، أثبتت قطر قدرتها الفريدة على إدارة الملفات الحسّاسة بحكمة ومسؤولية، حتى غدت نموذجاً يُحتذى به ووسيطاً نزيهاً يحظى بثقة المجتمع الدولي في حل أزماتٍ عجزت عن معالجتها قوى كبرى. ويمكن القول بثقة إن ما واجهته بلادنا خلال العقد الماضي يمثل تجربة استثنائية لم تمر بها دولة خليجية حديثة، باستثناء ما مرت به دولة الكويت الشقيقة أثناء الغزو العراقي عام 1990؛ فقد خرجت قطر من هذه التجارب أكثر استعداداً للمستقبل، وأعمق ثقةً بذاتها، وأرسخ تمسكاً بسيادتها وهويتها، وأقوى حضوراً وريادةً على الساحتين الإقليمية والدولية. وهنا تتجلى مسؤولية الجيل الحالي في إدراك أن ما تنعم به قطر اليوم من أمنٍ وازدهار ومكانةٍ مرموقة لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة تضحيات وجهود مخلصة بذلتها أجيال وقيادات سابقة آمنت بهذا الوطن وقدّمت لأجله الكثير. إن الحفاظ على هذا الإرث الوطني لا يكون بالشعارات والكلمات والأشعار فحسب، بل بالعمل الجاد، والولاء المطلق، والتمسك بالقيم التي قامت عليها نهضة قطر الحديثة. فمهما تطورت مظاهر الحداثة، سيبقى جوهر القوة الحقيقي كامناً في الإنسان القطري: في وعيه، وإيمانه، وولائه لقيادته، وغيرته على وطنه، واعتزازه بدينه وعروبته وثقافته. ومن هذا الوعي، تستمد الأجيال القادمة مسؤوليتها في صون المكتسبات والبناء عليها نحو أفقٍ أفضل، ينطلق من التميز والإبداع، لتبقى قطر كما أرادها مؤسسوها: وطنٌ يصون، وشعبٌ ينهض.. دولةً ذو سيادة مستقلة، عربية الجذور، إسلامية الهوية، إنسانية الرسالة، تمضي بثقة نحو مستقبلٍ يليق بها وبمكانتها بين الأمم.
291
| 18 ديسمبر 2025
أودّ توظيف مفهومٍ يُعرف بـ المشتقة الجزئية (Partial Derivative) كإطار تحليلي في استعراض الموازنة العامة لسنة 2026، وذلك من خلال تحليل أثر متغيّر واحد فقط، وهو «العجز»، مع تثبيت بقية المتغيّرات الأساسية، كالمصروفات والإيرادات. ويهدف هذا الأسلوب إلى طرح الفكرة بصورة منهجية وعملية، بعيدًا عن أي لبسٍ علمي أو التباسٍ تحليلي. ومن خلال استعراض الموازنة العامة لسنة 2026، يتضح بلا شك حرصُ الدولة الثابت والراسخ على الحفاظ على مستوى الرفاهية وجودة الحياة للمواطن في مختلف مناحيها، كالتعليم، والصحة، والإسكان، والبنية التحتية، والخدمات، إلى جانب الجوانب البيئية، بما يضمن حياةً كريمةً وعزيزةً، دون أي تراجع في مستوى المعيشة، بل تثبيتًا لها واستدامةً لمكتسباتها. وبناءً عليه، يبرز سؤالٌ جوهري: هل يمكن تقليص متغيّر العجز إلى حدود معقولة دون المساس بالبُنود الأساسية للموازنة؟ ومن وجهة نظري، فإن ذلك ممكن وقابل للتحقق، شريطة وجود تعاونٍ مؤسسي حقيقي ضمن رؤية موحّدة، تركّز على رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين أساليب الإعداد والتخطيط والتنفيذ، وتبنّي أدوات حديثة في إدارة المشاريع، وفي مقدّمتها التحول الرقمي (Digital Transformation)، لما له من دور محوري في تقليص بل والقضاء على مظاهر البيروقراطية، وتحسين جودة المخرجات، وتسريع الإنجاز، والحد من الهدر، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. فالمقصد ليس خفض المشاريع أو تجميدها أو تأجيلها، بل تحسين أسلوب إدارة الصرف والإنفاق، وتطوير نماذج التعاقدات القانونية بين الأطراف، وتحسين نطاق العمل (Scope of Work ) دون مبالغة في المواصفات، بما يحقق توازنًا منطقيًا بين الجودة والتكلفة، ويضمن استمرارية تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتعظيم القيمة مقابل الإنفاق. وتزداد أهمية هذا التوجّه في الاقتصادات الريعية التي تعتمد على الموارد الهيدروكربونية كالنفط والغاز؛ إذ يصبح تقليص العجز مع استمرار التنمية ضرورةً اقتصاديةً واجتماعيةً، تتطلّب فكرًا مبتكرًا خارج الأطر التقليدية (Thinking Outside the Box) في إدارة الموارد والمشاريع، وتمكينًا وتفعيلًا حقيقيًا للقطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، لا مجرّد منفّذ يعتمد على الإنفاق الحكومي. وفي هذا الإطار، يمكن ترجمة هذا التوجّه إلى حزمة من المقترحات العملية المختصرة، من أبرزها: توسيع الشراكات مع القطاع الخاص (PPP / BOT): نقل جزء من التمويل والمخاطر إلى القطاع الخاص، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة، ويعزّز كفاءة التنفيذ والتشغيل. تبنّي العقود المبنية على المخرجات: ربط الدفعات بالنتائج وجودة التنفيذ بدل التركيز على المدخلات، كعدد العمالة والمعدات والكميات، بما يقلّل الهدر ويحفّز الإنجاز والابتكار. إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العائد المباشر: تقديم المشاريع التي تولّد إيرادات أو تخفّض النفقات التشغيلية للدولة، دون المساس بالمشاريع الأساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية. تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة: إسناد المشاريع التشغيلية والخدمية إليها، بما يعزّز نشاط القطاع الخاص، ويخفف العبء المالي والإداري عن الدولة. مراجعة الضمانات البنكية: تقليص الضمانات المبالغ فيها، واستبدالها أو إلغاؤها عند إيجاد بدائل عملية ومنطقية، مثل الاقتطاع من الدفعات (Retention)، دون التأثير على استمرارية التنفيذ أو جودة الإنجاز. رفع نسبة المحتوى المحلي (30% على الأقل): لتعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق العام، وتقليل تسربه إلى الخارج، مع دعم سلاسل التوريد المحلية. اعتماد التدقيق الختامي والدروس المستفادة (Lessons Learned ): لجميع المشاريع بعد إنجازها، بهدف تقييم الأداء، وتعزيز المساءلة المؤسسية، وتفادي تكرار الأخطاء، ورفع كفاءة الإنفاق في المشاريع المستقبلية بصورة منهجية ومستدامة. وخلاصة القول، فإن تقليص العجز في الاقتصادات الريعية لا يُعد إجراءً تقشفيًا بقدر ما هو مسار تطوير اقتصادي، وأداة لتحسين كفاءة الإنفاق، ومحفّز حقيقي لتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في النمو والتنمية. كما أن أي نجاح في تقليص العجز من شأنه أن يخفّف من وتيرة السحب من سلة الاستثمارات السيادية للدول بمختلف أشكالها، بما يعزّز استدامتها، ويحافظ على قدرتها على دعم اقتصادات الأجيال القادمة، ويمنح الاقتصادات الوطنية مرونةً أكبر في مواجهة التقلبات المستقبلية.
423
| 16 ديسمبر 2025
في عصر طغت فيه الماديات على تفاصيل الحياة، وتضخمت فيه المصالح الشخصية حتى غطت على كثير من القيم الإنسانية الأصيلة، أصبح العثور على أشخاص بسطاء، طيبين في سجاياهم، رقيقي المشاعر، دمثي الخلق، كالعثور على دانة نادرة لم تلوثها ضوضاء الحياة ولا صخبها، ولم تطمسها تقلبات الأيام ولا أثقالها. لقد بات عالم اليوم وللأسف يقيس الإنسان بما يملك ويلبس، وبمنصبه ومظهره ومكانته وكلماته المنمقة، وبأحاديث قد تجرح أكثر مما تعبر، غير آبه بما يحمله للآخرين في داخله، حتى وإن كان بغير قصد. وفي زحام هذا الواقع المتشابك، يفقد الإنسان شيئا من بريقه الداخلي، ومن فطرته السليمة التي خلق عليها، تحت سعي لا ينتهي خلف ظل “المزيد” الذي لا يشبع ولا يكتفي. لكن الحياة رغم كل ذلك لا تزال تذكرنا، بل تؤكد لنا، أن معدن الإنسان الأصيل لا يصدأ مهما اشتدت تقلبات الزمن، ولا يتغير مهما تبدلت الوجوه. فهناك نفوس لا تحتاج إلى تكلف أو تصنع، ولا إلى مكياج (Makeup) أو بوتوكس اجتماعي، ولا إلى أقنعة ترضي الآخرين؛ إذ تكفيها بساطتها وطيبها وسجيتها، لأنها تحمل نورا خفيا يشهد على صفاء لا يشترى، ولا يصنع، ولا يخضع لمعايير المظاهر ولا لعيادات التجميل. فالإنسان السمح، الهادئ، المتواضع، النقي، القادر على التعامل بقلب طيب ونية صافية، هو أشبه بجوهرة خلقها الله جميلة بطبيعتها؛ لم تمسسها تعقيدات الحياة، ولم يقترب منها زيف المظاهر. وجوده مكسب، ورؤيته راحة، ومحبته فطرة. أناس كهؤلاء لا تنتظر منهم شيئا، بل يكفي أن تراهم وتقدر حضورهم؛ تماما كقطعة ألماس ثمينة لا تلمس ولا يقترب منها، بل يكتفى بالنظر إليها بإعجاب واحترام وهذا ما شاهدناه من الصحفي حسام الدين بن أحمد القُمري. إن البساطة والطيبة ليستا ضعفا كما يظن البعض؛ بل هما غنى في الجوهر، ورفعة في الروح، وقوة في السجية. إنهما إعلان صامت بأن معدن الإنسان حين يكون صافيا يظل أثمن من كل ما تغري به الحياة من ماديات، وأن النقاء والتواضع هما ذلك النور الداخلي الذي لا يستطيع ظلام الزيف مهما اشتد أن يخمده. وأخيرا يا سادة إنها البساطة والصفاء والانتماء وهيبة الله في القلوب.
345
| 12 ديسمبر 2025
عندما يصل شاب إلى منصب قيادي مبكرًا، فهذا لا يعني بالضرورة أنه الأفضل والأذكى والأكثر كفاءة، بل قد تكون الظروف والفرص قد أسهمت في وصوله. وهذه ليست انتقاصًا منه، بل فرصة يجب أن تُستثمر بحكمة. ومن الطبيعي أن يواجه القائد الشاب تحفظات أو مقاومة ضمنية من أصحاب الخبرة والكفاءات. وهنا يظهر أول اختبار له: هل يستفيد من هذه الخبرات أم يتجاهلها ؟ وكلما استطاع القائد الشاب احتواء الخبرات والاستفادة منها، ازداد نضجه القيادي، وتراجع أثر الفجوة العمرية، وتحوّل الفريق إلى قوة مشتركة بدل أن يكون ساحة تنافس خفي. ومن الضروري أن يدرك القائد الشاب أن أي مؤسسة يتسلّمها تمتلك تاريخًا مؤسسيًا وإرثًا طويلًا، وأن ما هو قائم اليوم هو حصيلة جهود وسياسات وقرارات صاغتها أجيال متعاقبة عملت تحت ظروف وتحديات قد لا يدرك تفاصيلها. لذلك، لا ينبغي أن يبدأ بهدم ما مضى أو السعي لإلغائه؛ فالتطوير والبناء على ما تحقق سابقًا هو النهج الأكثر نضجًا واستقرارًا وأقل كلفة. وهو وحده ما يضمن استمرارية العمل ويُجنّب المؤسسة خسائر الهدم وإعادة البناء. وإذا أراد القائد الشاب أن يرد الجميل لمن منحه الثقة، فعليه أن يعي أن خبرته العملية لا يمكن أن تضاهي خبرات من سبقه، وهذا ليس نقصًا بل فرصة للتعلّم وتجنّب الوقوع في وهم الغرور أو الاكتفاء بالذات. ومن هنا تأتي أهمية إحاطة نفسه بدائرة من أصحاب الخبرة والكفاءة والمشورة الصادقة، والابتعاد عن المتسلقين والمجاملين. فهؤلاء الخبراء هم البوصلة التي تمنعه من اتخاذ قرارات متسرّعة قد تكلّف المؤسسة الكثير، وهم في الوقت ذاته إحدى ركائز نجاحه الحقيقي ونضجه القيادي. وأي خطأ إداري ناتج عن حماس أو عناد قد يربك المسار الاستراتيجي للمؤسسة. لذلك، ينبغي أن يوازن بين الحماس ورشادة القرار، وأن يتجنب الارتجال والتسرع. ومن واجبات القائد اختيار فريقه من أصحاب الكفاءة (Competency) والخبرة (Experience)، فنجاحه لا يتحقق دون فريق قوي ومتجانس من حوله. أما الاجتماعات والسفرات، فالأصل أن تُعقَد معظم الاجتماعات داخل المؤسسة (On-Site Meetings) ليبقى القائد قريبًا من فريقه وواقع عمله. كما يجب الحدّ من رحلات العمل (Business Travel) إلا للضرورة؛ لأن التواجد المستمر يعزّز الانضباط، ويمنح القائد فهمًا أعمق للتحديات اليومية، ويُشعر الفريق بأن قائده معهم وليس منعزلًا عن بيئة عملهم. ويمكن للقائد الشاب قياس نجاحه من خلال مؤشرات أداء (KPIs) أهمها هل بدأت الكفاءات تفكر في المغادرة؟ هل ارتفع معدل دوران الموظفين (Turnover Rate)؟ تُمثل خسارة الكفاءات أخطر تهديد لاستمرارية المؤسسة، فهي أشد وطأة من خسارة المناقصات أو المشاريع أو أي فرصة تجارية عابرة. وكتطبيق عملي لتعزيز التناغم ونقل المعرفة بين الأجيال، يُعدّ تشكيل لجنة استشارية مشتركة بين أصحاب الخبرة الراسخة والقيادات الصاعدة آلية ذات جدوى مضاعفة. فإلى جانب ضمانها اتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة ومنع الاندفاع أو التفرد بالرأي، فإن وجود هذه اللجنة يُغني المؤسسة عن اللجوء المتكرر للاستشارات العالمية المكلفة في كثير من الخطط والأهداف التي يمكن بلورتها داخليًا بفضل الخبرات المتراكمة. وفي النهاية، تبقى القيادة الشابة مسؤولية قبل أن تكون امتيازًا، واختبارًا قبل أن تكون لقبًا. فالنجاح لا يأتي لأن الظروف منحت القائد منصبًا مبكرًا، بل لأنه عرف كيف يحوّل تلك الظروف والفرص إلى قيمة مضافة، وكيف يبني على خبرات من سبقه، ويستثمر طاقات من حوله.
1374
| 09 ديسمبر 2025
تشهد الساحة الدولية اليوم تصاعدًا لافتًا في الخطابات والتشريعات البيئية والمناخية التي تقودها مؤسسات ذات نفوذ واسع، مثل الاتحاد الأوروبي والمنظمات البيئية العالمية. وقد بدأت هذه الموجة في الأصل بحركات شبابية غاضبة ومتحمّسة تعبّر عن قلقٍ مستقبلي عميق تجاه الوقود الأحفوري (Fossil Fuels)، خاصة النفط والغاز. وتغذّي هذا التوجّه أحزاب سياسية، ونقابات عمالية، ومنظمات مجتمع مدني تمتلك نفوذًا إعلاميًا وتمويلًا كبيرًا، إضافةً إلى فئة من الأكاديميين والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة العالمية التي وجدت في ملف “المناخ” ضالّتها؛ مجالًا مناسبًا لتعزيز حضورها وبناء مسارات تجارية مربحة تُدرّ مئات الملايين من الدولارات سنويًا. تُمرَّر الضغوط المناخية اليوم عبر أدوات “خضراء” يبدو ظاهرها بيئيًا، بينما يحمل جوهرها أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية واضحة. وقد بات من الجليّ أن هذه السياسات تستهدف الثروات الهيدروكربونية في المنطقة من خلال فرض تشريعات وأنظمة وغرامات عابرة للحدود تُقيِّد الاستثمار في التوسع والإنتاج، وتضع عراقيل أمام مشاريع النفط والغاز تحت ذريعة التحول السريع نحو بدائل “نظيفة” أو “متجددة”. ويُضاف إلى ذلك الدفع نحو التزام صارم بأهداف الحياد الصفري للانبعاثات (Net-Zero Emissions) بحلول عام 2050، رغم عدم واقعية هذه الأهداف بالنسبة للعديد من الدول المنتِجة للطاقة. إن هذه الضغوط تُهدر طاقات وموارد مالية كبيرة بدل توجيهها نحو التقنيات والتكنولوجيا القادرة فعلاً على خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الإنتاج، وعلى رأسها حلول التقاط وتخزين الكربون (CCS) في التكوينات الجيولوجية العميقة، بما في ذلك استخدامها في تعزيز إنتاجية المكامن وإطالة عمرها (EOR). كما تتجاهل هذه السياسات حاجة الدول النامية إلى مصادر طاقة موثوقة تدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها النفط والغاز، اللذان يوفّران أبسط مقومات الحياة الكريمة لملايين البشر حول العالم إن ما يجري اليوم يتجاوز الاعتبارات البيئية البحتة؛ إذ أصبح خطاب المناخ أداةً لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي بين الدول المنتجة للطاقة والدول الصناعية المستهلكة. فالحديث المتكرر عن “خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري” لا يراعي حق الدول المنتجة في التنمية واستثمار ثرواتها الوطنية، على الرغم من أن هذه الثروات وفّرت للعالم، طوال عقود، طاقة مستقرة مكّنت الاقتصادات الصناعية من النمو والازدهار والتطور. وتبرز المفارقة بوضوح عند النظر إلى منظومة أرصدة الكربون (Carbon Credits)، التي تُسوَّق اليوم بوصفها حلًّا سحريًا لتجاوز صعوبة الوصول إلى الحياد الصفري، بينما تقوم في جوهرها على معايير منهجية معقدة وبيوت خبرة عالمية ومنصات تداول وصناديق مناخ دولية تتحكم في تسعير الائتمان الكربوني وتُحرّك مليارات الدولارات سنويًا. غير أن معظم هذه التدفقات المالية لا يصبّ في صالح الدول المنتجة والمصدّرة للطاقة، بل ينتهي في مؤسسات دولية خارج المنطقة، فيما تتحمّل دول الخليج النصيب الأكبر من الضغط السياسي والإعلامي دون أن تكون المستفيد الاقتصادي الحقيقي من هذا النظام. ومن هنا يصبح من الضروري التفكير في تطوير منظومات كربونية وطنية أو إقليمية تستند إلى واقع المنطقة واحتياجاتها، وتُسهم في تعزيز اقتصاديات دول الخليج وتمكينها من الاستفادة من أدوات الكربون متى دعت الحاجة مستقبلًا، بدل أن تبقى أسيرة لمنظومات عالمية لا تراعي مصالحها ولا خصوصياتها. وفي خضم هذا المشهد، يبرز سؤالٌ جوهريّ يتعلق بالصياغة الرسمية للمؤسسات: هل يخدم تضمين عبارات مثل “التغيّر المناخي” أو “شؤون المناخ” في أسماء الهيئات مصالح الدول المنتجة للطاقة؟ إذ إن تضمين مصطلح “التغيّر المناخي” في الاسم قد يُفسَّر بأنه قبول ضمني بالرواية التي تُصوّر النفط والغاز بوصفهما “مشكلة يجب التخلص منها تدريجيًا”. في المقابل، فإن الاكتفاء باسم “البيئة” مع إدراج ملف المناخ ضمن الاختصاصات الداخلية يمنح توازنًا مدروسًا؛ يوفّر مواكبة للخطاب العالمي دون تقديم اعتراف مجاني قد يتحول مستقبلًا إلى التزامات سياسية أو قانونية غير مرغوب فيها.
732
| 04 ديسمبر 2025
منذ فجر الحضارات الفرعونية والرومانية وبلاد ما وراء النهرين وقياصرة فارس، حاز الذهب مكانته الأبدية لا بسبب تفوقه الكيميائي وخصائصه الفيزيائية ذات الاستخدامات المحدودة فحسب، بل لأنه لِحُسن حظه التاريخي اكتُشف مبكرًا في زمن سمح له بأن يتسلل إلى قصور الملوك والسلاطين، وفي طقوس المعابد والكنائس، ويتحول إلى رمز للسلطة والهيبة والقداسة الدينية، وإلى زينة على صدور حسناوات البلاط وحريم السلاطين. ولندرته، واعتقادًا قديمًا بأن لونه يشبه الشمس والنور والخلود، بلغ ببعض الحضارات كالفرعونية أن عدته “لحم الإله”. ومع سهولة صهره وتشكيله، ترسخت صورته في الوعي البشري كأصل خالد للقيمة عبر آلاف السنين، حتى عندما ظهر معدن أكثر تفوقًا في خصائصه الفيزيائية كالبلاتين، لكنه حُرم من هذه الرمزية لأنه جاء متأخرًا في التاريخ، ولعل لونه الأبيض الفضي الهادئ لم يرتبط بأي دلالة قدسية أو أسطورية. وعلى الجانب المقابل، يقف النفط اليتيم المظلوم؛ المورد الذي غيّر شكل العالم. فلولاه لما وُجدت الكهرباء، ولا المياه المُحلاة في عالمٍ يعاني شحًّا مائيًا، ولا صُنِع الدواء ولا توافر الغذاء، ولا قامت المصانع، ولا سارت المركبات والقطارات والسفن، ولا طارت الطائرات، ولا ازدهرت اقتصادات دول كانت صحراء قاحلة، ولا تقدمت أوطان واستغنت شعوب بفضل هذا المورد المظلوم. بل إن الذهب نفسه الذي يعتلي عرش القيمة يستهلك كميات كبيرة من النفط في عملية تعدينه واستخراجه وفصله. وأخيرًا وليس آخرًا، ما كانت التكنولوجيا الرقمية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي لتتطور لولا الطاقة الهيدروكربونية (النفط والغاز) التي تغذي بنيتها التحتية الهائلة. بل إن الثورة الصناعية الغربية الحديثة نفسها، من الإمبراطورية البريطانية التي أصبحت يومًا “الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس” إلى الولايات المتحدة التي ورثت زعامة العالم، ما كانت لتبلغ ذروتها لولا النفط الذي منح الآلة قوتها، والجيوش تفوقها، والاقتصادات طاقتها. ومع ذلك، بقي هذا المورد بلا رمزية ولا مكانة تليق بدوره الحيوي وأهميته. فهو وقود الحضارة الحديثة والمستقبلية، لكنه واقع تحت ضغط أوراق السياسة لا منطق الاقتصاد، وتحت تأثير صراعات الدول الكبرى. والأهم من ذلك أن مشكلته الأساسية، في رأيي، هي وجوده في التكوينات الجيولوجية تحت باطن أرض الجزيرة العربية، وفي جغرافية قلب العالم، وعلى مقربة من أهم المضايق والممرات البحرية والبرية التي تمر عبرها تجارة الكوكب كله. في المقابل، ينعم الذهب “المدلّل” بحياة هادئة فوق رفوف البنوك وخزائن البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وصناديق الاستثمار العالمية. يُلمَّع ويُنظَّف ويُراقَب تحت أنظمة تبريد وكاميرات المراقبة،لا يُستهلك ولا يُستنزف. والأونصة الواحدة منه قد تعادل ما يقارب خمسة وثلاثين برميلًا من النفط، ما يعكس الفارق الجوهري بين أصلٍ يُخزَّن كقيمة خالدة، وأصلٍ يُستهلك فور استخدامه. الذهب محظوظ… والنفط يُحاسَب ويُتَّهَم ويُحارَب ويُستَخدَم كسلاحٍ في الصراعات. حتى عندما انفصل الدولار عن الذهب، أصبح النفط هو الغطاء الحقيقي للعملة الأمريكية عبر “البترودولار”. ومنذ ذلك اليوم، بات النفط، لا الذهب، هو الذي منح الدولار ثقله العالمي. ومع ذلك، لم يتحول النفط إلى أصل قيمة نهائي، بل بقي سلعةً استراتيجية تحاول الدول الصناعية المستهلكة التحكم بسعرها ومسارها تحت شعارات زاهية مثل “الطاقة المتجددة” و”حماية المناخ” و”الحياد الكربوني الصفري”. وهنا تبرز المفارقة الكبرى: الذهب محظوظ بإرثه وصولجانه التاريخي لأنه لا يفسد ولا يُستهلك، فاحتفظ برمزيته وقداسته. والنفط مظلوم، لا لعيب فيه، بل لأنه هو الذي يشغّل العالم كله، ولأنه خرج من طبقات أراضي الجزيرة العربية، فصار هدفًا للضغوط والسياسة وحتى للقوة العسكرية. ويبقى السؤال الجوهري الذي يراودني كثيرًا: كما أطفأ اليابانيون بريق لؤلؤ الخليج عندما أغرقوا الأسواق ببدائلهم الصناعية كاللؤلؤ الصناعي، هل تُعيد الدول الصناعية الكبرى، خصوصًا الأوروبية منها، صياغة سوق الطاقة بالأسلوب نفسه؟ هل تحاول عبر أدوات تشريعية وتنظيمات بيئية ومناخية دولية ومعايير “الصفر كربون” والطاقة المتجددة إعادة تشكيل معادلة القيمة لإضعاف نفوذ المنتجين العرب والخليجيين وتقليص دور النفط في النظام المالي العالمي؟ في النهاية، ليست معركة النفط والغاز معركة حول “من يملك المورد” بل حول من يحدد قيمته، ومن يحدد موقعه، ومن يحدد بدائله، ومن يحدد حجمه كمًّا وزمنًا داخل النظام المالي العالمي.
555
| 24 نوفمبر 2025
يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت المستخدم في رصف الطرق ومشروعات البنية التحتية وتطبيقات أخرى، وهو منتج نفطي ثقيل يُستخلص من بقايا تكرير النفط الخام عالي الكثافة. ومع توسع مشروعات البنية التحتية وصيانة شبكات الطرق، تبرز الحاجة إلى تأمين إمدادات محلية ومستدامة من هذه المادة الحيوية بما يعزز الاستقلال الصناعي والاقتصادي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتقلبات الأسعار العالمية. ونظرًا لطبيعة النفط القطري الخفيف، تُعَد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي تعتمد بالكامل على استيراد البيتومين لتلبية احتياجاتها المحلية، بخلاف جاراتها المنتجة له، إذ إن الخام القطري من نوع الخفيف الحلو (Light Sweet Crude) يفتقر بطبيعته إلى المخلفات الثقيلة اللازمة لإنتاج البيتومين التقليدي، ما جعل السوق المحلي والمشروعات الحكومية تعتمد اعتمادًا كليًا على الاستيراد لتغطية الطلب المتنامي. وقد بُذلت جهود بحثية مقدرة لمعالجة هذا التحدي عبر تعاون بين الجامعات والمراكز البحثية، حيث أُجريت في جامعة قطر وجامعة تكساس A&M دراسات متقدمة لتطوير خلطات بيتومينية مناسبة للبيئة القطرية. وأظهرت النتائج أن دمج التقنيات الحديثة يرفع كفاءة الأداء تحت الظروف المناخية الحارة والرطبة ويسهم في خفض تكاليف الصيانة على المدى الطويل. وفي الإطار ذاته، طرحت شركتا QatarEnergy وShell فكرة مبتكرة لإنتاج بيتومين اصطناعي من الغاز الطبيعي (GTL-Bitumen) عبر تكنولوجيا فيشر–تروبش (Fischer–Tropsch)، تقوم على تصنيع شموع ثقيلة (FT Waxes) تُعالج حراريًا أو تُخلط مع زيوت أثقل للحصول على مادة لزجة بخصائص قريبة من البيتومين التقليدي. وتبرز في هذا السياق تجارب دولية ملهمة لدول غير منتجة للنفط مثل هولندا واليابان، اللتين أثبتتا أن الاعتماد على النفط المستورد لا يُعد نقطة ضعف بالضرورة، بل يمكن أن يتحول إلى فرصة ابتكار صناعي. ففي هولندا يتم خلط خام ثقيل مستورد مع خام حلو محلي في مصافي روتردام لتحقيق المواصفات الفنية وضبط نسب الكبريت، مع إعادة تدوير نحو 50% من الأسفلت المستخدم. أما اليابان فقد طورت أنواعًا متقدمة من الأسفلت مثل الأسفلت الصامت والطرقات المبردة، وبلغت معدلات إعادة التدوير لديها أكثر من 70% من إجمالي الأسفلت المستخدم، ما يؤكد أن الجمع بين التقنيات الحديثة والمواد المعاد تدويرها يسهم في خفض التكاليف ورفع جودة الطرق واستدامتها. ورغم أن البيتومين لا يشكل سوى 4–6% من وزن الخلطة الأسفلتية، إلا أنه يمثل 65–78% من تكلفة المواد، وقد يصل إلى 30% من إجمالي تكلفة مشاريع الطرق، ما يجعل تقليل كلفة إنتاجه أو استيراده عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة الإنفاق على البنية التحتية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى مسارين استراتيجيين لتوطين صناعة البيتومين: الأول يتمثل في إنتاج البيتومين من الغاز الطبيعي (GTL-Bitumen) عبر تكنولوجيا متقدمة، وهو خيار ذو موثوقية بيئية عالية لكنه يحتاج إلى رأس مال كبير وشراكات أجنبية متخصصة تضمن نقل التقنية وتشغيلها تجاريًا بكفاءة. أما المسار الثاني، وهو الأكثر واقعية وعملية في المدى القريب، فيتمثل في استيراد خام نفطي ثقيل منخفض الكلفة وخلطه محليًا مع الخام القطري الخفيف في مصفاة قائمة أو ضمن توسعات المصافي المستقبلية، بشرط وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وعقود شراء طويلة الأجل (Off-Take Agreements) لتشجع المستثمرين المحليين والأجانب على دخول هذا القطاع الحيوي. ويمكن تعزيز الجدوى الاقتصادية لهذا الخيار من خلال التعاون مع شركات آسيوية من الصين أو الهند لما تمتلكه من تقنيات بسيطة، وتكاليف تنافسية منخفضة، وكفاءة تشغيلية عالية قادرة على تلبية المواصفات القطرية والخليجية. كما يتطلب نجاح هذا التوجه توفير دعم مؤسسي وضمانات تمويلية وحوافز استثمارية تشمل الإعفاءات الضريبية وتطبيق نماذج الشراكة الدولية (BOT، BOOT، BOO، DBFO)، إلى جانب تفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية في التطوير والاختبار وتحسين جودة الخلطات لتناسب الظروف المناخية المحلية. إن تبني هذا التوجه الاستراتيجي سيحول صناعة البيتومين من عبء استيرادي إلى فرصة صناعية واعدة تعزز الاستقلال الصناعي والاقتصادي، وتدعم مفهوم «التوطين» كإحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وتُرسخ شعار «صُنع في قطر» كرمز لجودة البنية التحتية وكفاءة الإنفاق وابتكار الحلول البيئية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعات التحويلية والتقنيات المحلية في مجالات إعادة التدوير وتطوير المواد المرتبطة بصناعة الأسفلت.
825
| 17 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية

المتأمِّل الفَطِن في المسار العام للسياسة السعودية اليوم...
702
| 21 يناير 2026

برحيل والدي الدكتور والروائي والإعلامي أحمد عبدالملك، فقدت...
687
| 25 يناير 2026

يمثّل فوز الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني...
672
| 28 يناير 2026

يُعدّ مبدأ العطاء أحد الثوابت الإنسانية التي تقوم...
633
| 22 يناير 2026

ليس كل من ارتفع صوته في بيئة العمل...
588
| 26 يناير 2026

بحكم أنني متقاعدة، وبحكم أكبر أنني ما زلت...
570
| 25 يناير 2026

لا أكتب هذه السطور بصفتي أكاديميًا، ولا متخصصًا...
543
| 22 يناير 2026

«التعليم هو حجر الزاوية للتنمية… ولا وجود لأي...
459
| 21 يناير 2026

لم يعد الزواج عند كثيرين لحظة بناء بيت...
453
| 25 يناير 2026

لم أكتب عن النّاقة مصادفة، ولكن؛ لأنها علّمتني...
432
| 27 يناير 2026

تخيل معي هذا المشهد المتكرر: شركة كبرى ترسل...
432
| 28 يناير 2026

سوريا ليست بلدًا قاحلًا، أو منزويًا في الخريطة...
411
| 23 يناير 2026
مساحة إعلانية