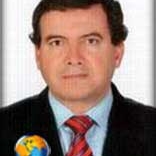رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قام الجنرال محمد ولد عبدالعزيز بانقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008، أطاح بحكم الرئيس ولد الشيخ عبدالله المنتخب ديمقراطيا في يوليو2007، وفي ظل التجاذب بين العسكر والمعارضة الديمقراطية، أقرَّ الجنرال محمد ولد عبدالعزيز ومعارضوه بقبول الوساطة السنغالية التي جرت تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية الخاصة ببحث الأزمة الموريتانية، والتي شملت الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الفرنكوفونية الدولية والأمم المتحدة. وفي18 يوليو2009تم انتخاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيسا لموريتانيا. وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم السبت 21يونيو الجاري، أشارت النتائج الرسمية للجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات الرئاسية، إلى فوز الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز علي بنحو 81.89في المائة من الأصوات، ضامناً بذلك غالبية واسعة أمام منافسيه الأربعة، ومحتلاً المرتبة الأولى أمام بيرام ولد داه ولد عبيد الذي حصد 8.67 في المائة. أما المرشح بيجيل ولد هميد فقد حصل على نسبة 4.5 في المائة من الأصوات، واحتل زعيم «حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية» إبراهيم صار المركز الرابع بحصوله على نسبة 4.44 في المائة، وجاءت في المرتبة الأخيرة المرأة الوحيدة في القائمة للا مريم بنت مولاي إدريس، المقربة من الحكومة، حيث حصلت على 0.49في المائة فقط. وكان الموريتانيون توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، في انتخابات شهدت مقاطعة ائتلاف المعارضة المتمثل في «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة». وراقب هذه الانتخابات أكثر من 200 مراقب عربي ودولي، بقيادة كل من أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والباجي قائد السبسي، الوزير الأول التونسي السابق ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، والسفير علاء الزهيري رئيس بعثة الجامعة العربية، ومنسق وفد الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء عبدالرؤوف عبدالعال. ووصلت نسبة المشاركة للناخبين إلى 56.54 في المائة، من أصل 1.3 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في موريتانيا التي يبلغ عدد سكانها 3.8 مليون. وكانت المفاجأة التي حملتها نتائج الانتخابات الرئاسية هي المكاسب التي حققها الناشط الحقوقي المثير للجدل بيرام ولد أعبيدي الذي يتبنى ملف العبودية في موريتانيا، وصرح أكثر من مرة عزمه وضع حد لحكم «العرب البيض» لموريتانيا. وكان بيرام ولد داه ولد عبيد، أحد المرشحين الذي واجه الرئيس المنتهية ولايته، والمعروف بنضاله من أجل أن ينال الحاراتين(المنحدرون من العبودية) حقوقهم. وكانت موريتانيا ألغت نظام الرق في عام 1981، واعتبرته جريمة في عام 2007. كما نص دستور 2012 على منع نظام الرق، وإن كانت الممارسات لا تزال قائمة بحدود ضئيلة. ويمثل الحاراتين نسبة 40 في المائة من السكان. وهناك مسألة العبودية في موريتانيا، فالخصوصية الحقيقية لنظام العربي- البربري أو الموري في موريتانيا، لا تعود إلى أنواع السلوك العبودي التي مورست، وإنما إلى الدرجة التي بلغتها في مستوى السلوك العبودي العام، كما يمكن تبنيه لجماعة الحاراتين التي تشكل شريحة واسعة من العبيد الموريين «المحررين» وذريتهم. وكان في العهد الماضي أحد أكثر الملفات سخونة، فالسلطات وموالوها سياسياً ينكرون وجود العبودية، ويعترفون بآثار لهذه الممارسة متمثلة أساساً في فقر الأرقاء السابقين، ووضعت برامج مكافحة الفقر للتغلب على هذا المشكل. ويقول حملة لواء الدفاع عن العبودية، وفي مقدمهم التياران القومي العروبي والإسلامي، إن قضية الرق في موريتانيا يمكن أن تحل بطريقتين: إما بثورة دموية، وهذا ما لا تقدر عليه البلاد، وإما بتطور المجتمع البطيء بفضل التنمية الاقتصادية، وهذا ما يجب تحقيقه. ويعتبر «ملف الزنوج الموريتانيين» أو ملف الأقلية الإفريقية، أحد الملفات الشائكة التي ستدور حولها المعارك البرلمانية، إذ لا يزال عشرات الآلاف من الأفارقة الذين هجّرهم نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع لاجئين في مخيمات على الحدود في دول الجوار، خصوصاً مالي والسنغال، منذ 1989 (ما بين 25 و60 ألفاً بحسب إحصاءات كل طرف)، ويتعلق الخلاف في هذا الملف بكيفية عودة هؤلاء المبعدين وتعويضهم، ووضع آلية لتحديد هوياتهم والتمييز بينهم وبين مواطني الدول المقيمين فيها. وكان الرئيس المرشح الفائز في الانتخابات محمد ولد عبدالعزيز، ركز في خطاباته الدعائية على الهجوم على الأحزاب المقاطعة للانتخابات، حيث اتهمها في أكثر من محطة من جولاته الانتخابية بالفساد والإجرام، وأكد سعيهم لجر البلاد إلى الفوضى من خلال ما يقول إن المعارضين يطلقون عليه «الثورة» معتبرا أنهم لو كانوا «ثوارا حقا لثاروا في العام 2005، أو العام 2004 أو ما قبلها»، وأضاف أنهم «لم يثوروا حينها لأنهم هم من كانوا في الحكم، ولا يمكنهم أن يثوروا على أنفسهم». ومن إنجازات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في ولايته الأولى، انتهاجه إستراتيجية حازمة في محاربة الإرهاب، حيث حقق الأمن للموريتانيين، في بلد تحول منذ العام 2005 إلى هدف مفضل لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ». فقد وضع الرئيس إستراتيجية فعالة تقوم على إصلاح المؤسسة العسكرية، والقيام بهجمات منظمة ضد تنظيم «القاعدة» في شمال مالي، حظيت بالدعم الكامل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. واستطاع الجيش الموريتاني في سنة 2010أن يقضي على مواقع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »في شمال مالي. ويعتبر الرئيس محمد ولد عبدالعزيز أن موريتانيا في عهده تحولت إلى دولة قوية في محاربة الإرهاب، وأصبح الجيش الموريتاني الذي تمرس على خوض المعارك ضد تنظيم القاعدة في الصحراء من أقوى جيوش المنطقة. أما في الجانب الاقتصادي فإن تفاصيل كثيرة لا يسهب ولد عبدالعزيز فيها، مقتصرا ـ غالبا ـ في أن موريتانيا قبل توليه الحكم 2008 كان نموها في حدود ناقص واحد، وفي 2013 ارتفع ليصل 6.7. ويرى الرئيس ولد عبدالعزيز أن موريتانيا في مجال الكهرباء انتقلت من العجز التام عام 2009، إلى تصدير الكهرباء خلال مأموريته. وفي مجال المياه يعدد الرئيس جملة من الإنجازات يقول إنها تحققت في عهده، والمدن التي يعدد أنها حصلت على المياه، لكن في نفس الإنجازات يعدد مشاريع يقول إنه سيعمل عليها، وأخرى بدأ العمل بها، أي أنها تنتظر الولاية الثانية على الأقل. وفي دقائق تفاصيل ما يعد الرئيس ولد عبدالعزيز من إنجازاته ربط موريتانيا بالكابل البحري، و1084 من الطرق المعبدة، ومطار نواكشوط الدولي، وإعادة تأهيل وترميم مطار سيلبابي. هناك عوائق بنيوية تقف بين الدولة الموريتانية التي هيمن عليها العسكر لأكثر من أربعة عقود وانتصار الفكرة الديمقراطية والحريات في بلد لا يزال يحبو على طريق الحداثة، مثل موريتانيا، الذي رغم أنه عرف نموا كبيرا لحركات معارضة فإنها لم تستطع أن تكون مجتمعا مدنيا قادرا على الصمود أمام وطأة الدولة، وعلى التفاوض مع هذه الدولة، وبالتالي على تزويد المجتمع السياسي باستقلاليته الفعلية.
1198
| 27 يونيو 2014
تحولت الأزمة العراقية إلى قضية تشغل اهتمام الدول الإقليمية الشرق أوسطية والدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حيث تسارعت التصريحات الغربية التي باتت تنادي بضرورة تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، واعتبار حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المدعومة من إيران، سبباً رئيسياً في اندلاع الأزمة.فقد شدّد الرئيسان الأمريكي والفرنسي - باراك أوباما وفرانسوا هولاند، مساء أمس، في بيان في ختام محادثات هاتفية بين الرئيسين،" على خطورة الوضع وعلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم على أساس حكومة وحدة وطنية.. واتفقا على أهمية تنسيق جهودهما من أجل التوصل إلى هذه الأهداف".وفي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار المسؤولين الأمريكيين على ضرورة "تشكيل حكومة وحدة وطنية" متحررة من النزعة الطائفية الشيعية، وتستبعد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الذي تحمله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في العراق عقب سيطرة المسلحين على مساحات شاسعة من المدن السنية، فيما دعا المرجع الشيعي الأرفع في العراق السيد السيستاني إلى تشكيل حكومة تتدارك الأخطاء.وجهت إيران انتقادات علنية إلى الإدارة الأمريكية بشأن تعاطيها مع الملف العراقي، حيث اعتبر مساعد وزیر الخارجیة للشؤون العربیة والأفریقیة حسین أمیر عبد اللهیان أنّ الرئيس باراك أوباما يفتقد "الإرادة الجادة لمواجهة الإرهاب في العراق والمنطقة"، مضيفاً أنّ "أمريکا ترکز الیوم في العراق علی تصعید الطائفیة، بدلا من التركيز على مكافحة الإرهاب وعلی الوحدة الوطنیة وسلطة الحكومة ومؤسسات الدولة". واعتبر أنّ "تسویة الأزمة العراقیة تكمن في خطوتین واضحتین" هما الوحدة الداخلية، إضافة إلى الوحدة في العملیة السیاسیة علی "أساس نتائج الانتخابات البرلمانیة الأخیرة في العراق".وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قال في البيت الأبيض إن "إيران يمكن أن تضطلع بدور بناء إذا وجهت الرسالة نفسها التي وجهناها للحكومة العراقية ومفادها «إذا تدخلت إيران عسكرياً فقط باسم الشيعة، فإن الوضع سيتفاقم على الأرجح». إن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عاجز عن اجتراح معجزات من نوع: تجريد ميليشيات حليفة ومعادية من السلاح، وتأمين بغداد لفترة مديدة، تقاسم الثروة، وتعديل الدستور، وتوسيع المشاركة السياسية لكي تشمل الطائفة السنية العربية التي تعيش حالة من التهميش، وإعادة النظر باجتثاث البعث، وبناء مؤسسات أمنية وطنية ذات طابع جمهوري، والتزام إنجازات مرحلية محدّدة، وحل مشكلات اقتصادية واجتماعية، وأخذ مسافة عن البيئة الطائفية المرتبطة بإيران التي أوصلته إلى حيث هو، إلخ... إنها مطالب لا يقدر عليها هذا إذا كان يريد تنفيذها أصلاً.هناك خريطة معقدة للميليشيات الرئيسة الموجودة على الأرض، إذ يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام منها ما يعتبر نفسه جيشا عقائديا مثل جيش المهدي، ومنها ما غير اسمه إلى مؤسسة مجتمع مدني مثل "منظمة بدر". ويقابل هذين الفصيلين الشيعيين فيلق عمر وأيضا تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، والتي تعتبر من أخطر الجماعات العاملة في العراق.. وهناك الميليشيات المخصصة لحماية الوزارات، وهي الأخطر لأنها تعمل وتتحرك بهويات وأسلحة الحكومة من دون رقيب أو حسيب. وفي العراق هناك أكثر من ثلاثين وزارة، وهناك أيضا عصابات منظمة، وأخيرا المافيات المسلحة، وشركات الحماية التي تعمل دون غطاء معروف أو لمن أو مع من. وفضلا عن ذلك، فإن الناس الذين يحملون السلاح من غير المؤدلجين في الشارع ناجم من عدم قدرة الحكومة العراقية على حماية من يسلم سلاحه للدولة في الوقت الراهن.. وهذا مرتبط بالمشروع السياسي الوطني الغائب الأكبر حتى الآن، والذي يصاحبه بطالة كبيرة، وفساد إداري مستشر.. فالميليشيات لا تحل بقرار حكومي بل تحتاج إلى قرار سياسي من جميع المشاركين في العملية السياسية، يبدأ باقتناع الأطراف السياسية العراقية بأهمية إلقاء السلاح، واحترام بناء دولة الحق والقانون، ثم منع التدخلات من دول الجوار، لاسيما إيران بالشأن العراقي.وأدت عملية إلغاء إنتاج السياسة في صلب المجتمع العراقي كله، إلى حصر السياسة في دائرة السلطة، الحكومة، أو الحكومة- السلطة، وإلى زيادة الطابع الاستبدادي لحكومة نوري المالكي الطائفية، الذي لم ينجم فقط عن طبيعة القوى الاجتماعية أو الفئة الاجتماعية المسيطرة على الدولة، بل ينجم عن بنية الدولة ذاتها ومن وظيفتها وميلها إلى مزيد من التفسخ والعودة إلى البنى الاجتماعية الإثنية والطائفية ما قبل القومية في إطار المزيد من التبعية، وهذا ما أصبحت تعيشه الدولة العراقية.. أما الدولة الوطنية فهي من هذه الزاوية دولة ديمقراطية بمعنى كونها دولة المجتمع التي يشعر كل مواطن بأنها صورته السياسية وملاذه، وضامن حقوقه، وحريته.إن المدخل الواقعي لإعادة بناء الوحدة الوطنية في العراق هي الصيغة التي تتحدد في ضوئها مهمات بناء الدولة الوطنية في هذا البلد العربي، الذي يعيش أجواء حرب أهلية وطائفية، وهي مهمات معقدة ومتداخلة، آثرنا أن يكون تحويل الدولة العراقية الحالية ديمقراطياً وقومياً مدخلاً إليها. وإذا كان من الضروري إيضاح الخطوط الرئيسية لاستعادة بناء الدولة الوطنية، فإن هذه الخطوط هي: أولاً: تحقيق التحول الديمقراطي في العراق، والتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الانتقالية بين نظام غير ديمقراطي ونظام ديمقراطي، فالنظام السياسي الذي يشهد تحولا ديمقراطيا يمر بمرحلة انتقالية بين نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي.. وبناء على ذلك فالنظام الديمقراطي هو النظام الذي يسمح بمشاركة سياسية واسعة في إطار الميكانيزمات الانتخابية، والاعتراف بمبدأ التداول على السلطة والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات، فمفهوم الديمقراطية يتضمن فكرة جوهرية وهي قدرة السياسات العامة على الاستجابة لمطالب الجماهير، وذلك عن طريق هياكل أساسية تقوم بتعبئة المصالح.. وتأسيسا على ذلك فإن التحول الديمقراطي هو مجموعة من المراحل المتميزة تبدأ بزوال النظم السلطوية يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها، وتعكس هذه العملية إعادة توزيع القوة بحيث يتضاءل نصيب الدولة منها لصالح مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن نوعا من التوازن بين كل من الدولة والمجتمع، بما يعني بلورة مراكز عديدة للقوى وقبول الجدل السياسي.وعليه فالتحول الديمقراطي هو عملية تهدف إلى إعادة النظر في خارطة القوة على مستوى النظام السياسي، والعمل على إعادة التوازن بين القوى الرسمية المتمثلة في الدولة والمؤسسات غير الرسمية متمثلة في منظمات المجتمع المدني.ثانياً: إن عملية الانتقال من نظام تسلطي إلى نظام ديمقراطي، يتم فيها حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية، لا تتم إلا من خلال انتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة الأنشطة السياسية، فالتحول الديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياسي وعلاقات التراتب في الحقل الاجتماعي. ثالثا: المقدمة الأولى للدولة الوطنية وضمانة تحولها إلى دولة ديمقراطية، تكمن في تحقيق الاندماج القومي في العراق، ونقصد بالاندماج القومي تصفية البنى والعلاقات ما قبل القومية، والانتقال من مفهوم الجماعة إلى مفهوم المجتمع المدني، ومن مفهوم الملّة الديني إلى مفهوم الأمة العلماني والديمقراطي، ومن وضعية التكسر المجتمعي وتحاجز فئات المجتمع إلى الوحدة المجتمعية السياسية - وسيرورة الاندماج القومي هذه هي ذاتها سيرورة نمو المجتمع المدني العلماني، وسيرورة بناء الدولة الوطنية وفق مقتضيات العقل ومطلب الحرّية. رابعاً: الدولة الوطنية هي التي تتبنى العلمانية، بفتح العين، وهي التنمية المنطقية والتاريخية للإنسانية، تعني على المستوى الوجودي، رفض أي سلطة على عقل الإنسان وضميره سوى سلطة العقل والضمير.. وتجلى ذلك في رفض سلطة المؤسسة الطائفية، لا رفض الدين، أي رفض سلطة مؤسسة الطائفة التي كانت ولا تزال تؤسس الاستبداد الديني وتعززه وتؤازر الاستبداد السياسي وتعززه.. وعلى هذه القاعدة لا يحق لأي جماعة أن تفرض عقيدتها الطائفية أو الدنيوية على المجتمع،ولا يحق لها كذلك أن تغض من شأن المعتقدات والمذاهب الأخرى.. العلمانية بهذا المعنى هي التجسيد العملي للمساواة.خامسا: الدولة الوطنية هي التي تتبنى العمومية، فتكون الدولة بهذا التعريف، دولة جميع مواطنيها بلا استثناء ولا تمييز، لا دولة طبقة رأسمالية أو بروليتارية ولا دولة جماعة إثنية أو عشيرة أو جماعة إسلامية، ولا دولة حزب ولا دولة طغمة تحتكر السلطة والثروة والقوة.. المجتمع المدني هو الذي ينتج الدولة السياسية أي الدولة الوطنية، تعبيراً عن كليته ووحدته التناقضية، بما هو مجتمع الأفراد المختلفين والجماعات المختلفة والطبقات أو الفئات الاجتماعية المختلفة ذات المصالح المتعارضة.سادساً: الدولة الوطنية هي التجسيد الواقعي لدولة القانون.
549
| 26 يونيو 2014
في العراق اليوم، الذي يعيش على وقع حرب طائفية مستعرة، مع تقدم الهجوم الذي تشنه جماعات سنية من بينها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بدأ من الموصل وزحف باتجاه العاصمة العراقية بغداد، رافقه تصعيد وتجييش طائفي من جانب الحكومة العراقية بقيادة نوري المالكي الذي يعتمد على ميليشيا شيعية تلقت تدريبات في إيران لصدّ هجوم محتمل على العاصمة، في هذا العراق الذي يعيش في ظل أجواء حرب طائفية، تلتقي إيران مع عدو الأمس، الولايات المتحدة الأمريكية، الملقبة بـ«الشيطان الأكبر» في الخطاب السياسي الرسمي، من أجل مواصلة العمل لتحقيق الهدف المشترك، ألا وهو تعزيز بقاء نظام نوري المالكي، ومواجهة هجوم الجهاديين السنة. هذه القصة باتت مألوفة، إذ يمكن أن تتقاطع المصالح بين هذين الخصمين منذ أكثر من ثلاثين سنة، فغزو العراق واحتلاله سنة 2003شكلا هدية أمريكية ثمينة لإيران، لاسيَّما وأن سلطات الاحتلال الأميركية آنذاك دمرت الجيش العراقي بعدما أطاحت بنظام صدام حسين، وقوّت حلفاء إيران داخل العراق، وجعلت من مناطق عديدة في العراق ساحة آمنة للنفوذ الإيراني القاطع. ففي ظل هذا الإجماع الجيد، كان ردّ الفعل للإدارة الأمريكية الحالية والقيادة الإيرانية بنفس الطريقة إزاء تقدم القوات المهاجمة من جانب تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"(داعش). فالأمريكيون والإيرانيون مستعدون لمساعدة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، للدفاع عن نفسها ضد هجوم "داعش". وكانت الحكومة العراقية التي تشكلت بعد انتخابات 2005، تمثل "الشيعية العراقية" التي أصبحت ماسكة للسلطة في العراق ومتحالفة مع واشنطن، وأضحت أيضا في صدارة الحكم ضمن صيغة الدولة العراقية ذات الشخصية الفيدرالية على صعيد العلاقات بين القوميات وذات الشخصية الطائفية غير المستقرة إلى حد الآن – على صعيد العلاقة بين طائفتي عرب العراق، الشيعة والسنة. إن حكومة نوري المالكي التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى السلطة ضمن "معادلة ديك تشيني"، تمثل نظاماً سياسياً زبائنياً ومذهبياً وعاجزاً عن القيام بأي إصلاح سياسي من شانه أن يساهم في بناء دولة القانون، هي مدينة للولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت لها كل مقومات الدعم غير المشروط لاستمرار بقائها في السلطة، والذي لا يمكن للمالكي الاستغناء عنه، والتي عبدت لها أيضا الطريق لكي تكون مقبولة من قبل النظام الرسمي العربي، لكي يستوعب "الشيعية العراقية " التي هي أكبر وأهم كتلة مسلمة شيعية في العالم العربي، دينياً وسياسياً واقتصادياً، باعتبارها أفضل طريقة لإبعادها عن وحدانية النفوذ الإيراني، قد صادقت على الاتفاقية الأمنية، حتى وإن اعترض نوري المالكي علنا على بعض بنودها، ولاسيَّما تلك المرتبطة بالولاية القضائية للحكومة العراقية، والسيادة. وعقب سقوط الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق في أيدي تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام "(داعش) الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان أن سفينة النقل البرمائية ميسا فيردي دخلت إلى مياه الخليج وعلى متنها 550 من مشاة البحرية لدعم أي نشاط أمريكي محتمل لمساعدة الحكومة العراقية. وتنضم السفينة إلى حاملة الطائرات "جورج إتش. دبليو. بوش" التي أمرت الوزارة يوم السبت الماضي بأن تتحرك إلى الخليج بالإضافة إلى طراد الصواريخ الموجهة "فيليباين سي" والمدمرة "تروكستون" تحمل صواريخ موجهة. وقالت وزارة الدفاع في بيان "السفينة ميسا فيردي قادرة على القيام بمجموعة من عمليات رد الفعل السريع والاستجابة للأزمات". وتحمل السفينة قطعة ملحقة لطائرات "إم في 22 اوسبري". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحدث عن عمل عسكري "فوري" يجب القيام به في العراق، من دون إرسال قوات ميدانية، وهو ما فسّر على أنه لجوء أمريكي محتمل إلى الغارات الجوية أو الضربات الصاروخية لمنع تقدم "جهاديي داعش" نحو العاصمة العراقية، وإدراك امريكي - ولو متأخر - بفداحة المشهد العراقي، وربما الإقليمي، إذ قال أوباما صراحة إن "الرهان هنا هو ضمان ألا يستقر الجهاديون بشكل دائم في العراق أو في سوريا أيضاً". وتابع قائلاً "لكن يجب أن يكون ذلك أيضاً تنبيهاً للحكومة العراقية. يجب أن يكون هناك مكوّن سياسي". ومن الجانب الإيراني، أجری الرئیس الإيراني حسن روحاني اتصالاً برئیس الوزراء العراقي نوري المالكي، حيث أشار إلی أنّ "إیران حكومة وشعبا تقف إلی جانب الشعب والحكومة العراقیة". وقال روحاني إنّ حكومة بلاده "ستبذل قصارى جهدها علی المستوی الدولي والإقلیمي لمواجهة الإرهابیین ولن تسمح لحماة الإرهابیین أن یمسوا الأمن والاستقرار فی العراق من خلال تصدیرهم الإرهاب إلی هذا البلد"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.وكانت مصادر من المعارضة العراقية، قالت إن طهران أرسلت 3 ألوية من قوات الحرس الثوري و"فيلق القدس" لمساعدة القوات الحكومية في معاركها لاستعادة السيطرة الكاملة على منطقة الأنبار، فيما تطوع حوالي 5000 إيراني للدفاع عن "الأماكن المقدسة" في العراق، أمام زحف المسلحين على ما أفاد موقع إنترنت إيراني محافظ، الثلاثاء. فإيران تحت غطاء نشر الثورة الإسلامية في بعدها الطائفي الشيعي، تعمل في حقيقة السياسة الواقعية إلى خدمة أهداف مشروعها القومي الفارسي، الذي يعمل على إبقاء العراق تحت الهيمنة الإيرانية، والادعاء بمحاربة العدو الصهيوني عبر دعم حزب الله في لبنان، لكي تقايض إيران الغرب بشأن برنامجها النووي، ويتم الاعتراف بها كقوة إقليمية في المنطقة. هذا التلاقي في المصالح الإستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يمكن أن يسهل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني التي استأنفت، يوم الإثنين 16 يونيو الجاري، في فيينا، ويأمل المشاركون فيها أن يتوصلوا إلى اتفاق من جزأين حتى 20 يوليو المقبل: ضمان البرنامج النووي لطهران ألا يتضمن أي بعد عسكري؛ ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية المطبقة ضد إيران. إيران كما هي أمريكا، لا تريدان أن تتشكل دولة وطنية ديمقراطية في العراق، حاملة لمشروع وطني، لأن هذا يتناقض مع المصالح الإستراتيجية الإقليمية لإيران، ومع أهداف الكيان الصهيوني، الذي يرفض أن يلعب العراق دورا إقليميا في المستقبل. في كتابه الهزيمة الذي صدر في لندن سنة 2008، يقارن الكاتب جوناثان ستيل، مراسل صحيفة الجارديان للشؤون الخارجية، بين هذين الاحتلالين الألماني والياباني واحتلال العراق، فيقول إن المحتلين الغربيين لألمانيا لم يفرضوا على هذا البلد مؤسسات غريبة عنه، بل كانوا يحاولون استعادة نظام سياسي واقتصادي كان قد اختل نتيجة الدكتاتورية النازية التي دامت ثلاث عشرة سنة أي فترة قصيرة بالحسابات التاريخية. ومما ساعد في نجاح تلك التجربة أن المحتلين كانوا مشابهين في خلفيتهم الثقافية وتربيتهم وقيمهم للشعب الذي حرروه. فلم يكن ثمة صدام ثقافات كبير.. أما في العراق، فلم يأخذوا في الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي، أو تاريخ العراق، أو مخزون السخط العربي العميق في المنطقة، مما سيحكم بالفشل على أي احتلال غربي. ليست مؤسسات الحكومة العراقية بزعامة نوري المالكي سوى أضحوكة، بما أنها على حافة الانهيار. ومن جانب آخر الجيش العراقي منقسم في معظمه إلى كتائب سنية وشيعية وكردية، حيث ترفض الوحدات بصورة دائمة تنفيذ الأوامر القادمة من السلطة المدنية، إذ كانت تتعارض مع تمنيات المرجعيات الدينية أو الإثنية.وفي مناخ الحرب الأهلية هذا، أي إستراتيجية تهدف إلى بقاء حكومة نوري المالكي بمؤسسات تضمن الأمن الوطني، مثل الشرطة والجيش، ليس لديها أي حظ من النجاح. فالمشكلة لا تكمن في أن حكومة المالكي حكومة طائفية بامتياز، وإنما علاوة على ذلك هي لا تسيطر على أي شيء، لاسيَّما في العاصمة بغداد. فالشرطة والجيش ليسا الضامنين غير المنحازين للأمن العام، وإنما المليشيات المتورطة في الحرب الأهلية. إن الخطأ الاستراتيجي الأمريكي وقع بسبب ضرب العامل الوحدوي في العراق، ألا وهو الجيش، بينما بقي هذا العامل قائما عبر الدوائر والمؤسسات في كل من ألمانيا واليابان بعد وقوعهما تحت الاحتلال الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث لم يحصل في البلدين أي خلل على صعيد الأمن الداخلي.. أما في حال العراق، فقد تم تدمير وحدته المجتمعية وتنوعه الديني والمذهبي والعرقي بعد الغزو الأمريكي في العام 2003، حيث عجزت السلطة العراقية الجديدة عن بناء دولة مدنية مركزية حديثة، الأمر الذي جعل الأكراد يستغلون ضعف السلطة المركزية لكي يعيدوا تجديد مطالبهم بشأن الانفصال وبناء دولة كردية مستقلة. وفي جانب العرب السنة، فإن الأحزاب السنية التي رفضت الاحتلال الأمريكي للعراق، وانبثقت منها مقاومة خاضت صراعا مسلحا ضد القوات الأمريكية، نجدها بعد الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، متوجسة خوفا من "النفوذ الإيراني" الذي يدعم المشروع الطائفي الشيعي في العراق، ويعمل على تهميش العرب السنة.
1329
| 20 يونيو 2014
عاد شبح سايكس بيكو جديد أو إعادة تقسيم كل بلدان الشرق الأوسط من جديد، المفروض من الخارج للظهور بشكل متواتر مع الغزو الأمريكي للعراق في مارس سنة 2003،. وبدا التصدع كبيراً وسريعاً، بسبب فشل السياسات التي اعتمدت خلال عقد كامل من الغزو الأمريكي للعراق، في بناء دولة وطنية ديمقراطية في هذا البلد العربي.. فها نحن نشهد اندفاعة قوية لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، باتجاه السيطرة على العاصمة العراقية بغداد، بعد أن غزا مدن الموصل وتكريت، والسامراء، خلال الفترة الأخيرة. إنّ ما يجري في العراق، من تنامي سطوة التنظيمات الإسلامية المتشددة، يؤكد مرّة أخرى على فشل مغامرة الولايات المتحدة وبريطانيا، فالوقائع في العراق، تثبت أن مدبّري هذه المغامرة العسكرية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا، لم يعودوا يسيطرون عليها كذلك. ويتحمل الغرب مسؤولية زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط،وما نجم عنها من عواقب وخيمة، لجهة تحطيم الدولة الوطنية العراقية، وإفساح في المجال لقيام نظام طائفي شيعي موالي لإيران.. وما من شك في أن من غزا العراق قبل عشر سنوات،، ويواصل فرض قراراته وإرادته على شعوب المنطقة العربية، أسهم بشكل كبير في إطلاق عملية زعزعة الاستقرار،وتدمير الدولة الوطنية العراقية، وهي النتيجة الواضحة اليوم عملياً في سائر الشرق الأوسط. إن سيطرة تنظيم "داعش" على المناطق النفطية الحدودية بين سورية والعراق، تعزز بطريقة رمزية مطلب الحركات الإرهابية في إقامة دولة للخلافة في المنطقة. ويعيش العراق اليوم مدًا غير مسبوق للقوى الدينية الطائفية والرجعية. فهذه القوى تكرس قوى الطوائف، وتضعف دور القوى الوطنية والديمقراطية، وتهدد بقيام "دول" أحادية الطائفة. لأن الوفاق الطائفي مستحيل، ما لم يلبّ مطالب كل الطوائف،و في مقدمتها الطائفة السنية التي تعاني من التهميش السياسي المفضوح،أو يفرض هيمنة بعضها على بعضها الآخر. ولأن السياسة الأميركية – الصهيونية والإيرانية، كانت تؤيد التبلور الطائفي هذا ولا تزال، الذي يقود حتماً إلى تقسيم العراق على أساس طائفي مذهبي وعرقي. في السنوات التي تلت ما بعد الغزو الأميركي للعراق، كانت المشكلة الأخطر التي تواجه المجتمع العراقي، هي المشكلة الطائفية، لأنها تحول المواطن من مواطن يفكر على صعيد الوطن إلى فرد يفكر على صعيد الطائفة. ولما كانت الطوائف متداخلة ومتشابكة في المعيشة والحياة، فإن اتجاه طائفي سوف يثير عداء بين مواطنيها، ويقود إلى صراعات طائفية وحرب أهلية، كحرب لبنان الأهلية، مما يسهل استقطاب المواطنين على أسس طائفية، ويبعدهم عن البرنامج الوطني الديمقراطي.و عليه فإن التوجيه الطائفي هو ما تسعى إليه الامبريالية الأميركية والعدو الصهيوني لاستخدامه سلاحا في معركتها من أجل تفتيت إرادة المواطنين العرب، لتوجيه الصراع في اتجاه خاطئ، مضاد للاتجاه التاريخي. وحين حصل الغزو الأميركي للعراق، انهارت معه الدولة الشمولية العراقية بطريقة دراماتيكية. وانهار معها. حزبها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية ومنظماتها ومجتمعها. لأن هذه الدولة المتغولة كانت كل شي ء. وقضت على بنى المجتمع المدني الحديث التي كانت من المفترض أن تشكل خنادق الحرب المعاصرة. عندما تنهار سلطة الدولة الحديثة. على حد قول أنطونيو غرامشي. وحين فتكت هذه الدولة الشمولية العراقية بمؤسسات المجتمع الأهلي التقليدية. ومؤسسات المجتمع المدني الحديثة كالأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الشعبية. جسدت ثقافة العنف الوطني، الأمر الذي يفسر لنا أيضا غياب هذا المجتمع المدني في زمن الكارثة العراقية الحالية بعد الهزيمة العسكرية لمؤسسات الدولة الشمولية العراقية:الجيش. والحرس الجمهوري. وفدائيي صدام. و جيش القدس. بيد أن الأحزاب السياسية المتبرقعة بالطائفة والقبيلة والمذهبية،ورثة الدولة الشمولية العراقية في زمن الاحتلال الأميركي، عجزت أن تبني دولة وطنية عصرية، لأن هذا ليس في برنامجها، ولا هي مؤهلة لذلك، كما أنها استبدلت ثقافة العنف الوطني الذي كان سائدا في العهد السابق بثقافة العنف الطائفي- المذهبي، الذي يتبجح بطائفيته، كما هو الحال في ظل نظام نوري المالكي، التابع لإيران. فانتقل المجتمع العراقي بذلك من ثقافة عنف الدولة الشمولية إلى ثقافة كابوس العنف الطائفي، وفرق الموت، والإرهاب الأعمى، والقتل على الهوية. تلك هي صورة العراق الجديد الذي يتماهى مع إيديولوجية الفوضى الخلاقة، التي روج لها المحافظون الجدد. وقد أسهمت مجموعة من العوامل في تبلور القوى الطائفية. أولها: إعطاء الدول الامبريالية، وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية العالم العربي اهتماما خاصا بحكم موقعه الاستراتيجي، وتحكمه بمضائق ومحيطات وبحار عديدة، واحتضانه في مخزونه الجوفي ثروة نفطية هائلة، واحتمال فقدان العالم العربي لمصلحة القوى الوطنية والديمقراطية، الأمر الذي يشكل ضربة قاسمة للعالم الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، والطبقات والفئات المحلية التابعة. ثانيها:قيام دولة الكيان الصهيوني، سنة 1948، وحرصها على منع تحرر الجماهير العربية من ربقة الأنظمة الشمولية،و منع وحدتها بكل الوسائل. ثالثها: ازدياد تغلغل العولمة الرأسمالية في المجتمعات العربية، حتى هزّ كل البنى التقليدية (المدينة، القرية، القبيلة، الطائفة) ودفع قطاعات تقليدية للدفاع عن مواقعها، خشية أن يجرفها سيل "الحداثة" الجارف. رابعها: عجز "الثورة الإيرانية" عن كسب معركة احتلال العراق والخليج في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وإقامة دولة "إسلامية "في العراق. خامسها: انشغال الأطراف الدينية والطائفية بالمعارك الداخلية عن المعارك مع الامبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، ومحاولة إشغال كل الأطراف، على الصعيد العربي، أو صعد الدول الإسلامية بالصراعات الداخلية. وقد التقت هذه العوامل جميعا، لتدفع القوى الامبريالية، بقيادة الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، وإيران،إلى البحث عن وسائل ناجعة للجم قوى التغيير الديمقراطي وفرض هيمنة القوى الطائفية. و اكتشفت هذه القوى مجتمعة ما يلي: أولا: أنها تستطيع توظيف الدين، ضد القومية والديمقراطية. فتجند جماهير واسعة من المؤمنين وترد على الهجوم الإيديولوجي بهجوم ايديولوجي واسع، له جذوره التاريخية، وركائزه الشعبية. وهكذا يرد على البرنامج القومي ببرنامج إسلامي ذي بعد طائفي، ويواجه الوحدة القومية بوحدة إسلامية، ودولة الحق والقانون بدولة إسلامية، والديمقراطية بالشورى، والحريات الديمقراطية بتطبيق الشريعة. فيكون الرد إيديولوجيا وسياسيا شاملا، ويصبح الديمقراطيون كفرة وملحدين خارجين على الدين.. ثانيا: أنها تستطيع أيضا حشد قوى الطوائف وراء زعامات طائفية، فتسحب من الأحزاب معظم قواعدها ورصيدها الشعبي، وتغلق تجمعات الطوائف في وجه الديمقراطية والقومية، وتثير نزاعات ليس لها حدود، لا تمنع وحدة الوطن فحسب بل تخلق فيه شروخا عديدة جديدة، وتستنزف قواه في صراعات داخلية متجددة. ثالثا: إنها تستطيع انتزاع زمام المبادرة بتكوين أحزاب طائفية مسلحة، لها مليشيات مسلحة، تمتلك الوعي السياسي، والتنظيم والتدريب. ومع سقوط الدولة الشمولية العراقية، وفي ظل الاحتلال الأمريكي، ارتبط الهجوم السياسي والأيديولوجي للقوى الطائفية المسنودة لوجيستيكيا وماليا من جانب إيران، بتكوين ميليشيات مسلحة، مستعدة للمواجهات، وقادرة على المبادرات. وخاضت هذه القوة الطائفية معارك غير معارك القوى الوطنية والديمقراطية، لأنها معنية بإقامة سلطة الطائفة الشيعية، ونشر ثقافة العنف المذهبي. و عملت برعاية أنظمة إسلامية مثل إيران، وقوى دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
561
| 16 يونيو 2014
طرحت الدولة المدنية في العالم العربي في ظل الثورات التي قامت في وجه أنظمة الاستبداد وبسبب الخوف من استغلال انتماء معظم مواطني البلدان العربية إلى الإسلام كذريعة من أجل إقامة الحكم الإسلامي بما يعنيه من تطبيق الشريعة أو «الحاكمية الإلهية»، وهو حكم بعيد عن الديمقراطية التي تطمح إليها الشعوب، على غرار الأنظمة الإسلامية المعروفة من مثل السعودية وإيران وأفغانستان والسودان و«حماس» في غزة.من هنا برزت الحاجة إلى ضرورة إيجاد دساتير جديدة وآليات لحماية أهداف الثورات والعمل على سيادة القانون، وإيجاد عقد اجتماعي جديد يضمن المساواة والحريات والعدالة الاجتماعية واحترام التعددية والانتقال السلمي للسلطة.إذن تطرح الدولة المدنية كبديل من الدولة الدينية التي أثبتت فشلها في جميع التجارب المحيطة بنا، وهذا ما تم نقاشه خلال الإعداد لوثيقة الأزهر كما ينقل جابر عصفور، حيث أُتي الإتيان على ذكر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة دون اعتراض في البداية، ثم اكتشف البعض أن الإبقاء على صفة المدنية يحمل معاني سلبية واستشهد البعض بأن لا وجود لما يسمى الدولة المدنية في معاجم النظريات السياسية الغربية رغم وجود ما يسمى مجتمع مدني، ورأى البعض الآخر أن مفهوم الدولة المدنية غامض، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مفهوم الدولة المدنية نشأ في بلدان الربيع العربي كي لا يتم الخلط بين الدولة العلمانية الفرنسية المعادية للدين فيما الدولة في البلدان الأخرى خاصة الانكلوسكسونية تستخدم مفهوم Secular State ويفهم منه الدولة المدنية كنقيض للدولة الدينية وليس كمعادية للدين كما يبدو عليه الأمر في فرنسا، انتهى الأمر بالنقاشات في الأزهر إلى اعتماد كلمة الوطنية في الوثيقة المعلنة لتصبح دولة وطنية ديمقراطية حديثة دون أن تكون معادية للأديان.يعرف مفهوم الدولة المدنية، المتداول حديثاً، بالدولة الديمقراطية التي تحافظ وتحمي جميع أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والعرق والدين والمعتقد، هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي لا يمكن أن تتحقق بغياب أحد الشروط عنها، أهمها: 1- الدولة المدنية هي الدولة التي تؤمن حرية المعتقد والمساواة والمواطنة، فالفرد لا يُعرّف بمهنته أو بدينه أو بماله أو بسلطته، ولكن يُعرّف تعريفا قانونيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. 2- الدولة المدنية يجب أن تقوم على دستور ومنظومة من القواعد التشريعية والتنفيذية، فالدستور يبلور جملة القيم والأسس التي ارتضاها أفراد المجتمع لبناء نظامه السياسي والاجتماعي. 3- الدولة المدنية هي أيضا دولة مؤسسات، وتقوم هذه المؤسسات على مبدأ التخصص فهي تمارس أعمالها بشكل مستقل وفق ما يعرف بمبدأ فصل السلطات، بحيث تقوم كل سلطة بممارسة مهامها ضمن مجالها المحدد ولا تتجاوزه إلا في حدود ما تقتضي ضرورات التعاون والتكامل بين هذه السلطات، إذ إن السلطة العليا في الدولة المدنية هي سلطة القانون الذي يلجأ إليه الأفراد من أجل حفظ حقوقهم من الانتقاص والانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع أي طرف من تطبيق أي شكل من أشكال العقاب بأنفسهم، النظام العام هو الذي يحمي المجتمع. 4- الشرط الأساسي لقيام الدولة المدنية المطلوبة اعتماد الديمقراطية كنظام سياسي لها، وأهم شروط النظام الديمقراطي تقوم على فصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة، والوصول إلى الحكم من طريق انتخابات حرة ونزيهة. 5- من المعالم الأساسية للدولة المدنية وجود مجتمع مدني فاعل ومؤسسات مدنية فاعلة للنهوض بمستوى الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع والمساعدة في فهم الواقع السياسي والاجتماعي فهماً صحيحاً والمشاركة في بناء مؤسسات ديمقراطية وممارسة الرقابة عليها من خلال التنظيمات المدنية المختلفة والوسائل الإعلامية والرقابية المتاحة.الدولة المدنية هي استعادة حقيقية لبناء الدولة الوطنية والارتقاء بها إلى دولة ديمقراطية، أي إعادة إنتاج الدولة الوطنية الحديثة، دولة الحق والقانون المعبرة عن الكلية الاجتماعية والقائمة على مبدأ المواطنة. وتشكل سيادة الشعب، العامل الحاسم في سيرورة التحول الديمقراطي في نطاق الدولة الوطنية. وتكمن المقدمة الأولى للدولة الوطنية وضمان تحولها إلى دولة ديمقراطية، في تحرر الأفراد من الروابط والعلاقات الطبيعية ما قبل الوطنية كالعشائرية، والعرقية، والمذهبية، والطائفية، واندماجهم في فضاء اجتماعي وثقافي وسياسي مشترك هو الفضاء الوطني.فالدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا دولة ديمقراطية التي تقوم على ما يلي: احترام حقوق الإنسان أولاً، وحقوق المواطن ثانياً، وفكرة الأكثرية الانتخابية الحرة التشكيلية، ثالثاً، وضمان التداول السلمي للسلطة على جميع المستويات وفي كافة مؤسسات الدولة، رابعاً. فالدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية لأنها تستبعد الاستئثار بالسلطة وتعتمد الرجوع إلى القاعدة بشكل دوري. والديمقراطية هنا هي الليبرالية مفهومة فهماً جدلياً وتاريخياً صحيحاً مفهوم الشعب، وهذا الأخير مُؤَسس على مفهوم الوطن والمواطنة، ونفي «الحرب خارج المدينة»، أي نفي العنف بكل صوره وأشكاله، ونفي الحرب خارج حدود الوطن ونطاق الأمة. إن الدولة المدنية ليست بدولة عسكرية، وليست أيضاً بدولة دينية، لكنها ليست بالضرورة أن تكون دولة علمانية بالمعني الغربي للكلمة، فالدولة المدنية ترفض الدولة الدينية « الثيوقراطية»، وتستبعد إسناد عملية الحكم إلى فئة من رجال الدين أو الفقهاء لأن السياسة والإدارة والقانون والاقتصاد هي تخصصات يؤهل لها من يمارسها تأهيلاً خاصاً كما يؤهل رجل الدين أو الفقيه أو العالم بالقضايا الشرعية في المعاهد والكليات الشرعية ولا يمكن لأحد أن يحل محله في الإفتاء والاجتهاد في القضايا الشرعية وكما نعترف لرجل الدين بعلمه وكفاءته في الإفتاء في الأمور الدينية فيجب أن نقر لرجل الاقتصاد والقانون والإدارة والسياسة بخبرته وتأهيله للقيام بالعمل الحكومي وبالتالي فإن الدولة المدنية لا تقبل بأسناد عملية الحكم للفقهاء أو رجال الدين لمجرد أنهم علماء بأمور الدين ويرتدون عباءة الفقيه. فالدولة المدنية لا ترفض الدين ولا تعادي الدين ولكنها ترفض استغلال الدين لأغراض سياسية فهي ترفض إضفاء طابع القداسة على الأطروحات السياسية لأي من الفرقاء في العمل السياسي أو تنزيه أي رأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات عن النقد أو النصح والتوجيه. فالإسلام يفرق بين الوحي وبين الاجتهاد في فهم وتفسير الوحي فلا يعطي لهذه الاجتهادات لذاتها قداسة وإنما يقبلها بقدر ما تقدمه من حجج على صحة فهمها وتفسيرها للكتاب والسنة.ومن جانب آخر فإن الدولة المدنية ترفض نزع الإسلام من ميدانه الروحي ومن مجاله المقدس والزج به في المجال المدنس الذي هو مجال الصراعات والمؤامرات والألاعيب السياسية.الدولة المدنية من هذا المنظور هي دعوة للانفتاح ودعوة لاستيعاب تراث فكر الحداثة الغربية، لاسيَّما في مجال قضية حقوق الإنسان، باعتبارها القضية المركزية في نسق الحداثة وفي منظومتها القيمية، وفي الثقافة الديمقراطية سواء بسواء. ولا يمكن فصل مقولة الحرية أو مشكلة الحرية، بتعبير الفلاسفة، عن قضية حقوق الإنسان وكرامته.ومن المهم أن نلاحظ أن قضية الحرية كانت غائبة عن الثقافة العربية وعن الفكر السياسي خاصة، ولا تزال غائبة، ولذلك من السهل تذويب الفرد في العشيرة والطائفة والجماعة الإثنية.
1269
| 06 يونيو 2014
تعيش نيجيريا منذ 14 أبريل الماضي على وقع اختطاف 276 تلميذة من مبيتهن الداخلي في مدرسة شيبوك الواقعة في الشمال الغربي للبلاد، من قبل جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة، وقد استطاعت 53 تلميذة الفرار من هذا الجحيم الذي وضعن فيه، بينما بقي 223 تلميذة قيد الأسر القسري في مكان مجهول من طرف خاطفيهن. وفي أول شريط فيديو بث يوم 12 مايو الجاري، أعلن أبو بكر شيكاو زعيم بوكو حرام في الفيديو هذا مسؤولية بوكو حرام عن عملية خطف التلميذات في ولاية بورنو في منتصف أبريل الماضي، وأضاف أن التلميذات اعتنقن الإسلام، مظهرهن في إطار صلاة جماعية، وطالب زعيم بوكو حرام باستبدال التلميذات النيجيريات المخطوفات بمعتقلين إسلاميين متشددين لدى الحكومة النيجيرية. يعتبر النيجيريون أن هذا الشريط الجديد يعكس صورة الزعيم الإسلامي الذي نسبت إليه سلسلة هجمات دامية منذ أن خلف محمد يوسف على رأس هذه الحركة بعد أن أعدمته الشرطة النيجيرية في 2009. وقالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير أخير "مع شيكاو على رأس بوكو حرام أصبحت الحركة أكثر عنفاً وفتكاً وتدميراً".. حتى إن جماعة أنصار الشريعة الإسلامية التي أعلنت مسؤوليتها عن خطف أجانب وبثت أشرطة فيديو عن إعدامهم على الإنترنت، قررت أن "تأخذ مسافة من بوكو حرام لأنها تعارض المجازر العشوائية التي ترتكبها ووحشيتها" كما ذكرت مجموعة الأزمات الدولية.رفضت وزارة الداخلية النيجيرية الخضوع لهذا الابتزاز، مؤكدة أنه لا مجال لاستبدال شخص بشخص آخر، وليس لبوكو حرام والخاطفين أن يملوا علينا شروطهم، وبالمقابل يرى الأستاذ من المعهد الفرنسي للجيوبوليتيك المتخصص في نيجيريا مارك أنطوان بيروس دو مونتكلو، أن هناك تواطؤا من قبل الأجهزة الأمنية النيجيرية سهلت عملية خطف التلميذات. ويتساءل هذا الخبير الدولي، لماذا هذه المدرسة بالذات ظلت مفتوحة للقيام بالامتحانات، بينما كل مدارس الولاية أغلقت أبوابها؟ و كيف تمكن الخاطفون من الفرار برهائنهم، بينما الطرقات تجوب فيها الدوريات العسكرية؟عملية خطف التلميذات النيجيريات أثارت تنديداً محليا في الداخل النيجيري، وكذلك تنديدا دولياً، إذ أعلنت الولايات المتحدة أن طائرات تجسس تحلق فوق شمال نيجيريا للمساعدة على العثور على نحو 223 تلميذة مخطوفات منذ منتصف أبريل لدى جماعة بوكو حرام الإسلامية التي رفضت الحكومة النيجيرية مطالبها للإفراج عنهن. وتأتي مهمات "التجسس" و"المراقبة" التي أعلنت عنها واشنطن مساء الاثنين 12 مايو الجاري في وقت تتوسع فيه التعبئة الدولية من أجل هؤلاء الفتيات وقبل بضعة أيام من انعقاد قمة تنظمها فرنسا حول هذا الملف.وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "لقد تقاسمنا مع النيجيريين صوراً التقطتها أقمار صناعية تجارية ونقوم بعمليات تحليق بمشاركة طياري تجسس ومراقبة واستطلاع فوق نيجيريا بإذن من الحكومة". تشكلت جماعة "طالبان" المعروفة في نيجيريا بلغة الهاوسا بـ"بوكو حرام" (أي التربية الغربية حرام)، في يناير 2004، من طلاب تخلوا عن الدراسة واتخذوا من قرية كاناما في ولاية يوبي (شمال شرق نيجيريا) المحاذية للحدود مع النيجر قاعدة لهم، لكن السلطات قالت إنها تأسست منذ العام 1995.. وضمت الجماعة عند إنشائها حوالي مئتي شاب مسلم متطرف بينهم نساء، وتبنوا على غرار نظام "طالبان" السابق في أفغانستان هدف إقامة دولة "إسلامية" شمال البلاد، ولاسيما بعد أن تمركزت الجماعة في أربع ولايات نيجيرية هي بوشي وبورنو وكانو ويوبي.وفي عام 2005، صرح امينو تاشن ايليمي، أحد قادة الجماعة، بأن الأخيرة تعتزم شن تمرد مسلح وتنظيف المجتمع من "الفسق والفجور". وكانت ولاية كانو الأكثر سكانًا بين الولايات النيجيرية الـ 36 بعد ولاية لاغوس، حيث يقيم فيها ما لا يزيد على 8 ملايين نسمة، منهم ثلاثة ملايين في مدينة كانو، والتي نظرا ًلتلقيها موازنة ضعيفة من الموازنة الاتحادية، هي الولاية التي رحب معظم سكانها بتطبيق الشريعة، علها تكون شبكة الخلاص لبؤسهم الاقتصادي والاجتماعي. بحسب الاعترافات التي أدلى بها المقبوض عليهم من أنصار "بوكو حرام" فإنّ محمد يوسف (39 عاما) قد اعتنق الفكر الشيعي لسنوات طويلة قبل أن يتحوّل إلى النهج الطالباني. وقالوا إن زعيمهم، الذي كان يلقب بـ "ملا عمر نيجيريا"، كان يحلم بإقامة إمارة ذات مظاهر طالبانية في شمالي نيجيريا يطبق فيها أفكاره التي تعتبر تعليم الفيزياء والعلوم من المحرمات وكذلك دراسة اللغات والعلوم الغربية وبخاصة اللغة الإنجليزية السائدة في نيجيريا، وأضافوا أنه لا يؤمن بتعليم أو عمل المرأة، وينادي بالتعدد المطلق للزوجات رغم أنه ليست لديه سوى زوجة واحدة وطفل واحد. واعترف أعضاء التنظيم بأن زعيمهم كان يكفر كل من يقبل العمل في أجهزة الدولة، لاسيما الأمنية، ولا يتسامح إزاء أصحاب الديانات الأخرى أو حتى مخالفيه في الفكر من المسلمين. كما أحل يوسف لأتباعه سرقة أموال وأسلحة ونهب ممتلكات الآخرين ممن لا يتبنون أفكار "بوكو حرام"، وكان يحث أصحابه على التمثيل بجثث قتلاهم. لقد بلغت حصيلة قتلى الهجمات التي وقعت في شمال نيجيريا - وتعزى المسؤولية عنها إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة - آلاف القتلى منذ العام 2009، و2000 قتيل منذ بداية عام 2014. وكانت مدينة أبوجا العاصمة النيجيرية تعرضت لتفجيرات بالسيارات المفخخة، وشهدت معارك بالرصاص بين المتمردين وقوات الأمن، مخلفة عشرات القتلى.وأعلنت بوكو حرام (الثقافة الغربية حرام) مسؤوليتها عن الهجمات في أبوجا، حين قالت: لقد قمنا بها ثأرا لإخواننا الذين استشهدوا على أيدي قوات الأمن في 2009. وتابعت: "سنواصل الحرب على الدولة النيجيرية حتى نقضي على النظام العلماني ونؤسس دولة الإسلام".بعد مقتل محمد يوسف زعيم حركة بوكو حرام في عام 2009، خلفه، أبوبكر محمد شيكاو على رأس الحركة، حيث تتضارب التقارير حول تاريخ ولادته بدقة، بين أعوام 1965 أو 1969 أو 1975 في قرية من المزارعين ومربي المواشي قرب الحدود مع النيجر في ولاية يوبي (شمال شرق). وقد درس الفقه لدى رجال الدين المحليين في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو المجاورة، وفي تلك الحقبة تعرف على الداعية محمد يوسف مؤسس بوكو حرام قبل أكثر من 10 سنوات.ورغم أن حركة بوكو حرام كانت حركة عُنْفِيَةً في عهد محمد يوسف لجهة تركيزها على تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا حيث الغالبية المسلمة، فإن الخبراء يعتقدون جازمين أنه مع وصول شيكاو على رأس الحركة ازدادت الهجمات المتكررة ضد المدنيين والمسيحيين والمسلمين ما جعل الجميع ينسون خطابات يوسف ضد النظام النيجيري الفاسد.وقبل مقتل يوسف كان شيكاو يتهمه بأنه "معتدل أكثر من اللازم" وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.ومع الاعتداء على مقر الأمم المتحدة في أبوجا في أغسطس 2011 الذي أوقع 23 قتيلا، انتقلت بوكو حرام إلى تنفيذ عمليات نوعية ما أشاع مخاوف من إلحاق الحركة بمجموعة جهادية على المستوى العالمي.ويعتقد البعض أن كوادر بوكو حرام تلقوا تدريبات في الجزائر والصومال، لكن العلاقات التي أقامتها الحركة في الخارج لم يتسن التأكد منها بعد. أما أبرز عمليات الحركة التي يعتقد أنها أرست أيضا علاقات مع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وحتى "حركة الشباب" الصومالية. ومنذ 2011 شنت حركة بوكو حرام هجمات نوعية على مدينة أبوجا، استهدفت الكنائس والمساجد ورموز السلطة وأيضا المدارس والجامعات ومساكن الطلاب حيث قتلوا تلاميذ أثناء نومهم، والولايات المتحدة تعد شيكاو "إرهابيا على المستوى العالمي" ورصدت مكافأة قيمتها سبعة ملايين دولار (5.3 مليون يورو) لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه. وهكذا، اعتقد بعض الطلاب الإسلاميين الأصوليين أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الحل لجميع المشكلات التي تعاني منها الولايات الشمالية، كما أنها تمثل الوسيلة الأنجع لتحسين الوضع الاقتصادي، ولاسيما أن نيجيريا تعتبر القوة الاقتصادية المسيطرة في منطقة ما بعد الصحراء، إذ إن سوقها يتجاوز 80 مليار دولار، وتمثل 40% من تجارة إفريقيا السوداء، وتمتلك موارد طبيعية ضخمة (زراعية، ونفطية، ومنجمية) تسيل لعاب القوى الدولية الغربية، ويزيد من اجتماع الرأسمالية المتطرفة مع القومية المتطرفة هذا الإغراء.. وتعاني نيجيريا من الاختلال المناطقي والإثني على صعيد توزيع منافع التنمية الاقتصادية، وهو ما شكل عائقاً مستمراً بالنسبة لبلد لم يحقق وحدته الوطنية إلا بواسطة حرب أهلية مدمرة.
1397
| 23 مايو 2014
عاد المجلس الوطني التأسيسي في تونس إلى مناقشة موضوع التطبيع على خلفية القضية التي أثيرت مؤخرا، بسبب دخول عدد من السياح الإسرائيليين لتونس. وكانت أصابع الاتهام في هذا الموضوع موجهة إلى الوزيرين، السيدة آمال كربول وزيرة السياحة، والسيد رضا صفر الوزير لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، بأنهما أفسحا في المجال لدخول السياح الإسرائيليين إلى تونس، الأمر الذي يتناقض مع الثوابت الوطنية والقومية للشعب التونسي المتعلقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. وتشغل السياحة في تونس نحو 400 ألف شخص "بشكل مباشر" وحوالي مليوني شخص "بشكل غير مباشر" بحسب وزارة السياحة التونسية. علماً أن الموسم السياحي لهذه السنة يبشر بالكثير، إذ دخل حوالي مليون ونصف المليون سائح خلال الأشهر القليلة الماضية من هذه السنة، الأمر الذي اعتبره المحللون بأنه مؤشر إيجابي للسياحة التونسية، التي تمثل الركن الأساسي للاقتصاد التونسي من حيث تدفق العائدات من العملة الصعبة، لا سيما وأن البلاد التونسية تعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر. وكان أعضاء كتلة "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وكتلة "حركة النهضة" وعدد من نواب "كتلة التحالف الديمقراطي"، والنائب عن "الحزب الجمهوري" إياد الدهماني، أي أكثر من ثمانين نائباً، قدموا مكتوبتين إلى المجلس التأسيسي في 24 أبريل الماضي، يتهمان فيهما الوزير المكلف بالأمن الوطني رضا صفر بالسماح كتابيا لدخول سياح إسرائيليين جزيرة جربة في الجنوب لزيارة «كنيس الغريبة"، ما يشكل محاولة "تطبيع مع الكيان الصهيوني"، ووزيرة السياحة آمال كربول باستقبالهم. ونظراً لحساسية الوضع السياسي التونسي، والتداعيات الخطيرة لإثارة موضوع التطبيع على الموسم السياحي التونسي، فقد أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه "تم سحب لائحتي اللوم"، أي سحب ثقة، من وزيرين تونسيين اتهما "بالتطبيع" مع إسرائيل، قبل دقائق قليلة من موعد التصويت عليهما، في الجلسة العامة التي انعقدت يوم الجمعة 9مايو الجاري. وتم تعويض اللائحتين ببيان موجه للحكومة أكد على "التزام تونس دولة وشعبا بمساندة الشعب الفلسطيني وتمسكها بعدم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ودعوة جميع الأطراف لاستكمال المرحلة الانتقالية وإجراء المحطات الانتخابية العام 2014". وأثارت عملية سحب اللائحتين ردود أفعال غاضبة في الصحافة التونسية، إذ تحدثت صحيفة "الصباح" عن "مهزلة في التأسيسي"، بينما اعتبرت "لوكوتيديان" أنها "زوبعة في فنجان"، مشيرة إلى أنّ "الجمعية العامة اقتصرت على استعراض لبعض (النواب) الذين يفتقرون إلى حضور إعلامي".أما صحيفة "لوتان" فأعربت بدورها عن الأسف "ليوم مناقشات بلا فائدة"، مضيفة أنّ "الوزيرين أفلتا" من حجب الثقة برغم الجدل الذي سبق جلسة الاستماع إليهما. وكانت وزيرة السياحة نفت أثناء الجلسة أن تكون استقبلت سياحا إسرائيليين، مبررة تصريحاتها المؤيدة لقدوم السياح من كل الجنسيات إلى تونس بضرورة إنعاش السياحة، القطاع الأساسي في الاقتصاد التونسي، والتي تراجعت بتأثير تداعيات الثورة التونسية قبل ثلاث سنوات. ومن جانبه نفى وزير الأمن الوطني التورط في أي تطبيع، موضحا أنه اتبع الإجراءات المعمول بها وهي السماح لكل السياح الذين يأتون إلى تونس في رحلات بحرية وينزلون لساعات فيها بـ"جواز عبور" دون قبول التعامل مع أي جواز إسرائيلي وأشار الوزير المكلف بالأمن إلى أن تونس تمنح منذ سنوات "رخص المرور" للصهاينة الذين يحجون سنويا إلى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة" الواقعة في جنوب شرق البلاد. كما أضاف أن الرخص تمنح لـ"عرب 48 الذين يشاركون في المؤتمرات.. الدولية (بتونس)"، أو للسياح الإسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات سفن سياحية عالمية ترسو بضع ساعات بموانئ سياحية تونسية. وذكّر الوزير أن مسؤولا في ميناء حلق الوادي منع في مارس الماضي 14 إسرائيلياً من النزول من سفينة سياحية رست بالميناء، ما أدى إلى استهداف تونس بـ"حملة إعلامية" تتهم البلاد بـ "التمييز إزاء الدين اليهودي". وأضاف أنه أصدر إثر هذه "الحادثة" مذكرة مكتوبة بتاريخ 11 أبريل 2014، طلب فيها من مصالح الحدود التونسية منح "رخص مرور" للإسرائيليين في الحالات المعمول بها، وللرد على "حملة دولية" تتهم تونس بـ"التمييز". وشدد صفر على عدم إمكانية "الطعن في أشخاصنا بالتطبيع، والتجني (علينا) بهذه الطريقة خطير جدا"، مشيرا إلى أنه "من الخطير القول إن الأمر يتعلق بالتطبيع فهذا أمر خطير.. القضية إدارية وإجرائية فحسب". وقال النائب فيصل الجدلاوي، الذي كان من بين 80 نائبا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بسحب الثقة من الوزيرين، "لم نقم بثورة حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني". مازال الموقف من القضية الفلسطينية يشكل في الذهن الجماعي التونسي حداً فاصلاً بين العداء والتطبيع مع الكيان الصهيوني، على الرغم من أننا لم نعد نشهد في تونس مظاهرات شعبية كما في السابق بمجرد حدوث صدام مسلح بين العرب والفلسطينيين من جهة، والصهاينة من جهة أخرى. ويرفض غالبية التونسيين في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني، أي سلوك من شأنه إقامة علاقات "طبيعية" مع إسرائيل طالما لم يحصل الفلسطينيون على دولتهم المستقلة. فتونس استقبلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وآلاف المقاتلين الفلسطينيين، عقب الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982. وكانت تونس مقرا بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وكان سلاح الجو الإسرائيلي أغار في أكتوبر 1985 على حمام الشط جنوب العاصمة حيث كان مقر منظمة التحرير الفلسطينية. وقتل في الاعتداء 68 تونسيا وفلسطينيا. كما اغتالت إسرائيل في 1988 بتونس خليل الوزير (أبو جهاد) المسؤول الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية. ورغم أن تونس تبادلت مع إسرائيل مكتبيْن لرعاية المصالح في عام 1996، فإن الحكومة التونسية قررت في أكتوبر 2000 إغلاق المكتبين، تنفيذا لقرارات القمة العربية، إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية. إذا كانت مثل هزيمة حزيران / يونيو 1967، وتوقيع اتفاقيات كمب ديفيد عام 1978، ومعاهدة السلام المصرية مع الكيان الصهيوني عام 1979، قد شكلت اتجاها تاريخيا بالغ التعقيد نحو التسوية للصراع العربي – الصهيوني، فإن اتفاقيات أوسلو عام 1993، ومعاهدة وادي عربة الأردنية – الصهيونية عام 1994، قد دفعت الدول العربية إلى الترويج لمقولة مفادها أن التطبيع والسلام مع الكيان الصهيوني أصبحا وشيكين للغاية وتاليا يتعين على الدول العربية، ولا سيما منها المغاربية، الإسراع في الرهان على "الكعكة الصهيونية" قبل فوات الأوان. ومنذ أن تم توقيع اتفاقات أوسلو-واشنطن القاهرة بين القيادة الصهيونية وقيادة الفلسطينية في 13 سبتمبر 1993، وتقديم المحيطين بالزعيم الراحل ياسر عرفات والنظام التونسي ذلك الاتفاق وكأنه النصر الحاسم ومفتاح الدولة الفلسطينية الذي كان مفقوداً وتم العثور عليه، تباينت المواقف من التطبيع مع العدو الصهيوني في صفوف المعارضة التونسية بين مؤيدين لخط التسوية، الذين يرون في الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود هو طريق الاستقلال ذاته الذي ارتضته السلطة الفلسطينية، وبين معارضين لكل ذلك جملة وتفصيلا معتبرين أن الانخراط في الكفاح من أجل تحرير فلسطين ومعاداة الكيان الصهيوني، كان ومازال يعتبر واجباً قومياً ودينياً، ويشكل أحد المقومات والثوابت الوطنية للشعب التونسي. ونظراً للالتباسات الحاصلة حول موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، فقد جزم رئيس حزب النهضة التونسي الشيخ راشد الغنوشي أن تونس لن تعترف أبداً بإسرائيل. وقال الغنوشي، في حوار مع المشاركين في "مؤتمر الثورات والانتقال إلى الديمقراطية" الذي نظمه مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي في الإسكندرية في مدينة الحمامات التونسية في بداية سنة 2012، إن حكومة تونس تريد الفصل بين علاقات تونس بالغرب والموقف من إسرائيل. ورداً على سؤال للصحفي محمد نور الدين اللبناني، والقريب من حزب الله، عن موقفه من الاعتراف بإسرائيل، قال الغنوشي إنه لا يوجد خلاف بين الحركات الإسلامية على أن فلسطين هي القضية المركزية. وأضاف "لن نعترف أبداً لا بالاحتلال ولا بالكيان. ولا داعي للغرابة، ففلسطين موضع إجماع كل الإسلاميين والقوميين".
1084
| 16 مايو 2014
بعد أربعة أشهر من إقرار الدستور الديمقراطي التوافقي مع بداية هذه السنة؛ ها هو المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أقر في جلسته المنعقدة يوم الخميس غرة مايو الجاري القانون الانتخابي الجديد في جلسة صاخبة شهدت صدامات بين النواب واتهامات بعضهم بالخيانة والمطالبة بمساءلة بعضهم الآخر، وقد تبنى المجلس القانون الجديد بعدما صوّت 132 نائبا لصالحه، فيما صوت 11 نائبا ضده وتحفظ 9 نواب آخرين عليه، وهو ما سيتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الحالي، وسيقود لاحقا لإنهاء الفترة الانتقالية المستمرة منذ ثلاث سنوات في البلاد.كان مشروع الفصل 167 من القانون الانتخابي أثار جدلاً ساخناً خلال عملية التصويت على مشروع القانون الانتخابي بسبب رفض نواب المجلس هذا الفصل الذي يحظر ترشح قيادات حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للانتخابات، إذ نص على منع أي شخص تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي إضافة إلى أي عضو في حكومات بن علي من الترشح للانتخابات التي من المقرر تنظيمها قبل نهاية 2014 وفق الدستور التونسي الجديد.واستثني من المنع كل مسؤول حكومي لم يكن عضوا في التجمع الحاكم في عهد بن علي.وتم إسقاط الفصل 167 المتعلق بالعزل السياسي، والذي تمّت العودة إليه في صيغة معدلة غير توافقية بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس بعد أن حصل على موافقة 100 صوت فقط واحتفاظ 46 نائبا بأصواتهم ورفض 27 آخرين. ولم يكتمل النصاب القانوني لتصويت نواب المجلس التأسيسي لصالح الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي، الخاص بمنع التجمعيين من الترشح للانتخابات القادمة، ما أدى إلى سقوط الفصل بحصوله على 108 أصوات واحتفاظ 43 نائبا بأصواتهم ورفض 23 آخرين، بعد أن افتقر إلى صوت واحد حتى يتم تمريره 2014.وفيما يلي نص الفصل 167: "لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، كما لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أغسطس2011.وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور".ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها الخميس فصل حول اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية.. في المقابل فشل مقترح بشأن فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم.وقد التقت أكبر حركتين سياستين في الحكم والمعارضة، والأمر يتعلق بحزبي "النهضة" و"نداء تونس" حول رفض تمرير قانون العزل السياسي وتركه للمواطنين في الانتخابات، وهو اتفاق يمثل محطة مهمة أخرى باتجاه إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية للانتقال إلى المرحلة الدائمة. في عملية التصويت على الفصل المتعلق بالعزل السياسي في القانون الانتخابي، انقسمت كتلة حركة النهضة، إذ صوت 39 نائبا مع القانون، و5 ضده، بينما تحفظ 26.وكشفت نتائج التصويت لكتلة النهضة أن الشيخ راشد الغنوشي لم يعد مسيطراً على واقع الحركة، رغم تأكيده على موقف حركة النهضة الرافض للعزل والإقصاء، لكن نصف نواب الكتلة (39نائباً) صوتوا عكس ما أمر به الغنوشي، بينما لم يثبت الولاء الحقيقي لخيارات القيادة سوى 5 نواب فحسب، واختار 26 نائباً التحفظ حتى لا يغضبوا القيادة التاريخية للحركة، ولا يؤججوا غضب القواعد المتشددة لقانون العزل السياسي. وكانت أحزاب المؤتمر والتكتل، والتحالف الديمقراطي، والكتلة الديمقراطية، قد صوتت لمصلحة قانون العزل السياسي.وصرّح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أثناء حضوره للمجلس التأسيسي لمناقشة تصويت النهضة على الفصل 167: «نحن لا نريد الزج بالمسار الانتقالي في الخطر خاصة وهو في مراحله الأخيرة، وموقف قيادة النهضة يتبنى عدم التصويت على الفصل وجئنا لإقناع النواب بهذا الموقف»، أما عن موقف قواعد حركة النهضة فقال الغنوشي: «قواعدنا جزء من الشعب ونحن نركن إلى مصلحة الوحدة الوطنية»، وشدد على أنه تم بذل جهد كبير لإعادة قطار تونس على السكة ولذلك يجب إنهاء المرحلة الانتقالية بسلام. أما عن إمكانية إبرام صفقة لإسقاط هذا الفصل فقال إن النهضة لا تأتمر بأوامر أي طرف، وتحصين الثورة لا يكون إلا للشعب.وقد لاقى مشروع قانون تحصين الثورة معارضة شديدة من أغلب الكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي لأسباب عديدة. فهناك من يرى أن العدالة الانتقالية وحدها هي المخوّلة للنظر في الأمر وتحديد المسؤوليات حول من ارتكب تجاوزات خلال مرحلة الديكتاتورية السابقة، وهناك طرف آخر يعتقد أن القضاء هو الإطار الأسلم لتدارس هذا الملف المثير للجدل، لكن هناك رأي صائب يمثله الأستاذ الحقوقي قيس سعيد الذي بيّن أنّ الشعب وحده هو المُخوّل للمعاقبة والحكم على من عمل في النظام السابق عن طريق الانتخابات واقترح أن يكون الانتخاب على الأفراد لا على القائمات حتّى لا يحدث ما حدث في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.وكان أبرز المعارضين لهذا القانون هو السيد الباجي قائد السبسي، مؤسس ورئيس حركة نداء تونس، الذي قال في وقت سابق إن قانون تحصين الثورة وضع على مقاسه، فوصفه بالقانون غير الطبيعي، معتبراً أن تحصين الثورة هو مهمة من قام بها وأن من قام بالثورة هم شباب المناطق المحرومة غير المؤطر، وليست له زعامات سياسية احتج من أجل التشغيل والفقر والحرية وليس من أجل نواقض الوضوء. وقال إن استحقاقات الثورة هي صياغة دستور جديد في مدة لا تتجاوز سنة وهي تنظيم انتخابات نهائية تسمح بالاستقرار في البلاد.وعبر السيد خميس كسيلة النائب عن حزب نداء تونس، الرابح الأول من إسقاط قانون العزل السياسي، عن اعتزازه بالمشاركة رفقة بقية نواب نداء تونس في إسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي، معتبراً في إسقاط الفصل المتعلق بالعزل السياسي إسقاطاً للعقل الانعزالي الداعي للفتنة وتقسيم التونسيين إلى فرقتين متاخمتين، مضيفاً أن عدم تمرير العزل في الفصل المذكور يمثل تخفيفاً على القانون الانتخابي. وأكد كسيلة أن حزب نداء تونس يدعم تفعيل العدالة الانتقالية والقضاء المستقل الذي يتولى الحسم في تركة الماضي ومحاسبة من تورطوا في منظومة الفساد ولطخت أيديهم بدماء التونسيين. أما الخاسرون من إسقاط الفصل 167، فهم كثر، لعل أبرزهم حزب المؤتمر وحزب التكتل، وحزب وفاء، وهم الأحزاب المتحالفة مع حزب النهضة الإسلامي. لكن يبقى اليسار متمثلا بالجبهة الشعبية هو الخاسر الأكبر، إذ قدم نواب الجبهة الشعبية تصورهم الخاص في شكل مقترح تعديلي في الفصل 167 وقعه كل من منجي الرحوي وحطاب بركاتي وفتحي اللطيف وأحمد السافي ومراد العمدوني، وينص المقترح على أن «يخضع العزل السياسي لقانون العدالة الانتقالية»، لكن تم سحب التعديل بعد مفاوضات في لجنة التوافقات التي ارتأت سحبه. يرى المحللون المتابعون للمشهد السياسي التونسي المتحرك أن الجبهة الشعبية صُدِمَتْ من إسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي الحالي، وبنيت هذه المقاربة على التصويت الجماعي لنواب الجبهة على التمرير حيث صوت مع الفصل كل من فتحي عبداللطيف ومنجي الرحوي وحطاب بركاتي وأحمد السافي.. وذهبت بعض الأطراف إلى التأكيد على أن هذا التصويت سيتسبب في شرخ في جبهة الإنقاذ الإطار السياسي الذي يجمع الجبهة الشعبية بحزب نداء تونس، واعتبار أن إسقاط الفصل قضى على آمال اليساريين في جبهة الإنقاذ في تمرير اسم مرشح للانتخابات الرئاسية إذا ما تم تطبيق العزل على الباجي قائد السبسي.استندت بعض الأطراف التي استشرفت أزمة سياسية في جبهة الإنقاذ بين حزب نداء تونس والجبهة الشعبية على تصويت نواب الجبهة وعلى التصريحات القوية لنواب الجبهة ولاسيَّما النائب منجي الرحوي الذي أكد أن عدم تصويت حركة النهضة على الفصل 167 الخاص بالعزل السياسي يؤكد وجود صفقة بين التجمعيين وحركة النهضة تشبه الصفقات التي عقدت خلال سنوات 87 و88 و89 وأنه على الشعب التصدي لعودة الفساد والاستبداد حسب تصريحه. واعتبر أن المصادقة على القانون الانتخابي «وضاعة وخيانة من التأسيسي». وأعرب الرحوي عن عدم استعداد الجبهة الشعبية للتعامل مع القانون الانتخابي المصدق عليه، مبينا أنه "لا يؤمن الآليات الكفيلة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
1814
| 09 مايو 2014
إذا كانت التجارة البينية بين تونس وبقية بلدان المغرب العربي لم تتجاوز نسبة 6.3 % خلال الخمس سنوات الأخيرة، فإن اتفاقية الشراكة التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي كأول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، التي تنص على تحرير التجارة في المواد غير الزراعية، في غضون 12 سنة، وتستبعد حرية دخول المنتجات الزراعية التونسية إلى السوق الأوروبية، وتتضمن محاصرة الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وتشجيع الهجرة المعاكسة، هذه الاتفاقية تبدو تعاقداً بين طرفين غير متكافئين على جميع الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية والسياسية، سيحول تونس إلى مجرد مصب أي سوق للسلع الاستهلاكية الوافدة من بلدان أوروبا. كما أن هذه الاتفاقية ستكون لها انعكاسات سلبية على الصناعات التونسية المحلية، حيث يقر المحللون الاقتصاديون المهتمون بالشأن التونسي إلى أن أكثر من ثلث المصانع التونسية ستقفل بمجرد رفع الحواجز الجمركية على المنتجات الصناعية الأوروبية، فضلاً عن أكثر من 120 ألف عامل سيحالون على البطالة. ومن تداعيات الشراكة أيضاً التسريع في وتيرة الخصخصة، والقيام بمراجعات جوهرية في مجلة قوانين الشغل التي وضعت في عقد الستينيات لتنظيم علاقة العمل في ظل سياسة الاقتصاد الموجه، ولم تعد اليوم متناسبة مع اقتصاد السوق. وهذا الوضع الجديد ستكون له إسقاطات مدمرة على أوضاع الطبقة العاملة والفئات الفقيرة من الطبقة الوسطى والحركة النقابية. إن اقتصادات الدول المغاربية تتسم بتخلف أكثر أهمية من السوق، فلا تجد احتكارات رأسمالية قوية خاصة كما هو الحال في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، التي تشكلت عبر آليات المنافسة خلال مرحلة تاريخية طويلة. والحال هذه، فإن القطاع العام مازال مسيطراً على عدة احتكارات، فضلاً عن أن الدولة المغاربية تمتلك سلطات واسعة استثنائية على جميع الصعد الإدارية والضريبية التي تمكنها من عقد صفقات مع شركات القطاع الخاص، أو مع رجال الأعمال المشهورين الذين تغذيهم الحكومة كما هو الحال في تونس مع العائلات السبع. إن البرجوازية الطفيلية ذات الصلات الوثيقة بالدولة في منطقة المغرب العربي والقطاع العام، لا مصلحة لها بشيء يتعدى التحرر المحدود من القيود، فهذه البرجوازية عاجزة عن أن تكسب في نظام السوق الحرة، كما أن التحرر الاقتصادي الشامل سيعرضها للأخطار. فالأنظمة المغاربية. خاصة في تونس والمغرب، التي أجبرت على تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي المملي عليها بشكل صريح من صندوق النقد الدولي أو غيره من الوكالات الأجنبية، لا تطبق عملية التحرر الاقتصادي كما كان يجب أن يحدث وفق النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، بل إنها تفتح أبواب الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام لبيعها إلى رجال النخبة في هذه الأنظمة أو إلى المقربين جداً منها. فهناك عملية تحايل واضحة المعالم تقع في أقطار المغرب العربي كلها، لجهة بيع مؤسسات القطاع العام إلى أقرب المقربين من السلطة، في تناقض كلي وصريح مع التحرك نحو الليبرالية الاقتصادية وقوانين السوق التنافسية. فوتيرة الإصلاح المتعلقة ببيع القطاع العام، هي ببساطة محاولة من قبل الدولة المغاربية لتأجيل الإصلاح المنشود، ومحاولة أخرى لفرض تقسيم جديد للمهمات الاقتصادية يرمي إلى خدمة مصالح النخب السياسية الحاكمة المتواطئة مع رجال الأعمال الجدد، أي المافيات الاقتصادية من جهة أخرى. وطالما ظل هذا التواطؤ قائماً بين النظم السياسية المغاربية والطبقة البرجوازية الكمبرادورية، فمن الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تتطور المساءلة الحكومية التي من دونها لا يكون للديمقراطية أي معنى. فالليبرالية الاقتصادية المطبقة على أوسع نطاق في المغرب العربي بدافع الاعتبارات الاقتصادية الدولية ـ لم تكن مترافقة معها عملية تحقيق الليبرالية السياسية كشرط لازم لها. فالتحرك نحو الديمقراطية المراقبة، والتعددية المحدودة التي أقرتها أنظمة المغرب العربي إنما هي للدفاع عن النفس والمحافظة على بقاء هذه الأنظمة، وليس للتحرك الفعلي نحو الديمقراطية. فالأنظمة المغاربية مازالت تنتهج إستراتيجية ميكيافيلية، لجهة اتخاذها إجراءات لتحرك سطحي نحو الديمقراطية أو التعددية دون أن تتخلى عن الاحتكار الفعلي للسلطة السياسية. وهي بذلك تحتاط بذلك من ظهور أكثرية معارضة في البرلمان وترسم خطوطاً حمراء للمعارضة بعدم تجاوزها، وتتهيب بل تخاف من وجود مجتمع مدني فعال وقوي أكثر مما ينبغي. لهذا فإن التحرر الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، لن يحققا بالضرورة تحركاً نحو الليبرالية السياسية وبالتالي نحو الديمقراطية. ففي بلدان المغرب العربي يتم التعامل مع الصراعات الاجتماعية والسياسية الداخلية بواسطة القمع، وهذا يتناقض كلياً مع ما هو سائد في الضفة الشمالية للمتوسط، حيث توجد أنظمة سياسية ديمقراطية تطورت عبر إبرام عقود سياسية واجتماعية بين مختلف الأطراف الاجتماعية والسياسية عبر سيرورة تاريخية طويلة من النضالات والصراعات السياسية. ما نلحظه في المجتمعات المغاربية هو سيطرة الدولة على مختلف تكوينات المجتمع المدني الحديث، لأنه في ظل وجود سلطة مركزية قوية، وغياب كامل لفصل السلطات، لا يمكن أن تزدهر فضاءات الحريات السياسية، واحترام حقوق الإنسان، والمواطن. وفضلاً عن كل ذلك فإننا نلحظ أنه في اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكل من تونس والمغرب لا تحتل«المبادئ الديمقراطية» واحترام الحقوق الإنسانية للإنسان الحر إلا مكانا هامشيا. من هنا فإن الشراكة المتوسطية التي تركز بشكل أساسي على التحرر الاقتصادي، سوف تقود إلى تعميق هوة التطور اللامتكافئ بين البلدان المغاربية وبلدان أوروبا، وإلى تعميق اللامساواة الاجتماعية والإفقار المطلق في الجنوب، لأن اقتصاد السوق الذي يهدف إلى تحقيق تقارب بين أنظمة متباينة في تطورها التاريخي، لا يضمن وحدة أسس تطبيقاته الفعلية في ظل غياب الديمقراطية السياسية الفعلية في دول المغرب العربي، كما أنه لن يجعل من النمو مكسباً مشتركاً للدول الأوروبية الغنية والدول المغاربية الفقيرة.
469
| 05 مايو 2014
تشهد العلاقات بين الإسلاميين ممثلين في حركة النهضة والدساترة ممثلين في حركة نداء تونس تقاربا واضحا في الأشهر الأخيرة خاصة حول موضوع العزل السياسي، فهل يدفع اليسار ثمن تحالفاته السابقة؟ وتعتبر مسيرة اليسار التونسي ممثلا في الجبهة الشعبية مثيرة للاهتمام حيث إنه مر بجملة من التحالفات غير المنطقية من حيث الأطراف المتحالف معها مثل الإسلاميين والدساترة كل في مرحلة ما لكنه يعود في نهاية كل تحالف إلى نقطة الصفر، ويواصل حلفاؤه طريقهم أحيانا في اتجاه معاداته. لقد تشكلت الجبهة الشعبية على أساس أن تكون قوة سياسية في مواجهة الاستقطاب الثنائي بين حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس الذي أسسه رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي القائد السبسي. وكانت هذه الجبهة متكونة من أحزاب يسارية وقومية عديدة بطبيعة الحال، على أمل أن تصبح قوة ثالثة في البلاد بعيدة عن قوى اليمين وبعيدة عن الحركات الإسلامية،لأن هدفها يتمثل في أن تكوّن قوة تأثير في الحياة السياسية، وقوة تعديل في المستقبل لمصلحة القوى الديمقراطية،إذ إن القوى اليسارية والقومية المشتتة لا تستطيع التأثير بقدر القوى المجتمعة. وتمكنت الجبهة الشعبية من تحقيق هذا التوازن السياسي فعلا قبل اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، اللذين كانا من العيار الثقيل، ويحسنان الخطاب السياسي الذي يجد صداه لدى عموم التونسيين، ومعهما تطور أداء الجبهة وارتفعت نسب المهتمين بها وقد فرض وجودهما تعديل المواقف داخل الجبهة وأصبحت قراراتها تؤخذ بطريقة ديمقراطية. لكن بعد اغتيالهما انعدم التوازن وانعدمت معها الديمقراطية داخل الجبهة الشعبية. وشكل اغتيال الشهيد شكري الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، نقطة تحول حقيقية في مسار الجبهة الشعبية إذ خرج حوالي مليون وأربعمائة ألف تونسي في جنازته في 8فبراير2013. وكان بإمكان الجبهة الشعبية أن تستثمر ذلك الزخم الشعبي الكبير لكي توظفه نحو بروز قوة سياسية ثالثة حقيقية تقف نداً أمام الحزبين الكبيرين النهضة والنداء، لكن ما راعنا أن وقع الاستيلاء على الجبهة من طرف الناطق الرسمي للجبهة السيد حمة الهمامي، والأمين العام لحزب العمال في الوقت عينه. فبدأت سياسة الإقصاءات للأطراف السياسية المخالفة لتوجهات الناطق الرسمي، فمن أصل 12 حزبا مكوناَ للجبهة، انحصر القرار الآن بين خمسة فقط يقودها حزب العمال. وهو ما أضعف الجبهة كثيراً، لاسيَّما في عدد من الجهات الداخلية للبلاد. إذ انتهج السيد حمه الهمامي سياسة تحالف الجبهة الشعبية مع حزب »نداء تونس« باسم ضرورات وأولويات المرحلة المتمثلة في اعتبار الإسلام السياسي الحاكم قوة »فاشية»، ولذا وجب القيام بتحالف واسع لإسقاط الحكم وتأجيل تحقيق أهداف الثورة إلى ما بعد الإطاحة بحكم الاستبداد الديني. إنها المبررات عينها التي قدمها حزب العمال الشيوعي الذي يتزعمه السيد حمه الهمامي، أثناء تحالفه مع الإخوان المسلمين في ائتلاف 18 أكتوبر عام 2005 ضد «الحكم الاستبدادي لبن علي» وهو هدف ينأى بالجبهة بعيداً عن مطلب «إسقاط النظام» الذي طالما ردده المتظاهرون قبل وبعد الإطاحة ببن علي (الشعب يريد إسقاط النظام) أو (الشعب يريد الثورة من جديد). فهذا الاتجاه الجديد يزج بالجبهة الشعبية في مساومات مع قوى ليبرالية ذات مصالح متناقضة مع قواعد الجبهة الشعبية، وذات تجربة في السلطة، وهو ما يفقد الجبهة الشعبية ارتباطها بالفقراء والعمال والكادحين الذين يطمحون لتغيير حياتهم نحو الأفضل، ويفقدها شرعية التعبير عن مطالبهم في (الشغل والحرية والكرامة الوطنية). كما يفقد هذا التوجه السياسي للجبهة الشعبية استقلالية قرارها بحكم ذوبانها داخل (جبهة الإنقاذ)، ويبعدها عن «تحقيق أهداف الثورة» وعن جماهيرها التي خرجت لتشييع الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ثم إن هذه السياسة التي تتبعها الجبهة الشعبية تجعلها مطية لعودة قادة الحزب الحاكم السابق (التجمع الدستوري المنحل بقرار قضائي) إلى الحكم من الباب الكبير، وعلى أكتاف اليساريين والقوميين وشباب وسكان سيدي بوزيد والحوض المنجمي والقصرين وسليانة، الذين اكتووا بنار القمع والتهميش والفقر، الذي كان الحلفاء الجدد للجبهة الشعبية سبباً مباشرا فيه (من التخطيط إلى التنفيذ). ولم تطور الجبهة الشعبية والأحزاب المكونة لها، أشكال النضال والتنظيم والمساندة والإعلام، لتغيير ميزان القوى لصالح الفقراء والكادحين والمنتجين والعاطلين عن العمل والإجراء، ولم تنشر الجبهة تحليلاً سياسياً دقيقا ًللقوى السياسية والاجتماعية لتوضح نظرتها لطبيعة التحالفات، وما هي القوى التي يمكن التحاف معها (لتحقيق أهداف الثورة) أو للتقدم خطوة نحو تحقيق هذه الأهداف. ففي أوج الضجيج الإعلامي حول تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني بين رموز النظام السابق (1956 – 2011) ومعظم تيارات اليسار والقوميين، عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي في 25يوليو 2013، التقى في باريس يوم 14 آب2013 الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي والباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس الذي لم يُخْبِرْ حلفاءه الجدد بهذا اللقاء، ما أثار تساؤلات في صفوف الجبهة الشعبية وفي صفوف بعض أحزاب المعارضة وشرائح عديدة من المجتمع، وكل من آمن بضرورة التغيير الجذري لمصلحة الشعب. إن تلك الأحداث هي التي تدفع اليوم إلى التساؤل عن دور القوى اليسارية في الحياة السياسية الوطنية المتميزة بسيطرة حزب النهضة الإسلامي الممثل لليمين الديني، وحزب نداء تونس الممثل لليمين الليبرالي بشقيه الاقتصادي والسياسي، الذي بات يشكل استعادة لبقايا النظام السابق، حيث يتبين يوما بعد يوم استعداد هذين الحزبين للتحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة لإدارة الحكم وفق صيغة جديدة.وكان حزب العمال انتهز فرصة اغتيال الشهيد محمد البراهمي أحد قادة الجبهة الشعبية للعودة إلى (التقاطعات مع القوى المعارضة للحزب الحاكم) والتحالف مع نداء تونس (رغم معارضة عائلة الشهيد محمد البراهمي). وهكذا عاد حزب العمال إلى إحياء صيغة ما سمي (تحالف 18 أكتوبر) التي دامت من 2005 إلى 2007 وضمت الإخوان المسلمين (النهضة) واليمين الليبرالي وبعض القوميين2005.إنه تحالف 18 أكتوبر بين اليسار والإسلاميين من أجل إسقاط بن علي. وقبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 كان هناك شبه تحالف بين حزب العمال وحركة النهضة. وبعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد في 6 فبراير2013، كان هناك شبه تحالف بين الجبهة الشعبية وحزب نداء تونس من أجل إسقاط النهضة. وبعد 25يوليو 2013، تحقق التحالف بين الجبهة الشعبية وحزب نداء تونس فيما بات »يعرف بجبهة الإنقاذ «، والتحق بهم في جبهة الإنقاذ زعيم حزب المبادرة الوطنية الدستورية السيد كمال مرجان (آخر وزير خارجية تونس في عهد بن علي). وجاء هذا الالتحاق في إطار استعداد الحزب للتحالف مع الأحزاب التي يتقارب معها في التوجهات والبرامج السياسية والاقتصادية، ولكن توجد دوافع أخرى تفسر التحاق المبادرة الوطنية الدستورية بجبهة الإنقاذ، إذ ذهب البعض من المحللين السياسيين إلى حد التأكيد على أنه تقارب بين الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس) وكمال مرجان (رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية). وتعكس هذه التحالفات غير الطبيعية بين الأحزاب الليبرالية واليسارية والقومية، من أجل إسقاط حكم النهضة، تراجعاً مهماً في المسار الثوري، يجسمه توظيف الجبهة الشعبية في خدمة أجندات الهيمنة الخارجية على البلاد، وتشريع العلاقات غير المتكافئة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
1492
| 02 مايو 2014
تعيش تونس هذه الأيام في حالة من القلق من جراء المصير المجهول للدبلوماسيين التونسيين اللذين تما اختطافهما في ليبيا مؤخراً، وهما: العروسي القنطاسي، ومحمد بالشيخ. وكانت مجموعة ليبية تطلق على نفسها " كتيبة الشباب التوحيدي " وراء اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، وهي كتيبة خطيرة حسب رأي المحللين الملمين بالشأن الليبي، تضم عديد الجنسيات ولها فروع في كل من ليبيا وتونس ومصر ولبنان، وعديد البلدان العربية،وهي متفرعة من تنظيم " أنصار الشريعة" المتشدد المرتبط بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ". فقامت بخطف السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان، في 15 أبريل الجاري في العاصمة الليبية طرابلس.وأعلنت الخارجية التونسية بعد ذلك بيومين اختطاف أحد دبلوماسييها العاملين في السفارة التونسية في العاصمة الليبية. الاعتقاد السائد في تونس،أن كتيبة "درعة" هي من تقف وراء عملية الاختطاف للدبلوماسيين التونسيين، لاسيَّما أنها كانت سبباً في غلق المعبر الحدودي لراس جدير بين تونس وليبيا،وهي تنفذ عملية الاختطاف بهدف الحصول على مبالغ مالية ضخمة، وعمليات ابتزاز، إذ غنمت من عمليات اختطاف سابقة حوالي 2 مليون دينار ليبي.وحول طلبات الكتيبة التي شاركت في عملية الاختطاف، فإنها تطالب السلطات التونسية، بإطلاق سراح السجينين الليبيين المتورطين في عملية الروحية الإرهابية بتونس،وهما: حافظ الضبع المكنى بأبو أيوب، وعماد اللواش المكنى الملق بأبو جعفر الليبي،إلى جانب المطالبة ببعض الليبيين من الإرهابيين الذين نشطوا بجبل الشعانبي، وأسهموا في بعض العمليات الإرهابية، وهو حاليا قيد السجون التونسية.ولا تستبعد السلطات التونسية أن يكون وراء عملية اختطاف الدبلوماسيين التونسيين الإرهابي التونسي رقم واحد أبوعياض زعيم تنظيم " أنصار الشريعة" التونسي المصنف منذ شهر أغسطس 2013، تنظيما إرهابياً. لا شك أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية صعبة، بعد أن ورثت مؤسسات دولة ضعيفة وفي ظل غياب الأحزاب السياسية،ومنظمات المجتمع المدني، وفشل المجلس الوطني الانتقالي، والحكومة الليبية الحالية في كبح جماح الميليشيات المنتشرة في كامل التراب الليبي، والتي تمارس عمليات النهب المنظمة لثروة الشعب الليبي من نفط وغيره، واختطاف الدبلوماسيين العرب، وهذا ما جعل الشعب الليبي يعيش مع تركة قاسية جداً. وتُعدّ الميليشيات الخارجة عن القانون التحدي الأكبر في ليبيا ما بعد القذافي، لاسيَّما بعد أن عجز المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الليبية عن إعادة دمج المقاتلين المسلّحين في صفوف الجيش الليبي، إذ كانت نتائج هذا التوجه محدودة للغاية،وواجه صعوبات كثيرة. ففي ظل فشل الحكومة في احتواء الميليشيات، تتجه ليبيا نحو الحرب الأهلية، لاسيَّما أن زعماء الميليشيات رفضوا تسليم أسلحتهم من منطلق أنهم لا يثقون في القادة الجدد، وفيما يمكنهم تحقيقه من مكتسبات في حال تجردوا من أسلحتهم. وتريد الميليشيات المسلحة أن تمارس شريعة الغاب في ليبيا،لاسيَّما إزاء 8 آلاف معتقل من أنصار العقيد القذافي،معلن عنهم يتوزعون في 60 مركز اعتقال في أنحاء البلاد. وترفض هذه الميليشيات تطبيق القانون على هؤلاء المعتقلين، بل لأنها لا تؤمن بأي شكل من أشكال العدالة الانتقالية، التي يجب أن تضطلع بها الحكومة الليبية.فهذه الميليشيات التي تريد المحافظة على فوضى السلاح، تريد تطبيق استراتيجيتها في الهجمات الانتقامية والثأرية، بدلاً من سياسة تضميد الجراح الناجمة عن الصراع تمهيدا للمصالحة الوطنية، باعتبارها أولى المهام المترتبة على المجلس الوطني الانتقالي، والحكومة الليبية. ويتخوف المجتمع التونسي، ومعه المجتمعات المغاربية، وكذلك المجتمع الدولي من الوضع الأمني الداخلي في ليبيا الذي تهيمن فيه الميليشيات القبلية والإسلامية، بل يذهب خوفه الأكبر إلى الأسلحة والمتفجرات المنتشرة على الأراضي الليبية والتي يتم تهريبها إلى تونس،والجزائر،عبر دول الجوار من تشاد إلى مالي والنيجر ونيجيريا وغيرها.والمشكلة الحالية التي باتت تقلق الشعب التونسي، تكمن في إمكانية وصول الأسلحة المهرّبة من ليبيا إلى مجموعات إرهابية مثل تنظيم "أنصار الشريعة" الذي يقوده أبو عياض التونسي،المرتبط عضويا بتنظيم "القاعدة والمغرب الإسلامي" و"بوكو حرام"النيجيرية، وغيرها من التنظيمات الإجرامية. وكان من تبعات كشف وزارة الداخلية التونسية هوية من قام باغتيال الشهيد محمد البراهمي وقبله الشهيد شكري بلعيد أن تم اعتبار "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا، ما يتيح اعتقال عناصره وسجنهم.لكن "أنصار الشريعة" بدا عند تاريخ حظره وكأنه قد استبق أي إجراءات ضده يمكن أن تتخذها حكومة على العرض الفاشلة في محاربة الإرهاب،وانتقل إلى العمل السري. وعلى رغم أن هذا العمل كان يتم عبر خلايا تنشط داخل تونس نفسها، إلا أن جزءاً منه كان لا بد أن يتم خارج تونس وتحديداً في ليبيا، حيث يقيم زعيمه أبوعياض في حماية تنظيم "أنصار الشريعة "الليبي. فقد أتاحت الفوضى التي عمّت هذا البلد بعد سقوط القذافي لأي جماعة أن تنشط كما تريد من دون أن يكون هناك من يردعها. وكان الإسلاميون المتشددون بالطبع من بين الذين استفادوا من سقوط القذافي، فأنشأوا معسكرات تدريب في عدد من المناطق لإنشاء جيل جديد من الإرهابيين المحترفين. وكان فرع القاعدة المغاربي هو المستفيد الأول من هؤلاء "الجهاديين" الذين يتخرجون من المعسكرات الليبية ويلتحقون بصفوفه، للقيام بعمليات إرهابية في داخل تونس، والجزائر ومالي، وغيرها من البلدان العربية والإفريقية. في عهد الميليشيات المسلحة تحولت ليبيا إلى بؤرة للإرهاب تهدد شمال إفريقيا كله، من تونس إلى المغرب مرورا بالجزائر وموريتانيا، ويتحمل الغرب المسؤولية التاريخية عن واقع ليبيا الحالي. إن ليبيا في ظل الحكومة العاجزة، التي لا تحكم حتى في العاصمة طرابلس، أصبحت برميل البارود الذي يهدد بالانفجار في أي وقت، لأن الميليشيات المسلحة ترفض الانصياع لمنطق الدولة،وتريد إعادة تقسيم السلطة بين الميليشيات المسلحة، الأمر الذي يجعل ليبيا مهددة بالتقسيم إلى دولتين أو ثلاث دول، لاسيَّما أن بعض القبائل بدأت ترسم حدود هذه الدويلات. ويرى مراقبون أنّ الأحداث الأمنية المتسارعة في ليبيا، خاصة منها الاعتداءات المتكرّرة على السفارات الأجنبية، واختطاف الدبلوماسيين، وتعطيل نشاط آبار النفط وعمليات الشحن، جعلت الدول الغربية والعربية المعنية مباشرة بتطوّر الأوضاع الأمنية في ليبيا، تفكر في القيام بعملية عسكرية في ليبيا لتطهيرها من سيطرة الميليشيات المسلحة.وبحسب المعلومات الاستخباراتية الواردة من الدول الغربية، فإن هذه الأخيرة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة للقيام بعملية عسكرية داخل الأراضي الليبية، اختير لها اسم «أزهار الربيع»، ضد الكتائب الليبية المتشددة التي كثفت من عمليات اختطاف الدبلوماسيين. وقال دبلوماسي غربي لصحيفة «العرب» اللندنية إن تنفيذ هذه العملية، التي ستكون محدودة في المكان والزمان، أصبح وشيكا بالنظر إلى التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها ليبيا هذه الأيام، خاصة منها الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية والقنصلية، واستهداف حقول النفط، بالإضافة إلى تزايد نفوذ تنظيم "القاعدة" في أجزاء متفرّقة من البلاد.ولم يُوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عدد الدول التي ستشارك في هذه العملية العسكرية المرتقبة، ولكنه أشار في المقابل إلى أنها ستنطلق من 3 محاور هي غرب ليبيا وشرقها، بالإضافة إلى البحر، حيث ستُستخدم فيها الطائرات والقنابل الذكية، وعمليات كومندوس برّية محدودة. وبحسب هذا الدبلوماسي، الذي أكد أنه اطّلع على جزء من هذه الخطة متعلق ببعض المسائل اللوجستية، خاصة منها تأمين انتقال دبلوماسيي ورعايا الدول الغربية المعنية بهذه العملية المقيمين في ليبيا حين تحديد ساعة الصفر، فإنّ شركات نفطية كبرى ضغطت باتجاه توجيه مثل هذه الضربة العسكرية المرتقبة.وأضاف أنّ تلك الشركات النفطية أبدت استعدادها لتمويل نفقات هذه العملية العسكرية بعد أن تضرّرت مصالحها في ليبيا بشكل لافت بسبب التهديدات المتزايدة للميليشيات وفوضى السلاح التي كبّدتها خسائر مالية فادحة.وتوقع ألّا تُثير هذه العملية العسكرية المرتقبة جدلا سياسيا على المستوى الإقليمي والدولي، باعتبار أنّ ليبيا مازالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستعمال القوة. كما أن اختيار اسمها أي "أزهار الربيع" المقصود منه الإيحاء بأنّ الدول المعنية بها مازالت تدعم "الربيع العربي" وتريد إنجاحه في ليبيا.
1417
| 25 أبريل 2014
أنهى رئيس الحكومة التونسية السيد مهدي جمعة زيارة ناجحة للولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 أبريل الجاري، توجت باستقباله من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض لمدة 45 دقيقة، ومنح الولايات المتحدة الأمريكية لضمان قرض لتونس بنحو 500 مليون دولار، وعن تفعيل اجتماعات الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار التي لم تجتمع منذ 2012، وحصول تونس على منحة أمريكية بقيمة 20 مليون دور سينتفع بها 400 طالب تونسي في أحسن الجامعات الأمريكية خلال السنوات المقبلة. يعتقد المحللون المتابعون لهذه الزيارة، أن هناك حواراً استراتيجياً قد حصل بين أميركا وتونس، لاسيَّما مع الحكومة الجديدة المتكونة في معظمها من النخب الليبرالية المتكونة في الجامعات الغربية، والتي عملت في المؤسسات الدولية المانحة،وفي ظل المتغيرات التي تشهدها تونس، بعد خروج حركة النهضة الإسلامية من الحكم، وتوجه تونس نحو إقامة ديمقراطية تعددية حقيقية ناضلت من أجلها أجيال كاملة من المناضلين التونسيين على اختلاف مرجعياتهم الفكرية والسياسية، رغم زواج الموائمة بين حركات الإسلام السياسي والدول الغربية، لاسيَّما مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تبين إخفاقه. الثورة التونسية التي فجرت ربيع الثورات العربية، جاءت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي اندلعت في سنة 2008. وجاءت الثورات العربية، وفي القلب منها الثورة التونسية، بعد أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تفقد سيطرتها على العالم العربي، وبعد أن أدركت أن حركات الإسلام السياسي أصبحت تمثل القوة الوحيدة المنظمة وعابرة الحدود في العالم العربي، والحالة هذه توصلت إلى قناعة أنه لا يمكن استمرار السيطرة الغربية المفقودة من دون التحالف مع الحركات الإسلامية المعتدلة في العالم العربي. والنموذج التركي في ظل حكم حزب العدالة والتنمية كان يشجع الولايات المتحدة الأمريكية على إقامة مثل هذا التحالف. الانفتاح الأمريكي على الحركات الإسلامية في العالم العربي، والذي ارتقى إلى مستوى التحالف كان المأمول منه، أن تحترم حركات الإسلام السياسي هذه عملية الانتقال الديمقراطي من أجل إقرار دستور ديمقراطي وعصري، وبناء الدولة المدنية، أي الدولة الديمقراطية التعددية، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية للخروج من دوامة الأزمة الاقتصادية التي تعيش فيها بلدان الربيع العربي، لاسيَّما في كل من تونس ومصر. واستند هذا التحالف الجديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والحركات الإسلامية المعتدلة في العالم العربي إلى مرجعية التحالف الأمريكي التركي، لاسيَّما أن النموذج التركي بات يستهوي تقريبا الحركات الإسلامية المعتدلة التي استلمت السلطة في العالم العربي. هناك حقيقية ثابتة في الإستراتيجية الغربية عامة، والأمريكية خاصة، تجاه العالم العربي، أن الغرب لن يسمح للثورات العربية أن تخرج عن سيطرته. وقد أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها ذلك من خلال محاولتها ترويض الإسلاميين الصاعدين إلى حكم الدول العربية على السياسة الأجنبية والاقتصادية، بدلاً من تفسيرات الشريعة. والأحزاب لإسلامية التي ستخضع لذلك سوف يتم اعتبارها «معتدلة» أما الباقي فسيظل من «المتعصبين».علماً أن الثورات العربية التي اشتعلت شرارتها الأولى في تونس في بداية عام 2011، وانطلقت لإسقاط الديكتاتوريات المدعومة من الغرب، شكلت تهديداً استراتيجياً للهيمنة الغربية، رغم أنها ركزت على القضايا الداخلية: الفساد والفقر وانعدام الحريات، وليس على الهيمنة الغربية أو الاحتلال الصهيوني لفلسطين وباقي الأراضي العربية الأخرى. بعد التداعيات الخطيرة التي شهدته مصر تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأحزاب والنخب الليبرالية في تونس. وتندرج زيارة السيد مهدي جمعة إلى واشنطن ضمن هذا السياق، حيث نجد أن هناك تياراً قوياً داخل الإدارة الأمريكية باتت يرى أن الوسيلة الوحيدة والمناسبة لمواجهة الإسلاميين هي قيام الولايات المتحدة بدعم وتمكين الأحزاب الليبرالية والعلمانية في بلدان الربيع العربي في مقابل الأحزاب الإسلامية، رغم تميز الأحزاب الليبرالية بضعف وهشاشة بنيتها الداخلية كما في حالة تركيا - أحد أعرق الدول ذات النظام العلماني-، حيث تراجع دور الأحزاب العلمانية أمام نظيرتها الإسلامية في السنوات الأخيرة ويؤكد هذا التيار الأمريكي على ضرورة دمج الأحزاب الإسلامية «المعتدلة» في العملية السياسية - إلى جانب تقوية شوكة الأحزاب الليبرالية، يرى هذا التيار داخل الإدارة الأمريكية أن هناك حلاًّ لهذه الإشكالية يكمن في فتح الباب أمام الإسلاميين ودمجهم ومشاركتهم في العملية السياسية وقد تكون مخاطرة كبيرة، إلا أن ذلك أمر لا يمكن تجاهله؛ نظرًا لما تتمتع به هذه الأحزاب من قاعدة شعبية كبيرة، كما أن تلك الإستراتيجية أثبتت نجاحها في تركيا والجزائر، حيث أدى دمج الإسلاميين في الحياة السياسية إلى إعادة صياغة برامجهم وتبني سياسات ديمقراطية، أما سياسة الحظر والقمع ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية كما حدث في مصر، وفي ضوء تلك الحقائق، تقترح الإدارة الأمريكية دمج الجماعات الإسلامية في العمل السياسي، خاصة الأجيال الجديدة لتلك الجماعات؛ لأنها الأكثر اعتدالاً وقبولاً للآخر، وكذلك وضع خطة لتحقيق الأهداف الآتية: - التركيز على الإصلاح السياسي بالتوازي مع الإصلاح التعليمي والثقافي للمجتمعات العربية، حيث إن الإصلاح السياسي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تطوير التعليم والنهوض بثقافة المجتمع. - دمج الإسلاميين في عملية الديمقراطية يعتبر ضرورة حتمية لرفع الرغبة التنافسية لدى الأحزاب الليبرالية لتطوير مؤسساتها من جديد، مما يؤدي أيضًا إلى تنشيط القوى السياسية المختلفة في المجتمع وخلق قدر من التنوع الحزبي أمام الناخبين مستقبلاً. - تشجيع ودفع الأنظمة العربية للاهتمام بالأجندة الاجتماعية التي تميزت فيها الجماعات الإسلامية والتي تستطيع الوصول وتحقيق خدمات إلى نحو 90% من المواطنين. - تفعيل دور الإعلام الحر في الترويج لمفهوم الديمقراطية والليبرالية وقيم الحرية والمساواة، وترى الإدارة الأمريكية أن الإعلام في تونس يتمتع بقدر كبير من الحرية التي تتيح له الضغط على الحكومة وتعبئة الشعب لتأييد الديمقراطية. - التحدي الحقيقي أمام الحكومات العربية والأحزاب العلمانية هو في كيفية أن يكون الإسلاميون أكثر تأييدًا للديمقراطية، وهذا لن يحول دون دمجهم في العملية السياسة وكذلك ربط مصالحهم بالإصلاحات السياسية. - إضافة إلى تلك الأهداف، لا بد من استثمار الانقسامات الداخلية الموجودة داخل الأحزاب الإسلامية نتيجة صراع الأجيال الدائر بين الجيل الجديد والقديم، وهو ما سيفرز حتمًا جيلاً جديدًا من الإسلاميين أكثر رغبة في المشاركة السياسية وأكثر انفتاحًا، وهو ما قد يؤثر على مستقبل الإصلاحات. ويخلص هذا التيار الأمريكي للقول إلى أنه ليس بإمكاننا الحديث عن العملية الديمقراطية أو حتى الترويج لليبرالية من دون أن نأخذ في الاعتبار تزايد تأثير الحركات الإسلامية، فالحل الآن هو كيف يمكننا أن ندفع بالإسلام المعتدل في مقابل الإسلام الراديكالي؛ لأن دمج الجناح الإصلاحي داخل الحركات الإسلامية سوف يعطي فرصة ذهبية للعلمانيين من تكوين تحالفات سياسية مع الإصلاحيين داخل الأنظمة الحاكمة . ولعل التحالف المرتقب بين حركة النهضة الإسلامية وحزب نداء تونس، عقب الانتخابات المقبلة مؤشراً حقيقياً على أن إدارة الحكم في المستقبل ستكون في إطار الشراكة بين الإسلاميين والليبراليين، في ظل استقالة اليساريين والقوميين عن دورهم التاريخي نتاج تمسكهم بالخطاب الخشبي، وبمرجعية أيديولوجيات الحرب الباردة، وعدم إفرازهم لنخب سياسية جديدة
927
| 18 أبريل 2014
مساحة إعلانية

ليش ما يمديك؟! بينما ممداني زهران، الشاب ذو...
17214
| 11 نوفمبر 2025

العلاقة العضوية بين الحلم الإسرائيلي والحلم الأمريكي تجعل...
8646
| 10 نوفمبر 2025

في عالم تتسابق فيه الدول لجذب رؤوس الأموال...
8259
| 13 نوفمبر 2025

ماذا يعني أن يُفاجأ أولياء أمور بقرار مدارس...
8046
| 11 نوفمبر 2025

تستضيف ملاعب أكاديمية أسباير بطولة كأس العالم تحت...
3555
| 11 نوفمبر 2025

على مدى أكثر من ستة عقود، تستثمر الدولة...
2994
| 11 نوفمبر 2025

تشهد الصالات الرياضية إقبالا متزايدا من الجمهور نظرا...
2100
| 10 نوفمبر 2025

تحليل نفسي لخطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن...
1635
| 11 نوفمبر 2025

عندما صنّف المفكر خالد محمد خالد كتابه المثير...
1158
| 09 نوفمبر 2025
يبدو أن البحر المتوسط على موعد جديد مع...
1086
| 12 نوفمبر 2025

شكّلت استضافة دولة قطر المؤتمر العالمي الثاني للتنمية...
1035
| 09 نوفمبر 2025

يحتلّ برّ الوالدين مكانة سامقة في منظومة القيم...
903
| 14 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية