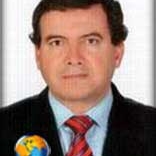رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لم تكن نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية في دورتها الأولى التي جرت يوم الأحد 23 نوفمبر 2014، مفاجأة في شيء، إذ كما كان هو متوقعاً حصل السيد الباجي قائد السبسي مرشح «حزب نداء تونس» على 1289384 صوتا بنسبة 39.46%، واحتل بذلك المرتبة الأولى، وحصل الرئيس المترشح محمد المنصف المرزوقي على 1092418 صوتا بنسبة 33.43 %، واحتل المرتبة الثانية، وحصل مرشح الجبهة الشعبية حمة الهمامي على 255529 صوتا بنسبة 7.82%، واحتل المرتبة الثالثة، وحصل مرشح «تيار المحبة» محمد الهاشمي الحامدي على 187923 صوتا بنسبة 5.75%، واحتل المرتبة الرابعة، وجاء مرشح حزب «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي في المرتبة الخامسة، بحصوله على 181407 أصوات بنسبة 5.55%.وانطلاقاً من نتائج الدورة الأولى التي أعلنتها اللجنة المستقلة للإنتخابات، سوف تنحصر الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية الثانية التي ستجرى في بحر ثلاثة أسابيع، بين المرشحين اللذين فازا بأعلى الأصوات في الدورة الأولى، وهما السيد الباجي القائد السبسي، والدكتور محمد المنصف المرزوقي. وكرست نتائج هذه الانتخابات الاستقطاب الثنائي، الاستقطاب الثنائي الذي أصبح حقيقة موضوعية في المشهد السياسي التونسي، تتأكد من انتخابات إلى أخرى، حيث إن هذا الاستقطاب حصل في الانتخابات التشريعية بين حزبي «نداء تونس» و«حركة النهضة»... ورغم غياب المرشح الرسمي للحزب الإسلامي عن الانتخابات الرئاسية، فقد تواصل هذا الاستقطاب وبنسب متقاربة أيضا وعوض المرشح المرزوقي حزب النهضة هنا. كما كرست هذه الانتخابات الرئاسية الانقسامات الجهوية في تونس، إذ صوت الناخبون ذوو التوجه العلماني، وكذلك منطقة الساحل «محافظات المنستير والمهدية وسوسة»، ومحافظات الشمال الغربي«باجة جندوبة والكاف وبنزرت»، وعدة مناطق من العاصمة تونس، وبالأخص الأحياء الراقية، لصالح قائد السبسي، مرشح «حزب نداء تونس». بينما صوت الجنوب التونسي، معقل حركة النهضة الإسلامية، لمصلحة الدكتور المنصف المرزوقي.ومن الواضح لجميع التونسيين، أن وصول المرشح المنصف المرزوقي للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، لم يكن بفضل أصوات حزبه «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي لم يحصد سوى 4 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بل حصل كل هذا الكم من الأصوات بفضل أصوات القاعدة الانتخابية لحزب «حركة النهضة»، حتى وإن لم يعلن الحزب الإسلامي ذلك رسمياً. وهذا ما جعل الباجي قائد السبسي يقول في تصريح يوم الإثنين الماضي لإذاعة «إر إم سي» الفرنسية «من صوتوا للمرزوقي هم الإسلاميون الذين رتبوا ليكونوا معه، يعني حزب حركة النهضة والسلفيون الجهاديون ورابطات حماية الثورة». وأصرّ الباجي قائد السبسي على أن «كل الإسلاميين اصطفوا وراء المرزوقي» في انتخابات الأحد الماضي. وأضاف الباجي قائد السبسي أن تونس ستنقسم خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى «شقين اثنين: الإسلاميون من ناحية وكل الديمقراطيين وغير الإسلاميين من ناحية أخرى».أما الذين صوتوا للباجي القائد السبسي، فهم المتمسكون بنموذج المجتمع التونسي المعتنق للحداثة الغربية، والمنفتح، والليبرالي، حيث نجح مرشح «حزب نداء تونس» في استثمار أجواء الخوف من الإرهاب الذي استوطن في تونس في زمن حكم الترويكا، ورغبة الشعب التونسي، والحنين إلى الأمن والاستقرار الضروريّين لكي تنهض تونس اقتصاديا، بعد أفول النموذج الاقتصادي التونسي القائم على الرأسمالية المحسوبية، باعتباره نظاماً أنتج البطالة، وارتفاع الأسعار، والعجز في خلق وظائف جديدة، ومن تعبيره عن خيبة أغلب التونسيين من حكم «الترويكا» الذي حوّل تونس خلال الثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي إلى العيش في ظل الفوضى، والإرهاب التكفيري، وغياب الدولة، والخوف من عودة الاستبداد، لكي تعود إلى البلاد إلى المربع الأول، والذي رفع الشعب التونسي فيه شعار« شغل حرية كرامة وطنية». فنجح الباجي قائد السبسي في إقناع الكثيرين من التونسيين، لا سيما من الطبقة المتوسطة بخطابه عن «استعادة هيبة الدولة» و«المحافظة على الإرث الحداثي البورقيبي والنمط المجتمعي التونسي»، كما استفاد في ذلك من الماكينة الحزبيّة والانتخابيّة القويّة التي ورثها عن «حزب التجمع» المنحلّ.وأسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية عن السقوط المدوي لقيادات وطنية كبيرة، من أمثال الأستاذ أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري ومن اللافت في هذه الانتخابات الرئاسية الصعود المفاجئ لمرشح الاتحاد الوطني الحرّ، حزب رجل الأعمال الشابّ سليم الرياحي، الذي احتل المرتبة الخامسة، وتحوم شبهات حول أمواله الطائلة التي جمعها أثناء إقامته في ليبيا قبل الثورة. وقال سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر إن نسبة 32٪ التي تحصّل عليها منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، جاءت على خلفية تصويت قواعد حركة النهضة له، مضيفا أنه سيتحالف في الدور الثاني مع المرشح الذي يشترك معه في نفس المبادئ، نافيا مغادرته تونس في الفترة القادمة. وأكد الرياحي أنه سيجتمع بهياكله لمناقشة مع من سيتحالف الحزب في الدور الثاني مؤكدا أن الخلافات التي حصلت بينه وبين حركة نداء تونس انتهت مع انتهاء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا سنعلن قريبا عن المرشح الذي سندعمه ليكون رئيسا لتونس في الخمس سنوات القادمة. ويرجح أن يصوت سليم الرياحي وحزبه لمصلحة الباجي قائد السبسي.السؤال الذي لا يزال يحير التونسيين لمن ستصوت الجبهة الشعبية في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية،لا سيما أن الجبهة أصبحت الآن موجودة بين المطرقة والسندان، بين مرشح اليمين الليبرالي السيد الباجي قائد السبسي، ومرشح الإسلام السياسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي؟رغم أن الموقف الرسمي للجبهة الشعبية سيعلن اليوم عقب اجتماع مجلس الأمناء، فإن الجبهة الشعبية تعتبر أن تسهيل كشف حقيقة مقتل الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهم سيكون من المطالب الأساسية والأولية، التي ستطالب بها الجبهة الحكومة القادمة. وهذا المطلب المرشح الباجي قائد السبسي في أولوياته عندما أكد على ضروة كشف كل الاغتيالات السياسية التي حصلت في البلاد إبان الترويكا. وتتناقض الجبهة الشعبية مع السياسة التي انتهجها الدكتور المنصف المرزوقي، لا سيما تحالفه مع الإسلام السياسي، واستقباله في قصر قرطاج رموز ما يسمى «رابطات حماية الثورة»، وانتهاجه سياسة خارجية قادت إلى ارتباط تونس بمحمور إقليمي ودولي لا يخدم مصالح الشعب التونسي، فضلاً عن قطعه العلاقات الديبلوماسية مع سوريا. لهذه الأسباب مجتمعة، وغيرها من الأمور الأخرى التي تلتقي فيها الجبهة الشعبية مع الباجي قائد السبسي، خاصة المحافظة على نموذج المجتمع التونسي المنفتح والعلماني، فإن الجبهة الشعبية ستصوت في الدورة الثانية لمصلحة مرشح «حزب نداء تونس»، حتى وإن اختلفت معه، على صعيد منوال التنمية الاقتصادية، فهي ستأخذ بعين الاعتبار المزاج الشعبي السائد الآن في تونس، والذي يتمثل في المحافظة على أمن واستقرار الوطن والشعب التونسيين، ومحاربة الإرهاب، والالتزام بإعادة العلاقات مع سوريا، ودعم أمن الجزائر، وإنقاذ البلد البارك اقتصاديا.
1191
| 28 نوفمبر 2014
تجرى يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري، الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ تقدم 27 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، والقاضية كلثوم كنو، ووزراء من عهد زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبية في 14كانون الثاني/يناير 2011 بعد 23 سنة في السلطة.. ويفترض تنظيم جولة ثانية من الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل في حال لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها التونسيون انتخابات لاختيار رئيسهم، فمنذ الاستقلال في عام 1956 وحتى الثورة، لم تعرف تونس سوى رئيسين هما الحبيب بورقيبة الذي انقلب عليه رئيس وزرائه بن علي في 7 نوفمبر 1987 ثم بقي في قصر قرطاج حتى هروبه إلى المملكة العربية السعودية في 14 يناير 2011.. وبهدف تفادي الجنوح مجددا نحو حكم تسلطي، حدّ الدستور الذي تم تبنيه في بداية سنة 2014 من صلاحيات الرئيس المقبل الذي لا يملك صلاحيات كبيرة وفق ما نصّ عليه الدستور، حيث باتت السلطة التنفيذية في يد رئيس الوزراء المنبثق من الأغلبية البرلمانية، لكن الرئيس القادم يحوز على صلاحية خطيرة وهي صلاحية حل البرلمان وفق الفصل 77 من الدستور، وكذلك تقديم مقترحات لتعديل الدستور وفق الفصل 143 من الدستور، ولعل هذه الصلاحية هي مكمن الصراع اليوم على منصب رئيس الجمهورية فالشق الإسلامي يخشى المس من الدستور إذا وصل رئيس حداثي إلى قرطاج والشق الحداثي يخشى أيضا من تعديل الدستور وبالتحديد يخشى من التخلّي عن حرية الضمير وفق الفصل السادس.قبل خمسة أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية بلغ عدد الانسحابات من السباق أربعة إلى حد الآن، مع وجود نية لدى البعض في إعلان انسحابهم، وهؤلاء المنسحبون هم: محمد الحامدي مرشح التحالف الديمقراطي، وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية قبل بداية الحملة الانتخابية، وكل من المرشحين المستقلين مصطفى كمال النابلي ونور الدين حشاد.أسباب الانسحاب والدوافع بدت مختلفة مقارنة بالانسحابين الأولين إذ كانت نتيجة الانتخابات التشريعية سببهما المباشر في ذلك، إلا أن انسحاب النابلي وحشاد، في تعليقه على هذين الانسحابين الأخيرين، قال المنسق العام لشبكة «دستورنا» في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة إن انسحاب مصطفى كمال النابلي هدفه البحث عن تموقع جديد له من خلال التفاوض حول منصب حكومي جديد بعد اقتناعه بأنّ حظوظه في الرئاسية ضئيلة. وأضاف أن انسحاب نور الدين حشاد كان متوقعا باعتبار أن ترشحه كان رمزيا. القضية المتداولة بين مختلف المترشحين، وعلى صعيد أجهزة الإعلام التونسية المكتوبة والمسموعة والمرئية، هي مسألة الخوف من الاستقطاب الثنائي، والتغول في إشارة واضحة إلى فوز حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية، وزعيمه السيد الباجي قائد السبسي المرشح الأوفر حظاً في الفوز في هذه الانتخابات الرئاسية منذ الدورة الأولى.. ويثير هذا الاستقطاب الثنائي للمشهد السياسي التونسي العديد من المخاوف لدى الشعب التونسي، لأنه يسهم في تكريس انقسامات أفقية وعمودية للمجتمع التونسي، رغم أن البعض من النخب التونسية، ترى أن هذا الاستقطاب الثنائي هو ضمان لاستقرار البلاد، حيث إن وجود قطبين (حزب نداء تونس العلماني، وحركة النهضة الإسلامية)، وبغض النظر عن طبيعتهما، يجعلان من التداول السلمي على السلطة أمرا ممكنا لا إمكانا نظريا فقط، لذلك كان المشهد الذي نتج عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 مختلا، بينما المشهد الحالي – وبغضّ النظر عن صاحب المرتبة الأولى من الثانية – أكثر ملاءمة لحصول التداول السلمي على السلطة وكنا سنفزع لو انهارت حركة النهضة مثلا وأصبحنا في مشهد شبيه بذلك الذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر 2011 ولكن بصفة معكوسة.. فالديمقراطية بحاجة إلى وجود حزبين أو تحالفين كبيرين متعادلين وإلا كان التداول السلمي على السلطة هراء لا معنى له.. لقد جاءت نتائج الانتخابات التونسية مخيبة لآمال حركة النهضة، وكانت بمنزلة «تسونامي» زلزل الخريطة السياسية في تونس، وجرف أمامه مشاريع عدد من الأحزاب السابقة سواء الحليفة لحركة النهضة أو الحليفة لحزب نداء تونس، واحتلت النهضة المرتبة الثانية، بعد أن احتلت المرتبة الأولى في انتخابات 23 أكتوبر عام 2011، وبذلك قلبت هذه الانتخابات كل المعادلات السياسية القائمة، حالياً وأظهرت من جديد قوة «المجتمع التونسي المنفتح والعلماني » العائدة بصورة لافتة بعد فشل ما يسمى «ثورات الربيع العربي» . بعد إخفاق الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفوز حزب نداء تونس، الذي يريد أن يبرز هويته السياسية على أنها انبعاث للبورقيبية في ثوب ديمقراطي جديد، طفت من جديد الوطنية القطرية، التي تعني العودة إلى الاستثمار في القطر ودولته، واكتشاف الهوية التونسية، والعمل على تزويدها بمعنى ودلالة إنسانية.. ويشكل هذا تطلعا جديدا إلى المستقبل يهدف إلى بناء الأمة بمفهوم "المواطنة". وفي هذا السياق، ينبغي أن نفهم معنى إعادة تثمين الوطنية التونسية الدستورية لحقبة ما بعد الاستقلال، واكتشاف مرجعية حقوق الإنسان، والديمقراطية. وفيه أيضا ينبغي أن نفهم عداء كثير من الإسلاميين المنضويين في حركة النهضة، وحلفائهم، للتيارات الديمقراطية التي تبدو وكأنها تساهم في إبعاد الفكرة الإسلامية أكثر عن الساحة أو الحلول محلها، وطرح مشروع يحيدها أو يثمن الدولة القطرية ويلغي أفق الإسلام السياسي، أو يضعفه. يبدو الخيار الديمقراطي في نظرها، بل في نظر الكثير من أنصار الديمقراطية أيضا، تعويضا وربما بديلا للخيار الإسلامي. ويثير نتيجة ذلك رد فعل قويا لدى أولئك الذين يخشون أن يكون المشروع الديمقراطي في النهاية "حصان طروادة" لترسيخ العلمانية، وإبعاد الخيار الإسلامي إلى عالم النسيان. ومن الأفكار الجديدة القديمة الناشئة في حضن أزمة الاستقطاب الثنائي في تونس، تنامي العصبيات الجماعية على أساس جهوي، حيث إن الشمال بات يصوت لحزب نداء تونس، والجنوب لحركة النهضة وللمرشح المنصف المرزوقي.. وهي تبدأ على شكل حزازات وانقسامات ونزاعات جزئية، ولا تلبث حتى تكتسب معاني ثقافية وسياسية، وتصبح مرجعية وهوية قائمة بذاتها يعرف الفرد التونسي نفسه من خلالها وبها. هكذا يعاد اكتشاف قيمة الاختلاف الجهوي وتحويله إلى قاعدة تضامن مستقل بين الأفراد، أي إلى أساس رابطة مجتمعية، جمعية سياسية أو شبه سياسية.. تسعى الجهوية بذلك إلى التعويض الجزئي أو الكلي عن غياب التضامن والترابط الاجتماعي العموميين. وهي تعبر عن إخفاق السياسة الوطنية في عهد النظام السابق في بناء إطار تضامنات فعلية وطنية ما فوق جهوية، أي بناء دولة وطنية ديمقراطية. وهذا أيضا ما يعكسه انبعاث العشائرية والجهوية في تونس: أي الاستثمار في القرابات المادية، الحقيقية أو الموهومة، والعشائرية والجهوية هي عودة إلى العصبية الطبيعية، الدرجة الأبسط والأغشم من الترابط الاجتماعي.. ومن الأفكار أو الأيديولوجيات الجديدة التي تسعى إلى وراثة الفكرة الإصلاحية التونسية المتوارثة منذ القرن التاسع عشر،هي ما يروجه حزب نداء تونس على أنه حامل للفكرة البورقيبية الدستورية وما تعرض نفسها على أنها نزعة كونية وإنسانية وتنويرية ترفض الانتماء الجزئي وتنادي بالاندماج في عالم الحداثة، التي تنظر إليها كحداثة قياسية، واحدة وتوحيدية.. وتركز من خلالها على العلمانية بوصفها جوهر الحداثة وعقيدة أو خيارا يتجاوز أو يرتفع على الهوية القومية والدينية، على العروبية والإسلاموية والطائفية والعشائرية في الوقت نفسه.
1089
| 21 نوفمبر 2014
لم تحتل المسألة الاقتصادية حيزاً كبيراً في برامج الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية سواء منها التشريعية التي انتهت بفوز «حزب نداء تونس» الذي يمتلك تصوراً ليبرالياً للاقتصاد، أم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 23نوفمبر الجاري. والسبب في ذلك، أنه خلال حكم الترويكا السابقة، هيمن على المشهد السياسي التونسي موضوع الإرهاب وتداعياته الأمنية والسياسية والمجتمعية، على استقرار البلاد، وعلى تغيير النموذج المجتمعي التونسي المنفتح على الحداثة الغربية، والليبرالي، الأمر الذي جعل الشعب التونسي برمته يشعر بغياب وفقدان هيبة الدولة التونسية، ويطمح قبل كل شيء إلى تحقيق الاستقرار، والمحافظة على النموذج المجتمعي التونسي المعتدل والوسطي.فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي التونسي الذي خضع لبرنامج الإصلاح الهيكلي وفقا لوصفات صندوق النقد الدولي في أواسط الثمانينيات من القرن العشرين، وسار في طريق «توافق واشنطن» في أواسط التسعينيات، بوصفه مذهباً اقتصادياً ليبرالياً يقوم على فلسفة التقشف، والتخصيص، والتحرير، والانضباط في الموازنة، والإصلاح الضريبي، وتخفيض النفقات الحكومية العامة، وتحرير المبادلات التجارية والأسواق المالية، فقد قاد هذا النموذج الاقتصادي إلى حدوث كارثة بالبلاد.لقد أدّى النموذج الاقتصادي التونسي إلى سيادة أنماط بائسة من التشغيل، لاسيَّما نمط التشغيل بالعقود ذات المدد المحدودة، حيث تؤكد التقارير التونسية أن ما يفوق 50 بالمائة من العاملين في قطاع السياحة يخضعون لهذا النمط الرديء من التشغيل، والشيء عينه تقريبا في مجال الخياطة، إذ تكون الأجور متدنية جداً، إضافة إلى غياب الضمانات الاجتماعية.بشهادة كبار الخبراء في الاقتصاد سواء من الدول العربية أو من الدول الغربية، يعتبر النموذج الاقتصادي التونسي هجيناً بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى دقيق، فهو ليس نموذجاً رأسمالياً خالصاً على الطريقة الغربية خاضعاً لقانون السوق، بل هو نموذج خاضع لقانون المافيا الاقتصادية المهيمنة على الاقتصاد التونسي في عهد سيطرة عائلة الرئيس المخلوع ابن علي وزوجته من آل الطرابلسي، حيث طبقت هذه المافيا الاقتصادية قانونها الخاص بدلاً من قانون، لتتحول تونس طيلة العقدين الماضيين إلى ما أشبه بالعيش في العصور الإقطاعية، لا في عصر العولمة الليبرالية كما يدعي النظام السابق.ومع ذلك، هل يمتلك حزب نداء تونس، الذي سيقود الحكومة المقبلة البرنامج الواقعي لقلب الأوضاع الاقتصادية رأساً على عقب في فترة برلمانية أو رئاسية واحدة، يفترض أن تشهد إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتغيير نموذج التنمية لما يعنيه ذلك من تغييرات موجعة وعميقة، لا يكتب لها النجاح إلا إذا صدرت عن وفاق وطني شامل؟في هذا المجال أكد رئيس اللجنة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية « لحزب نداء تونس»، سليم شاكر، أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب «يتميز بخلق منوال تنموي جديد يقوم أساسا على التكنولوجيا والقيمة المضافة في المنتوجات التونسية والخدمات» على حد تعبيره. وقال إن نجاح هذا المنوال التنموي الجديد، يتطلب إرجاع الأمن والطمأنينة للشعب التونسي، وتفعيل اللامركزية في القرار، وتعصير البنية التحتية، والاستثمار في الموارد البشرية، وإحداث بنك لتنمية الجهات. وأضاف أن البرنامج الاجتماعي للحركة يعمل على تفعيل العقد الاجتماعي، والرفع من المقدرة الشرائية للمواطن، وفرض التغطية الصحية للجميع، مع تأهيل قطاع الصحة العمومية، وبعث منظومة للتأمين ضد فقدان الشغل، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخصوصية، ومقاومة التمييز ضد المرأة، ودعم البحث العلمي. «حزب نداء تونس» لا يشذ عن قاعدة الأحزاب الليبرالية الحاكمة في العالم الثالث، فهو يريد المحافظة على نموذج التنمية الذي كان سائداً في تونس بهيكلته القديمة، رغم انتهاء صلاحية هذا الأنموذج التنموي السائد طيلة الحقبة التاريخية السابقة، وهو غير قادر أن يعطي أجوبة عقلانية وواقعية للتحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، في مجال المنافسة الدولية الشرسة، وتحقيق اختراق في مجال الاستثمار واكتساح الأسواق بما يمكنه من استحقاق نسق النمو ورفع حجم الصادرات وخلق مواطن شغل ودعم مدخراته من العملة الصعبة.يرث حزب نداء تونس تركة ثقيلة وأخطاء جسيمة ارتكبتها حكومات الترويكا المتعاقبة منذ نهاية عام 2011 ولغاية 2014، لكي تتجلى أمامنا صورة قاتمة عن الإفلاس الحقيقي لهذا النموذج الاقتصادي التونسي الذي تمسكت به حكومات الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية، حيث إن تونس أصبحت في الوقت الراهن باركة اقتصادياً بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى دقيق. ويتمثل هذا الإفلاس في الحقائق التالية:الحقيقة الأولى: على مستوى النمو يمكن أن يبلغ نسبة 2.3% في منتصف السنة الحالية حسب تقرير البنك العالمي الصادر في 25مايو 2014، تحت عنوان «الثورة غير المكتملة». الحقيقة الثانية: على صعيد العملة الوطنية، فقد تراجع الدينار في غضون سنتين بنحو 17%، مقابل اليورو.الحقيقة الثالثة: في عهد الترويكا السابقة، تطور ما يسمى الاقتصاد الموازي، وفاقت معاملاته 53.5% من إجمالي التداولات التجارية. وتقف وراء الاقتصاد الموازي العصابات المنظمة المحمية من قبل جهات سياسية نافذة، فأدّى هذا الوضع إلى تضخم هذا الاقتصاد الموازي الذي أصبح يستقطب في عهد الترويكا 42.% من اليد العاملة. الحقيقة الرابعة: في عهد حكم الترويكا، أغلقت 3742 مؤسسة أبوابها وغادر أكثر من 1200 مستثمر تونسي وأجنبي البلاد في ظل وجود عدم الاستقرار.الحقيقة الخامسة: ارتفاع نسبة البطالة من 15% في سنة 2010 إلى 23% في سنة 2013، فبلغ عدد العاطلين عن العمل مليون شخص. الحقيقة السادسة: تجاوز الدين الخارجي حوالي 17 مليار دولار، ليصل مؤشر الدين الخارجي حاليا إلى نحو 52.3% من الناتج المحلي الخام.الحقيقة السابعة: تجاوز الثروة المنهوبة في تونس من قبل الرئيس المخلوع وزوجته، وأقربائهما البالغ عددهم 110 أشخاص، نحو 10 مليارات دولار، حسب التقرير الذي أصدرته لجنة مكافحة الفساد. ورغم أن الثورة التونسية شكلت منارة حقيقية «لربيع الثورات الديمقراطية» التي شهدها العالم العربي، فإنها لم تقم بتغيير الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وإطلاق نموذج جديد من التنمية يقطع مع نهج التبعية، ويكَّسِرُ الأنماط الاقتصادية السائدة،لاسيَّما تلك القائمة على أساس التحرير الاقتصادي، والخصخصة الرأسمالية، والاندماج في نظام العولمة الليبرالية الجديدة، الذي خدم بدرجة رئيسية الفئات الرأسمالية الطفيلية غير المنتجة باعتبارها فئات تمثل تحالفاً مشبوهاً بين ما يسمى «رجال الأعمال» والعائلات المافياوية الحاكمة، والبرجوازية البيروقراطية العسكرية والأمنية التي كونت ثروتها من خلال هيمنتها المطلقة على أجهزة الدولة، والذي قاد إلى الثورة. وفي ظل غياب الثورة الاقتصادية يبدو حل المعضلة الاقتصادية في تونس بعيد المنال في المنظور الراهن، لاسيَّما في ظل غياب الاستثمارات العربية والأجنبية التي يمكن أن تحرك العجلة الاقتصادية.
809
| 14 نوفمبر 2014
ضرب الزلزال الانتخابي الخارطة التونسية بقوة يوم 26أكتوبر الماضي، في أول انتخابات ديمقراطية ونزيهة أجريت في البلاد بعد الثورة، فحصل «حزب نداء تونس» على المرتبة الأولى بنحو 85 مقعداً من أصل 217 عدد المقاعد في البرلمان التونسي، واحتل حزب«حركة النهضة الإسلامية» المرتبة الثانية بنحو 68 مقعداً، ولم يتحصل الحزب الثالث «الاتحاد الوطني الحر» المتشكل حديثا بعد سنة 2011، والذي يملكه الملياردير التونسي سليم الرياحي إلا على 17 مقعداً. من المنطقي أن الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد، وهو في هذه الحالة «حزب نداء تونس» هو المعني مباشرة بتشكيل ائتلاف ليحصل على الأغلبية (109مقاعد من 217)، لكن الحزب له 85 مقعدا فقط، فهو مطالب بالتحالف مع أحزاب أخرى للحصول على 24 مقعدا أو أكثر لكي يحصل على الأغلبية النسبية في البرلمان المقبل. ورغم أن «حزب نداء تونس» هو الفائز، فإنه في ورطة انتخابية، لأنه لا يمكن أن يحكم بمفرده. لاشك أن هذا السؤال يهيمن اليوم على قيادات «حزب نداء تونس» وأن لديهم الآن سيناريوهات متعددة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية التي أفرزها الصندوق. يتمثل السيناريو الأول في إقامة تحالف ديمقراطي عريض، يضم «حزب نداء تونس» (85)، و«حزب آفاق تونس»(8)، وفسيفساء من الأحزاب والمستقلين(16)، لكن هذا التحالف الديمقراطي الليبرالي سيكون حتما هشاً وقابلا للانفجار في كل أية لحظة، نظرا لأنه سيسير في نهج الليبرالية الرأسمالية المتوحشة. السيناريو الثاني، أن يتحالف «حزب نداء تونس(85) مع «الجبهة الشعبية»(15 مقعدا)، و«حزب آفاق تونس»(8)، و«حزب المبادرة» (4)، وهو ما سيمكن من تحصيل (112 نائبا)، وإذا بدا الأمر منطقيا بلغة الحساب، فإن ذلك غير وارد سياسياً على اعتبار سقف المفاوضات التي ستلتحق على قاعدتها الأحزاب المشكلة للحكومة المقبلة، وهو سيعيد إلى الأذهان قضية المحاصصة الحزبية لاقتسام غنيمة السلطة. وفضلاً عن ذلك، فالتوجهات الليبرالية لهذه الأحزاب الفائزة، باستثناء الجبهة الشعبية، تثير المخاوف لدى المواطن التونسي، لأن الليبرالية الاقتصادية التي تنشدها هذه الأحزاب، وإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي، ستكونان لهما تداعيات خطيرة ومنتظرة على نحو 70% من المواطنين التونسيين.أما السيناريو الثالث، فيكمن في تحالف«حزب نداء تونس » مع «حزب الاتحاد الوطني الحر»، وهذا التحالف مستبعد لاعتبارات سياسية ولطبيعة تموقع حزب سليم الرياحي. السيناريو الرابع والأخير، ويتمثل في تقاسم السلطة بين «حزب نداء تونس» وحركة النهضة، وهو التقاسم الذي أسسه اللقاء التاريخي بين الشيخين راشد الغنوشي والباجي القائد السبسي في باريس في 13 أوت 2013، إذ تتفق حركة النهضة وحزب نداء تونس على نمط التنمية السائر في نهج العولمة الليبرالية المتوحشة. وعلى هذه القاعدة يتفقان أيضا في نسج علاقات التبعية لمراكز النفوذ السياسية والاقتصادية الرأسمالية المؤثرة في العالم. ولكن ذلك لا يمنع وجود صراعات بينهما الآن – ولفترة أخرى من الوقت – مدارها احتكار الحكم السياسي والنفوذ الاقتصادي والاجتماعي من جهة ونوعية النموذج القيمي الاجتماعي للحياة العامة الحضارية والثقافية للشعب التونسي.غير أن هذا السيناريو مرهون بدعم «حركة النهضة» لترشح الباجي القائد السبسي في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 23 أكتوبر الجاري، مما سيتطلب من أنصار الحركة الإسلامية التصويت للباجي القائد السبسي كي يفوز في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى. وبذلك يتم تقاسم السلطة بين الباجي القائد السبسي كرئيس للجمهورية الثانية، وتشارك «حركة النهضة» في الحكم من خلال حصولها على رئاسة البرلمان، وبعض الوزارات الأخرى، فيما تسند رئاسة الحكومة إلى شخصية مستقلة مع عدد من الوزراء للأحزاب الفائزة في الانتخابات. لكن حركة النهضة تدرك أن قرارها سيرتهن مصيرها للسنوات الخمس القادمة، فهي لا تزال مترددة بين إستراتيجيتين، أحلاهما مر، إستراتيجية البحث عن الشراكة في الحكم، وهذا يقتضي منها دعم المرشح الباجي القائد السبسي في الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 23 نوفمبر الجاري، لكي يفوز من الدورة الأولى، وإستراتيجية الصدام مع «حزب نداء تونس» من خلال الانخراط بصفة فاعلة وقوية ضد مرشح نداء تونس ومساندة شخصية بعينها مع ما يستتبع ذلك من حدّة الخصومة السياسية، حيث إن هذه الإستراتيجية الصدامية ستخلق لها صعوبات جمّة بعد هذا الاستحقاق الانتخابي لإيجاد قاعدة تفاهم مع نداء تونس وذلك أيا كانت النتيجة النهائية للسباق الرئاسي.. وهذه الصعوبة ستزداد ولا شك في حالة هزيمة المرشح المسنود من قبل الحركة الإسلامية. المحللون التونسيون المطلعون على خبايا حركة النهضة، يعتقدون أن الشق الغالب داخل مجلس الشورى يدافع عن ضرورة مقاومة تغوّل نداء تونس وسعيه للاستفراد الكلي بمراكز القرار الأساسية في قصر قرطاج والقصبة وقبة باردو.. وهذا يقتضي ضرورة تعديل نتائج الانتخابات التشريعية بقطع طريق قرطاج أمام قائد السبسي بداية باختيار مرشح جدي والأفضل أن يكون وفاقيا لمنافسة رئيس نداء تونس وثانية بنزول الحركة بكل ثقلها من أجل كسب رهان الرئاسية وبذلك تجبر حركة نداء تونس على التفاوض معها من موقع الضعف النسبي لا القوة التي كانت ستحصل عليها لو أصبح قائد السبسي الرئيس الجديد لتونس. لقد آن الأوان، بعد الزلزال الانتخابي، أن تدرك القوى السياسية التونسية الديمقراطية، أن الديمقراطية في تونس لم تعد تجدي معها توفيقية باتت مستهلكة مستنفدة، وأنها لن تتبلور إلا عبر الصراع والتناقض وليس عبر توافق طوباوي مفترض، أو تسويات سياسية تعيد إنتاج النظام السابق. فقد تميزت الانتخابات التونسية بتأثير المال السياسي الفاسد، ولجوء الأحزاب الكبيرة إلى الرشاوى لشراء ذمم الناخبين، وهو ما قاد إلى هيمنة حزبين يمينيين هما «حزب حركة النهضة» (فرع الإخوان المسلمين في تونس) و«حزب نداء تونس» الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، والوريث الشرعي للحكم الذي أطاحت به انتفاضة 17 ديسمبر 2010/14 يناير 2011 وكانت حكومة السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى التي أعقبت الثورة، وانتهت بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها «النهضة» على 89 مقعداً. وباتت القوى الديمقراطية التونسية في حاجة إلى اجتراح مشروع مجتمعي جديد وخارج عن هذا الاستقطاب الثنائي(النهضة ونداء تونس) يكسر البنى التونسية التاريخية المتكلسة ويمهد لفكر ديمقراطي جديد وإنسان تونسي جديد.
701
| 07 نوفمبر 2014
يجمع المحللون السياسيون التونسيون أن ما حدث يوم الأحد 26 أكتوبر 2014، يعتبر زلزالاً سياسياً كبيراً ضرب بقوة الخارطة السياسية للأحزاب التونسية بعد هذه الانتخابات التشريعية التي اتسمت بـ"الشفافية" و"الصدقية"، بوصفها أول انتخابات حرة وديموقراطية في تاريخ تونس. فقد عزّز الشعب التونسي التزامه الديموقراطي بفضل انتخابات ذات صدقية وشفافة، مكنت التونسيين من مختلف الحساسيات السياسية، من التصويت بحريّة لمجلس تشريعي وفقا لأول دستور ديموقراطي في البلاد. وأظهرت نتائج الانتخابات فوز"حزب نداء تونس" العلماني بنحو 85 مقعداً من أصل 217 مقعدا، وهو الحزب الذي احتل المشهد السياسي التونسي منذ أكثر من سنتين، لا سيما بعد اعتصام باردو في صيف 2013. ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 عاماً)، مؤسس حزب "نداء تونس" (يمين الوسط) الفائز بالانتخابات التشريعية التونسية محامياً وسياسياً تونسياً مخضرماً. لقد صوت الشعب التونسي بقوة لمصلحة "حزب نداء تونس" لاعتقاده أنه الحزب الأوفر حظاً أمام حركة النهضة، ولهذا السبب استفاد "حزب نداء تونس" من "الانتخاب المفيد" حتى لا يتم تشتيت الأصوات، ومن اصطفاف كل الطبقة المتوسطة التونسية وراءه، حيث أرادت هذه الطبقة أن تصوت لمصلحة الحزب الذي يمتلك من القوة لكي يحافظ على نموذج المجتمع التونسي الوسطي والمعتدل والمنفتح على الحداثة الغربية، كما كان في عهد النظام السابق. فصوتت هذه الطبقة المتوسطة التي تمثل الأكثرية في المجتمع التونسي بقوة له، لأنها أرادت أن تتحرر من حكم الترويكا، وتزيح حركة النهضة من الحكم، وتقطع عليها طريق العودة نهائيا إلى السلطة عبر هذه الانتخابات. وهذا ما يفسر لنا أيضا أن بعض الشرائح هذه الطبقة التي كانت تصوت تقليديا لمصلحة أحزاب وسط اليسار، مثل الحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي،غيرت هذه المرة بوصلتها وأعطت أصواتها بالكامل لمصلحة حزب نداء تونس، وعاقبت في الوقت عينه كل الأحزاب التي كانت حليفة لـ"حزب نداء تونس"، والتي كانت مجتمعة داخل "الاتحاد من أجل تونس"، فهي لم تعد تقبل بأنصاف المواقف، حيث اندثرت هذه الأحزاب الديمقراطية الوسطية الحليفة للنداء من المشهد السياسي التونسي عبر هزيمتها الساحقة في هذه الانتخابات. فالحزب الجمهوري الذي يتزعمه السيد نجيب الشابي لم يفز سوى بمقعد يتيم، بعد أن كان له 16 مقعداً، وحزب المسار الديمقراطي لم يفز بأي مقعد، بعد أن كان له 10 نواب في المجلس التأسيسي السابق. واستفاد "حزب نداء تونس" من الدور الكبير للإعلام التونسي المنحاز بقوة له، والذي عبد له الطريق لكي يحتل طليعة المشهد السياسي التونسي طيلة العامين الماضيين، ويغرس في ذهنية الشعب التونسي صورة معينة مفادها أن "حزب نداء تونس" هو الحزب الوحيد القادر على هزيمة حركة النهضة، فتضخمت أعداد الوافدين إلى الانضمام للحزب المتشكل حديثاً. لكن هذا الفوز الكبير لحزب نداء تونس، ما كان ليحصل، لو لم يتوافر عاملان أساسيان في هذا الفوز. الأول: دور المال السياسي الفاسد الذي أسهم في شراء ذمم الناخبين، لا سيما في الأرياف، والأحياء الفقيرة من المدن، و الثاني: الدور القوي الذي لعبه "حزب التجمع" المنحل بقرار قضائي في مارس 2011، حيث أن الماكينة الحزبية و الانتخابية لحزب التجمع انضمت بقوة للعمل لمصلحة "حزب نداء تونس"، ووفرت له الأرضية التنظيمية، والخبرات الضرورية، و الدعم اللوجيستي لتحقيق هذا الفوز الانتخابي، إضافة إلى أن الأحزاب الدستورية المنبثقة من حزب التجمع، أعطت الضوء الأخضر لأنصارها للتصويت لـ"حزب نداء تونس"، ودعمه انتخابيا تجنبا لتشتيت الأصوات، فاكتسح هذا الأخير الشمال والساحل بدعم قوي من أنصار و منخرطي الأحزاب الدستورية ذات المرجعية التجمعية. وهكذا عاد "التجمعيون"، الذين أقصوا من الحياة السياسية بعد الثورة، لكي يعودوا من جديد عبر بوابة "حزب نداء تونس"، والشرعية الانتخابية. ويضم حزب "نداء تونس" نقابيين ويساريين ومنتمين سابقين إلى حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد بن علي الذي حكم تونس بين 1987 و2011. وتقول المعارضة القومية الديمقراطية، واليسارية، إن "حزب نداء تونس"، "تجمع جديد" وإن قائد السبسي الذي تولى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 من "أزلام" نظام بن علي. كما تحذر من عودة "الاستبداد" إلى تونس إن وصل "حزب نداء تونس" إلى الحكم، والمحافظة على نهج الليبرالية الرأسمالية المتوحشة التي كانت سائدة في العهد السابق، مما يؤكد أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس منذ بداية الثورة سوف تستمر من دون حل، ما لم تغير تونس من خياراتها الاقتصادية والاجتماعية نحو القطع مع نهج التبعية، والعمل نحو إقامة نموذج من التنمية يلبي مصالح وتطلعات الطبقات والفئات الشعبية . واحتلت حركة النهضة المرتبة الثانية بحصولها على 69 مقعداً، أي بخسارتها حوالي 20 مقعدا بالقياس إلى نتيجة انتخابات 2011. وكانت أكبر نسبة حققتها حركة النهضة هي في الجنوب معقلها التاريخي. ورغم أن حركة النهضة خسرت عدداً كبيراً من المقاعد، فإنها حافظت على نصيبها الانتخابي، وعلى تموقعها ومكانتها ضمن الأحزاب الكبرى في البلاد، باحتلالها المرتبة الثانية. ورغم أن حركة النهضة فقدت أكثر من ثلث قاعدتها الانتخابية. لقد ضرب هذا الزلزال الانتخابي في تونس، كل الأحزاب التي كانت حليفة لحركة النهضة في إطار الترويكا السابقة، التي حكمت تونس منذ بداية 2012 و لغاية بداية 2014، فحصل حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي على 4 مقاعد في هذه الانتخابات، بينما حصل على 29 مقعدا في انتخابات 2011، وحصل حزب التكتل الذي يتزعمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدكتور مصطفى بن جعفر، على مقعد يتيم بعد أن كان له 21 مقعدا في 2011، واندثرت الأحزاب الأخرى التي كانت تؤيد النهضة مثل حزب وفاء، وحزب التنمية والإصلاح وتيار المحبة، وهي كلها أحزاب عاقبها الشعب التونسي بسبب انتهاجها سياسة الإقصاء والثأر، والإدعاء بأنها أحزاب تدافع عن الثورة، وهي لم تشارك فيها، إضافة إلى تقسيمها التونسيين بين جماعة ما قبل الثورة، وجماعة ما بعدها. واحتل حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يتزعمه الميلياردير التونسي سليم الرياحي رئيس فريق النادي الإفريقي لكرة القدم، المرتبة الثالثة بحصوله على 17 مقعدا، وهو حزب من دون هوية سياسية أو فكرية، لكنه حزب شعبوي يؤمن بالليبرالية الاقتصادية، وهو ما سيشكل بيضة القبان في المشهد السياسي التونسي، عند تشكيل الحكومة المقبلة، لأنه سيتحكم بمفاتيح التحالف القادم، وسيرفع من سقف مطالبه، وهو من شأنه أن يدفع "حزب نداء تونس" في نهاية المطاف إلى التحالف مع النهضة في إطار حكومة تعايش، وهو سيناريو مستبعد، لكنه غير مستحيل. وتأتي الجبهة الشعبية بزعامة السيد حمه الهمامي المرتبة الرابعة بحصولها على 15 مقعدا، وهو أمر منتظر ولم يفاجىء أحداً من متابعي الشأن السياسي التونسي. فالجبهة الشعبية التي تشكلت على أساس أن تصبح القوة الثالثة القادرة على تكسير هذا الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة وحزب نداء تونس، لم تقدم البديل الثوري للنظام الديكتاتوري السابق، وأخفقت في تحقيق التوافق بين الجماهير والقوى الوطنية والديمقراطية من أجل بناء نظام ديمقراطي بديل، بالتالي أخفقت في بناء كتلة تاريخية تدافع عن الثورة، وتعمل إلى التوصل لأهداف وطنية جامعة على قاعدة الديموقراطية. واحتل حزب آفاق تونس الليبرالي جدا المرتبة الخامسة بحصوله على 8 مقاعد، حيث تقوده قيادة شابة ومتعلمة، ومثقفة، وتتقن التعامل مع وسائل الاتصال الجماهيري المتطورة. السؤال الذي يطرحه التونسيون بعد هذا الزلزال الانتخابي، من سيحكم تونس؟ من المنطقي أن الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد (وهو في هذه الحالة حزب نداء تونس) هو المعني مباشرة بتشكيل ائتلاف ليحصل على الأغلبية (109مقاعد من 217). لكن الحزب له 85 مقعدا فقط، فهو مطالب بالتحالف مع أحزاب أخرى للحصول على 24 مقعدا أو أكثر لكي يحصل على الأغلبية في البرلمان المقبل.
781
| 31 أكتوبر 2014
يتوجه يوم الأحد 26 أكتوبر 2014، إلى صناديق الاقتراع في تونس، حوالي 5 ملايين و285 ألفا و136 تونسيا ، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، لانتخاب أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير2011، بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتتنافس في الانتخابات 1327 قائمة (1230 قائمة داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج) بحسب إحصائيات «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وتضم القوائم الانتخابية نحو 13 ألف مرشح سيتنافسون على مقاعد «مجلس نواب الشعب» الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. ويضم المجلس 217 نائباً منهم 199 عن 27 دائرة انتخابية داخل تونس، و18 عن 6 دوائر خارج البلاد. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح «على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة» الواحدة، وفق القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية المقررة في 23نوفمبرمن هذا العام. ويترأس رجال الغالبية الساحقة للقوائم الانتخابية ما يعني أنهم سيهيمنون على «مجلس نواب الشعب» الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية. ما يميز هذه الانتخابات التشريعية التونسية هو العودة السريعة للعديد من قيادات وكوادر «حزب التجمع الدستوري» المنحل بقرار قضائي في مارس 2011، وهو حزب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ، لواجهة الأحداث السياسية في تونس، وهي فكرة ربما لم تكن حتى لتخطر ببال أتباع الرئيس المخلوع نفسه. فقد عادت الماكينة الحزبية «للتجمعيين» تعمل بكل قوتها لمصلحة «حزب نداء تونس» الذي يرأسه السيد الباجي القائد السبسي رئيس الحكومة السابق، والعديد من الأحزاب الأخرى المنبثقة عن «حزب التجمع بنفسه، مثل «حزب المبادلاة» الذي يترأسه السيد كمال مرجان وزير الخارجية السابق في عهد بن علي، والحركة الدستورية التي يترأسها السيد حامد القروين رئيس الحكومة السابق في عهد بن علي أيضا. إنها عودة «حزب التجمع»القوية للحياة السياسية، من خلال حضور مسؤولي الرئيس المخلوع بن علي قويا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لأول مرة بعد الثورة. بينما في الانتخابات الماضية التي جرت يوم 23أكتوبر 2011، لم يشارك أي مسؤول من النظام السابق في الانتخابات بسبب منعهم بقانون مؤقت. وبعد إجهاض الثورة التونسية من قبل حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة، وظهور الجماعات الإرهابية متمثلة في تنظيم «أنصار الشريعة»، واستيطان إرهابها متزامنا مع فترة حكم «حركة النهضة» لتونس، حيث شهدت البلاد أخطر أحداث بعد الثورة مثل مهاجمة السفارة الأمريكية في14سبتمبر 2012، واغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013، وتدهور الاقتصاد وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار وتفاقم البطالة، استغلت قيادات وكوادر وقاعدة «حزب التجمع » المنحل هذه الوضعية، ليفاخروا بإنجازات نظام بن علي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ووجدوا ضالتهم في الانتماء بقوة إلى «حزب نداء تونس». ويُعتبر حزب «نداء تونس» الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، أبرز حزب معارض لـ«حركة النهضة». وكان قايد السبسي ترأس بعد الثورة الحكومة الانتقالية التي قادت تونس حتى انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر2011. وسيخوض قايد السبسي (87 عاماً) الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر2014. وبحسب نتائج استطلاعات الرأي، يحظى حزب«نداء تونس» بشعبية تتفوق في الوقت الحاضر على «حركة النهضة». ويُعتبر، كما «النهضة»، أيضاً بين الأحزاب الأوفر حظاً في الانتخابات. ويضم هذا الحزب منتمين سابقين من حزب «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم في عهد بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم قائد السبسي ضد «حركة النهضة». ويشكو الحزب من تجاذبات داخلية، ويخشى عدد من كوادره من أن تمارس شخصيات من نظام بن علي نفوذاً واسعاً. ويتنافس «نداء تونس» مع أحزاب أخرى تضم مسؤولين في النظام السابق مثل حزب «الحركة الدستورية». وتجرى الانتخابات التشريعية هذه في تونس، في فترة ما بعد الثورة، واستجابة لما فرضته مسيرة الفرز السياسي الذي واكب تطور نضال الشعب التونسي، خلال هذه المرحلة الصعبة و المعقدة من عملية الانتقال الديمقراطي ،إذ عاشت تونس في 2013، أزمة سياسية حادة، إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية، وقتل أكثر من 60 عنصرا في الجيش والشرطة في هجمات نسبتها الحكومة المؤقتة إلى جماعة «أنصار الشريعة في تونس» التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيماً «إرهابياً». وانتهت الأزمة بعد قبول حكومة «الترويكا» التي كانت تقودها «حركة النهضة» الإسلامية، تقديم استقالتها تطبيقاً لخارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية. وحلت محل «الترويكا»، حكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة، على أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة . ولم تستطع القوى الديمقراطية التونسية أن تحدث نقلة نوعية حاسمة في موازين القوى العامة لمصلحتها في تونس، نظراً لأن القوى السياسية الفاعلة في عهد النظام الديكتاتوري السابق لا تزال ماسكة ومتحكمة بعناصر القوة المادية والسياسية في المجتمع والدولة. ورغم أنها فقدت إثر نجاح الثورة التونسية في 14 يناير/ جانفي 2011، في إسقاط النظام السابق، تعبيراتها السياسية القديمة ( التجمع الدستوري ) فإنها بعد فترة من الارتباك والتذبذب تتجه اليوم نحو حسم خيارها فيمن يحل محله سواء بالاصطفاف وراء حركة النهضة أو بإعادة تنظيم صفوف التجمعيين أو أيضا بعودة الوئام و التحالف بين النهضة والتجمعيين. فتجانس المصالح وتطابق الرؤى بينهما سيلعب دورا محددا في حسم الخلافات الجارية الآن بينهما والتي اتخذت في وقت من الأوقات طابعا عنيفا وحملات تشهير واسعة لا تزال متواصلة بأشكال عدة إلى غاية الانتخابات هذه. تتفق حركة النهضة وحلفاؤها من جهة وحزب «نداء تونس» (المنافس القوي لحركة النهضة، والذي يتزعمه السيد الباجي قائد السبسي، وأغلب مكونات « الأحزاب الدستورية» (الذي يضم الأحزاب الليبرالية في تونس) من جهة ثانية، على نموذج الاقتصاد الليبرالي، والانخراط في نظام العولمة الليبرالية من موقع الطرف التابع لمراكز النفوذ السياسية والاقتصادية الرأسمالية المؤثرة في العالم. غير أن هذا الاتفاق لا يمنع وجود صراعات بينهما الآن – ولفترة أخرى من الوقت – مدارها احتكار الحكم السياسي والنفوذ الاقتصادي والاجتماعي من جهة ونوعية النموذج القيمي الاجتماعي للحياة العامة الحضارية والثقافية للشعب التونسي. فكما هو معروف يتبنى حزب «نداء تونس» ومجمل القوى الليبرالية المتحالفة معه والتي يمكن أن تحذو حذوه نمطاً عصرانياً حداثياً للمجتمع يُكَرِّسُ مفهوماً خاصاً للحريات العامة والفردية على الطريقة الغربية بمضمونها البرجوازي الاستهلاكي والذي يبقى قابلاً للتكييف والتطويع ما بين الطابع الديمقراطي الليبرالي والشكل الاستبدادي حسب تقلب موازين القوى. بينما تعمل حركة النهضة وكل القوى المتغلفة بالدين وطائفة من الأحزاب المتحالفة معها والقريبة منها، علاوة على تمسكها بالخيارات الليبرالية المملاة من الدوائر الغربية الأوروبية و الأميركية، على فرض نموذج جديد على المجتمع التونسي يقوم على قيم محافظة ومتخلفة تجاوزها الزمن يريدون إحياءها وتفعيلها في العلاقات الاجتماعية العامة أساساً لاستبداد جديد باسم الدين. أما من الناحية السياسية فإن «الدساترة التجمعيين» الذين تمت إزاحتهم من الحكم يعملون اليوم بتسمياتهم المختلفة جاهدين من أجل استعادة الكرسي ويجري اليوم في أوساطهم سعي محموم إلى إعادة التشكل والانتظام من أجل العودة للحكم من جديد أو المشاركة فيه. بينما تعمل النهضة من أجل الاحتفاظ بالحكم بعد أن « تسللت » إليه عبر انتخابات 23 أكتوبر 2011. وتوصف «حركة النهضة» بأنها الحزب الأكثر انضباطاً في تونس التي تعاني أحزابها العلمانية المعارضة التشتت، لا سيما اليسارية منها. ويبلغ عدد المنضوين في «النهضة» نحو 80 ألفاً، حسبما أعلن زعيمها راشد الغنوشي في نيسان 2014. وركزت «حركة النهضة» حملتها للانتخابات التشريعية على «التوافق» الذي أمكن بفضله المصادقة (مطلع 2014) على دستور جديد للبلاد، وتجنيبها العنف والفوضى التي سقطت فيها دول شهدت حركات احتجاج شعبية. وتقول الحركة إن تونس لا يمكن أن تحكم على المدى القصير والمتوسط إلا بالتوافق بين الإسلاميين والعلمانيين. وخلافاً لانتخابات 2011، لم ترشح «حركة النهضة» للانتخابات التشريعية المنتظرة رموزاً من جناحها المتشدد الذي يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. وتظهر الحملة الانتخابية مدى امتعاض الشارع التونسي من «حركة النهضة» بسبب تنامي الإرهاب في عهدها، وعجزها الواضح عن إدارة الحكم، والدولة، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي الواسع الذي شهدته تونس. هل تشكل الانتخابات التونسية يوم الأحد المقبل، ولادة أول برلمان منذ ثورة 2011، سيعمل على بناء أول نظام ديمقراطي تعددي يقوم على حكم المؤسسات، ويعمق استمرار التحول الديمقراطي والاستثنائي في دول «الربيع العربي» التي سقطت في الفوضى والقمع، حيث تعيش ليبيا المجاورة، واليمن، اقتتالاً بين فصائل متناحرة، وسوريا حرباً أهلية، بينما استعاد الجيش السلطة في مصر؟
937
| 24 أكتوبر 2014
تجمع الأحزاب التونسية الديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدني، على أن المال السياسي الفاسد الذي بات يسيطر على المشهد السياسي التونسي، ويضرب الانتخابات التشريعية في العمق، يتأتى من مصدرين رئيسيين:الأول: داخلي، من خلال اكتساح رجال الأعمال المنضوين في إطار منظمة الأعراف(الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) بقيادة السيدة وداد بوشماوي، رئاسة القوائم الانتخابية في الأحزاب الكبرى، لاسيَّما حزبي نداء تونس، وآفاق تونس، بوصفهما حزبين ينشدان الليبرالية الاقتصادية، حيث احتل رجل الأعمال المشهور السلامي رئاسة قائمة صفاقس بالنسبة للأول، والكاتب العام الجهوي لاتحاد الصناعة والتجارة بتونس، بالنسبة لآفاق تونس، ومالك شركة «سيفاكس آر لينز» محمد فريحة بالنسبة لحزب النهضة. والثاني: خارجي. زواج المال والسياسة أحد الخصائص المميزة للانتخابات التشريعية التونسية هذه، وهو مؤشر واضح يعكس إخفاق النخب السياسية والأحزاب السياسية في مواجهة هجمة رجال المال والأعمال التي تصدرت المشهد السياسي والانتخابي التونسي، وفي تقديمها برامج انتخابية واقعية تستجيب لمطالب التونسيين في التنمية والتشغيل. فما يحصل اليوم خلال الحملة الانتخابية هذه، هي ممارسات تتلاعب بإرادة التونسيين، وحالة من إفلاس الأحزاب السياسية التي ارتمت في أحضان رجال المال والأعمال، وباتت لا تراهن على تجاوب الناخبين مع برامجها بقدر ما تراهن على شراء أصواتهم، لاسيَّما الأحزاب الليبرالية، لقناعتها بأن الفوز في الانتخابات يمر عبر قدرة رجال المال والأعمال على ضخ الأموال في الحملة الانتخابية. ويرى كثيرون أن هذا الزواج غير الشرعي بين المال والسياسة سيقود إلى نتائج كارثية لا تعكس طموحات الشعب التونسي، وأهداف الثورة، بل سيعيد إنتاج النظام القديم في ثوب ديمقراطي جديد زائف، تتقاسم فيه القوى القديمة والجديدة الهيمنة على مفاصل السلطة والثروة في المجتمع. وللشأن السياسي التونسي يرون بوضوح أن المال السياسي مكن حركة النهضة، والأحزاب الليبرالية الكبيرة من أن تتقدم بقوائم انتخابية في كل الدوائر البالغ عددها 33 دائرة، 27 داخل تونس و6 بالخارج فيما فشلت غالبية الأحزاب اليسارية والعلمانية في تغطية كل الدوائر الانتخابية ليس فقط بسبب محدودية انتشارها الشعبي وإنما أيضا بسبب تواضع إمكاناتها المالية.. ومع انطلاق الحملة للانتخابات التشريعية، أصبحت الأحزاب الصغيرة وذات الإمكانات المحدودة، وكذلك القوائم المستقلة، تتساءل عن مصادر التمويل بالنسبة للأحزاب الكبيرة، ومدى التزامها بالسقف الذي ضبطه القانون في الإنفاق على حملاتها الانتخابية. والسؤال الذي يطرحه التونسيون، هو هل تمتلك الهيئات المعنية بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، بموجب القانون الانتخابي والقانون بصفة عامة، القدرة على الوقوف على التجاوزات في هذا المجال.هناك قانون انتخابي تم إقراره في تونس، وينص صراحة على مراقبة حسابات المرشحين، لكنه يحمل العديد من الثغرات، فهيئة الرقابة العمومية للانتخابات في تونس لا تستطيع أن تراقب التمويل المشبوه المتأتي من قبل أصحاب المال داخليا ومن قبل القوى الإقليمية خارجيا، أو عبر بوابة الجمعيات الخيرية أو الهبات العينية أو التحويلات الكبيرة. فهيئات الرقابة العمومية يمكنها مراقبة الحسابات المالية الخاصة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية التي تمنحها الدولة للمترشحين، ولكنها لا تستطيع أن تراقب حساباتهم الشخصية ولا حسابات المرشحين معهم بنفس القائمة. وهو ما يمكن المرشحين من تمويل حملاتهم بأموال تأتي من مصادر مشبوهة بالخارج أو الداخل دون أن يعرضوا أنفسهم للعقوبات التي أقرها القانون. كما يمكن للمرشحين تمويل حملاتهم بأموالهم الذاتية أو من قبل المتعاطفين معهم ولا من رقيب أو حسيب، فسقف التمويل الانتخابي الذي أقره القانون يبقى سقفا نظريا إذ إن ما يصرف فعليا يتجاوز بكثير ما هو موثق بالدفاتر ولدى هيئة الانتخابات. خطورة المال السياسي الفاسد (من الداخل والخارج) في تفشي الفساد داخل الأجهزة الحزبية من جراء هشاشتها وضعف الديمقراطية والشفافية داخلها، لاسيَّما أن القواعد في تلك الأحزاب لا تعلم عن الميزانية داخل الأحزاب، ولا عن التدفقات المالية التي تأتيها، ولا عن الصفقات المالية المشبوهة مع رجال المال التي يوظفها القادة الحزبيون من أجل الفوز في الانتخابات أو التمركز في القيادة. وينخر المال السياسي الفاسد أجهزة الدولة عموماً، وهو يتفاقم مع تصاعد التسلل الهرمي السياسي، بدءاً من المسؤولين الكبار في الأحزاب السياسية الكبيرة، ومروراً بالعديد من النواب في المجلس التأسيسي الذين لم يكونوا متحمسين لسن عقوبات رادعة ضد استعمال المال الفاسد، ووصولاً إلى رجال المال والأعمال الذين هم أكثر فساداً من بين هؤلاء، وهم محل سخط شعبي وموضوع تتبع قضائي «مؤجل» في انتظار تفعيل العدالة الانتقالية، بسبب تهربهم من دفع الجباية المالية للدولة، وعملية تبييض أموالهم عبر ضخ المال الفاسد في هذه الحملة الانتخابية للعديد من الأحزاب، بهدف استمالة الفئات الهشة والفقيرة من أجل شراء أصواتها، لضمان فوزها في الانتخابات، وبالتالي ضمان صعودها إلى الحكم.. علماً أن النتائج في هذه الحال لا تعكس الإرادة الحرة للتونسيين في اختيار من سيمنحونهم أصواتهم.المال السياسي الفاسد يساهم في ضرب عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، حيث يتمثل هذا الخطر في استخدام الأحزاب السياسية المال لشراء أصوات الناخبين وذممهم لتحصيل أكبر عدد ممكن من الأصوات. وهو ما يجب إيلاءه كل الأهمية لأنه لا يمثل عملية تزوير لإرادة التونسيين بل هو عملية اغتيال للتجربة الديمقراطية. إن عملية «الانتقال الديمقراطي »لا يمكن أن نقول عنها إنها مكتملة إلا إذا توافرت فيها شروط عديدة، أبرزها: أن يعمل الفاعلون السياسيون الرئيسيون على محاربة تأثير المال السياسي الفاسد(من الداخل والخارج)، لأنه يشكل العدو الرئيسي للتجربة الديمقراطية عبر مصادرة إرادة الشعب، والمشاركة الشعبية المتحررة من الضغوطات المالية، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والحريات العامة والخاصة. وبصورة إجمالية، المال السياسي الفاسد يشكل العائق البنيوي الكبير نحو إقامة المؤسسات الدستورية والسياسية التي تشكل الأرضية الحقيقية لبناء النظام الديمقراطي الجديد في تونس، لاسيَّما تشكيل حكومة جديدة منبثقة من خلال انتخابات عامة تكون حرة ونزيهة. لكن المال السياسي الذي تقف وراءه منظمة الأعراف(اتحاد الصناعة والتجارة)، والقوى الإقليمية، يريد أن يصعد رجال الأعمال، والأحزاب السياسية التي تتبنى نهج الليبرالية المتوحشة، إلى الحكم، لكي يصبح البرلمان التونسي المقبل خاضعاً لتأثير وتوجهات منظمة الأعراف، التي تدافع عن النموذج الاقتصادي والمنوال التنموي الرأسمالي الليبرالي الذي سارت عليه تونس خلال العقود الخمسة الأخيرة، ما قبل ثورة 14 يناير 2011، والذي قاد إلى زيادة إفقار الطبقات والفئات الشعبية، والطبقة المتوسطة، وتنمية معدلات البطالة بصورة كبيرة، ورهن البلاد للمؤسسات الدولية المانحة. إن التحول الديمقراطي الحقيقي الذي ينشده الشعب التونسي ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مرتبط بإقامة نموذج جديد للتنمية الاقتصادية غير خاضع لمقتضيات الليبرالية المتوحشة، ويقوم على دعامتين أساسيتين: الدعامة الأولى تتمثل في أن الديمقراطية تعني تنظيم الأفراد في جماعات تنافسية من خلال نظام تعددية حزبية بهدف السيطرة على سلطة الدولة. والدعامة الثانية، إن الديمقراطية شرط أساسي لبناء الدولة الوطنية التي تستطيع مقاومة الضغوط السلبية النابعة من النظام الدولي الجديد الذي تتحكم فيه القوى الدولية الغربية، والمؤسسات المالية المانحة، وكذلك ما يترتب عليها داخليا من آثار وعواقب.ويمكن القول بصفة عامة إن مقولة الديمقراطية تساوي نموذج التنمية الذي أضحى قضية خلافية في الجدل السياسي التونسي. فهناك من يرى الديمقراطية من المنظور الليبرالي، ويدافع عن النموذج الاقتصادي الليبرالي المتوحش، وهو ما سيقود إلى إعادة إنتاج نظام ابن علي، وبالتالي إعادة إنتاج منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والثقافي التي كانت سائدة قبل الثورة، والتي جعلت تونس خاضعة للهيمنة الغربية وتابعة لها. وهناك من يؤكد في تونس على ضرورة تحلل مفهوم الديمقراطية من إطاره الرأسمالي، وانتهاج نموذج جديد للتنمية عبر إعطاء عملية التحول الديمقراطي توجها وطنياً (أي معاد للإمبريالية الغربية) ومضمونا اجتماعياً(أي معاد لليبرالية الرأسمالية المتوحشة ومن يمثلها من منظمة الأعراف والبرجوازية الطفيلية في الداخل).
648
| 17 أكتوبر 2014
انطلقت في تونس يوم السبت 4 أكتوبر الجاري، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. كانت القضية التي شغلت الساحة التونسية منذ قيام الثورة وليومنا هذا، هي إدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي، في بلد يعيش أزمة متعددة الأوجه: أزمة شرعية، أزمة سلطة، أزمة اقتصادية واجتماعية، أزمة أخلاقية، وانتشار الفوضى في عموم حياة الشعب التونسي في ظل تنامي ظاهرة العنف السياسي التي استشرت بشكل قوي أمام الانفلات الأمني وغياب هيبة الدولة، وانزلاق تونس في نهج الإرهاب المسلح الذي تمارسه الجماعات السلفية التكفيرية المنضوية في إطار تنظيم «أنصار الشريعة» الذي أضاق الشعب التونسي مرارة التكفير الدعوي الذي طال الأفراد والمؤسسات والمعالم الأثرية والثقافية وتجلى في عمليات التنكيل والتخريب بلغ حدّ الاغتيال السياسي والجريمة المنظمة. ففي 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال 2 من قادة المعارضة العلمانية وقتل ما يقارب 60عنصراً من قوات الجيش والأمن والدرك في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأسقطت تلك الأزمة حكومة حمادي الجبالي "الأمين العام السابق لحركة النهضة" المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر 2011. كما أسقطت حكومة خلفه علي العريض "الأمين العام الحالي لحركة النهضة"، التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. إن السجال الأكبر الذي ينقسم حوله المجتمع التونسي في الوقت الراهن أيما انقسام هو ذلك السجال القائم بين دعاة التعددية الثقافية وبين الإسلاميين المدافعين عن المذهب التوحيدي الشمولي الجامع. لكن الديمقراطية لا يسعها أن تتماهى لا بالتعددية ولا بالتوحيدية. فهي تنبذ بشّدّة هاجس الهوية الذي يجعل كل فرد حبيساً ضمن طائفة، ويختزل الحياة المجتمعية إلى حيّز التسامح والتساهل، مما يدع الساحة المجتمعية مشرعة، في الواقع، على كل احتمالات الفرز والتقوقع والحروب المقدّسة، كما تنبذ بالشّدّة نفسها تلك الذهنية اليعقوبية التي تتذرع بالجمعية لتقضي على تنوّع المعتقدات والانتماءات والذاكرات الخاصة. إن أكبر حزبين في تونس، وهما، حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط)، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، واللذان ترشحهما عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، للفوز في الانتخابات التشريعية يظهران بكل بوضوح أن التناقض الأساسي الذي يشق النخب التونسية والجسم الانتخابي أيضا، لا يتعلق بالنموذج الاقتصادي الاجتماعي الليبرالي المندمج في نظام العولمة الليبرالية المتوحشة، وإنما يتعلق بالمشروع المجتمعي. فلا يزال الصراع حول مشروع المجتمع الذي يريده الشعب التونسي قائما، ولم يحسم بعد، رغم إقرار دستور توافقي. فالنخب التونسية السياسية والثقافية، وحتى الطبقات والفئات في المجتمع التونسي، لا تزال منقسمة بين فريقين. الأول: يؤيد نموذج المجتمع الذي تبشر به حركة النهضة، التي لا تزال تعتبر نفسها حزباً إسلاميا معتدلاً ملتزماً بسياسة التوافق باعتبارها ضرورية في المرحلة المقبلة، وكشرط لإنجاح المسار الديمقراطي في تونس، ولكن حركة النهضة ملتزمة في الوقت عينه بمرجعية فكر الإخوان المسلمين، وببناء الدولة الإسلامية بالتدرج. والثاني يمثله حزب الباجي قائد السبسي، إذ يدافع عن المشروع المجتمعي القائم على تبني الفكر الحداثوي، وقيم العلمانية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية. فقد قال الباجي القائد السبسي بمناسبة ترشحه للانتخابات الرئاسية:"إن الانتخابات يتنافس فيها مشروعان: المشروع الإسلامي ومشروع بناء تونس العصرية (تونس القرن 21)، حزبنا يمثل المشروع الثاني ولن يتحالف إلا مع الأطراف التي تشاركه نفس المرجعية مع إيمانه بحق كل الأطراف في النشاط". واستبعد الباجي القائد السبسي التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما "إرهابيا". وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة الإسلامية جزء من "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، وإنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك. رغم أن جوهر الصراع الفكري والثقافي في تونس، يتمحور حول المشروع المجتمعي، فإن النخب الفكرية والسياسية التونسية لا تزال تراوح بين المساندة وإضفاء الصبغة الشرعية للسلطة الحاكمة وبين المعارضة والتهديد لها. فالنخب الفكرية والسياسية، اصطدمت أيضا بعوائق بنيوية يتسم بها المجتمع التونسي، وتتمثل فيما يلي:1- حالة الخوف كظاهرة مرضية (باتولوجية) أصبحت مستوطنة في نفسيات الغالبية العظمى من المجتمع التونسي، حيث بات التونسي شخصية خائفة من كل شيء.2- استشراس أزمة الثقة لدى المجتمع التونسي بسبب هيمنة نزعة الريبة، والشك، والاحتياط، والاستنفار، وهي مجموعة من الخصائص، تجعل التواصل مع أفراد الشعب التونسي من جانب النخب الفكرية والسياسية في غاية من الصعوبة، ولا يمكن كسر هذه الحالة إلا من خلال استخدام العلاقات العشائرية كآلية للتواصل السياسي وغيره.3-سيطرة نزعة التذمر على نفسية الفرد التونسي، باعتبارها ناجمة عن الخوف المبالغ فيه الذي يشعر به التونسي، وعن هيمنة حالة مرضية أخرى هي الرفض المصحوب بغياب البديل الأمثل.4-هيمنة الروح الانهزامية للمواطن التونسي، بسبب انعدام الثقة بينه وبين الأحزاب السياسية والطبقة السياسية الحاكمة، وحتى المثقفين، إلى درجة أنه بات يشكك في أي بديل يمكن أن يقدم أجوبة عقلانية للتحديات التي تواجهها تونس. لقد أسهمت هذه العوائق البنيوية في نفسية المجتمع التونسي لكي تشكل حواجز حقيقية تعيق عملية التفاعل بين النخب التونسية الفكرية والسياسية وبقية مكونات المجتمع التونسي، لكن هذا يشكل نصف الحقيقة، فللنخب التونسية أمراضها أيضاً، ومنها على سبيل المثال: 1-حالة العزلة المعنوية التي تعانيها هذه النخب بينها وبين الشعب التونسي، فهي نخب متقوقعة في العاصمة، أو في المناطق الحضرية داخل المدن التونسية، وتعيش عزلة حقيقية في التواصل مع بقية أفراد الشعب التونسي.2-استشراس الطبيعة الانتهازية للنخب التونسية الفاعلة، تتمثل في تعدد الانتماءات التنظيمية للشخص الواحد والتي تصل عند بعضهم الـ4 أو الـ5 انتماءات (معارضة، منظمات غير حكومية...). 3-الفجوة الطبقية الموجودة بين النخب التونسية، التي استطاعت أن تحقق مصالحها الطبقية، وامتيازاتها المادية من خلال حصولها على الشهادات الجامعية التي مكنتها من تبوؤ مراكز عمل مرموقة في المرحلة الماضية، وبين بقية أفراد الشعب، حيث بات ينظر المجتمع التونسي إلى النخب، بوصفها فئة طبقية محظوظة من المجتمع، إضافة إلى عدم إحساس النخب التونسية بمعاناة الشعب التونسي، وهذا ما يخلق هوة كبيرة في العلاقة بين الطرفين.
677
| 10 أكتوبر 2014
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 26 أكتوبر الجاري، تعيش تونس حراكاً متعدد الأبعاد، حيث تؤكد الانتخابات أن الصراع التنافسي الآن بين الأحزاب السياسية ليس صراعاً على البرامج، بقدر ما هو صراع على المشاريع المجتمعية، لاسيَّما أن الإسلام السياسي ـ متمثل في حركة النهضةـ أصبح عنصرا فاعلاً ورئيسياً في المشهد السياسي التونسي. وتزداد الضغوطات على حركة النهضة باتجاه التونسة، بعد الإخفاق الكبير في تجربة الحكم، وتنامي الإرهاب في معظم بلدان الربيع العربي، من هنا جاء الكتاب القيم الذي صدر حديثا في تونس، تحت عنوان "حركة النهضة بين الإخوان والتونسة"، ليسلط الضوء على هذا المخاض العسير، بل الصراع الداخلي الذي تشهده حركة النهضة بين المتغيرات في ممارستها السياسية داخل اللعبة الديمقراطية، وبين المحافظة على ثوابتها الأيديولوجية، وتمسكها بالمشروع الإسلامي الأولي لحركة الاتجاه الإسلامي، المعلن في يونيو 1981. عرفت تونس في الستينيات انقلابات اجتماعية عميقة، غيّرت - مع مرور السنوات– هياكل المجتمع التقليدي، ومع بداية السبعينيات عرف الاقتصاد التونسي انفتاحاً واسع النطاق على الخارج، وازدادت علاقات التبعية المالية والتجارية والصناعية للسوق الرأسمالية العالمية، والاحتكارات العالمية. وتدعمت أسس الرأسمالية التابعة، في نمط الاستهلاك والعيش، وفي تهافت الطلب على السلع الرأسمالية، وفي انتشار ظواهر الأنانية والربح السريع، واستغلال الفرص واللصوصية، مما أدى إلى انحطاط القيم الأخلاقية الموروثة من المجتمع القديم، التي كنستها أيديولوجية البرجوازية الكمبرادورية. وفضلاً عن ذلك، فقد ترسخت خيارات النظام القائمة على التبعية المطلقة إزاء القوى الإمبريالية، وبناء الاقتصاد التصديري الذي يلبي حاجيات السوق الرأسمالية العالمية، وتدمير الزراعة في الريف بعد إخفاق عصرنتها، وتنامي الثروات الفاحشة بسرعة مذهلة عند بعض الفئات الاجتماعية، وتزايد الفقر والعوز الاقتصادي لدى الطبقات الشعبية، وتفاقم تعقيدات الحياة المدنية، وهجرة أبناء الريف إلى المدينة مشكلين بذلك أحزمة الفقر. أدّت العوامل مجتمعة هذه إلى تفاقم التبعية والتخلف، وولّدت أزمة القيم بكليتها وشموليتها على صعيد المجتمع التونسي، في ظل طغيان نموذج "الحداثة المستلبة" التي قادتها البرجوازية التابعة في بناء نموذجها الدولتي. ثم إن الرأسمالية التابعة الاستهلاكية، أدت إلى تعميق الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، وإلى توسيع الهوة بين المدينة والريف، وإلى اختلال هائل في مسيرة"التنمية" غير المتكافئة، في تمركزها وشموليتها الاقتصادية الاستثمارية والاجتماعية، والثقافية، والترفيهية بين المناطق الساحلية وداخل البلاد. وهذا ما أدى إلى اشتداد التناقضات الطبقية بعمقها الاجتماعي. وشكلت الأسباب الرئيسية هذه القاعدة الأساسية لنشوء الحركة الإسلامية في تونس، التي تشكلت تحديداً في العام 1970، تاريخ تأسيس مجلة"المعرفة" الإسلامية الشهرية، التي تحلقت حولها أبرز العناصر الإسلامية (الشيخ راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو) الرافضة للعمل من داخل جهاز الدولة. ويعود الفضل في محاولة الإنعاش هذه إلى الشيخ أحمد بن ميلاد سنة 1965، لكن الديناميكية الجديدة التي مهدت لانبعاث الحركة الإسلامية التونسية لم تبدأ فعلياً إلا عندما تجمعت نواة أولى، وتعهدت بالعمل "لنشر الإسلام" متأثرة خاصة بأدبيات البنا وقطب والمودودي، مع انضباط مرجعه عمل جماعي، وفقه للدعوة، وبيعة للأكبر سنا ومكانة، مستفيدة من دعم رجل زيتوني هو الشيخ محمد صالح النيفر الذي فضل الهجرة إلى الجزائر على أن يبقى صامتاً بعد خيبة أمل دينية في شخصية بورقيبة، ومعتمدة على مجلة رجل لا يقل صموداً (عبد القادر سلامة) وضع صحيفته تحت تصرف الجماعة لتعكس ثقافتها الأولى، وتصبح شهادة ميلاد ووثيقة رئيسية تحدد ملامح الكيان الجديد. كان الموقف الرافض للمشروع التحديثي للدولة التونسية، وراء ظهور الحركة الإسلامية التونسية، «وهو – أي الموقف الرافض- المضمون الأساسي لمشروعية وجودها والمحدد لقاعدتها الاجتماعية التي أصبحت بها السبعينيات وأواخرها يحسب لها حساب بالمعنى السياسي. وبناء عليه فإن التفريط في موقف العداء الخالص والشامل لمشروع الدولة الوطنية الحديثة وللنخب المدافعة عنه، ليس أمراً بديهياً باعتبار أنه يمس بقوة عوامل ظهور الحركة والأسباب الاجتماعية التي ساعدت على بروزها في ذلك الظرف التاريخي دون غيره وأيضاً بتبني بديل المشروع الإسلامي في التغيير الثقافي والاجتماعي دون سواه، هذا ما عبرت عنه الدكتورة آمال موسى في كتابها الجديد المشترك مع الدكتور عبد القادر الزغل، عن «حركة النهضة بين الإخوان والتونسة» الصادر حديثا بتونس. الحركة الإسلامية في تونس هي ملتقى لتيار واسع من الألوان الفكرية والمنازع السياسية والأمزجة المتعددة ضمن منظور أصولي إسلامي. وكانت النواة المؤسسة والمبادرة للعمل الإسلامي بتونس مؤلفة من الشيخ راشد الغنوشي الذي لم يكن تكوينه الإسلامي ذا اتجاه واحد، وإنما كان تمازجاً بين مجموعة من الاتجاهات مع مجيء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى سدة الرئاسة في عام 1987، وإقراره سياسة التعددية الحزبية المسيطر عليها في عام 1988، نجد أن الأمين العام لـحركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي يقول في عام 1989 إنه «لا يمكن تصور مجتمع إسلامي وعلماني معاً إلا إذا تخلى عما هو أساسي في الإسلام. لا يكون المجتمع إسلامياً إلا إذا كان غير علماني ». ويزيد من إرباك المشهد السياسي التونسي، الخطاب المزدوج الذي يقدمه قادة الحركة الإسلامية مع إنجاز الثورة التونسية، واعتلاء حركة النهضة السلطة عقب انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، وتشكيلها حكومة الترويكا وقيادتها لها، مع حزبين علمانيين صغيرين، هما: حزب المؤتمر بزعامة الدكتور المنصف المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطي بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر. من يتابع الصراع الدائر في تونس منذ أكثر من ثلاث سنوات وليومنا هذا، يلمس بوضوح أن الصراع ليس على برامج سياسية بين حركة النهضة وبقية الأحزاب الديمقراطية المؤمنة ببناء دولة ديمقراطية تعددية، بل هو في حقيقة الأمر صراع على المشروع المجتمعي لتونس خلال المرحلة المقبلة، والذي لم يحسم بعد. فلا يمكن أن تتعايش مرجعية فكرية وسياسية ديمقراطية تؤسس لدولة القانون، لدولة مدنية تعددية، تقوم على مبدأ سيادة الشعب، وعلوية القانون، والإرادة الشعبية،مع مرجعية حركة النهضة التي لا تزال ترفض تجسيد القطيعة الإيبستيمولوجية مع حركة الإخوان المسلمين، التي تؤسس موضوعيا لدولة دينية تقوم بالتدرج.
819
| 03 أكتوبر 2014
هل يجوز نعت الليبرالية الجديدة، أو الليبرالية العولمية، أو الليبرالية المتوحشة "ديكتاتورية الأسواق" و"ديكتاتورية تقنيات الإعلام الجماهيري"، بالتوتاليتاتورية؟دأبت الإيديولوجية السائدة في الغرب على نقد ووصف النظام الشيوعي الذي كان سائدا في روسيا ودول أوروبا الشرقية طيلة مرحلة الحرب الباردة بالنظام التوتاليتاري. وقد كان لمفهوم التوتاليتارية، الذي يعرف بالشمولية، دور كبير في إسقاط التجربة التاريخية للشيوعية. ومن أهم خصائص هذه التوتاليتارية، تميزها بعدد من الثوابت والعلامات الفارقة: الحزب الشمولي الواحد، الدور المركزي للإيديولوجية، إلغاء الحدود الفاصلة بين الدولة والمجتمع، تقديم دولة السلطة على سلطة الدولة، تضخم أجهزة القمع والإرهاب وافتراسها المجتمع، نفي مشروعية الصراعات الداخلية وتقديس مبدأ الانصهارية. غير أنه مع انتصار إيديولوجيا النيوليبرالية، أو الليبرالية الجديدة في زمن العولمة، التي تزعزع أسس الحياة الاجتماعية في مختلف أنحاء المعمورة شمالا وجنوبا، والتي تقوم على المرتكزات التالية: الدعوة المتطرفة إلى الحرية الاقتصادية، وإنكار دور الدولة في ضبط آليات وحركة النظام الرأسمالي والتخفيف من شروره الاجتماعية (تحديدا في مجال التوزيع والعدالة الاجتماعية)، هيمنتها على المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). وتعاملها مع البلدان النامية من منطلق التكيف وضرورته مع السوق الرأسمالي العالمي، وإبعاد الدولة وإضعافها، وترك آليات السوق لكي تعمل طليقة، برزت في العالم الغربي إيديولوجيا نقدية هي الأكثر شيوعا اليوم، إيديولوجيا مضادة للعولمة الرأسمالية المتوحشة، تصف الليبرالية الجديدة أو الليبرالية المتوحشة، بإيديولوجيا كاملة لإدارة الأزمة في النظام الرأسمالي العالمي. فهناك اليوم في صفوف مناهضي العولمة، من يرى أن الليبرالية الجديدة تعبير عن توتاليتارية الأسواق، وعن توتاليتارية تقنيات الإعلام الجديدة، وأن الذي شجعها على اكتساحها في التطبيق مختلف مواقع الساحة العالمية، ضعف قوى اليسار، وهو الضعف الذي بلغ ذروته بانهيار دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي. ويترافق مع ازدهار الليبرالية الجديدة هذا، وحتى في البلدان الرأسمالية الأكثر تقدما، انحسار مهم لدور السلطات العامة بدءا بالبرلمان. وتخريب بيئي وتصاعد انعدام المساواة، وتسارع الفقر والبطالة، أي كل ما يمثل نقيض الدولة الحديثة والمواطنية. ونشهد أيضا فصلا جذريا بين تطور تقنيات الإعلام الجديدة من جهة، ومفهوم تقدم المجتمع من جهة أخرى. فالليبرالية الجديدة التي جاءت مع صعود رونالد ريغان إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومارغريت تاتشر في بريطانيا، في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، كانت نتيجتها تعميق الفوارق الطبقية الحادة داخل البلدان الغربية عينها. فهناك اليوم 60 مليون فقير في الولايات المتحدة الأمريكية أغنى بلد في العالم. وكذلك يمكن إحصاء 50 مليون فقير داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، أول قوة تجارية في العالم. في الولايات المتحدة يملك 1% من السكان 39% من خيرات البلاد، وعلى الصعيد العالمي تفوق ثروة 358 شخصا من أصحاب المليارات من الدولارات الدخل السنوي لـ 45% من السكان الأكثر فقرا أي 2.6 مليار نسمة. من هنا دأبت الايديولوجيا اليسارية الجديدة المناهضة للعولمة الرأسمالية المتوحشة، على نعت هذه الليبرالية الجديدة بالتوتاليتارية. لكي نشهد في عالم اليوم قلبا واضحا لمفهوم التوتاليتارية. ولكن قبل أن نغوص في تحليل سمات النظام الرأسمالي العالمي التوتاليتاري، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، علينا أن نميز بين الليبرالية الكلاسيكية الغربية وبين الليبرالية الجديدة المتوحشة التي يتبناها اليمين النيوليبرالي الأمريكي. التي تعبر عنها نازية بوش أفضل تعبير. ما هو جوهر الايديولوجيا الليبرالية؟ ظهرت الأفكار الليبرالية في عصر التنوير وحتى الثورة الصناعية (1750 – 1850)، وهي تشكل منارة مضيئة وعظيمة في تاريخ تطور البشرية. فالليبرالية متناقضة جذريا مع الأيديولوجيا الإقطاعية، أي أنها ضد فكرة الماوراء حين أكدت على موضوعية الطبيعة والمادة. وهي ضد الوحي والميتافيزياء حين أكدت على العقلانية والعلم. وهي ضد الاستبداد حين أكدت على الحرية وهي ضد سحق الفرد وامتصاصه في المجموع، حين أكدت على أولوية الفرد. فقد جاءت الليبرالية كانتصار باهر على النظام الإقطاعي الذي ساد في العصور الوسطى، وهو النظام الذي كان يستند على الاستبداد والعبودية وقهر حرية الفرد وحقوقه وشكل حينذاك بمؤسساته وقيمه وعلاقاته عائقا أمام تطور الرأسمالية في ظهورها. وهكذا فإن الأفكار الليبرالية هذه شكلت منظومة للإيديولوجية متكاملة لليبرالية، التي عبرت عن مرحلة تاريخية محددة، هي مرحلة الرأسمالية الوليدة والصاعدة، وعن اتساق متطلبات تقدم البشرية مع متطلبات صعود الطبقة البرجوازية. ولم يكن من الممكن انتشار الأفكار الليبرالية في مختلف دول القارة الأوروبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية لو لم تكن متفقة إلى أبعد الحدود مع حرية الفرد التي قادته إلى محاربة الاستبداد على الصعيد السياسي، وإلى العقلانية على الصعيد المعرفي، وإلى العلمانية، وتحرير المرأة، والديمقراطية التي تشكل التخطي الديالكتيكي لهذه الليبرالية. وقد ارتدت المبادئ الليبرالية هذه طابع فتوح دائمة للبشرية، رست في أساس المجتمعات الحديثة (حتى إذا تجاوزت الليبرالية). إلا أن حرية المشروع الاقتصادي التي بدت في ظل المجتمع التقليدي، بمنزلة مبدأ عقلاني، يحرر ولا يضطهد. ويطلق قوى الإنتاج، أصبحت فيما بعد تظاهرة لا عقلانية، وأداة للاستغلال ولمزيد من التفاوت الاجتماعي على حد قول ياسين الحافظ في كتابه عن التجربة التاريخية الفيتنامية.أما الليبرالية الجديدة، فقد جاءت بمنهاج جديد لإدارة الرأسمالية في زمن العولمة، وقد كشفت عن عدد من الحقائق أهمها: 1-تتسم العولمة الرأسمالية المتوحشة الحالية باستقطاب الرساميل والتدفقات الاستثمارية، وبالتالي بتركيز الثروة والرأسمال في البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة، خاصة في الولايات المتحدة.2-يزداد إفقار العالم الثالث وتهميشه وتتخذ عمليات نهبه السافرة والمقنعة طابعا همجيا.3- تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا رئيسيا في صياغة هياكل القوة الاقتصادية من خلال قوتها السياسية والعسكرية. ومنذ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها المطلقة على النظام الدولي الجديد في ظل القطبية الأحادية، حاولت أن تصيغ العالم على شاكلتها ومثالها. ونشر سلطتها في العالم الفوضوي الذي وصفه هوبس. والولايات المتحدة لا تثق بالقانون الدولي ولا بالمواثيق الدولية. وهي تنظر إلى تحقيق الأمن. كما الدفاع عن الليبرالية الجديدة. عبر حيازة القوة العسكرية واستخدامها. وهي تزداد ميلا إلى العمل العسكري في شكل أحادي الجانب. وترفض المبادرات أو القرارات التي تتخذ تحت راية مؤسسات دولية على غرار الأمم المتحدة مثلا. وتشك في القانون الدولي وتؤثر العمل خارج نطاقه حين ترى ذلك ضروريا – كما هو الحال في حربها المرتقبة على العراق- أو حتى مفيدا لمصالحها فحسب. ولقد ارتبط صعود الليبرالية الجديدة في الولايات المتحدة وأوروبا منذ الثمانينيات وحتى يومنا هذا بتولي اليمين المتطرف أو اليمين النيوليبرالي مقاليد السلطة. وهو اليمين الذي لا يعبأ مطلقا باعتبارات العدالة الاجتماعية وأهمية التوظيف الكامل في عصر العولمة. يقول اغناسيو رامونيه في كتابه " الجغرافية السياسية للفوضى " إن سادة العالم الجديد، ما عادوا يتمثلون برؤساء الدول ورؤساء الوزارات وزعماء الأحزاب السياسية وقادة التكتلات البرلمانية، بل بمديري الشركات المتعددة الجنسية ورؤساء مجالس الإدارة وأرباب الرأسمال المالي وكبار المضاربين في البورصات والأسواق المالية. وليست الدول هي التي تملي سياساتها على رجال الصناعة والمال، بل هؤلاء هم من يملون على السياسيين السياسة المطلوب تنفيذها.
4523
| 25 سبتمبر 2014
يعتقد العديد من المحللين أن الذي جرى في تونس يوم 14 يناير 2014، لم يكن ثورة، بل هو أقرب إلى «الحالة الثورية» القابلة للتطور والانتكاس، منه إلى الثورة الكبرى التي تفكك بنية النظام القديم بكل مؤسساته، كالثورة الفرنسية أو الروسية أو الصينية، وتبني على أنقاضه نظام ديمقراطي جديد. ومع ذلك،فقد أسقطت الثورة التونسية رأس النظام الديكتاتوري السابق، وحرّرت الشعب التونسي من كابوس الخوف، كما استعاد التونسيون حقهم في تملك الفضاء السياسي العام، فأفرغت السجون من المحكومين السياسيين بمن فيهم الإرهابيون، وعاد المهجرون من منفاهم، وتكرست حرية التعبير وتوافرت مساحات للحرية عبر وسائل الإعلام. بعد أن تعرضت الثورة التونسية ٌلأخطار محددة، أهمها استشراس العنف السياسي، واستهداف المعارضين من قبل الإرهاب التكفيري، شهدت نوعاً من الارتداد والنكوص بفعل استمرار ممارسات تقليدية من جانب الترويكا الحاكمة، فتعثر بناء النظام الديمقراطي الجديد، بسبب العوامل التالية: 1ـ تشبث ائتلاف الترويكا بزعامة حركة النهضة بالسلطة، التي باتت تمارس الاستبداد والفساد والمحافظة على امتيازاتها.2-غياب البديل الثوري للنظام الديكتاتوري السابق، وعدم توافق الجماهير والقوى الوطنية والديمقراطية، والتئامها في كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية.3ـ دور القوى الدولية الكبرى والدول الخليجية الحامية للترويكا الحاكمة،في عدم تجذر الثورة التونسية نحو الديمقراطية.4ـ عدم التوافق القوى التونسية على نظام ديمقراطي بديل، وعجز القوى التي شاركت في الثورة عن التوصل إلى أهداف وطنية جامعة. رغم أن «الثورة التونسية» كانت المفجرة لما يسمى «الربيع العربي»، فإن هذا الأخير أخفق في بناء دول ديمقراطية في البلدان العربية التي سقطت فيها الأنظمة الديكتاتورية، فاختفت التحركات الشعبية، وفعاليات تكوينات المجتمع المدني الحديث، والأحزاب السياسية،وحلّت مكانها التنظيمات الإرهابية الأصولية بوصفها أدوات تنفذ المخطط الإمبريالي الغربي- الصهيوني، والذي يستهدف تفتيت البلدان العربية وتقسيمها وخلق دويلات طائفية، في العراق وسوريا، واليمن،وليبيا، وربما تونس ومصر، ليسلم الكيان الصهيوني ويعطي مبرراً ليكون دولة لليهود. لقد كان الخطاب الديمقراطي في تونس ضبابياً وملتبساً في مقولاته، فالأحزاب السياسية على اختلاف مرجعياتها الفكرية والسياسية لم تركز على طرح أفكار الحرية الدستورية، والعلمانية، والمساواة المواطنية، وحقوق الإنسان والمرأة، حتى لا يسع المرء الا أن يتساءل: ما هي تلك الديمقراطية التي تتحدث عنها الطبقة السياسية التونسية والأحزاب السياسية، ما جوهرها وأسسها ومراميها، وكيف يمكن أن تجمع تحت لوائها كل تلك المتناقضات الايديولوجية والسياسية وكل تلك التوجهات المتنافرة في الأهداف والغايات والمصالح؟ هل يكفي أن يؤمن الجميع بالانتقال السلمي إلى نظام ديمقراطي ولو غير محدد الأهداف والأسس؟ وهل سيلبي هذا النظام حاجات وتطلعات هؤلاء دون الإخلال بالأمن السياسي أو الاجتماعي أو بمصالح كل فريق من الفرقاء؟ كيف ستتأمن في نظام جامع مصالح الأغنياء والفقراء والطوائف والمؤمنين بحقوق الإنسان والمرأة وأولئك الذين لا يعترفون بكل هذه الحقوق؟ تونس تدخل في مرحلة جديدة من خلال الاستحقاق الانتخابي الذي سيجرى يوم 26 أكتوبر المقبل، بعد أن عاشت أكثر من ثلاث سنوات في حالة من الفوضى،حيث اعتقد الإسلام السياسي أن الدولة المدنية والعلمانية والحداثة كمسار حضاري اختارته تونس منذ الاستقلال، فشلت عربياً مقابل الصعود الديني الأصولي، وتفشي الراديكالية الإسلاموية. غير أن الإسلام السياسي الذي اصطدم بقوة شخصية المجتمع المدني الذي دافع ببسالة قل نظيرها من أجل المحافظة على نموذج المجتمع التونسي المنفتح والليبرالي، يتجاهل بشكل واعي: أولاً، أن الدين في تونس ومنذ بدايات حركات الإصلاح التي شهدتها البلاد التونسية في عهد خير الدين باشا،وعلى مدى قرن ونصف القرن انسحب تقريباً من اشتباكاته بمساحات مختلفة من الحياة: التعليم والقانون والتنظيم الاجتماعي والثقافة والسياسة والنماذج المعرفية، مخلياً الطريق للقانون المدني والمدنية والدولة والمؤسسات التعليمية الخاصة؛ ثانياً، منذ بداية بناء الدولة الوطنية الحديثة فجر الاستقلال تراجع الدين إلى الهوامش رغم وجود الحضور الرمزي الرسمي، كما أن وجوده الرسمي قد تمّ قيادته تحت نطاق السيطرة البيروقراطية للدولة، التي في الكثير من الحالات قد تعلمنت؛ ثالثاً، تقلص الخطاب الإصلاحي الإسلامي، وتخبط عمليات الإصلاح السياسي، وتغذية قنوات التطرف، والتفكك الاجتماعي، والركود في مهمة تحديث الدولة التونسية في عهد النظام الديكتاتوري السابق، كل هذه العوامل وغيرها، دفعت الأصولية الإسلامية بالانتقال من المهمش إلى المركز بصرف النظر عن المجتمع التونسي المحدث أو المعلمن. الترويكا التي حكمت تونس طيلة السنوات الثلاث الماضية، وفي القلب منها حركة النهضة، كانت تفتقر إلى الشرعية الثورية، حتى وإن اكتسبت الشرعية الانتخابية في انتخابات 23 أكتوبر 2011،ولهذا اتسمت مرحلة حكمها بالضعف الشديد، ضعف مصدره الافتقار الواضح إلى مشروع مجتمعي يلبي أهداف الثورة التونسية في بناء دولة ديمقراطية تعددية، وتحقيق التنمية المستدامة التي قوامها التوزيع العادل لثمار التنمية، وبناء نموذج اقتصادي يحقق التوازن في التنمية بين المناطق المتقدمة تاريخيا في تونس، والمناطق المحرومة والمهمشة والفقيرة طيلة أكثر من نصف قرن، والتي تنتمي إلى تونس العميقة، ولاهي ضمنت الحريات العامة والخاصة، بل في عهدها تغول الإرهاب، ولا هي احترمت أو استطاعت التعامل مع النموذج المجتمعي التونسي القائم على التعددية الاجتماعية والثقافية، والانفتاح على الحداثة الغربية بكل منطوياتها الفكرية والسياسية والقيمية. يقتضي الخروج الآمن للشعب التونسي، وللوطن التونسي، من مرحلة تغول الإسلام السياسي المترافق مع استيطان الإرهاب التكفيري، وكلاهما ركبا موجة الثورة التونسية السلمية، وصادراها،أن يكون الشعب التونسي حاضراً بقوة في هذه المحطة التاريخية ألا وهي الانتخابات المقبلة (26 أكتوبر 2014)، والتي من المفترض أن تؤسس للمرحلة الجديدة، بتأسيس «العقدالاجتماعي » الجديد للدولة الوطنية المتوافق عليه بين الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية، والذي يقوم على مبدأ الفصل بين السُلط و على مبادئ المواطنة والحريات والحقوق، ومجمّل ما يقع في نطاق منظومة الدولة الوطنية الحديثة (= دولة الحق والقانون) من قواعد حاكمة للاجتماع السياسي،بعد أن أخرجت حركة النهضة طيلة السنوات الثلاث الماضية الدولة الوطنية التونسية عن معناها ككيان جمعي للشعب التونسي (أو الأمة) والوطن، فحوّتلها إلى مجرد سلطة في يد فريق سياسي حزبي يسخّرها لمصلحته. وهو، بهذا المقياس، وضع ما لا حصر له من المشكلات والحوائل دون تقدّمها، ودون تقدّم المجتمع المجتمع التونسي واستقراره. لقد دفع الشعب التونسي غرامات باهظة في سبيل إنجاز ثورته، ومن أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية، لاسيَّما بناء الدولة الديمقراطية التعددية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو في هذه المحطة الانتخابية المقبلة يريد أن يبني دولته الوطنية الديمقراطية ويبعثها من تحت رماد الحرائق، ويتحرر من مرحلة اللادولة العجفاء في عصر الإسلام السياسي، والتي دمرت المجتمع التونسي وشوهت تكوينه. في الثورة التونسية، لم يكن ثمة اجماع على المبادئ المؤسسة للديمقراطية، واولها قبول الآخر المختلف، في حين أن ما جري على الأرض ارتداد إلى أصوليات ظلامية وإرهابية نافية لأبسط المبادئ الليبرالية ومسلماتها. أن تصور اندراج التيارات الأصولية في التغيير الديمقراطي ليس الا وهماً، لأنها تمتلك رؤية إلى المجتمع من منظور شمولي تلغي التناقض والاختلاف، وقد انساقت إليها في أزمان مختلفة التيارات الاشتراكية والقومية كما هو جارٍ الآن مع التيارات الأصولية الإسلامية.
800
| 19 سبتمبر 2014
إن تضاعف الطلب على المواد الغذائية الذي يفرضه النمو الديموغرافي على المستوى الكوني خلال الخمسين سنة المقبلة، ولاسيما في البلدان الأكثر فقرا، طرح على المنتدى الاجتماعي العالمي الذي عقد في عدة عواصم إفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، والذي حمل هموم مطالب المنتجين الأفارقة، ومقترحات خبراء الاقتصاد والتغذية الساعين إلى بلورة مقاربة جديدة لدور الزراعة في التنمية، السؤال التالي: هل سيستطيع نمط الإنتاج الزراعي الحالي تأمين ذلك؟ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما تعلق الأمر بتغذية سكان أوروبا التي دمرتها الحرب، قدم مخطط مارشال قروضا لمساعدة المزارعين بهدف الحصول على البذار، والأسمدة، والماكينات الزراعية، وأسعار مضمونة، وتكوين مجاني لزيادة الإنتاجية.. وسمحت هذه الزراعة الكثيفة في تغذية نمو المدن، كما وفرت الهجرة من الريف اليد العاملة الرخيصة للصناعة.. وكانت المكننة على الأقل، إضافة إلى التحسن الوراثي للبذار، شكلتا هذه المقاربة "للثورة الخضراء" التي انطلقت في الستينيات من القرن الماضي، تحت إشراف البنك الدولي (الذي زاد بنحو %80 من الأموال المخصصة للزراعة خلال سنتين) في الهند أولا، ثم في كل القارات، وكان الأمر يتعلق بتجنب المجاعات المهددة كي لا يرتمي عالم الجنوب في أحضان الاتحاد السوفييتي. وفيما نجحت "الثورة الخضراء" في آسيا وأمريكا اللاتينية، أخفقت في إفريقيا.. فالأزمات المناخية رفعت أسعار كلفة القرض، وطبيعة الأرض جعلت استخدام الأسمدة قليلة المردودية، وحوّل ضعف الدول بوجه خاص الأدوات السياسية العمومية - صناديق الاستقرار، ومكاتب الشراء، ومؤسسات التسليف، والتكوين المهني، ونشر التكنولوجيا - إلى إدارات شرهة وفاسدة في أغلب الأحيان.. وكانت هذه المؤسسات من بين الضحايا الأوائل لسياسة الإصلاح الهيكلي التي فرضها صندوق النقد الدولي في بداية الثمانينات لإنقاذ الدول الإفريقية من الإفلاس. ونتيجة لهذا الوضع مع بداية عقد التسعينيات، كانت زيادة إنتاج المواد الغذائية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بطيئة بالمقارنة مع مناطق أخرى في طور النمو.. ولا سيما أن نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية، كانت هي الأكثر ارتفاعا على المستوى العالمي، بسبب الحروب والنزاعات التي تمزق بلداناً إفريقية عدة.. وما بين عامي 1996 و2005، ارتفع الإنتاج الغذائي في منطقة جنوب الصحراء بنحو6.2% (مقابل 8.3% في مجموع البلدان النامية). ومن أصل مجموع الأراضي المستصلحة للزراعة5.3% كانت مروية (مقابل4.22%)، واستهلاك الأسمدة كان بمعدل 4.13 : كيلوجرام للهكتار الواحد (مقابل (2,115. وبلغ عجز ميزان المواد الغذائية للبلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، أكثر من 900 مليون دولار في عام 2004، بينما حقق ميزان المواد الغذائية فائضا بنحو 55.1 مليار دولار في البرازيل، وما يقارب 10 مليارات دولار للأرجنتين، و7.5مليار دولار لفرنسا، وحوالي 4 مليارات دولار للهند. الدول الإفريقية التي تواجه رفض البلدان الغربية تفكيك الحواجز التجارية التي تحمي مزارعيها من المنافسة العالمية - والتي قادت إلى إلغاء دورة مفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدوحة حول تحرير المبادلات التجارية في يوليو العام 2006 - تحاول إقامة أو تعزيز الحواجز في مداخل أسواقها الزراعية الخاصة بها. واجتمع خمسة عشر بلدا من "الرابطة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية".. وفرضت منذ بداية يناير 2006 تعريفة خارجية مشتركة تتراوح من %5 إلى %20 على الواردات - المعدلات الأكثر ارتفاعا المتعلقة بالمواد الغذائية - مستعيدة آلية مدشنة من قبل البلدان الفرنكوفونية في العام 2000. بيد أن هذه التعريفة تظل ضعيفة جدا، لأن أعضاء "الرابطة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية" ملتزمون بإطار المفاوضات مع دائنيهم، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول تخفيف ديونهم، وفتح أسواقهم. ويرى رئيس شبكة المنظمات غير الحكومية تنسيق الجنوب هنري روييه دورفي بكل أسف "أن هذه البلدان الضعيفة جدا في العالم، هي الأكثر انفتاحا أيضا": زد على ذلك نحن نلاحظ أن حقوق الجمارك تتراوح من %50 إلى %80. لا شك أن هذه المبادرات هي متعاكسة مع حرية التبادل المعظمة من قبل منظمة التجارة العالمية، التي تستهدف مساعدة البلدان الإفريقية على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.. وكان نديوغو فول رئيس شبكة المنظمات الفلاحية والمنتجين لغرب إفريقيا، لاحظ في ديسمبر 2006، "أن الدخول الحقيقي إلى الأسواق التي نبحث عنها، هي أسواقنا الوطنية والإقليمية"، التي تجتاحها منافسة المواد المستوردة بأسعار رخيصة.
653
| 12 سبتمبر 2014
مساحة إعلانية

ليش ما يمديك؟! بينما ممداني زهران، الشاب ذو...
17352
| 11 نوفمبر 2025

العلاقة العضوية بين الحلم الإسرائيلي والحلم الأمريكي تجعل...
9423
| 10 نوفمبر 2025

في عالم تتسابق فيه الدول لجذب رؤوس الأموال...
9378
| 13 نوفمبر 2025

ماذا يعني أن يُفاجأ أولياء أمور بقرار مدارس...
8112
| 11 نوفمبر 2025

على مدى أكثر من ستة عقود، تستثمر الدولة...
3861
| 11 نوفمبر 2025

تستضيف ملاعب أكاديمية أسباير بطولة كأس العالم تحت...
3558
| 11 نوفمبر 2025

تشهد الصالات الرياضية إقبالا متزايدا من الجمهور نظرا...
2118
| 10 نوفمبر 2025

تحليل نفسي لخطاب سمو الأمير الشيخ تميم بن...
1653
| 11 نوفمبر 2025

عندما صنّف المفكر خالد محمد خالد كتابه المثير...
1191
| 09 نوفمبر 2025
يبدو أن البحر المتوسط على موعد جديد مع...
1113
| 12 نوفمبر 2025

شكّلت استضافة دولة قطر المؤتمر العالمي الثاني للتنمية...
1044
| 09 نوفمبر 2025

يحتلّ برّ الوالدين مكانة سامقة في منظومة القيم...
1038
| 14 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية