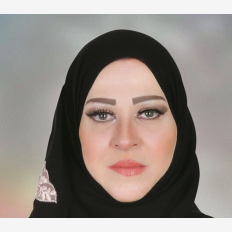رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين نفتح وسائل التواصل، نشاهد عالمين متناقضين ينبضان في اللحظة ذاتها، هناك من يرقص ويغني ويسافر ويتنزه، كأن الدنيا فرشت له أجنحتها، وفي المقابل وجوه مثقلة بالهموم، وأرواح محاصرة بالجوع والحروب والمرض والفقد. في غزة، تحت الحرب والحصار، أناس يقاومون الجوع والبرد والخوف، يبحثون في الركام عن لقمة أو غطاء، أطفال ينامون على الأرض، وأمهات يخبئن دموعهن ليقوين على يوم جديد من القصف. في ليالي غزة المظلمة، حين ينقطع التيار الكهربائي، لا يضيء البيوت سوى نور الشموع الخافتة، وأحيانًا لا شيء سوى ظلمة تتنفس الخوف. أصوات الطائرات في السماء تذكرهم بأن النهار لم يجلب الأمان، وأن الليل قد يحمل ما هو أقسى. في الشوارع، طوابير طويلة أمام شاحنات المياه، أطفال يمدون أيديهم لعلهم يحصلون على قنينة تكفيهم ليوم أو يومين. هناك، تُقاس الحياة بجرعة ماء ورغيف خبز. وفي الجهة الأخرى من الشاشة، عالم مختلف تمامًا: أعراس فاخرة كقصور ألف ليلة وليلة، سيارات فارهة، موائد عامرة بألوان الطعام، فساتين تتلألأ تحت أضواء لا تنطفئ، وكاميرات تلاحق كل لقطة بفخر. مقاطع مصورة لزفاف ضخم، أضواء تملأ السماء، موسيقى تصدح كأنها تنافس أصوات الرياح، وحلويات لا تُحصى. كل شيء يوثق وينشر وكأنه إنجاز يستحق التصفيق. هنا، تُقاس الحياة بطول موكب الزفاف وعدد الأطباق على المائدة. لا أحد يعترض على الفرح… الفرح حق، لكن الإسراف وسط مشاهد الدم والدمار جرح في الضمير. أن تحتفل أمر، وأن تتباهى وسط أنين الجائعين والمشردين أمر آخر. نحن لا نُحاسب على المال الذي ننفقه فقط، بل على الإنسانية التي نفقدها حين نغلق أعيننا عن معاناة الآخرين. قد نبرر لأنفسنا بأن الفرح حق، لكن… هل يحق أن نغرق في البذخ بينما من حولنا يفتقدون أبسط مقومات الحياة؟ الحياة لا تمنحنا العدالة، لكنها تمنحنا الاختيار… أن نعيش بإنسانية، أو نمضي بقلوب مغلقة. الفجوة بين العالمين تجرح القلب، وتتركنا نتساءل: كيف يمكن للحياة أن تجمع بين كل هذا الفرح وكل هذا الألم؟ لكن الحقيقة أن كل إنسان يواجه مصيره بطريقته؛ بعضنا يبتسم رغم الجراح، وبعضنا تغلبه دموعه، وبعضنا يهرب لحظات عبر ضحكة أو صورة جميلة، وآخرون يختبئون خلف صمت طويل. إن أردنا أن نصبح أكثر إنسانية وسط هذا التناقض، علينا أن نرى العالم بعيون غيرنا، لا بعيوننا فقط. لنستمع بتعاطف، ونتشارك بما نستطيع، ولو بكلمة طيبة أو دعاء. لنمد أيدينا لمبادرات صغيرة تصنع فرقًا، ولنكن ممتنين لما نملكه، حذرين من إصدار الأحكام، فربما المبتسم أمامنا يخفي وراء ابتسامته معركة لا نعرفها. ربما لا نستطيع إيقاف الحروب أو إنهاء الجوع، لكن يمكننا أن نختار أن نكون أقل قسوة في فرحنا، وأكثر رحمة في عيشنا. يمكننا أن نخفف من التباهي، وأن نتذكر أن في كل لقمة زائدة أو زهرة إضافية في زفاف، روحًا في مكان ما كانت ستدعو لنا لو وصلتها يد العون. الفرح جميل، لكنه أجمل حين يكون دافئًا، متواضعًا، يترك في القلب ذكرى طيبة لا غصّة. الحياة لا تتوقف لتوزع الحظوظ بعدل، لكنها تمنحنا دائمًا خيارًا صغيرًا: كيف سنعيش اللحظة القادمة؟ نغني رغم الألم، أو نحزن رغم النور… وفي النهاية، نحن من نكتب قصتنا، فإما أن تكون مبللة بالرحمة، أو جافة كحجارة الطريق. وعندما نتذكر أن الفرح يكتمل حين نتقاسمه، وأن الألم يخف حين نحمله معًا، يصبح العالم أكثر دفئًا… حتى وإن بقيت فيه الفجوات.
339
| 12 أغسطس 2025
مر أمامي مشهد على السوشيال ميديا لم أستطع تجاوزه بسهولة. طفلة صغيرة، بالكاد تبلغ الثامنة من عمرها، تحضر حفلة لفنان شهير يغني عن “جرح الحبيب”، وعن الهجر، والألم، والخذلان. لكن اللافت لم يكن فقط حضورها، بل انفعالها… كانت تردد كلمات الأغنية وكأنها عاشتها، تبكي بحرقة، تغمض عينيها، تعيش كل حرف، وكأن قلبها يحمل وجع النساء الناضجات لا براءة الأطفال. توقفت طويلًا عند هذا المشهد، ليس من باب السخرية ولا التعجّب، بل من باب الحزن الصامت. تساءلت… من علّم هذه الطفلة أن تُتْقن لغة الوجع؟ من أدخلها إلى عوالم الكبار قبل أوانها؟ وأين فَرَح الطفولة ودهشتها وبراءتها التي كان يجب أن تملأ ملامحها بدلًا من هذا الألم المستعار؟ نحن لا نتحدث هنا عن طفلة تمثّل مشهدًا، بل عن طفلة تعيش لحظة صدقٍ مزيفٍ في إحساسٍ ليس لها. وهذا ما يوجع أكثر: أننا نرى أطفالنا يكبرون على وجع لم يختبروه، يتقمصون مشاعر لا تخصهم، يُربّون على “أغاني الوجع” بدل أغاني الضحك واللعب. عن الطفولة التي خسرناها قبل أن تبدأ الطفولة لم تعد كما نعرفها. لم تعد هي المساحة التي نحمي فيها الطفل من العالم، بل أصبحت نافذة نفتحها ليطل منها على مشاعر لم ينضج ليحتملها بعد. صرنا نُطرب أطفالنا على لحن الخذلان، ونُدرّبهم على ألفاظ الغرام، ونتركهم يرددون كلمات عن الهجر والحب وكأنهم فهموها، بينما ما زالوا يتلعثمون في جدول الضرب. أين الخطأ؟ ليس في الطفلة، بل في من يحيط بها: • من يراها تبكي ويتباهى بـ”حسّها الفني”، • من يصورها وينشر المقطع بفخر، • من يعتبر تفاعلها نضجًا لا خطرًا. دور الأسرة… حين تغيب البوصلة الطفل مرآة بيئته، ما يشاهده، ما يسمعه، ما يُشجع عليه، هو ما يشكّل وجدانه… لا ما يُكتب في الكتب أو يُقال في المحاضرات. حين تغيب الرقابة الواعية، ويحل محلها الاستعراض، يصبح الطفل مادة للترند لا مشروعًا لإنسان سوي. من المؤلم أن تكون الطفولة مجرد مرحلة نُعجّل في دفنها، أن نرى طفلة تُحاكي خيانة العاشق بدل أن تتعلّم الرسم، أن يُسمح لها أن تنغمس في مشاعر لا تليق بعمرها، بدل أن تُعلَّم كيف تحب الحياة وتثق بالعالم. الوجع المُبكر… أخطر من الوجع الحقيقي الطفل حين يحزن، يحزن بصدق، حتى لو لم يفهم السبب. والمشاعر التي نحفّزه عليها اليوم ستصبح لغته غدًا، فماذا لو أصبحت هذه الطفلة تعتقد أن الحب ألم، وأن الهجر قدر، وأن الحياة كلها “خذلان نغنّيه”؟ نحن لا نحمي أطفالنا إن سمحنا لهم أن “يتقدموا في المشاعر” قبل أن ينضجوا في الفكر. نحن لا نمنحهم الوعي، بل نسرق منهم البراءة، ونستبدلها بما لا يفهمونه ولا يليق بأعمارهم. في الختام… فلنُعِد الطفولة إلى أصحابها أعيدوا الطفولة إلى ضحكتها. دعوها تفرح، ترقص، تخطئ وتتعلم، دعوها تلوّن الشمس والغيوم ولا تفسّر معاني الخذلان والندم. غنّوا لهم أغاني الفرح… لا لوعة الفقد. احكوا لهم عن الخير… لا خيانة القلوب. علموهم كيف يحبون الحياة، لا كيف يحزنون مثل الكبار. الطفولة ليست مرحلة… بل أمانة. فلنحفظها.
324
| 04 أغسطس 2025
كنت أشاهد أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن الزمن الحديث، ويقول إن المبادئ والقيم أصبحت في الحضيض. هذا الكلام أثار اهتمامي، وجعلني أكتب هذا الموضوع لأناقش من خلاله فكرة تغيّر القيم والمبادئ في العصر الحديث، وأوازن بين النقد والتأمل الواعي، فكان العنوان الأنسب لهذا الموضوع: “قيم تحت الرماد: هل فقد العصر الحديث بوصلته الأخلاقية؟” في خضم التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم، من ثورات تكنولوجية إلى تغيّرات اجتماعية جذرية، يجد الإنسان نفسه أمام سؤال جوهري: هل ما نعيشه هو تقدم حقيقي، أم مجرّد تحلُّل تدريجي من القيم التي شكّلت أساس المجتمعات عبر التاريخ؟ إن ما كان بالأمس عيبًا أصبح اليوم شجاعة، وما كان يُعدّ خروجًا عن المألوف صار يُحتفى به كتحرر وانفتاح. فهل هذا التغير نعمة أم نقمة؟ أولًا: التحولات القيمية في العصر الحديث شهدنا خلال العقود الأخيرة تحوّلات عميقة في النظرة إلى الأخلاق والسلوكيات. القيم الأصيلة مثل الحياء، الاحترام، الصدق، والالتزام كانت سابقًا من ركائز المجتمع. أما اليوم، فهناك نوع من التطبيع مع سلوكيات كانت مرفوضة أخلاقيًا واجتماعيًا. وأصبح يُنظر إلى من يتمسك بتلك القيم على أنه “رجعي” أو “غير متطور”، وهذا أمر مؤسف وغير عادل. ثانيًا: منظومة الممنوع والمسموح.. انقلابات صامتة في الماضي، كانت هناك خطوط حمراء تفصل بين المقبول والمرفوض، واضحة المعالم. أما اليوم، ومع انتشار وسائل التواصل والانفتاح العالمي، تلاشت تلك الحدود. أفعال كانت تُعد خروجًا عن الدين أو الأدب أصبحت تُعرض اليوم على أنها “حرية شخصية”، دون ضوابط واضحة. ثالثًا: التمسك بالقيم.. موقف أم تهمة؟ في واقعنا، من يتمسك بالمبادئ يوصف أحيانًا بالجمود أو التخلف. ويتعرض الأفراد لضغوط مجتمعية ليكونوا مثل “القطيع”، مما يجعل التمسك بالقيم موقف مقاومة بدلًا من أن يكون فطرة وسلوكًا طبيعيًا. رابعًا: هل كل تغير سلبي؟ لنكن منصفين لا يمكن إنكار أن بعض التغيرات جاءت لتصحيح مظالم تاريخية، مثل: • حرية التعبير • عدالة اجتماعية • حقوق الإنسان والمرأة • رفض التمييز والطبقية وهذه كلها مكاسب إيجابية لم تكن متاحة في السابق. لكن يجب أن ننتبه أن التمسك بالقيم لا يعني رفض التطور، بل من الممكن أن نحافظ على المبادئ النقية مع الانفتاح الواعي. المشكلة ليست في “التغيير” ذاته، بل في الفراغ القيمي الذي يخلفه إن لم يُضبط ببوصلة أخلاقية. الخاتمة: الزمن الحديث ليس خصمًا، بل وعاء تشكّله اختياراتنا. لسنا مضطرين للتنازل عن القيم لنكون “معاصرين”، كما لسنا مجبرين على رفض كل جديد بحجة الحفاظ على الأصالة. التحدي الحقيقي هو أن نُوازن بين الأصالة والتجدد، وأن نحافظ على ما هو نقيّ فينا وسط زحمة التغيرات. وأخيرًا أقول: “ليس التقدم أن نغير ثيابنا وأفكارنا، بل أن نحفظ ما هو نقيّ فينا وسط العاصفة.”
252
| 28 يوليو 2025
كما عودتكم، عندما يهزني خبر أو موقف أو مقطع يهز القلب ويحرك المشاعر، أجد قلمي يفيض، لا كتابةً فقط، بل فضفضة صادقة من قلبٍ تأثر وتأمل. فضفضتنا اليوم ليست كأي قصة، بل حكاية أمل عالق بين الحياة والموت. ليست هذه مجرد قصة غيبوبة، بل حكاية صبر وأمل وحب لا يشبه أي حب. إنها قصة الأمير الوليد بن خالد بن طلال، “الأمير النائم”، الذي مكث أكثر من 20 عامًا في غيبوبة، ومع ذلك ظل قلب والديه مليئًا بالإيمان بأن ابنهما سيعود يومًا. رحل الأمير، وترك خلفه قلوبًا أنهكها الانتظار، لكنها لم تعرف اليأس أبدًا. قلب أم لا ييأس تخيلوا أمًا تمضي 20 عامًا بجوار سرير ابنها، تمسك بيده، تهمس في أذنه، وتدعوه للعودة. كل يوم كانت تؤمن أن لحظة الفرج قريبة، ترى في كل رمشة بارقة أمل، وفي كل نبض حياة جديدة. لكن توقف الأمل فجأة. كيف لقلبها أن يصدق أن الحلم انتهى؟ أن الدعاء الذي كانت ترفعه صباحًا ومساءً، هذه المرة لم يأتِ بالشفاء، بل بالوداع؟ أبٌ لم يفقد ثقته بالله قال الأطباء: “لا أمل”… فردّ: “ربي كبير”. قالوا: “أبقوا على الأجهزة فقط”. فقال: “إنها حياة، والله قادر أن يُحيي العظام وهي رميم”. تحمّل الشفقة والكلمات المحبطة، لكنه ظل صامدًا، يؤمن، يدعو، ينتظر. واليوم، حين ودّع ابنه، لم يودّع جسدًا فقط، بل حلُمًا عاش لأجله عمرًا كاملًا. رسالة إنسانية خالدة أنا لست أمّه، ولا من دمه، لكنني بكيت عندما سمعت الخبر. كنت أتابع حالته، وأنتظر لحظة تقول: “الحمد لله، الأمير قام”. لكن جاءت النهاية مختلفة. رحل الأمير، لكن قصته بقيت، تلهمنا، توقظ فينا الرجاء، وتذكّرنا أن الحب لا يحتاج مقابلًا. دروس خالدة من الأمير النائم 1. الأمل لا يموت - طالما القلب ينبض، فالأمل باقٍ. 2. الصبر أعظم قوة - والديه قدّما نموذجًا نادرًا في الثبات. 3. الدعاء لا يرتبط بالنتائج - بل هو تعبير عن حب وإيمان عميق. 4. الحب لا يحتاج مقابلًا - حبهم لابنهم لم يتغير رغم الصمت والغيبوبة. 5. الحياة تُقاس بالأثر، لا بالحركة - الأمير ألهم الملايين رغم صمته الطويل. 6. لكل إنسان رسالة، حتى لو لم ينطق بها - وكان رسالته: “لا تيأسوا من رحمة الله” ختامًا… وداعًا أيها الأمير، يا من علمتنا أن الحب لا ينام، وأن الأم لا تيأس، وأن من يعلّق قلبه بالله، لن ينكسر وإن تأخر الفرج. اللهم ارحمه، واربط على قلب أمّه وأبيه، وامنحهم من رضاك ما يخفف ألم هذا الفقد الكبير.
318
| 22 يوليو 2025
مثل ما عودتكم، عندما أشاهد مقطع فيديو يحمل عبرة أو قيمة مجتمعية، أحب أن أشارككم الفضفضة لعلها تلامس القلوب وتوقظ فينا شيئًا من الخير. الفيديو الذي شاهدته هذا الأسبوع كان مؤثرًا جدًا. مجموعة من الأطفال يحاولون مساعدة أشخاص محتاجين (مسن، فقير، عامل نظافة، شخص عاجز). مشاهد بسيطة، لكنها مليئة بالمعنى، ذكرتني أن جبر الخواطر لا يحتاج إلى مال ولا مكانة، بل إلى قلب حي يشعر بغيره. في زمن تسارعت فيه الحياة، وغلبت الماديات على العلاقات، أصبحت القلوب أكثر جفاءً، والمشاعر أكثر تبلدًا. وسط هذا الزحام، يبرز خلقب نبيل قد نغفل عنه رغم عظيم أثره، وهو: جبر الخواطر. ليس مجرد لطف عابر، بل قيمة إنسانية، وسلوك راقٍ، وعبادة قلبية تترك أثرًا لا ينسى في النفوس. ومن هنا، وجب علينا أن نغرس هذا الخلق في نفوس أبنائنا منذ الصغر، ليكبروا وهم يشعرون مع الآخرين، ويقدرون مشاعرهم، ويكونون عونًا لا عبئًا في حياة من حولهم. ما معنى جبر الخواطر؟ جبر الخاطر هو مواساة النفس المكسورة، والوقوف مع من تألم، بكلمة طيبة، أو فعل جميل، أو حتى نظرة حنونة. هو تضميد جرح لا يرى. ودواء لا يباع. وبلسم لا يكلف شيئًا. أمثلة على جبر الخاطر: • بكلمة: لا بأس، أنا بجانبك، أفهم شعورك. • بسلوك: سؤال عن شخص غائب، مشاركة في موقف، مساعدة دون انتظار شكر. لماذا نعلم أبناءنا هذا الخلق؟ 1. ينمي الذكاء العاطفي: الطفل الذي يشعر بالآخرين يصبح أكثر اتزانًا ورحمة. 2. يبني علاقات صحية: من يُجبر الخواطر لا يتنمر ولا يسخر. 3. يُنشئ مجتمعًا راقيًا: الرحمة تنتقل من بيت لحيّ فمجتمع. 4. يغرس القيم الدينية: ديننا العظيم حث على الكلمة الطيبة، ومواساة الآخرين. كيف نعلم أبناءنا جبر الخواطر؟ أولًا: بالقدوة الحسنة • دعه يراك تجبر خاطر عامل، مسن، جار حزين أو طفل يبكي. • عندما تعتذر أو تظهر تعاطفك، فأنت تلقنه درسا عمليا. ثانيًا: بالحديث المباشر • تحدث معه عن أهمية الكلمة الطيبة. • اسأله: ماذا تفعل لو رأيت صديقك حزينا؟ ثالثا: بالمواقف اليومية • شاركه في زيارة مريض. • علمه عبارات مثل: شكرًا، عذرًا، هل أساعدك؟ • شجعه على العطاء والبذل دون مقابل. رابعًا: بالقصص المؤثرة • استخدم قصصًا واقعية أو نبوية، كقصة المرأة التي كانت تبكي على قبر فقابلها النبي ﷺ برحمة وصبر. • وعلمه أن تبسمك في وجه أخيك صدقة كما قال الرسول ﷺ. على ماذا يدل تصرف الأطفال: يدل على مجموعة من القيم العظيمة والمعاني الإنسانية الراقية، سواء كان ذلك نابعًا من تربيتهم أو فطرتهم النقية. فهو يدل على: 1. الفطرة السليمة والنقاء الداخلي الأطفال يولدون بفطرة نقية تميل للرحمة، والعطف، والمساعدة. عندما يبادر الطفل بمساعدة محتاج، فهو يعبر عن هذه الفطرة الإنسانية التي لم تلوثها قسوة الحياة بعد. 2. تعاطف وذكاء عاطفي مبكر هذا التصرف يدل على أن الطفل يشعر بالآخرين، ويفهم احتياجاتهم، ويتألم لألمهم. وهو ما يسمى بـ”الذكاء العاطفي”، وهي مهارة مهمة تبنى منذ الصغر وتؤثر على علاقاته وسلوكياته مستقبلًا. 3. تربية صالحة وغرس قيم إيجابية عندما يساعد الطفل عامل نظافة، أو كبير سن، أو فقير، فغالبًا يكون قد رأى في بيئته (المنزل، المدرسة، المجتمع) قدوة تعلمه الرحمة والاحترام والإنسانية. 4. تحمل للمسؤولية ومبادرة تصرفه يدل على شعوره بالمسؤولية الاجتماعية، وأنه لا يقف موقف المتفرج، بل يبادر بالفعل، حتى وإن كان صغيرًا. 5. نضج أخلاقي وشخصية إيجابية بعض الأطفال يظهرون قدرة مدهشة على التمييز بين الصواب والخطأ، والتصرف بدافع الضمير الحي والنية الطيبة، مما يعكس نضجهم الأخلاقي المبكر. قال رسول الله ﷺ: «من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه». رواه البخاري ومسلم
486
| 16 يوليو 2025
سألت نفسي سؤالا هاما هل نُربي أطفالنا ليكونوا مفكرين أحرارًا، أم مستهلكين يتبعون القطيع؟ وحقيقه اصابني حالة استغراب (وربما استياء) من بعض مظاهر السطحية المنتشرة في المجتمع اليوم، لظاهرة (الهوس الجماعي بالأشياء التافهة أو البسيطة) مثل الوقوف في طوابير طويلة للحصول على دمية أو منتج مؤقت، الاسعار المرتفعه للمنتج. واذا ما ناقشت هذا الهوس من جانب تخصصي بتحليل عدة أبعاد: (اجتماعية، نفسية، اقتصادية، اعلامية) أولًا: التحليل النفسي لماذا ننجذب للتفاهة من وجهة نظر نفسية ؟ الناس بطبيعتهم يبحثون عن الشعور بالانتماء لجماعة. حين ينتشر ترند معين، مثل دمية لابوبو أو منتج معين، يصبح المشاركة فيه شكلاً من أشكال (أنا منكم)، ووسيلة للاندماج مع المحيط، وايضا بسبب ان المنتجات التافهة غالبًا تمنح (متعة فورية) بدون مجهود، في عالم صارت فيه الحياة مرهقة ومليئة بالضغوط. اللعبة، الصورة، أو الترند تعطي جرعة مؤقتة من السعادة، كنوع من الهروب من الواقع. ثانيًا: التحليل الاجتماعي لماذا ننجذب للتفاهة من وجهة نظر اجتماعية ؟ بسبب انحدار في المعايير الثقافية حين يتحول الاهتمام الجماهيري من الفكر، الفن، أو المشاريع المجتمعية إلى منتجات تافهة أو محتوى سطحي، يعكس ذلك تحوّلاً في سلم الأولويات الجماعية. وغالبًا ما يُرافق هذا الانحدار صعود في «ثقافة الشهرة الفارغة». غياب القدوات الحقيقية في ظل غياب الرموز الثقافية والفكرية المؤثرة، أصبح المؤثرون التافهون هم الواجهة الجديدة. هؤلاء يروجون لمنتجات لا قيمة لها على حساب القيم والمحتوى الجاد.الفراغ الاجتماعي حيث ان بعض المجتمعات تعاني من فراغ فكري وعاطفي، يجعل الناس تبحث عن أي شيء يملأ هذا الفراغ، ولو كان بلا معنى. ثالثًا: التحليل الاقتصادي لماذا ننجذب للتفاهة من وجهة نظر اقتصادية ؟ وكيف تستفيد الشركات من هذه الظاهرة؟ في العصر الرقمي، (الاهتمام) صار سلعة تباع وتشترى. الشركات تستخدم استراتيجيات التسويق لجعل منتجها ترندًا، حتى لو كان غير مهم، فقط لجذب الانتباه، لأن الضجة = أرباح ويقوم البعض بترويج أن المنتج محدود أو (لفترة قصيرة فقط). رابعًا: التحليل الإعلامي والسوشال ميديا لماذا ننجذب للتفاهة من وجهة نظر اعلامية ؟ تظهر لعدة اسباب اهمها....وسائل التواصل تجعل من كل حدث بسيط ترندًا، وتضخمه، بينما تتجاهل في كثير من الأحيان المواضيع العميقة والمهمة لأنها لا تحصل على تفاعل كافٍ. النتائج طويلة المدى على جيل اطفالنا: 1. ينشأ جيل يهتم بالشكل لا المضمون، يبحث عن الترفيه لا التعلّم، ويُربّى على الشهرة لا على القيمة. 2. تآكل القيم الثقافية مثل العمل الجاد، القراءة، التفكير النقدي، قد تتراجع مقابل قيم استهلاكية مفرغة. 3. التطبيع مع السطحية فتصبح التفاهة أمرًا طبيعيًا، بل مرغوبًا، ومن يعارضها يُتهم بأنه (معقّد) أو (يأخذ الأمور بجدية زائدة). الخلاصة ظاهرة الاصطفاف خلف ترندات تافهة ليست مجرد (سلوك عابر)، بل مؤشر على تحولات أعمق في الثقافة والقيم والسلوك الاجتماعي. والمطلوب اليوم ليس فقط نقد الظاهرة، بل العمل على فهم أسبابها وتقديم بدائل حقيقية تعيد التوازن بين الترفيه والمعنى. لما نعود أطفالنا على لعبة لابوبو، إحنا ما نشتري لعبة فقط، إحنا نبرمج قيم. فإما أن نُربّي عقلًا ناقدًا يعرف ما يريد، أو نسلمه لموجات التفاهة القادمة بلا مقاومة.
480
| 08 يوليو 2025
لكل زمنٍ حكاية، ولكل جيلٍ ملامح تشبهه، وتفاصيل تشكله. كنا نظن أن ما عشناه سيظل هو الثابت، وأن قيمنا، وعلاقاتنا، وطريقتنا في الحياة ستروى كما هي لأبنائنا من بعدنا. لكننا صحونا لنجد أن الحكاية تغيرت، والملامح تبدلت، وبدأنا نتساءل هل الزمن هو من تغير؟ أم نحن من اختلف؟ أم أن أبناءنا يسيرون في طريق لا يشبهنا؟ الجميع يلاحظ اليوم اختلافًا واضحًا في سلوكيات الجيل الجديد، من حيث المشاركة في شؤون الأسرة، أو تحمل أعباء الحياة، أو حتى الإحساس بالمسؤولية. تغيرت مفاهيم كثيرة لم يعد التعب يرى ضرورة، ولا التضحية واجبا، ولم يعد الانتماء للأسرة كما كان. فهل المشكلة في الزمن الذي أصبح أسرع وأقسى؟ أم في تربيتنا التي لانت مع الوقت؟ أم في أبنائنا الذين نشأوا في ظروف مادية ونفسية مختلفة عنّا؟ بين جيل الأمس وجيل اليوم، مسافة ليست فقط في السنوات، بل في النظرة للأشياء، في اللغة، في الإحساس، وحتى في طريقة الحب والخوف والأحلام وفي طريقة التفكير، والتعبير، والتفاعل مع الحياة. لا أحد مخطئ تمامًا، ولا أحد على صواب مطلق، لكنها فجوة تستحق التأمل، لا الاتهام. وهنا جاء الوقت لكي اجيب على جميع التساؤلات...... هل تغير الزمن… أم نحن تغيرنا… أم أبناؤنا هم من تغيروا؟ هل الزمن تغير؟ نعم، الزمن تغير، الظروف اختلفت، والتقنية تسارعت، والحياة أصبحت مريحة وسريعة. لم تعد هناك فرص كافية للاحتكاك بالحياة القاسية التي كانت تصنع منا أشخاصًا أقوياء. جيل اليوم وُلد في عصر أسهل ماديًا، وأكثر تكنولوجيًا، وأقل احتكاكًا بالتحديات الحياتية اليومية. هل نحن تغيرنا؟ نعم. كآباء وأمهات، أصبحنا نخاف على أبنائنا أكثر مما نربيهم، نسهل حياتهم أكثر مما نعدهم لها. بدافع الحب والخوف، حرمناهم أحيانا من التجارب التي تبنيهم. صار شعارنا... نحن نتحمل لأجلهم بدل أن نقول نعدهم ليكونوا قادرين على التحمل هل أبناؤنا تغيروا؟ نعم، ولكن ليس بالضرورة أنهم أصبحوا أسوأ فقد ولدوا في بيئة مختلفة تمامًا: مدارس أجنبية حديثة. سوشيال ميديا تروج لحياة مثالية زائفة. صحبة تشجع على الراحة والتمرد. أمهات وآباء مشغولين. مال متوفر يساعدهم على مستوى حياة تتمتع بالرفاهية دون الشعور بالاخرين إذًا من المسؤول؟ ليس هناك إجابة واحدة، فالأمر مركب. ما هو الحل؟ • نعطي أبناءنا أدوارًا حقيقية داخل البيت. نشعرهم بأن العطاء جزء من النضج، والتعب جزء من التقدير. نمدحهم عندما يلتزمون، ونحاسبهم عندما يقصّرون. نقلل من الدلال المفرط، ونرفع سقف التوقع والثقة. وأخيرًا حكمة اليوم: الطفل لا يحتاج عالمًا مثاليًا، بل يحتاج أسرة تعده لعالم غير مثالي.
723
| 01 يوليو 2025
مساحة إعلانية

عند الحديث عن التفوق الرياضي، لا يمكن اختزاله...
2139
| 04 فبراير 2026

عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب...
1632
| 08 فبراير 2026

حين وصل الملك فريدريك الثاني الشام سنة 1228م،...
963
| 04 فبراير 2026

امشِ في أحد أحيائنا القديمة التي بقيت على...
744
| 04 فبراير 2026

انطلاقا من حرصها على أمن واستقرار المنطقة وازدهارها،...
645
| 04 فبراير 2026

تعكس الزيارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة العربية...
615
| 05 فبراير 2026

أحيانًا لا نحتاج إلى دراسات أو أرقام لندرك...
597
| 03 فبراير 2026

- تعودنا في هذا الوطن المعطاء عندما تهطل...
546
| 02 فبراير 2026

وجد عشرات الطلاب الجامعيين أنفسهم في مأزق بعد...
519
| 02 فبراير 2026

ليست كل إشكالية في قطاع التدريب ناتجة عن...
486
| 03 فبراير 2026

لم يكن البناء الحضاري في الإسلام مشروعا سياسيا...
447
| 08 فبراير 2026

يُردّد المحللون الاقتصاديون مقولة إن «الأرقام لا تكذب»،...
417
| 03 فبراير 2026
مساحة إعلانية