رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يثير طرح موضوع استخدام المرأة في الإعلان جدالا ونقاشا كبيرين، فمنهم من يرى أن الإعلان هو انعكاس لما هو موجود في المجتمع من سلوك استهلاكي وسلع وتصرفات المرأة في حياتها اليومية ولباسها..إلخ، ويؤكد هذا الفريق أنه إذا استهلكنا السلع التي تأتينا من وراء البحار فلا يوجد هناك مشكل في استهلاك والتعرض للإعلانات التي تروج لهذه السلع، ومنهم من يرى كذلك أنه مادام الجمهور يريد تلك الإعلانات فهو حر في اختيار ما يفضل، فأصحاب هذه الأفكار يرون في الإعلانات التي تخدش الحياء أمرا طبيعيا ولا مفر منه وهو جزء من حياتنا اليومية. هذه الآراء مع الأسف الشديد تنظر إلى الموضوع ببساطة كبيرة وبدون رؤية معمقة لقضية تنتهك القيم والأعراض والنسيج الأخلاقي للمجتمع، فأطروحة "الجمهور عاوز كدا" عارية من المنطق ومن الصواب فأذواق الجمهور تصنعها وسائل الإعلام بمرور الزمن وإذا التزمت وسائل الإعلام باحترام قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه فإنها تخلق أذواقا عالية تتناسب وتتناغم مع قيم المجتمع، لكن إذا تبنت وسائل الإعلام الرداءة بحثا وراء الربح فإنها تغرس أذواقا هابطة عند الجمهور. فوسائل الإعلام مسؤولة اجتماعيا ومطالبة بحماية الجمهور من التلوث الإعلامي والانجراف الثقافي بالتزام المادة الهادفة التي تتناغم مع قيم وأخلاق المجتمع.مع الأسف الشديد المواد الإعلامية والثقافية المعلبة المستوردة وكذلك الإعلانات المستوردة لها قيمها وأفكارها التي قد لا تتناسب كليا مع قيم وأخلاق مجتمعاتنا. ففي البداية يجب أن نعترف أن موضوع استغلال المرأة في الإعلان هو موضوع قيمي بالدرجة الأولى، ففي مجتمعنا العربي الإسلامي نجد أن الدين الحنيف كرم المرأة وأعطاها قيمتها الإنسانية كأم وكزوجة وكأخت وبنت..إلخ. فالمجتمع الذي يحترم المرأة لا يسمح لنفسه أن يستغل جسدها وجمالها لبيع سلعة أو خدمة ما، ويجب التذكير هنا أن في الدول الغربية هناك مئات الآلاف من الجمعيات المناهضة للإعلانات التي تستغل المرأة وتقوم بتشييئها (objectification). وهنا نعود إلى البدايات الأولى للإعلان في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما وظف علماء النفس الغريزة الجنسية للتأثير في السلوك الاستهلاكي للفرد، ومن هنا جاءت فكرة استغلال جسم المرأة ومفاتنها للترويج لأي سلعة سواء تعلق الأمر بقلم أو سيارة أو معجون أسنان أو شامبو أو تعلق الأمر بالرجل أو بالمرأة، فالمهم هنا هو التسويق والبيع بغض النظر عن الإساءة للمرأة ولكرامتها وشخصيتها وجسدها وقيمها وأخلاقها. فتشييء المرأة في الإعلان هو تفريغها من إنسانيتها وكرامتها وهو تناقض صارخ مع الدين الإسلامي والنسيج الأخلاقي في المجتمع. من جهة أخرى يجب أن نعي أن غالبية الإعلانات التي تنتهك حرماتنا في مجالسنا هي إعلانات أُنتجت في الغرب لجمهور في الغرب له قيمه وله نظرته للمرأة. فما يصلح للغرب لا يصلح بالضرورة للشرق كما أن نظرة الغرب للمرأة لا تعني بالضرورة هي نفسها في المجتمعات الأخرى. فالإعلان هو ليس مجرد عملية اتصالية بهدف التأثير في السلوك الاستهلاكي للفرد للإقبال على شراء السلعة. نعم هذا هو الهدف الرئيسي، لكن الإعلان له بعد ثقافي وهو عملية اتصالية تعكس قيم مجتمع معين وثقافته ونمط استهلاكه. فالإعلان الذي تنتجه شركة معينة للترويج عن سلعة معينة في بلد معين هو منتج هذا المجتمع يعكس قيمه ونظرته لأشياء مختلفة في المجتمع. هذا يعني أنه عندما نقوم بدبلجة إعلان وتقديمه للجمهور في مجتمعنا الإسلامي أننا ضحينا بكل شيء وسلمنا أنفسنا لثقافة الآخر ولقيمه ولنظرته للأمور ومن أهمها نظرته للمرأة. والأخطر من كل هذا أن حتى وكالات الإعلان والشركات المحلية التي تنتج الإعلانات في الوطن العربي أصبحت تتبنى نفس الطرق والوسائل والقيم والاستراتيجيات المتبعة في الإعلانات الغربية. فأصبح الكل يلجأ إلى المرأة كالمحور الأساسي في الرسالة الإعلانية للوصول إلى المستهلك والتأثير في سلوكه، وخطورة الموضوع هنا تكمن في أننا قمنا بتبني قيم الآخر في التعامل مع الإعلان واستغلال جسد المرأة في تحقيق الهدف والتأثير في السلوك الاستهلاكي للفرد، وهنا نتساءل أين هو الضمير المهني والأخلاقي عند الشركات التي تقبل على دفع أموال طائلة للمؤسسات الإعلامية لنشر وبث هذه الإعلانات الخادشة للحياء؟ وأين مسؤولية الوكالات والشركات المنتجة للإعلانات في منطقتنا العربية؟ فالتقليد الأعمى والجري وراء الربح أصبح هو هاجس المعلن والشركة المنتجة للإعلان والمؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها التي تصهر على بث ونشر هذه الإعلانات، بل تتنافس فيما بينها للحصول على أكبر حجم من الإعلانات. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هو هل بإمكاننا الإعلان عن سلعة دون استخدام المرأة؟ وهل بإمكاننا رفض الإعلانات التي تتعارض مع قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا؟ والجواب بطبيعة الحال هو نعم إذا كانت هناك رغبة وإرادة لاحترام المرأة بالدرجة الأولى والمجتمع بالدرجة الثانية، وهنا نلاحظ غياب جمعيات مهنية تعنى بالإعلان وتضع أطرا منهجية وتنظيمية لضمان جودته واحترامه لقيم المجتمع ونسيجه الأخلاقي. من جهة أخرى يجب على المجتمع المدني أن يلعب الدور المنوط به والمتمثل في حماية قيم المجتمع ومبادئه، فالمشكل هو الانجراف الذي يعاني منه المجتمع على مختلف الأصعدة، فهناك تبعية كبيرة جدا في المجال الإعلامي ونلاحظ أن نسبة كبيرة تفوق 80% من محتوى وسائل الإعلام العربية مستورد ومعلب وبطبيعة الحال يحمل في طياته قيم وأفكار البلد المنتج. فالإعلان هو الشكل الثاني أو الوسيلة الثانية للانجراف والتبعية. وتأتي اللغة في الدرجة الثالثة حيث نلاحظ تبعية أخرى لا تقل خطورة عن سابقتيها –الإعلام والإعلان- فالبعض لا ينظر للمسلسل أو الفيلم أو التحليل الإخباري أو الإعلان إلا من منظور الشكل فقط وليس المضمون. وحقيقة الأمر أن هذه الرسائل كلها عبارة عن سياسة وفكر وأيديولوجية وقيم وأنماط حياة. والمنطق يقول إن لكل مجتمع أطره الفكرية والأيديولوجية والقيمية ومن هنا ضرورة التعامل مع هذه المنتجات سواء كانت أخبارا أو أفلاما أو إعلانات بحذر وحيطة. فالتلوث الثقافي الذي يسود العالم هذه الأيام خاصة في عصر تكنولوجية الاتصال وثورة المعلومات يجب أن ينظر له بتأن وبحذر ويجب الوقوف عند كيفية التعامل معه وما هي البدائل لتجنب الانجراف الثقافي والقيمي والحضاري، والحل الأمثل بطبيعة الحال هو الإنتاج وصناعة المعرفة وتقديم البديل المحلي الوطني الذي يعكس قيم المجتمع وتقاليده وتراثه ونسيجه الأخلاقي. فمن المستحيل أن ننتظر من الآخر أن ينتج لنا فيلما أو إعلانا أو مسلسلا يعكس قيم مجتمعنا ويحترم المرأة ونسيجنا الأخلاقي. فالمنتج الفكري يحمل أفكارا على عكس المنتج المادي الذي يكون في معظم الأحيان مجرد سلعة (شامبو-كمبيوتر، قلم). متى إذن سنرى جهودا ومساعي لوضع حد للإعلانات التي تتعدى على كرامة المرأة، هذه المرأة التي قد تكون الأم أو الزوجة أو البنت أو الأخت.
8764
| 22 نوفمبر 2014
ما هي الفرص التي يقدمها الإعلام الجديد للحوار مع الآخر ونشر الثقافة الإسلامية في عصر تهيمن عليه الصناعات الثقافية والإعلامية الغربية من خلال شركات عابرة للقارات عملاقة وضخمة تتوفر على إمكانيات هائلة وموازنات ضخمة جدا؟ ما هي الفرص المتوفرة أمام المسلمين لاستغلال الإعلام الجديد وخاصة الإنترنت للقيام بالدعوة والتعريف بالإسلام والرد على الصور النمطية والتشويه والتضليل والحملات الدعائية المغرضة؟ هل وظف المسلمون الإمكانيات والوسائل التي يوفرها الإعلام الجديد والبيئة الرقمية لنشر الثقافة الإسلامية؟ فللشبكة العنكبوتية ميزات عديدة تؤهلها للعب أدوار محورية للتحاور مع الآخر ونقل التراث الثقافي والحضاري للعرب والمسلمين للآخر. ما هو وضع الثقافة الإسلامية في ظل العولمة وما هي خصائص المجتمع الرقمي؟ إلى أي مدى عولمت تكنولوجيا الاتصال الجديدة الثقافة وجعلتها أحادية البعد؟ ما هي الفرص المتوفرة لنشر الثقافة الإسلامية في عصر توفرت فيه الوسيلة للجمهور ليكون مستقلا ومرسلا في آن واحد؟ وما هي التحديات التي تواجهها هذه العملية في عصر تحكمه القوى العظمى وتسيطر على صناعة الصورة فيه الشركات الإعلامية والثقافية المتعددة الجنسيات؟ ما هي آليات وسبل نشر الثقافة الإسلامية في العصر الرقمي حيث ضرورة اعتماد لغة العصر وثقافة الحوار والتواصل بين الحضارات وتوفير الإمكانيات والموازنات الضرورية بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة لإيصال الثقافة الإسلامية إلى المنابر العالمية؟. إن إشكالية نشر الثقافة الإسلامية في العصر الرقمي تتمحور حول الاستغلال الأمثل للوسائل والإمكانيات المتاحة من تكنولوجيات حديثة لوسائل الاتصال ومن وسائط متعددة، فالحضور الثقافي على المستوى الدولي بحاجة إلى مجهودات كبيرة منسقة ومنظمة تخاطب الآخر بلغة العصر وبمنهجية وبعلمية وبمنطق حتى تحقق المبتغى منها، فالمشاركة في التراث الثقافي العالمي يحتاج إلى إنتاج فكري وعلمي ويحتاج إلى جودة ونوعية تستطيع أن تنافس ما هو موجود على الساحة العالمية. مما يعني أن هناك تحديات جسيمة وكبيرة جدا تنتظر العالم الإسلامي في مسعاه لنشر الثقافة الإسلامية. ومن بين أهم هذه التحديات سيطرة "الذين يملكون" على صناعة الثقافة العالمية وكذلك أحادية الثقافة العالمية وهيمنة الشمال على الجنوب. من جهة أخرى يجب الحذر والاحتياط عند الكلام عن الانترنت وتكنولوجيات وسائل الاتصال حيث إن هناك جوانب سلبية ومشكلات عديدة تشوب هذه الوسائل التي تعتبر سلاحا ذا حدين. وتتمثل آليات توظيف الإعلام الجديد في نشر الثقافة الإسلامية فيما يلي:* تشكيل لجان أو هيئات إسلامية عالمية بتمويل من المنظمات الإسلامية العالمية لخدمة الإسلام ونشر الثقافة الإسلامية والرد على أعداء الإسلام عن طريق الإنترنت.* الاهتمام بالإنترنت باعتبارها تقنية اتصال حديثة مهمة وضرورية في هذا العصر، وتوجيهها واستغلالها في خدمة الإسلام والمسلمين وفي نشر الثقافة الإسلامية عبر المعمورة.* التنسيق والتكامل بين جهود الهيئات والمنظمات الإسلامية العاملة داخل العالم الإسلامي وخارجه لتصحيح صورة الإسلام ونشر الثقافة الإسلامية عبر شبكة الإنترنت.* التنسيق بين المؤسسات العلمية والدينية في جميع الدول العربية والإسلامية عبر مواقع الإنترنت لتجنب التضارب والتناقض في الخطاب وفي رسالة الإسلام.* الاتفاق على موقف موحد بين جميع المسلمين أفراداً وجماعات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية وغير حكومية إزاء القضايا الإنسانية العالمية بهدف تقديم رؤية واضحة ومبسطة وواحدة تجاه هذه القضايا، خاصة أن هناك العديد من التضارب والاختلاف حول العديد من المسائل الجوهرية في الإسلام مثل ما تبثه بعض الفرق الضالة وبعض المؤسسات الإسلامية في الغرب تفتقر إلى المعرفة الدينية الصحيحة التي تتمتع بها المؤسسات والمرجعيات الإسلامية ذات المصداقية والصرامة العلمية والالتزام.* الاستفادة من الخبرات والطاقات الإسلامية المتوفرة في مجال تكنولوجيات وسائل الاتصال والعمل الإعلامي والثقافي والفكري والعلمي والمعرفي من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بهدف وضع استراتيجيات ناجعة للوصول إلى الآخر بأسلوب حضاري وعلمي ومنهجي يتماشى مع متطلبات العصر لخدمة العلم والأخلاق والفضيلة وخدمة الثقافة النافعة والفكر الصحيح وبناء الحضارة ونشر المعرفة.* نشر مبادئ الإسلام وإظهار العقيدة الصحيحة والثقافة الإسلامية بصورة علمية مبسطة وواضحة، وشرح الشريعة الإسلامية بمختلف جوانبها، وإبراز عظمة هذه الشريعة وواقعيتها في معالجة مشكلات الحياة والمجتمع المختلفة، وبيان أن الأخلاق الإسلامية هي الأسلوب الحضاري الواقعي الصحيح للتعامل بين الناس.* التركيز على البحث العلمي وصناعة المعرفة والمشاركة في التراث العلمي العالمي بهدف تسجيل حضور إيجابي وفعال للثقافة الإسلامية في جميع أنحاء العالم من خلال المنافذ الإعلامية والثقافية العالمية الفاعلة والمنتشرة والمسيطرة والمهيمنة في العالم. * بذل الجهود الممكنة لاتخاذ كل التدابير الناجحة وبالوسائل التقنية المتاحة والمبتكرة للحيلولة دون وصول البرامج والملفات والمعروضات الفاسدة والإباحية التي تروج للانحراف والفجور، إلى المشتركين بالشبكة سواء في حدود الاستخدام الشخصي أو على نطاق عام بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع الهيئات العالمية لتحقيق هذا الهدف.* الاهتمام بوضع استراتيجيات وخطط عمل مدروسة ومنهجية بهدف تقديم صورة عن الثقافة الإسلامية والإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية بأسلوب علمي ومنهجي وترد على أعداء الإسلام وعلى التشويه والتضليل والصور النمطية التي تُدبر وتٌحاك من قبل المتلاعبين بالعقول وصناع الرأي العام من خلال الصناعات الثقافية والإعلامية العالمية العملاقة. في عالم متعولم تسيطر عليه الصناعات الثقافية والإعلامية الغربية بات من الضروري والحتمي أن تفكر الأمة الإسلامية في استغلال الإعلام الجديد وتكنولوجيا الاتصال الجديدة للتثاقف مع الآخر ونشر الثقافة الإسلامية في ربوع العالم وعبر الوسائل التي تستحوذ على أوقات المشاهدة والاستماع والقراءة ومختلف أشكال التواصل عند الإنسان. ويعتبر الانترنت من أهم الوسائل التي تساعد على دخول الكونية والعالمية والتخاطب والتواصل مع البشرية جمعاء لما تتوفر عليها الشبكة العنكبوتية من مميزات وخصائص كاللامكان واللازمان والتفاعلية وقلة التكاليف وتنوع التطبيقات وسهولة الاستخدام. فالانترنت اليوم، أصبح بدون منازع وسيلة العصر في زمن أصبحت فيه الوسيلة هي الرسالة، لكن التعامل مع الانترنت يتطلب كذلك مهنية وحرفية ومنهجية وتنسيق للجهود حتى يتم تحقيق الأهداف المنشودة. فنشر الثقافة الإسلامية يتطلب التحكم في لغة وثقافة العصر والتنسيق والتكامل من أجل نشر الثقافة الإسلامية وتوحيد الجهود والرد على أعداء الإسلام والتحلي بثقافة الحوار والتواصل بين الحضارات وكذلك الاستثمار في التنمية الثقافية وصناعة العلم والمعرفة وتوفير الوسائل والإمكانيات والموازنات اللازمة التي تحقيق الأهداف المنشودة، لقد حان الوقت لوضع إستراتيجية واضحة المعالم لتوظيف واستغلال تكنولوجيا الاتصال والإعلام الجديد لخدمة قضايا الإسلام وقضايا الأمة وكسب معركة الصورة والرأي العام.
10462
| 15 نوفمبر 2014
السؤال الجوهري عند الكلام عن التعليم العالي في الوطن العربي هو ماذا تريد الدول العربية من التعليم العالي والبحث العلمي؟ هل الهدف هو تلقين المعلومات وتخريج عشرات الآلاف من الطلاب بغض النظر عن نوعية تكوينهم وعن احتياجات السوق، أم أن الغرض هو أكثر من ذلك، حيث يشمل كذلك صناعة المعرفة والمساهمة في حل المشاكل المختلفة للمجتمع. الفرق بين الجامعة البحثية والجامعة التدريسية هو أن الجامعة البحثية تتوفر على برامج الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا وعلى مراكز البحوث والدراسات وعلى ميزانيات بحث تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بل المليارات في بعض الجامعات العريقة والمتميزة في العالم. هذه الجامعات هي التي تفرز عادة كبار السياسيين والرؤساء ورجال الأعمال والفائزين بجوائز نوبل وغيرها من الجوائز العالمية. هذه الجامعات تتفاعل كذلك مع شركات عملاقة لتقوم بإنجاز مشاريع بحثية لحسابها في تطوير منتجاتها ومشاريعها المختلفة. ومن هنا نستنتج أن الكلام عن صناعة المعرفة في الجامعات العربية هو في غير محله وغير منطقي. فميزانية البحث العلمي في أعرق وأكبر جامعة عربية لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات وإذا غابت الوسائل والإمكانات ومستلزمات صناعة المعرفة فالكلام عن البحث العلمي وإنتاج المعرفة يبقى دون معنى. الكلام عن التعليم العالي والبحث العلمي يقودنا لفتح ملف التعليم الأساسي النظامي، حيث إن هذا الأخير يعاني من مشاكل لا تحصى ولا تعد، كالحشو والكم على حساب النوع، إضافة إلى التقليد والتلقين والتركيز على الحفظ بدلا من تنمية الفهم والتطبيق في الواقع وتنمية ذكاء الطفل ومهاراته. فالتلميذ بعد إنهائه الثانوية العامة يصل إلى الجامعة وهو لا يتحكم في لغته الأم بطريقة جيدة ولا باللغة الأجنبية. كما أنه يفتقر إلى أدنى مقومات التفكير التحليلي والتفكير النقدي. وفي هذه الحالة تواجه الجامعة مشكلات عويصة في التعامل مع هذه النوعية من الطلاب خاصة أولئك الذين يتابعون دراستهم باللغة الأجنبية. والحصيلة تكون في غالب الأحيان أن يفشل الطالب في الحصول على المعدل المطلوب في اللغة الأجنبية، فيضطر إلى تغيير التخصص وبذلك يضيّع سنة أو سنتين وفي الأخير لا يدرس التخصص الذي أراده في المقام الأول. والمشكلة التي يواجهها التعليم العالي في الوطن العربي هي ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم العام وهذا ما يؤدي إلى مشكلات عويصة تتعلق بتأقلم طالب الثانوية العامة مع البيئة الجديدة في الجامعة التي تختلف تماما عن الحياة المدرسة. ومن التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم العالي في الوطن العربي عملية التمويل، فالقطاع الخاص ينظر إلى الاستثمار في التعليم العالي من زاوية تجارية محضة، أي منطق الربح بغض النظر عن متغيرات هامة، كالجودة وتمويل البحث العلمي ورعاية المتميزين والمتفوقين، أما الدولة ومع تزايد الأعداد الهائلة من الطلاب المقبلين على الجامعة فإنها إما أنها تتنصل من دورها وتترك المجال للقطاع الخاص وإما أنها تتكفل بالموضوع دون احترام معايير الجودة الشاملة والنوعية، فالتعليم العالي أصبح يكلف الكثير، خاصة إذا تمت مراعاة الجودة والنوعية. فما تخصصه الدول العربية للإنفاق على التسلح يفوق بكثير ما يُخصص للتربية والتعليم والبحث العلمي، وما تخصصه الدول العربية قاطبة للبحث العلمي لا يتعدى الملياري دولار، وهو في حدود ما تخصصه جامعة هارفارد ومشيجان الأمريكيتان للبحث العلمي. وهذا دليل آخر على أن الكلام على صناعة المعرفة يتطلب الكلام على شروط ومستلزمات هذه الصناعة، فالبحث العلمي يتطلب إمكانات مادية معتبرة، وباحثين وعلماء في مستوى عال وإدارة رشيدة وفعالة وإستراتيجية واضحة المعالم وصناعات ومشاريع تنموية تتفاعل مع المشاريع البحثية وتمولها وتستخدمها في تطوير الأداء والنتائج وأهم من كل ما تقدم بيئة بحثية ومجتمع يقّدر العلم والمعرفة والبحث العلمي. في الوطن العربي نلاحظ أن بعض هذه المعطيات غير متوفرة وإذا توفرت فالمشكل يكمن في التخطيط والإدارة والتنسيق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البحث العلمي هو ثقافة وسلوك وحضارة يجب أن يؤمن به المجتمع بمختلف شرائحه، خاصة صانع القرار. وهنا نلاحظ تناقضا آخر، وهو الفجوة التي توجد بين صناعة القرار والبحث العلمي في الوطن العربي. من المشاكل التي تعاني منها الجامعات العربية كذلك هجرة العقول، حيث إن المتفوقين والمتميزين من الخريجين من الجامعات العربية يحصلون عادة على منح لمتابعة دراساتهم في الجامعات الغربية، فيلتحقون بها وفي غالب الأحيان يتفوقون ويحصلون على منح أخرى وامتيازات، وفي آخر المطاف يستقرون في تلك الدول، نظرا لتوفر شروط البحث العلمي والمنافسة والجودة والتميز والتفوق، الأمر الذي لا يتوفر في البلد الأم. الأمر الذي يجعلهم يقررون البقاء في الغرب وهكذا تخسر الدول العربية مئات، بل الآلاف من أحسن باحثيها وعلمائها ومفكريها في كل سنة، فالدول العربية تزرع ونظيراتها في الغرب تحصد. وهذا النزيف يعتبر خسارة كبيرة جدا، لأن الدول العربية تخسر النخبة المتخرجة من جامعاتها وهذه النخبة هي التي من المفترض أن تقود الإبداع والابتكار والاختراع وصناعة المعرفة. التحدي الآخر الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي هو الفجوة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل، ونلاحظ هنا أن نسبة البطالة في العالم العربي تقدر بـ15% وهذا يعني أن هناك آلاف الخريجين ينهون دراستهم الجامعية ويجدون أنفسهم دون عمل وأن البعض يعمل في وظائف بعيدة كل البعد عما درس في الجامعة وعن مستوى تأهيله. وهذا يعطي انطباعا عاما بأن التعليم الجامعي لا جدوى من ورائه ويفضل الشباب التوجه نحو التعليم المهني أو العمل في سن مبكرة أو الهجرة...إلخ. ومن المشكلات التي يواجهها التعليم العالي في الوطن العربي التبعية والتقليد ومشكلة الازدواجية اللغوية والهوية، حيث إنه في غياب إنتاج المعرفة والإنتاج العلمي تعتمد الجامعات العربية على ما ينتجه الآخر وفق معاييره وقيمه ومبادئه وأهدافه. فالاعتماد على الآخر وثقافة الاستهلاك والتقليد عوامل تؤدي إلى التبعية وذوبان الهوية الوطنية والثقافة الوطنية في طوفان العولمة التي لا ترحم. إصلاح واقع التعليم العالي والبحث العلمي وصناعة المعرفة في الوطن العربي يحتاج إلى إجراءات تنظيمية وهيكلية ومعرفية جذرية، تتمثل في تغيير الذهنية وتطوير الإدارة وزيادة الميزانية بنسب عالية وإشراك القطاع الخاص في التمويل. يجب كذلك التنسيق المنهجي والمنظم بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وكذلك التنسيق مع سوق العمل والقيام بدراسات وبحوث واستطلاعات دورية لتحديد الاحتياجات ووضع الإستراتيجيات للاستجابة لها.
4492
| 09 نوفمبر 2014
شاءت الصدف أن أكون في تونس قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، كان الوضع عاديا وكانت هناك حملة انتخابية في المحطات التلفزيونية الرسمية حيث كان يتداول على الشاشة رؤساء القوائم وكبار المرشحين لتقديم برنامجهم وتسويق مشاريعهم، أما بالنسبة للتسويق السياسي والإعلانات في الجرائد والمحطات الإذاعية والتلفزيونية وعبر الملصقات وغيرها فأخبرني محدثي أنه تم منع التسويق السياسي وكل أنواع إعلانات السياسية وعندما استفسرت عن السر في ذلك قال لي:"حتى لا يتسرب المال الفاسد إلى السياسة"، القراءة الأولية لانتخابات تونس تشير إلى النضج السياسي في هذا البلد الذي أصبح قدوة للانتقال الديمقراطي بعيدا عن العنف والفوضى والإقصاء، بل عمل بثقافة التناوب على السلطة والابتعاد عن أي نوع من العنف والخروج عن إطار إتيكيت العملية السياسية. تونس برهنت للعالم أنها مختبر ناجح للانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي والعالم الثالث، أكدت تونس ذلك عبر نجاحها في تنظيم انتخابات 26 أكتوبر التشريعية، ما أهلها منذ اليوم الأول للاقتراع، إلى نيل "إعجاب" كبار الفاعلين في العالم، فخلال 3 سنوات من المرحلة الانتقالية، تمكن التونسيون من تجنب الانزلاقات نحو العنف والفوضى والسطو على إرادة الشعب، ما جعل التونسيين يشعرون بالفخر والرضا، لأن الانتخابات البرلمانية جرت في هدوء واتزان وتحكم في النفس ودون وقوع حوادث شغب أو عنف، فضلا عن نسبة مشاركة جيدة ونتائج قبلت بها جميع الأطراف، رغم أنها أدخلت تغييرا جوهريا في موازين القوى السياسية بعد أن فقد "حزب النهضة"، الذي كان قد حاز على أغلبية مقاعد التأسيسي عام 2011، هذه الأسبقية لصالح خصمه السياسي المباشر، حزب نداء تونس. فالمشاركة في العملية الانتخابية بلغت نسبة 62% وهذه نسبة معقولة جدا تشير إلى الاهتمام بالفعل السياسي وبالمشاركة السياسية. أمر إيجابي عندما تشاهد طوابير منذ الصباح الباكر للقيام بالواجب الانتخابي، وهنا نلاحظ أن الشباب مع الأسف الشديد انسحب من هذه العملية وعبر عن عزوفه بلا مبالاة كبيرة حيث إنه يرى أن أحلامه لم تتحقق بعد. فالبطالة مازالت كما هي أما الأسعار فإنها ارتفعت والمعيشة أصبحت غالية. قد يتساءل سائل ويقول لماذا نجحت تجربة الياسمين وفشل الربيع المصري والليبي واليمني؟ ولماذا فشلت تجربة الجزائر قبل ربع قرن؟ بكل بساطة نجاح تونس يعود بالدرجة الأولى إلى عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية والتزامها مكانها الطبيعي وهو الثكنة العسكرية ودورها الطبيعي وهو حماية السيادة والإقليم والشعب، فالعسكر هو الذي ضرب عرض الحائط مقومات الديمقراطية والتناوب على السلطة واحترام الرأي والرأي الآخر في دول مثل مصر وليبيا والجزائر. النضج السياسي في تونس جعل راشد الغنوشي، رئيس حزب "النهضة" وقبل ظهور النتائج النهائية يبارك النجاح والفوز لباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس". هذا السلوك الحضاري ينم عن ثقافة وعن ممارسة أخلاقية ناضجة ومتفهمة لاختيار الشعب وقناعاته. فعلى عكس هذا السلوك الحضاري نلاحظ الانقلاب الأبيض على الرئيس مرسي في مصر وإلغاء الانتخابات التشريعية في الجزائر سنة 1991. وهذا يعني أن المؤسسة العسكرية في كلا البلدين قامت بالسطو على إرادة الشعب وفرضت إرادتها وهذا بطبيعة الحال لا يكتب له النجاح وتكون النتائج وخيمة، الأمر الذي أدى إلى عشرية سوداء في الجزائر جاءت على الأخضر واليابس راح ضحيتها 200ألف نسمة ومئات من المليارات من الدولارات. في مصر قسم العسكر البلاد إلى قسمين وفتح الباب على مصراعيه للثورة وللثورة المضادة والفتنة والأعمال الإرهابية والإقصاء والتهميش. فالديمقراطية هي سلوك حضاري بالدرجة الأولى يعتمد على قبول الربح والخسارة وعلى احترام الآخر واحترام وجهات نظره وأطروحاته، فالفضاء السياسي التونسي يحتوي على العلماني وعلى الإسلامي وعلى الوسط واليسار...إلخ، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عندما نتكلم عن الممارسة السياسية والفعل السياسي وصناعة القرار في تونس، فعندما يكون رئيس الحزب الحاكم مستعد لإشراك الفرقاء السياسيين في الحكم هذا يعني أن هناك إيمان راسخ بالعمل مع الآخر من أجل بناء البلاد، وهنا نلاحظ أن الجميع كان ينادي بأن تونس هي فوق كل اعتبار، كسبت تونس الرهان وبرهنت للعالم أنها قادرة على ضم كل الأطياف السياسية في الفضاء السياسي الواحد من علمانيين وإسلاميين لبناء تونس ما بعد الثورة، فالأهم الآن هو الرجوع إلى مطالب الثورة وإلى شباب سيدي بوزيد لتوفير مناصب الشغل والحياة الكريمة للشعب التونسي في جو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. فحزب نداء تونس بحاجة إلى استخدام كل القوى السياسية في الفضاء السياسي التونسي للخروج إلى بر الآمان. فالشارع التونسي اليوم يشتكي من غلاء المعيشة ومن البطالة ومن تدفق مئات الآلاف من الليبيين إلى تونس ومن أخطار عديدة بسبب تدفق الأسلحة من عدة جبهات ومن الدول المجاورة خاصة ليبيا، فالتحديات كبيرة وما ينتظر تونس أكبر بكثير من كسب رهانات الانتخابات التشريعية، ببلوغها طور التناوب على السلطة، ودخولها مرحلة جديدة قائمة على قطبين سياسيين، فإن مستقبل تونس يرتبط اليوم، وبشكل وثيق، بقدرة القوتين المهيمنتين على الفضاء السياسي في البلاد، "نداء تونس" و"النهضة"، بقبول بعضهما البعض والعمل من أجل تونس لا غير وليس المصالح الضيقة لجهات معينة، فالشعب التونسي برهن على نضجه وقام بدوره بكل مسؤولية حيث تجنب الفوضى والعنف والشغب وأستطاع أن يتجنب فوضى كانت قادرة على أن تعصف بجميع الأحلام في فترة ما بعد الثورة، فمثلما نجح من قبل في انتخاب مجلس تأسيسي قام بإصدار دستور جديد للبلاد، هاهو اليوم ينخرط في مرحلة جديدة تتميز بالتناوب الديمقراطي السلمي على السلطة، تناوب هو الأول من نوعه في بلدان "الثورات العربية". ستكون المرحلة القادمة بالنسبة لحركة النهضة بمثابة الاختبار، فهي مطالبة بالتعلم من الأخطاء وإدراك التحديات الكبيرة التي ستواجهها سواء بالحفاظ على قاعدتها أو العمل مع قوى سياسية قد تختلف معها في الرؤى والأيديولوجية، الأهم أن الفضاء السياسي في تونس يتسع للجميع والمهم هو الميدان والانتقال بتونس من عهد بن علي، عهد الفساد والتسلط وإهدار المال العام إلى عهد جديد تسوده الشفافية والديمقراطية والتعددية، فبالانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر القادم ستكمل تونس مشروعها الديمقراطي وبناء مؤسساتها الدستورية ويبقى على الجميع العمل في الميدان، فالشارع لا يؤمن بالشعارات والوعود والمشاريع والبرامج بل يؤمن بالميدان وبالنتائج وبما سيتحقق من استجابة لمطالبه وحل مشاكله.
1008
| 01 نوفمبر 2014
شهد النصف الأول من القرن العشرين حدثين هامين أثرا تأثيرا بالغا في طبيعة الصراع حتى يومنا هذا، حربين عالميتين أشعلتا وأججتا أحلام ورغبات الوطنيين وحطمتا شرعية الحكومات والنظام الدولي. شهد القرن الماضي تصاعد الوطنية عبر العالم، حيث أصبحت الشعوب المستعمَرة في العديد من الإمبراطوريات الاستعمارية تنشط على مختلف الأصعدة لتغيير أوضاعها والتخلص من الاستعمار والحماية والوصاية والتبعية وأدى تطور مفهوم العرق والأقليات وارتباط العديد من الدول بهما إلى دعم هذين المفهومين من قبل المنظومة الدولية والتطورات السياسية العالمية. وهكذا اقتنعت عناصر من حركات الأقليات المضطهدة والتي غابت من الخريطة الجيوسياسية بأنه حان الوقت لتحقيق المطامح الوطنية. واختار العديد من هؤلاء العناصر العنف والتخويف والإرهاب كمنهج للقيام بكفاحهم ونضالهم والتعريف بقضيتهم ووضعهم للقوى الدولية بهدف كسب ودها وتعاطفها. في أوروبا، على سبيل المثال، استعمل الأيرلنديون والمقدونيون منهج العمليات الإرهابية كجزء من صراعهم من أجل الاستقلال فكان النجاح حليف الأيرلنديين، أما المقدونيون فقد فشلوا. شهدت فترة الحربين تصاعد الحركات التحررية في مختلف بقاع العالم، حيث استعملت هذه الحركات كحقها الشرعي القوة والعنف والاغتيالات والترهيب والتخويف من أجل تحقيق استقلالها ما دام أن معظم الطرق السلمية الأخرى لم تجد آذانا صاغية من قبل المستعمر الغاشم. في هذه المرحلة من التاريخ وبعد الحرب العالمية الثانية شهد العالم حربا باردة بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية. وكان الاتحاد السوفييتي قطب الكتلة الشرقية يقدم كل ما أوتي من قوة من أسلحة وعتاد وتدريب للحركات التحررية التي تناضل من أجل استرداد أرضها وسيادتها وحريتها. أهم ما يميز الإرهاب في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة هو تدويل الإرهاب، وهذا من خلال التعاون الدولي بين العديد من المجموعات الإرهابية وكذلك إقامة شبكات قوية عبر القارات لهذه المجموعات من أجل التمويل والتدريب وتوفير الوسائل اللوجستية والأسلحة والأموال إلى غير ذلك. ستبقى أحداث 11 سبتمبر 2001، من دون أدنى شك، الحدث الإرهابي الأهم في هذا القرن وهذا نظرا لعدة اعتبارات من أهمها عدد الضحايا وطريقة التنفيذ ودقة التخطيط والبلد المستهدف وهو الدولة الأعظم والأقوى في العالم. دلالات أحداث 11/9 تشير إلى قراءة جديدة للإرهاب في القرن الحادي والعشرين حيث إنه يهدد ويصل إلى أي دولة في العالم بغض النظر عن قوتها وحجمها وخبرتها في الأمن القومي والدفاع عن نفسها. فالرسالة واضحة وهي أنه لا توجد دولة في العالم بمنأى عن الإرهاب. ضرب الإرهاب كذلك في السنوات الأخيرة الهند (البرلمان) إندونيسيا (بالي)، بريطانيا (مترو الأنفاق في لندن)، إسبانيا (القطار في مدريد) ومومباي في الهند (فنادق ومحطة القطار). أما مركز العمليات الدولي للإرهاب هذه الأيام فهو يتمحور بين العراق، سوريا، باكستان، أفغانستان. نظرا للرهانات والتحديات والتداعيات التي يحتويها الإرهاب فإنه كان دائما محل مساومات واستخدامات العديد من الدول في العالم، فحتى قبل الحرب العالمية الأولى كانت هناك قوى سياسية تستخدم الإرهاب لتحقيق أهدافها ولدعم ومساندة طرف ضد طرف آخر. وخير مثال على ذلك المسؤولون في الحكومة والجيش الصربي الذين كانوا يدعمون ويدربون ويسلحون المجموعات البلقانية المختلفة التي كانت تنشط قبل اغتيال الدوك "فرانز فرديناند" عام 1914 في سراجيفو. كما يرى والتر لاكور أن الحكومة البلغارية استعملت "المنظمة المقدونية الثورية" ضد يوغوسلافيا وضد الأعداء المحليين. إن ظاهرة إرهاب الدولة ليست وليدة البارحة وليست جديدة على المجتمع الدولي. حيث يرجع مصطلح "إرهاب الدولة" إلى أنظمة الرعب التي أفرزت الثورات الكبرى مثل إرهاب "ماكسيميليان روبسبيار" و"ستالين" وسلوكيات الدول الشمولية والسلطوية والعنصرية كالجرائم التي أرتكبها "هتلر" ونظامه في ألمانيا، وموسوليني في إيطاليا الفاشية، و"عيدي أمين" في أوغندا، و"موبوتو" في زائير، و"بوكاسا" في إفريقيا الوسطى و"بول بوت" في كمبوديا، وممارسات الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية بتوجيهات ودعم وكالة المخابرات الأمريكية، وإرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. هذا لا يعني أن الدول الديمقراطية لا تمارس الإرهاب ولا تستعمله، بل إنها تمارسه بحجة أنها تحارب الإرهاب أو تحمي مصالحها وأمنها. فالحرب القائمة على الإرهاب هذه الأيام ما هي إلا مكافحة الإرهاب بالإرهاب، فهي إرهاب في آخر المطاف وهي تناقض صارخ مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وما حصل في أفغانستان والعراق وجوانتنامو وباكستان لخير دليل على ذلك. فأمريكا تصدر سنويا قائمة بالدول التي ترعى الإرهاب حسب معاييرها ومقاييسها ووفق تطور علاقاتها مع هذه الدول بالسلب أو بالإيجاب، وهذه القائمة تتبناها العديد من الدول مقتنعة بذلك أم مرغمة. وهكذا أصبح الإرهاب متغيرا أساسيا في العلاقات الدولية وأصبح أداة في يد الدول الفاعلة في النظام الدولي لتحقيق مصالحها وأهدافها. وعملا بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فهناك العديد من الدول، البعض منها يدعي الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان، يستعمل الإرهاب كجهاز وإدارة مثل مؤسسات الدولة الأخرى لكن في السر والخفاء. يقول الدكتور عبيدات في هذا الشأن "إن فهم ظاهرة إرهاب الدولة يتطلب فهم أجهزتها الاستخبارية التي تقوم سرا بما عجزت عن تحقيقه الدولة علنا أو الذي لا ترغب الدولة بأن يُنسب إليها مباشرة كتمويل بعض المنظمات الموجودة في دول أخرى لاستخدامها كوسيلة للتخريب أو الضغط، أو للتصفيات الجسدية كما عملت فرنسا حينما دعمت منظمة "الجيش السري" لتفتك بحركة التحرير الوطني الجزائرية". يكتسي الإرهاب في عالم اليوم أهمية كبرى في المحافل الدولية والعلاقات بين الشعوب والأمم وأصبح أداة محورية من أدوات السياسة والدبلوماسية والعلاقات الدولية. لقد غيرت أحداث سبتمبر 2001 مفهوم التاريخ والأمن القومي والاستراتيجي ومنذ ذلك الحين أصبح الإرهاب يرتبط بفكرة أنه لا أحد في هذا الكون بمنأى عنه والأخطر من هذا أن الخوف الآن يرتكز حول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل المجموعات الإرهابية. وما زاد في المشكلة تعقيدا وخطورة هو أن نظرة الولايات المتحدة للإرهاب ومكافحته نظرة ضيقة، مركزية الذات والهوية، ذات أبعاد محلية وداخلية، بعيدة عن الموضوعية والبعد الدولي. فالإرهاب لا يتحدد في أسامة بن لادن والقاعدة ولا ينتهي عند طالبان وداعش؛ كما أن محاربة الإرهاب بالإرهاب لا جدوى من ورائها، أضف إلى ذلك أن القوى العظمى في النظام العالمي لا ترى في حلول الإرهاب (الأسباب والجذور)، بل تركز على القشور وعلى الانعكاسات والنتائج والحلول التجميلية الظرفية التي سرعان ما تختفي ويعود الإرهاب من جديد كالنار من تحت الرماد. وهذا ما نلاحظه هذه الأيام مع ظاهرة "داعش". ما يعني أن المنظومة الدولية مطالبة بإعادة النظر في التعامل مع الظاهرة وفي عقد مؤتمرات ومنتديات دولية صريحة وموضوعية وهادفة من أجل أمن واستقرار البشرية جمعاء ومن أجل التعاون والتكامل بدلا من الصراعات والنزاعات التي توفر الأرض الخصبة لانتشار الإرهاب وعدم القدرة على مكافحته وإيجاد الحلول الناجعة للحد منه. فاستمرار القاعدة وظهور "داعش" بالقوة والخطورة التي يشاهدها ويلاحظها العالم بأسره ما هو إلا خير دليل على فشل القوى العظمى والفاعلة في العالم في التعامل بفاعلية ونجاح مع ظاهرة الإرهاب وعدم القدرة على احتوائه والقضاء عليه.
948
| 25 أكتوبر 2014
تعود أسباب الإرهاب إلى عوامل عدة داخلية وخارجية، فبالنسبة للعوامل الداخلية تمر العديد من دول العالم بتغيرات جذرية وهامة فرضتها الظروف التي تمر بها المنظومة الدولية مثل انهيار الشيوعية والكتلة الاشتراكية وبذلك زوال القطبية الثنائية وظهور مؤشرات نظام عالمي جديد لم تتحدد معالمه بعد، لكن تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمقاومة شديدة وصراع كبير من قبل بعض الدول الفاعلة على الساحة الدولية. أضف إلى ذلك، فإن معظم التجارب التنموية في العالم الثالث والذي يضم أكثر من 75% من سكان العالم فشلت ولم تحقق الأهداف المرجوة منها مما عمق الهوة ما بين الدول المتقدمة، المستعمرة (بكسر الميم) سابقا والدول المتخلفة، المستعمرة (بفتح الميم)، كما أدى فشل المشاريع التنموية داخل دول العالم الثالث إلى اتساع الهوة بين الفئة القليلة جدًا التي تتقاسم ثروات البلاد وعامة الجماهير التي تعاني يومًا بعد يوم من الفقر وصعوبة تأمين لقمة العيش. فأسباب الإرهاب في الدول النامية وبالتحديد في الدول العربية تتحدد في عوامل سياسية، أيديولوجية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية. فالمشاكل التي ظهرت على هذه المستويات مجتمعة أدت إلى ظهور التطرف والإرهاب ورفض الآخر، هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الدولي فهنالك بعض الدول تعمل على إيواء الإرهابيين والبعض الآخر يعمل على استعمال الإرهاب لإضعاف بعض الدول النامية والقضاء على معنوياتها ونشاطاتها حتى يتحكم في مصيرها كما يشاء، أما النوع الثالث فهي تلك الدول التي تمارس إرهاب الدولة مثل الكيان الصهيوني حتى يضمن بقاءه ويقضي على كل من يقف في طريقة. فعلى الصعيد المحلي نلاحظ الأسباب والعوامل التالية: إن الإقصاء السياسي وضعف الحريات السياسية وعدم المشاركة السياسية من قبل فئات عريضة من المجتمع والناجم عن انتشار وسيادة النظم السياسية العربية السلطوية أدت إلى فجوة كبيرة جدًا بين الحاكم والمحكوم وأصبح بذلك المجتمع المدني محرومًا من أدنى حقوقه للتعبير عن مطالب ومشاكل واهتمامات الجماهير الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فانعدام المشاركة السياسية للغالبية العظمى للجماهير يؤدي إلى الإقصاء والتهميش ويفتح المجال أمام المؤسسات الحكومية للتلاعب في الفضاء السياسي كما تشاء ومن أجل خدمة حفنة من السياسيين والعسكريين. إن فشل المشاريع التنموية في معظم الدول النامية أدى إلى تفشي الفقر والجهل والمشاكل الاقتصادية في المجتمع وهذا نظرًا للزيادة المطردة في عدد السكان وفي احتياجاتهم المتزايدة من مأكل ومشرب وبنية تحتية ومدارس ومستشفيات …إلخ، هذه الأمور كلها أدت إلى تفاقم البطالة ومشاكل أخرى تزداد تعقيداً يوما بعد يوم كما أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها معظم الدول النامية من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر أدت إلى العديد من المشاكل كتسريح العمال واللجوء إلى الخصخصة التي لا ترحم… إلى غير ذلك من المشاكل. فالفجوة الطبقية الضخمة التي توجد في غالبية الدول النامية تزيد يومًا بعد يوم من غنى الأغنياء وفقر الفقراء وزيادة عدد المهمشين وانعدام الحد الأدنى للحياة الكريمة عند نسبة كبيرة من السكان. فالشباب المهمش في معظم دول العالم الثالث فقد كل أمل في الحياة وهو المتعلم الجامعي الذي لم يحصل على منصب شغل ولذلك لا يستطيع الحلم لا بمسكن ولا بحياة كريمة ولا بحياة زوجية ونظرًا للعولمة ولعالمية الصور والأنماط الاستهلاكية الغربية ومعيشة وحياة الوفرة والثراء التي تقدمها المسلسلات والأفلام الغربية يصبح المهمش في العالم الثالث قاب قوسين أو أدنى من التطرف، وإلغاء الآخر وبذلك الإرهاب والثورة ضد كل ما هو قائم في المجتمع. تعاني الكثير من الدول النامية من الانفصام الثقافي، والتبعية الثقافية وفي بعض الأحيان من أزمة هوية. وهذه الأمور كلها مجتمعة تؤدي إلى صراع داخل المجتمع إذا لم يكن مبنيًا على التسامح والتفاهم واحترام الرأي الآخر وانعدام المجتمع المدني تكون نتيجته الحتمية تصفية الآخر والتخلص منه. ومن مخلفات الاستعمار وجود نخبة من المثقفين وأشباه المثقفين والتابعين في الدول النامية منسلخة تمامًا عن الأمة تدافع وتمثل مصالح دولة المركز أو "المتروبول" المركز، والصراع الثقافي هذا أدى في الكثير من الدول النامية إلى وجود دويلات داخل دولة وهويات ثقافية مختلفة، الأمر الذي انعكس بالسلب على الإنتاج الثقافي وعلى هوية الصناعات الثقافية المختلفة وعلى مخرجات وسائل الإعلام. وهكذا أصبح الخطاب الثقافي يعكس عدة اتجاهات متناحرة ومتناقضة تمثل مختلف التيارات الأيديولوجية والعقائدية والتي لا يربط بينها قاسم مشترك واحد، وهذا ما من شأنه أن يغذي التطرف والحركات الإرهابية حيث إن هذه التيارات الثقافية المختلفة لا تؤمن ببعضها البعض وكل واحد منها يعمل على إقصاء الآخر بشتى الطرق والوسائل. ونلاحظ هنا الغياب الكلي للمؤسسة الإسلامية حيث تركت فراغا كبيرًا وأصبح كل من هب ودب يفتي حسب أهوائه ومعتقداته ومصالحه الخاصة ضاربا عرض الحائط كل من لا يرى العالم كما يراه هو. إن فشل المشاريع والخطط التنموية في معظم الدول النامية، والخلل الذي نجم عن هجرة سكان الأرياف إلى المدن، وعدم الاهتمام بتطوير البنية التحية في المناطق الريفية والنائية، نجم عنه ظهور الأحياء العشوائية و(الغيتوهات) وتدهور حالة المدن حيث انعدمت فيها مقومات الحياة الكريمة وتفشت فيها الأمراض والأوبئة وتفاقمت فيها أزمة السكن وانعدمت فيها الراحة والطمأنينة والأمان والشروط الأساسية للمدينة الحديثة. أضف إلى ذلك أن الأسباب السالفة الذكر، اقتصادية، سياسية، اجتماعية وثقافية كلها أدت إلى انتشار وتفشي أمراض اجتماعية خطيرة قضت على مفهوم الأسرة والعائلة والتلاحم الاجتماعي… الخ. هذه الأمور كلها هيأت الظروف لظهور جيل من الشباب حاقد على المجتمع وعلى الدولة والسلطة ومختلف مؤسساتها، جيل مهيأ للعنف والتطرف وإقصاء الآخر في غياب الوسائل والإمكانات. إن غياب البرامج الاجتماعية في الدول النامية أو استغلالها من قبل الفئات التي ليست بحاجة إليها في واقع الأمر زاد من تفاقم أوضاع الفئات المحرومة في معظم هذه البلدان.
553
| 18 أكتوبر 2014
أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة " إن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق باتَ يُشكِّل ذخيرة للمنظمات المتطرفة لغسل عقول البسطاء والشباب وتجنيدهم للانضمام لهذه المنظمات، وها نحن اليوم نشهد ارتكاب المجازر واستخدام وسائل الترهيب والتعذيب من المتطرفين من مختلف الأديان والمذاهب، وعليه فإن إضفاء صفة الإرهاب على دين أو فئة أو جماعة معينة بحسب الأهواء السياسية هو أمر غير مقبول". ودعت دولة قطر المنظومة الدولية لتنظيم مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب لوضع حد للتلاعب والتأويلات والمقاربات المختلفة للظاهرة التي باتت تهدد أمن البشرية جمعاء. أصبحت ظاهرة الإرهاب ظاهرة القرن الحادي والعشرين بامتياز؛ فالمشكلة أصبحت أداة للسياسة والعلاقات الدولية والحضور الإعلامي والوصول إلى الرأي العام مما جعلها مادة دسمة تتفنن وسائل الإعلام في تناولها وتغطيتها ومناقشتها. ومن أهم التحديات التي تفرضها ظاهرة الإرهاب على المنظومة الدولية هي تعريف كلمة "إرهاب" حيث إلى حد الآن لا يوجد تعريف شامل ومانع للكلمة ومتفق عليه دوليا. يثير مجرد الكلام عن الإرهاب عدة تساؤلات وجدال بسبب المشكلات التي تحيط بتعريف هذه الظاهرة وتحديد دوافعها وأبعادها وأهدافها. ونلاحظ هنا اختلاف نظرة كل مجتمع وكل دولة للمفهوم، وقد ساهم هذا الإشكال في الالتباس والتداخل والفوضى في الطرح والمعالجة والتحليل. فحتى اليوم لا يوجد تعريف للإرهاب متفق عليه دوليا وذلك لأسباب تتعلق بتباين المصالح واختلاف المعايير والقيم بين الدول والمجتمعات مما أدى على سبيل المثال لعدم التمييز في الكثير من الحالات ما بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال. ويرتبط إطلاق تسمية إرهابي بالرؤية السياسية والفلسفة الاجتماعية التي تؤمن بها المؤسسات والمنظمات ووسائل الإعلام، كما تلعب المصالح المختلفة التي تدافع عنها تلك المنظمات دورا كبيرا في ذلك. يؤكد علماء اللغة أن أصل كلمة إرهاب مشتقة من الفعل: رهب يرهب؛ ويقصد منها التخويف، والفزع. والإرهابي هو الذي يحدث الخوف والفزع عند الأبرياء. كما عرفته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأنه:" كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أيا كانت دوافعه أو أغراضه، يقع تنفيذه لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق أو الأملاك (العامة والخاصة) أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر" (المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998). بالرغم من أن هذا التعريف يبرز مظاهر وطبيعة النشاط الإرهابي؛ إلا أنه لم يتطرق للوسائل والأساليب المستخدمة من طرف الإرهابيين وهي عديدة ومتنوعة، بل قد تأخذ أشكالا حديثة: كالرسائل الإلكترونية، والرسائل القصيرة. كما أن هذا التعريف لم يتطرق لمختلف القطاعات، والمجالات، والأنشطة الإرهابية، وهو ما ركز عليه تعريف المجمع الفقهي الإسلامي، وذلك بتحديده للجوانب والقطاعات التي يستهدفها الإرهاب؛ إذ يؤكد التعريف بأن الإرهاب هو: "عدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه). ويشمل صنوف التخويف والأذى، والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصورة الحرابة وإخافة السبل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم، أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها." (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي – اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الإرهاب لسنة 1999م). وقد جاء في قرارات الأمم المتحدة بأن الإرهاب هو: "تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو تهدد الحريات الأساسية، أو تنتهك كرامة الإنسان". وفي السياق نفسه، عرفه خبراء الأمم المتحدة بأنه: "إستراتيجية عنف محرم دوليا، تحفزها بواعث عقدية (إيديولوجية) تتوخى إحداث الرعب داخل المجتمع لتحقيق الوصول إلى السلطة أو تقويضها." لقد ركز هذا التعريف على الهدف الجوهري للإرهاب وهو الوصول للسلطة أو تقويضها، ولكن في بعض الحالات فإن الإرهاب يستهدف خلق بلبلة وفوضى في المجتمع. كما أن بواعث وأسباب الإرهاب لا تكون دائما إيديولوجية بل قد تكون اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية. من خلال التطرق لهذه التعاريف يتجلى لنا بأن هناك اختلافا وتباينا واضحا في تحديد تعريف للإرهاب، وهذا راجع لعدة أسباب، ولعل أهمها: الالتباس القائم بينه وبين المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بحقوق شعوب العالم في النضال والكفاح والجهاد والمقاومة من أجل تحقيق استقلالها والدفاع عن مصالحها. كما أن بعض البلدان ليس لديها تشريعات وقوانين تحدد الفروق القائمة ما بين السلوك الإجرامي والعدواني وآفة الإرهاب، إذ ليس هناك فرق من الناحية التشريعية والقانونية ما بين الجريمة خصوصا المنظمة والسلوك الإرهابي. أضف إلى ذلك، فإن مصالح الجهات والمؤسسات التي تحدد وتضع التعاريف المختلفة للإرهاب تستمدها وتستلهمها بشكل مباشر أو غير مباشر من مصالحها الذاتية، وقد تتعارض هذه المصالح مع مصالح شعوب أو دول أو مؤسسات أخرى، ونحن نعلم بأن بعض الدول الكبرى تحدد وتعرف الإرهاب، والسلوك الإرهابي، والمنظمات والجماعات والشخصيات الإرهابية وفق مصالحها الحيوية والإستراتيجية. فالإرهاب هو حدث مفاجئ وغير متوقع، منظم، وهو عنف وعدوان غير مشروع يقوم به فرد أو جماعة ويكون عادة موّجها ضد مدنيين أبرياء ويستهدف الحضور الإعلامي والعلنية والدعاية للفت انتباه أكبر عدد ممكن من الناس بهدف الوصول إلى الرأي العام من أجل التأثير في صانع القرار لتحقيق غايات اجتماعية وسياسية وإستراتيجية. الإرهاب ظاهرة معقدة ومتشابكة تفرزها جملة من العوامل والأسباب حيث تتداخل العوامل الشخصية والنفسية مع الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتشكل ظاهرة الإرهاب التي تهدف إلى تحقيق الأهداف من خلال العنف والقتل والجريمة وإلغاء الآخر وإقصائه من الوجود. أما على الصعيد الدولي فتتلخص الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرز الإرهاب حسب لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة فيما يلي: "سيطرة دولة على دولة أخرى، واستخدام القوة ضد الدول الضعيفة، وممارسة القمع والعنف والتهجير، وعدم التوازن في النظام الاقتصادي العالمي والاستغلال الأجنبي للموارد الطبيعية للدول النامية، وانتهاك حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتعذيب أو السجن أو الانتقام، والجوع والحرمان والبؤس والجهل، وتجاهل معاناة شعب ما يتعرض للاضطهاد، وتدمير البيئة". إن استعراض الأسباب والعوامل التي تولد الإرهاب لا يعني محاولة تبريره وإيجاد حجج لانتشاره وتوسعه في العديد من المجتمعات وإنما الهدف تحدده طبيعة الظاهرة التي لم توجد هكذا من العدم وإنما هناك دائما أسباب وآليات لأي ظاهرة من الظواهر سواء كانت اجتماعية أم سياسية أم غير ذلك. تتعدد أسباب الإرهاب وتختلف حسب ظروف وطبيعة كل مجتمع، وظاهرة الإرهاب ظاهرة معقدة ومتشعبة، الوقوف عند أسبابها وأبعادها ليس بالعملية السهلة. فالإرهاب ظاهرة تعكس وضعا غير سوي في المجتمع، يكون في معظم الأحيان تعبيرًا عن الاستياء والتهميش والإقصاء والتنكر للواقع وللقيم السائدة في المجتمع. فهو إذن ظاهرة لا تؤمن بالآخر ولا تؤمن بالحوار ولا حتى بالقيم الإنسانية. الإرهاب يكون بعيدا كل البعد عن المنطق والبصيرة ويؤمن بالنفي الكامل لجميع القيم الأخلاقية. فالعقلية الإرهابية إذن تجد مصدرها في رفض ما هو موجود في المجتمع والثورة عليه، وتتسم بالكراهية والحقد والإنكار الأخلاقي لكافة القيم. ومما زاد في تعقيد الظاهرة وتشابك أطرافها استعمال الإرهاب من قبل بعض الدول للإطاحة بدول أخرى أو تقويض عمليتها التنموية وتطورها والحد من عملها الدبلوماسي ونشاطها السياسي على المستوى الإقليمي أو الجهوي…إلخ وقبل التطرق إلى أسباب الإرهاب يجب الوقوف عند أهدافه، ففي غالب الأحيان تلجأ الجماعات السياسية التي تفشل في الوصول إلى الحكم والسلطة والتأثير في القرار السياسي بالطرق السياسية المعروفة إلى استعمال العنف والتطرف للتعبير عن استيائها وعدم قبولها بالأمر الواقع. فالإرهاب إذن أصبح نوعًا من التعبير السياسي الذي يعكس فشل تنظيم معين في التأقلم والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته ومكوناته المختلفة.
2159
| 11 أكتوبر 2014
كلما ظهرت أعمال إرهابية وجماعات إرهابية جديدة زادت نسبة الاعتداءات على المسلمين في بلاد الغرب وزادت درجة الحقد والكراهية وارتفع حجم التضليل والتشويه والتزييف. فمنذ ظهور "داعش" وقتل الرهينة الفرنسية بطريقة وحشية في الجزائر تحركت الآلة الإعلامية الغربية والجماعات العنصرية للنيل من الإسلام والمسلمين والرعايا العرب في مختلف الدول الغربية.. ما يؤدي عادة إلى زيادة وارتفاع حملات التفتيش والاعتقالات والمضايقات على العرب والمسلمين الزائرين والمقيمين في العديد من الدول الغربية من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة بسبب وبدون سبب.. فمنذ أحداث 11 سبتمبر 2001 أصبحت العمليات الإرهابية والجرائم مقترنة بالعرب والمسلمين وانتشرت بذلك ثقافة الخوف من الإسلام.. هذا الدين الذي تم تصويره وتقديمه للرأي العام من قبل الصناعات الإعلامية والثقافية العالمية على أنه دين القتل والعنف والإقصاء وعلى أنه دين غير متسامح ولا يؤمن بالآخر.. كما استهدفت حملات إعلامية ودعائية مغرضة ومضللة عديدة الدين الإسلامي من خلال التخويف من الإسلام والمسلمين والتحريض ضدهم ومطالبة أجهزة الأمن من تكثيف حملات الاعتقالات والتدخل في تفاصيل الحياة الشخصية للمسلمين المقيمين في الدول الغربية ومراقبة تنقلاتهم ونشاطهم وحتى تصرفاتهم اليومية. وهكذا انتشرت صناعة الخوف وتفننت فيها بعض الدول والجهات التي تستهدف كل ما هو عربي ومسلم.. لقد اهتزت صورة الإسلام والعرب في السنوات الأخيرة في الرأي العام الدولي بصورة خطرة جدا ساهمت في العديد من المرات في اتخاذ مواقف معادية وسلبية ضد الشعوب العربية والإسلامية. وكنتيجة لهذه الحملات المنهجية والتشويه والتضليل المنظم أصبح الرأي العام في الدول الغربية معاديا ومتخوفا من الإسلام والمسلمين والعرب وأصبح ووفق الصور النمطية التي قدمت له يؤمن بصراع الحضارات وصدامها.. والأخطر من هذا فإن قادة الرأي وصناع القرار والساسة وحتى نسبة كبيرة من المثقفين انضموا إلى قافلة التهجم على الإسلام واستهدافه وتشويهه. وأصبح العديد ينظر ويفسر في شؤون الإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية عن جهل وبثقافة الحقد والكراهية والانتقام. في السنوات الأخيرة وخاصة بعد أحداث 11سبتمبر 2001 عانت وتعاني الجالية المسلمة المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، معاناة شديدة من الممارسات والمضايقات العديدة التي تقوم بها أجهزة أمنية عديدة ومختلفة.. فهناك درجة كبيرة من الإهانة والتعدي على الحريات الفردية وعلى حقوق الإنسان والنتيجة الحتمية لكل هذا هو انتشار الحقد والعنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين.. والمشكل هنا يُطرح على مستويين، المستوى الأول هو الصورة المشوهة والمضللة للإسلام والتي تفننت في صناعتها جهات عديدة من خلال وسائل الإعلام والصناعات الثقافية المختلفة.. أما المستوى الثاني فهو الضعف الكبير والغياب شبه التام للمخرجات الإعلامية والصناعات الثقافية العربية والإسلامية التي تقدم الإسلام للآخر وتسوّق صورة الحضارة الإسلامية والمسلمين على حقيقتها. من جهة أخرى، فشلت وسائل الإعلام العربية والنخبة المثقفة في احتواء الصور النمطية والآراء المشوهة والمضللة للإسلام والمسلمين وتفنيدها بالأدلة والحجج والبراهين والمنطق وبلغة الآخر ومنطقه وإطاره المرجعي. الإشكال المطروح هو هل استطاع المسلمون تقديم الإسلام إلى الآخر بشكل علمي منهجي مدروس وفعال؟ ماذا قدم الإعلام العربي والإسلامي.. وأين هي الصناعات الإعلامية والثقافية العربية من رسالة تقديم الدين الحنيف والحضارة الإسلامية للآخر.. ماذا عن الإنجازات والإنتاج العلمي والفكري والحضاري. كشفت أحداث 11 سبتمبر 2001 عن الإرهاب الفكري الذي تمارسه الآلة الإعلامية الغربية على عقول الناس والبشر والرأي العام، حيث أصبحت كلمة العرب والمسلمين مرادفة للإرهاب والجهل والتعصب وإقصاء الآخر وأصبحت وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها تنسج وتبني صورا نمطية وأنظمة فكرية ومعتقدات تجعل من العربي ومن المسلم معاديا للإنسانية وللبشرية وللأخلاق وللقيم السامية. والغريب في الأمر أن الآلة الإعلامية الغربية لم تطرح أسئلة جوهرية في تعاملها مع أحداث نيويورك وواشنطن، أسئلة هامة ومحورية لو طرحت ستساعد من دون شك على اكتمال الصورة الحقيقية لخلفيات الأحداث وتداعياتها.. لماذا ضرب الإرهاب أمريكا دون سواها؟ لماذا لم تتحرك الآلة الأمريكية الغربية عندما كانت دول مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا تأوي إرهابيين من مختلف الدول والجنسيات تحت ستار اللجوء السياسي وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغير ذلك...؟ لماذا لم تتفاعل الآلة الإعلامية الغربية مع إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني يوميا على الشعب الفلسطيني؟ وهل تستطيع أمريكا اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه بالعنف والقتل وفرض وجهة نظرها على باقي شعوب العالم كما يحلو لها.. هل الحل الأمثل لمعالجة الإرهاب هو العنف والقوة؟ هل تطرقت الآلة الإعلامية الغربية للأسباب الحقيقية للإرهاب؟ هل تساءلت الآلة الإعلامية الغربية عن من هو الذي صنع بن لادن والأفغان العرب و"المجاهدين" والجماعات الإسلامية المسلحة و"الأمراء" وغيرهم؟ وهل هؤلاء يمثلون الإسلام والمسلمين؟ هل ناقشت وسائل الإعلام التناقضات الموجودة على مستوى العلاقات الدولية السياسية منها والاقتصادية؟ كيف تجرؤ هذه الآلة الإعلامية العالمية على تفريغ قضايا وأحداث ومشاكل من محتواها الحقيقي ومن جوهرها وتركز على الشكل والقشور فقط؟ إلى متى تبقى وسائل الإعلام العالمية تتلاعب بعقول الناس وبمصيرهم؟ إلى متى تبقى هذه الوسائل تفبرك الواقع وتبث الرعب والخوف في نفوس البشر في مختلف أنحاء المعمورة؟ أكدت معظم الدراسات والأبحاث العلمية أن وسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية منها من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسينما وحتى الكتب ترسم صورة مشوّهة وسلبية وغير صحيحة عن الإسلام والعرب في مختلف المجالات والمضامين.. وهذه الصور النمطية تكون في معظم الأحيان نتيجة لأفكار مسبقة ولحقد على الأمة العربية ولجهل تاريخ العرب وحضارتهم وثقافتهم وأخيرا للصراع الحضاري بين الغرب والإسلام.. من أهم المشاكل التي تواجه التغطية الإعلامية للعرب والإسلام هو التباين الثقافي بين العرب والغرب.. فالقائم بالاتصال الغربي الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط أو المغرب العربي لا يعرف الكثير عن تاريخ وثقافة العرب لكن أكثر من هذا فإنه يستند إلى أفكاره المسبقة وقيم وأحكام وتقاليد نظامه في تغطية العرب والمجتمع العربي.. والكثير من هؤلاء الصحفيين الذين توكل لهم مهمة تغطية بلاد العرب لا يعرفون اللغة العربية ولا الدين الإسلامي ولا التاريخ والحضارة الإسلامية.
1524
| 04 أكتوبر 2014
بمبادرة كريمة من الجمعية الدولية للعلاقات العامة، فرع الخليج احتضنت كتارا ندوة موسومة "ماذا يريد الإعلام من العلاقات العامة؟" الكلام عن العلاقات العامة والإعلام أثار ويثير الكثير من النقاش والجدل منذ عقود من الزمن بين المهنيين والأكاديميين والباحثين ليس في المنطقة العربية فقط وإنما في معظم دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية مهد هذه المهنة، والبلد تطورت فيه نظريات وأخلاقيات العلاقات العامة. فالعلاقات العامة دون المؤسسات الإعلامية لا تستطيع أن تنجز الكثير من مهامها وتحقق الكثير من أهدافها. من جهة أخرى نلاحظ أن وسائل الإعلام بحاجة إلى إدارات العلاقات العامة في مختلف المؤسسات حتى تقوم بتقديم المعلومة للرأي العام، وبدون إدارات العلاقات العامة ستكون مهمة وسائل الإعلام في الحصول على البيانات والمعلومات عن أنشطة مختلف الهيئات والمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة مهمة صعبة جدا وهذا مع التنامي المتزايد للمؤسسات المختلفة في المجتمع وخصوصية كل واحدة منها.فإذا بدأنا الكلام عن العلاقة المهنية والصحية والمتميزة بين الطرفين فلابد من التقيد بالاحترام المتبادل وهذا يعني أن الطرفين يعملان من أجل المصلحة العامة ومن أجل تزويد المجتمع بالبيانات والمعلومات الضرورية حتى يتسنى للرأي العام أن يتوفر على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار السليم وللتعامل والتفاعل مع مختلف هيئات ومكونات المجتمع بوعي ودراية ومسؤولية.. وهذا يعني أن ممارس العلاقات العامة والصحافي كلاهما مسؤول أمام الله وأمام ضميره وأمام المجتمع عن أداء مهنته ورسالته بإخلاص وأمان ومسؤولية. فالإعلام المسؤول والنزيه هو ذلك الذي يساهم في التنمية المستدامة وفي طرح القضايا الجوهرية في المجتمع ليس من أجل القذف والشتم والافتراء وليس كذلك من أجل التسبيح والمدح وإنما من أجل توعية المجتمع وإبلاغه وإخباره بكل ما يتعلق بحياته اليومية سواء كان الأمر يخص المواصلات أو المدارس أو المستشفيات والقائمة قد تطول وتشمل كل مجالات الحياة ومكونات المجتمع وفئاته وإداراته...الخ. من جهة أخرى ممارس العلاقات مسؤول على احترام الصحافي بالدرجة الأولى والنظر إليه كزميل وكحليف استراتيجي لإخبار وإبلاغ الرأي العام بما يجري في مؤسسته بطريقة موضوعية وصريحة وشفافة وبدون تضخيم وتسبيح ومدح وبدون مبالغة. فالمصلحة العامة تتطلب الصدق والثقة واحترام الجمهور والرأي العام، فعملية إقناع الجمهور لتكييف سلوكه مع المنظمة تقوم بالدرجة الأولى باحترام هذا الجمهور من خلال الصدق والموضوعية والشفافية والالتزام بالاحترام المتبادل، وليعلم ممارس العلاقات العامة أن التركيز في مهامه على عملية النشر والحضور الإعلامي في وسائل الإعلام هي جزء بسيط جدا من مهام العلاقات العامة التي تشمل الاتصال الاستراتيجي والبحث والتخطيط وبناء الصورة وإدارة السمعة. فالعلاقات العامة لا يجب أن تركز على المدح والتسبيح للمؤسسة والعلنية والحضور الإعلامي، فهي أكبر من ذلك بكثير. فالجمهور يهمه بالدرجة الأولى أداء المؤسسة واستجاباتها لطلباته وحاجاته، فالعلاقات العامة هي أفعال قبل أن تكون أقوالا، وهذا يعني أنه يجب احترام ذكاء الجمهور حيث إنه عارف للواقع ومجرب له، فالتركيز على الحضور الإعلامي دون أنشطة ووظائف العلاقات العامة الأخرى يعني عدم استيعاب فهم المهنة كما ينبغي وعدم توظيفها لخدمة المجتمع والمصلحة العامة.. من واجب ممارس العلاقات العامة أن يتعامل مع الصحافي في السراء والضراء، في الأوقات الزاهية والجميلة للمؤسسة وفي الأوقات الصعبة والحرجة وفي الأزمات بنفس الاستعداد والمسؤولية، وعادة ما يحتاج الجمهور إلى المعلومات والأخبار والتفاصيل في الأوقات الصعبة للمؤسسة. ومن أجل علاقة متميزة بين العلاقات العامة والإعلام تخدم المصلحة العامة وتشكل رأيا عاما مستنيرا، واعيا وهادفا يشارك في التنمية المستدامة في المجتمع يجب على الصحافي الالتزام بالمهنية والبحث عن الحقيقة، ما يعني التركيز على صحافة الاستقصاء والبحث عن الأخطاء والتجاوزات بهدف تصحيحها وبهدف إرضاء احتياجات الجمهور. فبانتشار شبكات التواصل الاجتماعي والثورة المعلوماتية، انتهى إعلام البيانات الصحافية وإعلام "كل شيء على أحسن ما يرام" وصحافة البلاط، فالمجتمع اليوم بحاجة إلى إعلام هادف، إعلام لا يعتمد على البيانات الصحافية وإنما يغوص في أعماق القضايا التي تهم المجتمع بمختلف مكوناته وشرائحه، فالمجتمع بحاجة في المرحلة الحالية إلى إعلام قوي وفعال ومسؤول وملتزم ونزيه لا يعتمد على بيانات العلاقات العامة، بل يستعملها للشروع فيما بعدها من تحقيقات ومقابلات واستقصاءات من أجل تنوير الرأي العام. من جهة أخرى يحتاج المجتمع إلى علاقات عامة مسؤولة ونزيهة من أجل بناء علاقات تفاهم بين المؤسسة وجماهيرها مبنية على الاحترام المتبادل وعلى الصدق والثقة. السلطة كذلك يجب أن تكون مسؤولة تؤمن بالديمقراطية وتحترم الحريات الفردية وحرية الفكر والتعبير والرأي والشفافية وإشراك الفرد في صناعة القرار. فبدلا من الصراعات والمناوشات الدائمة بين العلاقات العامة والمؤسسات الإعلامية يجب تبني ثقافة التعاون والتكامل من أجل المصلحة العامة، فليعِ الصحافي أنه الوسيط ما بين الجماهير من جهة والسلطة من جهة أخرى وأن هدفه الأسمى هو تقديم الحقيقة للجمهور من أجل المصلحة العامة. فالديمقراطية تحتاج إلى شفافية وإلى إعلام قوي موضوعي، مسؤول وملتزم. كما يجب على ممارس العلاقات العامة أن يدرك أن دوره هو أن يكون الوسيط الناجح بين المؤسسة وجماهيرها بهدف تحقيق التفاهم بين الطرفين من أجل المصلحة العامة، الأمر الذي يتوجب الابتعاد عن التضخيم وعن ثقافة التمظهر والتركيز على الحضور الإعلامي. فمصلحة المؤسسة والجمهور تتحقق من خلال الأداء المتميز والاحترام المتبادل وليس عن طريق الأخبار والبيانات الصحافية المعسولة والمزركشة التي تعتمد التضخيم والتبجيل. نستنتج إذن من مصلحة الطرفين العلاقات العامة والإعلام التزام المهنية والأخلاق ومبدأ المصلحة العامة، فالطرفان بإمكانهما التعاون من أجل المصلحة العامة ومن أجل المساهمة في نشر روح المسؤولية والأداء المتميز عند المؤسسة وعند الجمهور بهدف تحقيق التنمية المستدامة، فكشف الأخطاء والتجاوزات لا يجب أن ينظر له بطريقة سلبية ولا يجب أن يفسد الود بين العلاقات العامة والمؤسسة الإعلامية، بل على العكس إن طرح المشاكل والتطرق للنقائص والسلبيات يفتح المجال للتعلم من الأخطاء وتصحيحها والمضي قدما في الازدهار والتقدم. كما أن الصراحة والشفافية هي مفاتيح النجاح والتقدم والديمقراطية. إن الحوار بين الطرفين، الإعلام والعلاقات العامة من شأنه أن يدلل العقبات والمشاكل القائمة ويقدم الحلول من أجل التعاون والتكامل وليس التنافر والتضاد، فإذا التزم كل طرف بأخلاقيات المهنة ومارس الوظيفة بمسؤولية والتزام واحترام الآخر، والجمهور ولمصلحة العامة فالجميع يكون مستفيدا وكل يؤدي مهمته وفق الأصول والمبادئ خدمة للمصلحة العامة وللديمقراطية.
934
| 27 سبتمبر 2014
قبل واحد وأربعين سنة وبالضبط في 11 سبتمبر من عام 1973، أطاح الجيش التشيلي بقيادة الجنرال أوغستو بينوشيه بالرئيس سلفادور أليندي المنتخب ديمقراطيا. الانقلاب خُطط له بطريقة محكمة من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث لعب وزير خارجيتها آنذاك هنري كيسنجر دورا مباشرا في المؤامرة العسكرية. في الأسابيع التي سبقت الانقلاب، عقد السفير الأمريكي ناثانيل ديفيس وأعضاء وكالة المخابرات المركزية اجتماعات مع كبار القادة العسكريين في تشيلي ومع قادة الحزب الوطني والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة. أمريكا وقتها وكذلك اليوم لا تطيق الفكر التحرري ولا أي أيديولوجية تختلف مع أهدافها وأجندتها. فاليسار الشيلي كان يزعجها والرئيس الجديد كان يثير قلقها خاصة أن فيدال كاسترو كان بمثابة المسمار في النعش بالنسبة للعم سام. فالولايات المتحدة كانت لا تريد حلفاء وأصدقاء للاتحاد السوفييتي في أمريكا اللاتينية وكانت لا تطيق من لا يؤمن بأيديولوجيتها وقيادتها للعالم. وبذلك كان الحل الوحيد أمامها هو استعمال كل الطرق والوسائل للتخلص من أي فكر سياسي يقف أمام مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة. يشاء القدر أن أمريكا التي لعبت بمصير شعب ودولة بكاملها تُضرب في كبريائها وكرامتها بعد 28 سنة من فعلتها الشنيعة في شيلي في نفس الشهر ونفس اليوم 11 سبتمبر. والأخطر من كل هذا أن العالم بأسره يعرف تفاصيل سبتمبر الأمريكي عن ظهر قلب، لكن معظم الناس في مختلف بقاع العالم لا يعرفون شيئا عن المخابرات المركزية الأمريكية ودورها في الانقلاب ضد أليندي، وأخطر من ذلك أنهم لا يعرفون أن عدد ضحايا الانقلاب في شيلي هو عشرة أضعاف ضحايا المركز التجاري في نيويورك. وهنا نلاحظ التلاعب والتحكم في الرأي العام الدولي والكيل بمكيالين وكأن الفرد الأمريكي أكثر أهمية وقيمة من غيره في العالم، أو يساوي عشرة أضعاف الفرد في باقي دول المعمورة خاصة في الدول الفقيرة والمغلوب على أمرها. عندما يذكر المرء 11 سبتمبر يخطر ببال الناس الهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاجون، بينما هناك سبتمبر آخر أكثر دموية وهمجية وأكثر ضرر. 11 سبتمبر جرت أحداثه في تشيلي في عام 1973، قبل 41 عاما. كان انقلابا دبرته الولايات المتحدة الأمريكية ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا سلفادور أليندي. الانقلاب الهمجي والوحشي تسبب في هلاك أكثر من 40،000 شخص بين مقتول ومفقود، ما يعني 10 أضعاف ضحايا 11 سبتمبر الأمريكي. في الوقت الذي نلاحظ فيه أن هجمات 9/11 على الولايات المتحدة الأمريكية نجمت عنها مئات الآلاف من المقالات والتعليقات والتحليلات في جميع أنحاء العالم وفي مختلف وسائل الإعلام، نلاحظ أن الإطاحة بالرئيس الشيلي لم تلق التغطية اللازمة ومر الحدث من دون اهتمام عالمي يذكر. انعكاسات انقلاب شيلي كانت وخيمة على الشعب الشيلي من حيث الضحايا والاقتصاد والوضع الاجتماعي. فالحكم الجديد الذي جاءت به أمريكا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور الاقتصاد وتفشي الفقر في البلاد والبطالة والأوبئة الاجتماعية من مخدرات وجرائم وكذلك انعدام الأمن والعدالة الاجتماعية. أحيت رئيسة الشيلي ميشيل باشيلي يوم الخميس 11 سبتمبر الماضي الذكرى السنوية للانقلاب العسكري عام 1973 والذي أطاح بالرئيس سلفادور أليندي من خلال حث الشيليين على المضي قدما مع أي معلومات قد تكون لديهم عن الأشخاص الذين اختفوا خلال الحقبة الدكتاتورية في عهد بينوشي، الحقبة التي شهدت قتل 40،000 شخص خلال ديكتاتورية دامت 17 عاما. من جهتها تحي أمريكا وغيرها من حلفائها في أرجاء العالم ذكرى 11 سبتمبر الأمريكي كل عام، ماذا عن 11 سبتمبر شيلي؟ ماذا عن الآلاف من الأبرياء والمدنيين والأطفال والمسنين الذين قُتلوا من قبل الجيش والطغمة العسكرية الغاشمة. إنها ليست مسألة مقارنة الحزن والألم، لكن لسنوات عدة حاولت وأصرت وسائل الإعلام الأمريكية إقناع بقية دول العالم ودول العالم الثالث بشكل أساسي أن حياة أمريكا الشمالية أغلى بكثير من حياة الناس الآخرين. بعد كل شيء، فإن الأمريكيين يعتقدون أن شعوب الدول النامية تستحق الاعتقال والتعذيب والقتل. والحقيقة هي أنه ولا رئيس أمريكي واحد اعتذر عما قامت به بلاده من التدخل في شؤون الغير والإطاحة برئيس دولة منتخب ديمقراطيا. الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام تستخدم معايير مختلفة لقياس المعاناة. هذا هو بالضبط النفاق وهذه هي المعايير المزدوجة التي تجعل بقية دول العالم تدين وتستنكر سلوك الولايات المتحدة في أجزاء مختلفة من العالم. فحتى وسائل الإعلام مع الأسف الشديد تركز على أشياء وتهمل أشياء أخرى أكثر أهمية. فأجندة الأخبار الدولية تحددها إمبراطوريات إعلامية مرتبطة ارتباطا شديدا بالقوى العظمى ومصالحها السياسية والاقتصادية، بل هذه الإمبراطوريات الإعلامية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الشركات المتعددة الجنسية وإمبراطوريات المال والأعمال والسياسة. كان الهدف الرئيسي من انقلاب عسكري تدعمه الولايات المتحدة في شيلي في نهاية المطاف هو فرض الأجندة الاقتصادية النيوليبرالية والتخلص من أي فكر سياسي وأيديولوجي قد يتعارض مع السياسة الأمريكية. فالتغيير في شيلي لم يُفرض من قبل الدائنين الخارجيين بتوجيه من صندوق النقد الدولي أو أي منظمة دولية أخرى وإنما تم فرض "تغيير النظام" من خلال عملية استخباراتية عسكرية سرية، والتي وضعت الأساس لانقلاب عسكري وضع " خطة لإصلاحات اقتصادية كلية واسعة" بما في ذلك الخصخصة وتحرير الأسعار وتجميد الأجور(في أوائل أكتوبر 1973) بعد بضعة أسابيع من الانقلاب العسكري. فالمجلس العسكري برئاسة الجنرال أوغستو بينوشيه أمر برفع سعر الخبز من 11 إلى 40 إسكودو، بزيادة كبيرة جدا وفي زمن قياسي، وصلت إلى 264٪. هذا "العلاج بالصدمة الاقتصادية" قد تم تصميمه من قبل مجموعة من الاقتصاديين تسمى "شيكاغو بويز" ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بنسب خيالية، تم تجميد الأجور لضمان "الاستقرار الاقتصادي ودرء الضغوط التضخمية". فبين عشية وضحاها دخل الشيلي في براثن الفقر. في أقل من سنة ارتفع سعر الخبز في شيلي ستة وثلاثين مرة 3700٪. كما أنه بفضل الانقلاب العسكري الأمريكي أصبح 85% من الشيليين يعيشون تحت خط الفقر باسم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. فهناك إذن اثنان 11 سبتمبر، الأول اعتدت أمريكا من خلاله على سيادة دولة مستقلة (11 سبتمبر 1973) والثاني تم من خلاله الاعتداء على أمريكا (11سبتمبر 2001)، لكن للإعلام وصانعي الرأي العام رأيا آخر حيث إن سبتمبر الأمريكي يحظى بالإعلام والعلنية والحضور وسبتمبر شيلي تناسه الزمن وهناك القلة القليلة التي تعرف عنه.
757
| 20 سبتمبر 2014
يشكل موضوع الصناعات الثقافية والإنتاج الإعلامي العربي، ومدى قدرته على التفاعل مع الإنتاج العالمي وعلى تسويق الفكر والصورة والذهنية العربية، تحديا كبيرا ورهانا أكبر للدول العربية قاطبة. وإذا أخذنا موضوع القنوات الفضائية العربية كمثال للخطاب الإعلامي العربي أو كمثال لمخرجات الآلة الإعلامية العربية نجد أن معظم هذه الفضائيات ركّزت على التكنولوجيا وأهملت الرسالة ومعظم هذه الفضائيات تفتقر لخطة ولإستراتيجية ولميزانية لإنتاج الرسالة الإعلامية الهادفة التي تواجه بها التدفق الإعلامي العالمي الغزير. تحديات الألفية الثالثة في مجال الاتصال والمعلوماتية متشعبة ومتعددة وخطيرة في الوقت نفسه، والعالم العربي يجد نفسه اليوم أمام واقع يحتم عليه التحكم في التطورات التكنولوجية الهائلة في مجال الإعلام والاتصال ومواكبتها وهذا لا يعني التحكم في التكنولوجيا دون التفكير في الرسالة والمحتوى والإنتاج بعبارة أخرى في المخرجات. والتحدي الكبير الذي يواجه العالم العربي هو حماية الهوية الثقافية والحضارية للأمة العربية والإسلامية وشخصيتها القومية ومواجهة الذوبان في الثقافة العالمية (الأمريكية) التي لا تعترف لا بالحدود ولا بالقيم ولا بالآخر.التحدي الأكبر الذي يواجه الدول العربية في مجال الإعلام هو تحرير هذا الإعلام وتحرير الطاقات والمهارات والإبداعات والاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانات المادية والبشرية لإرساء قواعد ومستلزمات صناعة إعلامية متطورة رشيدة وفعالة وقوية تستطيع أن تنافس وأن تقنع وأن تسوّق الأفكار والقيم والأصالة والهوية العربية الإسلامية للآخرين، كل هذه الأمور تتطلب الدراسة والبحث وإقامة علاقة متينة وتفاعل وتبادل وحوار صريح بين السلطة والمؤسسة الإعلامية والقائم بالاتصال والجمهور من أجل إرساء قواعد الثقة والمصداقية والفعالية في الأداء. ستكون معركة القرن الحادي والعشرين معركة إعلامية اتصالية معلوماتية يحسم نتيجتها مسبقا من يعرف كيف يستغل تكنولوجية الإعلام والاتصال وصناعة المعرفة. فالأمة العربية من الخليج إلى المحيط بحاجة إلى تحرير إعلامها وبحاجة إلى مواجهة النقد والاستقصاء والكشف عن العيوب والنقائص والتجاوزات، والكشف عن الأخطاء والتعلم منها. فالإعلام الحر والديمقراطي والفعال هو بارومتر تقدم الشعوب وتطورها، وبدون إعلام حر لا يحق للأمة العربية الإسلامية أن تتكلم عن مخاطبة الآخر ومواجهة الحملات الدعائية والصور النمطية ومختلف الصناعات الثقافية التي تنال من كرامة الأمة وشرفها. ومن دون نظام سياسي ديمقراطي يؤمن بحرية الفرد في المجتمع العربي ويوفر له مستلزمات الممارسة السياسية الديمقراطية فإنه لا يحق لنا أن نلوم الإعلام العربي أو نكلفه بأكثر مما هو قادر عليه. فشل العرب في امتلاك مشروع قومي وسياسي وتنموي وثقافي وإعلامي. فالإعلام العربي، ورغم التطورات الكمية التي شهدها خلال العقود الخمسة الأخيرة لم يكسب الرهان التاريخي في امتلاك مشروعا عربيا متكاملا يعكس البعد العربي الإسلامي العالمي والإنساني. فالإعلام العربي الموّجه للآخر يمثل امتدادا طبيعيا وموضوعيا للإعلام العربي الداخلي. فإلى أي مدى سينجح الإعلام العربي في تحقيق مهمة الدفاع عن الهوية الإسلامية والتاريخ والحضارة العربية الإسلامية؟ وهل الشروط والمستلزمات اجتمعت وتوفرت لإعطاء البديل ولتقديم ما يرضي المشاهد الغربي والعربي والمشاهد المسلم في مختلف بقاع العام؟ هل يستطيع الإعلام العربي أن يتحدى الواقع ويقدم رسالة إعلامية هادفة وجيّدة في قالب يكون بعيدا عن الرتابة والركاكة والروتين؟ هل يستطيع الإعلام العربي إيقاف ذوبان التراكم القيمي والمعرفي والاجتماعي للمسلم في الثقافة العالمية؟ هل يستطيع مواجهة الغزو الثقافي والرد على مظاهر الاغتراب والذوبان في الغير؟غيّرت أحداث 11 سبتمبر وقبلها انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية اتجاهات اهتمامات وبؤر تركيز الغرب من الأيديولوجية الشيوعية إلى الإسلام، هذا الدين الذي ينتشر في 55 دولة ويعتنقه أكثر من مليار وخمسمائة مليون نسمة إضافة أنه ينتشر بسرعة كبيرة في عدد من دول العالم. الإشكالية تحتاج إلى إجراءين اثنين الأول يتمثل في مواجهة حملات التشويه والتضليل والدعاية والحرب النفسية وهذا يحتاج إلى عمل استراتيجي علمي ومنهجي يقوم على هندسة الإقناع ولغة الأدلة والحجج والبراهين والمنطق. أما الإجراء الثاني فيتمثل في الاستغلال الأمثل للمكانة التي تحتلها البلاد الإسلامية في الخريطة الاقتصادية العالمية فهناك خمس دول إسلامية وهي الجزائر وتركيا وباكستان وإندونيسيا ومصر تشكل إلى جانب دول أخرى دول المحور التي تحسب لها أمريكا حسابات كبيرة في سياستها الخارجية. لقد زادت أحداث 11 سبتمبر من حدة صراع الحضارات لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب على مصراعيه لمئات الآلاف في الغرب لدراسة الإسلام وفهمه والتعرف على الآخر والتحاور معه. فالعالم اليوم شرقه وغربه أمام تحديات كبيرة جدا تتمثل في التحاور والتفاهم من أجل الأمن والاستقرار وإيجاد نظام عالمي عادل ومتكافئ ينعم فيه الجميع بالاحترام المتبادل والتعايش السلمي. تتميز العلاقة بين الغرب والإسلام بالمواجهة بدلا من الحوار، وبالتقصير من قبل الجانبين في تحقيق الفهم والتعاون لتجنب العداء والصراع. كيف ينظر كل طرف إلى الآخر ولماذا انتشرت ثقافة الخوف والصراع والاستئصال بدلا من التفاهم والتكامل والتعايش؟ ماذا يمثل الغرب للمسلمين؟ هل يمثل المسيحية أم العلمانية أم الإلحاد؟ هل يرمز إلى الثورة الاقتصادية والثورة المعلوماتية والمجتمع الرقمي والتنوير وحقوق الإنسان والحريات الفردية وحرية الفكر والرأي، أو تمثله الفاشية والعنصرية والاستعمار والهيمنة، أم أن الغرب تمثله كل هذه المقومات والعوامل والظواهر؟الغرب مفهوم ضبابي تمثله كل التناقضات والظواهر والعوامل السابقة والتي قد يناقض بعضها البعض. ما يُقال عن الغرب يُقال عن الإسلام كذلك حيث إننا لا نستطيع أن نتكلم عن مجتمع إسلامي مثالي خال من أي تأثير للثقافة والحضارة الغربيتين. كما أن العالم الإسلامي ليس عالما متجانسا بالضرورة، فهو عالم يتسم بتناقضات داخلية عديدة ومتنوعة، قد تكون في بعض الأحيان حادة. من جهة أخرى نلاحظ أن الغرب لا يعني بالضرورة الديانة المسيحية وأنه عالم لا يسكنه سوى الأوروبيين؟ الغرب يحتوي على جنسيات وديانات عديدة ومختلفة ومنها الديانة الإسلامية. فهناك ملايين المسلمين يعيشون في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ففي عصر العولمة هناك تداخل مستمر وخليط ومزيج بين الثقافات والمعتقدات والديانات وأنماط المعيشة. وهنا نلاحظ أن الإسلام كدين، يؤمن بهذا التنوع ويحترم الأديان والمعتقدات الأخرى، فالتنوع والاختلاف والتمايز هي سنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل، فالإسلام يرفض مذهب الصراع والتصادم ويمجد التدافع الحضاري وفلسفته. جاء في كتابه سبحانه وتعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون" المائدة:48."يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير" الحجرات:13.
993
| 13 سبتمبر 2014
في مساق "وسائل الإعلام والمجتمع" في قسم الإعلام بجامعة قطر، كنت دائما أطرح السؤال التالي: ما هو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني القطري المفضل لديكم؟ ولماذا؟ فكان الاختيار الأول للطلبة برنامج "وطني الحبيب" "لأنه برنامج الشعب، برنامج الجماهير، برنامج الصراحة والشفافية، برنامج طرح المشاكل والقضايا والبحث عن حلول لها.برنامج يجد الجمهور نفسه فيه لأنه يخاطبه ويعطيه فرصة للكلام والتعبير عن رأيه بكل حرية وديمقراطية وبدون رقيب"، هذا كلام الطلبة.. البرنامج الإذاعي الشهير والمتميز "وطني الحبيب صباح الخير" هو مثال وقدوة للإعلام المسؤول والفاعل والمؤثر والمتفاعل مع المجتمع. هذا البرنامج في إذاعة قطر هو الإعلام الحقيقي الذي يطرح قضايا وهموم وانشغالات ومشاكل واستفسارات المواطن والوافد على حد سواء. برنامج يجمع المسؤول والشعب عبر الأثير للرد على الاستفسارات والأسئلة وانشغالات واهتمامات الجمهور. برنامج إذاعي متميز هدفه هو طرح القضايا المجتمعية الهامة كالازدحام المروري، ارتفاع الأسعار، مشاكل الخدم، التركيبة السكانية، الرسوم الدراسية وغيرها كثير من القضايا والمشاكل اليومية التي يعاني منها المجتمع. مثل هذه البرامج ترفع مستوى الوعي والمسؤولية في المجتمع، وتنمي الحس الوطني عند الفرد في المجتمع. فهي منبر للحوار والنقاش والرأي والرأي الآخر، وهي كذلك برامج تقوي وتغذي المجتمع المدني بوسيلة وقناة تجمع المواطن بالمسؤول لتنمية روح المسئولية والمواطنة والولاء والدفاع عن الحق والصالح العام. مثل هذه البرامج تساعد صاحب القرار على التعرف على نبض الشارع وعلى حقيقة الواقع بدون تضليل ولا تزييف.فالإعلام في أي مجتمع هو مفتاح الديمقراطية والحكم الراشد فهو أساس الرقابة الذاتية والنقد الذاتي والصراحة والشفافية. فالإعلام الهادف والمسؤول والفاعل في المجتمع هو الإعلام الملتزم الذي يساير التغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. تثار في الأوساط العلمية والأكاديمية من حين لآخر حوارات ساخنة حول المنظومة الإعلامية ودورها في المجتمع وما تستطيع أن تفعله من بناء وتوعية ومساهمة في التغيير والتشييد والتنمية الشاملة وكشف الحقائق والتجاوزات والأمراض الاجتماعية والأخطاء المختلفة التي تشل العمل الهادف والناجح. فالإعلام سلاح ذو حدين؛ فقد تكون المنظومة الإعلامية عالة على المجتمع وهذا من خلال نشر ثقافة التلميع والتبسيط والتهميش والتركيز على القشور وإهمال الجوهر. هذا النوع من الصحافة هو النوع السلبي الذي لا يغيّر الأمور ولا يساهم في صناعة الأحداث وعادة ما تنكشف أموره عندما تتأزم الأوضاع وتسوء الأحوال.إعلام التلميع والتملق يكون همه الوحيد هو إرضاء المسؤول بكل الطرق والوسائل، همه الوحيد هو تكريس النظام والمحافظة على الوضع الراهن. فهمه الوحيد هو التبجيل والمدح والتسبيح. فالرسالة والأجندة في هذه الحالة تكون شيء والواقع شيء أخر. وبدلا من أن تكون المنظومة الإعلامية سلطة رابعة تراقب السلطات الأخرى وتكشف عن هموم ومشاكل الشارع وتطرح القضايا المصيرية للأمة للنقاش والحوار نجدها تعمل على تلميع السلطة. الضمير هنا غائب تماما حيث يقوم الصحافي بعملية تزييف وتضليل وتشويه منتظمة، مستمرة وبطريقة عفوية وتنحصر المهمة والرسالة في هذه الحالة في التبجيل والتسبيح الأمر الذي لا يضيف شيئا للمجتمع بل يسهم في نشر ثقافة التزييف والتضليل والنفاق الاجتماعي. وهكذا يصبح الصحافي ومؤسسته الإعلامية بعيدين كل البعد عن خدمة المجتمع وكشف الحقيقة والمشاركة في صناعة القرار والأحداث وتغيير الواقع.. صحافة التلميع تفرز رأيا عاما مزيفا مضللا. وقد يفاجئ هذا الرأي العام نفسه في ظل هذه الصحافة من حين لأخر بالأزمات وبالواقع المرير الذي يعيشه حيث التباين الكبير بين ما يُنشر في الصحف وما تبثه وسائل الإعلام والواقع. وهنا يبدأ التفكك وانهيار المصداقية بين الرأي العام والوسيلة الإعلامية حيث إنه آجلا أم عاجلا يكتشف الرأي العام أن ما يصله من رسائل إعلامية بعيد كل البعد عن الواقع. هل من رسالة يؤديها الصحافي في المجتمع؟ هل من مبادئ يؤمن بها ويعمل جاهدا على تطبيقها؟ هل من حقيقة يبحث عنها ويتعب من أجلها ويخاطر ليلا نهارا لإيصالها للقارئ الذي يعتبر رأس ماله؟ هل الهدف هو كشف أمراض المجتمع وتناقضاته وتجاوزاته؟ أم الهدف هو التملق والتلميع والتقارير المزخرفة والملونة والتي تهدف إلى إرضاء المسؤول باستعمال كل الطرق وكل الوسائل؟ هذه التساؤلات تظهر تافهة لا محل لها من الإعراب في قاموس الصحافة المسؤولة والفاعلة وقاموس السلطة الرابعة، لكن في مجتمعاتنا العربية ما زالت تُطرح ويجب علينا أن نطرحها باستمرار وبجدية ولأكثر من سبب. أولهما أن معظم المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي ما زالت لم ترق إلى مستوى المؤسسة الإعلامية الاجتماعية المسؤولة والمدركة للدور التي يجب أن تلعبه في المجتمع والدليل على ذلك مئات الفضائيات العربية التي تعتبر دكاكين لبيع الإعلانات والرسائل القصيرة وتحقيق الأرباح بأي وسيلة وطريقة. أما السبب الثاني فيتمثل في الموضة الجديدة التي ظهرت في بعض الفضائيات العربية والتي ابتكرت نوعا جديدا من الإعلام وهو إعلام "التمظهر" و"الشوبيز" والبحث عن الجمهور بكل الطرق والوسائل.إعلام التملق والتلميع والتسبيح يعمل على تسطيح التفكير والنظر إلى القضايا الجوهرية في المجتمع. يهدف إلى تغليط الرأي العام والتضليل وكل ما يتناقض مع أخلاقيات المهنة الشريفة والعمل النزيه، المهم هنا هو الحماس والتعبئة والتجنيد وليس التحليل واستقصاء الواقع والبحث عن الحقيقة واحترام الرأي الآخر والنقاش السليم والبناء. الهدف هنا هو ليس إرضاء الحاكم أو صاحب السلطة السياسية أو المالية وإنما البحث عن الحقيقة واستقصاء الواقع من أجل الصالح العام.الإعلام الذي يحتاجه المجتمع هو الإعلام الفعال الذي يخاطر ويغامر ويجازف من أجل إنصاف المسكين المهمش الضعيف المهضومة حقوقه، الإعلام الذي يقف أمام سلطة المال والسياسة، التي تستعمل كل السبل والوسائل والطرق التي تخرج عن الأعراف والقوانين والأخلاق لتحقيق أهدافها وأطماعها ومصالحها على حساب الفئات العريضة من المجتمع. الإعلام العربي اليوم بحاجة إلى صحافة فاعلة، صحافة تقف إلى جانب الضعيف تنصفه وتحميه من جبروت النفوذ المالي والسياسي. مع الأسف الشديد ورغم مرور عقود من الزمن من استقلال الدول العربية ومن الممارسة الإعلامية فيها ما زلنا في عهد صحافة التلميع وإذا خرجنا عنها من حين لأخر فنجد أنفسنا أمام صحافة " التمظهر" والفلكلور و"الشوبيز" وصحافة التسطيح والتهميش والتبسيط، صحافة تخلق ذوقا هابطا لا يفيد في شيء بل يساهم في ذوبان شبابنا في الآخر.أصبحت الصحافة القوية الفاعلة في عصرنا الراهن هي بارومتر الديمقراطية والتقدم والازدهار وهي صانعة الرأي العام القوي والفعال الذي يطيح بالمسؤولين والحكومات وقادة الأحزاب الفاسدة. فالمواطن العربي اليوم لا يتقبل احتكار المعلومة ولا التضليل والتزييف ولا فبركة الواقع. كما أنه لا يقبل بالرقابة والحذف والإعلام العمودي، التحديات كبيرة وضخمة والتغير في الميدان لا يكتب له النجاح إذا لم تتغير العقول وطريقة التفكير والتعامل مع الآخر. والمؤسسة المرشحة بامتياز للقيام بعملية التغيير الفكري والذهني وتغيير السلوكيات والعادات السيئة والخاطئة قبل التغيير المادي، هي المؤسسة الإعلامية إذا تحلت بالمسؤولية والالتزام والمهنية وإذا تبنت منطق الحوار والنقاش من أجل خلق سوق حرة للأفكار وإفراز مجتمع مدني قوي وفاعل، فمزيد من التألق والنجاح لبرنامج "وطني الحبيب" الذي نأمل أن نرى مثله الكثير في أرجاء الوطن العربي.
1473
| 06 سبتمبر 2014
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
13197
| 20 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1782
| 21 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1383
| 18 نوفمبر 2025

في لحظة تاريخية، ارتقى شباب المغرب تحت 17...
1164
| 20 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1134
| 18 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
969
| 20 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
912
| 20 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
804
| 18 نوفمبر 2025

يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت...
705
| 17 نوفمبر 2025
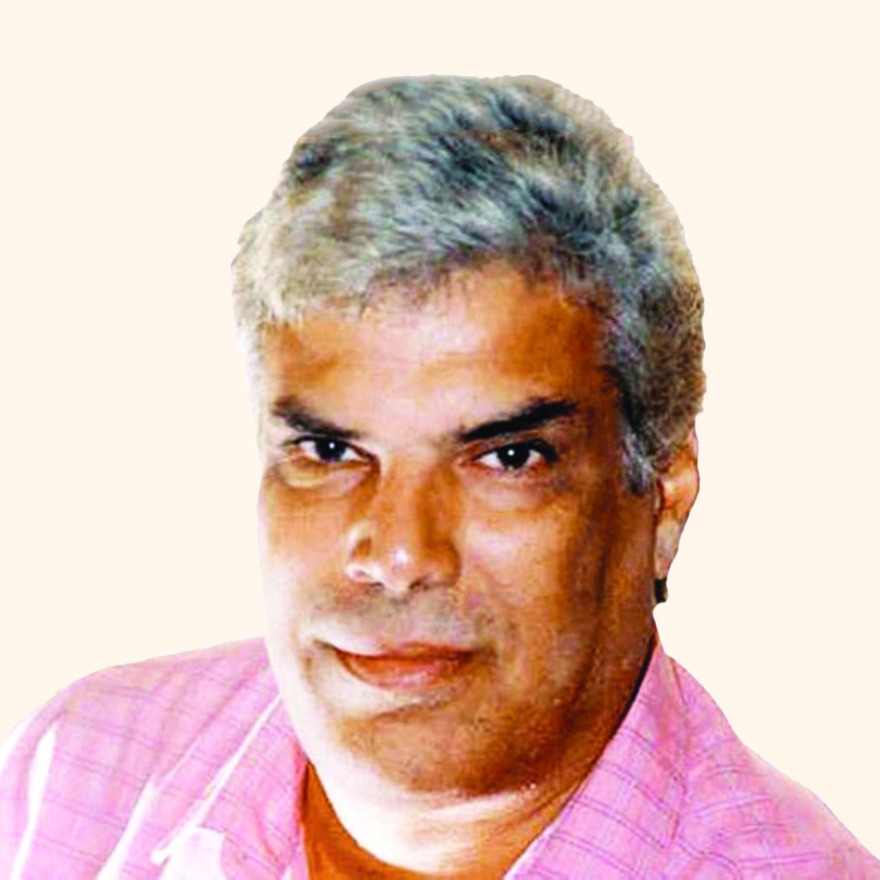
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
648
| 20 نوفمبر 2025

المترجم مسموح له استخدام الكثير من الوسائل المساعدة،...
621
| 17 نوفمبر 2025
مع إعلان شعار اليوم الوطني لدولة قطر لعام...
615
| 19 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







