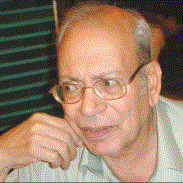رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يفقد الغزال رغبته في الحياة، حين يقع في الأسر. والفارق بين الحصان البري والحصان المستأنس فارق كبير، فالأول ينطلق في البراري شامخاً ومثيراً للإعجاب، أما الثاني فإنه لا يتحرك إلا بأوامر من يمتطي صهوته. وفي حدائق الحيوان يتجمع الأطفال – دون خوف – أمام قفص الأسد الذي يبدو ذليلاً ومنكسر الروح، لكن الأطفال ومعهم الكبار لابد أن يصابوا بالرعب لو تخيلوا أنهم تائهون في غابة، يحكمها الملك – الأسد.عشق الحرية كامن في قلب كل من الغزال والحصان البري والأسد، فبدون الحرية تصبح الحياة ذاتها بغير طعم، ولا شيء فيها يستحق عناء الاهتمام. هذا عن الحيوان، فما بالنا بالإنسان الذي يتصور أنه أرقى الكائنات؟. على امتداد الحضارة الإنسانية فوق سطح الأرض، لم يتوقف الصراع الطويل والمرير بين الذين يسلبون الآخرين حريتهم وبين من فقدوا هذه الحرية. غياب الحرية أبشع أنواع القهر. المنفى مرعب لأنه يقيد حرية الإنسان في العيش فوق أرضه التي يحبها، والسجن مرعب، لأن الإنسان في داخله لا يتحرك كما يشاء، وإنما يظل في دائرة، ينسى خلالها حركة الزمان، والقتل مرعب لأنه يلغي حرية الإنسان في أن يظل حياً مثل سواه من الناس الأحياء.الدكتور زكريا إبراهيم واحد من أهم أساتذة الفلسفة الراحلين في عالمنا العربي، وقد أصدر سلسلة من الكتب العميقة، لكن أسلوبها سهل وجميل، وبالتالي فإنه ييسر على القارئ العادي قراءتها، ويختص كل كتاب من تلك السلسلة بدراسة مشكلة واحدة محددة، فهناك – مثلا - مشكلة الإنسان ومشكلة الحب ومشكلة الحياة، إلى جانب كتاب مشكلة الحرية، الذي صدر في طبعته الأولى سنة 1957 ثم توالت طبعاته بعد تلك السنة، وفي مقدمته للطبعة الأولى يرى الدكتور زكريا إبراهيم أنه: ليس في لغات البشر كلمة تخفق لها القلوب قدر ما تخفق لكلمة الحرية، ولكن ليس بين مشاكل البشر مشكلة حارت لها الأفهام قدر ما حارت لمشكلة الحرية، فالإنسان هو في الأصل موجود طبيعي، ولكنه بين الكائنات جميعا أشدها حنينا للتخلص من جبرية الظواهر، وأقواها نزوعا نحو التحرر من أسر الضرورة.إذا كانت للحرية جوانب متعددة، فإن ما أشير إليه هنا يتعلق بالجانب السياسي وليس الفلسفي، حيث يواجه عشاق الحرية في كل مكان وزمان ما يواجهونه من سدود وقيود، تحاول التصدي لأشواقهم لها، وهذا ما صوره أجمل تصوير كثيرون من شعراء العالم، ممن عبروا عن أشواقهم وأشواق عشاق الحرية، وقاموا بحث الناس على عدم الاستسلام لما يفرضه الطغاة من الحديد والنار، ولعلنا نتذكر هنا البيت الشهير لأمير الشعراء العرب - أحمد شوقي: وللحرية الحمراء باب - بكل يد مضرجة يدق، وإذا كان الشعراء يبدعون ما يبدعون وهم يتصدون لقضايا سياسية معينة في زمان كل منهم، فإن ما يتبقى لنا مما أبدعوه يتمثل في القصائد التي تستطيع تجاوز الزمان الذي كتبت فيه، منطلقة إلى قلوب الناس في كل زمان ومكان، ومن هذه القصائد قصيدة الحرية للشاعر الفرنسي الكبير بول إيلوار، وهو ابن إحدى العائلات الفرنسية الكادحة، وقد ولد يوم 14 ديسمبر سنة 1895 ورحل عن عالمنا يوم 18 نوفمبر سنة1952 وخلال حياته لم يتوقف عن النضال الثوري ضد الطغاة والمحتلين، حيث كان أحد شعراء المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي الألماني لوطنه فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية، وهذا ما تكرر في أرضنا العربية فيما بعد، حين انطلقت قصائد توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم وسواهم من شعراء المقاومة الفلسطينية الذين واجهوا بالكلمة المقاتلة آلة القمع الصهيوني في فلسطين العربية، وتبقى قصيدة الحرية لبول إيلوار قصيدة متجددة ونابضة بالحياة وبالعنفوان، لأنها من القصائد الرائعة التي استطاعت الخروج من زمان كتابتها، لكي يقرأها من لم يقرأها من أبناء الأجيال الجديدة في أرضنا وفي أراضي سوانا من المتعطشين للحرية.
1864
| 30 يناير 2014
خلال مراحل التكوين الفكري والثقافي المبكرة، يحلم الشاب الصغير بأن يحقق ما لم يحققه الآخرون ممن سبقوه، وهذا ما أشار إليه أبو العلاء المعري حين قال مباهيا ومتفاخرا: وإني وإنْ كنت الأخيرَ زمانُه- لآتٍ بما لمْ تستطعه الأوائلُ، ويظل هذا الشاب الصغير يحلم على قدر طموحاته المتوثبة والزاخرة بالعنفوان، إلى أن يقنع شيئا فشيئا بما استطاع أن يصل إليه، خصوصا حين تكون طموحاته أكبر من قدراته وإمكانياته، وهذا الذي أقوله يدفعني لأن أضحك الآن من نفسي، حين أتذكر أني- على صعيد الاهتمامات السياسية خلال المرحلة الثانوية- كنت أجمع بين متناقضات، متصورا أن بإمكاني المزج بينها أو صهرها في بوتقة واحدة، ليتشكل منها مزيج جديد وفريد، حيث كنت معجبا- في آن واحد – بكل من أدولف هتلر وفلاديمير إيليتش لينين والمهاتما غاندي؟!.. إنها مرحلة العبث مع الأمواج قرب الشاطئ قبل أن يتعلم الإنسان السباحة، ثم يحدد وجهته ومقصده. منذ زمن بعيد، كنت قد قرأت مقالا مطولا عن كتاب كفاحي-mein kampf- وهو الكتاب الشهير الذي كتبه الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.. وهكذا قررت وقتها أن أتعلم اللغة الألمانية لكي أقرأ هذا الكتاب بلغته الأصلية، وبالفعل فإني التحقت خلال العطلة الصيفية بمعهد موريس للغات بالقاهرة، وربما لا يصدقني أحد الآن إذا قلت إن ما دفعته نظير شهر كامل من التعليم كان جنيها مصريا واحدا، أما المدرس الذي كان يشرح لي ولمن كنت معهم فقد كان رجلا نمساويا شديد الأناقة في مظهره، وشديد الدقة في الشرح والتوجيه، وفيما يتعلق بلينين فإن المركز السوفييتي الثقافي تكفل بحصولي على كتب مجانية عديدة عنه، من بينها قصيدة طويلة كتبها شاعر الثورة فلاديمير ماياكوفسكي، وهي مترجمة للغتنا العربية الجميلة، أما غاندي فقد حببني فيه كتاب جميل صغير للعملاق عباس محمود العقاد.أضحك الآن من نفسي، لأني لم أستطع أن أمزج بين التعصب القومي الأعمى الذي دعا إليه هتلر، والعنف الذي أراد به لينين أن يحقق المساواة بين الطبقات كما تصور، والتسامح الإنساني النبيل الذي انطلق لتحقيقه غاندي، فهؤلاء بالطبع يشكلون متناقضات، لا يمكن مزجها أو صهرها في بوتقة واحدة، وبعيدا عن مرحلة العبث مع الأمواج قرب الشاطئ، فإني أتوقف الآن عند هتلر وحده، بعد أن اكتشفت- منذ عدة أيام قلائل- أنه قد عاد من جديد ليكتسح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما نعرفه جميعا من أنه قد انتحر هو وعشيقته إيفا براون يوم 30 أبريل سنة1945.. وعلى أي حال، فإن هذا الاكتساح الجديد يختلف تماما عن ذلك الاكتساح الذي أصبح مجرد صفحات مروعة ومفزعة من صفحات تاريخ الصراع الإنساني على وجه الأرض.على امتداد ست سنوات، اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية(1939 – 1945) بعد أن رفع هتلر شعارا مثيرا لإعجاب الجماهير الألمانية وقتها، وهو شعار ألمانيا فوق الجميع، وهكذا اندفعت قواته العسكرية اندفاعا فجائيا للقيام بغزو بولندا، على إيقاع خطبه النازية النارية، وخلال ثلاث سنوات كانت ألمانيا قد اكتسحت معظم دول أوروبا، باستثناء بريطانيا، لكن غرور القوة أعماه عن المصير الذي حاق بجيوشه الجرارة عندما قرر أن يحتل أراضي الاتحاد السوفييتي، فقد حجب ذلك الغرور عن عينيه وعن تفكيره أن يتذكر المصير البائس الذي حاق بجيش نابليون بونابرت عندما حاول قبله غزو روسيا القيصرية سنة 1812، حيث وقف السوفييت- بكل بسالة- يدافعون عن وطنهم، ثم انطلقوا للهجوم المضاد، وأخذوا يطاردون الجيوش الألمانية من أرض إلى سواها إلى أن وصلوا إلى ألمانيا، بل إلى قلب برلين ذاتها، حيث كان هتلر يختبئ في مخبأ سري تحت الأرض، وكان عليه أن يتخذ آخر قراراته، وهو الإقدام على الانتحار، ولم تعد ألمانيا- كما كان يريد- فوق الجميع!منذ عدة أيام قلائل- كما ذكرت- اكتشفت أن هتلر قد عاد من جديد ليكتسح دول أوروبا، بل ليعبر المحيط، كي يكتسح الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الاكتساح لم يرعبني، وإنما أضحكني، لأنه اكتساح بلا قنابل وبلا صواريخ وليس فيه قتل وتدمير، فهو اكتساح يقوم به كتاب كفاحي-mein kampf- الذي كنت قد قررت- خلال مرحلة دراستي الثانوية- أن أتعلم اللغة الألمانية خصيصا لكي أقرأه بلغته الأصلية، فالآن عرفت- من خلال ما قرأت- أن هذا الكتاب قد تصدر قائمة أكثر الكتب الإلكترونية مبيعًا، بسبب إمكانية قراءته على الكمبيوتر اللوحي، بعيدًا عن أعين الآخرين، وفي هذا السياق يقال إن أكثر من 12 ترجمة إنجليزية لكتاب كفاحي قد أُنزلت نحو 100 ألف مرة من موقع واحد على الإنترنت هو موقع Archive الذي يوفر الطبعة الإلكترونية من الكتاب مجانًا.. كما أُدرج الكتاب على قائمة شركة أمازون لأكثر الكتب مبيعًا، إذ تصدر كفاحي الذي يُباع مقابل 99 سنتًا قائمة الكتب المباعة، وفي بريطانيا تصدر كفاحي الإلكتروني، الذي يباع مقابل 99 بنسًا، قائمة الكتب الأكثر مبيعًا. هتلر اكتسح دول أوروبا في عنفوان جبروته، ثم انتحر سنة 1945 بعد أن تجرع ما تجرع من هزيمة، وها هو كتابه "كفاحي" يكتسح نفس تلك الدول في مستهل سنة 2014، كما يعبر المحيط ليغزو الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الكتاب ليس كالإنسان، فالكتاب لا يستطيع الانتحار، وهنا أتوقف لأسأل: ما سر هذا الاكتساح الجديد؟
1026
| 17 يناير 2014
لا تستطيع امرأة "حلوة" أن تقف أمام المرآة لكي تكمل زينتها إذا كان حريق مفزع ومروع يلتهم أثاث بيتها، ويكاد يقترب من أطراف ثوبها.. ولا يستطيع رجل أنيق أن يحتفظ بأناقته إذا كان مضطرا لأن يخوض في مستنقعات الشارع الذي يمشي فيه، وعليه في هذه الحالة البائسة أن يحتفظ بتوازنه حتى لا ينزلق في الأوحال.. ولا تستطيع الساحة الأدبية والثقافية العربية أن تتذكر الراحلين من الأعلام الكبار إذا كان الراحلون يرحلون، بينما أمواج السياسة المتقلبة تجبر الجميع أن يحاولوا النجاة بأنفسهم من تقلباتها وتشنجاتها، وخصوصا إذا كانت هذه التقلبات والتشنجات لا تتيح الفرصة لأحد منهم لكي يتذكر ما حوله ومن حوله، حيث تبدو الحركة مربكة مرتبكة، وحيث يتحول النظام- حتى لو كان قاسيا- إلى فوضى مدمرة، ولو قيل عنها إنها فوضى خلاقة، وقد يتحقق من بعدها ما تتمناه النفوس المشتاقة! هذا حقا ما أشعر به حين أفاجأ بأن أديبا كبيرا قد رحل عن عالمنا، دون أن يتحدث أحد عن الخسارة الفادحة النابعة من فقد مثل هذا الأديب الكبير، وربما تتفضل الجرائد اليومية بكتابة عدة سطور تنعى فيها هذا الذي رحل، فليس لدى من يكتبون وقت يضيعونه إلا في المناوشات والمشاحنات وصب مزيد من الزيت على النار التي ما تكاد تخمد إلا وتشتعل من جديد، أقول هذا والحسرة تتملكني بعد رحيل شاعرين عربيين كبيرين عن عالمنا، دون أن تكون هناك إشارات حقيقية جادة تجاه الخسارة الفادحة النابعة من فقد كل شاعر منهما، رغم أنهما كانا ملء السمع والبصر، وكانا نجمين ساطعين في سماء الأدب العربي المعاصر..هذان الشاعران العربيان الكبيران هما سليمان العيسى ومحمد الفيتوري، وقد رحل كل منهما في قلب العاصفة القاصفة التي تجتاح أرضنا العربية، دون أن تترك لأحد فرصة التقاط الأنفاس.لسليمان العيسى ومحمد الفيتوري عطاء شعري رائع، تحتضنه مجلدات الأعمال الشعرية لكل منهما، وقد أسهم كل منهما في إثراء الشعر العربي بما أبدعاه وخلفاه للأجيال العربية المقبلة، إذا كان لدى أبناء هذه الأجيال متسع من الوقت- فيما بعد- للقراءة وللتذوق واكتشاف ملامح الجمال الفني واستيعاب جوهر الروح العربية التي يحاول كثيرون من الآخرين أن يشوهوها، مثلما أساء إليها كثيرون منا نحن العرب.. وإذا كان كل منا يعتز ويتباهى بجواز سفره الذي ينتمي إلى هذه الدولة العربية أو تلك، فإن المبدعين العرب الحقيقيين والجادين يعتزون ويتباهون بأن ما يبدعونه لا يتوجه إلى أبناء الدول العربية التي ينتمون إليها وحدهم، وإنما يتوجه إلى كل أبناء العروبة في كل أرض "مشرقية" أو "مغاربية"، وهذا ما نجده متحققا- بأجمل صورة- في العطاء الشعري الذي أبدعه سليمان العيسى ومحمد الفيتوري، وبالطبع فإن لكل منهما شخصيته الفنية المستقلة وصوته الشعري الخاص، لكنهما يتقاربان ويتشابهان في الإحساس الحاد بالفقد، فقد ولد الأول ذات يوم من أيام سنة 1921 في قرية النعيرية إحدى قرى لواء الإسكندرون، وهو اللواء الذي ضمته تركيا إلى أراضيها فيما بعد، بينما ولد الثاني ذات يوم من أيام سنة1930 في الجنينة عاصمة دار مساليت على حدود السودان الغربية، ثم انتقل مع عائلته– وهو طفل صغير- إلى الإسكندرية في شمال مصر، وهكذا تجرع الطفلان مرارة فقد مكان الميلاد، وقد رحل الأول عن عالمنا يوم9 أغسطس سنة 2013 في دمشق، بعد أن كان مقيما في صنعاء على امتداد ما يزيد على خمس عشرة سنة، أما الثاني فقد رحل عن عالمنا يوم29 ديسمبر سنة 2013 بعد أن عاش سنوات من حياته في كل من مصر ولبنان وليبيا والمغرب، وكان والده الشيخ مفتاح رجب الفيتوري من المتصوفة الكبار، وقد تأثر الابن بطريقة الوالد في التعامل مع الحياة، وهذا ما يتجلى في ديوان "معزوفة" لدرويش متجول، وهو الديوان الذي يشتمل على قصيدة من أجمل القصائد الصوفية، بعنوان "ياقوت العرش".كنا- الصديق الجميل بابكر عيسى وأنا- نردد في سهراتنا قصيدة ياقوت العرش، وكان الفيتوري حين يزور الدوحة يسعد حقا حين نُسمعه أبياتها العذبة التي نحفظها عن ظهر قلب، وفي هذه القصيدة يقول الفيتوري: دنيا لا يملكها من يملكها أغنى أهليها سادتُها الفقراء الخاسرُ مَنْ لم يأخذْ منها ما تعطيه على استحياء والغافلُ من ظنَّ الأشياءَ هي الأشياء...أما سليمان العيسى، فإن أبناء جيلي- خلال سنوات المد القومي العربي- كانوا يرددون ما قاله وقتها بكل الصدق عن الزعيم الخالد جمال عبد الناصر: من المحيط الثائرِ إلى الخليج الهادرِ لبيك.. عبدَ الناصرِإذا كان الشاعران العربيان الكبيران سليمان العيسى ومحمد الفيتوري قد رحلا عن عالمنا، بينما العاصفة القاصفة التي تجتاح أرضنا العربية ما تزال تشغلنا وتؤرقنا وتسلب منا أرواح أحبابنا البسطاء الأبرياء، فإني أتمنى- من كل قلبي- أن يأتي اليوم الذي تحتفي فيه الساحة الأدبية العربية بعطاء كل منهما، لكن هذه الأمنية لن تتحقق إلا عندما يعود لأرضنا العربية الاستقرار الذي يتيح لها الازدهار.
767
| 09 يناير 2014
سكرنا من أغانيكم وذبنا في مآسيكم «فلا منكم» حُرمنا.. هذا ما نطق به أحد أمراء الأندلس، بعد ليلة جميلة، تناسق فيها إيقاع الأقدام وهي تدق الأرض بقوة وحيوية، متجاوبة مع كلمات الأغاني الجماعية التي ينشدها المغنون.. وبالطبع فإن هذه الحكاية ليست موثقة، لكنها تتردد بين حين وآخر، عندما يحاول أحدهم أن يفسر معنى «فلامنكو» من خلال التأكيد على أن أصل الكلمة عربي، حيث قال الأمير الأندلسي، أو قيل على لسانه «فلا منكم حُرمنا»! حتى الآن لم يتوصل أحد من الباحثين في تاريخ الموسيقى والغناء إلى تفسير منطقي أقرب إلى اليقين فيما يتعلق بأصل كلمة فلامنكو، ولم يستطع أحد أن يهتدي إلى بدايات هذا الفن الجميل وكيفية نشأته، وكأنه قدر له أن يظل غامضاً في طفولته، أو كأنه نبات فجائي، يواجهنا على غير توقع بأغصانه وأوراقه وزهوره المتنوعة. لكن المعروف أن إسبانيا وحدها هي التي تحتضن هذا الفن الجميل، دون سواها من الدول الأوروبية المحيطة بها، فضلاً عن سائر دول العالم، فحين نقول: فلامنكو تتبادر إلى أذهاننا إسبانيا والعكس صحيح كذلك، ونضيف إلى الفلامنكو بالطبع رياضة مصارعة الثيران التي يرى كثيرون من غير الأسبان أنها رياضة متوحشة، لا تراعي أبسط قواعد حقوق الحيوان!. وعلى أي حال، إذا كان هناك من يقولون إن أصل كلمة فلامنكو أصل عربي، ودليلهم «فلا منكم حُرمنا» وسواها من الأقوال الأخرى، فإن هناك آخرين يرون أن أصل الكلمة يرجع إلى ارتباطها بالشعب الفلمنكي، ولم يكن الأسبان يحبون هذا الشعب لأسباب تاريخية قديمة. وممن يقولون إن هناك مؤثرات عربية في الفلامنكو الباحث البريطاني نييل أردلي في كتابه الجميل «الموسيقى.. موسوعة شاملة» حيث يرى أن المؤثرات الآسيوية والشرقية تبدو واضحة في الموسيقى الإسبانية وفي موسيقى أوروبا الشرقية، وأن هذه المؤثرات جاء بها العرب والأتراك منذ قرون بعيدة، أما «المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية» وهو أحد الكتب المهمة للدكتور ثروت عكاشة فإنه يعرف الفلامنكو قائلاً: «أغنية الفلامنكو هي أغنية إسبانية أندلسية مصحوبة برقصة «نورية» على أنغام الجيتار، وتختلف باختلاف المدن التي تؤديها، ومن ناحيتي فإنني حاولت التعرف على أوجه الاختلاف في رقصات الفلامنكو، لكنني أتذكر هنا أنني وقفت - ذات مرة - مبهوراً أمام راقصة طويلة ممشوقة وجميلة، تؤدي رقصة تغمر الروح بالعنفوان، وقد أطلقت عليها المرأة – الرمح، والحقيقة أن هذه المرأة – الرمح هي التي ألهمتني قصيدة بعنوان فلامنكو إسبانيا الأندلسية، قلت فيها: الفلامنكو صبايا مستحمات بموسيقى كساها الكبرياء - في زمان عربي أبله النظرة يعدو صاغراً دون رداء - الفلامنكو عزاء - عندما أحضن يأسي.. في زمان عربي صادروا منه الرجاء! عندما نتعرف على الذين يؤدون رقصات الفلامنكو ويغنون أغانيه، نستطيع أن نتعرف على سر هذا الكبرياء الذي يغمر الرقص والغناء، فقد كان هؤلاء جميعاً ممن نسميهم الغجر أو النور ويسميهم الغربيون «Gipsy» وهؤلاء كلهم من القبائل التي تنتقل من قارة إلى قارة ومن دولة إلى أخرى، لكنهم لا يعيشون في المدن، وإنما يعيشون على أطرافها، وكأنهم من المنبوذين اجتماعياً، وإلى الآن فإن مجموعات من الغجر أو النور تعيش في مصر وسوريا وتركيا والمجر ورومانيا، وبالطبع في إسبانيا، من هذا المنطلق أستطيع القول إن الغجر أو النور يحاولون بأغانيهم ورقصاتهم التي تمتد طول الليل إثبات وجودهم في الحياة بما تموج به أرواحهم ونفوسهم من كبرياء وعنفوان، وما تختزنه أعماقهم من تمرد حاد على المجتمعات التي يعيشون فيها، نتيجة لإحساسهم بالتمييز العرقي أو العنصري ضدهم. أياً كان معنى كلمة فلامنكو فإنه فن يستحق التقدير، لأنه يزيح اليأس عن النفس، بل يغمرها بالعنفوان والكبرياء.
3487
| 29 نوفمبر 2013
في تصوري أن ما استطاع الشعراء العظماء أن يحققوه من نفاذ إلى أعماق الإنسان في كل زمان ومكان، ينبغي أن يذكرنا دائما بأن الشجرة المثمرة العملاقة كانت في البداية مجرد بذرة صغيرة، وعلينا- من هذا المنطلق- أن نعود إلى تلك البذرة الصغيرة، وأن نتعرف- بالتالي- على ما تحمس هؤلاء الشعراء العظماء لقراءته عندما كانوا أطفالا صغارا، وهنا ينبغي أن نتوقف عند الينابيع الشعرية العربية وغير العربية التي نهل منها هؤلاء جميعا، لكن علينا- قبل التوقف عند هذه الينابيع- أن نقتطف هذه الفقرة المهمة والدالة من كتاب ممتع ورائع للشاعر العظيم صلاح عبد الصبور، وهو كتاب حياتي في الشعر، حيث يقول في هذه الفقرة: إن الفنان يولد في الفن، ويعيش فيه، ويتنفس من خلاله. وكل فنان لا يحس بانتمائه إلى التراث العالمي، ولا يحاول جاهدا أن يقف على أحد مرتفعاته فنان ضال. وكل فنان لا يعرف آباءه الفنيين إلى تاسع جد لا يستطيع أن يكون جزءا من التراث الإنساني، وهو في الوقت ذاته لا يستطيع أن يحقق دوره كإنسان مسؤول في هذا الكون. لو أننا انطلقنا من هذا الإطار النظري الشامل الذي حددته تلك الفقرة، لكي نطبقه بشكل عملي على الشعراء العظماء وعلى عطائهم الشعري الذي أبدعوه خلال مسيرة كل منهم مع الحياة ومع الفن، فلا بد أن نتوقف عند عدد من آبائهم الفنيين حتى تاسع جد، بشرط أن ندرك أنهم قد تأثروا أو أعجبوا ببعض هؤلاء الآباء الفنيين تأثرا عابرا وسريعا خلال مرحلة تكوينهم الشعري المبكر، كما تأثروا بآخرين من هؤلاء الآباء الفنيين، ونهلوا من ينابيعهم الشعرية بصورة عميقة خلال مرحلة ما بعد التكوين واتضاح الرؤية والطريق أمامهم. حين نتحدث عن الشاعر العالمي توماس ستيرنز إليوت، لابد أن نعرف أنه بمثابة أب فني لشعراء كثيرين من شعراء العالم، ممن عايشوا فظائع الحرب العالمية الثانية، فقد تأثروا به بشكل أو بآخر، وعلى سبيل المثال فإني حين زرت اليابان سنة 1998 أجريت حوارات مع عدة شعراء يابانيين، ووجدتهم يشيرون إلى مدى تأثرهم بإليوت، بل إن أحدهم وهو الشاعر متسؤو تاكاهاشي أكد لي أنه لم يتأثر بشعر إليوت فحسب، وإنما جاراه- بشكل عملي- في رفض الحضارة الغربية الزائفة، حيث شيد لسكناه بيتا منحوتا في جبل، تحف به الخضرة والأشجار الرشيقة العالية، ويطل مباشرة على المحيط الهادئ، ومن الطريف أن هذا الشاعر الياباني قد أصر على أن يكون لقائي معه في بيته الجبلي، لأنه لا يحب طوكيو التي تنهج نهج الحضارة الغربية الزائفة! إذا ابتعدنا عن اليابان وعن شعرائها الذين تأثروا بإليوت، واقتربنا من حدود أرضنا المشرقية العربية، فلا بد أن نشير إلى الشاعر الإيراني أحمد شاملو الذي يبدو تأثره بإليوت تأثرا واضحا وجليا، فهذا الشاعر الكبير هو رائد الشعر الحر في إيران، وقد ولد في طهران سنة 1925 قبل أن يولد اثنان من رواد الشعر الحر العرب بسنة واحدة، حيث ولد كل من بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي سنة 1926 وكما كان السياب عضوا في الحزب الشيوعي العراقي واعتقل عدة مرات، فكذلك كان أحمد شاملو عضوا في حزب توده الشيوعي الإيراني، واعتقل سنة 1943 ولم يفرج عنه إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد رحل أحمد شاملو عن عالمنا يوم 23 يوليو سنة 2000 وله قصائد عديدة مترجمة من الفارسية إلى لغتنا العربية الجميلة، بما يتيح للمهتمين من الباحثين أن يعقدوا مقارنات نقدية بين حركتي الشعر الحر في كل من إيران وأقطار أرضنا العربية. وفيما يتعلق بساحتنا الأدبية العربية، فإننا نلاحظ مدى الاهتمام المتحمس بإليوت، وقد كان الناقد الموسوعي الكبير الدكتور لويس عوض هو الرائد الأول في ترجمة العديد من قصائده الشهيرة، وهي القصائد التي نشرها متتابعة في مجلة الكاتب الشهرية المصرية ابتداء من العدد الثاني الذي صدر في شهر مايو سنة 1961 ويضم هذا العدد ترجمة لقصيدة الرجال الجوف الشهيرة، وقد تتابع مترجمو إليوت بعد لويس عوض، وأذكر منهم الدكتور فائق متى والدكتور ماهر شفيق فريد والدكتور عبد الواحد لؤلؤة. أما الشاعران العربيان اللذان تأثرا بإليوت أكثر من غيرهما فهما بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور، ولهذا فإننا نجد عدة دراسات متخصصة، تتناول هذه القضية، أذكر منها دراسة مهمة وإن كانت متحيزة للسياب، هي دراسة الدكتور محمد شاهين الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت سنة 1992 وهي بعنوان إليوت وأثره على عبد الصبور والسياب، ومن الطريف أن أشير هنا إلى أن السياب يبدو متذبذبا في الألقاب أو الصفات التي كان يضفيها على إليوت على ضوء تقلباته السياسية، حيث وصف إليوت بأنه الشاعر الرجعي عندما كان عضوا في الحزب الشيوعي العراقي، ثم وصفه بعد ذلك بأنه شاعر العصر العظيم عندما تخلى عن هذا الحزب، بينما نجد أن إليوت ظل يحظى بكل صفات التكريم والتقدير من جانب صلاح عبد الصبور في حواراته وفي كتاباته عنه، لأن موقفه منه كان منطلقا من حس فني، وليس مرتبطا بموقف سياسي. هذا الذي قلته يعني أن السابقين يؤثرون في اللاحقين، وهذا ما نرصده في كل مجالات الحياة، حيث ينبثق كل جديد مما سبقه، حتى وإن ادعى المدعون غير ذلك!
1186
| 21 نوفمبر 2013
منذ إطلالة روائعه المبكرة قبل الإسلام، لم يكن الشعر العربي حكرا على من نسميهم الآن النخبة أو الصفوة، فقد كان الشاعر مصدر فخر للقبيلة التي ينتمي إليها، تماما مثلما تتباهى هذه القبيلة بالفارس الذي يدافع عنها ويحميها من غارات سواها عليها، ولم يفقد هذا الشعر الأصيل والجميل مكانته الاجتماعية إلا خلال عصور التردي والانحطاط أثناء هيمنة المماليك والعثمانيين، وحين انطلقت النهضة الأدبية الحديثة عاد الشعر إلى سابق عهده وعادت له مكانته الرفيعة على أيدي البارودي وأحمد شوقي وغيرهما من رواد تجديد الروح وضخ دماء جديدة قي الشكل العمودي المتوارث، ثم انطلقت تيارات التجديد بصورها وأنماطها المتنوعة عبر مدرسة الديوان وجماعتي المهجر وأبولو. شغلت القضايا الجماعية العامة حيزا كبيرا من اهتمام رواد النهضة الأدبية الحديثة، فعلى سبيل المثال تصدى أمير الشعراء أحمد شوقي لصراعات الأحزاب السياسية في زمانه، ورأى أنها صراعات عقيمة، ليس فيها منتصر أو مهزوم، فالكل في حالة خسران مبين: إلام الخلف بينكمو إلاما وهذي الضجة الكبرى علاما؟ وفيم يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصاما؟ كما تحدث شاعر القطرين خليل مطران عن الشعوب التي تستكين وتستسلم أمام ما تواجهه من ظلم واضطهاد دون أن تسعى للتغيير الذي يزيح عنها ما تنوء به، ورأى أن هذه الشعوب هي التي تطيل أعمار الطغاة، وهي التي تصنعهم نتيجة السكوت على المذلة والهوان: كل قوم خالقو نيرونهم قيصر قيل له أم قيل كسرى وهذا ما يفسر لنا سر اهتمام الجرائد اليومية وقتها بنشر تلك القصائد وسواها في صدر صفحاتها الأولى، وإذا كان الشعراء الرومانسيون قد اهتموا بما يشغلهم من قضايا ذاتية، فإن الشعر الحر على أيدي رواده الكبار قد حرص على أن يمزج بين ما هو عام جماعي وما هو خاص وذاتي، ويكفي أن نتذكر هنا كيف مزج بدر شاكر السياب بين عشقه للحبيبة واشتياقه للوطن عندما كان بعيدا عنه دون إرادته، حيث يقول في رائعته غريب على الخليج: لو جئت في البلد الغريب إلى ما كمل اللقاء الملتقى بك والعراق على يديّ هو اللقاء شوق يخض دمي إليه كأن كل دمي اشتهاء جوع إليه كجوع كل دم الغريق إلى الهواء... ظلت جسور التلاقي قوية ووطيدة بين شعرائنا العرب والجمهور المتذوق للشعر، إلى أن أطلت ما يسمونها– قصيدة النثر– وأطل معها الغموض الكثيف الذي جعل كتابات كثيرين ممن يكتبونها تبدو مثل الفوازير والألغاز، وقد تصور هؤلاء أن التعالي على الواقع والاغتراب المتعمد عن الروح العربية يتيح لهم أن يصبحوا شعراء عالميين مشهورين، فصار الواحد منهم يتباهى بأنه مدعو للمشاركة في مؤتمر للشعر العالمي في هولندا أو في أستراليا أو حتى في كوكب المريخ، ولكنهم حين يعقدون أو ينظمون أمسيات شعرية في أية دولة عربية يكتشفون دون أن يشعروا بالخجل والحرج أن القاعات خالية إلا من بعض أصدقائهم الذين حضروا للمجاملة أو للتسلي، وقد يتبجح بعض هؤلاء قائلين إنهم لا يكتبون للجمهور الجاهل والساذج بل يكتبون للنخبة وللصفوة، ويرى آخرون منهم أنهم يكتبون للأجيال القادمة، لأنهم شعراء خالدون وعظماء لكن الناس الجهلاء في زمانهم لا يفهمونهم! طالما أن هؤلاء الذين يكتبون لا يحسنون قراءة روائع الشعر العربي، وطالما أنهم يخطئون في قواعد الإملاء بدعوى أنهم يريدون أن يبتكروا لغة جديدة لم يسبقهم أحد لاختراعها، وطالما أنهم يتباهون بأنهم بعيدون كل البعد عن قضايا أرضهم العربية في مختلف الميادين والمجالات، فإن ظاهرة انهيار الجسور بينهم وبين الجمهور ستظل قائمة وقاتمة، ملقية بظلالها الخاوية على الساحة الأدبية في كل دولة عربية، وإذا كان هؤلاء قد نجحوا في شيء فإنهم نجحوا في تذكيرنا بعصور التردي والانحطاط أيام المماليك والعثمانيين!
1684
| 14 نوفمبر 2013
من شعرائنا العرب من يكتفون بأن يعرفهم القراء في الدول التي ينتمون إليها دون أن يطمحوا إلى أن تصل أصواتهم الشعرية خارج الحدود، لكن هناك آخرين يحرصون على التواصل الذي يقود إلى التفاعل فيما بينهم وبين غيرهم من شعراء العروبة، بصرف النظر عن البعد الجغرافي بين أوطانهم العربية، حيث يحرصون على تشييد جسور المحبة والتآلف التي تتيح لهم ولسواهم المساهمة في إثراء حركة الشعر العربي والعمل على ازدهارها، والتعرف على تجارب الآخرين وإبداعاتهم المتنوعة، وبطبيعة الحال فإن الجهود الفردية تظل محدودة، رغم أنها جهود مشكورة ومحمودة. هذا الذي أقوله عن الشعراء العرب ينطبق كذلك على وزارات الثقافة والمؤسسات الثقافية العربية، فمنها من تركز على المحيط المحلي وقد تتجاوزه إلى الإطار الإقليمي، ومنها وزارات ومؤسسات تتجاوز الساحة المحلية، وهي تنطلق لتؤدي رسالة عربية شاملة ومتكاملة، وعلى سبيل المثال فإننا نتذكر أن ربان سفينة الثقافة في قطر- الدكتور حمد عبد العزيز الكواري أقام منذ نحو سنة احتفالا لتدشين ما احتضنته قطر- ممثلة في وزارة الثقافة والفنون والتراث من دواوين لشعراء سودانيين كانوا يتمنون أن يصدروا إبداعاتهم الشعرية لكي ترى النور، لكن عوائق مادية وفنية كانت تقف بالمرصاد أمام أمنيات هؤلاء الشعراء الذين ينتمون للسودان الشقيق. وإذا كانت مؤسسة البابطين للإبداع الشعري تقوم بدور متميز في إثراء حركة الشعر العربي، فإن الهيئة المصرية للكتاب تقوم بين حين وآخر بإصدار مجموعات شعرية لشعراء عرب لا ينتمون لمصر، وإنما ينتمون لدول عربية أخرى شقيقة مثل تونس والمغرب وسلطنة عمان، وهذا ما يفعله كذلك المجلس الأعلى للثقافة الذي أصدر حديثا كتابا ضخما يتألف من مجلدين كبيرين، وهو بعنوان قاموس الشعر والشعراء من إعداد وتقديم الدكتور يوسف نوفل، ويحصي هذا الكتاب في المجلد الأول الدواوين والمختارات الشعرية التي أصدرها الشعراء العرب في كل من: الإمارات العربية المتحدة- البحرين- تونس- الجزائر- السعودية- السودان- سوريا- العراق- عمان- فلسطين والأردن- قطر- الكويت، أما المجلد الثاني فإنه يحصي دواوين ومختارات شعراء كل من: لبنان- ليبيا- مصر- المغرب- المهاجر الشمالية والجنوبية- موريتانيا- اليمن، ومن خلال ترتيب هذه الدول العربية نتبين أن قاموس الشعر والشعراء قد راعى الترتيب الأبجدي. فيما يتعلق بشعراء قطر فإن ترتيبهم- ابتداء من صفحة 361 من المجلد الأول- يخضع كذلك لحروف الأبجدية، وهكذا جاء في صدارتهم أحمد بن يوسف الجابر الذي جمع قصائد ديوانه الدكتوران يحيى الجبوري ومحمد عبد الرحيم كافود، ويتوالى شعراء قطر وفقا للترتيب الأبجدي، حيث يذكر قاموس الشعر والشعراء أعمال حصة العوضي- خالد عبيدان- زكية مال الله- سعاد الكواري- عبد الرحمن المناعي- عبد الرحمن بن قاسم المعاودة- علي بن سعود آل ثاني- علي ميرزا محمود- ماجد الخليفي- مبارك بن سيف آل ثاني- محمد بن خليفة العطية، فضلا عن آخرين عديدين. قاموس الشعر والشعراء جهد مشكور حقا، لكن الثناء عليه لا يعني أنه مبرأ من الأخطاء الفنية والتاريخية، وعلى سبيل المثال فإن هذا القاموس لم يشر إلى شعراء عرب عديدين، من بينهم فيما يتعلق بشعراء قطر الدكتور حجر أحمد حجر وسنان المسلماني ومعروف رفيق، كما أنني لاحظت أن دواوين عديدة لم تتم الإشارة إليها عند الحديث عن الشعراء الذين تمت الإشارة إليهم في القاموس، فضلا عن الوقوع في أخطاء تتعلق بسنوات صدور مجموعة من الدواوين، أو الإشارة إلى أنها قد طبعت في دول غير الدول التي طبعت فيها بالفعل، وأكتفي هنا بمثال واحد، حيث يذكر القاموس أن بعض دواويني قد صدرت عن المطبعة العالمية في القاهرة، بينما المطبعة العالمية موجودة في الدوحة، وهكذا... ومن هذا المنطلق أقول إن قاموس الشعر والشعراء الذي صدر عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة يحتاج لإعادة نظر عندما يصدر في طبعة جديدة، وهذا الذي أقوله لا يقلل بالطبع من الجهد الذي بذله معده الدكتور يوسف نوفل، فهو جهد مشكور.
561
| 07 نوفمبر 2013
أن نتعرف على الآخرين ممن يختلفون عنا في اللغة والدين والثقافة والعادات، فهذا يعني أن نهجر أوطاننا – ولو بصورة مؤقتة – لكي نرحل إلى حيث يقيم هؤلاء الآخرون المختلفون. بهذا المعنى تصبح الرحلة محاولة لاكتشاف الناس الذين لا نعرفهم والتعرف على طبيعة أوطانهم التي قد تتشابه أو تختلف عما ألفناه وعرفناه في أوطاننا، وقد لا يكون للرحلة من هدف إلا المتعة التي تنبثق من فرحة الاكتشاف، وقد تكون وراءها دوافع أخرى، من بينها التفكير في احتلال أوطان ليست لنا واستنزاف ثروات تلك الأوطان التي يفترض – عقليا وإنسانيا – أنها ثروات لأبنائها المنتمين إليها. في كتابه الصغير والجميل الرحلات، يتحدث العلامة الدكتور شوقي ضيف عن الرحلات الجغرافية التي قام بها العرب، وبصفة خاصة منذ عصر المأمون ابن هارون الرشيد، ويقول: إن الجغرافيين العرب قد اتبعوا طريقة ممتعة في وصف عالمهم والعوالم المحيطة بهم، إذ عنوا بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطباعها وما بديارها من آثار وعجائب، وقصوا ما عندها من أساطير وخرافات، وبذلك أصبحت كتبهم الجغرافية كتبا أدبية، تعتمد على المشاهدة وحكاية ما رآه الجغرافي تحت عينه وسمعه بأذنه، وهي من هذه الناحية أقرب إلى أن تكون كتب رحلات منها إلى أن تكون كتبا جغرافية بالمعنى الذي نفهمه اليوم. وينطلق الدكتور شوقي ضيف ليحدثنا – بصورة سريعة لكنها دقيقة – عن كتاب المسالك والممالك لابن حوقل، وكتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي، وكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبد الله محمد الإدريسي أكبر جغرافيي بلاد المغرب والأندلس، وهكذا نواصل معه إلى أن نصل إلى الرحلات البحرية، ومن بينها عجائب الهند.. بره وبحره وجزائره لبزرك بن شهريار الناخداه، ومن رحلات البحر وما فيها من متاعب ومغامرات إلى رحلات في الأمم والبلدان نمضي مع العلامة الكبير، حيث يحدثنا عن أبي حامد الأندلسي في شرقي أوروبا، وأسامة بن منقذ بين الصليبيين، ثم يفرد فصلا كاملا لرحلة ابن جبير الأندلسي ثم لرحلة ابن بطوطة وجولاته من الأناضول إلى بلاد المغول، وفي الهند، ومن قندهار إلى الصين. يكتسب كل إنسان منا – بدرجة متفاوتة – خبراته الإنسانية من مصدرين، أولهما التجربة المعاشة والشخصية، وثانيهما التجربة المكتسبة من آخرين، بما فيها الشغف بالقراءة بغية التعرف الذي قد يقود إلى الاكتشاف، أو بالمصدرين معا، وهذا هو الأعمق والأكثر فائدة ومتعة، ومن أشهر الرحلات التي امتزج فيها المصدران، التجربة المعاشة والتجربة المكتسبة، رحلة الرائد العظيم رفاعة رافع الطهطاوي إلى بلاد الفرنسيس، والتي سجلها في كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريز، ومن الطريف أن هذا الكتاب قد ترجم إلى اللغة الفرنسية ولاقى رواجا بين الفرنسيين والفرنسيات، لأنهم أحبوا أن يروا صورتهم هم من خلال عيني إنسان مصري – عربي – شرقي. بعد رفاعة رافع الطهطاوي، انطلق آخرون من العمالقة والمرموقين المشاهير إلى فرنسا وسواها من الدول الأوروبية الغربية، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هؤلاء الذين انطلقوا إلى الغرب من أبناء الشرق الشيخ محمد عبده وجورجي زيدان وميخائيل نعيمة وطه حسين وتوفيق الحكيم ويحيى حقي إلى أن نصل – على سبيل المثال – إلى الطيب صالح ورائعته الروائية موسم الهجرة إلى الشمال، وقد اهتم دارسون وباحثون أكاديميون من العرب والغربيين على حد سواء بدراسة تأثير الصدمة الحضارية التي وقع تحت وطأتها هؤلاء العمالقة والمرموقون المشاهير. من الكتب الممتعة والجميلة التي لا تصور رحلة واقعية، بل رحلة متخيلة تلك الكتب التي اصطلح على تسميتها أدب الخيال العلمي، ومنها كتاب عشرون ألف فرسخ تحت سطح الماء لجول فيرن، وكتاب مزرعة الحيوانات لجورج أورويل، أما الكتاب الممتع الذي قرأته منذ صباي، فهو كتاب يتحدث عن رحلة خيالية، وقد اشترك في كتابته طه حسين وتوفيق الحكيم، وهو كتاب القصر المسحور، الذي تقع فيه حوادث عجيبة ووقائع غريبة، من بينها عملية اختطاف توفيق الحكيم نفسه على أيدي أعوان شهر زاد، حيث تم اتهامه بأنه رجل عدو للمرأة ويريد أن ينتقص من مكانتها في المجتمع وفي الحياة، ولكي يتم الإفراج عن توفيق الحكيم كان لابد له أن يتحايل وأن يتجمل وأن يقنع شهر زاد بأنه ليس من طراز شهريار القاسي القلب والذي كان يقتل فتاة عذراء كل ليلة، منتقما من خيانة زوجته له، وذلك قبل أن تروضه شهر زاد بحكاياتها التي استسلم لها وكأنها مخدر سحري ينيمه هادئ الأعصاب ومرتاح البال! مقابل هؤلاء العمالقة والمرموقين الذين انطلقوا من أرضنا العربية إلى دول أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن كثيرين من العمالقة والمرموقين الغربيين والأمريكيين قد انطلقوا إلى أرضنا العربية، أما ما يجمع بين هؤلاء وأولئك فيتمثل في الرغبة في الاستكشاف والتعرف على الآخرين، رغم اختلاف دوافع كل منهم، فكأن هؤلاء جميعا يحبون الانطلاق، لكي يستمتعوا بنزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وأظن أن هذه النزهة لها جدواها، لأن لها مزاياها من جميع زواياها!
1146
| 03 أكتوبر 2013
رجل مجنون... هذا ما يتبادر إلى أذهاننا حين نصادف رجلا هائما على وجهه في الشوارع، ونراه وهو يكلم نفسه بصوت مرتفع دون أن يكون معه أحد يتوجه بكلامه إليه، لكننا لن نستطيع أن نلصق تهمة الجنون بالرجل الذي أحببته وما زلت أحبه وأتحدث عنه الآن، رغم أن هذا الرجل كان يتحاور مع الأشجار في الغابات، ويكلم الهواء في الصباح وفي المساء، قبل أن يرحل عن عالمنا منذ أربعين سنة! الرجل الذي أتحدث عنه الآن هو الشاعر العاشق بابلو نيرودا الذي ولد في إحدى قرى وطنه شيلي يوم 12 يوليو سنة 1904 ورحلت أمه عن عالمنا بعد شهر واحد من ولادته، بينما كان أبوه يعمل في السكك الحديدية، وهذا ما أتاح له- فيما بعد- أن يتنقل بالقطارات على امتداد أرض وطنه، وأن ترتسم في ذهنه ملامح الطبيعة الخلابة، وهي الملامح التي ظلت منعكسة بجمالها وجلالها على ما أبدعه من عطاء شعري متدفق ومتألق، وبفضل هذا العطاء فاز بابلو نيرودا بجائزة نوبل للآداب سنة 1971 أي قبل أن يرحل عن عالمنا بسنتين، وذلك يوم 22 سبتمبر سنة 1973 وعلى امتداد حياته ظل هذا الشاعر العاشق مخلصا وفيا لحبيبته الرائعة والساحرة، لكنه لم يكن يشعر بالحيرة أو بالغيرة، وهو يعرف حق المعرفة أن آخرين كثيرين من شعراء العالم يعشقون نفس الحبيبة الرائعة والساحرة، وأنهم جميعا يرددون اسمها الجميل العذب، حين يفتقدونها فيجرفهم الشوق العطشان للسعي إليها، وليس هذا عجيبا ولا غريبا، إذا عرفنا أن الحبيبة الرائعة والساحرة هي الحرية- معشوقة كل إنسان على وجه الأرض. كتب بابلو نيرودا عن الحرية بلغته الأم- الأسبانية، كما كتب شعراء العالم في زمانه عنها بلغاتهم الأم، فهناك- على سبيل المثال- ناظم حكمت الذي كتب عن الحرية بلغته التركية، وهناك بول إيلوار ولوي أراجون اللذان كتبا عنها بالفرنسية، وهناك برتولت بريشت الذي كتب بلغته الألمانية، وبالطبع فإن شعراءنا العرب الكبار كتبوا عن معشوقة كل إنسان بلغتنا العربية الجميلة، ومن منا يستطيع أن ينسى أمير الشعراء في صرخته المدوية: وللحرية الحمراء باب- بكل يد مضرجة يدق، وكما كتب شعراؤنا عن الحرية فإن المترجمين العرب الجادين قاموا بجهود مشكورة في ترجمة قصائد الشعراء العالميين الذين تغنوا بالحرية، عندما كانت الساحة الثقافية والأدبية العربية غير منعزلة ولا منفصلة عن سواها في أرجاء العالم. اهتم الدكتور محمود صبح- وهو مترجم عربي فلسطيني- بترجمة مجموعة كبيرة من قصائد شاعر شيلي العظيم بابلو نيرودا، وقد صدرت هذه المجموعة عن وزارة الثقافة العراقية في بغداد سنة 1974 كما قام بترجمة مذكرات بابلو نيرودا التي صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت سنة 1975 وأعيدت طباعتها سنة 1978 وتحمل هذه المذكرات المشوقة والممتعة عنوانا فرعيا هو: أعترف بأنني قد عشت، وإذا كنت قد أشرت من قبل إلى أن بابلو نيرودا كان يكلم الهواء، فذلك لأني كنت أستدعي إحدى قصائده الجميلة التي أحبها، وهي من ترجمة الدكتور محمود صبح، وعنوانها نشيد إلى الهواء، وعلى الرغم من أن القصيدة طويلة فإني سأحاول أن أشير إلى أجوائها، حيث يفاجئنا شاعر شيلي العظيم بأنه قد التقى مع الهواء: وأنا أسير في طريق، التقيت بالهواء، فحييته وقلت له باحترام: إنه ليسعدني أنك لأول مرة تدع شفافيتك، فهكذا نستطيع أن نتحدث، فرقص الذي لا يتعب، وهز أوراق الشجر، وحرك بضحكته الغبار عن نعلي، وظل يصغي... ما الذي قاله الشاعر للهواء عندما التقى معه في الطريق؟ لقد طلب منه أن يظل حرا، طلب منه ألا يبيع نفسه، فالماء باع نفسه! كيف هذا؟ هذا ما نعرفه من بابلو نيرودا وهو يقول للهواء: إن الماء باع نفسه- ففي القنوات بالصحراء رأيت القطرات وهي تشح، ورأيت العالم فقيرا، والشعب يمضي على ظمأ، يترنح في الرمال. وحين نمضي مع القصيدة نجد أن الماء ليس وحده الذي باع نفسه.. فقد رأيت نور الليل مقننا، لكن النور الكثير في بيوت الأغنياء، فكل شيء مشرق في الحدائق الجديدة الخاصة، بينما كل شيء معتم في ظلال الأزقة الرهيبة، فمن هذه الأزقة تخرج الليلة بلا حنان مثل زوجة الأب، تقسو على الأطفال بخنجر في عينيها، كأنهما عينا بومة! بعد أن يؤكد الشاعر للهواء أن الماء قد باع نفسه وكذلك فعل نور الليل، نجده يطالبه بإلحاح: كلا أيها الهواء.. لا تبع نفسك.. ولا تقبل أن يقننوك وأن يحبسوك في الأنابيب، وأن يخنقوك في الصناديق، وأن يحصروك في العلب، وأن يحشروك في الزجاجات. لماذا هذا الطلب من الشاعر؟ لأنه يريد من الهواء أن يكون للكل وليس حكرا على الأغنياء وحدهم، فالهواء هو كل ما يملكه الفقراء وهم يسعون لكي يروا ما سيأتي به الغد لهم. هذا هو بابلو نيرودا الذي نتذكره الآن في أجواء غيابه عن عالمنا منذ أربعين سنة، هذا هو الشاعر الذي أحب ملامح الطبيعة الخلابة، منذ أن كان يتنقل بصحبة أبيه في القطارات عندما كان صبيا صغيرا، وهذا هو العاشق الذي غنى للحبيبة الرائعة الساحرة- الحرية، وهو الذي التقى مع الهواء وطالبه بأن يظل متشيثا بحريته وبألا يبيع نفسه، لكي يكون متاحا ومباحا للجميع في كل أرجاء الأرض التي تضمنا جميعا، بصرف النظر عن الاختلاف في الدين أو اللون أو اللغة، هذا هو بابلو نيرودا الذي يعلمنا أن نتذكر المحبة، وأن يكون الإنسان محبا للإنسان، لا قاتلا له!
747
| 26 سبتمبر 2013
هناك كتاب وشعراء وفنانون رحلوا عن عالمنا وهم في ذروة شبابهم، ومن هؤلاء أسمهان وبدر شاكر السياب وأمل دنقل، وهناك آخرون عاشوا طويلا، لدرجة أن منهم من كان يطل خلال حياته من شرفة الثمانين أو التسعين، ومن هؤلاء فدوى طوقان ومحمد مهدي الجواهري ونجيب محفوظ، لكن القضية الجوهرية التي ينبغي أن نركز عليها – في تقديري – لا تتعلق بما قدر لكل واحد من هؤلاء أن يحياه، وإنما بما استطاعوا جميعا أن ينجزوه وأن يحققوه خلال سنوات الحياة، بصرف النظر عما إذا كانت حياة قصيرة أو طويلة، لأن الرصيد الذي يبقى - وقد يتجدد على امتداد الأجيال - يتمثل في الثروة الأدبية أو الفنية التي يبدعها الكاتب أو الفنان طيلة سنوات حياته، ويخلفها وراءه بعد غيابه النهائي عن الحياة والأحياء. ثلاثة شعراء من جيل عربي واحد، قدر لهم أن يرحلوا عن عالمنا وهم في ذروة شبابهم، وبالتالي لم يقدر لأي شاعر منهم أن يجمع قصائده بنفسه، وأن يقوم بتبويبها وترتيبها في ديوان يضمها ويحتضنها بين صفحاته، وهكذا قام آخرون بهذه المهمة، نيابة عمن رحلوا، ووفاء لذكراهم، وحرصا على تراثهم الشعري الذي أبدعوه. هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين رحلوا في ذروة شبابهم هم – وفقا لأسبقية ميلاد كل منهم – محمد عبدالمعطي الهمشري وأبو القاسم الشابي والتيجاني يوسف بشير. الهمشري ولد في مصر سنة 1908 ورحل عن عالمنا يوم 14 ديسمبر 1938عن ثلاثين سنة. والشابي ولد في تونس يوم 24 فبراير 1909 ورحل عن عالمنا يوم 9 أكتوبر1934عن خمس وعشرين سنة وقد صدرت الطبعة الأولى من ديوانه أغاني الحياة سنة 1955 حيث نشرته دار الكتب الشرقية، وتم طبعه في دار مصر للطباعة بالقاهرة. أما التيجاني فقد ولد في السودان سنة 1910 في أغلب المراجع، وهناك من يقول إنه ولد سنة 1912 وقد رحل عن عالمنا سنة 1937عن سبع وعشرين سنة. وحين راجعت كتابا في مكتبتي بعنوان التجاني يوسف بشير – لوحة وإطار لمؤلفه أحمد محمد البدوي، وجدته يذكر تاريخ رحيل التيجاني بشكل دقيق وهو يوم الأربعاء 28 يوليو 1937 وقد صدر هذا الكتاب سنة 1980 وهو مطبوع في المطبعة الفنية للطبع والنشر والتجليد بالقاهرة، وقد صدر للتيجاني ديوان إشراقة – الطبعة الثانية سنة 1949عن المطبعة الوطنية بالخرطوم، أما الطبعة الأولى منه فإني لم أستطع حتى الآن تحديد تاريخ صدورها، وعلى أي حال فإني لاحظت أن كثيرين من أدباء السودان يكتبون اسم التيجاني دون حرف الياء أي أنهم يكتبونه التجاني وهناك آخرون منهم يكتبونه كما نكتبه نحن خارج السودان بالياء! إذا كان لم يقدر لكل شاعر من هؤلاء أن يجمع قصائده بنفسه، فإن أحد معاصريهم ومحبيهم - وهو الأديب محمد فهمي - قد تكفل بمهمة اختيار باقة شعرية من إبداعات كل منهم، ثم أصدرها في كتاب بعنوان الروائع لشعراء الجيل، وقد صدر هذا الكتاب سنة 1945 ولكن هل هناك ما يجمع بين هؤلاء الشعراء الثلاثة الذين ينتمون لثلاث دول عربية في قارة إفريقيا؟ بالطبع فإن هناك ما يجمع بينهم، فهم ينتمون لجيل شعري عربي واحد، يتمثل في جماعة أبولو الشعرية، التي يتسم شعراؤها بغلبة الرومانسية الرقيقة والحزينة على أرواحهم وعلى إبداعاتهم الشعرية. وهكذا عاش كل شاعر من هؤلاء حياته كالفراشة الحائرة التي تنتقل من غصن إلى غصن، عساها أن تجد الزهرة المنشودة، وكلما توهم أنه قد وجد تلك الزهرة كانت الهوة العميقة ما بين المثال وبين الواقع تبرز له.. ولقد كانت تلك الهوة تفصل ما بين المثال الذي خلقته تصورات شاعر مثالي للمرأة التي ينشدها بكل ما يخلع عليها من صفات ملائكية تجعلها دوماً مرفرفة في محرابها العلوي بعيداً عن البشر الفانين، وبين الواقع الذي تتمخض عنه الحياة بكل ما فيها من نقائص بشرية. يقول الهمشري، مناجيا حبيبته في قصيدته الرقيقة نداء الفجر: أنت فجر يشع في ظلماتي يكشف السحر في مروج حياتي فتغني فيها ملائكة الرحــمة أنشودة الخلود الآتي! أنت سحر يبدو وراء خيالي أنت نور يرف في مشكاتي وعيون فجرية تتجلى لتنير الكئيب من ليلاتي! شاء الشعراء الثلاثة أن يكونوا أحبابا محبوبين خلال حياتهم، لكنهم رحلوا عن عالمنا وهم في ذروة شبابهم، وهكذا جمع بينهم الشوق المتعطش للحب، كما جمع بينهم مفرق الجماعات وهادم اللذات، وتبقت لنا من بعد غيابهم باقات لا تزال نضرة من القصائد الرقيقة العذبة.
1517
| 19 سبتمبر 2013
حين أصدر شاعر الحب الرقيق الدكتور إبراهيم ناجي ديوانه الأول وراء الغمام سنة 1934 كتب عنه الدكتور طه حسين مقالا قاسيا، وكان مما حاسبه عليه وأنكره عليه بشدة أن الشاعر قد صور الحنين وجسده في هيئة طفل، لكن هذه الصورة التي أنكرها طه حسين قد فتنت كثيرين من رواد حركة الشعر الحر فيما بعد. يقول ناجي في قصيدة الحنين: ويحَ الحنين وما يجرعني مِن مُره ويبيت يسقيني ربيته طفلاً بذلتُ له ما شاء من خفضٍ ومن لينِ فاليوم لما اشتد ساعده وربا كنوار البساتينِ لم يرض غير شبيبتي ودمي زادا يعيش به ويفنيني والحقيقة أن رواد الشعر الحر الذين أعجبتهم قصيدة ناجي أخذوا يسيرون على طريقه، ويرسمون صورة الطفل باعتباره رمزا للحب في أحيان كثيرة، كما أصبح آخرون منهم يرمزون به في أحيان أخرى إلى الحزن، ومنهم من أصبحوا يرمزون به إلى الفرح وإلى توق الإنسان إلى استكشاف أعماق المجهول، وكانت الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة أول هؤلاء الشعراء الرواد، حيث رسمت صورة الحب الذي يتجسد طفلا في قصيدتها الخيط المشدود في شجرة السرو التي يتضمنها ديوانها الثاني شظايا ورماد، وقد أعادت نازك الملائكة رسم هذه الصورة بشكل فني ناضج في قصيدتها ثلاث أغنيات للحزن التي يتضمنها ديوانها الثالث قرارة الموجة، وفيها تقول: افسحوا الدرب له، للقادم الصافي الشعور للغلام المرهف السابح في بحر أريج ذي الجبين الأبيض السارق أسرار الثلوج إنه جاء إلينا عابرا خصب المرور إنه أهدأ من ماء الغدير فاحذروا أن تجرحوه بالضجيج وبعد نازك الملائكة، رسم صلاح عبد الصبور هذه الصورة أيضا، لكنه عبر بها عن الحب المفقود، ومن يتتبع عطاءه الشعري الرائع يجد أنه قد رسم هذه الصورة مرتين، أولاهما في قصيدته طفل التي يتضمنها ديوانه الأول الناس في بلادي الصادر سنة 1957، والمرة الثانية في قصيدته العائد التي يتضمنها ديوانه الثاني أقول لكم الصادر سنة 1961وفيها يقول: كان طفلا عندما فر عن البيت وولّى من سنين عشرة، ذات مساء، كان طفلا وافتقدناه، وناديناه في أحلامنا وانتظرنا خطوه المخضر في كل ربيع وشكونا جرحه خلاننا وتسلينا بكأس مرة من يأسنا وتناسيناه إلا رعدة تجتاحنا أول أيام الربيع عندما نشعر بالشوق إلى طفل وديع وهنا ينبثق سؤال: لماذا أعجب الشعراء الذين جاءوا بعد ناجي بقصيدته التي لم تعجب عميد الأدب العربي، بل إنه هاجمها هجوما قاسيا؟... أتصور أن الإجابة التي تحتمل الخطأ أو الصواب تتمثل في أن الأذواق العامة قد تتغير من جيل إلى سواه، وهذا ما نلمسه في التغيرات المادية والحياتية، وما يستحدثه الأدباء والفنانون من مذاهب واتجاهات جديدة، يتقبلها من يتقبلها، بينما يرفضها الرافضون الذين يحاولون أن يجمدوا الحياة عند الحدود التي عرفوها وألفوها، ولا يريدون أن يخرجوا عليها أوأن يحيدوا عنها، وهكذا أحب رواد الشعر الحر ما لم يرض عنه طه حسين.
2751
| 12 سبتمبر 2013
يعرف الذين يشاركون في الحفلات التنكرية أن عليهم أن يخفوا شخصياتهم الحقيقية عن الآخرين، بل عن أقرب الناس إليهم.. فقد ترتدي سيدة ثرية ملابس خادمة، وتتقنع بقناع يجعلها تبدو في هيئة بائسة زرية، وقد تكون طبيعة إنسانة أخرى طبيعة غائصة في الوحل والثرى، لكنها تضع قناعا باهرا وساحرا يجعلها في هيئة من تتعالى إلى نجوم السماء، وصاحب القلب الطيب قد يرتدي قناع إنسان شرير، تنبئ ملامحه عن الإجرام المتأصل .. وهكذا .. ولكن في خاتمة تلك الحفلات التنكرية يعود كل إنسان من المشاركين فيها إلى طبيعته المعتادة وشخصيته المألوفة بعد أن يخلع القناع الذي يخفي به وجهه الحقيقي. هذا بعض ما يحدث في الحفلات التنكرية. أما في الحياة ذاتها، فإن هناك بعض النماذج البشرية التي يطيب لأصحابها – لأسباب متعددة ومختلفة – أن يضعوا أقنعة تداري طباعهم وسلوكياتهم.. فهناك من يكره الآخرين في أعماقه ولا يحب أحدا غير نفسه المريضة، لكنه يرتدي أمام الآخرين ممن يجهلون أعماقه الحقيقية قناع الطيبة والنقاء لكي يخفي به ما في أعماقه الخفية التي لو اتضحت للآخرين لأدركوا أنه أقرب إلى الشيطان.. وهناك من يخدع الآخرين لوقت طويل بفضل براعته في ارتداء قناع الفضيلة والسمو والرقة، بينما هو – في واقع الأمر – إنسان له نزواته وعلاقاته المريبة وتصرفاته القبيحة، ومثل هذا الإنسان يظل أمام الآخرين إنسانا فاضلا وساميا ونقيا، إلى أن يكتشف واحد من هؤلاء الآخرين أو عدد منهم حقيقة هذا الإنسان الذي خدعهم لوقت طويل. يتوقف على سرعة أو بطء اكتشاف حقيقة الإنسان الذي يرتدي قناع الخداع مدى ذكاء ودهاء هذا الإنسان أو مدى تبلده وغبائه، فهناك إنسان يظل يخدع الآخرين سنوات عديدة، وهناك من لا يستطيع أن يخدع الآخرين إلا لفترة قصيرة، وسرعان ما يفتضح أمره وينكشف سره. حول سرعة أو بطء اكتشاف حقيقة الإنسان الذي يضع على وجهه قناع الخداع سألني أحد الأصدقاء: هل يستطيع الكاتب الأديب أن يكتشف حقيقة الإنسان الذي يرتدي قناع الخداع بصورة أسرع من غيره؟.. الأمر هنا يتوقف على هذا الكاتب الأديب، فمن الأدباء من يتغلغلون في أعماق النفس البشرية، حتى لو كانوا لم يقرأوا أبدا أي كتاب علمي من كتب علم النفس، وهناك من تبدو معرفتهم بالنفس البشرية سطحية.. الطراز الأول من الأدباء يكتشف بسرعة وبسهولة.. أما الطراز الثاني منهم فإنه لا يستطيع أن يكتشف بنفس السرعة والسهولة، وحين يكتشف فإنه يبدو مندهشا وتنعكس هذه الدهشة على كتاباته. من أجمل القصص القصيرة العالمية في هذا المجال قصة لعملاق هذا الفن أنطون تشيخوف، وهي بعنوان القناع، أما في شعرنا العربي الحديث فقد كتب كثيرون من النقاد عن ظاهرة الوجه والقناع، وذلك من خلال تحليلهم لقصائد من شعر بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور. هؤلاء الشعراء الكبار استخدموا القناع باعتباره أداة فنية موفقة، فقد يتحدثون بضمير المخاطب أو بضمير الغائب عن تجارب ذاتية، سواء كانت شخصيات حقيقية أو أسطورية ليعبروا من خلالها عما يجيش بأعماقهم هم، وعلى سبيل المثال فإن لعبد الوهاب البياتي قصائد عديدة، تبدو وكأنها تصور أعماق المتنبي أو المعري أو عمر الخيام، لكنها – في حقيقة الأمر- تصور أعماق عبد الوهاب البياتي نفسه. وهناك السندباد الذي يتجلى في قصائد عديدة من شعر صلاح عبد الصبور، فهو لا يقصد أن يرسم صورا شعرية للسندباد، بقدر ما يقصد أن يصور أعماقه هو ولكن من خلال شخصية السندباد، وعلى ضوء هذا اصطلح كثيرون من النقاد على تسمية هذه النماذج الشعرية العميقة بأنها: الوجه والقناع.
2632
| 05 سبتمبر 2013
مساحة إعلانية

يترقّب الشارع الرياضي العربي نهائي كأس العرب، الذي...
1038
| 18 ديسمبر 2025

لم يكن ما فعلته منصة (إكس) مؤخرًا مجرّد...
930
| 16 ديسمبر 2025

يوماً بعد يوم تكبر قطر في عيون ناظريها...
696
| 15 ديسمبر 2025

السعادة، تلك اللمسة الغامضة التي يراها الكثيرون بعيدة...
669
| 14 ديسمبر 2025

يُعد استشعار التقصير نقطة التحول الكبرى في حياة...
630
| 19 ديسمبر 2025

إنه احتفال الثامن عشر من ديسمبر من كل...
609
| 18 ديسمبر 2025

هنا.. يرفرف العلم «الأدعم» خفاقاً، فوق سطور مقالي،...
591
| 18 ديسمبر 2025

في عالمٍ تتسارع فيه الأرقام وتتناثر فيه الفرص...
588
| 14 ديسمبر 2025

يأتي الاحتفال باليوم الوطني هذا العام مختلفاً عن...
549
| 16 ديسمبر 2025

لقد من الله على بلادنا العزيزة بقيادات حكيمة...
501
| 18 ديسمبر 2025

-إعمار غزة بين التصريح الصريح والموقف الصحيح -...
444
| 14 ديسمبر 2025

يُعَدّ علم الاجتماع، بوصفه علمًا معنيًا بدراسة الحياة...
435
| 15 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية