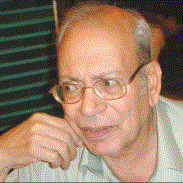رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ذات صباح من أيام سنة 2003 انطلق نجيب محفوظ - مشيا على الأقدام - ليرى تمثاله الذي قيل له إنه قد تم وضعه في أحد ميادين القاهرة، تكريما له وتقديرا لأدبه. بعد طول تأمل وتمعن، سأل نفسه: أهذا هو أنا يا ترى، أم أن هذا الذي أراه يمثل رجلا بائسا ومسكينا، يتوكأ على عصاه، وقد انحنى ظهره، لكي يستعطف الناس، طالبا منهم أن يعطوه مما أعطاه الله لهم؟! ولم يفكر نجيب محفوظ في إجابة كافية ووافية على سؤاله، بقدر ما أحس أن الفنان الذي نحت تمثاله قد نحته بقدر كبير من التسرع، كأنه موظف روتيني يريد أن ينجز ما تم تكليفه به، لكي يتسنى له أن يقبض مكافأته دون تأخير أو إبطاء. وفي إحدى الأمسيات سأله أحد الأدباء المتحلقين حوله عما إذا كان قد رأى تمثاله، وعن رأيه فيه إن كان رآه، فما كان من نجيب محفوظ إلا أن أطلق ضحكة مجلجلة، وهو يقول لمن سأله ولمن حوله: يبدو أن الفنان الذي قام بنحت تمثالي لم يقرأ لي من أعمالي غير رواية واحدة، هي رواية الشحاذ! لم يكن نجيب محفوظ هو وحده الذي أقيم له تمثال، ففي إطار مشروع لم يكتمل لتجميل بعض ميادين القاهرة، تم وضع تماثيل لكل من طه حسين وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، كما تم وضع تمثال للفريق الشهيد عبد المنعم رياض، وأتذكر أن مجلة وجهات نظر قد استكتبت- في عدد أغسطس2003- كلا من رجاء النقاش وأحمد فؤاد سليم لإبداء الرأي فيما تم، فأبدى رجاء النقاش تحمسه الفائق لمشروع التجميل، بينما أكد أحمد فؤاد سليم- وهو فنان تشكيلي- أن تلك التماثيل التي نصبت أخيرا ما هي إلا نكبة ثقيلة لفن النحت، ولا بد من محاسبة الذين ارتكبوا تلك النكبة! سبع سنوات تنقضي الآن على رحيل نجيب محفوظ عن عالمنا يوم 30 أغسطس سنة 2006 وفي هذه الأجواء قررت أن أستعيد هذا الكاتب المصري- العربي- العالمي بطريقتي الخاصة في استعادة الأدباء العمالقة الذين أحبهم، وهكذا انطلقت- متحمسا ومستمتعا- لإعادة قراءة رواياته ميرامار التي أبدعها سنة 1967 وثرثرة فوق النيل التي أبدعها سنة1966والشحاذ التي أبدعها سنة1965 ومع استكمال إعادة قراءة تلك الروائع زاد يقيني بأن الحياة تكرر ما يطفو على سطحها من شخصيات سلبية أو إيجابية، بصرف النظر عن اختلاف الأسماء والوجوه، فعلى سبيل المثال، رأيت سرحان البحيري- الانتهازي الحقير في ميرامار يتكرر أمامي في أسماء ووجوه كثيرين آخرين، من الانتهازيين الوصوليين الذين يحاولون أن يرتفعوا على ظهر أية موجة يرون أنها أصبحت أكثر ارتفاعا من سواها، حتى لو تطلب الأمر أن يقوموا بإغراق أحبائهم وأصدقائهم، ورأيت أنيس زكي الغائب عن الوعي في ثرثرة فوق النيل يتكرر هو أيضا، ورأيت سمارة بهجت الصحفية الجادة تتكرر كذلك، كما رأيت من يسمون أنفسهم بالنخبة أو الصفوة أو المثقفين وهم يجاهدون لكي تتحقق لهم المتع العابرة، ولكي يقتنصوا ما يستطيعون أن يقتنصوه من مصالح شخصية على حساب الأغلبية المسحوقة التي يزعمون أنهم يعبرون عن آلامها، ويدافعون عن قضاياها، ويناصرون مطالبها الإنسانية المشروعة في حياة كريمة، تتسع للجميع، أما في الشحاذ فقد رأيت عمر حمزاوي- المحامي الشهير الذي فقد اليقين تجاه كل ما كان يؤمن به، فاندفع- بلا تردد- وراء العبث واللاجدوى، وقد تكرر عمر حمزاوي في شخصبات آخرين كثيرين، ممن تغلغل اليأس في أعماقهم، ولم يعد أمامهم إلا أن يهربوا من الحاضر، وأن يزيحوا من أذهانهم فكرة الأمل في الزمن الآتي على جناحي الحرية والعدل. هكذا استعدت متحمسا ومستمتعا بعض ما أبدعه نجيب محفوظ، كما استعدت نوادره ودعاباته التي لا تنتهي، ومنها ما يتعلق بذلك الفنان الذي نحت تمثاله، حيث اتهمه- من باب الدعابة- بأنه لم يقرأ من رواياته غير رواية الشحاذ، وبعيدا عن دعابات نجيب محفوظ الإنسان، فإن هذا العملاق الذي انقضت سبع سنوات على رحيله، كان يتعامل مع الحياة ومع إبداعه الأدبي بأقصى قدر من الجدية ومن الإحساس العميق بأمانة الكلمة ومسؤولية الكاتب تجاه مجتمعه الذي ينتمي إليه، وتجاه الإنسان في كل مكان.
1052
| 29 أغسطس 2013
تفتحت عيناي في شبابي والكون مقلوب على رأسه، وكان حلم حياتي أنا وجيل من أصحابي أن نعدل هذا الكون المقلوب، وأدركنا اليأس بعد قليل أو كثير، ثم ما لبثنا أن وقفنا نحن على رؤوسنا لكي نستطيع أن نتواصل مع الحياة والبشر. هذا ما قاله صلاح عبد الصبور في ثنايا كتابه الجميل حياتي في الشعر ، لكي يقوم بمقارنة سريعة ما بين طموحات الشباب لتغيير واقع الحياة، ثم الرضا أو الاستسلام لهذا الواقع عند المخضرمين. ومنذ أيام قلائل أطلت علينا ذكرى غياب هذا الشاعر العربي العظيم الذي لم تدم مسيرته مع الحياة سوى خمسين سنة، حيث ولد في مدينة الزقازيق المصرية يوم 3 مايو سنة 1931 ورحل عن عالمنا يوم 13 أغسطس سنة 1981، أي منذ اثنتين وثلاثين سنة، ومن حصاد المصادفات أن جثمان صديقه الشاعر الكبير محمود درويش قد جرى تشييعه لمثواه برام الله في نفس ذلك اليوم سنة 2008. أصدر صلاح عبد الصبور ديوانه الأول الناس في بلادي سنة 1957 أي وهو في السادسة والعشرين من عمره، لكن هذا الديوان أحدث ضجة نقدية هائلة فقد هاجمه عباس محمود العقاد هجوما عنيفا بدعوى أن قصائده فيها خروج على تقاليد الشعر العربي، كما كتب عنه بقدر من التحفظ الدكتور زكي نجيب محمود، بينما انبرى للدفاع عن الناس في بلادي وللتحمس لمبدعه الشاب وقتها كثيرون من أدباء ونقاد الوطن العربي بأسره. تتابعت بعد هذا الديوان البكر دواوين صلاح عبد الصبور وهي : أقول لكم – أحلام الفارس القديم – تأملات في زمن جريح – شجر الليل – الإبحار في الذاكرة، لكن الشاعر العظيم لم يكتف بما حققه، بل انطلق لكتابة المسرح الشعري وفقا لنهج الشعر الحر، متجاوزا ما كان أمير الشعراء أحمد شوقي قد أبدعه وفقا لنهج الشعر العمودي، وهكذا تلقت الساحة الأدبية والثقافية العربية مسرحية مأساة الحلاج التي ترجمت إلى العديد من اللغات العالمية، من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، وتتابعت من بعدها مسرحيات مسافر ليل، والأميرة تنتظر، وليلى والمجنون، وبعد أن يموت الملك. لم يكن صلاح عبد الصبور شاعرا عظيما وكاتبا مسرحيا من الطراز الرفيع فحسب، ولكنه كان مثقفا موسوعيا بكل معنى الكلمة ، وقد تجلت هذه الثقافة في كتاباته النقدية والفكرية وكذلك فيما قدمه من ترجمات لشعراء عالميين، من بينهم لوركا وبودلير وايفتشنكو وبرتولت بريشت، وقد اهتمت الهيئة العامة للكتاب في مصر بإصدار أعماله الكاملة بعد غيابه عن عالمنا وكان الحصاد أحد عشر مجلدا، وكلها نفدت منذ سنوات وأتمنى أن يعاد طبعها من جديد لكي تتمكن الأجيال العربية الجديدة من اقتنائها وتذوق ما فيها من متعة روحية وفائدة عقلية. على الصعيد الإنساني فإني أفخر وأعتز بأني قد صادقت هذا الشاعر العظيم منذ أن كنت طالبا جامعيا وقد ساعدني كما ساعد كثيرين من أبناء جيلي على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم وعلى نشر دواوينهم وأذكر هنا أن أمل دنقل كان قد يئس من نشر ديوانه الأول البكاء بين يدي زرقاء اليمامة بعد أن تخلى نزار قباني عن وعده بنشره في دار النشر التي كان يملكها، إلى أن تكفل صلاح عبد الصبور بتقديمه بنفسه إلى الدكتور سهيل إدريس حيث تم نشره ضمن إصدارات دار الآداب البيروتية . إذا كنت قد أحببت هذا الشاعر العظيم منذ أن كنت شابا صغيرا، فإني لن أنسى ذكريات زيارته للدوحة في مايو سنة 1980 حيث استضافه عميد الصحافة القطرية الأستاذ ناصر محمد العثمان والذي كان وقتها مديرا لإدارة الثقافة والفنون، كما تكفل بتقديمه للحاضرين في أمسية شعرية أقيمت في إحدى قاعات فندق رمادا وقد امتلأت تلك القاعة وقتها بالحاضرين الذين تصدرهم كل من الكاتبين الكبيرين الراحلين الطيب صالح ورجاء النقاش، وكان لي شرف حضورها وما زلت إلى الآن أحتفظ بشريط الفيديو الخاص بتلك الأمسية الرائعة لأعود لمشاهدته بين حين وآخر، ولكي أستعيد ما كان أطلقه وقتها من نبوءة صادقة وحزينة: رعب أكبر من هذا سوف يجيء. وها هي اثنتان وثلاثون سنة تنقضي على غياب صلاح عبد الصبور، والغريب أن بعض الشعراء المصريين ما زالوا يغارون منه حتى الآن، لأنهم يدركون أن قامته ما تزال عالية وأن حضوره الشعري والإنساني ما يزال واضحا وناصعا رغم فداحة وطول هذا الغياب !
1295
| 22 أغسطس 2013
على امتداد أكثر من أسبوع، سجنت نفسي باختياري داخل جدران البيت، وحرمت على جسدي الراحة، والهدف هو العثور على أوراق مخطوطة، أعتز بها كل الاعتزاز، لأنها تضم قصائد رائعة، كتبها شاعر كبير بخط يده، وكنت قد حصلت عليها منه شخصيا منذ أكثر من أربعين سنة، وجاء أوان الكتابة عنها. يا ترى أين أنت الآن أيتها الأوراق التائهة في زحام مكتبتي؟ ظللت أبحث وأبحث بين آلاف الأوراق الأخرى، بل إني أخرجت ما تضمه المكتبة من جرائد ومجلات قديمة تذكارية، أما ما كان يخفف من معاناتي خلال البحث المرهق والمتواصل فهو العثور على أشياء ثمينة كثيرة، كنت قد نسيتها أو ابتعدت عنها وسط دوامة الحياة اليومية، وعلى أي حال، فإن معاناتي في البحث تحولت- فجأة- إلى بهجة بغير حدود، بمجرد أن وقعت عيني على غلاف إحدى المجلات القديمة التذكارية. كانت المجلة التي أبهجتني، تباع بخمسة مليمات مصرية، أما اسمها فهو مجلة الراديو، ووفقا لما هو مدون على غلافها فإنها مجلة تعنى بنشر برامج محطة الإذاعة اللاسلكية، وأما تاريخ صدور العدد الذي بين يدي فهو السبت 12 أغسطس سنة1939 ويزدان غلافه بصورة حديثة للآنسة أم كلثوم، أخذت لها في أوروبا، وإلى جوار الصورة عنوان بخط كبير: مبروك على سموك، وهي الأغنية التي غنتها الآنسة أم كلثوم في زفاف الأميرة فوزية المحبوبة من تأليف الأستاذ بديع خيري وتلحين الأستاذ رياض السنباطي، نعيد نشرها تلبية للطلبات الكثيرة التي وصلتنا من القطر المصري والسودان والبلاد العربية. أعترف بأني لم أسمع هذه الأغنية، بل لم أسمع عنها من قبل، رغم أني واحد من عشاق أم كلثوم، ويطيب لي أن أتباهى بما في حوزتي من أغان نادرة لها، وهكذا رددت بصوت هامس بيت أبي نواس: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة- عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، ثم انطلقت لقراءة نص كلمات الأغنية التي لم أكن أعرف عنها شيئا على الإطلاق: مبروك على سموك وسموه نسب إيران والنيل الغالي يا اللي القمر قال لك في علوه أغيب.. وتطلعي إنت بدالي كان المتداول بين عشاق أم كلثوم، ممن عايشوا ثورة يوليو المجيدة بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، أن كوكب الشرق لم تغن غير أغنية واحدة للملك فاروق الأول، وهي أغنية الليلة عيد، وها أنا أعرف الآن أنها قد غنت في حفل زفاف أخت ملك مصر والسودان- الأميرة فوزية إلى الأمير محمد رضا بهلوي ولي عهد إيران، وأمام المفاجأة التي حققتها لي مجلة الراديو، كان لا بد أن أخطو خطوات أخرى، تتمثل في البحث عن أغنية مبروك على سموك، وقررت الاستعانة بعدد من الأصدقاء، فأخبرني أحدهم بأن الأميرة فوزية قد رحلت عن عالمنا منذ فترة قريبة، كما زارني في الليل صديق آخر، مصطحبا معه الأغنية مسجلة بصوت أم كلثوم، وهكذا قدر لي أن أستمتع بسماع أغنية حفل زفاف الأميرة فوزية، في نفس الليلة التي عرفت فيها أنها قد رحلت عن عالمنا يوم 2 يوليو سنة 2013 وكان لا بد أن يمتزج الفرح في أعماقي بالحزن، وأن أحاول التعرف على سيرة حياة الأميرة الراحلة. ولدت الأميرة فوزية يوم 5 نوفمبر سنة 1921 وهي ابنة فؤاد الأول ملك مصر الأسبق، أما أمها فهي الملكة نازلي، وقد ظلت الأميرة فوزية إمبراطورة إيران منذ سنة 1941حتى سنة 1945 حيث كانت قد تزوجت من ولي عهد إيران، وتم زفافها في قصر سراي القبة بالقاهرة يوم 29 مارس سنة 1939 وغنت أم كلثوم في حفل الزفاف أغنية مبروك على سموك وسموه، ثم أقيم حفل الزفاف الثاني في طهران، وبعد سنتين تقلد زوجها مقاليد الحكم بعد تنحي والده عن العرش، وقد أنجبت ابنتها الوحيدة من شاه إيران وهي الأميرة شاهيناز بهلوي، لكن هذا الزواج لم يدم طويلا، حيث وقع الطلاق سنة 1945 وتسبب الطلاق وقتها في نشوب أزمة كبيرة بين مصر وإيران، وفي مارس سنة 1949 تزوجت من العقيد إسماعيل شيرين الذي كان آخر وزير للحربية قبل ثورة يوليو 1952 المجيدة في مصر. ها هي الأميرة فوزية ترحل عن عالمنا، ويوارى جسدها الثرى، لترقد إلى جوار زوجها الثاني إسماعيل شيرين في مقبرة مسجد السيدة نفيسة، أما محمد رضا بهلوي شاه إيران السابق وزوجها الأول فكان قد رحل عن عالمنا يوم 27 يوليو سنة 1980 ودفن في مسجد الرفاعي بالقاهرة، بعد أن رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستقبله وهو حي يرزق، رغم أنه كان مريضا للغاية، وتكفل الرئيس المصري محمد أنور السادات وقتها باستقباله في مصر، وتكفل هذا الاستقبال الإنساني بنشوب أزمة جديدة كبيرة بين مصر- السادات وإيران- الثورة المذهبية الإسلامية. لم أعثر بعد على الأوراق المخطوطة التائهة، لكن البهجة غمرتني عندما استمعت إلى أغنية أم كلثوم- مبروك على سموك وسموه، وسرعان ما امتزجت البهجة بالحزن على الأميرة الراحلة فوزية، وهكذا الحياة لا تتوقف عن الجريان على امتداد الزمان، ومع اندفاعها تتبدل مصائر الناس في كل مكان!
771
| 15 أغسطس 2013
تُنسى كأنك لم تكن.. تُنسى كمصرعِ طائرٍ.. ككنيسةٍ مهجورةٍ تنسى.. كحُبّ عابرٍ وكوردةٍ في الليل تُنسى.. هذا ما استهل به الشاعر العظيم محمود درويش قصيدته الرائعة والمؤثرة التي سماها تُنسى كأنك لم تكن، وهي إحدى قصائد ديوانه لا تعتذر عما فعلت، وفي ثنايا هذه القصيدة يظل مبدعها يركز على نسيان الأحياء من الناس لمن يرحل منهم عن عالمنا، حتى وإن كان هذا الراحل إنسانا مرموقا ذائع الصيت، وهكذا تتكرر في القصيدة قضية النسيان.. تُنسى كأنك لم تكن شخصًا ولا نصّا.. وتُنسى- تُنسى كأنك لم تكن خبرًا ولا أثرًا.. وتُنسَى. صدر ديوان لا تعتذر عما فعلت الذي يضم هذه القصيدة سنة2004 وبعد أربع سنوات من صدوره، وبالتحديد يوم السبت 9 أغسطس سنة 2008 رحل محمود درويش، وتم تشييع جسده في جنازة مهيبة بكل معنى الكلمة، واحتضنته أرض رام الله الفلسطينية وسط مشاعر الحزن والحسرة على فقد هذا الشاعر الفلسطيني- العربي العظيم، وهاهي خمس سنوات تنقضي على هذا الفقد، وعلى الفور ينبثق سؤال محدد: هل تحققت نبوءة محمود درويش بأنه سينسى؟ وأبادر فأقول- نيابة عن سواي- إن كل محبي الشعر العربي، ومعهم كل من يرتبطون بقضايا الإنسان الجوهرية لم ينسوا هذا الشاعر العظيم، ولن يستطيعوا نسيانه إلا إذا فقدوا محبتهم للشعر وتخلوا عن قضاياهم التي يرتبطون بها، فكل ما في الأمر أن الجسد قد غاب، أما العطاء الشعري والنثري الرائع الذي أبدعه الشاعر على امتداد سنوات حياته فإنه سيظل باقيا ومتجددا، لأنه عطاء يستعصى على النسيان. ارتبط محمود درويش ارتباطا حياتيا حميما بقضية فلسطين- الشعب والأرض، لكن شاعريته الخصبة منعته أو عصمته من أن يكون واحدا من شعراء المناسبات الذين يتلاشى تأثير قصائدهم بمجرد انتهاء المراحل التاريخية التي يكتبون في أجوائها الساخنة، وقد تعمقت شاعريته الخصبة بفضل حرصه على الارتواء من ينابيع الثقافة والمعرفة في الشرق والغرب على حد سواء، ومن هنا أتيح لصوته الشعري العربي الفلسطيني أن يتجاوز الرقعة الجغرافية للأرض العربية كلها، وأن ينطلق عبر الآفاق الرحبة الممتدة، ليصل إلى الإنسان في كل مكان وزمان، ولم تعد قضية فلسطين- بفضل هذا الصوت الشعري الصادق والواثق- مجرد قضية سياسية، وإنما أصبحت قضية إنسانية شاملة، تحظى بالتجاوب العالمي العميق، المستند إلى التقدير والاحترام، والبعيد كل البعد عن محاولة استدرار الدموع من العيون، وهي المحاولة التي لا يمل الصهاينة من تكرارها حين يتحدثون عن اضطهاد النازية لهم في زمن عنفوان أدولف هتلر، وبالطبع فإن محاولة استدرار الدموع من العيون لا تقتصر على الصهاينة وحدهم، إذ يلجأ إليها المتاجرون بالإسلام وهم يسعون لتحقيق مآربهم الدنيوية. مازال الناشرون بعد غياب محمود درويش يعيدون طبع دواوينه الشعرية وكتبه النثرية، وهذا يؤكد أنه شاعر غير قابل للنسيان، ومازلت أعيد قراءة كتابه النثري البديع أثر الفراشة بنفس المتعة التي تذوقتها حين قرأته أول مرة، وهاهو يناجي حبيبته- مدينته حيفا العربية الفلسطينية رغم احتلال الغرباء الصهاينة لها منذ سنة 1948 هاهو يناجي حيفا، هامسا: حيفا.. يحق للغرباء أن يحبوك، وأن ينافسوني على ما فيك، وأن ينسوا بلادهم في نواحيك، من فرط ما أنت حمامة تبني عشها على أنف غزال، وفي ذكرى انقضاء خمس سنوات على غياب هذا الشاعر العظيم يطيب لي أن أستعيد صوته في أثر الفراشة، حيث يقول: أثر الفراشة لا يُرى- أثر الفراشة لا يزول- هو جاذبية غامض، يستدرج المعنى، ويرحل حين يتضح السبيل- هو خفة الأبدي في اليومي.. أشواقٌ إلى أعلى، وإشراقٌ جميل- هو شامةٌ في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل- هو مثل أغنيةٍ تحاول أن تقول وتكتفي بالاقتباس من الظلال ولا تقول- أثر الفراشة لا يُرى.. أثر الفراشة لا يزول. وفي ذكرى الغياب يتردد في روحي بيت أمير الشعراء أحمد شوقي: الناس صنفان: موتى في حياتهم- وآخرون ببطن الأرض أحياء، وتبقى تحية الحب لمحمود درويش الذي لا يمكن لأحد أن ينساه.
1554
| 08 أغسطس 2013
من الشعراء من يواجهون الواقع مواجهة المتخاذلين أمامه، ومنهم من يواجهونه مواجهة المتجاوزين له. فالأولون يهربون من هذا الواقع عن طريق خلق عوالم مثالية ينعمون فيها بالفراديس الوهمية التي تتمثل غالباً في الارتداد إلى الماضي وأطيافه، وهذا ما يستتبع – بطبيعة الحال – النكوص إلى الوراء. أما الآخرون فإنهم يتطلعون كذلك إلى خلق عوالم مثالية، لكن هذه العوالم تتمثل في استشراف آفاق مستقبل إنساني ينعم فيه البشر بدنيا جديدة تتخطى عثرات الواقع وتتجاوزه مبتعدة عن نقائصه. وبطبيعة الحال، فإن الشعراء يختلفون - من شاعر إلى آخر – في كيفية مواجهتهم للواقع، وفقاً لنوعية العوامل الإنسانية المتشابكة التي تسهم إسهاماً كبيراً في تكوين شخصية كل منهم، وتشكيل أسلوب تفكيره الذي يقوده - بالتالي – إلى اتخاذ هذا الموقف دون ذاك تجاه قضية بعينها من القضايا التي يجد الشاعر أنه مطالب بأن يتخذ منها موقفاً معيناً، أياً كان هذا الموقف، بحكم كونه شخصية من الشخصيات العامة المؤثرة في مجتمعها الذي تعيش فيه، وفي عصرها المضطرب الذي تتجاذبه شتى التيارات، وتتصارع فيه شتى التناقضات. ولكي تتضح الصورة، فإنه بوسعنا أن نتخذ الشاعر الأمريكي الكبير ت. س. إليوت مثالاً للشعراء الذين يواجهون الواقع مواجهة المتخاذلين أمامه، وأن نتخذ الشاعر الألماني الكبير برتولت بريخت مثالاً للشعراء الذين يواجهونه مواجهة المتجاوزين له. إن المدنية الأوروبية الحديثة قد أفزعت ت. س. إليوت.. أفزعته بضجيج آلاتها التي لا تكف عن الحركة، فتفسد بضجيجها كل التأملات الميتافيزيقية والشطحات الصوفية، وأفزعته بأناسها الذين حشيت رؤوسهم بالقش، فغلبوا المادة على الروح، والمظهر على الجوهر، واندفعوا متزاحمين في شتى مناحي الحياة. يفكر كل منهم في ذاته فحسب، دون أن يشغل نفسه بالآخرين إلا إذا تحققت له من وراء هذا منفعة مادية ملموسة. وبدافع الفزع من المدنية الأوروبية الحديثة الذي اعترى إليوت، فإنه أولاها ظهره، بعد أن صورها في هيئة سهل مقفر لا أمل يرتجى منه، وجلس الشاعر وحيداً على شاطئ الغيب، بعيداً عن السهل المقفر، ينشد الخلاص بالعودة إلى حظيرة الدين، منقباً عن المثل العليا والمبادئ السامية التي كانت سائدة في العصور الخوالي، وحلق الشاعر في آفاق شطحاته الصوفية، بعد أن تصور أن جسر لندن – الذي يمثل المدنية الأوروبية في نظره – قد انهار تماما. أما برتولت بريخت، فإنه وإن كان قد فزع – هو الآخر – من مظاهر التفسخ في المدنية الأوروبية الحديثة، إلا أنه لم يولها ظهره مرتداً إلى العصور الخوالي بقيمها ومثلها التي كانت تتفق معها وحدها دون غيرها من العصور، وإنما حاول تشخيص العلل والأدواء التي انتابت تلك المدنية، كما أبرز نقائص المجتمع الرأسمالي، مطالباً – في شعره – بتقويضه من أساسه، لكي تزدهر رؤوس الناس بالفكر الحر بدلا من أن تظل محشوة بالقش، فيفكر كل فرد منهم – بالتالي – في ذاته وفي الآخرين أيضاً، حيث «يصبح الإنسان صديقاً للإنسان»، وما من شك في أن فجر هذا العالم الجديد لن يطلع إلا إذا قضى على الحقد المتولد من استغلال الإنسان للإنسان، وذلك ما تحققه الثورة ضد الظلم، لكن هذه الثورة لا تتحقق تلقائيا، وإنما تندلع كالبركان أو تندفع كالطوفان حين يشعر الإنسان بوطأة الظلم، وبأن عليه أن يواجهه بصورة حاسمة.
637
| 01 أغسطس 2013
عجبت لمن يبلغ الأربعين ولم يكره البشر بعد! هذه مقولة موجعة وقاسية، قالها الفيلسوف الفرنسي باسكال، وهي مقولة تعكس عدم ثقته بالناس أجمعين، أما فرانز كافكا – الروائي التشيكي الشهير- فإن له رواية من أشهر رواياته، هي رواية المسخ، وفيها يصور إنسانا قد صحا من نومه ليتأهب للذهاب إلى عمله لكي يساعد أفراد عائلته باعتباره الأخ الأكبر، لكنه يكتشف أنه قد تحول إلى حشرة وأصبح صرصارا كبير الحجم، وهنا بدأت مشكلاته مع أقرب الناس إليه وهم أهله، حيث رأى بعينيه أنهم كانوا يتعلقون به لمجرد أنه في نظرهم مجرد بقرة حلوب، تجلب لهم ما يريدونه، وحينما أصبح حشرة أخذوا يؤذونه، بل يتمنون له الموت، إلى أن مات بالفعل، فقامت الخادمة بكنسه مع القمامة خارج البيت. هذان المثالان من باسكال وكافكا يصوران غياب الثقة بين الناس، وعدم طمأنينة الإنسان حتى لأقرب الناس إليه. فالإنسان يظل محبوبا - في الظاهر- طالما أنه مفيد لمن يلتفون حوله، لكن المحبة تسقط في الأوحال بمجرد أن يصبح الإنسان في نظرهم غير ذي نفع. إذا كان هذان المثالان من أوروبا، فهل – يا ترى – تبدو الصورة مختلفة عندنا نحن العرب؟ هناك أنماط مزعجة من التصرفات والأفعال، وكلها تحولت إلى ظواهر مخيفة، لكن كثيرين قد تعودوا عليها وتآلفوا معها، لدرجة أنهم أصبحوا يتعاملون معها باعتبارها من الأمور المسلم بها.. بمجرد أن يكبر الأب وتعتريه الشيخوخة يصبح في نظر أبنائه عالة عليهم، وعليهم أن يحاولوا التخلص من هذا العبء الثقيل، وهكذا يظل هؤلاء الأبناء يترقبون بشوق ولهفة دنو أجل الأب، حتى يتقاسموا ما خلفه من ميراث.. وبمجرد أن يتخلف صديق من الأصدقاء لسبب أو لآخر عن جلسات أو سهرات أصدقائه، فإن كثيرين منهم يقيمون موائد النميمة والمكائد لذلك الصديق الغائب، وبمجرد أن ينجح إنسان ويتألق في عمله، فإن المتفرجين الذين لا يعملون لأنهم لا يحبون العمل، ينصبون حوله شراك الشائعات الكاذبة والمشككة في قدراته وإمكاناته، دون أن يحاول أحد أن يتصدى لتلك الشائعات. من هذا المنطلق يأخذ كل إنسان في هذا الزمان حذره من الآخرين، لأنه لا يثق فيهم ولا يحبهم، وكل هذه الظواهر المخيفة والتي أصبحت من المسلمات في حياتنا العامة والخاصة على حد سواء تنعكس سلبا على مختلف مجالات الحياة. حين يتحدث الإنسان عن الحب الذي يقرب بين الناس، فإن الآخرين يستهزئون من حديثه، قائلين له إنك تتحدث عن المثاليات، في زمن كله أطماع وماديات، وحين تصبح كل الأشياء الجميلة والقيم النبيلة عرضة للسخرية والاستهزاء، فعلينا أن نتناسى قول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا- وما لزماننا عيب سوانا، وأن نقنع ونقتنع في قرارة أنفسنا بما قاله باسكال وأن نطبقه عمليا في حياتنا اليومية، مرددين في صمت: عجبت لمن يبلغ الأربعين ولم يكره البشر بعد. السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا: هل أصبحت أرواحنا غير قادرة على الحب؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أننا مطالبون بأن نواجه أنفسنا مواجهة شجاعة وصادقة، ولابد أن نحسم هذه المواجهة مع النفس، قبل أن نفكر في مواجهة الخصم أو العدو!
2024
| 25 يوليو 2013
كاميليا وغيداء امرأتان عربيتان، أولاهما من لبنان، وفي هذا الزمن العربي المعتل والمختل لا بد من القول إنها تنتمي إلى طائفة الدروز، أما المرأة الثانية فهي من العراق، ولأنها مسلمة سنية تلقت منذ عدة سنوات تهديداً بالقتل إذا لم تغادر مدينتها - البصرة - حتى يحقق التطهير المذهبي مبتغاه وما يتمناه!. كاميليا لا تعرف غيداء والعكس صحيح، لكني قرأت اسم الأولى عشرات المرات عندما كنت وما زلت مهتماً بتتبع سيرة حياة أمها المشهورة، كما التقيت مع الثانية لقاء مطولاً على امتداد يوم كامل في مدينتها - البصرة - التي أُخرجت منها فيما بعد، وقد سعيت - وقتها - للقائها باعتبارها ابنة رجل شهير ممن أحبهم. حصاد المصادفات هو عنوان قصيدة جميلة للشاعرة الكبيرة نازك الملائكة، وقد تذكرت هذا العنوان الذي يصور ما قد تفاجئنا به الحياة، وهذا الحصاد هو ما يجمع بين كاميليا وغيداء، وهو الذي يذكرني - بين حين وآخر - بكل منهما، كما أن هذا الحصاد هو الذي يجمع في ثناياه ما بين ثنائية الحياة والموت، فعندما كانت كاميليا تحتفل مع ذويها في لبنان بعيد ميلادها العاشر، تلقت خبر غرق أمها في النيل بمصر يوم 14 يوليو سنة 1944 وعندما كانت غيداء تحتفل بعيد ميلادها الثامن مع ذويها في البصرة، كانت روح أبيها تفيض وهو في المستشفى الأميري بالكويت يوم 24 ديسمبر سنة 1964. أسمهان الرائعة هي والدة كاميليا، وبدر شاكر السياب هو والد غيداء، وحين أكتب - كما هو شأني مع من أحبهم - عن ذكرى صاحبة الصوت السماوي الأخضر، فإني أتذكر - تلقائياً - ابنتها، وكذلك الحال حين أكتب عن الشاعر الرائد العظيم، فإني أتذكر ابنته، متسائلاً في صمت وفي حزن عن حصاد المصادفات الذي جمع ما بين كاميليا وغيداء. هل تستطيع كاميليا أن تحتفل بعيد ميلادها وهو نفس اليوم الذي غرقت أمها خلاله، وهل تستطيع غيداء أن تحتفل بعيد ميلادها وهي تعلم أن أباها قد غاب عنها وعن الحياة كلها في مثل ذلك اليوم؟ كثيرون يقولون إن النسيان نعمة، فهل يا ترى تستطيع كاميليا أن تنسى يوم غياب أمها أسمهان وهي تحتفل بعيد ميلادها، وهل يمكن للابنة غيداء أن تنسى الأب بدر شاكر السياب حين تفكر في عيد ميلادها؟! طرحت على نفسي هذا التساؤل بدل المرة مرات، ويبدو أني أريد التخلص من وقع هذا التساؤل، بأن أكتبه على الورق لكي أخرجه بعيداً عن أعماقي! ومع هذا التخلص الذي أحاوله أتساءل في الخاتمة: هل النسيان حقاً نعمة، وهل الذاكرة الحية نقمة؟! ليس سرا أني تواصلت وما زلت أتواصل مع غيداء ابنة الشاعر العظيم الذي حفظت روائعه منذ كنت طالبا جامعيا، وليس سرا أني تواصلت مع كاميليا الأطرش ابنة أسمهان التي أشعر حين أسمع صوتها أن هذا الصوت النادر وردة ترتوي بالألم، وها أنذا أكتب هذه السطور في أجواء ذكرى غيابها عن محبيها وعشاق صوتها منذ تسع وستين سنة، وإذا كانت أسمهان قد رحلت عن عالمنا، وهي في عنفوان الشباب، ذات صباح مكفهر الملامح، هو صباح يوم الجمعة 14 يوليو سنة 1944 فإن عشاق الأصوات الجميلة والأصيلة لا يستطيعون- رغم انقضاء كل ما انقضى من سنوات- أن ينسوا هذه الفنانة الرائعة.
1161
| 18 يوليو 2013
يدرك الذين يستمتعون بقراءة حكاياتنا الشعبية العربية أنهم أمام كنوز ثمينة، يظل لها سحرها المتجدد ورونقها الأصيل، رغم مرور مئات السنوات على رواية أحداثها ووقائعها، ومن هذه الحكايات الشعبية سيرة الأميرة ذات الهمة، وسيرة سيف بن ذي يزن، وحكاية الزير سالم، وحمزة البهلوان، وحكايات ألف ليلة وليلة التي انبهر بسحرها أدباء وشعراء عالميون، وتجلى هذا واضحا فيما كتبوه وأبدعوه من الروايات والمسرحيات والقصائد، التي تشي بهذا الانبهار. تتردد في تلك الحكايات بصورة عامة وفي ألف ليلة وليلة بشكل خاص وقائع ومشاهد الخوارق العجيبة والأمور الغريبة، ورغم أن عقولنا البشرية الآن تعرف أن هذه الوقائع والمشاهد أشبه بالأحلام التي لا تتجسد واقعا أبدا، إلا أنها في الوقت نفسه تثري الخيال وتضفي على الروح متعة ما بعدها متعة. ومن وقائع ومشاهد الخوارق العجيبة والأمور الغريبة صورة القمقم الذي يتيح لمن يعرف أسراره أن يستدعي العفريت بسهولة حيث يقف أمامه طائعا وهو يقول: شبيك لبيك.. عبدك بين إيديك، وصورة القضيب المنقوش بالطلاسم والذي أدرك الصائغ حسن البصري أسراره في ألف ليلة وليلة، فعندما وقع في مأزق من المآزق الصعبة التي تعرض لها، قام بضرب الأرض بذلك القضيب... وإذا بالأرض تنشق ويخرج منها سبعة عفاريت، كل عفريت منهم رجلاه في تخوم الأرض ورأسه في السحاب، فقبلوا الأرض بين يدي حسن البصري ثلاث مرات وقالوا كلهم بلسان واحد: لبيك يا سيدنا، بأي شيء تأمرنا، إن شئت نيبس لك البحار وننقل لك الجبال من أماكنها.. وبالطبع فإن حسن البصري لم يطلب غير إخراجه من مأزقه الصعب. في كثير من الأحيان يخيل لي أن هذا العفريت هو نفسه العلم الذي توصل إليه الإنسان عبر رحلة الإنسانية نحو الارتقاء والاستكشاف، فالعلم – بمختلف فروعه وميادينه- هو الذي حقق وما يزال يحقق للإنسانية أشياء عجيبة، لم يكن القدامى من البشر يستطيعون أن يتصوروا أنها يمكن أن تحدث. ومثلما كان العفريت يتحول إلى أداة للشر إذا كان من يتحكم في القمقم إنسانا شريرا، أو يصبح أداة للخير إذا كان من يتحكم فيه إنسانا طيبا محبا للخير، فكذلك العلم فهو- في حد ذاته- أداة محايدة، ومن هنا يستطيع من يتحكم فيه أن يوجهه إلى ما ينفع أو إلى ما يضر، ولعلنا نتذكر في هذا السياق عذاب الضمير الذي ظل يلاحق ألفريد نوبل عندما اخترع البارود فأصبح قتل الإنسان لسواه أسهل بكثير، ولعلنا نتذكر كذلك أن الطيار الأمريكي الذي ألقى القنبلة الذرية فوق هيروشيما اليابانية يوم 6 أغسطس سنة 1945 قد أصيب بالجنون من هول وبشاعة ما شاهده من الدمار الذي لحق بتلك المدينة، وفي المقابل فإننا نستطيع أن نرصد المنجزات العلمية العديدة التي أسهمت في خير البشرية وفائدتها. وقد يتحول التقدم العلمي إلى أداة من أدوات العبودية أو إلى مشعل ضخم ينير للبشرية طريقها في سعيها نحو الحرية، والأمر في الحالتين يتوقف على الإنسان الذي يحمل بين ضلوعه وفي ثنايا عقله خيرا أو شرا، محبة للآخرين أو رغبة في إذلالهم والسطو على ما يملكونه من خيرات وثروات، لأن العلم في حد ذاته ليس سوى أداة محايدة. لا يستطيع الضعفاء أن يصونوا حقوقهم المادية والمعنوية إلا إذا امتلكوا العلم الذي يحميهم من طيش وبطش الأقوياء إذا تجبروا عليهم، فلو أن الهنود الحمر في الأمريكتين الشمالية والجنوبية كانوا يمتلكون أسلحة متطورة لما تمكن المستعمرون الأوروبيون أن يبيدوهم إبادة شاملة، وأن يحتلوا أرض بلادهم وبلاد آبائهم وأجدادهم، ولهذا فإننا- نحن العرب- لن نستطيع أن نحقق ما نتمناه لمجتمعاتنا إلا إذا خرجنا جميعا من كهوف الخرافة، وحاولنا أن نكون أقوياء بسلاح العلم، وعلينا أن نتذكر - أولا وأخيرا- أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف! حاشية: لا يستطيع الإنسان أن يتنازل عما في حوزته لسواه إلا إذا كان يتمتع بحس إنساني نبيل وجميل، وهذا ما فعله الصديق الرقيق صالح غريب رئيس القسم الثقافي في الشرق، حيث تخلى عن كتابة عموده الشهير- مراويس- في موعده المحدد، لكي ينشر مكانه عمود مرايا الروح الذي كانت الإعلانات قد باعدت بينه وبين موعد نشره، وتبقى تحية الشكر واجبة لصالح غريب الذي آثرني على نفسه.
1056
| 12 يوليو 2013
أقوم اليوم بتأجير مساحتي " مراويس " للأستاذ الكبير حسن توفيق حيث لم نتمكن من نشرها الأسبوع الماضي بسبب الضغط الإعلاني الكبير وكان التأجيل من نصيب صفحات القسم، وإنني أعتذر كثيرا لأستاذي الكبير حسن من عدم تواصل قرائه مع مقاله مرايا الروح كل يوم خميس وإنني أتنازل عن مساحتي إليه على أمل أن التقي بكم الأسبوع المقبل. صالح غريب رغم كل ما قدمته الحضارة العربية – الإسلامية في الأندلس من مآثر ومنجزات، إلا أن أهل الأندلس لم يكونوا متجانسين ولا متقاربين، بل كانوا ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة – تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى – فقد كان فيهم عرب وبربر – أمازيغ، ومعهم يهود، وكان من حكامهم من يستعينون بالفرنجة ضد أشقائهم، وهذا ما جرى في عصر الفتنة ثم عصر ملوك الطوائف وما تلاهما من عصور مضطربة تكفلت بطرد العرب والمسلمين ومعهم اليهود من كل شبر في الأندلس. في تلك الأجواء التي لم تنعم بالأمن والأمان، ولد ابن زيدون في مدينة قرطبة سنة 394هجرية – 1003 ميلادية، وهو إنسان عربي صميم، وهذا ما يشهد عليه اسمه ونسبه، فهو أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن زيدون المخزومي الأندلسي القرطبي، وكان أبوه قاضيا في قرطبة ورجلا محبا للعلم وللعلماء، وهذا ما انعكس على نشأة ابنه بصورة مشرقة، وهي نشأة تتناقض تماما مع النشأة اللاهية للأميرة المدللة ولادة بنت الخليفة المستكفي بالله. منذ بداية حكاية الحب بين الطرفين – ابن زيدون وولادة، ظل الطرف الأول عاشقا صادقا، وقد تجلى هذا فيما أبدعه من روائع شعرية خالدة، بينما ظلت ولادة تتلهى وتتسلى بعد أن ضمنت أنها قد أوقعت الشاعر العاشق في حبالها، وانطلقت لتبحث عن مغامرات ونزوات أخرى، لكي يظل قلب عاشقها الشاعر الصادق محترقا، وهو يقاسي مما يتجرعه من كؤوس العذاب، المرصوصة فوق مائدة السراب. كان لابد أن تحدث الجفوة ما أحدثت من فجوة في العلاقة ما بين الطرفين، ولكي تمعن الأميرة المدللة في إغاظة الشاعر العاشق، بادرت لإقامة علاقة حميمة مع أبو عامر بن عبدوس، وهو وإن كان وزيرا خطيرا وفاسقا وله في المكائد صولات وجولات، إلا أنه لم يكن شاعرا مرهفا كبيرا وشهيرا، وكيف يمكن لمن يجيد حبك المؤامرات والمكائد بدهاء ومكر، أن يكون واحدا ممن يجيدون فن الشعر؟! مكيدة جديدة دبرها الوزير الخطير الفاسق على موائد المكائد ضد الشاعر المرهف العاشق، أما الأميرة اللاهية المدللة فقد اكتفت بأن تتفرج على ما جرى، ربما بشماتة، وربما بلا مبالاة، ومن سجنه الذي ألقته المكيدة في ظلماته كتب ابن زيدون إلى المتفرجة اللاهية: وأعجب كيف يغلبني عدو رضاك عليه من أمضى سلاح فلو أسطيع طرت إليك شوقا وكيف يطير مقصوص الجناح؟ ظل الشاعر العاشق غارقا في ظلمات السجن نحو خمسمائة يوم، ولما يئس من أن يفرج عنه الذين ظلموه حين سجنوه، قرر الهرب لكي يستعيد حريته المفقودة، وقد ساعده فيما قرره أحد محبيه وهو أبو الوليد بن جهور، لكنه برغم محنة السجن لم يستطع أن ينسى حبيبته الجميلة ولادة، وهذا ما سجله في رائعته المطولة التي أرى أنها لؤلؤة ساطعة من لآليء تراثنا الشعري العربي، وفيها يقول: إنا قرأنا الأسى يوم النوى سورا مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا أما هواك فلم نعدل بمنهله شربا وإن كان يروينا فيظمينا لم نجف أفق جمال أنت كوكبه سالين عنه ولم نهجره قالينا عليك مني سلام الله ما بقيت صبابة منك نخفيها فتخفينا أظن أن من حقي الآن أن أتساءل: أيهما انتصر على الآخر.. الشاعر العاشق أم الوزير الفاسق؟. وأبادر فأقول إننا جميعا نستعيد إلى اليوم روائع ابن زيدون بنفس القدر الذي نتذكره بها، أما ابن عبدوس، فلا أحد منا كان يمكن أن يتذكر اسمه لولا ما اقترفه من مكائد تجاه شاعر كبير عاش وسيظل يعيش متجددا ومتألقا في كل قلب من قلوب العشاق الصادقين والشعراء المرهفين.
5127
| 07 يوليو 2013
لا يستطيع الإنسان أن ينزل النهر مرتين، هذا ما قيل في زمن الإغريق، وما زال كثيرون منا يكررونه ويرددونه حتى اليوم، أما برهانهم على هذا الذي يكررون ويرددون فهو يتمثل في أن مياه النهر لا تتوقف عن الجريان، ومن هنا فإن الإنسان لا يستطيع أن يستحم في نفس المياه حتى لو نزل إلى النهر من مكان محدد معروف... ولأن الزمان أمر نسبي، يبدو زمان الأرنب - بسرعته وبقصر عمره- مختلفا تماما عن زمان السلحفاة -ببطئها وبطول عمرها- ولأن الزمان أمر نسبي، فإن الأحداث التي تقع فيه هي التي تفرض علينا الإحساس بأنه يمرق بسرعة أو ينقضي ببطء. فالعاشق حين تهجره الحبيبة يشعر بطول الليل، أما حين يلتقيان بكل اشتياق، فإنه يشعر أن الوقت يمرق بسرعة، وهذا ما يؤكده شاعر الأندلس الجميل ابن زيدون في إحدى روائعه الشهيرة، قائلا: يا أخا البدر سناء وسنا حفظ الله زمانا أطلعك إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك الذين لا يخططون للزمان الآتي ولا ينظرون بالبصيرة وبالعقل إلى المستقبل، لابد أن يجرفهم طوفان الزمان في حاضرهم، حتى وإن اعتصموا منه بأعالي الجبال. فلو نظرنا – على سبيل المثال - إلى تاريخ الصراع الطويل بيننا نحن العرب وبين الكيان الذي زرع في جسد الأمة العربية منذ 15 مايو عام 1948، فإننا نجد أن الصهاينة كانوا يخططون للزمان الآتي، ثم ينفذون كل ما خططوا له بدقة وإحكام، أما نحن فقد كنا ننتظر ما يحدث، فلا تصدر منا إلا ردود أفعال غاضبة سرعان ما تتلاشى عندما نواجه حدثا آخر جديدا، ينسينا ما حدث ويجعلنا نندفع لإغراق أنفسنا في دوامة جديدة من الانفعالات الجوفاء، التي نغرق فيها مع كل فعل معاد لنا. نحن دائما نتعامل مع الأحداث لا بالأفعال، وإنما بردود الأفعال، وهذا ما يجعل كل حركة من جانبنا تبدو حركة مرتبكة، وحين نشعر بالارتباك نتجمد في أماكننا، كأن الشلل قد داهمنا فجأة، لكننا مع هذا نظل نعزي أنفسنا أو نبرر عجزنا بالقول إن الأمور ستتحسن في القريب، دون أن نبادر إلى العمل المثمر الخلاق الذي يتيح لمثل هذا التحسن أن يكون واقعا ملموسا ومحسوسا! ما أعرفه أن الزمان لا ينتظر أحدا، فهو يتحرك بكل عنفوان، وقد يبدو من سرعة حركته أنه بمثابة الطوفان الجامح الذي يجرف في طريقه كل ما يعترضه ومن يعترضه. ومن البديهي والمنطقي أن الزمان لا ينتظر أن يصحو النائمون من رقادهم حتى يتحركوا معه، فالناجون من الطوفان هم وحدهم الذين يهيئون أنفسهم بقدراتهم لملاقاته ومواجهته. أظن أن علينا أن نسأل أنفسنا: هل حركتنا مع الزمان – الطوفان مثل حركة الأرنب في سرعته، أم مثل حركة السلحفاة في بطئها؟ وعلينا أن نمتلك شجاعة الفعل، لا أن ننتظر الفعل المعادي ثم نقوم برد فعل مضاد، قد يكون عاتبا أو غاضبا أو يائسا، ولكي نمتلك شجاعة الفعل، أتصور أنه من الضروري والحتمي أن نخطط للزمان الآتي.. للمستقبل.. هذا ما أتمناه، وهو ما يدعوني لأن أصرخ بأعلى ما أستطيع: علينا أن نخطط من الآن.. فالطوفان قادم، وهو لا يرحم المرتبكين الشاكين أو الباكين!
767
| 20 يونيو 2013
ميخائيل نعيمة كاتب عربي- لبناني كبير، ولد يوم17 أكتوبر سنة 1889 ورحل عن عالمنا يوم 22 فبراير سنة1988 أي أنه عاش تسعا وتسعين سنة، وعلى امتداد مسيرة حياته تنقل ما بين بيئات مختلفة، وتغلغل في أعماق ثقافات متنوعة، وهذا ما يدفعني للقول إن عطاءه الأدبي الرائع ثمرة مدهشة من ثمرات تزاوج البيئات والثقافات، حيث انتقل – وهو طفل صغير- من بسكنتا اللبنانية إلى الناصرة الفلسطينية، ثم عاش في أجواء البيئة الروسية في زمن روسيا القيصرية، وبعد خمس سنوات انتقل منها إلى بيئة أخرى، هي البيئة الأمريكية، التي عاش في أجوائها إحدى وعشرين سنة، وإلى جانب لغتنا العربية التي يعد أحد أدبائها العظماء، فإن له نتاجا أدبيا وشعريا باللغتين الروسية والإنجليزية. لميخائيل نعيمة كتاب مشوق ورائع، سجل فيه مسيرته مع الحياة عبر البيئات المختلفة والثقافات المتنوعة التي أسهمت في تشكيل وجدانه الإنساني، كما انعكست إشعاعاتها على عطائه الأدبي، لكن ما يعنيني الآن يتمثل في كونه واحدا من المهاجرين العرب الأوائل الذين انطلقوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان معظم هؤلاء من أهل الشام- سوريا ولبنان، ثم تتابعت قوافل المهاجرين العرب من أوطانهم العربية إلى أمريكا وإلى سواها من دول العالم، وأمامي الآن- على سبيل المثال- كتاب جديد، بعنوان: الجيل الثاني من المصريين في أوروبا، وهو من تأليف فاطمة حامد الحصي، وقد صدر عن مكتبة جزيرة الورد بالقاهرة. ما أود الإشارة إليه هنا يتمثل في مدى انصهار المهاجرين العرب في بوتقة المجتمعات التي انطلقوا للعيش فيها، وكيف تمكنوا من التغلب على الصعوبات والمآزق التي واجهتهم إلى أن استطاعوا الاندماج مع طبيعة تلك المجتمعات التي حملوا فيما بعد جنسيات دولها المختلفة؟ وبالطبع فإن هؤلاء المهاجرين العرب لا يشكلون عجينة متجانسة، تتيح لنا أن نطلق أحكاما عامة عليهم، فمنهم من خرجوا هربا من اضطهاد ديني أو عرقي أو مذهبي، ومنهم من خرجوا لمجرد البحث عن حياة أفضل وأجمل، وكل هذه الأسئلة والقضايا وسواها تعيدني إلى الكتاب المشوق والرائع لميخائيل نعيمة، وهو بعنوان: سبعون، وفيه ملاحظات طريفة عن محاولات أقاربه وأصدقائه المهاجرين اللبنانيين لأن ينسلخوا من جلودهم، لكي يشعروا أنهم أمريكيون، مثل سواهم من الأمريكيين الآخرين! يقول ميخائيل نعيمة: في عقيدة مهاجرينا إلى أمريكا أن تبدل الأماكن والأزمان يقضي بتبدل الأسماء كذلك، وهكذا غيّر أخي أديب اسمه فأصبح دجو، وغيّر أخي هيكل اسمه فأصبح هنري، وكم من مهاجر ترجم حتى اسمه وكنيته ترجمة حرفية، فبات منصور حداد- مثلا- فيكتور سميث، ولولو أسمر أصبح بيرل براون! هذا الذي قاله ميخائيل نعيمة، يذكرني بالمقولة الخالدة التي قالها العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في ثنايا كتابه العظيم- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، حيث يقول: المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه. إذا كان ميخائيل نعيمة قد أشار إلى ما فعله أقاربه وأصدقاؤه من تغيير لأسمائهم، بل من ترجمة حرفية لها، وهم من المهاجرين العرب الرواد والسباقين إلى الهجرة من أوطانهم العربية، فما بالنا بما فعله أبناء هؤلاء وأحفادهم، لكي يندمجوا ويذوبوا تماما في المجتمعات التي هاجروا إليها؟ كلنا بالطبع نعرف إيليا أبو ماضي، صاحب رائعة كُنْ جميلا تَرَ الوجودَ جميلا، وصاحب الطلاسم التي غنى محمد عبد الوهاب ومن بعده عبد الحليم حافظ مقطوعات منها، واشتهرت بعنوان لست أدري، لكن كثيرين منا لا يدرون أن أبناء وأحفاد هذا الشاعر العربي المهجري الكبير لا يستطيعون أن ينطقوا كلمة عربية واحدة، وهكذا يظل المغلوب مولعا بالاقتداء بالغالب، وتلك سُنّة الحياة في كل زمان ومكان!
4278
| 13 يونيو 2013
في كل زمان ومكان، يتجلى جمال الإنسان في شوقه المتجدد لأن يتجاوز ما استطاع أن يحققه في حاضره، وهو يخطو إلى المستقبل. هذا الشوق المتجدد هو مفتاح التقدم الذي يتيح لأبناء كل حضارة حديثة أن يحققوا ما لم يستطع أبناء الحضارات السابقة أن يحققوه. وإذا كان الإنسان يستمتع- وجدانيا- بالفنون والآداب، فإنه لا يستطيع أن يرتقي بحضارته إلا بالعلوم المتنوعة في مختلف المجالات والميادين. وفي مجال البحث العلمي، ينبغي على الباحث أن يشحذ عقله، لكي يقدم جديدا مفيدا، أما إذا لم يوظف العقل، واكتفى بالنقل، فلا بد أن ينطبق عليه قول الشاعر العربي القديم: وظَلّ يقدح طولَ الليل فكرته- وفسّر الماءَ بعد الجهدِ بالماءِ! يلجأ الباحثون الجادون، ومعهم عشاق المعرفة إلى مصادر عديدة، تتيح لهم أن يبحثوا، ومن هذه المصادر الموسوعات العامة أو المتخصصة، وأشهر موسوعة عالمية هي الموسوعة البريطانية، أما الأشهر في عالمنا العربي فهي الموسوعة العربية، ولكي لا أكون مثل هذا الذي يفسر الماء بعد الجهد بالماء، فإني سأنقل حرفيا تعريف (ويكبيديا) للموسوعة، حيث تقول: الموسوعة أو دائرة المعارف هي مؤلف يحوي معلومات عامة حول موضوعات المعرفة الإنسانية أو متخصصة في موضوع معين, ويغلب على معلوماتها الاختصار، وتعتمد على دقة التنظيم بحسب الترتيب الهجائي ليسهل على المستفيد الرجوع إليها بأقل جهد. وتعتمد الموسوعات الجيدة على عدد من الكاتبين، كل يكتب في مجال تخصصه. من المعروف أن ويكبيديا العربية قد تم إطلاقها يوم 9 يوليو سنة 2003 وقد جذبت هذه الموسوعة كثيرين من الشباب العرب الذي يستسهلون البحث عما يريدون من خلال فضاء الإنترنت، وهذا أمر لا اعتراض عليه، لكن ما جرى بعد ذلك أن السيدة فلورانس ديفوارد رئيسة مؤسسة ويكبيديا قد زارت مكتبة الإسكندرية يوم 17 يوليو 2008 حيث أعلنت عن إطلاق ويكبيديا مصري، بدعم من المدعو السيد غالي، وأنقل هنا حرفيا تعريف هذه الموسوعة كما هو مكتوب باللهجة العامية المصرية: ( ويكبيديا مصري مكتوبة بالمصري اللي بيتكلمه المصريين ومكتوبة زي ما بيكتبوها في جواباتهم لبعضيهم وفي حياتهم اليومية.. ممكن الكتابة بالمصري بأي طريقة طالما أي مصري ممكن بفهمها. ما دام اليوزر يعرف يكتب بالمصري ممكن انه يكتب اللي يعرفه في ويكبيديا مصري...) كنت قد تنبهت إلى هذه الكارثة الفضائحية، وأنا أتهيأ لكتابة ما كتبته بعنوان: طه حسين بالعامية في ويكبيديا، وأقول الآن- وبمنتهى الوضوح: إن هذه الكارثة الفضائحية هي جزء لا يتجزأ من محاولات التخريب الحاقدة التي تسعى بشكل محموم إلى تدمير الجسور الثقافية ما بين أبناء العروبة الذين تجمعهم لغة واحدة عريقة، هي لغتنا الجميلة والمعروفة للجميع في كل دولة عربية، ولن يكون مستغربا فيما بعد أن يتطوع أمثال المدعو السيد غالي بدعم: ويكبيديا عراقي-أو مغربي أو قطري أو سوداني، طالما أن لكل شعب عربي لهجة عامية، وفي هذه الحالة لا بد من ترجمة إبداعات المتنبي والمعري والجاحظ وسواهم من عمالقة الأدب العربي من اللغة العربية التي أبدعوا بها إلى اللهجات المحلية لكل شعب عربي، وبالمناسبة فإن هناك من يصفون أبناء الدول العربية بأنهم الشعوب الناطقة بالعربية، لكي يلغوا كل ما بيننا من وشائج وروابط متينة، ولابد لي أن أشير إلى أن مقالات ويكبيديا مصري تُكتب بالحروف العربية وكذلك بالحروف اللاتينية، تماما كما أصبحت اللغة التركية تكتب بالحروف اللاتينية منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك وإلى يومنا هذا، وهذا هو نفس ما كان سلامة موسى قد دعا إليه في مصر ولكنه فشل في دعوته، وهو كذلك نفس ما حاول سعيد عقل أن يحققه –عمليا- في لبنان، لدرجة أنه أصدر جريدة كانت تُكتب باللهجة اللبنانية وبالحروف اللاتينية، ولكن لم يقدر لها أي نجاح. في الخاتمة أقول: لست خائفا ولا منزعجا من الكارثة الفضائحية المدعوة ويكبيديا مصري، لأن مصيرها سيكون نفس مصير ما دعا إليه كل من سلامة موسى وسعيد عقل. لست خائفا ولا منزعجا لأني واثق أن المكر السيئ لن يحيق إلا بأهله!
490
| 06 يونيو 2013
مساحة إعلانية

يترقّب الشارع الرياضي العربي نهائي كأس العرب، الذي...
1038
| 18 ديسمبر 2025

لم يكن ما فعلته منصة (إكس) مؤخرًا مجرّد...
930
| 16 ديسمبر 2025

يوماً بعد يوم تكبر قطر في عيون ناظريها...
696
| 15 ديسمبر 2025

السعادة، تلك اللمسة الغامضة التي يراها الكثيرون بعيدة...
669
| 14 ديسمبر 2025

يُعد استشعار التقصير نقطة التحول الكبرى في حياة...
630
| 19 ديسمبر 2025

إنه احتفال الثامن عشر من ديسمبر من كل...
609
| 18 ديسمبر 2025

هنا.. يرفرف العلم «الأدعم» خفاقاً، فوق سطور مقالي،...
591
| 18 ديسمبر 2025

في عالمٍ تتسارع فيه الأرقام وتتناثر فيه الفرص...
588
| 14 ديسمبر 2025

يأتي الاحتفال باليوم الوطني هذا العام مختلفاً عن...
549
| 16 ديسمبر 2025

لقد من الله على بلادنا العزيزة بقيادات حكيمة...
501
| 18 ديسمبر 2025

-إعمار غزة بين التصريح الصريح والموقف الصحيح -...
444
| 14 ديسمبر 2025

يُعَدّ علم الاجتماع، بوصفه علمًا معنيًا بدراسة الحياة...
435
| 15 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية