رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الرحمة مبعث الإنفاق والشعور بالآخرين، وهي قَسم مشترك بين بني البشر، وكل من يعلي من إنسانيته، ومن ثم لا يختص بالإنفاق مسلم عن كافر، ولا رجل عن امرأة اللهم إلا في الدوافع والمآلات.وتخفيف معاناة المنكوبين شعور وسلوك مركوزان في الفطرة الإنسانية بعيدًا عن اللون، أو العرق، أو النوع، أو الدين.قرأت أن لاعب الجولف الأمريكي (تايجر وودز) أنشأ مركزًا تعليميًا للأطفال ضمن سلسلة مراكز مماثلة موزعة في الولايات المتحدة، وأنشأ كذلك منظمة تايجر وودز الخيرية سنة 1996م، كما أنه يقيم حفلاً سنويًا لجمع التبرعات.كما أن (وارن بوفت) من أغنى أغنياء العالم تبرع بمبلغ 31 مليار دولار من ثروته المقدرة بأربعة وأربعين مليار دولار إلى المؤسسات الخيرية، وأولها مؤسسة "بيل جيتس" الخيرية.وإن السمو الإنساني يكتمل ليتجسد في إنفاق نبي الإنسانية، وهو يعلمنا كيف نتعامل مع المال، ووظيفته في سد حاجات المجتمع، وإسعاد الفقراء والمساكين، حتى إنه ينفقه كله لا يبقي منه شيئًا.قالت أم سلمة - رضي الله عنها-: دخل عليَّ رسول الله وهو أسهم الوجه - أي متغير لون الوجه - فحسبت ذلك من وجع، فقلت: يا نبي الله: مالك أسهم الوجه؟ فقال: «من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس، أمسينا وهي في خصم الفراش»، وفي رواية: «أمسينا ولم ننفقها» رواه أحمد في مسنده وروى أحمد – أيضا - عن أنس بن مالك " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين"، فأتى الرجل قومه فقال: أي قومي، أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطية رجل ما يخاف الفاقة. أو قال: الفقر.- واليد التي تعطي لله، غير ناظرة إلى ثناء أو مدح، وغير آبهة بشهرة أو مكانة هي اليد الطولى التي امتدح النبي أهلها.- قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-: قال رسول الله: «أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا»، قالت: فكن – أي زوجات الرسول - يتطاولن أيتهن أطول يدًا، قالت: وكانت أطولنا يدًا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، وفي طريق آخر: فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب، رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل زينب أم المؤمنين.وشعور المؤمن بحاجة الآخرين، واعتقاده بوجوب تخفيف المعاناة عنهم بقدر الوسع، وقضاء حوائجهم يدفعانه إلى التفنن في العطاء، وكأن الإنفاق فنون ومدارس، أو رؤى ومذاهب، وقد علمنا من ذلك مدرستين.. مدرسة عائشة ومدرسة أسماء. قال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما-: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء - رضي الله عنهما- وجُودُهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئًا لغد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
1212
| 12 ديسمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مداواة المريض واجب ديني واجتماعي، والإحسان إليه مكرمة، وعيادته فضيلة، والدعاء له والتخفيف من معاناته أدب إسلامي رفيع، وفي حديث ثوبان أن رسول الله قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع»، وفي رواية، قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها». وقد اهتم المسلمون منذ القرن الأول الهجري بحقوق المرضى،ووجد الحكام والخيرون في إقامة المشافي، ورعاية المرضى واجبًا دينيًا، وخلقًا اجتماعيًا يستحق أن تبذل فيه كرائم الأموال، فبنوا عشرات المشافي، وجلبوا لها الأطباء المتخصصين في كافة فروع الطب قيامًا بالواجب تجاه المرضى. وقد بدأت المارستانات - أو البيمارستانات - في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88هـ بدمشق.وأنشأ المنصور ملجأ للعميان، واليتامى، والقواعد من النساء.وقد حكى التاريخ أن فتحة بنت سنان بن ثابت أنشأت مارستانًا سنة 306ه، وكانت تنفق عليه 600 دينار شهريًا. وللخيرين - أفرادًا ومؤسسات وهيئات - أن يضربوا بسهام من الخير في هذا المجال، فمرضى الكبد والسرطان والكلى والقلب وغيرهم يعدون بالآلاف، بل بالملايين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولهؤلاء حق على مجتمعهم في العلاج، والتخفيف عنهم وتسريتهم.وقد عرف الوقف الخيري في تاريخ حضارتنا الإسلامية وقفًا باسم (مؤنس المرضى والغرباء) كان ينفق منه على عدة مؤذنين من كل رخيم الصوت حسن الأداء، فيرتلون القصائد الدينية طوال الليل، بحيث يرتل كل منهم ساعة حتى مطلع الفجر، سعيًا وراء التخفيف عن المريض الذي ليس له من يخفف عنه، وإيناس الغريب الذي ليس له من يؤنسه. وكم من مريض اليوم يحتاج إلى من يواسيه، ويخفف عنه في ثمن العلاج الذي لا يجده، حتى يستعصي الداء على الدواء، وتعجز قدراته عن الوفاء بتكاليف الطبيب أو الدواء أو كليهما، واسألوا الأطباء والصيادلة والمشافي عن عشرات الحالات التي يقف فيها المريض - أو مرافقه - حائرًا أمام المبلغ المطلوب دفعه وفاءً بثمن الروشتة التي حددها الطبيب.وكم من حاجة مماثلة كشفت ستر المتعففين، فسألوا الناس مضطرين تفيض أعينهم بالدمع، وتستر وجوههم خمرة الخجل، ويتمنى بعضهم لو أنه قبض قبل أن يصير إلى هذا المآل.بل سجل التاريخ عن المسلمين في تخفيف معاناة المرضى ومواساتهم وقفًا عُرف باسم (وقف خداع المريض)، - كما يذكر الشيخ القرضاوى - وفيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة في المستشفيات، وهي تكليف اثنين من الممرضين أن يقفا قريبًا من المريض بحيث يسمعهما ولا يراهما، فيقول أحدهما لصاحبه: ماذا قال الطبيب عن هذا المريض؟ فيرد عليه الآخر: إن الطبيب يقول: إنه لا بأس به، فهو مرجو البرء، ولا يوجد في علته ما يشغل البال، وربما نهض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام .ويستطيع الموسرون والقادرون - أفرادًا وهيئات - أن يواسوا المريض اليوم بالزيارة والدعاء، وتحمل نفقات العلاج، خاصة الذين يتناولون أدوية بصورة منتظمة ومستمرة، مثل مرضى السكري، والضغط، والقلب.. وغيرهم.كما يستطيعون أن يوقفوا مستوصفات علاجية في القطاعات الشعبية والأحياء الفقيرة، يتم توقيع الكشف فيها بأجر رمزي، ويصرف الدواء فيها مدعومًا أو مجانا .ويتسع العطاء والمواساة للمرضى لتشمل تزويد المستشفيات والمستوصفات العامة القائمة، بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية والجهات المعنية بالأجهزة والمستلزمات الطبية، كي تحسن أداءها خدمة للفقراء من المرضى.كما تشمل المواساة توفير الكراسي المتحركة للمعاقين والمرضى الذين يحتاجون إليها، فكم من حالة بحاجة إلى مثل هذه الكراسي عزّ من يلبيها.وليتذكر الغني الصحيح، كم لله عليه من نعمة وهو يسير على قدميه أو راكبًا سيارة فارهة، وإلى جواره من يحتاج إلى كرسي متحرك ليتنقل بواسطته.يقول بعضهم : كنت أبكى عندما أرى من يركب السيارة وأنا أسير بلا حذاء ، ثم توقفت عن البكاء عندما رأيت إنسانا مقطوع القدمين .
5470
| 05 ديسمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أدت بيعة العقبة الثانية، وما اشتملت عليه من بنود النصرة والمنعة وما تلاها من هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة إلى ظهور المجتمع السياسى الإسلامى الأول، وبالهجرة اجتمع أصحاب المنهج الفكرى الواحد، على أرض يأمنون فيها، تحت قيادة يرتضونها، فتحول المجتمع الإنسانى إلى مجتمع سياسى، وبتولية النبى صلى الله عليه وسلم زمام السلطة السياسية فى المدينة، وكتابته للوثيقة التى يسميها كثير من الباحثين " دستور المدينة " وعقد ما يمكن تسميته حديثًا باتفاقية دفاع مشترك بين أهل المدينة قاطبة مسلمين وغير مسلمين، بهذا تأسست دولة الإسلام الأولى وتشكلت معالمها السياسية، حيث تحقق لها العناصر اللازمة لتكوين الدولة من الشعب والأرض والقيادة. وقد اشتملت وثيقة المدينة أو دستور المدينة " على أهم المبادئ السياسية التى تقوم عليها أعظم الدول عراقة وحضارة فى عالم اليوم. فقد اشتملت على مبادئ تحديد أساس المواطنة فى الدولة، وتوسيع نطاقها فلم تحصر المواطنة فى المسلمين وحدهم، بل نصت الوثيقة على اعتبار اليهود المقيمين فى المدينة من مواطنى الدولة وحددت ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، وكذا مبدأ تعيين شخص رئيس الدولة، وتقرير مبدأى العدل والمساواة، وتقرير مبدأ الانضمام إلى المعاهدة بعد توقيعها، ومنع إبرام صلح منفرد مع أعداء الأمة. لقد كان واضحًا منذ بداية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها دعوة عالمية شاملة، السياسة فيها حلقة من حلقاتها، ولا تنفك السياسة فى مبادئها عن الأخلاق، ولا المعاملات عن السلوك، ولا الاقتصاد عن العبادات. لقد كانت نشأة الدولة الإسلامية الأولى فى المدينة تتويجًا لهذا التصور الشامل، والذى كان واضحا تمام الوضوح فى دعوة النبى صلى الله عليه وسلم فى العهد المكى يوم أن كان هو وأصحابه مضطهدين فى مكة، وإن العهد المدنى بكل مشتملاته إنما هو امتداد طبيعى للعهد المكى دونما تغير فى المبادئ والتصورات العامة، وإن جاءت التشريعات فيه أكثر تفصيلًا، وإن زيدت بعض المبادئ بما يناسب طبيعة الزمان والمكان الجديدين. وقد نقل الدكتور محمد ضياء الدين الريس فى كتابه النظريات السياسية الإسلامية عن المستشرق " جب " ما يوضح هذه الحقيقة التاريخية، ونحن ننقل عنه مقالته لأهمية كلامه كونه يصدر عن غير مسلم، والحق ما شهدت به الأعداء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كونه يعبر عن الحقيقة التاريخية بأصدق ما يكون التعبير وأدقه. يقول : يُنظر إلى الهجرة غالبًا على أنها نقطة تحول آذنت ببدء عهد جديد فى حياة محمد وأخلاقه، ولكن المقابلة المطلقة التى يعرضونها عادة بين شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم غير المشهور المضطهد فى مكة، وبين شخصية المجاهد فى سبيل العقيدة فى المدينة ليس لها ما يبررها من التاريخ. لم يحدث انقلاب فى تصور محمد لمهمته أو شعوره به من الوجهة الشكلية ظهرت الحركة الإسلامية بصورة جديدة، وأدت إلى إيجاد مجتمع قائم بذاته منظم على قواعد أساسية تحت قيادة رئيس واحد. ولكن هذا لم يكن إلا مجرد إظهار ما كان مضمرًا – أى ماكان نظريا -، وإعلان ما كان مستترًا، فقد كانت فكرة الرسول الثابتة ــ وكانت هى أيضًا ما يتصوره خصومه ــ عن هذا المجتمع الدينى الجديد الذى أقامه أنه سينظم تنظيمًا سياسيًا، ولن يكون هيئة دينية منفصلة مندرجة تحت حكومة زمنية. وكان يبين دائمًا فى عرضه لتاريخ الرسالات السابقة أن هذه هى إحدى الغايات الأساسية التى تتألف منها الحكمة الإلهية فى إرسال الرسل. فالشئ الجديد الذى حدث بالمدينة هو إذن فقط:" إن الجماعة الإسلامية قد انتقلت من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية . لقد أقام النبى صلى الله عليه وسلم على أساس مبادئ وثيقة المدينة دولة بالمعنى الفنى الكامل لهذا المصطلح عند أهل الاختصاص، ومارس فيها فعلًا أمور الحكم والرئاسة ومارست هذه الدولة الجديدة السلطات التى تمارسها أية دولة فى العالم ــ قديمه وحديثه ــ وهى سلطات التشريع والقضاء والتنفيذ، ورغم أن هذه التعبيرات من ابتداع النظم الدستورية والقانونية فى العصر الحديث إلا أنه من المسلم أن الدولة الإسلامية ــ منذ قيامها ــ قد عرفت هذه السلطات( كما يقول أستاذنا الدكتور محمد سليم العوا.
792
| 28 نوفمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نقل الإمام ابن القيم في تعريف السياسة عن أبي الوفاء عقيل الحنبلي "أن السياسة هي الفعل الذي يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد ما دامت لا تخالف الشرع". وقال الإمام الغزالي في الإحياء عن قدرها وفضلها: إن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا، والملك والدين توءمان، فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. وقد عرف ابن خلدون الخلافة – الرئاسة - في مقدمته بأنها نيابة عامة عن صاحب الشرع - وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ في حراسة الدين، وسياسة الدنيا به. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، سياسيًا بجوار كونه مبلغًا ومعلمًا وقاضيًا.. فقد كان هو رئيس الدولة، وإمام الأمة، وكان خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده سياسيين على نهجه وطريقته، حيث ساسوا الأمة بالعدل والإحسان، وقادوها بالعلم والإيمان. وكتب الشيخ محمود شلتوت كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة" ليؤكد على أن الإسلام دين ودولة. وقد فصل بعض العلماء في المعنى الشامل للإسلام، فقالوا: إن الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، وسماحة وقوة، وخلق ومادة، وثقافة وقانون، وأن المسلم مطالب بحكم إسلامه أن يعنى بكل شؤون أمته ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وقد انتقد الشيخ الخضر حسين وضع الفصل بين الدين والسياسة، واعتبر هذا الفصل بدعة منكرة. وشخصية المسلم التي يشكلها الإسلام تمثل السياسة فيها أحد جوانب التشكيل والصياغة، ومن ثم فلا مفر من أن تكون شخصيته سياسية، لأن الإسلام يضع في عنق كل مسلم فريضة اسمها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يعبر عنها بعنوان النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وإن المسلم قد يكون في قلب الصلاة، ومع هذا يخوض في بحر السياسة حين يتلو من كتاب الله الكريم آياتٍ تتعلق بأمور تدخل في صلب السياسة، مثل الآيات التي تتحدث عن الصراع بين موسى عليه السلام وفرعون في سورة طه، أو الآيات التي تدعو إلى الحكم بما أنزل الله تعالى في سورة المائدة. ويرجع السبب في ذم السياسة لدى كثير من مسلمي اليوم إلى كثرة ما عانوه من السياسة وأهلها – كما يقول الشيخ يوسف القرضاوي - سواء كانت سياسة الاستعمار، أو سياسة الحكام الظلمة، فقد كرهوا السياسة، وكل ما يتعلق بها، خصوصًا بعدما أصبحت فلسفة ميكيافيلي هي المسيطرة على السياسة والموجهة لها، حتى حكوا عن الشيخ محمد عبده أنه بعدما ذاق من مكر السياسة وألاعيبها ما ذاق ــ قال ــ كلمته الشهيرة: "أعوذ بالله من السياسة، ومن ساس ويسوس، وسائس ومسوس".
1238
| 21 نوفمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قد تقع من الولاة والحكام بعض الهنات تجاه أهل الذمة، وقد يصدر منهم بعض الإيذاء لهم، ولكن يبقى العلماء العاملون والفقهاء الصادقون ضمير الأمة الحي إذا تجاوز الحكام أو ظلموا، أو جاروا وبدلوا، فهم الأمناء على ميراث النبوة، وهم الحاكمون على تصرفات الحكام والأمراء، فما وقع منهم موافقًا للشرع أقروه، وما جاء على غير هذه الصفة أنكروه وبينوا صوابه، وقلما نجد فى التاريخ الإسلامى عهدا ظلم فيه أهل الذمة إلا وقد ظلم معهم أو قبلهم المسلمون. ويبقي إنكار فقهائنا شاهدًا على نقاء صفحة الإسلام، وبراءته من كل صنيع يقع مخالفًا للشريعة. حدثنا التاريخ عن الموقف الإيماني الأخلاقي للإمام الأوزاعي كما يذكر البلاذري في فتوح البلدان حين أجلى صالح بن على بن عبد الله بن عباس قوما من أهل الذمة فى لبنان حين جاءوا بما يعد نكثا للعهد ، فكتب إليه الأوزاعي رسالة طويلة حفظ منها:" قد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئًا – مساعدًا ومعاونًا- لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم، ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت، فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة، حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم وحكم الله تعالى : ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ النجم 38،وهو أحق ما وُقِف عنده، واقْتُدِي به، وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: "من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته فأنا حججيه". رواه أبو داود. وفي زمان عبد الملك بن صالح وقع من أهل قبرص – أيضا - حدث رآه عبد الملك نكثًا للعهد، أو من بعضهم، والفقهاء يومئذ متوافرون، فكتب إلى عدد منهم يشاورهم في محاربتهم فكان ممن كتب إليه الليث بن سعد ، ومالك ابن أنس، وسفيان بن عيينة، وموسي بن أعين ، وإسماعيل بن عياش ، ويحيى بن حمزة ، وأبو إسحاق الفزاري ، ومخلد بن حسين ، فكلهم أجابه فى المسألة . ثم عقب أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه الخراج فقال: وقد اختلفوا في الرأي إلا أ نَّ منْ أمره بالكف عنهم والوفاء لهم وإن غدر بعضهم أكثر ممن أشار بالمحاربة. وكان مما جاء في كتاب إسماعيل بن عياش :"وإني أرى أن يقروا على عهدهم وذمتهم، فإن الوليد بن يزيد كان قد أجلاهم إلى الشام، فاستفظع ذلك واستعظمه فقهاء المسلمين، فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرص، فاستحسن المسلمون ذلك ورأوه عدلًا. هذه أخلاقيات فقهائنا النابعة من تعاليم ديننا ، فأين هذا من أخلاق الآخر الذى يطعننا فى ظهورنا ؟ وأين هذا ممن يعيشون بيننا ويدينون بالولاء لغيرنا ؟ وأين هذا من الآخر الذى يستقوى بالخارج ضد أبناء وطنه ؟ وأين أخلاق الآخر من المذابح التى ترتكب في حق المسلمين فى بقاع شتى يمثل فيها المسلمون أقلية عددية بل وللأسف فى بعض البلاد التي تقطنها أغلبية مسلمة ؟لقد سقطت أخلاقيات زعامات الآخر الدينية من سجل الضمير الإنسانى حين صمت أو أيد أوحرض على قتل المسلمين فى بقاع شتى لمجرد الهوية .
914
| 14 نوفمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان للفقه الإسلامي نظرته الصائبة في الانتقال بالمرأة من الولاية الخاصة إلى الولاية العامة منذ القرن الثاني الهجري حين قرر أبو حنيفة والأحناف جواز ولاية المرأة للقضاء فيما تشهد فيه ــ أي ما عدا الحدود والقصاص ــ، وتوسع الأمر أكثر حين قرر الطبري وابن حزم وبعض المالكة جواز ولاية المرأة للقضاء بإطلاق . وحين نقف على تلكم الرؤية الفقهية الحضارية لحقوق المرأة في الولايات العامة في القرن الثاني الهجري وما بعده، نتبين إلى أي حد حظيت المرأة في الفقه الإسلامي بحقوقها منذ أمد بعيد. وكان من الطبعي أن تمتد مسيرة التوسع والعطاء لحقوق المرأة إلا أن عصور الجمود الفقهي والتعصب المذهبي، والتراجع الحضاري حالت دون ذلك ووقفت عند هذا الحد، ولم تكتف بذلك بل أرادت أن تتراجع عن المكتسبات الحقوقية في الولايات العامة للمرأة التي قررها الفقهاء من قديم. وأراد البعض أن تظل المرأة حبيسة بيتها، وأن تظل أسيرة عادات وتقاليد ليست من الإسلام في شيء، وحاولوا في ذلك أن يضفوا على نظرتهم صفة الشرعية بتفسيرات مغلوطة لبعض النصوص الشرعية مثل تنصيف ميراث الأنثى بالنسبة للذكر، وتنصيف شهادة المرأة بالنسبة للرجل، وأن النساء ناقصات عقل ودين . وكان هذا أكبر خطر يواجه قضية المرأة، ألا وهو خطر سيادة مفاهيم وتصورات تخالف ما جاء به الشرع ياسم الشرع . وفي ظل سيادة هذه المفاهيم الخاطئة عن المرأة والتي تتزيا بزي الشرع ظل وضع المرأة في تراجع . وفي عصرنا وقعت المرأة ضحية بين صنفين من الغلاة. غلاة المتدينين، وغلاة العلمانيين ومن على شاكلتهم. فالصنف الأول لا يرى لها مقرًا طبيعيًا إلا في مكانين أحدهما البيت والآخرالقبر، ولم يعترف لها بحق، في المشاركة الاجتماعية أو السياسية ولم يفرق في ذلك بين المشاركة المنضبطة بضوابط الشرع وبين غيرها. والصنف الآخر لا يرى لها مقرًا إلا في ساحات المزاحمة للرجال، ولا يراها إلا متحررة من كل قيد، فلا حجاب يسترها، ولا أدب يزينها، ولا ضوابط شرعية تحكم وجودها مع الرجال، ولا قيود على ما تمارسه من وظائف وأعمال. وهذا الصنف يقتفي بالمرأة أثر النموذج الغربي في التحرير، فالحرية عندهم هي التحرر من كل قيد، لأن الغرب في نموذجه التحريري للمرأة لم ينطلق من ثوابت إنسانية أو فطرية ترسم له معالم الطريق، وإنما انطلق كالثور الهائج لا شيء يضبط إيقاع حركته، فاقتحم بالمرأة كل مكروه، وانتهك كل محظور، وداس على كل مقدس، وكلا الصنفين ظلم المرأة، وأساء إلى قضيتها العادلة.
361
| 07 نوفمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كان للفقه الإسلامي نظرته الصائبة في الانتقال بالمرأة من الولاية الخاصة إلى الولاية العامة منذ القرن الثاني الهجري حين قرر أبو حنيفة والأحناف جواز ولاية المرأة للقضاء فيما تشهد فيه ــ أي ما عدا الحدود والقصاص ــ، وتوسع الأمر أكثر حين قرر الطبري وابن حزم وبعض المالكة جواز ولاية المرأة للقضاء بإطلاق . وحين نقف على تلكم الرؤية الفقهية الحضارية لحقوق المرأة في الولايات العامة في القرن الثاني الهجري وما بعده، نتبين إلى أي حد حظيت المرأة في الفقه الإسلامي بحقوقها منذ أمد بعيد. وكان من الطبعي أن تمتد مسيرة التوسع والعطاء لحقوق المرأة إلا أن عصور الجمود الفقهي والتعصب المذهبي، والتراجع الحضاري حالت دون ذلك ووقفت عند هذا الحد، ولم تكتف بذلك بل أرادت أن تتراجع عن المكتسبات الحقوقية في الولايات العامة للمرأة التي قررها الفقهاء من قديم. وأراد البعض أن تظل المرأة حبيسة بيتها، وأن تظل أسيرة عادات وتقاليد ليست من الإسلام في شيء، وحاولوا في ذلك أن يضفوا على نظرتهم صفة الشرعية بتفسيرات مغلوطة لبعض النصوص الشرعية مثل تنصيف ميراث الأنثى بالنسبة للذكر، وتنصيف شهادة المرأة بالنسبة للرجل، وأن النساء ناقصات عقل ودين . وكان هذا أكبر خطر يواجه قضية المرأة، ألا وهو خطر سيادة مفاهيم وتصورات تخالف ما جاء به الشرع ياسم الشرع . وفي ظل سيادة هذه المفاهيم الخاطئة عن المرأة والتي تتزيا بزي الشرع ظل وضع المرأة في تراجع . وفي عصرنا وقعت المرأة ضحية بين صنفين من الغلاة. غلاة المتدينين، وغلاة العلمانيين ومن على شاكلتهم. فالصنف الأول لا يرى لها مقرًا طبيعيًا إلا في مكانين أحدهما البيت والآخرالقبر، ولم يعترف لها بحق، في المشاركة الاجتماعية أو السياسية ولم يفرق في ذلك بين المشاركة المنضبطة بضوابط الشرع وبين غيرها. والصنف الآخر لا يرى لها مقرًا إلا في ساحات المزاحمة للرجال، ولا يراها إلا متحررة من كل قيد، فلا حجاب يسترها، ولا أدب يزينها، ولا ضوابط شرعية تحكم وجودها مع الرجال، ولا قيود على ما تمارسه من وظائف وأعمال. وهذا الصنف يقتفي بالمرأة أثر النموذج الغربي في التحرير، فالحرية عندهم هي التحرر من كل قيد، لأن الغرب في نموذجه التحريري للمرأة لم ينطلق من ثوابت إنسانية أو فطرية ترسم له معالم الطريق، وإنما انطلق كالثور الهائج لا شيء يضبط إيقاع حركته، فاقتحم بالمرأة كل مكروه، وانتهك كل محظور، وداس على كل مقدس، وكلا الصنفين ظلم المرأة، وأساء إلى قضيتها العادلة.
571
| 07 نوفمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الناس لآدم وحواء، وغير المسلمين للمسلمين إخوة في الخلق، وأشقاء في الإنسانية، وهذه الرابطة يجب أن تكون هي مظلة التعايش والتراحم بين الناس جميعًا. جاء في الحديث الذي رواه البخاري: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: « أليس نفسًا». وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني بسنديهما عن الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وروى ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن جبير قال لابن عباس: مات رجل نصراني وله ابن مسلم. فقال ابن عباس: ينبغي له أن يتبعه ويدفنه. ومما جاء في وصية علي بن أبي طالب لواليه على مصر الأشتر النخعي كما وردت في نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده : « أشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبُعُا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق» . وقد وردت النصوص النبوية لتؤكد على أن غير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين خاصة باعتبارهم قلة عددية إنما هم جزء من الضمير الإسلامي الحي، والواجب الديني المستمر، لا يحل انتقاصهم أو ظلمهم أو تكليفهم فوق الطاقة . فقد أخرج أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة «. وفي ظلال هذه الأخوة الإنسانية والتي هي حقيقة إسلامية يجب أن تقوم العلاقة بين بني البشر، كما يجب أن نعتقد أن إسلامنا العظيم هو الذي أمرنا بالبر بالآخر مادام عاش معنا مسالما ولم يظاهر المعتدين علينا . نؤصل لهذا الأساس في وقت القوة قبل وقت الضعف، وفي حال الرخاء قبل حال الشدة ، لأننا أصحاب مبادئ وورثة قيم تمثل ميراث النبوة، وقد ُأُمِرنا بترسيخ دعائمها بين الناس، فإن فهم الآخر ذلك فهذا خلق من ينتمون للآدمية، وهو ما نأمل أن يعم بين بني البشر، وإن لم يفهم فهذا شأنه، فإن عاملناه بالمثل فهذا عدل وإن عاملناه بالصفح فهذا فضل.. فهلا فهم الآخر هذا المشترك الإنساني!! وهلا أفاق من أهدروا قيمة الأخوة الإنسانية قبل أن يأتي يوم نعاملهم فيه بالعدل لا بالفضل!!
1138
| 31 أكتوبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ورد في صحيح الإمام البخاري عن عائشة: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب قال «يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها» في وضوح تام وصراحة لا تقبل التأويل يقرر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد فوق القانون، وأن القانون يطبق على الجميع لا فرق بين شريفهم ووضيعهم ولا عظيمهم وصغيرهم، حتى وإن كان السارق بنت الحاكم نفسه صلى الله عليه وسلم وحاشاها. وقد أوضح الخليفة الأول من أول يوم في خلافته أن الناس جميعًا أمام القانون سواء، فكان مما أكد على نهجه في الحكم كما جاء فى مصنف عبد الرزاق: يا أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن ضعفت فقوموني وإن أحسنت فأعينوني، الصدق أمانة والكذب خيانة، الضعيف فيكم القوي عندي حتى أزيح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . وقد كتب عمر بن الخطاب في التذكير بأصل مبدأ المساواة بين الناس في القضاء إلى قاضيه أبي موسى الأشعري، جاء فيه :هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ــ رضي الله عنه ــ أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، افهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع كلمة حق لا نفاذ له، آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك. ومما كتبه أيضًا للناس: اجعلوا الناس عندكم في الحق سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم، وإياكم والرشا والحكم بالهوى، وأن تأخذوا الناس عند الغضب . ولم تكن هذه المبادئ بمنأى عن حياة الناس، أو شعارات يتلهى بها المغلوبون على أمرهم، فلم يكن التنظير بمعزل عن التطبيق ولا تجد دنيا الناس في ممارسة مبدأ المساواة أمام القانون أعظم مما سطرته صحائف القضاء فى تراثنا الإسلامي. يقول الشعبي كما يروي البيهقي في السنن الكبرى : كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب ــ رضي الله عنه ــ تدارى في شيء، وادّعى أبّي على عمر، فأنكر ذلك، فجعلا بينهما زيد بن ثابت، فأتياه، فلما دخلا عليه، قال له عمر: أتيناك للحكم بيننا، وفي بيته يؤتى الحكم، فوسع له زيد عن صدر فراشه، فقال: ها هنا يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: لقد جُرْت في الفتيا، ولكن أجلس مع خصمي، فجلسا بين يديه فادّعى أُبّي، وأنكر عمر، فقال زيد لأبي: اعفُ أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره، فحلف عمر ــ رضي الله عنه ــ. ثم أقسم: لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء . ولا يخفى ما كان من قضائه لابن القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص حاكم مصر، وإجرائه المساواة لأبعد حدود مما يعد لدى غير المسلمين أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. لقد أصّل الخلفاء الراشدون لمبدأ وقاعدة المساواة أمام القانون حتى إن كتب الآثار تروي أن علي بن أبى طالب اختصم إلى شريح القاضي في درع له وجدها مع نصراني وقال: اقض بيني وبينه يا شريح. فقال شريح: تقول يا أمير المؤمنين. فقال علي: هذه درعي ذهبت مني منذ زمان. فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أكذب أمير المؤمنين الدرع هي درعي. فقال شريح: ما أرى أن تخرج من يده. فهل من بينة؟ فقال علي: صدق شريح. فقال النصراني: أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليه، هي والله يا أمير المؤمنين درعك. اتبعتك من الجيش، وقد زالت عن جملك الأورق، فأخذتها. فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: أما إذ أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق. فقال الشعبي: لقد رأيته يقاتل المشركين. إنه لاعبرة لقول قائل، ولا حجة في قوله أمام القضاء إلا بالبينة والدلائل حتى ولو كان صاحب هذا الادعاء هو حاكم المسلمين وخليفتهم لأن المبدأ يسري على الجميع والجميع أمام القانون سواء.
1390
| 24 أكتوبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); رأيت أن كثيراً من الآراء الفقهية الجديدة التي تعكس حالة الاجتهاد والتجديد الفقهى المعاصر والتى تخالف المعهود والمألوف لدى المقلدين من أرباب الفقه تثير استغرابا واستنكارا بل واستهجانا في بادئ الأمر، ثم يظهر بعد ذلك من العلماء من ينتصر لها، ويثبت أقدامها في الوسط الفقهى، ثم تتعاقب الأصوات الفقهية المترددة بالتأييد والتسليم حتى يصير الرأى الجديد المستغرب بالأمس مألوفا مقبولا اليوم، يأخذ به من يشاء ويدعه من يشاء.. ويكون الفضل في هذه المعركة الفقهية لصاحب السبق الذي اخترق جدار الصمت،وألقى حجرا في المياه الراكدة، وصدع بما يعتقد صوابه، وما أداه إليه اجتهاده، غير هيابٍ ولا آبهٍ لكثرة المعارضين الذين يتناولونه بالنقد والتجريح بل وربما بالتشويه.. وقديما قيل: الإنسان عدو ما يجهل، وهو كذلك أسير المألوف. من هذه القضايا الفقهية القول بجواز رئاسة المرأة للدولة بالمفهوم المعاصر أي الدولة القُطْرية ودولة المؤسسات، والقول بأن عقوبة المرتد تعزيرية موكول تحديدها إلى القاضي وليست عقوبة حدية، والقول بأن عقوبة الخمر تعزيرية وليست حدية، والقول بأن الحاجة لها أثرها في تقدير عقوبة السرقة تخفيفا واستبدالا بعقوبة تعزيرية مناسبة، والقول بمساواة المرأة بالرجل في الدِّية، والقول بمساواة المسلم بغير المسلم في القتل العمد والدية وعقوبة القذف، والقول بأن المحصن الذي تقع عليه عقوبة المحصن هو من ارتكب جريمة الزنا في ظل زوجية قائمة بالفعل، والقول بمشروعية العمليات الاستشهادية في فلسطين ضد العدو الصهيوني المحتل..وغير ذلك من القضايا الأخرى. ومن هؤلاء المجتهدين المجددين في عصرنا الذين حركوا المياه الراكدة الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ عبدالوهاب خلاف، والشيخ مصطفى شلبي، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ يوسف القرضاوي،وأستاذنا الدكتور محمد سليم العوا، وأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن، والأستاذ الدكتور أحمد الريسوني،...وغيرهم. هؤلاء الفقهاء من الذين ذكروا آراءهم في كثير من القضايا الجديدة وتحملوا ضريبة الاجتهاد والتجديد في الساحة العلمية وعبء النقد من البعض والتطاول من البعض الآخر، وإن كنت أؤكد على عدم تقديس الأشخاص، وأن كلا يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن الاحترام والتقدير واجبان حتى وإن اختلفنا مع غيرنا في قضايا الاجتهاد. وقد رأيت أن كثيرين من أهل العلم مقتنعون بآرائهم الفقهية، ولكنهم يضنون بسمعتهم العلمية من أن تُنال، أو يقال عن أحدهم: الشيخ خرق الاتفاق، أو الدكتور شق عصا الإجماع كما كان يحكَى عن كبار المجتهدين في عصرنا من أمثال الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد أبي زهرة والشيخ القرضاوي. وكانوا يتحاشون التشنيع عليهم ممن هم ليسوا في نضجهم الفقهي، ولا مكانتهم العلمية، ويتحامون إشهار سيف الإجماع في وجوههم، ذاك السيف الذي رفع بغير حق في مواطن كثيرة فحرم الأمة من اجتهادات كثيرة أن تخرج إلى النور لكبار الأئمة في عصور التراجع الحضاري والتعصب المذهبي والجمود الفقهي. وهذا إفراز الإرهاب الفقهي ــ إن جاز التعبير ــ الذي يمارس من البعض ضد كل صاحب اجتهاد جديد في المحيط العلمي، والذي سرعان ما يستغرب مثل هذه الاجتهادات الجديدة التي تخرج عن مألوفه وما ترسب لديه دون بحث أو تأمل في حجة الرأي الجديد، ودون احتفاظ لحق الآخرين بحرية الاجتهاد ما داموا من أهله، وأصعب من ذلك أن ينال من عرض العالم، أو يهال عليه التراب، وينتقص من قدره بسبب اجتهاده، باسم النصيحة في الدين أو الأمر بالمعروف، والغيرة على الإسلام. إن القرآن الكريم لم يطالبنا في باب الاجتهاد والفكر بأكثر من قوله تعالى « قل هاتوا برهانكم» البقرة 111. وأي اجتهاد له دليله فهو معتبر وفق شروط الأصوليين، وهو في نهاية المطاف رأي يدور بين الأجر والأجرين، وإن قبله البعض واعترض عليه آخرون.
536
| 10 أكتوبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببناء الإنسان، وأعلى من قدره، وكرم آدميته، بعيدا عن لونه وجنسه، وغرس فيمن حوله الاستقلال في الرأي، والحرية في اتخاذ القرار، بعيدا عن التأثر بوضع ومكانة المحيطين به، أو وضعه هو الخاص إن كان ضعيفا، فلا يهاب عظيما، ولا يستصغر نفسه أمام ذي جاه، ولا يلجمه ضعف حاله عن الصدع بما يقتنع به، كما أن مكانته ووجاهته لا تغريانه باحتقار رقاق الحال. وإزاء هذا التأسيس الحضاري لبناء الإنسان لم يكن تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لحرية الرأي والفكر - التي تمثل عماد البناء الإنساني - مقصورًا على الأحرار وذوي المكانة العالية والمراكز المرموقة، وأصحاب الجاه في المجتمع، بل شمل ذلك العبيد والإماء. وما تحكيه كتب السنة من أمر بريرة ومغيث خير شاهد على ذلك، فقد روى أنه كان في المدينة جارية تدعى بريرة لما أعتقها أهلها، فارقت زوجها، وكانت لا تحبه، وكان زوجها مولعًا بها فشق عليه فراقها، وجعل يتبعها في كل مكان يبكي ويستشفع إليها الناس، فطلب منها الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه، فرفضت في وضوح وحسم. والقصة كما رواها البخاري في صحيحه عن ابن عباس: إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: "يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا". ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: "لو راجعته". قالت: يا رسول الله: تأمرني. قال: "إنما أنا أشفع". قالت: لا حاجة لي فيه.بمثل هذا الحسم والرفض أجابت هذه الجارية – الأمة - النبي صلى الله عليه وسلم حين علمت أن القرار قرارها، وأن الأمر موكول إليها.ومن الحرية التي لا نظير لها في تشريعات الدنيا حينذاك ما ضرب به الإمام الغزالي في كتابه المستصفي مثلًا على المصالح التحسينية وهو قبول فتوى العبد وروايته، مع سلبه أهلية الشهادة، من حيث إن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة - اجتماعيا - باستسخار المالك إياه، فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة. وفي هذا رقي إنساني وحضاري، وتعظيم لقدر الإنسان ولو كان عبدًا مسلوب الحرية، فإن الشرع قبل فتواه وروايته في الشأن العام فيما يترتب عليه تشريع للأمة، وتحفظ في شهادته في الشأن الخاص بين المتخاصمين لعلة رآها تحقق المصلحة وتراعى الواقع. هذه الحرية التي أطلق لها العنان في حياة الجماهير المسلمة هي التي جعلت من الموالي والعجم في حقبة وجيزة من الزمن أئمة للعرب أنفسهم في المحاريب والعلم.
7673
| 19 سبتمبر 2014
googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إن الإسلام يربي أتباعه على حرية التفكير، وإبداء الرأي، ومناقشة الأقوال، والأخذ منها والرد عليها، وقبولها أو رفضها ما دامت ضمن الإطار المسموح به في ممارسة الحرية دون تجاوز . لقد بلغ حق حرية التفكير والرأي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مبلغًا يفوق الوصف، بتشجيع منه صلى الله عليه وسلم وكان يهيئ لهم المناخ الآمن لممارستهم حقهم في ذلك بحرية تامة وصراحة لا نظير لها. وقد كان في ذلك كله يميز دائمًا بين مكانته الشخصية ومكانته النبوية في معاملاته لهم، وتصرفاته معهم. وكيف كان يخولهم الحرية التامة في الرأي والتفكير ويحفزهم على الاختلاف معه في آرائه الصادرة عن مكانته الشخصية مع جعله إياهم يطيعونه طاعة غير محدودة على المنشط والمكره وفي اليسر والعسر في جوانبه النبوية كما يقول الشيخ أبو الأعلى المودودى . وكتب السنة والسيرة مليئة بتقرير ذلك ، وما رأي الحباب بن المنذر بتغيير مكان معسكر الجيش في غزوة بدر ونزول النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه، وما مخالفة عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في شأن أسرى بدر، وكذلك ما واقعة تأبير النخل التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم برأيه الشخصي ولم يكن هو الأولى، وما نزوله صلى الله عليه وسلم على رأي أصحابه في غزوة أحد بالخروج من المدينة لملاقاة العدو،. وما استشارة السعدين – سعد بن معاذ وسعد بن عبادة - في غزوة بني قريظة في الصلح مع بني غطفان على ثلث ثمار المدينة ورفضهما لذلك ونزوله صلى الله عليه وسلم على رأيهما. ما هذا كله عنا ببعيد، وما كان ذلك إلا ممارسة عملية، وتطبيقًا واقعيًا، لحرية الرأي والفكر والتعبير عن الرأى حتى وإن جاءت نتيجة هذه الممارسة لهذا الحق مخالفة لرأي النبي صلى الله عليه وسلم الشخصي . هذه الأحداث وغيرها من ممارسات الصحابة لهذا الحق الأصيل في واقعهم وأحوالهم جعلت البعض يصفهم بأنهم أسبق الناس اتباعًا لأحكام الله تعالى، وأشد الناس تمسكًا بالحرية الفكرية وأكثر الناس حبًا للديمقراطية .ومما لا يحتاج إلى تدليل أنه لم تكن هناك فئة من المسلمين تستحق التبجيل والإجلال والتوقير أكثر مما يستحقه الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ ومن غير المنكور أنه لم يكن هناك أحد يضارع التابعين في حبهم وإجلالهم وتوقيرهم. ولكن هذا كله شيء، وحرية موافقتهم أو مخالفتهم فيما صدر عنهم من آراء شخصية أو اجتهادية شيء آخر. وهذا ما يقرره الشيخ أبو الأعلى المودودى حين يقول: اقلب نظرك في كتب التاريخ تجد بأي حرية كان التابعون ينتقدون الصحابة ويغربلون آراءهم، ويميزون أقوالهم، ويميلون من رأي أحدهم إلى رأي غيره منهم. يقول الإمام مالك بن أنس بصدد ما يوجد من الاختلاف في آراء الصحابة بصراحة متناهية: "خطأ وصواب فانظر في ذلك". ويقول الإمام أبو حنيفة: " أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع". أي لابد من خطأ أحد القولين من أقوال الصحابة إذا تعارضا . ومايزال قول مالك :"كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب الروضة المعصوم صلى الله عليه وسلم " عنوانا لهذه الحقيقة.
2038
| 12 سبتمبر 2014
مساحة إعلانية

هناك لحظات في تاريخ الدول لا تمرّ مرور...
7533
| 20 نوفمبر 2025

وفقًا للمؤشرات التقليدية، شهدت أسهم التكنولوجيا هذا العام...
2454
| 16 نوفمبر 2025

شخصيا كنت أتمنى أن تلقى شكاوى كثير من...
1341
| 18 نوفمبر 2025

في قلب الإيمان، ينشأ صبر عميق يواجه به...
1152
| 21 نوفمبر 2025

القادة العظام يبقون في أذهان شعوبهم عبر الأزمنة...
1122
| 18 نوفمبر 2025

كنت في زيارة لإحدى المدارس الثانوية للبنين في...
903
| 20 نوفمبر 2025

الاهتمام باللغة العربية والتربية الإسلامية مطلب تعليمي مجتمعي...
885
| 16 نوفمبر 2025

نعيش في عالم متناقض به أناس يعكسونه. وسأحكي...
804
| 18 نوفمبر 2025

يُعد البيتومين (Bitumen) المكون الأساس في صناعة الأسفلت...
681
| 17 نوفمبر 2025

في عالم يتسارع كل يوم، يصبح الوقوف للحظة...
639
| 20 نوفمبر 2025
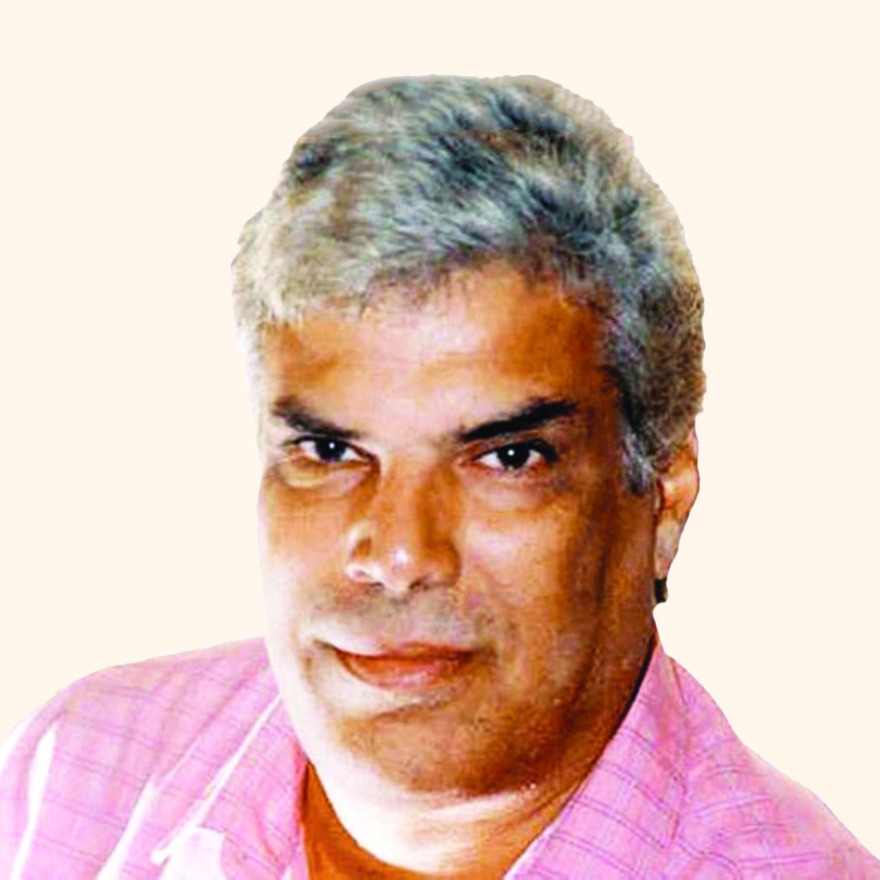
أقرأ كثيرا عن مواعيد أيام عالمية اعتمدتها منظمة...
618
| 20 نوفمبر 2025

المترجم مسموح له استخدام الكثير من الوسائل المساعدة،...
615
| 17 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية







