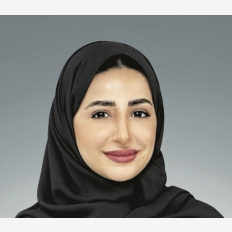رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لبناء استراتيجية ثقافية مبنية على دعم المجتمع ومعطياته، لا بد وأن يكون المجتمع معززا لنفسه في الإمكانيات قبل أن تبني له الاستراتيجية أهدافها التي تود تحقيقها من خلال هذا المجتمع. هذه ليست معادلة معقدة، إنما هي توجه عكسي للنظر هذه المرة لغاية المجتمع نحو تفاعله الواقعي عبر الاستراتيجية الثقافية على الصعيد الإبداعي لتحقيق الأهداف المرجوة ليس بشكلها الكمي، إنما النوعي وبعيدة المدى، خاصة ونحن نركز على الثقافة بين منظوري الفكر والواقع، كونها خطاباً ومشروعاً مراد تحقيقه. بالتالي يتحقق الهدف بالتأثر، بالتعلم، بالمهارة وغيرها من سبل الالهام لتمكين الممارسة. ومن هنا أوجه هذا الشأن لرواد الحضور الثقافي البارز، هل يصح الحضور الإبداعي بغياب المهارة والممارسة؟! وهنا أعتقد تكمن آلية تفكيك تلك المعادلة المعكوسة، لأن من خلال هذا المنظور الاستراتيجي لا بد وأن نبحث عن المبدعين في الساحة الثقافية ونحدد مدى ومستوى تمكينهم الإبداعي حتى اليوم. إن خصصنا من خلال هذا العمود الصحفي محور المهارة التي تندرج تحت مظلة الثقافة المتجددة، نتوجه في هذه الحال نحو المجتمع محاولين اكتشاف امكانياتهم الإبداعية والحفاظ على مهاراتهم كي تكون جزءاً مستمراً ومكملاً لحراك ثقافي متكامل، بدلاً من وجودها كاسم بأثر سابق من دون مدرسة ابداعية تؤهل أجيالا تعمل على نفس الأثر. ومن وجهة نظري أجد أن غياب الحاضنات الثقافية الإبداعية بشكل عام يأتي بسبب الاتكالية والضغط المجتمعي على المؤسسة الثقافية لتقوم بالأدوار الرئيسية لصالح المثقف المبدع لبناء وتعزيز المشهد الثقافي، وقد تكون هي الحاضنة المرجوة من قبل المجتمع أيضاً لاستقطاب المواهب الإبداعية كافة. وهذا الأمر يعتبر قد يحد من التجديد الاستراتيجي بحسب عطاء المجتمع له، خاصة عندما نلاحظ بأن مخرجات ذلك المجتمع فقد مهارته الفنية ووقف عن الاستمرار. فالمجتمع لابد وأن تكون له حركته الخاصة. وحتى نضمن بناء مشهد ثقافي حيوي، لابد وأن نفكك المعادلة من خلال بناء الطموح النهضوي في الجانب الثقافي الابداعي، حيث ان خطاب النهضة في هذه الحال لابد وأن يتمحور حول قضية التجديد الفكرية واسقاطها على الواقع باستراتيجية ثقافية فعالة وبشكل مستمر يعزز من التصور الذهني لاتساع دائرة التمكين والاستقطاب الابداعي كي تكون أشمل ومعنية أكثر بالاستدامة واستكمال المسيرة. وهذا الخطاب لابد وأن يكون أقل اتكالاً وأكثر عطاء من حيث زيادة التمكين وتقوية المهارات. ولا بد من منح القطاع الخاص هذه الفرصة لتفكيك عقدة المعادلة وتشجيعها على الانخراط والمشاركة الفعالة كجزء مهم اليوم في تجديد المشهد الثقافي - استراتيجياً. ولا يزال للنخبة الثقافية بالتأكيد الدور الأمثل في تسيير هذه التوصيات لبناء حراك قائم على التجديد ولا يقف عند دائرة الاستنزاف. ولا شك بأن المثقف يعتبر العنصر الفاعل والوسيط الحيوي، إذ تظل طبيعة النظام الطريق الأمثل لفهم الدور الذي يمارسه المثقف لتقديم كافة التوصيات المناسبة للنخب الثقافية المحركة لعجلة التجديد، بشرط أن يكون دور المثقف واضحا، وعمله بارزا ولا يستثنى الشباب حتى كجزء محرك ومنطلق في تلك المسيرة الإبداعية اليقظة. وهذه توصية أخرى، حينما تكون المشاركة الشبابية موسميه فلن تنضم بسهولة إلى الدوائر الثقافية الضيقة، لأنه قد تكون المسألة تشجيعا لحظوياً وليس دفعاً للاستمرار، إنما التعامل مع تلك المشاريع الشبابية يجب أن تكون بشكل مستدام، يعطي دافع العطاء المستمر، والتحفيز الواعد لتمكين القطاع الخاص في المجال الثقافي – الإبداعي والذي سيكون المحرك الفاعل في عملية الابداع المستمر والحفاظ على المهارات المكتسبة بشكل أفضل وأكثر تأثيراً وعلى مدى أبعد. وهذه تركيبة متجددة للثقافة تصلح أن يتبانها القطاع الخاص ليظل الابداع باستحقاق! هنا تكتمل الخطة الاستراتيجية الثقافية لتحقيق هدف الاستمرارية والتبشير بالوعي الذي ينتج مشاريع ثقافية متنوعة وبحس إبداعي منطلق.
927
| 29 مارس 2022
التركيز على المواضيع المعنية بالثقافة وما يتبعها من شؤون فرعية مهمة بحسب ارتباطها بعصر اليوم، والتفافها نحو جذورها السابقة وما تركته من تبعات، لا تزال قابلة للنقاش ونقيضة للتقدم أحياناً، وراسخة أحياناً في عصرها السابق. وكل تلك الأمور تعمل على تجسيد ما نرغب في تسليط الضوء عليه وبشكل عملي نحو المواضيع التي من الممكن أن تتجسد على أرض الواقع وبشكل مؤسسي، فردي أو حتى مجتمعي عندما نتحدث عن الثقافة، وليس الأمر بهين أن تخلق من الجانب النظري للثقافة الجانب العملي الملموس، خاصة إن كان القياس لها كمياً أو نظرياً مع غياب البعد الواقعي والنوعي فيه. ولكن سيكون من الشيق أيضاً التعرف على أحد مواضيع الثقافة ودور مثقفيها بعلاقاتهم مع الجمهور من منظور التأثر والتأثير، الجمهور الذي يمثل الاستقبال والقبول والبطاقة التي يتمرس من خلالها النخبة الثقافية، حيث إن فهم العلاقة وطبيعة أدوارها تحدد طبيعة علاقتهم بالأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومدى إخلاصهم أو حذرهم منها. وهذا الجانب الثقافي مهم من حيث التعرف أيضاً على القاعدة الجماهيرية ومدى تأثرها من النخب الثقافية، وما نوعية هذه الجماهير أيضاً، هل هي إيجابية، واعية أم جاهلة، متخلفة أم متقدمة؟، إذ إن السمات الجماهيرية تعتبر أحد العوامل المهمة في تحديد وفهم تلك العلاقة التي تربط الطرفين ببعضها البعض أو تؤدي إلى التنافر الذي لا يضمن بالضرورة الصمود لمدى طويل. ولا نريد أن نسرد المقاربات الفكرية في هذه الحال لتفسير علاقة الطرفين، إنما سيكون من الشيق استقطاب منظور آخر للجماهير من حيث معرفة النخبة الثقافية عن هذا الجمهور وكيف يمثل مطالبه، خاصة عند المحاولة في تقريب هذا المنظور بحثاً عن الجمهور المعاصر، حجمه ومدى تفاعله، وكيفية التعرف على الجمهور نفسه هو الجانب المشوق في هذا المقال من وجهة نظري، على أي أساس نضع معايير الجهل، أو الوعي، أو التخلف أو التقدم لتحديد مستوى الجمهور، ومن خلال هذا السؤال يصعب أحيانا الإجماع على السمات إن كانت تظهر من شريحة ضيقة أو التي تبرز في وسط معين عن آخر، ولا شك أنه في الوقت المعاصر، يظل الاستدلال على نمط الجمهور وانفعالاته محدوداً بحسب الوسائط الافتراضية التي تبرز فئات عن أخرى وتتحدث نيابة عن الشعب أو توجه خطابها له، فالخشية أن يصاحب هذه الشريحة الوسط المتكل عليه للاستدلال والتماهي فيه، حيث يسهل التحكم في شريحة جماهيرية افتراضية، قادر أن تتجنب منها وتتغافل عنها، وتحرص على تضخيم ما تريد منها، هنا تفقد المقياس الواقعي للشريحة، وهنا تكون العلاقة في محط شك وسطحية، لأنها غير قابلة للقياس الذي يعكس مجتمعاً ككل. وإن كانت العلاقة قائمة بين الطرفين بشكلها السطحي، فهذا يعني أن ما سيأتي بعد السطحية مباشرة كسب العاطفة والتماهي مع الجماهير من دون الدخول في تفاصيلهم، كما تظل المسألة عالقة في النوعية الطبقية التي تحدد سمات الشعب، فعلى الصعيد العربي على سبيل المثال، الخليجي تحديداً تظل الطبقة الوسطى هي الطبقة السائدة، مما يعني أنها طبقة حصدت تعليمها العالي، حازت مناصب مهنية متفرقة، مما يعكس الرفاه المعيشي والحياة الميسرة بخدماتها باختلاف مستحقيها. وكل تلك المزايا في الطبقة الوسطى قد تناقض تحديد معايير الجمهور ورسم علاقتهم في النخب الثقافية، خاصة ونحن نسلط الضوء على الشريحة الجماهيرية الافتراضية، إذ يظل التساؤل قائماً حول مدى التأثير على الجمهور الافتراضي في الوسائط الاجتماعية، حيث إن تمثيلهم ليس عمومياً، ولكن من الممكن القول إنه تكراري، أي يكسب تأييد عدة حسابات افتراضية حوله، ولا يعني بالضرورة انعكاسها على مجتمع كامل، إنما من الممكن أن تكون جماهيرية بنطاقها الأوسع. من الصعب الاستدلال على ربط هذه العلاقة خاصة وإن لم نعتبرها جزئية، أي أنها قائمة على الاعتماد على العلاقات الأخرى التي تحدد مستوى التأثير السياسي والاجتماعي على شريحة الجماهير، وبما أن تلك العلاقة تعتبر متباينة، من المفترض أن يعرف الجمهور نفسه أيضاً، كيف يرى نفسه وكيف يرسم علاقته مع النخب الثقافية. تربط هذه العلاقات عدة عوامل متداخلة ومعقدة، قد يطغى أحدها على الآخر، فالمسألة في هذه الحال ليست كماً جمهورياً يعكس كافة الرغبات، بل تعميماً افتراضياً من حيث تعزيز القناعات بين فئة متجانسة. baljanahi86@gmail.com
850
| 22 مارس 2022
من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات تظهر من خلال القدرة على صقل المسار الثقافي، الحفاظ عليه وتسهيل عملية الانتقال فيه بأشكاله المعاصرة من دون أن تكون طفيلية ودخيلة على المجتمع بشكل صادم وصعب تقبله. وهذا من وجهة نظري يعتبر من أصعب التحديات وأكثرها جرأة لرسم ذاك الطريق الذي بإمكانه تحديد الثقافة كمظلة إنتاجية حيوية، تفادياً أن تكون رهينة الإنتاج الاستهلاكي المكتسح. وقبل أن نبدأ الحديث عن العملية التي من خلالها نستطيع أن نبني الخطة الاستراتيجية الثقافية، لا بد وأن تتبنى أولاً مبدأ المحافظة على الثقافة حتى تكون في مقدمة الإنتاجية الاستهلاكية، بل ورفيعة المستوى من الاستهلاكية الترفيه خاصة، والتي نقلت الأفراد من نمط سلوكي مسرف ومرفه لا يستند على قاعدة على قدر استناده على السعي وراء الثراء السريع، أو حتى التجويف النوعي للمعرفة والمحتوى، الذي أدى إلى نزعة استهلاكية وما يتبعها من اهتمامات وقيم بديلة قد لا تستند بالضرورة إلى أسس اجتماعية واقتصادية وثقافية راسخة، ولا تفسر التحولات القيمية لهذا النمط السلوكي بعجلته المتسارعة والتبعية. وهذا التخوف بحد ذاته يعتبر سبباً رئيسياً في ارتقاء الإنتاج الاستهلاكي الترفي على الإنتاج الثقافي القيمي والنوعي بما يحمل من سمات روحية ومادية وفكرية وعاطفية تتجسد في الخصخصة الاجتماعية متضمنة الفنون والأدب والقيم والتقاليد والمعتقدات، وحتى المبادئ. وكل تلك السمات تتطلب أهدافا واضحة، جريئة وابداعية لتحقيقها. ولا تختلف عن أهمية الاستهلاك الذي يسبق الإنتاجية، إذ لابد من الاقرار بأن الاستهلاكية تعتبر آلية مستدامة ومطلوبة للانتعاش الاقتصادي، ولكن حاز الاستهلاك في هذه الحال على الصدارة التي طالت الثقافة من دون أساس واضح على الرغم من ثرائها السريع! حتى إن الثقافة نفسها تم استغلالها استهلاكياً كي تكون من ضمن إنتاجية الترفيه السريعة والترفيهية، والمجوفة نوعياً من وجهة نظري وذلك من خلال ضم الثقافة الشعبية للائحة الاستهلاك الجوفي. وهذا الانسياق يعتبر بالنسبة لعدة باحثين إساءة إلى القيم الثقافية وتؤثر حتى على الذوق الرفيع والجمالي للناس، حيث تصب الذائقة في هذه الحال في دائرة ثقافية ضيقة تعكس ضعف النقد الثقافي فيها، وصعوبة هضم المنتج، أي صعوبة الانتقال وتفسير المبدأ الجديد من دون إعادة انتاج وتجديد للخصخصة الاجتماعية التي تنسجم أكثر مع أحوال وذائقة المجتمع الثقافية - المحلية. وهذا التصور بحد ذاته يحتم صعوبة الانتقال للنظرة المعاصرة وصعوبة التجديد الثقافي، لأنها ابتعدت عن الانسجام الأساسي وانجرف نحو الانسجام الخارجي والجديد، لأن الاستهلاك الترفي والسريع في هذه الحال عكس واقعا يعتمد على مصادرة السلعة التي تغرس القيم الجديدة وليست المتجددة باستخدام عدة وسائل ووسائط تروج لتلك القيم بسرعة. ومن هنا يكمن التحدي في مواجهة نمط الاستهلاك السائد كنقيض للثقافة الجادة. كما نلاحظ أيضاً أن مهمة الثقافة لا تنحصر فقط على التجديد وهضم القيم والتقاليد السائدة، إنما أيضاً لا بد من اتساع مشروع الاستراتيجية الثقافية كي تكون ممارسة مرهونة بالوعي أولاً، تستقطب التعددية الثقافية لتقديم أهداف شمولية تلبي ذائقة المجتمع من حيث تشجيع الانسجام مع أحواله وتطلعاته، حتى يكون حضور المجتمع الثقافي حضورا خاصا يحمل معه سيادة الابداع والتعبير والفن والنقد والانتاج عوضاً عن المبالغة في السطحية، الاسترخاء والابتذال. من هنا تنطلق الاستراتيجية الثقافية عبر زيادة وزن الثقافة كي تكون أكثر رفعة وأكثر شمولية وتأثيرا كتنمية ثقافية شاملة وجادة. خلاصة موجزة: الاستراتيجية الثقافية من المفترض أن تحمل ثلاث مراحل رئيسية بأهدافها الفرعية كي تضمن مستوى التأثير وتقاوم نقائض الثقافة الجادة، حيث تتضمن مرحلة المدخل من متغيرات ومؤثرات تلعب الدور في غرس السمات الثقافية، والمخرج عبر أداة التعبير وانعكاس السمات عموماً، وما يتوسط هذه العملية من مسرعات ومنشطات تحفيزية، وقوى ناعمة قادرة أن تكون حلقة الوصل للتأثير العمومي للثقافة بمعانيها الواسعة ومحيطها الابداعي. baljanahi86@gmail.com
2094
| 15 مارس 2022
أحياناً أجد أن مساحة العمود الصحفي تكفي للتنفيس وإبداء الرأي الوجيز حول البعد الحضاري والتمني المستقبلي لما هو في صالح الثقافة، وأحياناً كثيرة أطمع لمساحة أكبر للتعبير! ودعوني أؤكد لكم بأن محور الثقافة ليس أقل شأناً من أي محور استراتيجي آخر لبناء الانسان، بل هو الخيط الخفي الذي يعمل على بناء الشخصية الوطنية متضمناً هواجسه الثقافية ومنابع إلهامه. وبحكم اهتمامي العميق في الحراك الثقافي المحلي، لدي ملاحظات أود أعبر عنها من خلال دراسة المشهد الثقافي في دولة قطر، حيث يتطلب وبقوة التمكين والقدرة على بناء المكسب من وجود المثقفين، بعيدا عن استنزاف طاقاتهم (ولي في كلمة استنزاف وجهة نظر)،. وهنا يكمن المحور الاستراتيجي والتركيز على أهميته لصقل الشخصية الوطنية الثقافية خاصة، ولِمَ لا عندما نوجه هذا التمكين لفئة الشباب كونهم مثقفي اليوم! وهذا الجزء بالتحديد أجده مكملاً لمساعي من يحمل على عاتقه الثقافة بصورها المتجددة والحضارية. لأن صناعة الانسان تعني أيضا صناعة ذاته وإعطاءه تلك المساحة التي تمنحه القدرة على التعبير في المنصات المتعددة. فدعنا لا نثقل على الثقافة ونضيق عليها في منصة واحدة تستنزف إمكانياتها وتستهلك طاقاتها من دون أن تجد لها سبيلاً آخر. فهي ليست شكلية ولاهي كمية تكتفي بالظاهر وتتغافل عن النوعية فيه. وفي الحديث عن المنهج الكمي، فإن الخطة الاستراتيجية في صناعة الانسان المثقف ووضع التوقعات لحال المشهد الثقافي ومواكبته المعاصرة قد تقع تحت الدلالات المحدودة للثقافة والتي تحد مفهومها الواسع بقياس العددية وليس النوعية وكلاهما مهم بنفس حال التركيز على الثقافة بأنها المادية وغير المادية، وهذا موضوع شيق آخر. كما تجد أحياناً دراسات الأهداف الثقافية محدودة على إنها حصرا على هوية، أو الاكتفاء بكونها التراث وما بين طياته من فنون شعبية. ولا تستبعد أيضاً حكر المفهوم على الأكاديميين والمحاضرات بتفاصيلها التاريخية أو بالنصوص الجامدة. وهذه المحدودات الثقافية تظل نتيجة التضييق الدلالي على المفهوم الثقافي. وبالتأكيد كل تلك التصنيفات لا غنى عنها، ولكنها إن طغت على تصنيفات التمكين الإبداعي والفنون فذلك يعني أنها أصبحت استنزاف طاقات وهدر إمكانيات ثقافية وعددية، أكثر من كونها انعكاسا لحراك ثقافي نشط يشمل جميع الفئات ويمنح المحتوى الإبداعي مساحته الخاصة لاستدامة عطائه وتقديم خدماته التي من المفترض أن تنعكس على المحور الاستراتيجي الثقافي كجزء من عملية الانصهار الثقافي وبشكله المتجدد والمعاصر. لذلك، جزء من الاستراتيجية الثقافية يجب أن تركز على الحد من استنزاف طاقات المثقفين، وذلك من خلال تقديم أفضل الدلالات المدروسة لأهداف تشمل الجميع في المشهد الثقافي بشكل مستدام يضمن الحراك الاجتماعي المستمر والمتجدد باعتبارها نقطة مهمة تسهم بشكل كبير في التركيز على الجودة الجوهرية واللامادية لقيم الانسان، وتمنحه الفرصة في تطوير المفهوم وليس التضييق عليه. كما أن التطور الدلالي للمفهوم الثقافي على الصعيد الاستراتيجي سيمنحه فرصة كبيرة لدعم المجتمع في التخطيط لمشاريعه الثقافية الخاصة باعتبارها محورا رئيسيا لإثراء البشرية ومواكبة أيضاً للزمان والمكان. baljanahi86@gmail.com
3383
| 01 مارس 2022
سؤال ماذا نريد؟ لا يقتصر فقط على التطلعات الانشائية عند الحديث عن بناء الذات أو للسعي وراء الفرص وتحقيقها ليتم السعي وراء فرص أخرى كي تشعر بأنك حققت إنجازات على مدى سنوات! ولكن يجب أن تضع هذا السؤال أيضاً من منظوره الأوسع والأشمل، الذي ينسب إليه الجمع وتنسب فيه للجمع بما فيه من شيوع واتفاق واختلاف أحياناً في ظل التلاحم. فكي تحقق الامتداد الثقافي على سبيل المثال، عليك أن تقر بأنها الخلفيات المتنوعة بحسب ما جاء في الوعي التاريخي تحت مظلة الوحدوية التي تتطلع من خلالها للإجابة عن سؤالك الأسمى مع من حولك، ماذا تريد وماذا يريد مجتمعك؟ وما هي المقاييس التي تضعونها سوياً لامتداد ثقافي واضح وصريح لا يمس ولا يطال ولا يتأثر من الداخل أو الخارج. في الحقيقة في هذا السؤال عدة تطلعات وعدة تناقضات أيضاً في نفس الوقت، لأن المجتمع يريد أن يكون متشابها تحت مظلة الوحدة والهوية والأصالة، ولكنه يرفض التنوع تحت نفس المظلة الوحدوية، فهو يفضل التشابه تحت مظلة التشابه. فإما أن تكون معه في نفس الرأي ونفس التيار، ونفس النمط ونفس الخلفيات. وان كنت ضده، سيتم مواجهتك بالتنمر، وهذا كسب بحد ذاته لهجوم أكبر عليك. لأن المجتمع طالك بالتنمر والاستهتار والتشكيك في هويتك، أصلك، ومدى انتمائك أو اختبار تحريضك بانتقاء ما يلائم الهجوم عليك. ولا أعمم بالتأكيد هذا النمط المتنمر الحاصل في نوعية الهجوم الذي يتعرض له العديد ممن لديهم رأي متفرد، إنما نلاحظ الوسط الافتراضي الذي سمح أن يكون مساحة الهجوم المشخصن بدلاً من أن يكون منبراً للنقاش. ونعيد السؤال الذي نطرحه على أنفسنا، ماذا نريد؟ وكيف نرى الثبات والتحول في مجتمعاتنا، وما هو دورنا عند التحول في ظل عدة متغيرات وعدة عوامل لها الدور الرئيسي والتحدي الحق في تمكيننا في الانتقال بينما نتمسك بما هو ثابت. ولا يوجد قياس دقيق عند المقارنات بين الأجيال، خاصة وإن لم نضع في الحسبان العوامل الجديدة التي تؤثر على تغير نمط الحياة والعيش والسلوكيات. وهذا تحد متغير من حقبة إلى أخرى نواجه جميعنا بحسب تلك العوامل المؤثرة الجديدة وباختلاف معايير الصعوبات فيها على مدى قدرة تأثيرنا على أجيال قادمة. وهذه تعتبر ظاهرة حياتية في انتقال الأجيال والتغيرات التي تطرأ عليه، حيث تعتبر دائرة متكررة بمحيط مختلف عما سبق وبتحد أزلي حول الحفاظ على ما هو ثابت. وجزء من التحدي يشمل أيضا لغة الخطاب عند الهجوم على صاحب الرأي الصريح بالتنمر بدلاً من المواجهة المثلى. إذ نحن أصحاب مشهد اليوم نراقبه عن كثب ونرى الواقع ونخشى من المستقبل، فبلا شك مواجهة جرأة الطرح يقابلها تطور الذات الثقافية بمستوى نقدها وإضافاتها النوعية. أو على الأقل هذا ما نتصوره ونأمل أن يبرز في الساحة الفكرية عند مواجهة الرأي والرأي الآخر. ولكن ما يحدث ليس إلا مواجهة شعبوية افتراضية تبرز جانبها اللا أخلاقي بدلاً من حضورها النقدي. لربما تريد أن تكون مؤثراً في رأيك، وهذا من حقك بالتأكيد، ولكن التأثير لا يكون بالتنمر ولا بالإساءة، لأنك تتصدى النقد بسلوكياتك الدونية والشعبوية التي لا ترتقي لدرجة المواجهة البناءة او حتى المناظرة الجريئة. فخوفي عليك أن تكون ضحية تأهيل اجتماعي محدود في شبكة تواصل اجتماعي وتتمسك في شعبويتك على أنها مصدر تأثير. فنصيحتي قبل فوات الأوان أن تكون منتجاً للأفكار وليس منظماً وقائداً في التظاهرات الكلامية!. تريد أن تكون مشروعاً ثقافياً وممثلاً نخبوياً في وجهات نظرك في الحراك الاجتماعي، فلتكن الفكرة نابعة من توطين مفهوم كونك من ضمن شريحة مؤثرة وليس من منظور طبقة عنصرية متنمرة. لأنك تعمل على إلمام الجموع بالسوقية بدلاً من إلهامهم بفكرة رسالية. فالوعي الجماعي لن يكون له أثر إن كنت تحرضه عبر السوقية الشعبوية. baljanahi86@gmail.com
4227
| 15 فبراير 2022
الحديث عن العولمة لا يقتصر على التوحدية في المبادئ والاجماع على الأسس المعاصرة لأي مجتمع حديث. ولكن أيضاً يتطلب النظر من خلالها على بناء الأسس التي تسهم في تفويض المبادئ وتعزيز القيم الثقافية لمجتمع يعاصر الحداثة بينما يتمسك بالعادات الاجتماعية والتقاليد ولا يزال يتطلع للأمام وهو حبيس كينونته وعزلته المنغلقة على نفسها! ودعنا لا نقلل من أهمية الخصخصة وترسيخ الهوية الجمعية، فلربما تتضارب الفكرة بين ما هو عاطفي وما هو تنموي، أو ما هو بنيوي وما هو رجعي. وتظل هناك العوامل التي تسهم في الانتقال الزمني والنوعي للبشرية من حيث مدى التغيير والانتقال الحدثي، وذلك بحسب الطفرة أو الظاهرة التي تمر من عليه بتأثيراتها المختلفة. ولا أستطيع أن أقف عند العولمة بمفهومها الواسع والحاضن للعالم من دون أن أنظر إلى فاعليتها على المجتمعات التقليدية كمنطقة الخليج على سبيل المثال ومحاولة فهم المراحل الانتقالية للمنطقة. وما اسهامات العولمة في هذه الحال في بناء مواطن عالمي متبني الأسس الثقافية الحديثة. وهنا تكمن عدة مفارقات في تصنيف المواطن الخليجي في البدايات بحسب الأسس الثقافية التي انتقلت معه. إذ ان بناء الفرد في المنطقة يأتي منذ زمن البناء الإنساني اليدوي، ومن صنعة اليد وامتهان الحرف اليدوية والمهن البرية والبحرية، وصولاً إلى أكبر طفرة واجهت منطقة الخليج على سبيل المثال، مما سببت له فجوة ونقلة سريعة لم يستطع انسان المنطقة مواكبتها إلا عن طريق الانتقال السريع والمباشر مما أدى إلى ضياع الهوية التقليدية وامتهان ما هو مواكب للطفرة البترولية. وعلى الرغم من تلك الصدمة، واكب انسان المنطقة الانتقال بين الحرفة والمهنية والمواطنة، ولكنه ظل متمسكاً في نوستالجيا الماضي على أنها تقاليد وعادات اجتماعية، حتى ولو كان غير ممتهناً فيها، إنما تظل منها شكلية تستمر معه مواكبة مع عصره. وأعتقد من تلك الفجوة بنيت مسألة الانتقالية ما بين التقليد والحداثة على بنيوية مواطن المنطقة الجديد. ومن تلك الفجوة أيضا بني هذا المواطن أسسه التقليدية وبنى عليها تيارات الحداثة على الرغم من التصادمات التي واجهها مع الأسس الثقافية. وهنا تكمن الإشكالية في الانتقالية الحديثة بغياب مظاهرها وسماتها الفكرية والعلمية على مستوى حقوق الانسان على سبيل المثال، التفكير النقدي أو حتى التعددية الثقافية. إنما غلب على الانتقال الحديث طابع المواكبة، حيث يصعب عليه أحياناً مواجهة الاختلافات الثقافية بتنوع أسسها ومنهجياتها للتعامل مع الواقع ومواجهة قضايا الساعة بين منظوري الأسس الثقافية الجيوغرافية عندما ترتبط بالتقاليد والعادات والاجتماعية وبين منظور الأسس الحديثة والتي تجد في سماتها الثقافية التعددية الفكرية، وحرية التعبير، حوار الثقافات وغيرها. كما تظهر عقبات أخرى لا توجد لها أرضية مشتركة أو موحدة لآلية التعامل مع الواقع بمنظوريه التقليدي والمعاصر في آن واحد وتحت مظلة العولمة الوحدوية. إذ يعتمد الموضوع على القدرة في استخدام الأدوات والأساليب للوصول إلى الواقعية من دون حشر الثقافة في زاوية العنصرية، أو التسيس الثقافي. واحدى تلك العقبات تكون بسبب الخطاب الثقافي الفوقي، مما يؤدي إلى تهميش التعددية الثقافية وتمييز بعضها، ولربما يقود إلى دوامة الأسس الثقافية التقليدية المبنية على الخطاب الثقافي الانتقائي وليس على أساس التنوع الثقافي بناء على أسس العولمة التنموية الحديثة. بالتالي، تظل العولمة مفهوما واسعا، خاصة ان تركناها في مكانها العام من دون أن نفهم فاعليتها على الأسس الثقافية على المنطقة ومدى ابتعادها أو قربها من مظاهر التنمية ومدارك التعبير باختلافها، والتعددية الفكرية بتنوع ثقافاتها. العولمة تظل هيمنة سائدة ولكن لا تستطيع فهمها إلا إذا أسقطتها على الواقع الجيوغرافي بشكل تفصيلي. baljanahi86@gmail.com
4328
| 08 فبراير 2022
قد يكون في مقالي هذا نوع من التناقض، ولا تلوموني على هذا الاضطراب الفكري، فالوضع على المستوى الثقافي ومدى تقدمه وتأخره في آن واحد يحير الكثير من العقول ويعيق تحليل واقعها إن كان مواكباً حقا مع المجتمع المدني، أم انه متأصل وراسخ في محوره التقليدي السابق. وهذا ظاهرة ثنائية نتعايش معها دائماً ونمر في تناقضاتها ومستويات الخلل على الانسان بشكل متكرر. فلا ينبغي أن نتأمل المستقبل لنصلح الثقافة، خاصة إن كانت الثقافة تستنجد من عدة أحمال كنا سببا فيها وأصبحنا نتعايش معها يومياً من دون أن نرسم لها الخرائط الواضحة للمستقبل. فالمستقبل لا شيء من دون نظرة التيقن والتخطيط بتأمل وتطلع مشرق، أو التخطيط للمستقبل بأسوأ التوقعات، إذ يعود الأمر في النهاية على العقلاني الذي يتيقن ما يراه في مستقبله وما يحتاج إليه من مشروعه الثقافي. بالتالي، من هذا التناقض أجد علامات استفهام متعددة لم تفسر بعد ولم نحصل على إجابتها على قدر حملها على عاتقنا، فالعيش في الواقع يعني التعايش مع الحقبة كاملة ومراقبة المشهد الذي قد يحمل عبئاً ثقافياً أكثر من ملاحظة الارتقاء والتقدم الثقافي فيه ومن نفس المشهد. وهذا الأمر يقلقني كثيراً، خاصة عندما يكون الشأن الثقافي أقل وزناً من الشأن المادي، وعندما يتم تفضيل ما هو غير الثقافة والتنازل عما يعتبر رفاهية ثقافية لإقصائه لأنه أقل تفضيلاً. كما يحزنني التجرد الفعلي من جوهر الثقافة عندما تكون غير واقعية ولا تصلح للواقع الجديد، على قدر كونها ثقافة مشوهة أو حتى قشرة ثقافية نتبناها لفترة وجيزة ومن ثم نتركها للاهتمام في الأمور الأخرى. فيحيل على الثقافة الحول وتموت في أغلب أوقاتها. ومن هذا المنطلق، يجب ألا تكون الثقافة إلا وازعاً فردياً يأتي نتيجة اجتماعية تكتشف حاجة المجتمع له، وتساهم في تنميته بحسب نظرتها إلى نفسها وللآخر على القدر الذي تستحقه الثقافة بمعناها الذي يرسم المشروع الذي يحتاج إليه المجتمع كي يتقدم، ولكن يظل بناء تلك الحاجة التنموية على المستوى الاجتماعي بطيئا، وهنا أتوقع أني سأبدأ التناقض مع نفسي. ولكن تناقضاتي في هذه الحال لن تتعارض مع مبدأ يقر بأن لا البطء ولا السرعة سمات يجب أن تغلب على الأخرى، فكلتا السمتين تهتم في دعم الحاجة والمواكبة، وكلتا السمتين أيضاً تحددان الخلل الذي قد تخلفانه من وراء سرعة التقدم، والتمييز الزمني الذي قد تخلفانه من سرعة الحداثة. وهنا عدة أسئلة أطرحها على نفسي كي أتمكن من استيعاب هذا الكم من التناقض الذي نتعايش معه من دون الخروج منه بسهولة. ما هي الثقافة الخاصة التي نعتمد عليها وتساعدنا على التقدم، وما هي تلك الأسس الثقافية التي من الممكن طرحها كي تتماشي مع الواقع الجديد. الخوف من أن تكون الأجوبة مكررة حيث تعيد نفس الإجابة، والرجوع لنفس النظرة الثقافية التقليدية، لأنه سينبع شعور الخوف في الإدلاء والتعبير في رغبة التقدم. بل وسيتم التيقن العمومي حول مصير أجيال بالانهيار، كما سيتم التعبير عن تلك الأسئلة بالموجات العمومية، إما مع أو ضد، وننتج في نهاية الأمر معوقات التطور الثقافي بأنفسنا. ولا شك أن تظل هناك عدة مؤثرات على تطور المشروع الثقافي، تمثل ظواهر الافرازات التي أثرت على التحولات الثقافية الجوهرية وابقائها في سطحيتها وقشرتها المحدودة، وما انعكس عليه من تفضيل مالي وشكلي. ولكن يظل الانتقال من الثقافة التقليدية إلى مواكبة الدولة الحديثة يعني مشروع النهضة الثقافية الذي لا بد أن ينقل الانسان إلى اكتساب المفهوم الثقافي بما يتناسب مع طبيعته المدنية المعاصرة. ولا شك بأن علامة الاستفهام للسؤال الأكبر حول ماهية الثقافة لن تكون الإجابة عليها سهلة، ولن تخرج منها بسهولة من دون تناقضات المع والضد لأسس تجديدها، فلا تزال أنت مسؤولاً عن تقدم الثقافة كما تظل مسؤولاً عن تراجعها. ستشعر بالتناقض أيضاً، أنا متأكدة! baljanahi86@gmail.com
6674
| 25 يناير 2022
بعد أن توصلنا لمفاهيم متجددة للثقافة خاصة عند اسقاطها على المنظور المحلي وما حولها من معان، والتي نستدل من خلالها على الإحساس والتعبير واستخدام الأدوات الإبداعية بشكل تجريدي يعبر عن الداخل ويصقل الإمكانيات بالخارج من حيث تحديد المسار وتخصيص الهوية وغيرها. كما حاولنا أن نحدد مسيرة المشهد الثقافي وفقاً لعدة عوامل تبرز في التعليم، التمكين والدور الإعلامي وحتى فهم المشهد الثقافي خلال فترة الأزمات. وكل تلك العوامل تستحق مقالاً آخر للحديث عن أثرها الثقافي العميق على المجتمع. نأتي الآن إلى المنظور الجندري، وذلك لأجل الاقتراب من المفهوم بشكل إنساني معمم، خاصة وعندما ننوه عن المرأة وعلاقتها بالحراك الثقافي. وأنا أكتب لأجل المرأة لهذا المقال بالتحديد، أدرك تماماً ان ابراز المرأة في كل شيء والتنويه على وجودها يعني التأكيد على استثنائيتها في المواضيع عامة، وكأنها تطلب لفت النظر للمساواة حتى في سياق الحديث! وأنا ضد حشر المرأة في زاوية التمييز، بعكس المتداول والذي يتم بشكل اعتيادي عند الحديث عن الرجل لأنه يشمل عموم المجتمع من دون التنويه على أهمية وجوده، فهو في واقع الامر مهم كحال المرأة ولكن باختلاف مستوى الحشر الجندري في مواضيع حقوقية وتنافسية على سبيل المثال. بالتالي، ما يحدث أن المرأة في هذه الحال تظل العنصر الحساس بحسب مكانتها من النقاش المحوري. وأنا شخصياً لا أحب تمييز المرأة ولا أحبذ التنويه على مكانتها بالحراك الثقافي. لأنني في هذه الحال سأنساب نحو الإنشاء في سرد إنجازاتها في كافة المجالات وسأتغافل عن الحديث عن محوريتها الرئيسية في كل تلك المجالات بما فيها الثقافة. ولكن، لابد من التعبير عن جذور الثقافة القطرية وفهم موقف الثقافة من المرأة. فليس بغريب أن نعبر عن ذلك الموقف بناء على تجسيد الثقافة التقليدية وفقا لعلاقتها مع النظام الاجتماعي والهرمي. ولا بد أن تكون لهذه العلاقات ملامح داخلية مؤثرة يتضمن الوجه القبلي وغير القبلي، الانفتاح الحضاري وخصوصية المجتمع. كل تلك العوامل لعبت أدواراً مختلفة على مر السنوات في صقل مكانة المرأة وبناء مكانتها الرمزية في دولة قطر على المستوى الثقافي في عدة تصنيفات فنية وثقافية، سواء كانت في الدراما، أو المسرح، والأدب، والشعر، والفنون والسياسة. ولا أشكك في محاولتها المستمرة في تحقيق إنجازاتها، ولكن تظل المرأة كمخرج لمجتمع تقليدي تجاوزته بعراقيل مختلفة، بل ولعبت الدور الأمثل فيه. وبلا شك أن المرأة لم تغب عن المشهد الثقافي اليوم كونها رمزية ثقافية رفيعة المستوى قادرة أن تواكب الفن وتبرزه بأشكاله المتنوعة، كما تظل هي الصورة الثقافية المعبرة على المستوى الأدبي والعلمي. ولكنها تظل مغيبة في الخطاب الثقافي وعن منجزات المرأة في تلك التصنيفات الثقافية وما لها وما تأمل منه في المستقبل. وقد نقع في نفس السياق المتداول عادة حول مأزق الثقافة، عندما يتغنى المخضرمون على الأولين، وينادي الأولون لأسماء الحاضرين للمخضرمين وهلم جرا، إذ نعود مرة أخرى وندور في نفس الدائرة التي تجلب السابقين لإعادة الاسترسال لأمجاد الماضي بسنواته العريقة في المشهد الثقافي خلال المحافل الكبيرة. بينما يغفل عن تلك الدائرة المواكبة العصرية وإدخال عنصر الشباب بما لديه من إنجازات وعقبات في الساحة الثقافية لمناظرة صريحة وحلول واضحة، وهنا تختفي المرأة عن تلك الدائرة التقليدية أيضاً ويختفي معها العنصر الشبابي المواكب. أعتقد أني حاولت أن أعبر عن المرأة بمنظور جديد في المشهد الثقافي ولو كان بشكل محدود، وفي نفس الوقت أفترض أني وددت أن أرى لها حضوراً أكبر كرمزية ثقافية في المشهد الثقافي، وليس حصراً في محفل سنوي كبير، إنما في مشاريع ثقافية مستدامة طوال السنة، تعكس منجزاتها في ذلك المحفل السنوي!. baljanahi86@gmail.com
6620
| 18 يناير 2022
أدرك تماماً مدى استغرابكم من العنوان، ولكن لا تستغربوا من واقعيته، فنحن لا نتكلم عن مجرد مظهر ولن ندخل في الشخصيات لتحليل انفعالاتهم ومشاعرهم، ولكن بالتأكيد لنا وقفات عند آرائهم ومواقفهم. إذ نحن في صدد رؤية الثقافة بالعين المجردة، نريد أن نستشعرها في محيط وفكر وعقل وذائقة، لأننا وصلنا في اعتقادي لمرحلة أحكمنا على العقل لفهم الثقافة ككلمة منزوعة المعنى، بل وأسقطنا عليها كل شيء من دون أن نشعر في ذاتها ومدى انعكاسها على محيط بالكامل. والأهم، كيف نرى هذا الانعكاس في محيطنا يعمل ويفكر ويحرك؟. وبيجامة العقاد ليست إلا طابعا يحمل الإدراك للثقافة أكثر من المفهوم نفسه، بل ويعكس الجاذبية نحو صقل الذات بالنقد والمسارعة بالمقارنة في المعارف في محيط يتسع، من بإمكانه أن يقاوم المظهر ويعبر عن ذاته بصراحة عما هو حوله، فإن اتفقت في الرأي فلك تبريراتك وإن اختلفت فلديك الجرأة في الرد، ولربما المقاومة بدلاً من الاقتناع بسهولة. يهم الوسط الذي ينشأ فيه الإدراك الثقافي، ويهم ما يخرج من ذلك الوسط وما يعود معك وعليك لهذا الوسط أيضاً. فالكم الذي بحوزتك يتطلب المساحة التي ينطلق فيها الرأي، وتستمع لها الأذهان قبل الآذان. وكل تلك الغايات لا تتطلب الشهادات أو الوجاهة أو الطبقية لكي تكون في قمة تنويرها، إنما تظل هذه القاعدة النشأوية التي تخلق الجيل صاحب الرأي وصاحب القضية والساعي للمعرفة والمطلع والمعبر والهاوي والمرح. جيلاً لن يجد في نفسه إلا اللا طبقية عندما يدرك أن الثقافة تجاوزت المكانة وخلقت الروح السوية باختلاف مفكريها المتنافسين ومواهبها المعبرين. فالثقافة ليست استحضاراً في حدث معين، ولن تكون موسماً نتذكره مدة عشرة أيام كي ننساه من جديد، أو يصعب علينا استحضاره في المواسم الأخرى. الثقافة ليست الشريط الأحمر ولا المقص الذهبي ولا هي عرس نحتفل فيه كي نحزن على انفصاله عنا لاحقاً. إذا لم نقدر الثقافة على انها أكثر من كونها شكليات مؤقتة وحشوا إعلاميا، لن نجد للثقافة روحاً ولا منبعاً يظل يعطي ويسيل من خلاله العقل والروح والقلب بلا توقف، فأنت بحاجة إلى من يوحي لك المعنى قبل أن يسايرك في الحدث. أقلامنا تنتعش لفترة ولأسباب إعلامية بشكلياتها المتعددة، وقد تجتاز تبريكات المخضرمين مضموناً وتفشل عند الآخرين تسويقاً. ولكننا نظل نناجي من جديد لأن تحكمنا قلة التعددية في استغلال الوسائل. ما يهم أن يكون الدافع تنشئة الأجيال على الإدراك الثقافي، ولا يتطلب هذا الأمر اللقب ولا المنصب ولا الشهادات العليا ولا البدلة الرسمية، إنما يحتاج إلى الغرس والاكتساب من ذلك الغرس حتى نكون مجددين للجلسات الثقافية المستمرة ذات الروح والحس، والتي تتجاوز الرسمية ولا تنتظرها، حيث نخلق تلك الأبعاد التي تعطي المساحة لصاحب الرأي أن يصقل رأيه بالوسيلة الحديثة، حتى لا تكون الثقافة في نهاية الأمر موسماً. بيجامة العقاد ليست رمزية خالصة لماهية المثقف، ولكنها بالتأكيد تجرد واف يعبر عن الثقافة مضموناً. تظل حاجتنا لمواكبة عصرنا بروح تتشابه مع تواضع العقاد وإدراكه المحوري للثقافة واتساعها كي تكون ثقلاً في محيط يقدمها كنمط حياتي وليس كرسمية ديباجية. baljanahi86@gmail.com
7822
| 11 يناير 2022
على قدر السنوات التي كنا في محيط المدارس، إلا أن تلك السنوات لم تكن بالنسبة لنا إلا الطريق الذي سنكون فيه مثل الجميع. لا تعتبر هذه الجملة مدحاً وليست بدرجة كبيرة ذماً. ولكن إن طرحنا السؤال على أنفسنا من حيث منجزات التعليم علينا كطبقة وسطى ممتدة وتتسع بشكل مستمر، فلم نتلق إلا الأساس الذي يجعلني أتشابه معك في الحساب ومستوى القراءة. بل وتشابه حتى معك في تعاملي الحياتي لما هو أساسي. أما كل شيء أعمق، فهو يعتبر حصيلتك أنت في اكتشاف ذاتك والحفاظ على خصوصيتك التي تميزك عن الآخر، وذلك بحسب حجم الطاقة التي تقدمها لنفسك وتقدمها لمن هم حولك. هنا تختلف. بل ويختلف معك استفرادك عن البقية، كونك سيد نفسك، وقِسْ تلك السيادة على عدة أمور لا تقف عند ماذا تقرأ، بل ماذا تعمل. ولا نختلف في هذه الحال كثيراً على قدر تشابهنا ببعضنا البعض، بل قد نتبع بعضنا في التقليد والتسابق على نفس القدر من التفكير المادي، باختلاف القدرة على التواصل ومستوى السيطرة الجماهرية التي سترفع أحدا على آخر وتعطي أولوية لطرف عن آخر. إذ تصبح القيمة الفعلية للجميع متشابهة، حتى ويصبح عامل النجاح المال أكثر من أي شيء آخر، ويتحول مستوى الشهرة إلى ظهور اجتماعي يحجب التعليم عن الاستهلاك، ويحجب النهضة عن الترفيه. بالتالي، تتشارك الأغلبية بشؤون المعيشة ومستوى الترفيه كأقصى همومها التي لا يستطع تداركها للوصول إلى مشاريع أكبر تضعه هو المحرك بدلاً من أن يكون مجرد وسيط لمشاريع أكبر حيث يكون فيها عاملاً منزوع الحيوية كقوة محركة تشبع رأسمالية ضخمة على حساب طبقة وسطى عرضية حتى تغيب فيها الحرفة إلى الوظيفة، وتتشابه طبيعة الأعمال وتتوحد من خلالها الإنتاجية للثروة لصالح رأس مالية أكبر تخدم أسياداً تفردوا عن المتشابهين. من هنا، وهذا الواقع العام، نجد أن هناك عدة أبعاد خضعت لها العامة وهي موحدة في التأمين على الترفيه والمعيشة. حيث يغيب العمق، وتفقد الحرفة، وتنتعش نظرية التفاهة عبر إخماد الفكر وتغييب الأدب الرفيع، إلى العقل الجمعي الذي يميل ويتفق على فهمه للأدب الشائع. إذ تنتج هذه الظواهر الضخمة الطفيليين على الثقافة ومستهلكي الثروة بشكلها المظهري والاستهلاكي المبالغ فيه. نحن في زمن لا يعتمد فقط على التعليم لتنشئة أجيال منافسة قد تتجاوز مبادئ ونهضة العصر، ولكن ان استمر الانسان أن يخضع للجماعة وتشابهه مع الآخرين، ففي نهاية الأمر سيكون حتماً جزءاً غير مكمل لاستمرارية المبدأ، بل ستظل الوسيط التي يعمل كقوة لتفريغ المبادئ جوهرياً. كما يظل وجوده مستمراً لإشباع حاجته من دون الإدراك العميق لقدراته ومهاراته الخاصة، وحسه الذي من خلاله يستطيع أن يعبر ويستطيع ان يكون الأنا التي تميزه عن الآخر. لا تشبع نظرية التفاهة ولن تقف، طالما ظل الانسان يلحق التوافه من أجل استدامة الترفيه والمظهر الاستهلاكي، ولن يتحرر الإنسان مالم يذق الاختلاف. فكل ما تحتاجه النظرية كي تنتعش مزيداً من المال، كثيراً من التشابه، وقليلاً من التميز! baljanahi86@gmail.com
7410
| 04 يناير 2022
أي هوية متماسكة تحد من الآخر الدخيل، على الرغم من قوة التأثير التي تستمر في الولوج بشكل غير مباشر على المجتمعات، هذا باختصار محط الاهتمام نحو فهم الهوية ومدى قدرتها على مقاومة الآخر على انه غريب، خاصة عندما تحدد له خطوطه الحمراء في محيط يصعب من خلاله الترحيب فيه! يحصل أن تتحول الهوية إلى عنصر هش، عندما يتقبل المجتمع المحلي ذاك الغريب بقيمه وأخلاقياته ويتقمص تلك الهوية على انها انفتاح حضاري عليه وعلى الآخر أيضاً، هنا يكمن الفرق الخطير، ومن هنا تتضح الصورة أكثر لمدى الخوف والقلق على الهوية من الانهيار ومدى هشاشتها أمام الغريب الآخر. وهذه نظرة عامة، ولكن أجد أنها صريحة جداً حول مدى وازع وقيم المجتمع في وضعه للخطوط الحمراء أمام الآخر غير المرغوب به، ولو أصبح تقبل الآخر نابتا وسط المجتمع اليوم، وهنا يكمن القلق الفعلي، عندما تحصر الهوية في تعريف وتتعامل معها في محيطك بتعريف آخر، بل عندما تتعايش مع الآخر في أجهزتك وتواصلك الاجتماعي وحياتك الشخصية، وتترفع عنها مع الجماعة على أن الغريب غير مرحب به!. وهذا بحد ذاته يعتبر هوسا جدليا مستمرا لسؤال من نحن في ذروة ثقافية نعيشها ويصعب علينا أحياناً كثيرة التصدي لها، فيبدأ الناس في هذه الحال الاهتمام أكثر بسؤال الماهية خلال ذروة القلق، وحاملين هم التنشئة الاجتماعية بشكلها الجماعي وأثرها على أجيال تبتعد من الآن من مبادئ وأخلاقيات المجتمع وتتقبل الآخر لأنه منفتح، منطلق مبدع ومتجرد، ويضع نفسه المهم أمام كل شيء آخر. نشء ينظر للنواة والوحدوية باختصار على انها انطلاق وحرية وقوة في الشخصية. ولا أستطيع في الحقيقة في هذه الحال أن أضع حملاً على المنزل، الأسرة أو المؤسسة وحدهما لتعزيز الانتماء وتقوية الهوية، إلا إذا كان جهداً يتوحد في المفهوم أولاً والمبادئ التي تبرز من خلالها الرسالة التوعوية، بأهمية الحفاظ على هوية مجتمع تميزه عن الآخر ولا تتشابه معه في منكراته، وما يتوارد الآن في الوسط المجتمعي من دون تعميم هو الخوف على الهوية الظاهرية واستنكارها لأنها تختلف عن ظاهرية المجتمع، وهذا جزء واحد لمنظور هوية يخشى على حدوده من الغريب. وبالنسبة لي، استبق موضوع الهوية جزء آخر أهم منه بكثير! تظل مثل هذه الجدليات الثقافية مستمرة من دون أن تجد لها حلاً واضحاً وجواباً موحداً، خاصة إن ظل مفهوم المواطنة أيضا من دون تعريف موحد يعكس منظور الهوية من خلال تعريف القطري لنفسه، من أنت كقطري وكقطرية، كيف تعرف نفسك على أنك قطري؟ أو كيف يعرفك القطري الآخر على أنك قطري؟ هل يراك الآخر بأنك قطري تتشابه معه في الحقوق والواجبات والمواطنة. إذ يعتبر جزء المواطنة مساراً أعمق من مجرد طرح موضوع الهوية في ذروة القلق والخوف على مجتمع من الخارج. بل من المفترض أن ينبع المفهوم من الداخل وتبرز فيه روح الانتماء بتشابه المواطنة ولو تنوع تاريخها الثقافي الحافل واختلفت أطيافها. فلا غنى عن تلك العناصر التي تصنع الهوية الوطنية وتربط علاقتها الاجتماعية بالجماعة بشكل أعمق وأقوى، إذ إن الوطن والثقافة يعتبران العنصرين اللذين لا غنى عنهما في تشكيل أي هوية في العالم، فمن دونهما لن تكون هناك شخصنة مجتمع، ولن تتشكل القيم التي تختلف من جغرافيا لأخرى. بالتالي، لن تجد الإجابة الواضحة للهوية لتصدي الآخر الظاهري الذي لا ترغب فيه، طالما لا توجد مقاربة مشتركة وموحدة للمواطنة والهوية بنظرة الداخل وتقبله لقطري اليوم وقطري الأمس، إذ نختلف هنا في تقبل الآخر حينما يكون مرغوباً وحينما يكون منبوذاً، ولابد من تقبل الآخر المرغوب ممن يمثل بعلمه، يعكس وطنه، يكرس حياته باسم وطن، وحام لقيمه ومبادئه. فلا بد أن تنظر للآخر من الداخل ولا تخشى منبوذ الخارج عندما يكون طفرة تأتي وتذهب إن ظلت معايير الهوية والمواطنة واحدة، وقاومت المنبوذ بمواطنة تقاومه وتعي قيمها ضده!. ولا شك بأن العولمة لن تترك المجال للخصوصية أن تكون محدودة داخل أسوار المنزل ولا جغرافيا الدول، بل اجتازت الأسوار واخترقت الشبكات كي تكون عند كل فرد في نفس المنزل، وفي كل منزل من نفس المجتمع. بالتالي، يظل التحدي مستمراً في تشكيل وحماية الهوية من الانهيار في ظل موجات خطيرة لها دخول غير مرحب به وبشكل مبطن لعملية تقبل الآخر، ولكن تظل الموازنة مهمة في الوعي بالقيم والوازع الديني والأخلاقي والذي سيظل يقابله الانفتاح على الآخر بشكل مستمر سواء كان جزءاً من تنمية وطنية أم من دخيل عابر!. baljanahi86@gmail.com
6856
| 07 ديسمبر 2021
من الصعب أن ينتشل الإنسان من الزمان والمكان الذي كون من خلاله انتماءه، وتخيل عندما تتبنى الجماعة نفس هذا الحس وشعور الأمان بأنه جزء من ذكريات ومكان ظل في الذاكرة ورسخ الزمان الذي خلد له الولاء من ذاك الظرف وذاك المحيط الذي ولد له الحس وكون حوله جماعة ينتمي إليها وتنتمي إليه. ولا يسبق الزمان المكان، على قدر ثبات المكان ليكون طيفاً يعود من خلاله الزمان وتبدأ مرحلة المقارنات بين اليوم والأمس، وتتناقل القصص عما كان أفضل من اليوم وكيف كان المجتمع أقرب للموروث مما هو عليه اليوم. مقدمة قد يتباكى عليها الكثير من جيل سابق يحن لقناعة الماضي وتواضعه، وقد يظل هناك دون أن يدرك بأنه يمر في كل تلك الحقب التي جعلته متغيراً، في حين لم يعد ذاك الزمان وذاك المكان من دون أن تطرأ عليه تغييرات اجتماعية عدة. إذ يصعب عليه في هذه الحال الانتقال، كما يصعب عليه التجرد من موروثاته الفردية ومرجعياته التقليدية، أياً كانت معاييرها وقناعاته حولها. ولن يكون الأمر يسيراً على الجماعة، إن ظلت المرجعيات القديمة في عزلة عن التجديد. وقيس هذا الانتماء المتعصب للماضي لما فيه من مرجعيات تقليدية وأثرها على أجيال شعرت بالخلخلة من تلك المنظومة التقليدية والتي لا رابط لها في تلك الموروثات إلا مفهوم هوية معاصر يحدد مكانته اليوم، أهميته ودوره الفاعل وغير الفاعل حتى لمجرد إنه جزء من وطن!. فالمفاهيم تتغير، ولا تقف عند زمان واحد، حتى لو ظلت الأصالة صامدة في زمانها ومكانها، إلا إنها بلا شك قابلة للتمدن وقادرة على العصرنة كي تواكب العصر وتتماشى مع أجيال جديدة، تتمسك في الماضي لأنه جزء من هوية جماعة يعرف من خلاله نفسه، بينما يستطيع أن يتطلع للمستقبل من دون تبعات قد تجره للوراء مع من واكب ذاك العصر وظل معزولاً فيه. فما يحدث في هذه الحال في الحداثة حتى ولو كانت قائمة يعتبر تشويهاً لما تنتجه بناء على مخرجات غير مستقرة في ماهيتها، أي من المجتمع من الداخل، غير قادرة على الانطلاق في ظل المجتمع التقليدي ولا هي قادرة على البقاء والصمود مع الموروثات الفردية كعقليات جامدة، ولا قادرة بالخروج كي تتجرد منها لتطلعات مستقبلية أقرب إلى الابداع كإجراء توظيفي وتشغيلي لها وعلى مستوى حديث بأقل الأضرار والعراقيل التي تأتي من مرجعيات تقليدية فردية وسلوكيات اجتماعية سابقة. ومن هنا يأتي مفهوم الحداثة أكثر إدراكاً لطرق التعامل مع البعد الأخلاقي والتقليدي عند المجتمع، من حيث قدرة الحداثة على التوسع من ضائقة الموروثات السابقة كسبب منطقي وفكري لانفتاح المجتمع كي يكون أكثر مدنية وبروح وطنية عالية. وقيسها أيضاً على انطلاقة الفرد كعنصر إبداعي يترقب الانطلاق من نفس ذاك المجتمع العرفي. وهذا الشعور والتحول الاجتماعي لن يأتي بشكل سهل إن لم يكن نابعاً من الداخل ومواجهاً لعقبات الحداثة عندما تصبح دخيلة، بل حتى وعقبات الموروث عندما يكون عائقاً. ويصعب علي في حقيقة الأمر أن أراهن على مجتمع متقدم من دون أن أحزن على أعرافه الاجتماعية التي لا يتجرأ أن يبقيها معزولة ولو لوهلة خاصة وعندما نبدأ الحديث عن التنمية والمحاولة للخروج إلى الانتماءات المجتمعية الحديثة التي يشعر من خلالها الفرد بأنه عضو فعال لا يضيق عليه محيطه بسبب مرجعيات تقليدية قد لا تكون إلا عرفاً لا غاية له إلا البقاء في الماضي والاحتماء فيه!. والمشكلة ليست مؤسسية من وجهة نظري في هذا المقال، بل تظل المؤسسة لديها القدرة على إحداث التحولات الاجتماعية المطلوبة وتمكين الإبداع بشكل مركزي أكثر، إلا إن يظل للمجتمع الهيمنة العرفية من خلال قدرته الفردية على فرض رغباته على سياق رجعي أو تقليدي معين، إذ يعمل على اخماد شرارة الإبداع بشكل تلقائي وشرس. ويطرح بعض المفكرين سؤالاً تفكرياً مهماً: ما حاجة المجتمع إلى الجديد عندما يملك ثقافة وتقاليد؟ وفي الحقيقة يظل هذا السؤال عميقاً ولكن الجواب عليه قد يقتصر على جملة بسيطة، بأنها مسألة توجيهية تقاس من خلال آلية تقبل التمدن وتمكين التحولات الاجتماعية المعاصرة من خلال الضرر الأقل على خصخصة مجتمع، بالإضافة إلى القدرة التوجيهية على إتاحة فرصة الابداع من خلال رسم الخطوط الحمراء والخضراء على أبعاد الثقافة وأبعاد التقاليد التي تساهم في الحفاظ على تأصيل المجتمع، وفي نفس الوقت تتيح له الاستمرارية المعاصرة لأبعاد اجتماعية متجددة تواكب الحداثة بينما تظل ماهيتها صلبة وبروح إبداعية محركة. هذا أفضل سيناريو نقيس عليه مسألة التمدن مع أجيال ترغب في تحديد إطارها الوطني بحس ابداعي وبتقليل ضرر العرف الاجتماعي عليها. وفي نهاية الأمر، يظل التحدي قائماً في فهم آلية التنفيذ التنموية ورسم الخطوط الحمراء والخضراء لتغييرات المجتمع وتقاليده في زمن الحداثة بمعناه الفكري والتجريدي لمنظومات اجتماعية سابقة. هل تراهن على مجتمع متقدم عندما ينجرف وراء عرفه بنفسه؟! baljanahi86@gmail.com
7345
| 23 نوفمبر 2021
مساحة إعلانية

راقب المشهد في أي مجمع تجاري في عطلة...
1887
| 12 فبراير 2026

ربما كان الجيل الذي سبق غزو الرقمنة ومواقع...
1755
| 15 فبراير 2026

يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة،...
1653
| 10 فبراير 2026

الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وهي...
870
| 12 فبراير 2026
لم يكن الطوفان حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه مع...
855
| 10 فبراير 2026

لقد طال الحديث عن التأمين الصحي للمواطنين، ومضت...
681
| 11 فبراير 2026

منذ إسدال الستار على كأس العالم FIFA قطر...
615
| 11 فبراير 2026

يشهد الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة حالة مزمنة...
597
| 09 فبراير 2026

لم يعد هذا الجهاز الذي نحمله، والمسمى سابقاً...
528
| 09 فبراير 2026

في السنوات الأخيرة، أصبحنا نلاحظ تزايدًا كبيرًا في...
525
| 12 فبراير 2026

يستيقظ الجسد في العصر الرقمي داخل شبكة دائمة...
459
| 10 فبراير 2026
في زمن السوشيال ميديا، أصبح من السهل أن...
459
| 12 فبراير 2026
مساحة إعلانية