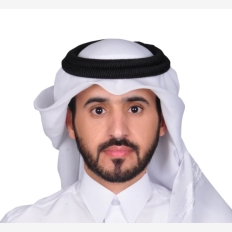رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
زرتُ معرض الرياض الدولي للكتاب مؤخراً، فوجدتني بين زمنين؛ أسير بين أروقة تمتد امتداد خريطة العالم، فتستحضر ذاكرتي تلقائياً زياراتي لمعارض أوروبية كبرى وما لفتني فيها من ابتكارات ورؤى في العرض والتسويق، فتساءلت من باب المقارنة والافتراض: لماذا لا يكون لدول الخليج معرض موحد ينتقل بين عواصمه؟ تثبت التجارب العالمية أن التكامل الثقافي الإقليمي بات ضرورة إستراتيجية. إذ نجد الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، رغم تنوع لغاته وثقافاته، يدعم سوق نشر تقدر قيمته بـ36 مليار يورو عبر برنامج «كريتيف أوروبا» الذي خصص له للعام المقبل ميزانية قدرها 380 مليون يورو، ضمن ميزانية إجمالية تبلغ 2.44 مليار يورو للفترة 2021-2027. حيث يدعم البرنامج تداول الأعمال الأدبية وتنوعها اللغوي، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع من خلال شبكة معارض الكتاب الأوروبية وجائزة الاتحاد الأوروبي للأدب التي كرّمت منذ 2009 أكثر من 175 كاتباً ناشئاً من 41 دولة. كما ساهم الحضور الموحد للاتحاد الأوروبي في معرض فرانكفورت التنوع الثقافي الأوروبي لأداة دبلوماسية ناعمة قوية. وفي تجارب ناجحة أخرى تنسّق الدول الإسكندنافية عبر شبكة «نورد ليت» جناحاً شمالياً مشتركاً في معارض لندن وبولونيا، إلى جانب جائزة المجلس الشمالي للأدب التي تمنحها الشبكة منذ 1962. ولا شك أننا حين نضرب المثل بهذه النماذج فذلك لأنها حولت معارض الكتب إلى مشاريع حضارية تعزز الهوية وتخلق أسواقاً إقليمية متكاملة. وفيما يخصنا نحن، فلدينا في الخليج أساس تكاملي يمكن البناء عليه، من خلال جهود «لجنة المسؤولين عن معارض الكتب» التي تعمل منذ سنوات تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وترفع توصياتها لاجتماعات وزراء الثقافة وتناقش الإستراتيجية الثقافية المشتركة، كما يلتقي مديرو المعارض الخليجية دورياً لمتابعة القرارات ومناقشة المبادرات المشتركة. وهو تنسيق من شأنه أن يشكل قاعدة صلبة نحو القفزة النوعية التي يمكن أن يمثلها مشروع معرض خليجي موحد للكتاب. لدينا معارض وطنية عريقة تستقطب ملايين الزوار: الدوحة والرياض وأبوظبي والشارقة والكويت والمنامة ومسقط. وكل واحد منها حدث له وزنه الثقافي المتراكم بحد ذاته، وبإضافة مظلة خليجية جامعة لمعرض موحد للكتاب يمكننا على الأقل من ثلاث ميزات إستراتيجية، أولها؛ قوة الحضور الإقليمي في المحافل الدولية، ثانيها إطلاق جائزة خليجية للكتاب تضاهي الجوائز العالمية، وثالث هذه الميزات إيجاد سوق نشر إقليمية موحدة توفر فرصاً اقتصادية حقيقية ومنافسة في الطباعة والتوزيع والترجمة ضمن خريطة سوق النشر وصناعة الكتاب العالمية. وبذلك يكون المعرض الخليجي المتنقل سنوياً بين عواصمنا تتويجا للمعارض الوطنية، تحمل دوراته شعاراً ثقافياً سنوياً يعكس رؤية المنطقة، كما يستضيف مؤتمرات وندوات خليجية وعربية في مجالات النشر والإبداع على نحو يصبح فيه الموعد واجهة ثقافية كبرى لمواجهة تحديات التحول الرقمي وتأثيره على معدل القراءة، وحضور اللغة العربية من جهة، ويبرهن من جهة أخرى؛ أن الخليج ليس فقط قوة اقتصادية وإنما منارة فكرية قادرة على إنتاج المعرفة وتصديرها إلى العالم، ثم أخيراً تحقيق خطوة جوهرية في مسيرة التكامل الخليجي المستمرة، من شأنها تعزيز الثقل الثقافي بما يوازي الثقل الاقتصادي والسياسي لدول المجلس.
378
| 13 أكتوبر 2025
المؤثرون اليوم مشاهير يشغلون الصغير والكبير، ويمدون الجماهير بشتى الأخبار. والأكثر من ذلك كله، فهم مقصد العلامات التجارية، وفاعلون اقتصاديون وسياسيون يملكون القدرة على تشكيل الوعي وتوجيه سلوك متابعيهم. هذا واقع ظاهرة عالمية فرضت نفسها بقوة الانفجار الرقمي، لتزعزع قواعد التأثير والثقة في الفضاء الرقمي، الأمر الذي استوجب وضعها على مرمى السياسات العامة والتوجيه الإيجابي عبر إعادة النظر في الأطر التنظيمية لهذه الصناعة المتنامية. وتكشف التجارب الدولية عن محاولات رائدة في توظيف المؤثرين إيجابياً، حيث استعانت الحكومة الفنلندية خلال جائحة كورونا بألف وثمانمائة مؤثر للوصول إلى شرائح يستعصي الوصول إليها عبر القنوات التقليدية، بينما نجحت المملكة المتحدة في توظيف مؤثرين من الأقليات لتخفيض التردد تجاه اللقاح من ثلاثين بالمائة إلى مستويات طبيعية عبر استثمار ما تسميه الدراسات «العلاقات الباراصوشيالية»؛ أي تلك الروابط الحميمة التي يبنيها المؤثر مع متابعيه حتى يصير صوتًا موثوقًا يتفوق أحيانًا على المؤسسات الرسمية. غير أن هذا الصعود العالمي للمؤثرين بصورة تفوق التوقعات، يحمل في طياته تحديات تهدد جوهر المصداقية التي قامت عليها الممارسة الإعلامية. إذ تكشف دراسات حديثة حول صناعة المؤثرين عن مفارقة لافتة تتمثل في صعوبة التحقق من «الحقيقة وراء أصالة المؤثر الظاهرية»، حيث تسود ممارسة مفادها «أن تكون أصيلًا وليس بالضرورة دقيقا»؛ أي تقديم الذات بصورة تبدو حقيقية في جوهرها دون أن تكون كذلك فعليًا. ثم يتفاقم هذا التناقض مع ازدهار «الاقتصاد الظلي» للصناعة، من شراء المتابعين الآليين، وانتشار مزارع النقر، وشبكات التضخيم الذاتي المعروفة بـ«عُقَد إنستغرام» حيث يتواطأ المؤثرون على تضخيم محتوى بعضهم البعض لخداع الخوارزميات. وخلف كواليس هذه الصناعة يكمن التحدي الأكبر في تحول القيم والمواقف إلى سلعة قابلة للمساومة، فقد يروّج المؤثر لمحتوى معين اليوم ولمنافسه في الغد، ما دام قادرًا على إبقاء سرد علامته الشخصية متماسكًا ظاهريًا، متنقلًا من اقتصاد الانتباه العابر إلى ما تصفه الأدبيات بـ «اقتصاد العاطفة» حيث الولاء للشخصية وليس لمصداقية المحتوى. في ظل هذا المشهد المعقد، بادرت دول عديدة إلى وضع أطر تنظيمية تحفظ التوازن بين تشجيع الإبداع وحماية المجتمع، حيث سنَّت المملكة المتحدة وأستراليا منذ 2017 قوانين تلزم المؤثرين بالإفصاح الواضح عن المحتوى المدفوع، بينما أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحكومات ببناء شبكات مؤثرين موثوقين للتواصل الحكومي، معتبرة أن «المؤثرين قادرون على ترجمة الرسائل العامة إلى سرديات مقنعة للفئات المستهدفة». وألزم المشرع، في المملكة العربية السعودية، المعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة سنوية تخضعهم لمعايير واضحة في المحتوى والإفصاح، مع آليات رقابية فاعلة تحد من المواد «الهابطة». أما في دولة قطر، فقد جاء اقتراح مجلس الشورى في ديسمبر الماضي ليضع إطارًا متكاملًا لتقنين صناعة المحتوى الرقمي؛ حيث نص الاقتراح على إصدار رخصة «مؤثر» من جهة معنية بالدولة، تتضمن معايير مهنية وأخلاقية واضحة تقضي باحترام الوحدة الوطنية والموروث الثقافي، وتجنب خطابات الكراهية والتمييز، وعدم نشر معلومات مضللة، والشفافية في الترويج. كما شمل الاقتراح ضوابط إدارية تحدد مدة الرخصة وآليات تجديدها، مع رقابة تضمن الامتثال وعقوبات تدريجية عند المخالفة، ساعيًا لتحويل المؤثرين إلى شركاء في التنمية يقدمون «محتوى يتوافق مع قيمنا ويحد من البذخ والإسراف ويمنع انتشار الثقافات الدخيلة». وتبقى حاجتنا إلى هذا الإطار القانوني خطوة تشريعية بناءة تؤكد أن تنظيم هذا المجال ليس مصادرة لحرية التعبير بل صيانة للفضاء العام من العبث، بما يعزز «مناعة معرفية» للمجتمع عبر قانون يحوّل المؤثر المرخّص إلى إعلامي محترف يخضع لمعايير المهنة ويتحمل مسؤولية ما ينشر. وعندها نؤسس فضاءً رقميًا يحمي النشء، ويعزز الثقة والمصداقية وفق قانون يضمن مراعاة التأثير الإيجابي ومسؤولية المحتوى.
471
| 06 أكتوبر 2025
ينعقد غدًا الثلاثاء «ملتقى الإعلام الوقائي شريك في القيم المجتمعية والتماسك الاجتماعي»، بتنظيم من مركز دعم الصحة السلوكية وبالتعاون مع تلفزيون قطر. الملتقى يأتي ليضع مفهوم الإعلام الوقائي موضع النقاش والتأطير المؤسسي، من خلال جلسات تشاركية تسعى إلى الإجابة عن سؤال محوري: كيف يمكن للإعلام أن يتحول إلى منصة تمكين؟ سؤال يشمل بالضرورة مدى استيعاب أدوات الإعلام التقليدية والرقمية لطموحات الشباب بما يرسخ ثقتهم كشركاء في التنمية، ورسم ملامح الغد. قد تكشف الملاحظة المباشرة حقيقة لا تحتاج إحصائية لإثباتها، وهي أن صناع المحتوى الرقمي لا يتحققون كلهم من المعلومات قبل نشرها، وقد لا نبالغ في القول بأن غالبيتهم لا يقومون بذلك. لنتخيل بصورة عامة، حجم المعلومات الخاطئة، بما فيها المضللة، التي قد تتسلل من هذه الفجوة، حتى وإن كنا نضع في الحسبان أن نسبة كبيرة من صناع المحتوى، تُبدي رغبة صادقة في تعلم مهارات التحقق والتوثيق. وكما نردد دائما، فإن الضرر لا يمكن تداركه طالما قد حصل بمجرد نشر معلومة مضللة، لذلك تقترح فكرة «الإعلام الوقائي» مقاربة تستلهم من علم المناعة قدرته على التحصين قبل المرض، ويكون المبدأ في ذلك قائما على «التلقيح المعرفي» الذي يسلح وعي الجمهور الإعلامي بأدوات الكشف والتمييز التي تجعله خط الدفاع الأول ضد التضليل. وبناء مناعة مستدامة، يعني أن الاستثمار في التربية الإعلامية والتحصين المعرفي ضرورة حتمية لبناء مجتمع قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة ووعي. من هذا الفهم ينبثق تحول جذري في النظرة إلى دور الشباب، من «فئة مستهدفة» تحتاج للحماية من التضليل إلى «شركاء حقيقيين» في التصدي له، على نحو تتشكل فيه أسس «البنية التحتية المجتمعية» التي تقاس في أهميتها بأهمية الطرق والمستشفيات والمدارس، إذ إن ما يضع الإعلام في مرتبة البنية التحتية الحيوية للمجتمع هو أن منظمة الصحة العالمية تصنف «التواصل حول المخاطر والمشاركة المجتمعية» كإحدى القدرات الأساسية التي يجب على الدول تطويرها، حيث تصبح المنصات الإعلامية مساحات لتداول المعرفة وبناء الوعي الجماعي وتطوير قدرات المواجهة. وفي هذا الصدد تشهد دولة قطر جهوداً متصاعدة لبناء قدرات مجتمعية في مواجهة التحديات الإعلامية المعاصرة، سواء على صعيد الجهود والمبادرات المؤسسية داخليا، والتي تعكس توجهاً نحو تطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية كركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على التعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، أو على صعيد المبادرات المشتركة كان آخرها مشاورات نظمتها اليونسكو بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ومعهد الجزيرة للإعلام جمعت حوالي 75 مشاركاً من قطاعات حكومية وأهلية وتعليمية وإعلامية متنوعة، حيث خلصت المشاورات إلى وضع خطة عمل شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع في مواجهة التضليل الرقمي وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، مؤكدة على أهمية بناء بيئة رقمية آمنة. ولا شك أن هذا التوجه يشكل جزءاً من حراك عالمي يسعى لتجاوز النهج التقليدي في التعامل مع المعلومات المضللة من مجرد الرد عليها إلى بناء مناعة مجتمعية مسبقة تمكن الأفراد من التمييز والتقييم النقدي للمحتوى الذي يواجهونه في الفضاء الرقمي. وهو توجه يجد تطبيقات ملموسة في مبادرات تدريب المؤثرين على التحقق، والتجارب والبرامج الإعلامية الشبابية في المنطقة العربية تؤكد أن الشباب قادرون على أن يكونوا خط الدفاع الأول ضد التضليل، شريطة توفر الأدوات والثقة والمساحة للمشاركة الفاعلة. تمكين الشباب بالإعلام وفي الإعلام مسار لا ينتهي، وهو محكوم ببيئة إعلامية متسارعة. وغدا محطة أخرى ضمن هذا المسار، سيطرح الملتقى خلالها تصوراته حول استراتيجيات التمكين، بدءًا من تشكيل وعي جمعي قائم على القيم والاحترام والمسؤولية، وصولًا إلى ابتكار برامج موجهة للنشء والشباب تغرس فيهم السلوكيات الإيجابية وتعزز المواطنة الصالحة، وانتهاءً ببحث السبل العملية لتسخير الإعلام في توفير محتوى تثقيفي يواكب احتياجات الشباب ويوجههم نحو خيارات رشيدة ومسارات حياة مستقرة. يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل كل مواطن إلى حارس أمين للحقيقة، مسلح بالمعرفة والوعي. وفي هذا التحول من الحماية إلى التمكين الفعّال تكمن بذور إعلام وقائي قادر على بناء مجتمع مؤمن بأن المناعة بالمعرفة هي حصنه الذي يقف سداً منيعاً أمام كل أشكال التضليل.
528
| 29 سبتمبر 2025
عند كل مناسبة يلتئم فيها العرب حول قضاياهم المصيرية المشتركة، يسبق إعلان البيان الختامي سيل من التعليقات المتشائمة، مرده إلى المزاج العام الذي يعتبر القمم العربية منبرا لخطابات وبيانات لا أثر لها على أرض الواقع، ونتيجة لذلك يواجه الخطاب الإعلامي العربي في مثل هذه المناسبات جمهورا مثقلا بخيبات متراكمة، أو منجذباً إلى سردية اللاجدوى. وآخر هذه الالتئامات ما شهدته الدوحة في استضافتها القمة العربية الإسلامية الطارئة في الخامس عشر من سبتمبر، بعد أيام قليلة من الضربة الإسرائيلية الغادرة التي استهدفت منطقة سكنية يقيم فيها وفد حركة حماس المفاوض، في سابقة خطيرة هزّت الحسابات الإقليمية، وتداعت لها الأمة جمعاء في اجتماع ضم قادة سبعٍ وخمسين دولة عربية وإسلامية، ووضع الالتئام العربي والإسلامي هذه المرة في بؤرة التغطيات الإعلامية الدولية، بين من أبرز وحدة الصف العربي الإسلامي، ومن اكتفى بالتشكيك في جدوى المخرجات. وسردية اللاجدوى، إن غذاها الإعلام الغربي، فذلك ليس بغريب عنه، ومن ذلك أن شبكة عالمية ذهبت إلى وصف القمة الطارئة بأنها «تمرين في العبث»، فيما رأت أخرى أن البيان الختامي «مجرد محاولة لإخفاء العجز عن الفعل». وهي توصيفات سرعان ما تتلقفها منصات التواصل العربي وتعيد تدويرها دون وعي إعلامي بسياقاتها، وفي غياب أي تأطير بخصوصية البيانات الختامية التي تتطلب قراءة متأنية لسد الفجوة بين ما يراه الدبلوماسيون أرضية للتحرك القانوني وما يُختزل بتمرير الأصابع على الشاشات في خطاب بلا أثر. وفي مقابل هذه السردية، انبرى الإعلام القطري بكل مكوناته لترسيخ خطاب متزن وواقعي في تغطية القمة وتأطير مقرراتها، مؤكداً دور دولة قطر كوسيط فاعل يستند إلى الشرعية الدولية، عبر تحليلات موضوعية ولقاءات تطرقت إلى البيان الختامي وما تضمنه من الدعوة إلى مراجعة العلاقات مع دولة الاحتلال ووقف تزويدها بالأسلحة، وطرح مسألة تعليق عضويتها في الأمم المتحدة، باعتبار المس بالسيادة انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناولت التغطيات ما أسفر عنه اجتماع مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون من تحديث للخطط الدفاعية وتعزيز التكامل الخليجي في مواجهة التهديدات التي تمس أمن دول المجلس وسيادتها واستقرارها. فيما تتواصل تغطية التحركات الدبلوماسية التي يقودها أمير البلاد المفدى وقياداتنا الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي، لتنسيق المواقف وتأكيد مسار الوساطة، وبحث آليات المساءلة مع جهات الاختصاص في لاهاي، بالتوازي مع حضور نشط في جنيف عبر مجلس حقوق الإنسان. غير أنّ سردية اللاجدوى التي تغذيها المنصات الرقمية وبعض وسائل الإعلام، وجدت تقويضاً حتى عند منابر غربية متحفظة، والتي أشارت إلى أنّ القمة دشّنت بداية تغيير في النبرة الإقليمية، وأن اجتماع هذا العدد الكبير من القادة على موقف واحد يشكّل بحد ذاته نقطة قوة، وأن تفعيل آلية الدفاع الخليجي هو النتيجة الأكثر واقعية المنبثقة عن القمة. ومن المهم، في هذا الصدد، التمييز بين النقد المشروع الذي يعبّر عن خيبة أمل متراكمة، وبين نزعة تتغذى على تبخيس كل جهد جماعي عربي. فالتجارب تكشف أن بعض المواقف الأيديولوجية لا تكتفي بانتقاد قصور القمم، بل تنقلب إلى خطاب ينزع الشرعية عن فكرة العمل العربي المشترك ذاتها، في تماهٍ مع أصوات ناشزة دأبت على تصوير العرب كعاجزين عن أي فعل منسّق. وهو ما يجعل المتلقي العام أكثر عرضة للانزلاق إلى أحكام مسبقة تتغذى على خطاب جلد الذات وتكريس فكرة الأزمة الأبدية، بنبرة يتداخل فيها النقد مع نزعات عدائية تجاه العروبة. في بيئتنا الإعلامية المتغيرة، تتبدل أنماط الاستهلاك الإخباري، ويزداد نفور الجمهور من التحليل المطوّل وبذل الجهد المعرفي في التحقق وتحري الحقيقة، حتى بات في طلبها يُكتفى بمقطع لا يتجاوز ثلاثين ثانية، بغض النظر عن طبيعة الفهم الذي يترسخ في ذهن مشاهده. وأمام هذا الواقع لم تعد المؤسسات الإعلامية وحدها من يوجه دفة الرأي العام، الأمر الذي يعمّق الهوة بين ما تبنيه غرف الأخبار بوعي مؤسسي ومهني وما يستقر في أذهان المتلقين المرهقين من التمرير القهري على الشاشات. لذلك يبقى الدرس الإعلامي الأبرز هو أن معركة الجدوى أو اللاجدوى تُحسم اليوم في الفضاء الرقمي السريع الاستهلاك، حيث يمكن لمقطع فيديو قصير أن يرسخ صورة نمطية في ذهن من لديهم القابلية لها، أو أن يكون محط نقد وتحفظ لمن لديهم وعي إعلامي، ويمكن أن يتحول، متى أحسن تحريره، إلى معبر لسردية الجدوى، أي الرواية الحقة التي ما فتئت مؤسساتنا الإعلامية الوطنية تنقلها في مواجهة السرديات المضللة.
201
| 22 سبتمبر 2025
خلال الحدث الغادر الذي شهده وطنُنا الأبي الثلاثاء الماضي، تكرّرت التوجيهاتُ الرسمية بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة؛ وهو تذكيرٌ دأبت عليه السلطاتُ الأمنية حرصًا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. ففي دقائق معدودة قد ينتشر خبرٌ عبر المنصّات، وتتسارع التعليقاتُ تأييدًا أو تشكيكًا، ثم يتبيّن أنّه عارٍ من الصحّة؛ لكنّ الضرر يكون قد وقع بالتشويش على الوعي العام، وربما اهتزّ يقين بعضهم بإشاعة أراد لها الأعداء أن تكون سلاحاً أبلغ وقعاً من الرصاصة! فهكذا تُدار الحرب الحديثة؛ بالكلمة والصورة والخبر. فالعدو اليوم لا يكتفي بانتهاك سيادة الدول، وإنما يسعى لاختراق وعي المجتمع محاولًا شق الصف الوطني وإضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات وطنه. وهي حرب صامتة أخطر من دوي المدافع، إذ تهدف إلى إشاعة حالة اللايقين والارتباك في النفوس الضعيفة، وزعزعة المواقف الراسخة التي يجتمع عليها الشعب والدولة وتتقوى بها اللحمة الوطنية. وفي مثل هذه الأحداث يتجلى الدور الحاسم للوعي المجتمعي باعتباره حصن الوطن المنيع في وجه أيّ اختراقٍ إعلاميٍّ معادٍ. ومن ثمّ على المواطن أن يكون يقظًا ومسؤولًا؛ فلا ينجرف خلف الشائعات، ولا ينقل خبرًا بلا تحقّق، ذلك أن حق الوطن عليه الثباتُ على الحقيقة، وأن يكون سندًا لروايتِه، وشريكًا في نشرِ الوعي بها. إذ في كلّ لحظةٍ يختار فيها ما يصدّقه وما ينشره وما يعرض عنه، يكون، بدوره، مجنّدا في معركة الحقيقة التي سلاحها المواطنة الواعية والتثبّتُ والحذر من ألسنة التضليل. ولطالما أشرنا في هذه الزاوية إلى أهمية التربية الإعلامية، فإذا بالوعي الإعلامي في مثل هذه المواقف واجب وطني. فكما يتدرّب الجندي على حمل السلاح، يجب على المواطن أن يتدرّب على حمل الكلمة الصادقة تجاه الوطن والتي تكون درعًا يرد سهام التضليل، ورسالة دالة على أن هذه الأرض أبية بمواقفها وتماسك مجتمعها، ووعي أهلها، وكلها خصال متجذّرة تقوَّت بها مناعتنا الوطنية عبر الأزمان وصانت روايتنا من أي تزييف. تثبت الشواهد أن الشعوب التي تتمسّك بمبادئها يخلّدها التاريخ بحروف النصر والعزّة. وقطر اليوم تقف صفًا واحدًا خلف قيادتها، متسلّحة بمواقفها وقيمها الراسخة في نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ومهما كان ثمن هذه المواقف، فإنها لا تزيدنا، نحن أبناء هذا الوطن الأبي، ومعنا كل مخلص يقيم بيننا، إلا تباثًا سندًا لوطننا، واثقين أن السيادة تُصان بالسلاح والتضحية، كما تُصان بالكلمة التي تحفظ وحدة الصف، وبالموقف الراسخ الذي ينير وعي المواطن، وبالتفاني في العمل ومواصلة البناء. وفي تضافر ذلك كله يبقى وطننا حصنًا منيعًا، نلتف حوله شعبًا ودولة خلف قيادتنا الحكيمة، في تماسكٍ وصمود أمام كل تحدٍّ خارجي. وإذا كان رهان العدو بغدره السافر ضرب جهود دولة قطر النبيلة في تحقيق السلم الدولي، فإن سلاحه في ذلك بائدٌ، بينما سلاحنا الإيمان بالسلام وهو الرهان الذي لولا أنه يرعب العدو ما كان ليتطاول على نسفه بإرهابه الدولي، ولن يتحقق له ذلك ما دام السلام في وجداننا الإسلامي قوة متجذرة، إذ منه إيماننا ورسالتنا الحضارية للإنسانية جمعاء.
369
| 15 سبتمبر 2025
تتموضع حقوق الملكية الفكرية في قلب الاقتصاد المعرفي المعاصر بوصفها الضمانة الأساسية لحماية الاستثمار في الإبداع والابتكار. وإدراكا لهذا، تمضي دولة قطر في تحديث تشريعاتها بخطوات نوعية، كان آخرها الانضمام إلى بروتوكول مدريد في أغسطس 2024 الذي وسّع نطاق حماية العلامات التجارية إلى أكثر من 130 دولة عبر طلب موحّد، وإطلاق الجريدة الرسمية الإلكترونية للعلامات التجارية في يوليو الماضي واعتماد شهادات رقمية للتسجيل، وهي تطورات تعكس توجهًا حكيمًا نحو رقمنة أدوات الحماية وتعزيز الشفافية، وتفتح في الوقت نفسه أفقًا للتفكير في مدى قدرة الأطر القانونية التقليدية على مواكبة التحولات التقنية في عصر يعيد تعريف الإبداع ذاته. ولعل مجال النشر يأتي في صدارة التحديات، فما كان بالأمس حقوقاً راسخة محددة المعالم، أصبح اليوم موضع إعادة نظر جوهرية تفرضها طبيعة الأدوات الرقمية التي تنتج محتوى بكثافة وتنوع يتطلبان إطاراً قانونياً أكثر مرونة وشمولية، لضمان التوازن بين حقوق المبدعين ومصالح المجتمع المعرفي. وقد رسّخ القانون القطري رقم (7) لسنة 2002 إطارًا متوازنًا لحماية الإبداع، إذ جمع بين الحقوق المالية التي تكفل عائدًا عادلاً للمؤلف، والحقوق الأدبية التي تحفظ نسبة العمل إليه، مع منظومة تنفيذية فعالة تتولاها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة. كما يتيح القانون استثناءات مدروسة للأغراض التعليمية والبحثية، تسمح بالاقتباس أو النسخ المحدود بشرط احترام نسب العمل لمؤلفه وعدم الإضرار باستغلاله التجاري، وهو ما يعكس مقاربة تجمع بين الحق في المعرفة وحقوق المبدعين. كما يتعزز التشريع المحلي بارتباطه بالمنظومة الدولية، إذ تمتد الحماية وفقاً لأي اتفاقية تكون دولة قطر طرفاً فيها، وهو ما تجسّد على سبيل المثال في الانضمام إلى اتفاقية «برن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية. وكلها إجراءات ساهمت على نحو حكيم في الموازنة بين صرامة العقوبات، ومرونة تطبيقية تجيز الاستفادة المحدودة من المصنفات للأغراض التعليمية والنقدية ضمن شروط واضحة تشمل ذكر المصدر واسم المؤلف مع عدم الإضرار بالاستغلال التجاري العادي للعمل. وقد شكّل هذا التوازن المدروس بيئة قانونية محفزة للإبداع وضامنة لحقوق المبدعين، لكنه اليوم يواجه اختباراً حقيقياً أمام موجة التطورات التقنية المتسارعة. غير أن التحديات التي تواجه قطاع النشر لا تقتصر على الجوانب القانونية، وإنما تتفاقم باستفحال ظواهر القرصنة الرقمية وانتشار النسخ غير المشروعة عبر الشبكات الإلكترونية. وهي ظاهرة تقوض الأسس الاقتصادية لصناعة النشر برمتها وتقوض الحوافز الضرورية لاستمرار الإنتاج الفكري النوعي. لذلك فإن الحلول الفعّالة تستدعي بدائل قانونية جاذبة، مثل إتاحة نسخ رقمية بأسعار رمزية، مزودة بوسائل حماية تقنية، بما يقلل من دوافع اللجوء إلى النسخ المقرصنة، ويتيح في الوقت نفسه وصولًا أوسع للمعرفة. وتبقى هذه الفعالية مرهونة بوعي المجتمع بها، وجهود المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية في تعزيز ثقافة احترام الملكية الفكرية عبر برامج توعوية وتدريبية تؤسس لفهم مجتمعي لطبيعة العلاقة التكاملية بين حماية الحقوق وازدهار الثقافة. وبموازاة هذه الجهود التثقيفية، تبرز الحاجة إلى مبادرات عملية تعزز التوازن بين الحماية والانتشار، مثل تفعيل أنظمة الترخيص الجماعي المنصوص عليها في القانون والتي تسمح للمكتبات والجامعات باستخدام المواد المحمية قانونيًا مقابل رسوم تفضيلية، وإنشاء آلية موحدة وسريعة للتعامل مع البلاغات بشأن المحتوى المقرصن. كما يمكن للشراكات بين دور النشر، والجامعات، والمكتبات، أن تسهم في رفع الوعي لدى المؤلفين والقراء على حد سواء، من خلال ورش عمل وحملات تثقيفية. لقد بات وعي المؤلف القطري بحقوقه أكثر رسوخًا في صون الحق وتوطين الكتاب. ومن موقعي كناشر، أدعو المؤلفين الشباب إلى التمعن في عقود النشر واستيعاب بنودها، والتفكير في صيغ مبتكرة تتيح لكتبهم الانتشار والحماية بنسخها الورقية والرقمية، فالمصنف الذي يُصان حقه ويُتاح للقراء قانونيًا لا شك في أنه يترك أثره البعيد. كما أن ما يتأسس على وعي المؤلف، يتعزز بمسؤولية القراء في جعل حماية الإبداع واحترام حقوقه طريقًا لازدهاره، وفي ذلك صون للمعرفة التي نحن جميعًا ورثة لها وأمناء على نقلها للأجيال القادمة.
744
| 08 سبتمبر 2025
ليس الزمن المقصود في استعارة هذا العنوان زمن بروست في «البحث عن الزمن الضائع»؛ فذاك زمن منسي يمكن أن يُستعاد بالسرد الروائي. أمّا زمننا فهو زمن مهدور في فراغ رقمي يبدّد كل قيمة حقيقية للوقت والإنتاجية. ومع ذلك، فإن هذا الزمن المستنزَف يكشف عن طاقة كامنة في الانتباه تتولّد حين يجتمع الناس حول إشارة أو كلمة واحدة، فيحوّلونها إلى حدث جماعي يترك أثرًا قيميًّا ومجتمعيًّا. ولعلّ أوضح تجلٍّ لهذه الطاقة الكامنة ما جسّدته حملة «دوام» التي أطلقتها قطر الخيرية مؤخرًا بهدف «التذكير بمفهوم المداومة على فعل الخير، ولفت الانتباه إلى أهمية الاستمرار في البذل والعطاء والإحسان». حيث لفتت الحملة أنظار المجتمع بكلمة واحدة ظهرت على اللوحات الإعلانية والمنصات الرقمية، فأيقظت فضول الناس وأطلقت سيلًا من التخمينات: أهو إعلان عن وظائف؟ أم مشروع جديد؟ أم مبادرة حكومية؟… حتى تحوّلت الكلمة البسيطة إلى لغز جماعي شدّ انتباه الجميع، وقدم نموذجًا عمليًا لما يُعرف بـ»اقتصاد الانتباه». ففي العالم الرقمي الحديث لم يعد الانتباه مجرد خاطر عابر، بل صار سلعة تُباع وتُشترى. وكل لحظة نمضيها أمام الشاشة تتحوّل، في إطار «اقتصاد الانتباه»، إلى قيمة تسويقية تُضاف إلى رصيد طرف آخر. ولهذا تنخرط المنصات الرقمية في سباق محموم تديره خوارزميات متطورة تلاحق آثارنا على الشبكة. وهكذا استحالت كل مشاهدة أو إعجاب أو متابعة، بصماتٍ تُلتقط لتتكرر وتُضخَّم، وتُبنى عليها حالة رقمية تُبقينا مشدودين ومُستنزَفين في آن واحد. وهذا الاستثمار في الانتباه ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى سبعينيات القرن العشرين، حين صاغ عالم النفس والاقتصاد الأمريكي هربرت سيمون مصطلح «اقتصاد الانتباه»، مشيرًا إلى أن وفرة المعلومات تُفضي بالضرورة إلى ندرة في الانتباه. ثم مع بزوغ الإنترنت وصولا إلى تصدر منصات التواصل المشهد الرقمي، غدا هذا المفهوم حجر الزاوية في فهم الطريقة التي تُدار بها المنصات الكبرى، وفي الكيفية التي تبني بها نماذجها الربحية على اجتذاب انتباه المستخدمين أكثر من اعتمادها على جودة المحتوى.وبترسّخ هذا المفهوم، لم يعد السؤال: ماذا أريد أن أتابع؟ بل: ماذا تريد الخوارزميات أن أتابع؟ ومن ثمّ لم يعد المحتوى يُنتَج من أجل الإفادة أو التثقيف وحدهما، بل ليجذب القارئ ويشدّ انتباهه أولًا. وهكذا وجد المستخدم نفسه وقد انضم، طواعيةً ومن حيث لا يدري، إلى عملية الإنتاج؛ فصارت أنشطته الرقمية تمدّ المنصات ببيانات تُستثمر لاحقًا في التنبؤ بسلوكه وتوجيهه، داخل منظومة بُرمجت لتجعله أسيرًا رقميًا في قبضة الخوارزميات. وثمن هذا الأسر يُدفع، إلى جانب الساعات المهدورة، من إنتاجيتنا وعلاقاتنا الاجتماعية. فنحن في غفلة ما دمنا لا ننتبه إلى استئثار المنصات الرقمية بالحصة الكبرى من زمننا؛ إذ كل لون يلمع، وكل إشعار يرنّ، وكل نغمة تقتحم صمتنا، ليست سوى شباك صغيرة تشدّنا إليها. لتزداد الكلفة مع تبعثر تركيزنا، وتراجع تحصيلنا، وتكاثر الأعراض المقلقة التي تغذّيها المقارنات المستمرة وصور حياة مثالية لا وجود لها إلا على الشاشات. يبقى اقتصاد الانتباه سيفًا ذا حدَّين؛ أحدهما يغرقنا إن انجرفنا وراء سطحياته، والآخر ينفعنا إذا وُجِّه بوعي وتربية إعلامية تُعلِّمنا كيف نصون انتباهنا ونستثمره فيما يفيد. وقد نصّ إعلان الدوحة للتربية الإعلامية والمعلوماتية منذ عام 2013 على هذا التوجّه، مؤكّدًا منذ وقت مبكر أن بناء الوعي الإعلامي يبدأ من المدرسة والجامعة، وأن ترسيخه يحتاج إلى سياسات عامة وشراكات بين الإعلام والمجتمع. غير أنّ هذه الجهود تظل ناقصة من دون ممارسة مجتمعية وثقافة إعلامية واعية، تصون انتباهنا من الهدر وتعيد إلينا زمام وقتنا.
204
| 01 سبتمبر 2025
تحدثتُ في المقالة السابقة عن التربية الإعلامية وأهمية وعي المتلقي في عصرٍ تتشابك فيه الأخبار مع الترفيه وتذوب فيه الحدود بين الإعلام المهني ومنصات التواصل. واليوم، ومع موجة التفاعل المجتمعي الرقمي تجاه بعض المؤثرين وناشطي التواصل، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم وأطلقوا حملات لإلغاء المتابعة، نقف أمام مشهدٍ يتحوّل فيه الوعيُ الإعلامي من فكرةٍ إلى سلوكٍ جماعي تتجلّى فيه مسؤولية المتلقي في ضبط الفضاء الرقمي. وهو مشهد يقدّم مثالًا حيًّا على ما ينبغي أن تثمره التربية الإعلامية؛ إذ لا يكتمل أثرها إلا بالانتقال من الوعي النظري إلى الممارسة العملية التي تجسّد موقف المجتمع وتحدد ما يقبله وما يرفضه، لتصوغ بذلك ملامح مجتمع رقمي واعٍ يرفض أن تتحول المنصات إلى فضاء فوضوي، أو أن تُصنع فيه نجومية زائفة تُضخَّم بلا استحقاق فتؤثر في أجيال كاملة بمضامين فارغة من القيم والمسؤولية. فلطالما كشفت التجربة أن قوة المؤثرين لا تقوم على حجم المتابعين، بل على الثقة التي يمنحها لهم الجمهور بمواصلة الدعم المتمثل في المشاهدة والتفاعل والمشاركة. ومتى تراجع هذا الدعم وتقلّصت الثقة، تهاوى حضور المؤثر سريعًا، إذ يبقى وجوده الرقمي مرهونا برأي عام يملك أن يرفع أو يخفض، ويضخّم أو يهمّش، وفق ما يراه أهلًا للبقاء. بيد أن الأشد وقعًا من صعود المؤثرين الزائفين أو أفولهم هو ما يترتب عليه من دينامية سيئة لا تفتأ تفرز شخصيات رقمية مصطنعة توحي بالنزاهة والنجاح، فيما يجد متابعوهم أنفسهم في اضطرابٍ كلما حاولوا مجاراة أنماط الحياة المفبركة على المنصات، على نحوٍ يُفضي تدريجيًا إلى انفصال ذواتهم عن واقعهم، ويجعلهم عرضةً لأزمات نفسية واجتماعية لا يمكن إغفال أثرها في الأفراد والمجتمع معًا. وإزاء هذا النمط من الارتهان للمؤثرين وما قد يخلّفه من آثار نفسية واجتماعية، تبرز التربية الإعلامية كضرورة وقائية؛ فهي، إلى جانب كشف التضليل والخداع البصري أو السرديات الزائفة، تمنح المتلقي قدرة على التحصين النفسي حتى لا يقع في فخ المقارنات المدمرة أو الانبهار بالأقنعة الرقمية. ومن يتربى على هذا الوعي يدرك أن بريق الصور زائل، وأن الصوت الأعلى ليس بالضرورة الأصدق، وأن اختياراته وتفاعلاته تسهم في تشكيل المشهد الرقمي جنبًا إلى جنب مع ما ينتجه صانعو المحتوى. ولعل اللافت في التفاعل الراهن ضد بعض الممارسات المسيئة أنه يكشف عن تحوّل تدريجي في سلوك الجمهور الرقمي، بالانتقال من حالة التلقي السلبي إلى مشاركة ناضجة تقوم على التعبير والفعل. فحين يقرر قطاع واسع من المتابعين إلغاء متابعة هذا المؤثر أو ذاك، فذلك رسالة واضحة بأن المنصات ليست فضاءً بلا حدود، بل مجالًا تضبطه قيم ومعايير يصوغها جمهورها بوعيه واختياراته. لقد انتقل المتلقي من شريكٍ يساهم في إنتاج الخطاب الرقمي عبر إعجاب أو مشاركة، إلى صاحب القرار في المتابعة أو الإلغاء، وإلى مانحٍ للشرعية الرمزية لمن يضيف قيمة، ونازعٍ لها ممّن يتوسّل الزيف والبريق. وفي مشهد رقمي متسارع التحوّل، تبرز التربية الإعلامية كضرورة قصوى، لتعزيز أخلاقيات الفضاء الرقمي وحمايته من الانزلاق إلى الفوضى. وما نشهده اليوم من حملات واعية لإلغاء متابعة بعض المؤثرين، ليس إلا مؤشراً على ثقافة رقمية تتشكّل وفق قيم المجتمع الرقمي نفسه، في زمن تشكل فيه المواطنة الواعية الرأسمال الحقيقي في سياسات «اقتصاد الانتباه».
462
| 25 أغسطس 2025
قبل خمسةٍ وخمسين عامًا، وفي زمن كانت فيه الشاشات العربية في طور التأسيس ووسائل الاتصال المرئي محدودة، وُلد تلفزيون قطر في الخامس عشر من أغسطس 1970، ليكون من أوائل التلفزيونات الخليجية والعربية. ومنذ انطلاقه بالأبيض والأسود ثم انتقاله إلى البث الملوّن عام 1974، غدا مرآةً لمسيرة الدولة ونهضتها الحديثة، شاهدًا على تحولاتها ومُسهمًا في ترسيخ قيم وهوية أهل قطر في وجدان أبنائهم. ولم يلبث قطار التطوير أن انطلق، حتى تعاقبت محطات تأسيسية في مسيرة تلفزيون قطر. ففي مطلع الثمانينيات افتُتح استديو الأعمال التلفزيونية (استديو 4) لمواكبة احتياجات الإنتاج المتزايدة، وتبعه إطلاق القناة الثانية (37 إنجليزي) لتخاطب الجمهور الناطق بالإنجليزية، وهي اليوم قيد التطوير لإعادة إطلاقها رقميًا. وفي نهاية التسعينيات انطلق البث الفضائي للقناة الأولى، فاتحًا المجال أمام الإعلام الوطني لإيصال رسالته إلى أبعد مدى. إذ سيجد تلفزيون قطر آفاقا أرحب للاضطلاع بتوثيق إنجازات الدولة، ونقل نبض المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية عبر محتوى إخباري وثقافي ودرامي متنوع، فضلًا عن تغطيته للمناسبات الكبرى وحضوره في المحافل الإقليمية والدولية. وعلى امتداد ذلك كله، أقام جسرًا بين الماضي والحاضر، وما فتئ يمهّد الطريق نحو آفاق أوسع من التطوير والمأسسة. وفي مسيرته الطويلة، كان تلفزيون قطر مدرسة لصقل الكفاءات الوطنية، فبرزت منها أسماء أصبحت رموزًا في الإعلام القطري والعربي. وقد ارتبط هذا الدور التكويني بنهج مؤسسي اعتمد التخصص والمهنية ضمن منظومة متكاملة حافظت على جودة المحتوى واستمرارية التطوير. وبهذا التلاقي بين صناعة الإنسان والبناء المؤسسي، رسّخ التلفزيون ثقافة مهنية وتحريرية هي اليوم مرجع للرسالة الإعلامية الوطنية. ثم جاء عام 2009 بمرحلة مؤسسية مفصلية، مع إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام، إذ ارتقى تأسيسها بالهيكل التقليدي للتلفزيون إلى تجربة مؤسسية حديثة ضمن منظومة تجمع الإذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية تحت مظلة واحدة. ومع هذا التحول، اكتسب التلفزيون قدرة تنظيمية وتقنية أوسع انعكست في تحديث البنية والبث عالي الوضوح، وتطوير استوديوهات الإنتاج ومنظومة النقل الخارجي، مما جعله أكثر جاهزية لمواكبة التحولات الإعلامية العالمية. فكان إطلاق منصة «تابع» عام 2019 تتويجًا لهذه الجاهزية المؤسسية، إذ أتاحت للمشاهد أرشيفًا رقميًا وإنتاجات متجددة، بقدر ما ترسخ اليوم حضور التلفزيون على المنصات الرقمية بتغطيات حية للأحداث الكبرى. واليوم، ومع تولي قيادات شبابية وطنية مواقع القرار، يتواصل مسار التطوير الذي عرفه تلفزيون قطر عبر عقوده، ليتخذ توجهه الحديث في تجديد الخريطة البرامجية وتعزيز صلته بجمهوره، على قاعدة من التكامل بين البث التقليدي والمنصات الرقمية. وبهذا الامتداد الاستراتيجي في تمكين القيادات الوطنية، يرسخ تلفزيون قطر موقعه باعتباره منصة وطنية جامعة، تثبت قدرتها الحيوية على تلبية التوجهات الوطنية في فضاء إعلامي متغير. لا تُقاس مسيرة تلفزيون قطر بعدد السنوات فحسب، بل بما تركته شاشته من أثر في القلوب والعقول، وبما حققته من حضور وطني وعربي وعالمي. ومع بلوغ مسيرته أكثر من نصف قرن، يواصل تلفزيون قطر أداء دوره الحضاري والثقافي، متطلعًا إلى مستقبل إعلامي متميز وراسخ القيم والجذور. ولا يسعنا، في استحضار هذه المسيرة، إلا تجديد الشكر والعرفان لكل من كان جزءًا منها، من العاملين السابقين الذين أسسوا القواعد، إلى الحاضرين اليوم أمام الشاشات وخلف الكواليس، ممن يواصلون حمل الرسالة بإخلاص وإبداع.
441
| 18 أغسطس 2025
في زمن أصبحت فيه الكاميرات حاضرة في كل يد، وأضحى الهاتف الذكي نافذة مفتوحة على العالم، لم يعد التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو مقتصرًا على المناسبات أو اللحظات الخاصة، بل أصبح جزءًا من الروتين اليومي. لكن وسط هذا الانفتاح الرقمي الذي لا يعرف حدوداً، لا تفتأ قضية خصوصية الأفراد، تطفو على السطح باعتبارها معضلة مجتمعية وجب التصدي لها نظرا لما يترتب عليها من إضرار بحقوق الغير، فليس كل ما يمكن تصويره أو مشاهدته يحق نشره وتداوله أمام الملأ. ولأن حرية استخدام التقنية لا يجوز أن تكون على حساب القيم والحقوق، جاء القانون القطري الجديد الذي صدّق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والمتمثل في القانون رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. مكرسًا بذلك مبدأ راسخًا مفاده أن كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية لا يخضعان للمزاج العام أو لهوس الشهرة، بل هما حقان أصيلان محميان بالقانون. وبحسب التعديل الجديد، فإن أي شخص يقوم بنشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لأفراد أثناء وجودهم في الأماكن العامة، دون علمهم أو موافقتهم، أو في غير الحالات المصرح بها قانونًا، عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية، يعرض نفسه لعقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، أو غرامة تصل إلى 100 ألف ريال قطري، أو الجمع بينهما. ولا تقف دلالة هذه العقوبات عند حدود الردع القانوني، بل تحمل في طياتها رسالة واضحة مفادها أن التكنولوجيا، مهما تطورت، لا ينبغي أن تكون أداة لانتهاك الحياة الخاصة أو تشويه سمعة الآخرين. فالصورة أو المقطع الذي قد تراه أنت طريفًا أو عابرًا، قد يضر بسمعة غيرك، أو يؤذيه نفسيًا، أو يضعه في موقف حرج أمام أسرته أو مجتمعه. وإذا كان النص القانوني يُعلي من شأن الكرامة والخصوصية، فإن الالتزام به لا يُعد امتثالًا قانونيًا فحسب، بل هو، في جوهره، تعبير عن إيمان راسخ بقيم نشأنا عليها، تقوم على احترام الإنسان وصون حدوده، في الواقع كما في الفضاء الرقمي. فالتشبث بهذه القيم هو ما يُسهم في بناء وعي جماعي يُرسخ ثقافة رقمية قائمة على الاحترام والمسؤولية. وكلما امتنعنا عن نشر ما قد يسيء إلى الآخرين، جسدنا تلك القيم التي تؤكد أن الكرامة الإنسانية أسمى من كل محتوى، وأرفع من كل تفاعل. وهذا الوعي لا يكتمل إلا حين يتحول إلى سلوك يُغرس في الناشئة، ويصير جزءًا من التربية اليومية في الأسرة والمجتمع. ولكي نكون جزءًا من هذا السلوك الإيجابي، لا بد أن نكون قدوة لأبنائنا، ونعلمهم أن حرية التعبير لا تعني التعدي على خصوصيات الآخرين، ولا تبرر المساس بحياتهم الخاصة. فكما نحرص على أن تُصان خصوصيتنا، ينبغي أن نمنح غيرنا الاحترام نفسه، سواء كانوا من معارفنا أو من أولئك الذين لا تربطنا بهم صلة. ولعلنا، في ضوء هذا القانون، نعيد النظر في علاقتنا بالفضاء الرقمي؛ فنراجع ما ننشره، ونتوقف عند كل مشاركة، مستحضرين كرامة الآخرين وحقهم في صون حياتهم الخاصة، باعتبارها ركيزة أخلاقية متجذرة في ثقافتنا. فإذا كانت الخصوصية قد أصبحت، في زمن الصورة والصوت والانتشار اللحظي، أكثر عرضة للانتهاك، فإن الوعي بأحكام القانون الجديد، والالتزام به من الجميع، هو ما يضمن فضاءً رقميًا آمنًا، تتحول فيه التقنية من أداة منفلتة إلى وسيلة للتواصل المسؤول، ومنصة تعكس وعينا وقيمنا التي نفاخر بها.
294
| 11 أغسطس 2025
لم يعد الإعلام مجرد نافذة نُطلّ منها على العالم، بل صار مرآة تُرينا صورًا نصدقها دون أن نُدرك أحيانًا مَن رسمها، وبأي غرض وصلت إلينا. وبين مشهدٍ دراميٍّ يبيع الحب كلغزٍ ساحر، وخبرٍ سياسي يتقنع بالحياد، وصورة تروّج لجسد مثالي أو منتج فاخر، يجد المتلقي نفسه محاطًا برسائل متوالدة، تتكاثر كل ساعة، وتُعيد تشكيل وعيه بهدوء. ووسط هذا الزخم، باتت أحكامنا ذاتها تحت الاختبار اليومي. فالعقل، مهما بدا يقظاً، لا ينجو من تأثير التكرار المستمر، والحذر وحده لا يحمي من اختلاط الحقيقة بما نراه على الشاشات. ولهذا، تبرز الحاجة إلى تربية إعلامية حقيقية، لا تُلقّننا الإجابات الجاهزة، بل تُدرّبنا على طرح الأسئلة: من ينتج هذه الرسالة؟ لأي غرض؟ وما الذي أُخفي خلف الكاميرا أو أسفل العنوان؟ والتربية الإعلامية، في جوهرها، مهارة حياة لا غنى عنها، تبدأ بالقدرة على رؤية ما وراء البريق، وتمتد إلى قراءة الرسائل الخفية التي تحملها الصور، وتتطور لتصبح فناً في تحليل الخطابات التي تتقنع بالموضوعية بينما تخفي مرجعياتها ومصالحها الحقيقية. ومن دون هذه التربية، نتحول إلى متلقين سلبيين، أشبه بشاشات تعكس ما يُعرض عليها دون أدنى تساؤل أو مقاومة. ومع صعود ما يُعرف بـ«المُنتِج/ المُستخدِم»، وهو الفرد الذي يستهلك الإعلام وينتجه في الوقت ذاته، انهارت الحدود التقليدية بين المتلقي وصانع الخطاب الإعلامي، فجميعنا الآن نشارك ونُعلّق، نصوّر وننشر، نحرّر ونُعيد الصياغة، على نحو يضاعف فيه هذا التداخل مسؤوليتنا، طالما لم نعد مجرد مستهلكين للخطاب، وإنما شركاء في نسج محتوى قد يشكل رؤى الآخرين ويؤثر في اختياراتهم. ولما كانت وظيفة الإعلام قد تجاوزت مجرد نقل الأحداث إلى صناعة المعنى ذاته، وبات القارئ يملك أدوات السرد التي لطالما اقترنت بالصحفي التقليدي، فإن الرسالة الإعلامية تحولت حتماً من أحادية الاتجاه إلى تفاعلية، ومن تعليمية إلى تشاركية. بيد أن هذا التحول، رغم إيجابيته، ينطوي على مفارقة خفية؛ فتعدد مصادر الرسائل لا يضمن بالضرورة تنوعاً حقيقياً في الرؤى، مادام مجرد صدى واحد يتردد بأصوات مختلفة. كلّ يوم، نستفيق على سيلٍ جارف من الأخبار والمحتوى الذي يغمر شاشات هواتفنا. وقد نتساءل: كيف نميّز الحقيقي من الزائف؟ ما المعيار الذي يجعلنا نُصدّق رواية ونُشكّك في أخرى؟ وإذا كانت الخلفية الثقافية تسهم في تشكيل قناعاتنا إزاء هذه التساؤلات، فإنّ التربية الإعلامية تُعدّ عاملًا حاسمًا في تحصين الوعي إزاء ما يشوب المشهد الرقمي من فوضى وتشويش. إن المحتوى الذي نتلقّاه ليس مجرد معلومة عابرة، بل هو بنية رمزية تُعيد تشكيل تصوّراتنا عن الواقع، والآخر، والذات. وهو محتوى قد يُسهم في ترسيخ الانحيازات أو في توسيع آفاق الفهم، تبعًا لقدرة المتلقّي على التمييز بين ما يُقدَّم على أنه معنى، وما يُوظَّف كأداة للتأثير أو التضليل. ومن هنا، تبرز قيمة إضافية للتربية الإعلامية، بوصفها أداة فعّالة في تفكيك وهم الحياد؛ إذ تُعلّمنا أن لكل وسيلة إعلامية أجندتها، ولكل رسالة سياقًا وغرضًا، وأن الصورة، وإن لم تكذب، فإنها لا تقول الحقيقة كاملة. في زمن يتداخل فيه الخبر مع الترفيه، وتتنكّر فيه الإعلانات في هيئة محتوى معرفي، تشتدّ الحاجة إلى وعي لا يُعلّب، ووجدان لا ينجرف مع الضجيج. وإذا كنا مع كل ضغطة على زر المشاركة، أو تعليق على منشور، أو تعبير عن رأي، نُمارس شكلًا من أشكال التأثير ونُعيد صياغة السرد، فإنه يصبح لزامًا علينا أن نُسائل أنفسنا: هل نفعل ذلك بوعي كامل ومسؤول؟ أم أننا نتشارك، في غفلة منا، روايات تخدم مصالح من يصيغونها، فنكون بذلك أدوات في إعادة إنتاج سردياتهم التي لا تعكس بالضرورة قناعاتنا الخاصة!
375
| 04 أغسطس 2025
تمر المؤسسات أحيانًا بمنعطفات إدارية عادية، تغييرات روتينية لا يتوقف عندها كثيرون. لكن ما شهدناه الأسبوع الماضي في تلفزيون قطر لم يكن كذلك. ما جرى لم يكن فقط إعادة توزيع للمهام أو تحديثًا في الهيكل، بل كان تعبيرًا عمليًا عن رؤية ناضجة، قررت فيها القيادة الإعلامية أن تُعيد الاعتبار لمفهوم «الفرصة المستحقة». فالتعيينات الأخيرة، من مساعد مدير التلفزيون، إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، لم تكن مجرد حركة تنظيمية. بل كانت تعبيرًا صادقًا عن إيمان مؤسسي وعميق بقدرات الكفاءات القطرية الشابة، وبأن هذه الطاقات لم تعُد في موقع الانتظار، بل في موقع الإنجاز. اللافت أن هذه التعيينات لم تعتمد على الشعارات، بل على معايير واضحة: الخبرة، التخصص، الجدية، والحضور المهني. وكل اسم أُعلن عنه جاء تتويجًا لسيرة عملية داخل المؤسسة، أو في مجال الإعلام الوطني، أثبت فيها صاحبه كفاءته، وقدرته على تحمل المسؤولية، ومهنيته في الأداء. وهذه، بلا شك، تحسب للقيادة الإعلامية في المؤسسة، التي اختارت أن تضع أصحاب العطاء في موقع القرار، وأن تبني المستقبل من داخل البيت المهني، لا من خارجه. وليس سرًا أن التلفزيون شهد منذ بداية هذا العام سلسلة من المؤشرات الإيجابية على مستوى الإنتاج والمحتوى. فتطبيق «تابع» الذي أعاد تقديم التلفزيون بطريقة عصرية ومتاحة، الإنتاجات الدرامية التي بدأت تستعيد مكانتها، التقارير الوثائقية التي تُقدم بجودة أعلى، والبرامج الجماهيرية التي باتت تمس واقع المشاهد وقضاياه اليومية. حتى فترات البث وخريطة البرامج شهدت إعادة هيكلة واضحة، تقوم على التنوع، والتجديد، والتوزيع الذكي للمحتوى. كل هذه المؤشرات، حين تقترن اليوم بقيادة جديدة شابة ذات اختصاص، تعني أن المؤسسة اختارت أن تنتقل من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة البناء الحقيقي. بناء إعلام وطني قادر على المنافسة، وعلى تمثيل صوت قطر بالصورة التي تليق بها. ومن المهم أن نُشير إلى أن هذه التغييرات لم تُحدث صدى داخليًا فقط، بل كانت محل ترحيب ورضى في الأوساط الإعلامية والمجتمعية. لأن الناس يعرفون هذه الأسماء، ويعرفون ما قدمته من عمل وجهد سابق، ويعلمون أن وصولها لمواقع القيادة لم يكن نتيجة فراغ، بل نتيجة مسار طويل من الالتزام والتدرج. وفي ظل التحولات التي تشهدها المؤسسات الإعلامية في المنطقة، والتطورات التي تواجه المشهد الإعلامي عموماً، يبرز تلفزيون قطر اليوم بتوجه نموذجي واضح نحو تعزيز المهنية، والتمكين المستحق. ولعلّ هذا التوجه بقدر ما يُقرأ في قائمة التعيينات، يتجلى كذلك في بصمته التي تترجمها الشاشة بلغة راسخة وحوار متفاعل مع تطلعات المجتمع، وقضاياه واهتماماته. والامتنان هنا واجب للقيادة الإعلامية التي أحسنت التقدير، والتي قررت أن تجدد من الداخل، وتعطي الكفاءات الفرصة لتقود. لأن هذا هو الإعلام الذي يصنع فرقًا: حين يُمنح القرار لمن يستحقه، ويُدار الحاضر برؤية تُدرك معنى التغيير، وأهمية الثقة. إن هذا التمكين هو ما يجعلنا نتابع اليوم تلفزيون قطر لا كمجرد شاشة، بل كمؤسسة في طور التحوّل الجاد. مؤسسة تستعيد عافيتها بثقة، وتبني مستقبلها بمن فيها، وتؤكد أن الإعلام الوطني حين يُدار بالكفاءة، يكون أكثر قدرة على الصمود وعلى الإقناع. لا شك بأن المستقبل يتّسع للخطوط الثانية من الطاقات الشابة، ممن يعملون في الظل وينتظرون فرصة مستحقة. فما حدث اليوم هو بداية لمسار طويل من التمكين، يفتح الباب أمام جيل جديد من الإعلاميين، ويؤكد أن المؤسسة تعرف أبناءها جيدًا وتمنحهم الثقة حين يحين وقتهم.
537
| 28 يوليو 2025
مساحة إعلانية

تهاوي هياكل الظلم والظلام واللاإنسانية أرثت عوالق ما...
14310
| 23 فبراير 2026

الواقع يفرض على أنديتنا الرياضية أن تمارس أنشطة...
2532
| 27 فبراير 2026

رمضان في الوعي الإسلامي ليس مجرد شهر عبادة...
2085
| 25 فبراير 2026

في رمضان، حين يخفُّ صخبُ العالم وتعلو همساتُ...
1002
| 26 فبراير 2026

جوهر رمضان هو العبادة، وتخليص النفس للطاعة، والتقرب...
783
| 25 فبراير 2026

رمضان يأتي ليطرح سؤالًا ثقيلًا: ماذا تبقّى منك؟...
777
| 27 فبراير 2026

يشهد قطاع التعليم تطورًا مستمرًا في أدواته وأنظمته،...
654
| 24 فبراير 2026

استكمالا لما ورد في (مقالنا) الذي نُشر تحت...
612
| 24 فبراير 2026

كشف التقرير السنوي لقطر للسياحة أن عدد الزوار...
606
| 22 فبراير 2026

لم أفهم معنى أن يكون للطفولة ظلٌّ يحرسها...
576
| 23 فبراير 2026

لئن كان صيام رمضان فريضة دينية، إلا أن...
543
| 22 فبراير 2026

لم تكن المساجد في صدر الإسلام مجرد مساحةٍ...
537
| 26 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل