رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يستيقظ الجسد في العصر الرقمي داخل شبكة دائمة من القياس والمراقبة. فمع أول نظرة إلى "الموبايل"، تكون الخوارزميات قد قرأت إيقاع القلب، وجودة النوم، ومؤشرات الإجهاد والتنفس، وقدّمت تفسيرات أولية لما يجري في الداخل قبل أن يتشكل الإحساس ذاته. العناية بالصحة بهذا المعنى لم تعد فعلاً مؤجلاً إلى لحظة المرض، بل ممارسة يومية تُدار عبر شاشات وأجهزة محمولة تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وجسده. يقود هذا التحول تسارعٌ لافت في تطوير الأجهزة الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد تكتفي بتتبع النشاط البدني، بل باتت تقترب من عتبة التشخيص الطبي. فالساعات الذكية، والمجسات القابلة للارتداء، والأجهزة المنزلية المتصلة، تحولت إلى أدوات ترصد المؤشرات الحيوية بشكل مستمر، وتحوّل الجسد إلى مصدر بيانات متدفقة قابلة للتحليل والتنبؤ. ويُسوَّق هذا المسار بوصفه انتقالاً من طبّ يعالج المرض بعد وقوعه، إلى طبّ يستبق الخطر قبل أن يتجسد. غير أن ما يجري لا يمكن اختزاله في تطور تقني معزول، بل يرتبط باستثمار اقتصادي عالمي واسع النطاق. فقد قُدِّر حجم سوق الأجهزة الطبية القابلة للارتداء بنحو 40 إلى 45 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بأن يتجاوز 160 مليار دولار مع نهاية العقد الحالي. أما سوق التكنولوجيا القابلة للارتداء عموماً، فيتجه ليبلغ مئات المليارات خلال السنوات المقبلة. هذه الأرقام لا تعكس فقط طلب المستهلكين، بل تعبّر عن اندفاع استثماري كثيف من شركات التكنولوجيا الكبرى وصناديق رأس المال نحو قطاع يُنظر إليه بوصفه أحد أعمدة اقتصاد المستقبل. لكن كلما ارتفع منسوب الاستثمار، ازدادت حساسية الأسئلة المؤجلة. فالأجهزة الاستهلاكية، مهما بلغت دقتها، لا تعمل في فراغ طبي محايد، بل ضمن منظومات خوارزمية تصممها شركات ذات مصالح واضحة. وهنا يصبح الخط الفاصل بين المعلومة الصحية الإرشادية والقرار الطبي خطاً هشاً؛ فالاطمئنان الزائف الناتج عن قراءة غير دقيقة قد يكون خطيراً بقدر الذعر الناتج عن إنذار مبالغ فيه. هذا الأمر لا يتوقف عند دقة القياس، بل يمتد إلى ملكية البيانات. فالمعلومات الصحية، وهي من أكثر أنواع البيانات خصوصية، باتت تُجمع خارج المؤسسات الطبية التقليدية، وتُخزن في منصات رقمية عابرة للحدود. وفي ظل تفاوت الأطر التنظيمية بين الدول، يبرز خطر تحوّل هذه البيانات إلى مورد تجاري، أو إلى أداة غير مباشرة للفرز والتمييز، سواء في التأمين أو التوظيف أو تقييم ما بات يُعرف بـ"الجدارة الصحية" للأفراد. إن هذا الواقع يكشف عن شكل جديد من التفاوت الصحي الرقمي. فالوصول إلى هذه التقنيات لا يتوزع بعدالة، بل يرتبط بالقدرة المادية والبنية التحتية الرقمية. ومع غياب سياسات إدماج واضحة، قد تتحول الصحة الرقمية من أداة لتقليص الفجوات الصحية إلى عامل إضافي لتكريسها، حيث يتمتع البعض برفاهية المراقبة والاستباق، بينما يبقى آخرون خارج هذا النظام أو عرضة لنسخه الأقل أماناً. والمفارقة أن التكنولوجيا التي تُسوّق بوصفها وسيلة لتمكين الفرد من إدارة صحته، قد تُنتج شكلاً جديداً من القلق الدائم. فالمراقبة المستمرة للجسد قد تعزز الوعي، لكنها قد تخلق أيضاً علاقة مرضية مع الأرقام، حيث يتحول كل تغير طفيف إلى مصدر توتر، ويغدو «الطبيعي» معياراً رقمياً صارماً لا يراعي الفروق الإنسانية. في جوهر هذا التحوّل، لا تكمن المشكلة في التكنولوجيا ذاتها، بل في غياب النقاش العام حول شروط استخدامها وحدودها. فالتقدم التقني سبق النقاش الأخلاقي، والاستثمار سبق التنظيم، والتجربة سبقت المساءلة. وهذا الخلل هو ما يجعل الصحة الرقمية ساحة مفتوحة للصراع بين منطق الرعاية ومنطق السوق. تتجه التكنولوجيا اليوم إلى إعادة تشكيل علاقتنا بالحياة نفسها، لا بوصفها أدوات نستخدمها، بل منظومات تُعيد تعريف ما نراه طبيعياً ومقبولاً وآمناً. فالأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تكتفي بتوسيع قدراتنا، بل تتسلل إلى قراراتنا اليومية، وتعيد رسم حدود الجسد والصحة والخصوصية. وفي هذا المسار، لا تطرح شركات التكنولوجيا حلولاً فحسب، بل تفرض رؤيتها لما ينبغي أن تكون عليه الحياة "الأفضل". غير أن هذا التحول ليس بريئاً ولا محايداً. فخلف واجهة الابتكار، تجري مقامرة كبرى على بيانات الأفراد، وعلى استقلال قراراتهم، وعلى قدرة المجتمعات على ضبط هذا الزحف التقني قبل أن يتحول إلى أمر واقع لا رجعة فيه. والسؤال لم يعد إن كانت هذه التكنولوجيا قادمة، بل من يملك حق توجيهها، ومن يدفع ثمن أخطائها، ومن يحاسب حين تختلط الرعاية بالهيمنة، والتقدم بالمخاطرة!
438
| 10 فبراير 2026
ماذا لو كانت أثمن فضائلنا الإنسانية هي نفسها أخطر نقاط ضعفنا؟ في المخيال الأخلاقي تبدو الثقة قيمةً خالصة لا يطولها الشك، لكن التجربة الحديثة- خصوصًا في زمن الفضاء السيبراني والتحولات الرقمية- تكشف أن الثقة قد تكون أيضًا نقطة اختراق. ففي هذا المجال لا تُعامل الثقة بوصفها فضيلةً إنسانية، بل بوصفها متغيرًا يرفع مستوى المخاطر إذا مُنح بلا ضوابط. من هنا ظهر مبدأ «الثقة الصفرية» (Zero Trust) بوصفه إحدى أكثر فلسفات الحماية صرامة وواقعية، ويمكن تلخيصه في قاعدة واضحة: لا تمنح الثقة مسبقًا… تحقّق دائمًا. الملفت أن ما يثير الانتباه في هذا النموذج أنه لا يقتصر على التقنية بقدر ما يفتح نافذة لفهم أعمق لعلاقاتنا الاجتماعية التي أصبحت تتشكل اليوم داخل بيئة مليئة بالواجهات المصقولة والانطباعات السريعة، حيث يبدو القرب سهلًا لكنه ليس دائمًا آمنًا. كما هو معروف لا يكافئ النظام الرقمي حسن النية، ولا يراهن على الانطباع الجيد، لأنه يعلم أن الخطر لا يأتي دائمًا بوجه عدائي واضح، وأن الاختراق قد يُنفَّذ عبر لغة ودودة، أو هوية منتحلة، أو صلاحية مُنحت أكثر مما ينبغي. لذلك لا تُبنى الثقة في المنظومات الحديثة على لحظة قبول أولى ثم استرخاء دائم، بل على منطق مختلف: الهوية تُثبت، والصلاحيات تُستحق، والوصول يُمنح بقدر الحاجة لا بقدر الألفة. وهذه الفكرة—على قسوتها الظاهرية— تخفي حكمة عميقة؛ لأنها تعيد تعريف الثقة باعتبارها عملية تُدار، لا هبة تُقدَّم، وتربطها بالسلوك والاستمرارية لا بالاندفاع العاطفي. عند إسقاط هذه المقاربة على العلاقات الإنسانية، يظهر أن المشكلة ليست في الثقة بذاتها بل في طريقة توزيعها. لقد أصبحنا نعيش زمنًا لم يعد فيه التراكم البطيء شرطًا للعلاقة، بل صارت العلاقات تُستهلك بسرعة، وتُصنع فيها الألفة أحيانًا خلال ساعات كما لو أنها تاريخ طويل. صرنا نلتقي بالآخر لا كما هو، بل كما يريد أن يظهر؛ نلتقي بالصياغة لا بالجوهر، وبالقول لا بما يثبت، وبالواجهة أكثر من الحقيقة. ننجذب للوضوح السريع، وللقرب السهل، وللتوافق الذي يبدو قدرًا، ثم نكتشف لاحقًا أن بعض ما حسبناه قدرًا لم يكن إلا تمثيلًا متقنًا للحظة قصيرة، أو استجابة محسوبة لحاجة عابرة. هنا يصبح السؤال جوهريًا: هل نحسن إدارة الثقة؟ أم أننا نوزّعها كما لو أنها لا تُكلّف شيئًا؟ في النظم الرقمية، الخطر لا يتوقف عند بوابة الدخول، ولذلك لا تكتفي الثقة الصفرية بفكرة «التحقق مرة واحدة»، لأن المخترق قد يمرّ بسلام، وقد ينتحل العدو هوية الصديق، وقد يتحول الداخل ذاته إلى تهديد إذا تبدّلت نواياه أو تبدلت أدواته. ولهذا يقوم النموذج على التحقق المستمر لا بسبب الهوس، بل بسبب إدراك أن الخطأ في الثقة ليس خطأ بسيطًا، بل خلل قد يجرّ وراءه انهيارًا في كامل البنية. تأسيسًا على ذلك، يبدو ليس من الصعب رؤية النظير الاجتماعي لهذا المنطق؛ فنحن أيضًا نمتلك «بيانات حساسة» لا تظهر على شاشة: أسرارنا، وذاكرتنا، ومساحاتنا الهشة، والندوب التي نخفيها خلف سلوك طبيعي. ونحن أيضًا نمنح صلاحيات دون قصد: صلاحية الدخول إلى يومنا، وإلى أعماقنا، وإلى تفاصيل كنا نظن أنها لا تُقال إلا لمن يستحق. غير أن ما يحدث كثيرًا هو أننا نمنح ذلك لمن يتقن الحضور لا لمن يتقن الوفاء، لمن يجيد اللغة لا لمن يملك اتساقًا أخلاقيًا، لمن يمنح شعورًا سريعًا بالطمأنينة لا لمن يستطيع حمل مسؤولية القرب. والخديعة في العلاقات لا تأتي دائمًا على هيئة شرّ صريح كي يسهل اكتشافها. أحيانًا تأتي بوجه لطيف وبحضور دافئ وبكلمات تعرف كيف تُربّت على الفراغ. وأحيانًا لا يكون الخطر شخصًا سيئًا بقدر ما يكون شخصًا هشًا: متقلبًا، اندفاعيًا، يَعِد كثيرًا ويثبت قليلًا، يمنح دفئًا كبيرًا ثم ينسحب بلا تفسير. وفي الحالتين النتيجة واحدة: ثقة تُمنح بجرعة كاملة، ثم تُسحب منك كأنها لم تكن، تاركةً أثرًا أقرب إلى الاختراق منه إلى الخيبة العادية، لأن ما يُنهك الإنسان هنا ليس فقط الانسحاب، بل فكرة أنه سمح لشخص ما بالدخول إلى مناطق لا يجوز أن تُفتح إلا بتدرج. لهذا لا يبدو «الشك» في هذا السياق رذيلة كما اعتدنا تصويره، بل قد يكون سلوكًا وقائيًا بالغ العقلانية. ليس شكًا عدائيًا يكره الناس ويُحاكمهم مسبقًا، بل شكًا واعيًا يعرف أن القرب لا يعني الأمان، وأن الانسجام لا يعني الأخلاق، وأن الكلام الجميل لا يساوي شيئًا إن لم يثبت في المواقف. فالاختبار الحقيقي للإنسان لا يظهر في لحظات المزاج الجيد، بل في لحظات الاختلاف والضغط والغياب، وفي قدرته على حفظ الود حين تتراجع المصلحة وحين يصبح الالتزام مكلفًا. ومن هنا لا تكون الفكرة أن نعيش بمنطق الارتياب الدائم، بل أن نتعلم بناء الثقة تدريجيًا. أن لا نعطي «صلاحيات كاملة» من اللقاء الأول، وأن لا نفتح أبوابنا النفسية لمن يتقن الدخول السريع، وأن نفهم أن العلاقة ليست قرارًا عاطفيًا لحظيًا بل مسارًا يحتاج إلى تراكم أدلة. تمامًا كما تُدار الصلاحيات في الأمن السيبراني وفق مبدأ «أقل قدر من الامتياز « (Least Privilege)، يمكن للعلاقات أيضًا أن تُدار بذكاء مشابه: ليس لأننا نختزل البشر إلى ملفات، بل لأننا نحمي أنفسنا من الاستنزاف. فليس كل من اقترب يستحق أن يعرف أكثر، وليس كل من ابتسم يستحق أن نراهن عليه، وليس كل من شاركنا حديثًا طويلًا يستحق أن يمسك تفصيلًا هشًا من حياتنا. الخلاصة أن «العقل السيبراني» لم يعد مفهومًا تقنيًا معزولًا، بل أداة معرفية لفهم سلوكنا الاجتماعي في زمن التلاعب والانطباعات السريعة. ففي السيبرانية، الثقة العمياء ليست فضيلة بل سطح هجوم واختراق مؤجل، وفي العلاقات، الثقة المجانية ليست طيبة قلب بقدر ما قد تكون ثغرة نفسية تُكلّف صاحبها كثيرًا. إن المطلوب ليس إلغاء الثقة، بل حوكمتها: أن يصبح القرب مثل الوصول داخل النظام؛ هوية تُثبت، وسلوك يُختبر، وصلاحيات تُمنح بقدر الحاجة. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يبقى إنسانًا دون أن يتحول قلبه إلى مساحة مفتوحة لكل عابر، وأن يحافظ على دفئه دون أن يدفع ثمنه استنزافًا متكررًا.
165
| 02 فبراير 2026
ماذا لو كانت أثمن فضائلنا الإنسانية هي نفسها أخطر نقاط ضعفنا؟ في المخيال الأخلاقي تبدو الثقة قيمةً خالصة لا يطالها الشك، لكن التجربة الحديثة - خصوصًا في زمن الفضاء السيبراني والتحولات الرقمية - تكشف أن الثقة قد تكون أيضًا نقطة اختراق. ففي هذا المجال لا تُعامل الثقة بوصفها فضيلةً إنسانية، بل بوصفها متغيرًا يرفع مستوى المخاطر إذا مُنح بلا ضوابط. من هنا ظهر مبدأ «الثقة الصفرية» (Zero Trust) بوصفه إحدى أكثر فلسفات الحماية صرامة وواقعية، ويمكن تلخيصه في قاعدة واضحة: لا تمنح الثقة مسبقًا… تحقّق دائمًا. الملفت أن ما يثير الانتباه في هذا النموذج أنه لا يقتصر على التقنية بقدر ما يفتح نافذة لفهم أعمق لعلاقاتنا الاجتماعية التي أصبحت تتشكل اليوم داخل بيئة مليئة بالواجهات المصقولة والانطباعات السريعة، حيث يبدو القرب سهلًا لكنه ليس دائمًا آمنًا. كما هو معروف لا يكافئ النظام الرقمي حسن النية، ولا يراهن على الانطباع الجيد، لأنه يعلم أن الخطر لا يأتي دائمًا بوجه عدائي واضح، وأن الاختراق قد يُنفَّذ عبر لغة ودودة، أو هوية منتحلة، أو صلاحية مُنحت أكثر مما ينبغي. لذلك لا تُبنى الثقة في المنظومات الحديثة على لحظة قبول أولى ثم استرخاء دائم، بل على منطق مختلف: الهوية تُثبت، والصلاحيات تُستحق، والوصول يُمنح بقدر الحاجة لا بقدر الألفة. وهذه الفكرة - على قسوتها الظاهرية - تخفي حكمة عميقة؛ لأنها تعيد تعريف الثقة باعتبارها عملية تُدار، لا هبة تُقدَّم، وتربطها بالسلوك والاستمرارية لا بالاندفاع العاطفي. عند إسقاط هذه المقاربة على العلاقات الإنسانية، يظهر أن المشكلة ليست في الثقة بذاتها بل في طريقة توزيعها. لقد أصبحنا نعيش زمنًا لم يعد فيه التراكم البطيء شرطًا للعلاقة، بل صارت العلاقات تُستهلك بسرعة، وتُصنع فيها الألفة أحيانًا خلال ساعات كما لو أنها تاريخ طويل. صرنا نلتقي بالآخر لا كما هو، بل كما يريد أن يظهر؛ نلتقي بالصياغة لا بالجوهر، وبالقول لا بما يثبت، وبالواجهة أكثر من الحقيقة. ننجذب للوضوح السريع، وللقرب السهل، وللتوافق الذي يبدو قدرًا، ثم نكتشف لاحقًا أن بعض ما حسبناه قدرًا لم يكن إلا تمثيلًا متقنًا للحظة قصيرة، أو استجابة محسوبة لحاجة عابرة. هنا يصبح السؤال جوهريًا: هل نحسن إدارة الثقة؟ أم أننا نوزّعها كما لو أنها لا تُكلّف شيئًا؟ في النظم الرقمية، الخطر لا يتوقف عند بوابة الدخول، ولذلك لا تكتفي الثقة الصفرية بفكرة «التحقق مرة واحدة»، لأن المخترق قد يمرّ بسلام، وقد ينتحل الصديق هوية الصديق، وقد يتحول الداخل ذاته إلى تهديد إذا تبدّلت نواياه أو تبدلت أدواته. ولهذا يقوم النموذج على التحقق المستمر لا بسبب الهوس، بل بسبب إدراك أن الخطأ في الثقة ليس خطأ بسيطًا، بل خلل قد يجرّ وراءه انهيارًا في كامل البنية. تأسيسًا على ذلك، يبدو ليس من الصعب رؤية النظير الاجتماعي لهذا المنطق؛ فنحن أيضًا نمتلك «بيانات حساسة» لا تظهر على شاشة: أسرارنا، وذاكرتنا، ومساحاتنا الهشة، والندوب التي نخفيها خلف سلوك طبيعي. ونحن أيضًا نمنح صلاحيات دون قصد: صلاحية الدخول إلى يومنا، وإلى أعماقنا، وإلى تفاصيل كنا نظن أنها لا تُقال إلا لمن يستحق. غير أن ما يحدث كثيرًا هو أننا نمنح ذلك لمن يتقن الحضور لا لمن يتقن الوفاء، لمن يجيد اللغة لا لمن يملك اتساقًا أخلاقيًا، لمن يمنح شعورًا سريعًا بالطمأنينة لا لمن يستطيع حمل مسؤولية القرب. والخديعة في العلاقات لا تأتي دائمًا على هيئة شرّ صريح كي يسهل اكتشافها. أحيانًا تأتي بوجه لطيف وبحضور دافئ وبكلمات تعرف كيف تُربّت على الفراغ. وأحيانًا لا يكون الخطر شخصًا سيئًا بقدر ما يكون شخصًا هشًا: متقلبًا، اندفاعيًا، يَعِد كثيرًا ويثبت قليلًا، يمنح دفئًا كبيرًا ثم ينسحب بلا تفسير. وفي الحالتين النتيجة واحدة: ثقة تُمنح بجرعة كاملة، ثم تُسحب منك كأنها لم تكن، تاركةً أثرًا أقرب إلى الاختراق منه إلى الخيبة العادية، لأن ما يُنهك الإنسان هنا ليس فقط الانسحاب، بل فكرة أنه سمح لشخص ما بالدخول إلى مناطق لا يجوز أن تُفتح إلا بتدرج. لهذا لا يبدو «الشك» في هذا السياق رذيلة كما اعتدنا تصويره، بل قد يكون سلوكًا وقائيًا بالغ العقلانية. ليس شكًا عدائيًا يكره الناس ويُحاكمهم مسبقًا، بل شكًا واعيًا يعرف أن القرب لا يعني الأمان، وأن الانسجام لا يعني الأخلاق، وأن الكلام الجميل لا يساوي شيئًا إن لم يثبت في المواقف. فالاختبار الحقيقي للإنسان لا يظهر في لحظات المزاج الجيد، بل في لحظات الاختلاف والضغط والغياب، وفي قدرته على حفظ الود حين تتراجع المصلحة وحين يصبح الالتزام مكلفًا. ومن هنا لا تكون الفكرة أن نعيش بمنطق الارتياب الدائم، بل أن نتعلم بناء الثقة تدريجيًا. أن لا نعطي «صلاحيات كاملة» من اللقاء الأول، وأن لا نفتح أبوابنا النفسية لمن يتقن الدخول السريع، وأن نفهم أن العلاقة ليست قرارًا عاطفيًا لحظيًا بل مسارًا يحتاج إلى تراكم أدلة. تمامًا كما تُدار الصلاحيات في الأمن السيبراني وفق مبدأ «أقل قدر من الامتياز» (Least Privilege)، يمكن للعلاقات أيضًا أن تُدار بذكاء مشابه: ليس لأننا نختزل البشر إلى ملفات، بل لأننا نحمي أنفسنا من الاستنزاف. فليس كل من اقترب يستحق أن يعرف أكثر، وليس كل من ابتسم يستحق أن نراهن عليه، وليس كل من شاركنا حديثًا طويلًا يستحق أن يمسك تفصيلًا هشًا من حياتنا. الخلاصة أن «العقل السيبراني» لم يعد مفهومًا تقنيًا معزولًا، بل أداة معرفية لفهم سلوكنا الاجتماعي في زمن التلاعب والانطباعات السريعة. ففي السيبرانية، الثقة العمياء ليست فضيلة بل سطح هجوم واختراق مؤجل، وفي العلاقات، الثقة المجانية ليست طيبة قلب بقدر ما قد تكون ثغرة نفسية تُكلّف صاحبها كثيرًا. إن المطلوب ليس إلغاء الثقة، بل حوكمتها: أن يصبح القرب مثل الوصول داخل النظام؛ هوية تُثبت، وسلوك يُختبر، وصلاحيات تُمنح بقدر الحاجة. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يبقى إنسانًا دون أن يتحول قلبه إلى مساحة مفتوحة لكل عابر، وأن يحافظ على دفئه دون أن يدفع ثمنه استنزافًا متكررًا.
171
| 27 يناير 2026
لم تكن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته مجرّد حدث أمني صادم أو اقتحام عسكري تقليدي، بل مثّلت ذروة نموذج جديد من العمليات المركّبة، حيث يُحسم الصراع قبل أن يبدأ فعليًا، وتُشلّ الدولة من داخل بنيتها العصبية لا عبر تدمير جيوشها أو احتلال أراضيها. فاللافت في العملية لم يكن سرعتها أو جرأتها، بل الصمت الذي أحاط بها: غياب أي ردّ فعل فعَّال، وتعطّل منظومات الإنذار المبكر، وانعدام أي استجابة جوية أو اتصالية ذات معنى في لحظة يفترض أنها الأكثر حساسية في حياة أي نظام سياسي. هذا الصمت لا يمكن تفسيره بوصفه فشلًا تكتيكيًا عابرًا، بل يُشير إلى حالة تعطيل شبه كامل للفضاء الكهرومغناطيسي للدولة. عمليًا، كانت فنزويلا في تلك اللحظة «خارج الخدمة». فالدولة الحديثة لا تُهزم فقط عندما تُدمَّر دباباتها أو تُقصف قواعدها، بل عندما تُقطع أعصابها: شبكات الاتصال، منظومات القيادة والسيطرة، وقدرتها على إدراك ما يجري واتخاذ القرار في الزمن المناسب. هنا بالضبط تتقدّم الحرب السيبرانية والحرب الإلكترونية من دور المساند إلى موقع الفاعل الرئيسي. في قلب هذا المشهد برز الدور الحاسم لطائرات الحرب الإلكترونية الأمريكية EA-18G Growler، وهي ليست مجرد منصة تشويش تعمل في هامش المعركة، بل تجسيد عملي لفلسفة قتالية كاملة تُعيد تعريف معنى السيطرة الجوية. فهذه الطائرات لا تُصمَّم لإسقاط الأهداف بقدر ما تُصمَّم لإسقاط «الإدراك» ذاته: إدراك الخطر، إدراك الاتجاه، وإدراك لحظة القرار. إنها تستهدف العقل قبل السلاح، والوعي قبل القدرة النارية، عبر تحويل ساحة القتال إلى بيئة مشوشة لا يمكن الوثوق بمعطياتها. من خلال أنظمة متقدمة لرصد وتحليل الإشعاعات الرادارية والاتصالات العسكرية، تستطيع هذه الطائرات بناء ما يسمى «خريطة إدراك» للخصم في الزمن الحقيقي، ثم إغراق المجال الجوي بطبقات كثيفة من التشويش الذكي والموجّه. وبهذا، لا تُعطَّل الرادارات فحسب، بل يُعاد تشكيل واقعها الإدراكي، بحيث تفقد القدرة على التمييز بين الهدف الحقيقي والضوضاء المصطنعة، وبين التهديد الفعلي والإشارة الخادعة. في مثل هذا السياق، تتحول الرادارات من أدوات كشف وإنذار إلى مصادر معلومات مضللة، بل وخطرة، لأنها تدفع متخذي القرار إلى قراءات خاطئة في لحظات حرجة. العملية تكشف تحوّلًا جوهريًا في منطق القوة. فالسيطرة لم تعد تعني فرض الهيمنة على المجال الجغرافي، بل الهيمنة على المجال الإدراكي. وما إن يُفقد النظام قدرته على الفهم والتمييز، حتى تصبح أقوى منظومات الدفاع الجوي بلا قيمة عملياتية، لأن المشكلة لم تعد في السلاح، بل في العلاقة بين المعلومة والقرار. في هذه اللحظة، لا يحتاج الخصم إلى معركة طويلة أو استنزاف تقليدي؛ تكفي ضربة صامتة، مركّزة، وفي التوقيت الصحيح، لكسر الإرادة قبل أن تتشكل المعركة. ضمن هذا السياق، تبرز الحرب الإلكترونية بوصفها الشرط المسبق لأي تحرّك ميداني ناجح. تعطيل الرادارات، تشويش الاتصالات، وإرباك منظومات القيادة والسيطرة، كلها ليست أهدافًا ثانوية، بل جوهر العملية نفسها. فحين تُعطَّل قدرة الدولة على التنسيق واتخاذ القرار، تتحول الوحدات العسكرية إلى جزر معزولة، وتصبح القيادة بلا أدوات، والسلطة بلا سيطرة فعلية على الأرض. ما جرى في فنزويلا، إذًا، لا ينبغي قراءته كحادثة أمنية استثنائية أو رسالة سياسية محدودة، بل كنموذج مكثّف لحروب السيادة في العصر السيبراني. نحن أمام نمط من الصراع تُدار فيه المعارك من خلف الشاشات، وتُحسم في الفضاء غير المرئي، حيث يصبح التحكم في الفضاء الكهرومغناطيسي شرطًا لممارسة السيادة ذاتها، لا مجرد ملحق تقني بها. في هذا العالم، تُكسر الدول لا عندما تُهزم جيوشها، بل عندما تُشلّ قدرتها على الإدراك، ويُفرض عليها الواقع قبل أن تدرك أنها دخلت الحرب أصلًا.
273
| 11 يناير 2026
بات الأمن السيبراني اليوم أحد المفاتيح المركزية لفهم تحوّلات الصراع الدولي وإعادة تشكيل مفاهيم القوة والردع في النظام العالمي المعاصر. وقد تجلّى هذا التحوّل بوضوح خلال «الأسبوع السيبراني 2025» أو ما يسمى بـ «Cyber Week 2025»، الذي انعقد بين 8 و11 ديسمبر في جامعة تل أبيب، حيث تحوّل المؤتمر إلى منصة لإطلاق خطاب أمني إسرائيلي صريح يعيد تعريف طبيعة الحرب وحدودها. فبحضور آلاف الخبراء وصنّاع القرار من أكثر من مائة دولة – حسب ما جرى نشره إعلاميًا - قُدِّمت الحروب القادمة بوصفها صراعات تُخاض داخل الشبكات والبنى التحتية والبيانات، لا على خطوط تماس تقليدية، وباعتبار أن شلّ الدول من الداخل، وتعطيل وظائفها الحيوية، وفرض الوقائع السياسية، يمكن أن يتحقق من دون إطلاق رصاصة واحدة. في هذا السياق، لم تعد «الحرب السيبرانية» توصيفًا مجازيًا أو مفهومًا نظريًا، بل تحوّلت إلى عقيدة صراع مكتملة تُعاد على أساسها صياغة مفاهيم الردع والدفاع والأمن القومي. هذا الخطاب لا يمكن فصله عن المسار الذي قطعه الأسبوع السيبراني على مدى خمسة عشر عامًا، حيث تحوّل تدريجيًا من مؤتمر أكاديمي– تقني إلى منصة إستراتيجية عابرة للقطاعات، تُعرض فيها الرؤية الإسرائيلية للأمن القومي في عصر الرقمنة. فالمؤتمر لم يعد يكتفي بتبادل الخبرات التقنية أو استعراض الابتكارات، بل بات مساحة لصياغة مفاهيم الحرب والردع والدفاع الوطني في عالم تتداخل فيه التكنولوجيا مع السياسة والاقتصاد والإعلام. يُقام الأسبوع السيبراني بشراكة مؤسسية واسعة تجمع بين مراكز بحثية أكاديمية وهيئات رسمية إسرائيلية، ما يعكس طبيعة الرسالة التي يسعى إلى ترسيخها: الأمن السيبراني ليس مسألة تقنية منفصلة، بل ركيزة مركزية من ركائز الأمن القومي وإدارة الدولة الحديثة. وفي هذا الإطار، جرى تقديم الفضاء السيبراني بوصفه ساحة الصراع المقبلة، حيث تتحول البنية التحتية الرقمية – من كهرباء ومياه واتصالات ونظم معلومات – إلى خط المواجهة الأول. في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر 2025، طُرح تصور بالغ الدلالة لمستقبل الحروب، يقوم على فكرة «الحرب بلا رصاص». ووفق هذا التصور، لم تعد الحرب تُخاض بالضرورة عبر الجيوش والدبابات، بل يمكن أن تبدأ وتنتهي في الفضاء السيبراني، عبر تعطيل الوظائف الحيوية للدولة ودفعها إلى الشلل الوظيفي والسياسي بأدوات رقمية منخفضة الكلفة وعالية التأثير. هذا التحول لا يعني إلغاء القوة العسكرية التقليدية، بل إزاحتها عن موقع الحسم النهائي لصالح أدوات رقمية قادرة على تحقيق النتائج ذاتها، وربما بفعالية أكبر. دلالة هذا الطرح تتجاوز توصيف التهديد، لتصل إلى إعادة تعريف معنى الحرب نفسه. فبدل الحديث عن التكامل بين الضربات العسكرية والهجمات السيبرانية، برزت قناعة متزايدة بأن نتائج الصراعات المقبلة قد تُحسم عبر الهجوم السيبراني وحده. ومن هنا جاءت الدعوات المتكررة خلال المؤتمر إلى بناء «شبكة دفاع وطنية متكاملة» تتجاوز منطق الاستجابات القطاعية، وتعامل الدولة كوحدة رقمية واحدة، لا كسلسلة مؤسسات منفصلة. ضمن هذا السياق، برز مشروع «القبة السيبرانية» (Cyber Dome) بوصفه أحد التعبيرات العملية عن هذا التحول، إذ يسعى إلى نقل منطق الدفاع الجوي – القائم على الاعتراض المبكر والآني – إلى الفضاء السيبراني، عبر منظومات قائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على رصد الهجمات والتصدي لها في الزمن الحقيقي. وهنا لا يعود الدفاع الرقمي مجرد إجراء تقني، بل يتحول إلى أداة ردع إستراتيجية موازية لمنظومات الدفاع العسكري التقليدية. وقد جرى خلال المؤتمر تقديم قراءة تاريخية لتطوّر الحرب السيبرانية، انطلاقًا من مرحلة كانت فيها الساحة الرقمية منفصلة عن القتال الفيزيائي، مرورًا بتفاعل متزايد بين المجالين، وصولًا إلى الحرب الهجينة، قبل الانتقال إلى ما وُصف بـ «الحرب القائمة على الفضاء السيبراني» (Cyber-Based War) في هذا الطور الأخير، لا تعود الهجمات الرقمية وسيلة دعم أو إرباك، بل تصبح أداة الحسم الأساسية، حيث يكفي تعطيل الكهرباء والمياه والاتصالات، إلى جانب بثّ حملات تضليل نفسي وإعلامي، لإفقاد الدولة قدرتها على العمل بوصفها كيانًا وظيفيًا متماسكًا. الذكاء الاصطناعي شكّل العامل الأكثر حضورًا في هذا النقاش، بوصفه مضاعِفًا نوعيًا للتهديدات السيبرانية. فالهجمات لم تعد تعتمد على فرق بشرية محدودة تكتب الشيفرات وتنفذ الاختراقات، بل باتت تُدار عبر وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التعلّم الذاتي، واكتشاف الثغرات، والتكيّف مع الدفاعات، دون تدخل بشري مباشر. هذا التحول ينقل الهجوم السيبراني من كونه فعلًا محدود النطاق إلى عملية واسعة النطاق، يمكن أن تُنفّذ في وقت واحد وعلى مستويات متعددة، مستهدفة البنية التحتية والرأي العام معًا.
153
| 05 يناير 2026
يعكس مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2025 (Global AI Vibrancy Index) الصادر عن جامعة ستانفورد Stanford University تحوّل الذكاء الاصطناعي من كونه مجالًا تقنيًا ناشئًا إلى أحد أهم محددات القوة في النظام الدولي المعاصر. فالمؤشر لا يكتفي بقياس حجم الابتكار أو عدد الأوراق البحثية، بل يقدّم تقييمًا شاملًا لديناميكية النظم الوطنية للذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحويل البحث العلمي والاستثمار والتقنيات المتقدمة إلى أثر اقتصادي واجتماعي وسياسي ملموس. تكشف نتائج المؤشر عن هيمنة واضحة للدول ذات الدخل المرتفع على المراتب الأولى، وهي هيمنة لا يمكن فصلها عن التراكم الطويل في الاستثمار في البحث والتطوير، وقوة أنظمتها الجامعية، وتقدّم بنيتها التحتية الرقمية، وقدرتها على توفير الحوسبة المتقدمة والبيانات على نطاق واسع. في هذا السياق، تحافظ الولايات المتحدة على موقع الصدارة العالمية، مستفيدة من تفوقها في الاستثمار الخاص، وتطوير النماذج المتقدمة، واستقطاب المواهب، تليها الصين التي تواصل توسيع قاعدتها البحثية ونشر الذكاء الاصطناعي ضمن إستراتيجية دولة منسقة، ثم الهند التي تمثل حالة استثنائية بوصفها الدولة الوحيدة من فئة الدخل المتوسط إلى الأدنى التي نجحت في دخول قائمة أفضل ثلاثين دولة عالميًا، مستندة إلى حجم قوتها العاملة التقنية واتساع قاعدة البحث والتطبيقات الرقمية الحكومية. في المقابل، يبرز صعود دول من فئة الدخل المتوسط إلى الأعلى، مثل البرازيل وماليزيا، إلى جانب الصين، من خلال اعتمادها مزيجًا من المبادرات الحكومية، والإستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي، والنشاط المتزايد للقطاع الخاص، في محاولة لتقليص الفجوة مع الدول المتقدمة. غير أن المؤشر يوضح أن هذا الصعود لا يزال يواجه قيودًا بنيوية، تتعلق بكلفة الحوسبة المتقدمة، وتركيز الاستثمارات، وصعوبة الوصول إلى منظومات البيانات العالمية. الأهم في دلالات المؤشر هو تأكيده أن التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي لم تعد مسألة تفوق تقني أو سباق ابتكار فحسب، بل أصبحت تعبيرًا عن قدرة الدول على بناء نظم متكاملة تشمل جذب المواهب ورؤوس الأموال، وصياغة الأطر التنظيمية، وضمان الاستخدام المسؤول، ونشر التقنيات على نطاق واسع داخل الاقتصاد والمجتمع. فالدول المتقدمة في هذا المجال لا تكتفي بالابتكار بوتيرة أسرع، بل باتت تملك القدرة على التأثير في المعايير العالمية، وتحديد قواعد الحوكمة، وصوغ الأطر الأخلاقية والتنظيمية التي سيضطر الآخرون إلى التكيّف معها. وتتجاوز هذه الريادة أبعادها الاقتصادية لتترجم بشكل متزايد إلى قوة جيوسياسية. إذ تهيمن الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي على قطاعات إستراتيجية حيوية مثل الدفاع والطاقة والتمويل والخدمات اللوجستية والمنصات الرقمية، كما تتحكم في تدفقات البيانات والبنية التحتية للحوسبة، وهي عناصر باتت تشكل العمود الفقري للقوة في القرن الحادي والعشرين. من هذا المنظور، لا يمكن فصل مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي عن خرائط النفوذ العالمي، ولا عن إعادة تشكيل موازين القوة بين الدول. وعليه، يقدّم المؤشر رسالة واضحة مفادها أن النجاح في سباق الذكاء الاصطناعي لا يتحقق عبر مبادرات معزولة أو استثمارات ظرفية، بل يتطلب قدرة الدولة على تنسيق البحث، ورأس المال، والسياسات العامة، والبنية التحتية، والثقة المجتمعية ضمن رؤية وطنية شاملة. أما الدول المتأخرة، فإن التحدي الحقيقي أمامها لا يكمن في اللحاق التدريجي بالروّاد، بل في البحث عن مسارات قفز نوعي، عبر التعاون الإقليمي، وبناء سيادة رقمية حتى لو جزئية، والاستثمار المركّز في المواهب، إذا ما أرادت تجنّب التحول إلى مجرد مستهلك للتقنيات والمعايير التي يصوغها الآخرون.
228
| 30 ديسمبر 2025
يمضي الذكاء الاصطناعي اليوم نحو لعب دورٍ يتجاوز كونه أداةً تقنية، ليغدو نواةً تحويلية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي من داخله. فمع انتقاله إلى فاعلٍ مستقلٍ قادرٍ على اتخاذ القرار والتنفيذ، تتبدل مفاهيم الإنتاج والمسؤولية والحوكمة، وتبرز أنماط جديدة من المخاطر المعقّدة. هذه المخاطر لا يمكن اختزالها في أعطال تقنية أو ثغرات تشغيلية، إذ باتت تمس البنية العميقة للاستقرار المؤسسي، عبر تداخلها مع سلاسل التوريد الرقمية، وبُنى القرار، ومنظومات الثقة التي تضبط عمل المؤسسات الحديثة. في هذا السياق، يقدّم تقرير «6 توقعات لاقتصاد الذكاء الاصطناعي: القواعد الجديدة للأمن السيبراني لعام 2026»، الصادر عن شركة «بالو ألتو نتوركس»، مدخلًا كاشفًا لفهم هذا التحول البنيوي. فالقضية المطروحة لا تتعلق بتطوير أدوات الحماية أو رفع كفاءة الدفاعات الرقمية فحسب، بل بإعادة تعريف طبيعة المخاطر في اقتصاد تعمل فيه الأنظمة الذكية بوصفها فاعلين مستقلين داخل المنظومات المؤسسية، وما يستتبع ذلك من إعادة نظر شاملة في مفاهيم الأمن والحوكمة والمسؤولية. لقد مثّل عام 2025 ذروة اضطراب سيبراني غير مسبوقة، بلغ فيها مشهد التهديدات مستويات عالية من السرعة والتعقيد، مدفوعًا بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الهجوم، وبالهشاشة المتراكمة في سلاسل التوريد الرقمية. وتكشف المعطيات أن 84% من أبرز الحوادث السيبرانية الكبرى التي جرى التحقيق فيها خلال هذا العام أسفرت عن توقف تشغيلي أو أضرار بالسمعة أو خسائر مالية مباشرة، ما يؤكد أن الهجمات لم تعد أحداثًا معزولة يمكن احتواؤها عبر استجابات ظرفية، بل تحولت إلى أزمات تشغيلية شاملة تمس صميم استمرارية الأعمال. هذا الواقع كشف بوضوح حدود النموذج الأمني التقليدي القائم على الاستجابة اللاحقة، وأبرز الحاجة إلى مقاربة مختلفة جذريًا، لا تنطلق من منطق «الاختراق» بقدر ما تنطلق من مفهوم «الانكشاف البنيوي». مع الاقتراب من عام 2026، يتبلور انتقال نوعي من منطق الاضطراب إلى منطق الدفاع، ليس بمعناه الكلاسيكي القائم على التحصين والمطاردة، بل من خلال إعادة تصميم منظومات الأمن لتواكب اقتصادًا تقوده كيانات غير بشرية. ففي البيئات التشغيلية الحديثة، يتجاوز عدد الهويات والوكلاء الآليين عدد البشر بنسبة تُقدَّر بنحو 82 إلى 1، وهو تحول كمي يعكس تغييرًا نوعيًا في بنية القوى العاملة الرقمية. ومع هذا الاختلال العددي، لم يعد الإنسان الفاعل الوحيد في اتخاذ القرار، ولا الهدف الأساسي للهجمات، بل أصبح جزءًا من منظومة هجينة تتقاسم فيها الآلة والبشر الصلاحيات والمسؤوليات. في هذا السياق، لم يعد الأمن يعني حماية الشبكات أو الأنظمة فقط، بل حماية منطق التشغيل والقرار وسلاسل الثقة التي تقوم عليها المؤسسة. وتبرز الهوية هنا بوصفها ساحة المواجهة المركزية. ففي عالم تتكاثر فيه الهويات الآلية وتتراجع فيه القدرة على التمييز بين الحقيقي والمصطنع بفعل تقنيات التزييف العميق في الزمن الحقيقي، تدخل المؤسسات في أزمة ثقة بنيوية. الخطر لم يعد مقتصرًا على سرقة بيانات أو تعطيل خدمات، بل امتد إلى إمكانية توجيه سلاسل كاملة من القرارات المؤتمتة عبر أوامر مزيفة أو هويات مخترقة، بما يجعل أمن الهوية شرطًا جوهريًا لاستقرار القرار المؤسسي ذاته، لا مجرد إجراء وقائي تقني. هذا التحول يتقاطع مع مفارقة أعمق تتعلق بوكلاء الذكاء الاصطناعي أنفسهم. فهؤلاء الوكلاء يُعوَّل عليهم لسد فجوة المهارات السيبرانية العالمية التي تُقدَّر بنحو 4.8 مليون متخصص، وتقليص إرهاق فرق الأمن، وتسريع الاستجابة للحوادث عبر العمل المستمر. غير أن منحهم صلاحيات واسعة وثقة ضمنية يحولهم، في الوقت ذاته، إلى الأصول الأعلى قيمة داخل المؤسسات، وبالتالي إلى الأهداف الأكثر جاذبية للهجمات. وهنا يتغير مفهوم «التهديد الداخلي» تغيرًا جذريًا، إذ لم يعد مرتبطًا بالسلوك البشري، بل بإمكانية تحويل وكيل ذكي موثوق إلى عنصر يعمل ضد الجهة المالكة له بسرعة ودقة تفوق أي اختراق تقليدي. ولا يقل البعد القانوني والمؤسسي خطورة عن الأبعاد التقنية. فالفجوة بين التسارع الكبير في تبني الذكاء الاصطناعي ومحدودية المؤسسات التي تمتلك استراتيجيات ناضجة لأمنه—حيث لا تتجاوز النسبة 6% وفق التقديرات—تنقل المخاطر من مستوى تقني إلى مستوى سيادي مؤسسي. لم تعد تصرفات الأنظمة الذكية غير المنضبطة أعطالًا تقنية محايدة، بل باتت قرارات ذات تبعات قانونية ومسؤوليات مباشرة تقع على عاتق القيادات التنفيذية ومجالس الإدارة، ما يعيد رسم حدود الحوكمة في العصر الرقمي. أما على مستوى الممارسة اليومية، فقد تحوّل متصفح الإنترنت من أداة عرض إلى مساحة تنفيذ مركزية، تُدار عبرها التطبيقات والبيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي. ومع الارتفاع الحاد في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح المتصفح نقطة التقاء بين الإنسان والآلة والبيانات، وفي الوقت ذاته أحد أوسع أسطح الهجوم غير المحكمة، ما يفرض نقل الضوابط الأمنية إلى نقطة التنفيذ الأخيرة بدل الاكتفاء بحماية الأطراف الخلفية للأنظمة. في المحصلة، لا يتعلق التحول الجاري بإدخال أدوات أمنية أكثر تطورًا، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقرار والثقة. ففي اقتصاد تقوده الأنظمة المستقلة، تصبح المخاطر السيبرانية مرآة لمخاطر الحوكمة والقيادة والمسؤولية. والتحدي الحقيقي مع اقتراب عام 2026 لن يكون في سرعة تبني الذكاء الاصطناعي، بل في القدرة على ضبطه وحوكمته وتأمينه بوصفه فاعلًا اقتصاديًا مستقلًا، دون أن يتحول من محرّك للنمو إلى مصدر دائم لانعدام اليقين. فالسؤال الذي يواجه البشرية اليوم لم يعد: هل نتبنى الذكاء الاصطناعي؟ بل: كيف نعيش وندير مؤسساتنا في عالم أصبح فيه الذكاء الاصطناعي فاعلًا لا مفر منه في تشكيل مصيرنا الاقتصادي والمؤسسي؟
291
| 22 ديسمبر 2025
لم يعد المشهد الاقتصادي العالمي محكومًا فقط بقوانين النمو والانكماش، ولا بخطط الدول والبنوك المركزية، بل بواقع جديد تشكّل بصمت: سبع شركات خاصة - لا تملك جيوشًا ولا مقاعد في الأمم المتحدة - باتت تتمتع بنفوذ يفوق قوة دول صناعية كبرى. في زمن تُقاس فيه القوة بالبيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، تحولت هذه الشركات إلى مراكز سيادة موازية تعمل خارج الإطار التقليدي للدولة، وتعيد رسم خرائط الاقتصاد والسياسة والحقوق على مستوى العالم. هذه الكيانات هي: أبل، مايكروسوفت، إنفيديا، أمازون، ألفا بيت، ميتا، غوغل... إنها سبع شركات فقط باتت تسيطر على ثلث القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 الذي يتجاوز 51 تريليون دولار، وأبعاد القصة لا تقف عند حدود المؤشرات المالية ولا عند هيمنة الشركات على أرباح وادي السيليكون. فالنمو الهائل الذي حققته هذه الكيانات خلق طبقة جديدة من السلطة تتجاوز الاقتصاد التقليدي إلى فضاءات أكثر حساسية: تشكيل الوعي، وصناعة السلوك البشري، والتحكم بالبنية التحتية الرقمية التي باتت شريان الحياة للدول والشعوب. ولهذا بدأت المخاوف تنتقل من غرف التحليل الاقتصادي إلى قاعات الأمم المتحدة. إذ حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن تركّز القوة الاقتصادية والبيانية في يد سبع شركات فقط يشكّل تهديدًا بنيويًا للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويخلق وضعًا غير مسبوق في التاريخ الحديث. فاليوم، لم يعد نفوذ هذه الشركات مقتصرًا على الأسواق، بل امتد ليطول: • بيانات مليارات البشر التي أصبحت الوقود الرئيسي لإنتاج الخوارزميات وتطوير النماذج الذكية. • أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على التأثير في الإدراك والاختيارات الفردية، بل وإعادة صياغة السلوك الجماعي. • المنصات الاجتماعية التي تُعتبر المختبر الأول لصناعة الرأي العام وتوجيه النقاشات السياسية والاجتماعية. • البنية السحابية والحوسبية التي تعتمد عليها الحكومات والمؤسسات المالية والإعلامية والصحية. إنها منظومة سيطرة تتجاوز نموذج الربح والخسارة. صارت هذه الشركات تمتلك القدرة على توجيه المعلومات، التأثير في نتائج الانتخابات، ترجيح كفة طرف سياسي على آخر، وحتى تعطيل شبكات وطنية أو شلّ قطاعات اقتصادية بقرار تقني واحد. إن ما كان في السابق شأنًا سياديًا للدول—مثل الأمن المعلوماتي، والرقابة على تدفق البيانات، وتنظيم المحتوى—أصبح اليوم فعليًا تحت سيطرة كيانات خاصة لا تخضع إلا جزئيًا للحكومات أو للمعايير الدولية. لهذا وصف بعض الاقتصاديين والمفكرين هذه الظاهرة بأنها لحظة ولادة لـ “قوى فوق–سيادية”؛ فهذه الشركات لا تُقيّدها حدود جغرافية، ولا سلطات تنظيمية فعّالة، وتعمل في إطار عالمي يسمح لها بتجاوز محاسبة الدول، وتغيير قواعد اللعبة أسرع من قدرة التشريعات على اللحاق بها. إن التوازن بين القوة التكنولوجية والسلطة السياسية بات يميل بشكل خطير لصالح الشركات، ما يثير قلقًا حقيقيًا من أن يتحول الاقتصاد الرقمي إلى نموذج حكم جديد لا يقوم على العقد الاجتماعي، بل على العقد الخوارزمي. خلاصة القول، ثمة ثنائية دقيقة تقف البشرية أمامها: من جهة، أحدثت هذه الشركات ثورة تكنولوجية هائلة تقود إنتاجية جديدة وتحولات صناعية ومجتمعية إيجابية. ومن جهة أخرى، أدّت هيمنتها المطلقة إلى اختلالات في الأسواق، وقلق سياسي عالمي، وتخوف متزايد من أن يتحول الذكاء الاصطناعي من نعمة الابتكار إلى أداة للهيمنة. ويبقى السؤال: هل يستطيع النظام الدولي تطوير حوكمة عالمية توقف الانفلات التكنولوجي وتحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ أم أننا نتجه إلى مستقبل تصنعه شركات أصبحت بالفعل أكبر من دول، وأكثر تأثيرًا من حكومات، وأكثر حضورًا من المؤسسات التقليدية؟ ففي المحصلة، يشكّل السبعة الكبار ظاهرة اقتصادية-سياسية جديدة: قوى عابرة للدولة، تصنع المستقبل، لكنها قد تهدد أساس النظام العالمي إذا لم تُخضع لضوابط تحمي الإنسان قبل التكنولوجيا، والحق قبل الخوارزمية.
204
| 11 ديسمبر 2025
لم يعد المشهد الاقتصادي العالمي محكومًا فقط بقوانين النمو والانكماش، ولا بخطط الدول والبنوك المركزية، بل بواقع جديد تشكّل بصمت: سبع شركات خاصة - لا تملك جيوشًا ولا مقاعد في الأمم المتحدة - باتت تتمتع بنفوذ يفوق قوة دول صناعية كبرى. في زمن تُقاس فيه القوة بالبيانات والحوسبة والذكاء الاصطناعي، تحولت هذه الشركات إلى مراكز سيادة موازية تعمل خارج الإطار التقليدي للدولة، وتعيد رسم خرائط الاقتصاد والسياسة والحقوق على مستوى العالم. هذه الكيانات هي: أبل، مايكروسوفت، إنفيديا، أمازون، ألفا بيت، ميتا، غوغل... إنها سبع شركات فقط باتت تسيطر على ثلث القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 الذي يتجاوز 51 تريليون دولار، في سابقة تاريخية تعكس صعود كيانات عملاقة تقودها أبل وإنفيديا. هذه الشركات لم تعد مجرّد مؤسسات تكنولوجية، بل تحوّلت إلى قوى اقتصادية فوق وطنية تُعيد تشكيل الأسواق العالمية، وتفرض منطقًا جديدًا للنفوذ خارج سلطة الدول والبنوك المركزية. إنها قوى نظامية Systemic Powers تتحكم بالبنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي الحديث. يكمن جوهر قوة هذه الشركات في أنها لم تعد مجرّد منتجة للتكنولوجيا، بل أصبحت مهندِسة للبيئات الرقمية التي نعيش ضمنها. فهي تبني منظومات مغلقة تتشابك فيها البيانات والخوارزميات والبنى السحابية والعتاد الحوسبي، لتصنع فضاءً اقتصاديًا ومعرفيًا مغلقًا تتحكم بقواعده وحدها. لم يعد المستخدم أو المستهلك أو المطور مجرد طرف يتعامل مع خدماتها، بل أصبح عنصرًا مُندمجًا في شبكات مترابطة تحكمها هذه الشركات، شبكات تتجاوز فكرة السوق إلى نظام بيئي رقمي كامل تُعاد صياغة العلاقات داخله عبر الخوارزمية لا القانون. مع توسع هذه المنظومات، بات تأثيرها يتسلل إلى مستويات كانت يومًا حكرًا على الدول: البحث العلمي، الأمن السيبراني، التعليم، الإعلام، الخدمات الحكومية، والبنى التحتية للاتصال. إنها شكل جديد من السلطة الناعمة، لكنّه أكثر اختراقًا وعمقًا؛ سلطة لا تعمل عبر الحدود، بل تتلاشى أمامها الحدود، لأن نفوذها يتوسع مع كل تدفق للبيانات وكل عملية حسابية وكل اتصال عبر السحابة. تقف إنفيديا كما هو معروف في قلب هذا التحول بقيمة سوقية تجاوزت 4.4 تريليون دولار - رقم يفوق اقتصاد اليابان بأكمله. ما حققته الشركة ليس نجاحًا تجاريًا بالمعنى التقليدي، بل ثورة في بنية الحوسبة العالمية. فقد أصبحت شرائحها الحاسوبية بمثابة «محرّك التشغيل» للذكاء الاصطناعي الحديث، وهو ما يجعلها أقرب إلى مزوّد للطاقة الفكرية للعالم. إن قوة إنفيديا اليوم تشبه قوة من يتحكم بالكهرباء في القرن العشرين أو بالنفط في السبعينيات: إنها تتحكم في البنية التحتية للمعرفة والحوسبة، أي الأساس الذي تقوم عليه الصناعة والبحث العلمي والاقتصاد الرقمي معًا. ثورة تكنولوجية… أم فقاعة تتخفّى خلف بريق التقدم؟ العالم اليوم يقف أمام صعود غير مسبوق في تقييمات شركات التكنولوجيا، صعود يحوّل آلاف الدولارات إلى ثروات هائلة خلال سنوات قليلة؛ فاستثمار بسيط بقيمة 7000 دولار عام 2015 كان سيبلغ قرابة 470 ألف دولار اليوم. ولكن خلف هذه القفزة المذهلة يكمن سؤال أشد تعقيدًا: هل يعكس هذا الارتفاع تحوّلًا تاريخيًا تقوده ثورة الذكاء الاصطناعي، أم أننا نعيد إنتاج منطق الفقاعة؛ حيث تغدو السرديات التقنية بديلاً عن الحقائق الاقتصادية، وتصبح التقييمات انعكاسًا للتوقعات أكثر من الواقع؟ إن ما يحدث لا يتعلق بالنمو وحده، بل بهندسة جديدة للسوق تقوم على تركيز غير صحي للثروة والقيمة في عدد محدود من الشركات. لقد تحولت الأسواق الأمريكية إلى بنية معتمدة بشكل مفرط على بضعة كيانات فقط، بحيث أصبح وزن هذه الشركات ضخمًا إلى درجة تجعلها أشبه بـ «أعمدة تحمل سقف السوق». وأي خلل في أحد هذه الأعمدة لا يسبب تراجعًا في قطاع واحد، بل هزة نظامية Systemic Shock قد تتردد أصداؤها عبر أسواق العالم. هذا النوع من التركّز لا يشير فقط إلى مخاطرة مالية، بل إلى اختلال هيكلي يجعل التقييمات عرضة للمبالغة، ويحوّل السوق إلى بيئة يغذيها التفاؤل المفرط بقدر ما يهددها التشاؤم المفاجئ. وفي هذا السياق تبدو مقولة د. ريان ليمند، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوفيجن لإدارة الثروات» أشبه ببوصلة لفهم اللحظة: «استفد من الفقاعة طالما استمرت… لكن تذكّر أنها ستنفجر». فهو لا يتحدث عن احتمال، بل عن قانونٍ من قوانين الأسواق: كل موجة صعود متطرفة تحمل في داخلها بذور التصحيح، مهما ارتدى هذا الصعود ثياب الثورة التكنولوجية أو استند إلى سرديات الذكاء الاصطناعي.
318
| 04 ديسمبر 2025
يشهد الخليج اليوم لحظة مفصلية في مسار الذكاء الاصطناعي، لحظة تتجاوز حدود التبنّي التقني إلى إعادة تشكيل منظومات القوة وممارسات الدولة. فمن الواضح أن دول مجلس التعاون لم تعد تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة لتحسين الكفاءة الحكومية أو رفع جودة الخدمات، بل بات جزءًا من هندسة النفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتكشف رؤى 2020– 2030 و2030– 2040 عن هذا التحول بوضوح، إذ جرى تضمين الذكاء الاصطناعي ضمن الخطط الوطنية الكبرى، وتسخير موارده لتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية واستقطاب الشركات العالمية وبناء المكانة الجيوسياسية. خطوات مؤسسية مثل إطلاق الإمارات لإستراتيجية AI 2031 وإنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي، وتأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير قطر لمسارات الذكاء الاصطناعي ضمن رؤيتها الوطنية، ليست مجرد مبادرات تقنية، بل تعبير عن تحوّل الدولة الخليجية نحو نموذج «القوة الرقمية الشاملة». في هذا السياق، أصبح الذكاء الاصطناعي بمرتبة الطاقة والمال والبنية التحتية في تشكيل مستقبل المنطقة. ومع توسع هذا التوجه، لم يعد صناع السياسات ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي كأداة لتحسين الإنتاجية فحسب، بل كقوة دافعة لبناء قطاعات جديدة بالكامل - من الرعاية الصحية واللوجستيات إلى التقنيات المالية وكفاءة الطاقة - وهي القطاعات التي باتت تمثل أعمدة رئيسية في مسار تنويع الاقتصاد الخليجي. كما بات الذكاء الاصطناعي يتحوّل بسرعة من أدوات للتجربة إلى أنظمة تشغيل تعتمد عليها المؤسسات في عملها اليومي، غير أن هذا التسارع يكشف في المقابل فجوة بنيوية تزداد وضوحًا كلما توسّع الاعتماد على المنصات والخوارزميات، ضمن هذا التحول، تبرز ظاهرة “الاختراق العميق” بوصفها أحد أخطر التهديدات المستجدة. فهي لا تستهدف النظام الشبكي فقط، بل البنية المعرفية التي تُشغّل الدولة الحديثة: ولمواجهة هذا النوع من المخاطر، تحتاج دول الخليج إلى نموذج حوكمة موحد يتجاوز منطق اللوائح العامة و»الإستراتيجيات الموازية»، إلى منظومة متكاملة تربط بين البيانات والنماذج والبنية التحتية. فالحوكمة تبدأ من البيانات عبر تصنيفها وتحديد مستويات حساسية كل فئة، ومن ثم فرض ضوابط دقيقة على كيفية تخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود، بما يحفظ السيادة الرقمية ويقلّص مساحات الهجوم. أما على مستوى النماذج، فإن المرحلة القادمة تتطلب إنشاء سجل وطني للنماذج الخوارزمية الحساسة، وإخضاعها لتقييمات مخاطر صارمة قبل التشغيل، وإجراء اختبارات هجومية موجهة للخوارزميات ذاتها للتحقق من صمودها أمام محاولات التضليل، مع ضمان وجود سجلات قرارات تتيح تتبّعًا دقيقًا لأي خلل أو انحراف. ويكتمل هذا النموذج بتطوير بنية تحتية تكنولوجية مبنية على مبدأ “انعدام الثقة”، بحيث لا يُفترض أمان أي عنصر داخل الشبكة - مستخدمًا كان أو جهازًا أو خدمة - إلا بعد التحقق المستمر، مع إدارة شديدة الانضباط لمخاطر سلسلة التوريد الرقمية. في المحصلة، فإن دول الخليج تمتلك اليوم الإرادة السياسية، والبنية المؤسسية، والاستثمارات اللازمة لبناء منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة، لكنها تحتاج إلى خطوة حاسمة تتمثل في دمج هذه المنظومة داخل إطار الأمن الوطني. فالتحدي لم يعد في تطوير الذكاء الاصطناعي، بل في ضمان ألا يتحول إلى نقطة ضعف إستراتيجية يمكن استغلالها. وإذا ما نجحت المنطقة في بناء منظومة موحدة تربط بين أمن البيانات، وسلامة النماذج، وهندسة انعدام الثقة، مع استيعاب الديناميات الجديدة للسوق والتحول المؤسسي، فإن الذكاء الاصطناعي سيغدو ركيزة صلبة للسيادة الرقمية، لا مجرد تقنية واعدة، وسيتمكن الخليج من تحويل طموحه الرقمي إلى قوة حقيقية تعزز موقعه في التوازنات الإقليمية والدولية.
321
| 30 نوفمبر 2025
تتشابك الأكواد مع الخرائط، وتتقاطع الخوارزميات مع مسارات النفوذ، لترسم ملامح عالمٍ جديد تتداخل فيه التقنية بالسياسة، وتتماهى فيه البيانات مع السلطة. لم يعد الفضاء السيبراني امتدادًا للواقع فحسب، بل واقعًا موازياً تُدار في فضائه القرارات، وتُعاد فيه صياغة مفاهيم القوة والسيادة والأمن. ففي زمنٍ تُقاس فيه الهيمنة بقدرة الخوارزميات على الرؤية والتحليل والتوجيه، يتراجع السلاح المادي أمام نفوذ الكود، ويغدو الأمن الرقمي معيارًا حاسمًا لاستقرار الدول ومكانتها في النظام الدولي الجديد. عند هذه العتبة من التحوّل، يبرز الاستقرار السيبراني كأحد أكثر المفاهيم إشكالًا في الفكر السياسي المعاصر؛ فهو لا يعني غياب التهديدات، بل القدرة على إدارتها ضمن فضاءٍ متغيّرٍ بطبيعته، ولا يقوم على الردع وحده، بل على بناء الثقة كشرطٍ للأمن المشترك. إنّ الانتقال من إدارة التهديد إلى هندسة الثقة يمثل جوهر المقاربة الجديدة للأمن في العصر الرقمي؛ مقاربة لا ترى في الفضاء السيبراني ميدانًا للصراع فقط، بل بنية حيوية لاستمرار العالم الحديث، تُعاد فيها صياغة مفاهيم النظام والاستقرار، كما تُعاد كتابة الأكواد التي تحكمه.فمسألةُ بناءِ نظامٍ سيبرانيٍّ عالميٍّ مستقرٍّ ومتوافقٍ مع بنى النظام الدولي الراهن تُعَدّ إحدى أكثر القضايا إلحاحًا على جدول أعمال المجتمع الدولي في المرحلة المعاصرة. فالتطور المتسارع في التكنولوجيا الرقمية، واتساع الفضاء السيبراني ليغدو البنية التحتية الخفيّة لكلّ أنشطة الاقتصاد والسياسة والأمن والمعرفة، جعلا منه ميدانًا تتقاطع فيه مصالح الدول وتتشابك فيه حدود السيادة على نحوٍ غير مسبوق. وقد أفرز هذا التشابك المتنامي تحدّيات عميقة تتعلق بكيفية إدارة الترابط العالمي وضبط مخاطره، في بيئةٍ رقمية تتغيّر سرعتها أسرع من قدرة الأنظمة السياسية والقانونية على التكيّف معها. بناءً على هذه المعطيات التي تُظهر أن الاقتصاد الرقمي بات يُشكّل أكثر من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، غدا الاستقرار السيبراني مسألةً مركزية لا تُختزل في بعدها الأمني، بل تمثّل شرطًا أساسيًا لاستدامة النمو الاقتصادي والتطور التقني للدول. فهو اليوم لا يقلّ أهمية عن الاستقرار النووي أو المالي، إذ يحدّد مدى قدرة الدول على حماية بناها التحتية الحيوية، وصون مؤسساتها السياسية والديمقراطية، وضمان أمنها الاقتصادي والاجتماعي في عالمٍ تراجعت فيه فاعلية القوة الصلبة التقليدية، لتحلّ محلّها أشكالٌ جديدة من النفوذ القائم على السيطرة على البيانات، والبنى التحتية الرقمية، وتدفّقات المعلومات العابرة للحدود. على مدى العقود الثلاثة الماضية، تحوّل الإنترنت من مشروعٍ أكاديمي محدود إلى نظامٍ عصبيٍّ كونيّ يغذّي أكثر من 5.35 مليار إنسان ويربط ما يزيد على 75 % من سكان الكوكب، فاتحًا الباب أمام مكاسب غير مسبوقة للبشرية في مجالات التواصل والإنتاج والمعرفة. ومع توسّع الاقتصاد الرقمي ليشكّل أكثر من 15 % من الناتج العالمي، أصبحت الشبكات الرقمية عصب الحياة الحديثة ومحرّكها الخفي. غير أن هذا الترابط نفسه أوجد هشاشةً جديدة؛ إذ باتت الأنظمة الوطنية متشابكة على نحوٍ يجعل من أيّ خللٍ في شبكةٍ محلية تهديدًا محتملًا للنظام العالمي بأسره. وتشير التقارير إلى أن عدد الهجمات السيبرانية ارتفع بنسبةٍ تفوق 28 % في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بمتوسطٍ بلغ 1250 هجومًا أسبوعيًا على كل مؤسسة حول العالم، فيما تجاوزت الخسائر الاقتصادية العالمية عشرة تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2025. ومع هذا التصاعد، برزت المعضلة الكبرى: كيف يمكن الحفاظ على استقرار عالمٍ تحكمه الأكواد بدلًا من الحدود، وتُدار فيه القوة بالمعلومة لا بالسلاح؟ تأسيسا على ذلك، أصبحت الحوكمة السيبرانية الدولية أحد الميادين البحثية الصاعدة في العلاقات الدولية، لأنها تمسّ جوهر مفهوم السيادة ذاته. فالفضاء السيبراني لا يعترف بالحدود الجغرافية، لكنه يتغلغل في مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحيوية بعمقٍ غير مسبوق. هذا التناقض بين الطابع الكوني للبنية الرقمية والطابع القومي للسيادة السياسية جعل من الفضاء السيبراني ساحة تنافس بين القوى الكبرى على تحديد قواعد اللعبة الجديدة. فبينما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرض نموذج الانفتاح والحرية الرقمية الذي يكرّس هيمنة الشركات العملاقة في وادي السيليكون، تدفع الصين وروسيا باتجاه نموذج السيادة الرقمية الذي يضمن للدولة السيطرة على تدفقات المعلومات وحماية الفضاء الوطني من التأثير الخارجي. وهكذا، لم يعد الصراع حول التكنولوجيا صراعًا تقنيًا فحسب، بل صراعًا على تعريف مفاهيم الشرعية والسيادة والأمن في العصر الرقمي.
222
| 13 نوفمبر 2025
لم يعد الفضاء السيبراني مجرد امتداد تقني للبنى المعلوماتية، بل أصبح مجالًا جيوسياسيًا قائمًا بذاته، يتداخل فيه الأمن القومي مع الاقتصاد الرقمي، وتتقاطع فيه القوات المسلحة مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتتداخل فيه الحدود السيادية مع حدود رقمية غير مرئية، تصنع الواقع وتشكّل الإدراك وتعيد صياغة معادلات النفوذ والقوة. إنّ هذا الواقع الجديد يفرض إعادة قراءة الأدوات التقليدية لتحليل القوة، ويستدعي نماذج جديدة تقدر على تفسير هذا الحقل المعرفي الذي يتوسع بوتيرة متسارعة، وتتخلق فيه بنوعيات جديدة من الفواعل، من الشركات العملاقة إلى الجيوش الرقمية، ومن وحدات الحرب السيبرانية إلى الذكاء الاصطناعي ذي القدرة على اتخاذ القرار. من هذا المنطلق، طرحت في أطروحتي للدكتوراه المتعلقة بالفضاء السيبراني وتحولات القوة في العلاقات الدولية سؤالًا محوريًا: كيف يمكن إعادة تعريف القوة في عالم لم تعد فيه السيطرة تُقاس بالحدود المادية والقدرات العسكرية وحدها، بل بالقدرة على امتلاك البيانات وتوجيهها، والتحكم في البنى الخوارزمية التي تصنع الوعي وتدير السلوك وتعيد تشكيل المجال العام؟ أحد أبرز الاستنتاجات التي خلصت إليها الأطروحة تمحورت حول مسألة أنّ العالم العربي لا يمكنه الاكتفاء بدور المستهلك أو المتلقي للمعايير الدولية في قياس القوة السيبرانية؛ لأن امتلاك أدوات القياس ليس وظيفة تقنية، بل هو فعل سيادي يمس تعريف الذات وتحديد موقعها في النظام الدولي. فالانتقال من موقع من يُقاس إلى موقع من يضع معايير القياس هو في جوهره انتقال من التبعية المعرفية إلى إنتاج السلطة الرمزية والتقييمية، وهو شرطٌ لبناء حضور عربي مستقل في المجال السيبراني العالمي. وفق هذا المنظور، فإن الدعوة إلى تأسيس نموذج عربي مستقل لقياس القدرات السيبرانية لم تأتِ كتوصية شكلية، بل كضرورة إستراتيجية مرتبطة بوجودنا في نظام دولي يتشكل، حيث تتنافس الدول الكبرى على وضع المعايير، وتحديد قواعد السلوك في الفضاء السيبراني، وصياغة أطر تقييم القدرات الوطنية. إذ إن غالب النماذج الرائجة اليوم - مثل مؤشرات جامعة هارفارد، والاتحاد الدولي للاتصالات، ووكالات الاستخبارات الغربية - تعكس منظومات قيمية وسياسية مُصممة لتعزيز تصورات محددة للقوة. لماذا نقول ذلك؟ لأنّ مراجعة الأدبيات ذات الصلة في هذا السياق كشفت عن مشكلتين جوهريتين متأصلتين في بنية المؤشرات الدولية ومعاييرها التقييمية. أولًا: التحيّز المعرفي والسياسي في المؤشرات الدولية. فالتحيّز في القياسات الدولية يعكس شكلًا جديدًا من القوة المعيارية (Normative Power)؛ حيث تُدار المنافسة السيبرانية عبر تعريفات ومعايير مسبقة تُحدد من يستحق صفة «المتقدّم» ومن يُوضع ضمن خانة «المنكشف» أو «غير الجاهز»، حتى وإن امتلك قدرات تشغيلية وعملياتية أثبتتها التجارب الميدانية. ثانيًا: تجاهل السياقات الوطنية والبيئة الأمنية العربية وهذا الأكثر جوهرية بالنسبة للعالم العربي، حيث تتمثل في فجوة السياق بين البيئة الواقعية الإقليمية والمعايير المستخدمة عالميًا لتقييم القدرات السيبرانية. فغالبية المؤشرات تُبنى على فرض أنّ التهديدات المهيمنة هي جرائم إلكترونية ونشاطات تجسسية تقليدية وهجمات على البنى الرقمية المدنية، في حين أنّ البيئة العربية تُظهر طبيعة تهديدات أكثر تعقيدًا وتشابكًا. بمعنى آخر، فإن المؤشرات الحالية لا تلتقط حقيقة أنّ الفضاء السيبراني في المنطقة ليس فقط مجالًا تقنيًا، بل مسرحًا جيوسياسيًا يرتبط بالأمن الوطني والاقتصاد السياسي الإقليمي. وبالتالي، فإن تقييم دول المنطقة وفق معايير تركّز على عناصر تقنية معزولة دون دمجها في سياق أوسع من التحديات الإقليمية يجعل المؤشر غير قادر على عكس القدرات الفعلية أو الاحتياجات الإستراتيجية. في الحالتين، تكمن الإشكالية في أن هذه المؤشرات تتحول، دون قصد مباشر أحيانًا، إلى أدوات لتعريف «من هو جاهز سيبرانيًا» وفق منظومة قيمية خارجية، وليس وفق احتياجات وطنية، ومصالح إستراتيجية، وتحولات جيوسياسية تخص المنطقة العربية. وبذلك يصبح تأسيس نموذج عربي فعلًا معرفيًا سياديًا يستعيد القدرة على تعريف الذات الرقمية، وتحديد موقعنا في النظام السيبراني العالمي وفق معايير نابعة من سياقاتنا وضروراتنا، لا وفق عدسات الآخرين ومصالحه
450
| 09 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية

عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب...
15105
| 08 فبراير 2026

يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة،...
1449
| 10 فبراير 2026
لم يكن الطوفان حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه مع...
813
| 10 فبراير 2026

تعكس الزيارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة العربية...
624
| 05 فبراير 2026

لقد طال الحديث عن التأمين الصحي للمواطنين، ومضت...
615
| 11 فبراير 2026

يشهد الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة حالة مزمنة...
552
| 09 فبراير 2026

منذ إسدال الستار على كأس العالم FIFA قطر...
513
| 11 فبراير 2026

راقب المشهد في أي مجمع تجاري في عطلة...
498
| 12 فبراير 2026

لم يعد هذا الجهاز الذي نحمله، والمسمى سابقاً...
498
| 09 فبراير 2026

لم يكن البناء الحضاري في الإسلام مشروعا سياسيا...
483
| 08 فبراير 2026
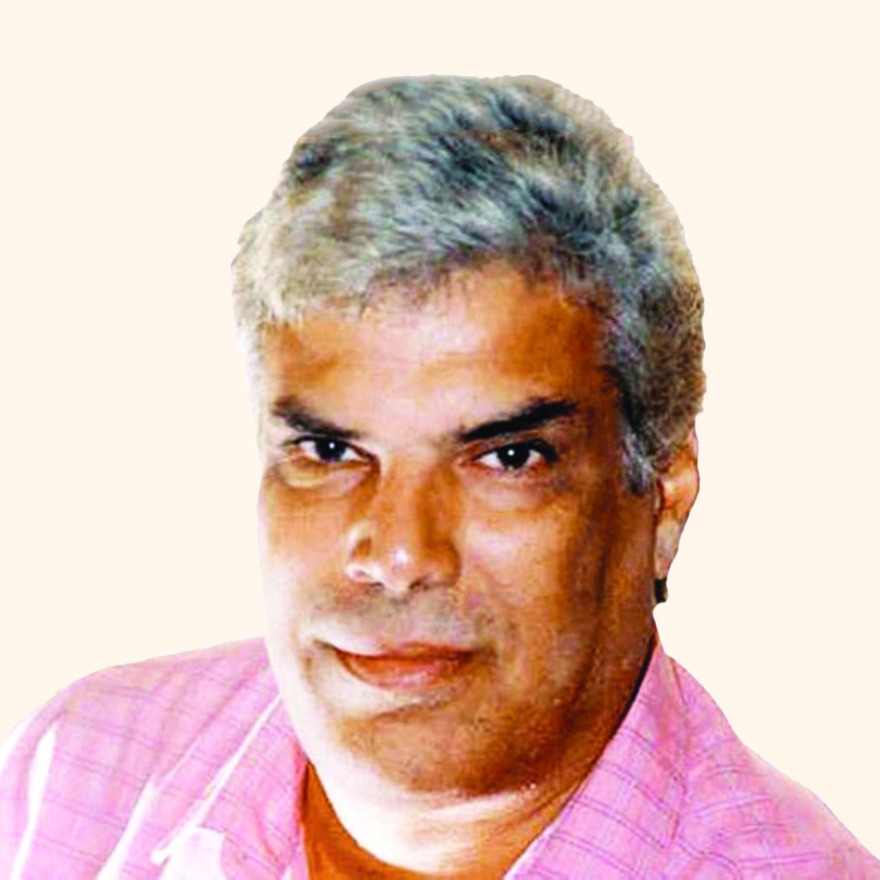
«الآخرة التي يخشاها الجميع ستكون بين يديّ الله،...
447
| 05 فبراير 2026

يستيقظ الجسد في العصر الرقمي داخل شبكة دائمة...
438
| 10 فبراير 2026
مساحة إعلانية







