رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إن اليقظة الذهنية، كما عرفتها الأدبيات النفسية والتنظيمية الحديثة، هي أن تكون حاضرًا بتمامك في اللحظة.. حاضراً بجسدك، وعقلك، ومشاعرك، وقيل أنها تعني أن تعيش كل مهمة بتأنٍ، وأن تلاحظ ما يدور حولك دون أن تنجرف خلف التوتر أو التشتت أو العجلة. فعلا.. إنها مهارة تحررنا من تكرار ممارساتنا دون وعي، أو أن نخطئ دون أن ندري، وأن نتعب دون أن نعرف لماذا. لذلك، فإن إدخال هذه المهارة في القطاع الحكومي ليس ترفًا، بل هو ضرورة إدارية وإنسانية وتنظيمية، فالموظف الذي يتعامل مع المواطنين والمراجعين والمستفيدين كل يوم، ويستقبل شكاواهم، وينفّذ تعليمات، ويتخذ قرارات، هو موظف في موقع تأثير مباشر على حياة الناس. فإذا افتقد التوازن، غابت جودة الخدمة المقدمة، وتآكلت الثقة بين الطالب والمطلوب، وتراكم الإحباط الوظيفي وكثرت الأخطاء. فماذا سيخسر الموظف الحكومي إن بدأ يومه بخمس دقائق من التوقف الذهني، ومن الإصغاء لنَفسه، وسعي الى ترتيب أفكاره، قبل أن يغوص في زحمة البريد والمراجعين، دون استعجال أو انفعال، كيف سيكون أثر ذلك على المؤسسة؟ على جودة الخدمة؟ على نفسية الفريق؟ ففي لحظة اليقظة النادرة، يتوقف الموظف مع نفسه ويتساءل.. هل ما أفعله هنا له قيمة فعلية؟ هل أؤدي هذا الدور لأنني أؤمن به، أم لأنني اعتدت عليه؟ ثم ينظر حوله ويتأمل في نظام العمل، ويهمس لنفسه.. هل الإجراءات التي أكررها كل يوم ما زالت تخدم الناس كما ينبغي؟ أم أنني أتحول دون أن أشعر إلى جزء من تعقيد يرهقهم؟، ثم يغوص في أعماقه متسائلًا: هل فقدت شغفي بسبب غياب التحفيز؟ أم لأني لم أعد أرى أثر ما أقوم به؟ هل أنا موظف يغيّر شيئًا... أم أنني مجرد رقم في سلسلة طويلة من الأوامر والتعليمات؟ لذلك ترون أنني لا أدعو لحلول سحرية، بل لخطوة أولى بسيطة: أن تعترف الادارات العليا بحاجة الموظف إلى لحظات استعادة ذهنه وأن ندربه على التركيز، وأن نفتح باب الحديث عن الضغوط والتوازن الذاتي دون خجل أو إنكار، وأن توفر له بيئة مناسبة تتيح له ممارسة اليقظة الذهنية، فالموظف ليس آلة، بل هو كائن بشري، له نفسٌ تتعب، وعقلٌ يرهق، وقلبٌ يتأثر، ويحتاج فعليا الى وقفة جادة من الادارة العليا للاجابة عن هذه التساؤلات.. وقد تكون المفارقة هنا أن الموظف العربي الحكومي – رغم الاستقرار الوظيفي الذي قد يحسده عليه آخرون خصوصا في بيئة العمل الخاص – هو أكثر من يحتاج إلى محفزات داخلية للاستمرار، فكما تعلمون أن الرتابة تسرق الشغف، والتكرار يُطفئ الحماسة، والبيروقراطية تُرهق الروح، وهنا يأتي دور «اليقظة الذهنية» لتعيد إشعال تلك الشعلة الداخلية الصغيرة. وإنني أؤمن أن الاستثمار في هذه المهارات الناعمة (soft skills) هو استثمار في الإنسان ذاته، وهو أبعد أثرًا من شراء برامج إلكترونية أو خط خدمات جديدة أو إصدار تعاميم صارمة، فنحن نحتاج إلى إعادة صياغة العلاقة بين الموظف وعمله، وبين الإنسان ومهنته، وهذا لا يتم إلا حين نضع الإنسان وذاته في قلب المعادلة. لذلك من الجميل أن تهتم الإدارات الحكومية العربية بتوفير كل السبل لصناعة بيئة قادرة على تعزيز ثقافة بناء اليقظة الذهنية للموظف، وأن تقوم بتنظيم ورش في اليقظة الذهنية وأدوات ممارستها، وتسعى بها الى ادخال مفاهيم مثل «الإصغاء»، و»الانتباه»، و»الإدراك اللحظي» و» التساؤلات المنطقية « و» النقد البناء « إلى عقول موظفيها وعامليها وتستخرجها من أدرج أدبيات علم الإدارة الحكومية الى أرض الواقع العلمي. ولنتذكر دائماً.. أن لحظة يقظة واحدة في يوم مزدحم قد تفتح نافذة جديدة على الداخل النفسي، وقد تغيّر الطريقة التي نفكر بها ونعيش بها، فالعالم لا يحتاج إلى موظفين أكثر، بل إلى موظفين أكثر يقظة.
651
| 30 أبريل 2025
ظهرت في الآونة الاخيرة عدة بحوث ومقالات أكاديمية تناولت الفجوة التي نجدها بين الاكاديميين وبحوثهم وبين أصحاب القرار من الساسة واصحاب النفوذ في الدول العربية، فشعرت بقلق عميق على مستقبل المعرفة التي ينتجها الباحثون العرب، وإنني لم أقرأ مجرد أرقام وتحليلات، بل قرأت بين السطور التي سطرها أولئك الباحثون صرخة مكتومة من قلب أروقة الجامعات ومراكز البحوث، تلك الصرخة التي تسأل وتتساءل.. هل لا يزال لما يكتبه الباحث العربي أثر؟ هل ما زال للبحث وزنه في تشكيل واقع الناس وسياسة الدول ؟ أم أصبح يدور في حلقة مغلقة، فيكتب لنفسه، ويقرأ لنفسه، ويقيَّم على معايير لا تمتّ بصلة لحياة الناس ومشكلاتهم؟ فأدركتُ حينها أننا قد نكون – كباحثين وأكاديميين ومثقفين - من حيث لا نشعر، جزءًا من منظومة تُنتج معرفة معقمة، منزوعة المعنى، منفصلة عن هموم الميدان. فالجامعات، في كثير من الأحيان، صارت تحتفي بعدد ما يُنشر لا بما يُغيّر، وتهتم بمقاييس الاقتباس أكثر من اهتمامها بأثر الأفكار على أرض الواقع، وغاب السؤال الجوهري: لمن نكتب؟ ولماذا نكتب؟ وهل نكتب لأنفسنا أم لمجتمعنا؟ أكثر ما أقلقني هو أن هذا الانفصال والانفصام الذي لا يصيب فقط الباحثين، بل يمتد إلى المجتمع بأكمله، فصناع القرار والساسة يبتعدون عن الأبحاث ونتائجها والقائمين عليها وبل يتجاهلونها، والباحثون يفقدون الإيمان بجدوى ما يقدمونه، وهذا التباعد يهدد، بصمت، القيمة الحقيقية للتعليم العالي والبحوث الاكاديمية، ويجعلنا نتساءل: ما الفائدة من كل هذا الحشد الأكاديمي إن لم يكن له حضور في حياة الناس؟ بل الأدهى أن بعض الأبحاث – رغم أنها تُبذل فيها جهود ذهنية جبارة – تُرفض لأنها لا تلتزم بالقالب النظري الجامد، أو لا تتماشى مع اهتمامات مجالات النخبة، وكأننا ننتج لمرآتنا، لا لعالمٍ يحتاج إلى حلول واقعية، فأصبحت المعادلة باهتة.. كلما زادت الأبحاث، قلّ الأثر. ولأنني أعمل في بيئة أكاديمية، فإنني ألمس هذا التناقض يوميًا، أرى أساتذة كبارًا يجهدون أنفسهم في كتابة أبحاث دقيقة، لكنها لا تجد من يقرؤها خارج أسوار الجامعة، وأرى في الجانب الآخر بعض أصحاب الضمير اليقظ ممن يعمل في ادارات الحكومة في الميدان يبحثون عن حلول فورية لمشاكلهم، لكنهم لا يرون في البحوث الأكاديمية سوى ترف نظري لا علاقة له بالواقع، فعلا.. إنها فجوة لا تُقاس بالأمتار، بل تُقاس بعدد الفرص المهدرة، والثقة المتآكلة، والمعرفة الضائعة. فالدراسات تحدثت عن أسباب كثيرة لهذه القطيعة ومنها.. أنظمة المكافآت التي تكافئ الكم لا النوع، إلى الضغوط المتزايدة للنشر، وحتى أزمة المصداقية التي تتفاقم بسبب الممارسات البحثية المشكوك فيها. ولكنني أعتقد أن هناك سببًا آخر لا يقل خطورة، فقدان الشغف الحقيقي بالأسئلة الكبرى، فحين يتحول الباحث إلى موظف نشر، ويفقد الدهشة الأولى التي دفعته للبحث، فإن النتيجة تكون جافة، بلا حرارة، وبلا حياة. ورغم كل هذا، ما زال الأمل قائمًا، فأنا أؤمن أن بإمكاننا تصحيح المسار لو تحلّينا بالشجاعة الكافية لمراجعة أنفسنا، أن نكتب بلغة يفهمها غير المتخصصين، وأن ننخرط مع المجتمع ولا ننعزل عنه، وأن نعيد الاعتبار لدور الباحث كبانٍ للحضارة، لا كحافظ لأرفف المجلات المحكمة. أتمنى من أعماقي أن يدرك الساسة وأصحاب القرار في عالمنا العربي أن الباحثين والمفكرين ليسوا زينة معرفية تُستدعى في المناسبات، بل هم خزائن عقول تضم بين طياتها حلولًا لمشكلاتنا، ورؤى لمستقبلنا، وإجابات لأسئلتنا المؤجلة. كم أتمنى أن تصبح الاستعانة بالأبحاث والدراسات جزءًا أصيلًا من صناعة القرار، لا ترفًا أكاديميًا مؤجلًا إلى حين. لقد تناول الباحثون في دراساتهم الدقيقة مختلف جوانب الحياة: من الاقتصاد والتعليم، إلى الصحة والإدارة، ومن التنمية البشرية إلى التحولات الاجتماعية والديموغرافية، وقدموا رؤى تحليلية عميقة واقتراحات واقعية مدعومة بالأدلة. لكن المؤلم أن تلك الجهود كثيرًا ما تبقى حبيسة الرفوف أو المجلات العلمية، لا تجد طريقها إلى مكاتب الوزراء ولا إلى طاولات النقاش في غرف القرار. وأتمنى أيضا أن تكون هذه الصحوة الأكاديمية بداية لنهج جديد، يتقدم فيه البحث ليكون في خدمة الإنسان، لا في خدمة الورق، وأن تعود الجامعات لتكون منصات حياة، لا أبراج صامتة، وأن نعيد للعلم شرفه القديم، أن يكون نورًا يهدي، لا نصوصًا مهجورة في زوايا مكتبات مغلقة.
639
| 23 أبريل 2025
في عالم يزداد تداخلًا وغموضًا، ويكاد لا يستقر على نسقٍ واحد من الفهم أو الإدراك، تصبح الحاجة إلى التفكير وبناء نموذج أمثل للتفكير الابداعي أكثر من ضرورة وجودية، إنها مهمة إنقاذ، لا للواقع فحسب، بل للذات التي تغدو مهددة بالذوبان في طوفان المعلومات والانفعالات والانتماءات المتشابكة دون تمحيص. إننا اليوم أمام مرحلة تتكسر فيها البديهيات، ويعاد فيها تشكيل المعاني، فلا تعود المعرفة كما كانت، ولا تبدو الحقيقة ثابتة كما توهّمنا ذات زمن. في هذا المسار المتقلّب، ينهض سؤال عن طبيعة التفكير، لا بوصفه أداة تحليل فقط، بل كبوصلة نجاة في وجه الرياح العاتية. فالنموذج الجديد للتفكير الذي يقترحه الآن بعض الباحثين لا يَعدُ بالفصل بين الجوانب العقلية والوجدانية، بل يتكئ على فكرة شديدة العمق: أن التفكير ليس عملية ذهنية باردة، بل هو تفاعل حيّ بين العقل والوجدان، بين التجربة والسؤال، بين الماضي كذاكرة والحاضر كمصنع يفتح الاحتمالات والمآلات، وبهذا، لا تعود ممارسة التفكير ترفًا فلسفيًا، بل حاجة ملحّة في واقع الشباب الخليجي الذي يعيش على تقاطع التقاليد والتحديث، وعلى تخوم الانتماء المحلي والضغط العالمي، في قلب توازن هشّ بين الأصالة والتجديد. ولعلّ الإشكال ليس في غياب الرغبة في التفكير، بل في ضياع المنهج في طريقتنا في التفكير. إذ كيف تفكر في زمن يقنعك بالاستهلاك قبل تأمل المنتج، وبالتنميط والتصنيف قبل التساؤل والتحليل ؟ كيف تخلق فكرتك الخاصة حين يطاردك تقليد القوم كظلّ ثقيل؟ إن النموذج المقترح اليوم لا يفرض طريقة واحدة للتفكير، بل يتيح خريطة ذهنية متحررة، تعترف بتعدد الزوايا وشرعية الشك البنّاء الإيجابي، وتدفع نحو ممارسة واعية للتأمل وتحليل الأشياء، دون الخضوع التام لما يُعرض على عقلك من نتاج الآخرين، ودون الارتهان للمعتاد. من هنا، فإن إعادة بناء التفكير ليست مهمة فردية، بل هي مشروع جماعي يبدأ من التعليم، ويمر بالإعلام، ولا يكتفي بدروس تُلقّن، بل يطالب ببيئات تتنفس السؤال وتصنعه، في بيئات تمنح الشاب حق الخطأ، وحق التجريب، وحق الصمت أيضًا، لأن الصمت أحيانًا مقدمة ضرورية لصوت جديد. فإذا كنت تريد أن تطوّر تفكيرك وتخرج من النمط المعتاد، فلا تظن أن «الإبداع في التفكير» يعني فقط معارضة السائد أو التمرد على الواقع، بل يعني أن تبدأ بكتابة نصّك الخاص، نص يحمل وجهة نظرك، ويعكس تجربتك، ويعبّر عن طريقتك في فهم العالم، فلا تقلّد الآخرين لمجرد شهرة آرائهم، ولا تكرّر ما يُقال فقط لأنه مألوف. بل ابدأ بالتعبير عن أفكارك بأسلوبك، وكن صادقًا مع نفسك، ولا تخف من أن تكون مختلفًا، فقط اسأل كثيرًا، وراجع المسلمات، وجرّب أن ترى الأمور من زوايا جديدة، وسجّل خواطرك، وافترض حلولًا غير تقليدية، ثم ناقشها مع من تثق بعقولهم، وتذكّر أن التفكير الإبداعي لا يعني الفوضى، بل هو عملية واعية تُبنى على فهم عميق وتحليل واقعي.
516
| 16 أبريل 2025
من يرى تحولات المشهد الأمريكي الحاصلة الآن ويتأمل في ذلك بنظرة تاريخية، يدرك عمق الأزمة التي تعصف اليوم بأمريكا التي طالما تغنّى بأمجادها أجيال مع الأسف من العرب والمسلمين الذين هاجروا اليها عبر عقود طويلة ومكثوا بها، ويبدو أن تلك الدولة العظيمة والتي كانت تُقدَّم نموذجًا للديمقراطية والحرية، أصبحت بعد وصول ترامب تنزلق إلى هاوية القمع، والانقسام، وتصفية الحسابات، وذلك في ظل قيادة تعبث بالمؤسسات وتتنكر لمبادئ الآباء المؤسسين. فالملاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد في السنوات الأخيرة تحولات خطيرة تُنذر بانهيار داخلي قيمـي وسياسي، وأصبحت تتخلى تدريجيًا عن المبادئ التي تأسست عليها، مثل الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، و لعل ما حصل مؤخرا في غزة قد كشف قبح الادارة الامريكية وازدواجية المعايير لديها، فغدت هذه المبادئ التي طالما تغنت بها أمريكا دوما، تُفرغ من محتواها في ظل تصاعد النزاعات والتطرف السياسي، وتكميم الأفواه، وقمع الحريات، مثل ما رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي من ملاحقة للطلاب، وترحيل الأجانب، والتضييق على حرية التعبير خاصة تجاه القضية الفلسطينية، يكشف عن واقع جديد لدولة تسير في طريق التخلي عن إرثها الأخلاقي والدستوري. ومن قرأ التاريخ وتحولاته يجد أنه من قواعد التاريخ التي لا تتغير أن كل أمة تخلت عن مبادئها المؤسسة سقطت، مهما بلغت من القوة والاتساع، فالمبدأ الأول في سقوط الدول هو تفكك العقد الأخلاقي والالتزام السلوكي بين الحاكم والمحكوم حين تصبح السلطة أداة انتقام بدل أن تكون وسيلة إصلاح، وأما القاعدة الثانية فهي تآكل المؤسسات، وذلك عندما تنهار المهنية ويُعيَّن غير المؤهلين في المواقع الحساسة والحيوية، فضرب الكفاءة وهدمها داخل المؤسسات هو مسمار قاتل في نعش أي دولة، وأما القاعدة الثالثة هي فقدان العدالة وازدواجية المعايير، فحين يُقمع الطلاب لمجرد التعبير عن رأيهم في مظاهرة سلمية، وتُصنف الاحتجاجات الأخلاقية كجرائم أمنية، فإن النظام يكون قد اختار طريق السقوط الاخلاقي والمؤسسي، فالعدل هو أساس الملك، وإذا غاب، غابت معه شرعية الدولة، مهما ادّعت القوة أو السيادة. ولمن يقرأ في التاريخ السياسي الاسلامي يجد ذلك جلياً وواضحاً، فالدولة الأموية فقدت توازنها عندما غلب التعصب القبلي والترف على مبادئ العدل، والدولة العباسية انهارت عندما ضعفت القيادة واستبدت الرؤوس الفرعية وظهرت الثورات من الهامش غير المتوقع، وأما الدولة العثمانية، فقد بدأ تدهورها حين انشغلت بالحروب الخارجية وأهملت الإصلاح الداخلي، وفسدت إدارتها، وابتعدت عن مبادئ الشورى والعدل. * لذلك نجد أن القاسم المشترك في سقوط هذه الدول جميعًا كان الابتعاد عن المبادئ التأسيسية التي قامت عليها، واليوم نجد الولايات المتحدة تُعيد هذا السيناريو، على مرأى العالم بلا حياء، وبنفس المؤشرات كالقمع، والمحاباة، وغياب العدالة، وتغليب المصالح على المبادئ، والتاريخ لا يرحم أمة تنسى لماذا قامت، ولا تعرف إلى أين تتجه.
501
| 09 أبريل 2025
نعيش هذه الأيام فرحة عيد الفطر السعيد، بعد أن ودّعنا شهر الرحمة والمغفرة، والذي نسأل الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالأمن والسلام والوحدة. إلا أننا في دوامة الحياة اليومية، حيث تتزاحم المهام والالتزامات، وتتكاثر هموم الأعمال، ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي يدور في فلك الواجبات غير المتناهية دون أن يلتفت إلى روحه، يصبح الفرح شيئًا مؤجلًا، مؤجَّلًا إلى حين وإلى وقتٍ غير معلوم، نجد البعض يتساهل حتى في اقتناص الفرحة الموسمية والمتمثلة بالعيد وما يحويه من مشاعر روحانية واجتماعية وما ذلك الا كسل اجتماعي وفتور نفسي. *والحقيقة أن الفرح ليس خيارًا هامشيًا، بل حاجة إنسانية فطرية، هو ليس نقيضًا للجدية، ولا عدوًا للإنجاز، بل هو وقود للنفس، وتجديد للمعنى، وإعادة ضبطٍ لنبض القلب، فالإنسان بطبيعته لا يمكنه أن يستمر في العطاء والإنتاج إن لم يتنفس بهجة الحياة بين الحين والآخر، والفرح ليس فقط لحظة زهو، بل توازن داخلي، ودفقة نور تذكر الإنسان بأنه ما زال حيًّا بروحه لا بجسده فقط. حين يأتينا العيد، نجد أن من المنطق والطبيعي أن يتسلل الفرح إلى أرواحنا لا بوصفه احتفالًا موسميًا دينيا عابرا، بل كتذكير ناعم بأننا نستحق السعادة والفرح، مهما أثقلتنا الأعباء، ومهما جرحتنا الأيام، ونستحق أن نضحك، أن نرتدي الجميل، أن نُصافح بحب، أن نعيش لحظة لا يسرقها القلق من الغد، ولا يفسدها حنين إلى ما لا يُستعاد، والعيد يحمل رمزية عميقة، فهو لحظة توقف في الزمن، تُمنح للروح كي تتنفس، للقلوب كي تتلاقى، وللنفس كي تستريح من جدية الحياة. *لكن لماذا نؤجل الفرح أو لا يحاول استشعاره؟ لأننا ببساطة نربطه بشروط، فلا نفرح إلا إذا أنجزنا شيئًا ملموساَ، أو حققنا هدفا ماديا، أو تحسنت الأحوال المعيشية، فالبعض يرهن الفرح لحدوث ما لا يمكن السيطرة عليه، ثم يستغرب لماذا لا نشعر بالسعادة. وهكذا، نبقي مع الأسف الفرح في غرفة الانتظار، ونسجن أنفسنا في دائرة التأجيل والتمني للمشاعر، فنؤجل الفرح، حتى حين يكون بين أيدينا، ونؤجله لأنه يتطلب منا جرأة على كسر القالب، وتخفيف الحمل، والخروج عن النص. والناظر الى حقيقة الفرح يجد أنه لا يُمنح من الخارج، بل يُصنع من الداخل، هو موقف داخلي قبل أن يكون حالة ظرفية. والعيد، في جوهره، ليس مجرد تقويم أو مناسبة، بل هو دعوة روحية لمصالحة النفس، وتجديد العلاقة بالحياة، ففي العيد، لا نفرح لأن كل شيء كامل، بل نفرح رغم أن لا شيء كامل بل النقصان شأن الأمور والأشياء، *ولا ننسى أن الفرح لا يكتمل حين يكون فرديًا، بل حين يمتد للآخرين، خصوصا في وجوه الأطفال، ويكمن في يدٍ تعطي، وفي زيارة يتجدد بها الود، فنجد المعنى الأعمق للعيد. فالعيد يا أحبابي هو موسم للتخفف من الأثقال، لتصفية الخواطر، لتقبيل الذاكرة، وللسماح للفرح بأن يتنفس في صدورنا، فلا تؤجلوا فرحتكم. وعيدكم مبارك.
645
| 02 أبريل 2025
في زمن تعالت فيه صرخات العرب، وضاعت فيه الحقائق بين دخان الحروب وأشلاء الأحلام، بات السؤال يحترق في ضمائر المخلصين من هذه الأمة العربية متساءلين: إلى متى نظل نحن العرب أسرى دور الضحية؟ إلى متى نعوّل على سردية المؤامرة، ونتقن البكاء على الأطلال، بينما ترتفع رايات الأمم الأخرى على أنقاض أوطاننا؟ عجبا لنا ولزمننا، إنه زمن العرب الذي يترنح بين ماضٍ تليد صنعه الأجداد، وحاضر مشلول نرثي فيه أنفسنا، وننتظر معجزة تسقط من السماء، دون أن نمد أيدينا وننتزع مصيرنا من بين فكّي التبعية والتيه والخنوع والخضوع. فقد صار العربي يتفنن في سرد القصص عن الاحتلال، والاستعمار، والخيانة، دون أن يسألوا أنفسهم: ماذا قدّمنا نحن؟ كيف نوقف هذا السقوط الحر؟ متى تحوّلنا إلى أمة تُحسن البكاء ولا تحسن الفعل؟ متى نكف عن اجترار ماضينا بحسرة، وننهض لصناعة مستقبل يليق بعظمة العرب التي دفناها بأيدينا؟ فالأمة العربية، منذ ما يزيد على قرن، تتقمص دور الضحية ببراعة، باستسلام واضح للعيان، فثقافة الاستضعاف تملكت عقولًا كثيرة من العرب، وتروّج لنظرية المؤامرة كذريعة للكسل، وتهرب من مواجهة الذات. فنلوم القوى الخارجية على مصائبنا، ونتجاهل فساد إداراتنا العربية، وسلبية شعوبنا، وتمزيق وحدتنا بأيدينا، وقيام إعلامنا بتضليلنا، وكلما تقدمت أمة، رمينا نجاحها على أنها لعبة من ألاعيب الاستعمار، بينما نغرق في تخلف صنعناه بأيدينا، ونحن نصفق له على أنه قدر لا فكاك منه. لذلك نجد – حتى نكون عمليين – أن الحل يبدأ بإعادة صياغة العقل العربي، فنحن بحاجة إلى ثورة فكرية حقيقية تخلع عنّا عقلية الضحية، وتزرع مكانها قيم المبادرة والعمل، بعيدًا عن جلد الذات أو تعليق الفشل على شماعة الآخر، وهذا لا يتحقق إلا من خلال إيجاد مناخ سياسي يؤمن بالتعبير عن المشكلة والتنبيه لها والإشارة إليها، ثم تعليم واعٍ، لا تعليم تلقيني يخرّج حفّاظًا يمجدون أوهامًا لا تصنع مستقبلًا، فنحن نرنو لتعليم ينتج مفكرين ومبدعين يحملون رؤية جديدة تنهض بالأمة. وإلى جانب ذلك، لا بد من بناء مؤسسات حقيقية، فالدول القوية تنهض بالمؤسسات الراسخة، لا بالأشخاص العابرين، ونحن بحاجة إلى قضاء مستقل، وإعلام حر، واقتصاد منتج، يخلق فرصًا ويحرر الإرادة الوطنية من التبعية، وبعيدًا عن انتظار الزعيم المخلّص الذي قد لا يأتي. فإحياء المشروع العربي المصيري الوحدوي أصبح ضرورة، ومشروع لا يستند إلى حنين عاطفي للماضي، بل إلى رؤية معاصرة تنطلق من المصالح المشتركة، وتجاوز الخلافات المصطنعة بين العرب والأقطار العربية، والأهم من ذلك كله هو إشاعة ثقافة العمل والإنجاز، بدلًا من ثقافة الشكوى والتذمر، لأن المستقبل لا ينتظر من يبرع في الحزن، بل من يملك خطة واضحة للعمل والإصلاح.
1311
| 26 مارس 2025
إن المتأمل في العادات والتقاليد يجد أنها ليست مجرد مظاهر شكلية أو أفعالًا مكرورة توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، بل هي خلاصة التجربة والممارسة الإنسانية لمجتمع ما عبر الدهور، فهي تعكس رؤيته للحياة، وتترجم قيمه ومعتقداته وثقافته، كما تعكس نظرته إلى الوجود والعالم من حوله، فإن العادات والتقاليد هي بمثابة الذاكرة الجمعية للشعوب، وسجلها الحيّ الذي يحفظ ملامحها وهويتها، ويصنع من خلالها سلوك الأفراد وينظّم علاقتهم بعضهم ببعض، كما تُرسّخ قواعد الانتماء، وتعزّز الشعور بالهوية والخصوصية الثقافية، فيعرف بها الإنسان نفسه، ويشعر بالانتماء إلى مجتمعه وبيئته، ويدرك موقعه ضمن نسيج اجتماعي واسع ومتداخل. إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح في هذا السياق: هل العادات والتقاليد مقدسة؟ وهل ينبغي التمسك بها على إطلاقها، مهما كانت طبيعتها أو أثرها؟ إن الحقيقة التي لا خلاف فيها أن التقديس لا يكون إلا لما ثبت بنصٍ من وحي السماء، أما العادات والتقاليد والأعراف، فهي جهد بشري خالص، ونتاج لسياق تاريخي مجتمعي وثقافي محدد، فالعادات خاضعة للتطور والنقد، والتقاليد قابلة للمراجعة والاختبار مع تغيّر الأزمنة والأحوال والظروف، فما كان منها منسجمًا مع فطرة الإنسان ومصلحته العليا العامة، ومحققًا للعدل، ودافعًا إلى صيانة الكرامة الإنسانية، فهي تقاليد وأعراف تستحق الحفظ والصيانة والاعتزاز. وأما ما تحوّل منها إلى قيدٍ يكبل الإنسان وحريته الفكرية والمعرفية والسلوكية، أو حاجزٍ يحول دون تطور المجتمع وارتقائه، فهو مما تجب مراجعته، بل وربما تجاوزه، بعقل راشد، وبصيرة نافذة. لذلك فالتقاليد ليست صخورًا صماء لا تتحرك، بل أشبه بالنهر الجاري، يتجدد في مساره العام، ويحمل شيئًا من ماضيه القديم، لكنه لا يتوقف عند نقطة واحدة من حياة البشرية، فالمجتمعات التي تجمّدت عند أعراف لم تعد تناسب روح العصر الآني، نجد أنها قد أصابها الوهن والجمود، وتراجعت مكانتها بين الأمم. وكما هو الغلو مذموم فالتجافي مذموم أيضا، فنرى المجتمعات التي نسفت جذورها تمامًا، وتنكرت لموروثها، تاهت عن ذاتها، وفقدت خصوصيتها، وضاعت في زحام الأمم. وقد جاء الإسلام بتشريعاته وأطره الواسعة ليقدم موقفًا متوازنًا تجاه الأعراف والعادات والتقاليد، فلم يرفضها لأنها موروث بشري، بل قبِل منها ما وافق مبادئ العدل والإحسان، ورفض ما يعارض الكرامة أو يكرّس الظلم، بل إن كثيرًا من التقاليد العربية السابقة، مثل إكرام الضيف، وصلة الرحم، والوفاء بالعهد، أقرها الإسلام، وشجّع عليها. وهذا يدل على احترامه لما هو أصيل ومتجذر، ما دام لا يصادم أصول الدين. وفي نهاية الأمر، تبقى النصيحة لكل مجتمع في الوجود، أن يعيد النظر في عاداته وتقاليده بين الحين والآخر، بعين الحكمة والعدل، فيحافظ على ما يربطه بجذوره، ويمنحه هويته وشخصيته، ويتخلّى عما يقيّده ويعيق حركته نحو التقدم، فالعادات حين تتجدد بروح العصر، تبقى حيّة نابضة، تخدم الإنسان، ولا تستعبده.
861
| 22 مارس 2025
يروى في التاريخ أن الحسن البصري أفتى يومًا فتوى، فخالفه ابن سيرين، فردّ عليه ببيانٍ جليّ، وحجةٍ قوية. فما كان من الحسن إلا أن أطرق رأسه، ثم قال: "كلنا خطّاء، وخير الخطّائين من أناب للحقّ وأذعن للصواب". فلم يرَ في الردّ غضاضة، ولا في النقد مهانة، بل علم أن العالم يؤخذ منه ويُردّ عليه، وأن الفضل لا يُمحى بزلة، ولا العلم يُنسف بهفوة. نجد في كل عصر، أن العلماء والمثقفين لا يزالون بمثابة منارات تضيء الطريق أمام مجتمعاتهم، حاملين شعلة الفكر والتجديد، ولكن ماذا يحدث عندما يخطئ أحدهم؟ هل يُمحى تاريخه بضربة قاضية؟ هل تُنسف جهوده كأنها لم تكن؟ نرى أن التعامل مع أخطاء العلماء والمثقفين هو في جوهره اختبار لمستوى الوعي والنضج الفكري في المجتمع. أحبابي.. إن الخطأ طبيعة بشرية، والعصمة ليست من سمات المفكرين ولا العلماء، بل هي شأن إلهي خالص يهبه لأنبيائه. ومع ذلك، نرى اليوم من يتعامل مع زلات العلماء وكأنها جريمة لا تُغتفر، فيمارس محاكمات علنية قاسية، تُجرد صاحبها من كل منجزاته السابقة، كأن تاريخه الفكري والعلمي كان وهماً لا حقيقة له وصرحا من خيال قد هوى، فإن هذا اللون من التفكير قائم على رؤية نقدية أحادية وحادة، لا تعترف بالتطور والنمو، بل تحاكم الإنسان بلحظة واحدة من حياته. فالنقد الموضوعي البنَّاء شيء، والهدم المتعمد شيء آخر، ونقد العالم والمثقف أمر مشروع، بل ضروري، فهو جزء من ديناميكية الفكر وتطوره وتحسينه، لكن يجب أن يتم ذلك في إطاره الصحيح، بعيداً عن التهجم الشخصي أو النوايا المغرضة والطعن في الذوات، فاحترام الشخص لا يعني أبداً تبني كل آرائه، كما أن مخالفة الرأي لا تعني الطعن في الشخص ذاته. يمكن أن نخالف عالماً أو مفكراً في مسألة ما، ومع ذلك نظل نُقدر إسهاماته ونحفظ له مقامه العلمي. وهنا يكمن الفارق الجوهري بين النقد البناء والتشهير، فالأول يستهدف تصحيح الفكرة، والثاني يستهدف إلغاء الإنسان ذاته، والشعوب التي تتقدم هي التي تُدرك هذا الفارق بوضوح، فتتعامل مع الفكر كحقل للنقاش والجدل، لا كحلبة للصراع والإقصاء. وعلى جانب آخر فالانحياز المطلق، سواء كان للعلماء والمثقفين وادعاء عصمتهم والتطبيل لهم، هو مظهر من مظاهر ضيق الأفق والجهل المريع، فكما أن العداء المطلق للعلماء خطأ، فإن تقديسهم واعتبارهم فوق النقد خطأ لا يقل فداحة، والمطلوب هو موقف متزن، يعترف بفضل المبدعين من العلماء والمثقفين لكنه لا يُنزههم عن الخطأ، فيحترم الأشخاص لكنه لا يُلزم نفسه بتبني آرائهم دون تمحيص. وفي النهاية، يجب أن نعي أن التراث العلمي والفكري هو بناء تراكمي، وكل عالم أو مفكر يضيف لبنة في هذا البناء، فإن أخطأ، نبهناه، وإن أصاب، شكرناه، لكن لا ينبغي أن يكون الخطأ معول هدم يهدم كل شيء، فالعبرة ليست في السقوط، بل في القدرة على النهوض، ولعلنا حين نُدرك ذلك نصبح مجتمعاً أكثر إنصافاً ونضجاً، وأكثر قدرة على احتضان الفكر بكل ألوانه.
528
| 12 مارس 2025
يعتقد بعض الموظفين أن رمضان هو شهر التباطؤ في الأداء والانخفاض في الإنتاجية، متناسين أنه يمكن أن يكون فترة مثالية لتعزيز الكفاءة والفاعلية في بيئة العمل، فعبر التاريخ، كان رمضان شهر الإنجازات والانتصارات، فلماذا أصبح اليوم مرتبطًا بالتأجيل والتسويف؟ من يتأمل ذلك يجد أن التحول من ثقافة الكسل إلى ثقافة الإنتاج في رمضان يتطلب وعيًا إداريًا، وتخطيطًا فعالًا، وانضباطًا شخصيًا، فالمنظمات الناجحة تدرك أن إدارة الوقت والطاقة خلال هذا الشهر يمكن أن تزيد من كفاءة العمل وتساعد في تحقيق الأهداف المؤسسية دون الإخلال بروحانية الشهر الفضيل. فكيف نجعل رمضان شهرًا للكفاءة والإنجاز؟، أعتقد أنه أول المتطلبات لتحقيق الكفاءة في رمضان هو إعادة ترتيب الأولويات واستغلال أوقات الذروة بذكاء، فالساعات الأولى من اليوم، بعد السحور غير الثقيل طبعا، هي الأكثر إنتاجية بسبب صفاء الذهن ونشاط الجسم، لذك، ينبغي التركيز خلالها على المهام التحليلية والإبداعية، بينما يمكن تخصيص فترة ما بعد الظهيرة للمهام الأقل استنزافًا للطاقة مثل الاجتماعات الروتينية والتنسيق الإداري. وأحيانا نجد أن بعض المؤسسات تقلل ساعات العمل في رمضان دون استراتيجية واضحة، مما قد يؤدي إلى تراكم الأعمال بعد الشهر الفضيل، لذلك فالحل يكمن في تصميم نظام مرن يوازن بين تقليل عدد الساعات وزيادة الفاعلية، من خلال تحديد الأهداف بوضوح وتحفيز الموظفين على الإنجاز ضمن الإطار الزمني المتاح. ونأتي هنا إلى أن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الموظفون خلال رمضان هو الاعتماد على التأجيل والبطء في إنجاز المهام، لذلك يجب تشجيع التخطيط المسبق، ووضع قائمة بالمهام اليومية، والالتزام بإنجاز الأولويات بدلًا من تأجيلها. ويجب علينا أن نتذكر البعد الروحاني للشهر الفضيل، فرمضان شهر تهذيب النفس والانضباط الذاتي، وهذه القيم يمكن توظيفها في بيئة العمل، عندما يدرك الموظف أن الالتزام بالعمل بإتقان هو جزء من أداء الأمانة الوظيفية، فإنه سيعمل بجدية أكبر، ويمكن للإدارة تعزيز هذا المفهوم عبر مبادرات تحفيزية، مثل مكافآت الأداء، أو حملات «العمل عبادة» التي تربط بين العطاء الوظيفي والأجر الروحي. ولا ننسى أبدا دور العادات الغذائية والنوم الجيد اللذين يلعبان دورًا حاسمًا في الحفاظ على النشاط خلال رمضان، فالموظفون الذين يتبعون نظامًا صحيًا متوازنًا، ويتجنبون الإفراط في الطعام عند الإفطار، ويتمتعون بساعات نوم منتظمة، يكونون أكثر تركيزًا وأعلى كفاءة في أداء مهامهم. لذلك فقد حان الوقت لتغيير الصورة النمطية عن رمضان كشهر للكسل والخمول إلى شهر للإنجاز والفاعلية، فالعمل في رمضان ليس عبئًا، بل فرصة لإعادة اكتشاف قدراتنا وتحقيق التوازن بين الروحانية والإنتاجية، وإذا كان أجدادنا قد حققوا انتصارات تاريخية عظيمة في هذا الشهر، فمن الأولى أن نحقق نحن انتصاراتنا المهنية والوظيفية.
591
| 05 مارس 2025
الصباح هادئ جدا، والهواء نقي، لكن هناك شيء مختلف هذا اليوم، فالضوء الذي يتسلل عبر النوافذ يبدو أكثر نقاءً، والطرقات أقل ازدحامًا، والمباني من حولي تعكس الشمس دون أن تستهلكها. هنا مبنى حكومي حديث، واجهته الزجاجية تمتص الطاقة الشمسية لتضيء مكاتبه الداخلية، وتزيد موظفيه إشراقا في نفوسهم وأرواحهم أثناء عملهم، وعند المدخل الرئيسي، عبارة منقوشة تقول: "بسلوكنا الأخضر.. نحن نرعى بيئتنا كما نرعى خدماتكم". السلوك الأخضر ليس مجرد إجراء، بل حالة وعي، إنه تلك اللحظة التي يدرك فيها الإنسان أن الأشياء الصغيرة التي يقوم بها يوميًا لها تأثير حقيقي، وأن لكل فعل صدى أبعد مما يتخيل. فكيف يمكن لمؤسسة حكومية أن تكون أكثر خضرة؟ ربما ببيئة عمل تقلل من استخدام الورق، أو بإضاءة ذكية تتكيف مع حركة الناس، أو حتى بمبانٍ تحتضن الأشجار بدلاً من أن تقتلعها. السلوك الأخضر ليس مجرد نزعة حديثة أو اتجاهًا بيئيًا عابرًا، بل هو مفهوم علمي إداري عميق وقائم على دراسات في الإدارة والاستدامة، يربط بين تصرفات الأفراد والمنظمات وتأثيرها على البيئة. فعلا إنه الترجمة العملية لفكرة أن القرارات الصغيرة، سواء في المؤسسات الحكومية أو في الحياة اليومية، يمكن أن تصنع فارقًا حقيقيًا في الحفاظ على الموارد وتقليل الأثر البيئي. في المباني الحكومية الحديثة، لم تعد الاستدامة رفاهية، بل ضرورة متكاملة مع أساليب العمل. فالزجاج العاكس للحرارة يقلل الحاجة إلى التكييف، والإضاءة الذكية تعمل فقط عند الحاجة، بينما تقلص المعاملات الرقمية استهلاك الورق بشكل جذري. وهذه التغييرات ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل ناتج دراسات علمية تؤكد أن الإدارة البيئية الفعالة تساهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقليل التكاليف على المدى الطويل. السلوك الأخضر يتجاوز كونه ممارسة مؤسسية ليصبح نمط حياة وظيفي، وعندما يصبح تقليل الهدر عادة وتقليدا، وعندما يتحول الحفاظ على الطاقة إلى وعي داخلي، فإن الاستدامة تتحقق ليس فقط في القوانين، بل حتى في السلوكيات اليومية. والأبحاث العلمية تشير إلى أن الأفراد الذين يعملون في بيئات تتبنى الاستدامة يصبحون أكثر ميلًا لتطبيق هذه العادات في منازلهم أيضًا وحياتهم الشخصية، مما يخلق تأثيرًا متسلسلًا يجعل المجتمع بأكمله أكثر وعيًا بيئيًا. لذلك نجد أن الحديث عن السلوك الأخضر ليس ترفًا فكريًا، بل استجابة علمية لاحتياجات العصر. فالعالم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، والتغير المناخي ليس مجرد خبر في نشرات الأخبار، بل واقع يتطلب حلولًا عملية تبدأ من أصغر التفاصيل، ونستطيع أن نقول بأن السلوك الأخضر ليس مجرد خيار، بل هو مسؤولية ووعي بأن كل قرار، مهما بدا بسيطًا، يترك أثرًا، وعندما يصبح هذا الإدراك جزءًا من ثقافة المؤسسات والأفراد، فإن العالم حتمًا سيصبح مكانًا أنقى، وأجمل، وأكثر قدرة على الاستمرار.
810
| 26 فبراير 2025
كما تعلمون أن الإدارة ليست مجرد قواعد علمية ورقمية فقط، بل هي فن يستند إلى فهم الطبيعة البشرية والتعلق بالبصائر والنظر الى حوادث الأمور، وهنا يتلاقى الفكر الفلسفي مع علم الإدارة، حيث يمكن لأفكار الفلاسفة العظماء أن تقدم إضاءات غير تقليدية للقادة السياسيين والاداريين اليوم، فمن سقراط الذي أسس للحوار قواعد النقد، إلى العلامة ابن خلدون الذي وضع نظريات في العمران والاجتماع البشري كوحدة تنظيمية، تتجلى الفلسفة كمنبع لا ينضب للحكمة الإدارية. وقد كان سقراط يؤمن بأن المعرفة تبدأ بالسؤال وليس بالإجابة، وهو نهج يمكن للقادة تبنيه من خلال الإدارة بالحوار والمناقشة، حيث يمكن استبدال الأوامر المباشرة بأسئلة تحليلية تحفيزية ملهمة تدفع الموظفين للتفكير النقدي والبحث عن حلول مبتكرة في أداء أعمالهم، مما يعزز روح الفريق والشعور بالمسؤولية. وفي المقابل، رأى أفلاطون أن الدولة المثالية يقودها “الفيلسوف الملك”، وهو تصور يمكن إسقاطه على القيادة الإدارية حيث يحتاج القادة في المنظمات والمؤسسات إلى رؤية استراتيجية عميقة تتجاوز الحلول السريعة إلى التفكير في الأثر البعيد للقرارات، والحكمة من قراراتهم، مما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات. وأما أرسطو، فقد قدم مفهوما يحقق التوازن بين التطرفات والمتناقضات، وهو ما يعكسه القائد الناجح في قدرته على اتخاذ القرارات بحكمة بين الحزم والمرونة، والجمع بين المخاطرة والاحتياط، وبين الابتكار والمحافظة على الاستقرار، مما يجعل قراراته أكثر عقلانية وأقل اندفاعًا. أما العلامة ابن خلدون، فقد وضع أنموذجًا لفهم دورة حياة الدول والمجتمعات، وهي نظرية يمكن تطبيقها على عالم الأعمال والمنظمات والمؤسسات، حيث تمر تلك المنظمات بمراحل مبتدئة بروح الفريق والابتكار في مرحلة النشأة، ثم تزدهر مع تحقيق النمو، قبل أن تدخل في الجمود الإداري بسبب إحلال البيروقراطية والترهل الإداري محل الإبداع، وهنا إذا لم تتمكن من تجديد نفسها، فقد تصل إلى الانهيار والموت حالها حال البشر. فالقائد هنا إن تبنى حكمة الفلاسفة فسوف يدرك أن فهم الدورة التنظيمية تمكنه من اتخاذ قرارات استباقية تمنع مؤسسته من التراجع، وذلك من خلال تبني ثقافة الابتكار وإعادة الهيكلة الدورية لتجنب الركود والموت الإداري. ومن منظور آخر، نجد أن الفلاسفة لم يتحدثوا فقط عن نظم الحكم والإدارة من حيث اتخاذ القرارات والصرامة في شؤون الحكم، بل ناقشوا أيضًا الأخلاقيات المرتبطة بها، حيث أكد سقراط على أهمية تبني النزاهة من القائد في أطروحاته، بينما شدد أفلاطون على أن الحاكم أو القائد لا يجب أن يسعى وراء مكاسبه الشخصية بل يجب أن يضع مصلحة الجماعة فوق كل اعتبار، وهو ما يتطابق مع مفاهيم الحوكمة الرشيدة في الشركات الحديثة. فالفكر الفلسفي يمكن أن يساعد أيضًا في فهم تعقيدات بيئة العمل المعاصرة، حيث إن القائد الذي يتبنى نهجًا سقراطيًا في النقاش وبناء الحوارات، ونهجًا أفلاطونيًا في صياغة الرؤية والحكمة البعيدة، ونهجًا أرسطويًا في تحقيق التوازن بين المتناقضات والمصالح، ونهجًا خلدونيًا في استشراف المستقبل وفهم تقلب الأيام والدول، سيكون قادرًا على إدارة فريقه ومؤسسته بفعالية وتحقيق النجاح المستدام.
687
| 19 فبراير 2025
في عالم السياسة والفكر، حيث تلتقي الحكمة بالقوة الناعمة، تبرز لُولوة الخاطر كنموذج للمرأة العربية المثقفة، فهي ليست مجرد مسؤولة سياسية، بل مفكرة وأديبة، استطاعت أن تقدم خطابًا متوازنًا يدمج بين الذكاء في الادارة المؤسسية وبين الرؤية الثقافية العميقة، مما جعلها صوتًا مؤثرًا في المشهد العربي ولافتا في المشهد الدولي، من خلال عملها تمكنت من إبراز صورة جديدة للمرأة العربية القادرة على التأثير في صناعة العمل السياسي الرصين والمحاط بالفكر المستنير والمستند إلى ثقافة واسعة وفهم عميق لمجريات الأمور. فحين نتابع مسيرتها، يتبادر إلى الذهن اسم آخر من أعماق التاريخ الإسلامي وكأن لولوة الخاطر قد استدعت تلك الشخصية من أعماق التاريخ العربي الى حاضرنا، ألا وهي السيدة المبجلة فاطمة الفهرية – طيب الله ثراها - رغم الفاصل الزمني الشاسع بينهما، إلا أن كلتيهما جسدت صورة المرأة القادرة على الجمع بين الإدارة والفكر، فكما جمعت "الفهرية" بين الإدارة الحكيمة والرؤية العلمية في القيروان في ذلك الزمان البعيد، جمعت "الخاطر" بين الفكر والسياسة، فكلتاهما لم تكتفِ بالدور التقليدي للمرأة، بل خاضتا مجالات معقدة ونجحتا في ترك بصمة بارزة. * فأما عن السيدة المبجلة فقد ولدت فاطمة الفهرية في القرن التاسع الميلادي بمدينة القيروان، وانتقلت مع أسرتها إلى مدينة فاس المغربية، التي كانت آنذاك مركزًا حضاريًا مزدهرًا، وبعد وفاة والدها، ورثت ثروة كبيرة، لكنها لم تسعَ وراء متاع الدنيا، بل قررت توظيف هذه الثروة لبناء مشروع حضاري خالد له أثر في منظومة التعليم والتدريس عبر التاريخ، نعم أحكي عن جامعة القرويين، أقدم جامعة تعليمية في التاريخ البشري، والتي أصبحت منارة علمية استقطبت كبار العلماء والمفكرين من مختلف بقاع العالم الإسلامي وأوروبا، فلم يكن بناء جامعة القرويين مجرد مشروع خيري من قبل السيدة المبجلة فاطمة، بل كان خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ العلم في المجتمع، مما يعكس رؤيتها الثاقبة ودرايتها بأهمية التعليم في بناء الأمم. والعجب أنه لم يكن دور السيدة فاطمة الفهرية مجرد تمويل بناء الجامعة، بل أشرفت على المشروع بنفسها، وحرصت على أدق التفاصيل الهندسية والمعمارية، مما يجعلها من أوائل النساء في التاريخ اللواتي جمعن بين الفكر والإدارة الفعالة. لقد أرادت أن يكون هذا الصرح العلمي مركزًا لنشر المعرفة، فلم تقتصر الدراسة فيه على العلوم الدينية، بل امتدت إلى الفلسفة، الطب، الرياضيات، والفلك، مما جعل جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم ما زالت قائمة حتى اليوم، كما استقطبت الجامعة نخبة من العلماء الذين أثروا الفكر الإنساني وساهموا في تطور العلوم. * إن التشابه بين السيدتين يتجلى في قدرتهما على الجمع بين الإدارة والرؤية الثقافية، وبين التأثير العملي والفكري. فكما ساهمت "الفهرية" في بناء مؤسسة علمية تركت أثرًا خالدًا، تعمل "الخاطر" اليوم على تقديم نموذج جديد للقيادة النسائية، حيث تتداخل الادارة المؤسسية مع الفكر والثقافة، والسياسة مع الأدب. فرسالتي لأبناء جيلي الغر الميامين، أنتم امتداد لإرث عريق صنعه أجدادكم بالحكمة والعلم والإدارة الفاعلة، فلا تكتفوا بالنظر إلى الماضي بإعجاب وبكاء على أطلاله، بل اجعلوه منارة حية مستنيرة تستلهمون منها عوامل النهضة في أنفسكم، فتعلموا من رموز التاريخ العربي كيف تجتمع الفكرة المعنوية مع العمل التطبيقي، فأنتم القادرون على استكمال المسيرة، على بناء مجد جديد لكم يجمع بين الأصالة والابتكار.
1128
| 12 فبراير 2025
مساحة إعلانية

عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب...
14373
| 08 فبراير 2026

يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة،...
1443
| 10 فبراير 2026
لم يكن الطوفان حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه مع...
801
| 10 فبراير 2026

تعكس الزيارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة العربية...
624
| 05 فبراير 2026

لقد طال الحديث عن التأمين الصحي للمواطنين، ومضت...
585
| 11 فبراير 2026

يشهد الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة حالة مزمنة...
546
| 09 فبراير 2026

منذ إسدال الستار على كأس العالم FIFA قطر...
507
| 11 فبراير 2026

لم يعد هذا الجهاز الذي نحمله، والمسمى سابقاً...
495
| 09 فبراير 2026

لم يكن البناء الحضاري في الإسلام مشروعا سياسيا...
483
| 08 فبراير 2026
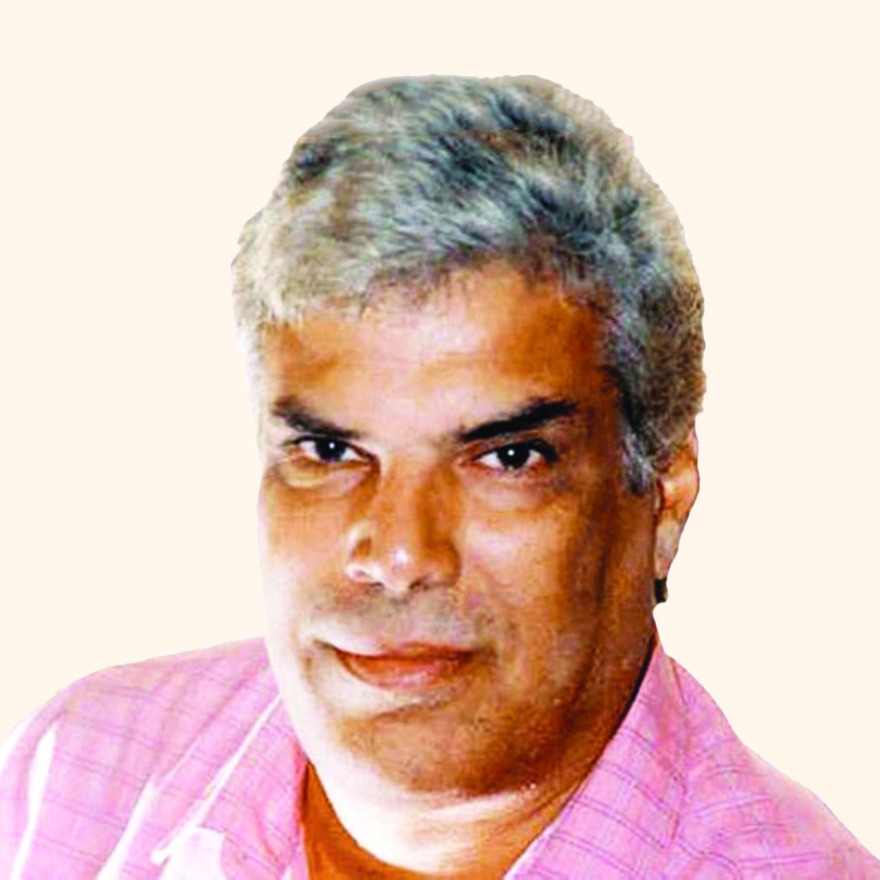
«الآخرة التي يخشاها الجميع ستكون بين يديّ الله،...
447
| 05 فبراير 2026

يستيقظ الجسد في العصر الرقمي داخل شبكة دائمة...
435
| 10 فبراير 2026

الثاني من فبراير 2026م، ليلة النصف من شعبان...
414
| 09 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
د. جاسم الجزاع
* باحث وأكاديمي كويتي
Jassimaljezza@hotmail.com
عدد المقالات 119
عدد المشاهدات 104700

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل





