رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عندما نعود بذاكرتنا إلى الزمن البعيد حيث مجالس العلم القديمة، على ذلك الحصير البسيط والبنيان المتواضع وشيخ جليل وطلبة نجباء، لم تكن العلاقة بين المريد وشيخه تبدأ بالتداول المعلوماتي والفكري، بل بالصمت والإنصات الذي يسبق السؤال، وصناعة التربية والقدوة في الطرفين العالم والمتعلم، فقد كانت تلك العلاقة تربيةً للعقل والروح معًا، يُرى فيها الشيخ قبل أن يُسمع، ويُفهم من حضوره أكثر مما يُفهم من عباراته، ويعرف المريد أنه أمام عقلٍ حر وليس عقلاً يباع وقت الحاجة وأمام انسان يملك من المروءة والاخلاق ما يعفه لقبول أفكاره العلمية والثقافية. ولكن حين أنظر اليوم إلى صورة المثقف في زماننا وفي الفضاء العام، أشعر أن تلك المسافة الإنسانية قد اتّسعت بين المريد الآن وشيخه ؛ فالفكر لم يعد يصل الناس عبر علاقة مباشرة في أكثر الأحيان، بل عبر منصّات افتراضية، ولم يعد المثقف يُعرف بأثره الحقيقي وأخلاقياته المثلى بل بموقعه الآن في السياق الافتراضي والمنصات وكذلك مدى الرضا السلطوي السياسي عنه، والتفكير دوماً بماهية الجهة التي يتكلم عنها، ولحساب من يعمل ؟ وهكذا من أسئلة التحقيق التي تلاحقهم، حتى صار موقع المثقف يسبق الفكرة والانتماء السياسي او الايديولوجي يسبق عمق المعلومة ومنفعتها. ففي هذا السياق، فقد المثقف الآن شيئًا جوهريًا هو « ثقة الناس»، لكن ليس لأن الناس تغيّروا كثيرًا، بل لأن المثقف الآن حوصر في أطر لا تشبهه، إطار سياسي، اقتصادي، أمني.. الخ، أو اختار الصمت حين كان الكلام واجبًا، وبين الصمت والخطاب المحسوب ظهر فراغٌ في الفكر لم يملؤه إلا الشعبوية. فالشعبوية التي ظهرت فجأة، - وأعني بها أن يتصدر العلم ومنابره الشارع العام والأفراد غير المتخصصين من الشعب و ليس النخب الفكرية -، لم تنشأ من فراغ، بل جاءت بوصفها استجابة مباشرة لشعورٍ عام بالإقصاء والفجوة بينهم وبين المفكرين المثقفين إلا من رحم الله، وبأن الخطاب النخبوي لم يعد يفهم الناس ولا يصغي لهم ولحاجاتهم، فحين يشعر الفرد البسيط أن المثقف أو المفكر يتحدث بلغة لا تشبهه، أو يقدّم تفسيرًا باردًا لآلامٍ حارّة في قلبه، يبحث عن صوت آخر، حتى لو كان ذلك الصوت غير متخصص أو غاضبًا أو مبسّطًا أو مضللًا أو جاهلاً، فالشعبوية لا تقدّم حلولًا معقّدة، لكنها تقدّم إحساسًا بالانتماء للشعب والناس، وتمنح الناس شعورًا بأن أحدًا أخيرًا يتحدث بلغتهم، ولو على حساب الحقيقة. لذلك نجد بعض النخب الآن، فقد ساهمت – بوعي أو دون وعي – في تآكل موقعها وقوة تأثيرها، فبعضها استسلم لإغراء القرب من السلطة السياسية، فسال لعابه مما في أيديهم، فصار جزءًا من خطاب السلطة، أو الخوف منها وهو أمر محتوم و معروف، ولكن أن يبرّر لها أكثر مما ينبغي، ويُدافع أكثر مما يُطلب منه، أو أن يقلب الباطل الى حق أبلج فهذا يعاب، وفي الجانب الآخر نجد البعض منهم اختار الانعزال، واكتفى بالحديث داخل دوائر ضيقة، مكتفيًا بنقاء الفكرة على حساب وصولها، وبين هذا وذاك، تلاشى الدور الوسيط والفعال للمثقف والمفكر، ذلك الدور الذي كان يُفترض أن يربط المعرفة بالناس، لا أن يعزلها عنهم. جلستُ شخصياً أكثر من مرة مع علماء ومفكرين لا يعرفهم أحد، عقول عميقة تمتلك قدرة نادرة على الفهم والتحليل، لكنها لا تظهر في المشهد العام، لا لضعفٍ في الفكرة التي يتبنونها، بل لرفضهم الدخول في سوق الاعلام الآن، هؤلاء لا يجيدون اختزال الأفكار في جمل رائجة، ولا تحويل الفكر العميق الإنساني إلى محتوى سريع للتناول و التداول، فيبقون خارج الضوء، بينما يتقدّم المشهد من يملك الصوت الأعلى لا الفكرة الأعمق. والناس الآن، في حقيقتها، لم تفقد ثقتها بالعلم ولا بالمعرفة، بل فقدت ثقتها بمن ادّعوا تمثيلهما من بعض المثقفين والمفكرين، لذلك أرى أن استعادة الثقة لا تكون بمحاربة «الشعبوية» بوصفها ظاهرة مزعجة، بل بمعالجة جذورها، فتبدأ بإعادة تعريف دور المثقف، كعقل حر يتعامل بذكاء مع المعضلات التي تحول بينه وبين وصول أفكاره و يتحمّل كلفة الكلمة، ودون أن تبتذل الفكرة، و دون أن يستعلي بمنبره، وأن يعترف بحدود معرفته قبل أن يطالب الآخرين بالثقة. ربما لن تعود العلاقة بين المريد وشيخه كما كانت، فالعالم تغيّر، والمنابر تعدّدت، لكن الحاجة إلى الصدق في العطاء والذكاء في توصيل المعلومة بما يتناسب مع العصر الراهن وظروفه لم تتغيّر.
264
| 11 فبراير 2026
من يتأمل حال الكثير منا في هذا الزمان في تناوله لمنصات التواصل الاجتماعي يجد أنها لم تعد منصات للتواصل الفكري والمعلوماتي، ولا حتى مساحات عابرة لتبادل الصور والتعليقات والحكايا بين الناس، بل تحوّلت شيئًا فشيئًا إلى مسارح مفتوحة لصناعة الذات البشرية، حيث لا يقدّم البعض نفسه – خصوصاً المشاهير - كما هو على الحقيقة، بل كما يريد هو أن يُرى أمام الناس، ومع هذا السعي في هذا المسار، نجد أن السؤال الذي يفرض نفسه لم يعد: ماذا سنشارك الآخرين؟ بل ما هي النسخة منّا التي نختار أن نعرضها لهم؟ أنا الحقيقي؟ أم أنا المزيف؟ وهل ما نراه يوميًا لدى بعض من نتابعهم حياة حقيقية… أم وهمًا وخداعاً مُتقن الإخراج؟ وفي هذا السياق، تكشف مراجعات علمية حديثة عن حقيقة مقلقة عن السوشيال ميديا التي لم تعد تنقل الواقع، بل تقوم بإعادة تركيبه وعرضه للآخرين، ولا تعرض الحياة كما هي، بل كما يُراد لها أن تبدو، صافية من الهموم، محسّنة للمظهر، ومختارة بعناية، ومليئة بالأضواء والأمجاد، بينما تُخفى الزوايا المعتمة خلف فلاتر الصمت والابتسامة المصطنعة المخادعة. وتشير بعض التقارير والدراسات التي استعرضتها واطلعت عليها أن كثيرًا من المستخدمين لأدوات السوشيال ميديا لا يتعاملون مع حساباتهم بوصفها مساحة للتعبير وعرض الأفكار، بل كـمشروع تسويقي للذات شديد الغلو، فالصورة، والزاوية، والكلمات، بل وحتى الصمت، كلها أدوات لإدارة الانطباع العام، فالإنسان في هذا العالم الافتراضي، إلا من رحم الله، لا يعرض ما يعيشه، بل ما يظن أنه سيُكسبه القبول، والإعجاب، والانتماء عند المتابعين. ومع تكرار هذا السلوك، تتحوّل التفاعلات الرقمية، كعدد الإعجابات، وعدد المتابعين، ونمطية التعليقات، إلى مقياس للقيمة الذاتية، ويصبح الرضا الداخلي مشروطًا برأي الآخرين، ويغدو الشعور بالوجود مرهونًا بظهوره على الشاشة، ومن هنا لا يعود الشخص يعيش حياته بحقيقتها، بل ليؤدي دوراً آخر. وحقيقة أمامنا تتجلى وهي أنه ما كان لهذا الوهم أن يتضخم لولا الأدوات التقنية التي جعلت التزييف وخداع الناس سهلًا وسريعًا، فالفلاتر مثلاً لا تغيّر الصور فقط، ولكنها تعيد تعريف الجمال وتزيد تعقيداته، وتزرع في الوعي معايير مستحيلة لذلك، ومع الذكاء الاصطناعي، لم يعد التزييف مقتصرًا على تحسين الواقع، بل وصل إلى خلق واقع بديل بالكامل بأفكار مدعاة مكذوبة وبعمق فكري مزعوم. والأسوأ من ذلك السعي الحثيث للانتقاء المتعمّد، فصورة جميلة من بين مئات الصور غير الجميلة، ولحظة في ثوانٍ من بين أيام وساعات طوال، وابتسامة من بين تعب وإرهاق شديد، وهكذا.. نجد أنها تُبنى قصة حياة بعيدة عن الواقع، وتُقدَّم للمتابعين باعتبارها نموذج حياتنا المثالي الواقعي. والمعضلة في ذلك التزييف أنه لا يبقى حبيس الشاشة، بل يتسرّب إلى الداخل، فالمقارنة المستمرة مع الصور المثالية تزرع شعورًا بالنقص لدى المتابعين الذين يجدون بوناً شاسعاً بين نعيم المشاهير وشقائهم، وتُنتج ضغطًا نفسيًا خفيًا، فيتساءل الفرد منهم: لماذا حياتي أقل بريقًا وأقل نعيماً؟ ولماذا لا أبدو كما يبدون؟ ومع الزمن، يتحول هذا السؤال إلى قلق دائم، وقد يقود إلى الاكتئاب أو فقدان الثقة بالنفس. وحين يصبح القبول الرقمي لهذا الزيف شرطًا للشعور بالقيمة، يدخل الإنسان حينها في حلقة مفرغة، مزيد من التزييف، فمزيد من الترقّب، فمزيد من القلق. أيها الأحباب، السوشيال ميديا ليست شرًا في ذاتها كأدوات، فهي كأداة للتبادل الفكري والمعلوماتي فيها خير كثير واختصار للوقت، لكنها تصبح خطرًا حين تتحوّل من نافذة على الحياة الحقيقية إلى مرآة مشوّهة لها، وحين نخلط بين ما نراه وما هو كائن، نفقد القدرة على التمييز بين الواقع والأداء، وربما آن الأوان أن نسأل أنفسنا: هل نحن نستخدم المنصات ونحقق الفائدة منها؟ أم هي التي تستخدمنا وتعيد تشكيلنا كما يريده الذين نتابعهم؟ وهل نحن في مناعة نفسية من ذلك أم في هشاشة مضطربة؟
369
| 04 فبراير 2026
تُظهر بعض البيانات المتعلقة بدوران الموظفين ذوي المواهب والجدارات في دول الخليج أن معدلات خروجهم من المؤسسات تتراوح في المتوسط بين 12% و18% سنويًا، والفئة ترتكز على الكفاءات المتوسطة والعالية الخبرة، وتشير بعض التقارير إلى أن أكثر من 60% من الجدارات الوظيفية الذين يغادرون وظائفهم لا يفعلون ذلك بسبب مستوى الرواتب فقط، بل نتيجة ضعف فرص التقدم الوظيفي، وغموض المسارات المهنية، وضعف جودة الإدارة المباشرة. إن الاحتفاظ بالموظفين المميزين والذين يسمون في الادبيات الإدارية بالكفاءات أو المواهب أو الجدارات ليس أمرًا ثانوياً أو كمالياً، فالأمر في غاية الأهمية لما يحتويه من تقرير مصير المؤسسات والشركات في قابل الأيام، فالحقيقة التي تُظهرها بعض الدراسات بوضوح هي أن الشركات التي يطول بقاء موظفيها الأكفاء لا تنجح بسبب النوايا الحسنة، بل لأنها تدير شؤونهم بطريقة مترابطة ومنظمة، وليس بطريقة اعتباطية هامشية عفوية. ويقصد بالمواهب والكفاءات في بيئة العمل أولئك الموظفين ذوي القدرات العالية، والفعالية المرتفعة، والقابلية للتعلّم والتأثير، فأولئك لا ينجزون مهامهم فقط، بل يُحسنون طريقة إنجازها، ويرفعون مستوى الأداء من حولهم، وهم لا يشكّلون مجرد أيدٍ عاملة، بل يمثلون رأس المال الحقيقي لأي مؤسسة تسعى إلى الاستقرار والنمو. وعندما ننظر إلى المسيرة المهنية لهؤلاء الجدارات مع مرور الوقت، نلاحظ حقيقة واضحة، أن بعضها يغادر المؤسسات الى مؤسسات أخرى، رغم تشابه الوظائف والرواتب والظروف العامة، وفي الغالب، لا يعود هذا القرار إلى الشخص نفسه، بل إلى طريقة تعامل المؤسسة معه، وإلى البيئة التي تضعه فيها. فتُظهر التجارب أن السياسات الفردية المزاجية للإدارات في المؤسسات، مهما بدت سلطوية، فإنها لا تكفي للحفاظ على الكفاءات إذا طبقت قوانينها بمعزل عن مراعاة الجوانب الإنسانية للكفاءات، فاستقطابهم يعني اختيار من يملك قدرة فعلية على العمل والتطور، فيتطلب ذلك توفير تدريب منظم لهم للحفاظ على مستواهم، وإيجاد إدارة واعية تدير شؤونهم، ووجود مسار وظيفي واضح أمامهم، فالمؤسسات التي تنجح في الاحتفاظ بمواهبها لا تراهن على موظفين غير جاهزين، بل تستثمر في الخبرة، وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ولا يمكن إنكار أهمية الراتب هنا، وأنه يظل في مدرسة بيئات الاعمال عاملًا أساسيًا ودافعاً للعمل، فالدخل الجيد يدفع المواهب للبقاء فترة أطول، لكنه لا يصنع انتماءً طويل المدى، لأن الذي يحفظ الكفاءات بالحقيقة هو شعورها بالتقدير، ورؤيتها لمستقبل واضح داخل المؤسسة، وإحساسها بأن جهدها يُترجم إلى نمو حقيقي. وتزداد خسارة المواهب عندما تتم الترقيات والمكافآت دون معايير واضحة أو عادلة، فالترقية غير المنصفة قد تخلق حراكًا ظاهريًا في المؤسسة، لكنها تدفع أصحاب الكفاءة إلى المغادرة بصمت، وفي المقابل، تُظهر بيئات العمل التي تعتمد العدالة والشفافية قدرة أعلى على الاحتفاظ بالكفاءات، لأن الموظف يرى أن اجتهاده لن يضيع. ولا ننسى أن مفهوم الخبرة داخل المؤسسة ليست مجرد سنوات عمل، بل الخبرة هي المعرفة المتراكمة والثقافة الأدائية، فبقاء الكفاءات يخلق استقرارًا بالمؤسسات، ويدعم نقل المعرفة بين الموظفين فيها، ويسهم في إعداد قيادات مستقبلية من داخل المنظمة نفسها، ومن هذا التراكم تتشكل ثقافة العمل الحقيقية التي يصعب تقليدها أو شراؤها. وفي النهاية، قد تختلف المؤسسات والمنظمات في سياساتها وأساليبها وطريقتها في الإدارة، لكنها لا تنجح إلا حين تدرك أن المواهب والكفاءات لا تُدار بالأوامر السلطوية ولا تُحفظ بالشعارات غير المطبقة، بل بمنظومة متكاملة تجعل المواهب والكفاءات يشعرون أن وجودهم مهم، وأن البقاء خيار له قيمة في أعينهم.
411
| 28 يناير 2026
يمر علي أحياناً وأنا أجلس وحدي بعد انتهاء لقاء استشاري إداري مع أحد المستفيدين من الشباب المقبلين على صناعة مستقبل وظيفي أو منصب قيادي، أو مشروع خاص، تساؤل معتاد: لماذا يبدو طلب الاستشارة الإدارية مثقلًا في نفوس البعض ؟ ففي تلك اللحظات، لا أفكر في النماذج التي قدمتها ولا في الخطط التي وضعتها، بل في ذلك الشعور الخفي الذي يرافق من يطلب المشورة الإدارية، شعور يشبه محاولة التقاط النفس قبل الغرق، فلم يكن طلب الاستشارة الإدارية يومًا ترفًا أو خطوة باردة محسوبة، بل كان في الغالب فعل يحوي اعترافًا داخليًا بثقل المسؤولية، وبالخوف من الخطأ، وبالوحدة التي تصيب من يُطلب منه أن يدير مؤسسة أو منشأة أو شركة أو حتى إدارة حكومية، وهو يعلم أن القرار لا يحتمل الفشل. فخلال سنوات من العمل المباشر في التدريب والاستشارات في القطاعين العام والخاص، واستقبالي لعدد من طالبي الاستشارة، كان هذا الإحساس حاضرًا بقوة، حتى حين لا يُقال، فإني أراه في نبرة الصوت، وفي التردد قبل طرح السؤال، وفي الرغبة غير المعلنة بأن يكون الحل ممكنًا دون أن يكسر شيئًا قائمًا منذ زمن أو دون تحمل مخاطرة ما. ورأيت ما يحوم حول عالم الاستشارات الإدارية من قدر كبير من «المثالية»، فتُعرض الاستشارة غالبًا كحل جاهز، كأنها قادمة من عالم واضح لا تشوبه تعقيدات البشر وممارساتهم، فنجد مصطلحات أنيقة، ونماذج مرتبة، وخططاً تبدو على الورق منطقية ومقنعة، لكنني تعلمت أن الواقع مختلف، فمن يجلس في موقع القرار يعرف أن المشكلة ليست في فهم الحل، بل في كيفية العيش معه، وفي الأثر الذي سيتركه على الناس، وعلى العلاقات، وعلى توازنات تشكلت عبر سنوات طويلة. فكثير ممن طلبوا الاستشارة كانوا مترددين في الأخذ بها، لا لأنهم لا يثقون بالمعلومة أو يرفضون التطوير، بل لأنهم يشعرون أن ما يُعرض عليهم لا يشبه بيئتهم الشعبوية، وثقافتهم المجتمعية الخاصة بعاداتها ولا تناسب توقعاتهم غير المكتوبة، فلا تصنع واقعًا يمكن القفز فوقه، فهناك قرارات “صحيحة” نظريًا، لكنها قاسية اجتماعيًا، وأخرى منطقية إداريًا، لكنها مربكة نفسيًا لمن سيُطلب منهم تنفيذها. في مجتمعاتنا العربية التي تقوم فيها علاقاتنا على المنفعة الشخصية، أو مراعاة الاعتبار الاجتماعي والمجاملة، تصبح بعض التوصيات الإدارية عبئًا لا حلًا، وحين لا يلتفت المستشار إلى هذا الجانب، تتحول الاستشارة من دعم إلى مصدر ضغط إضافي، وهنا يتضاعف الألم، وأعني به ألم الحاجة إلى التغيير، وألم الإحساس بأن الحل أحياناً لا يفهم الواقع كما هو. وبكل صراحة ما كان يؤلمني شخصيًا، أن بعض من يطلبون الاستشارة يأتون وهم يشعرون بشيء من التوتر، كأن طلب المشورة اعتراف بالعجز أو الفشل، وهذا الإحساس لا تصنعه الإدارة ومعطياتها، بل تصنعه النظرة الاجتماعية التي ترى القائد أو المدير أو صاحب المشروع مطالبًا بأن يعرف كل شيء وألا يتردد في فعل كل شيء، وحين تأتي الاستشارة محمّلة بمثالية زائدة، فإنها تزيد هذا الشعور عبئاً بدل أن تخففه. حديثي هنا ليس نقدًا قاسيًا لعالم الاستشارات الذي أعمل به وأسعد به، بل محاولة لإعادته إلى موضعه «الإنساني»، فالاستشارة الحقيقية لا تبدأ بالنماذج، بل بالإنصات والاستماع الجيد، وأن لا تُقاس بجمال العرض، بل بقدرتها على أن تُحتمل ويتم تفعيلها في الواقع، فالإدارة، في النهاية، ليست مجموعة وصفات، بل تعامل يومي مع بشر لهم مخاوفهم وحدودهم.
267
| 21 يناير 2026
في علم الإدارة، لا تُقاس كفاءة القائد بقدرته على إطفاء الحرائق بعد اشتعالها، بل بقدرته على منعها من التمدد والأفضل منع الاشتعال في بدايته، وهذا ما يُعرف في الأطروحات الإدارية بـ «التدخل الوقائي» أو ممكن أن نسميه في عالم السياسة خصوصاً في هذه المقالة بـ «الوساطة الوقائية»، والتي تعنى بـ «التدخل الهادئ في لحظة حاسمة»، حين تكون الخلافات لا تزال داخل البيت المؤسسي الواحد، وقبل أن تتحول إلى صراع كبير يهدد البنية العائلية كلها، لذلك نجد أن في البيئات المؤسسية المغلقة نسبيًا، كالتكتلات الإقليمية المتشابهة مثل طبيعة دول الخليج العربي المتشابهة في المرجعية الثقافية، تصبح الوساطة الداخلية أكثر تعقيدًا من الوساطة الخارجية، لأنها تمس التوازنات الحساسة والكرامة السياسية بقدر ما تمس المصالح. وفي سياق أوسع لهذا الحديث، لا يمكن فصل هذا التوتر الإقليمي عن المناخ الدولي المشحون الذي أعقب حادثة اختطاف الرئيس الفنزويلي وما رافقها من صدمة سياسية وأخلاقية، فالعالم اليوم يعيش لحظة ارتباك عميق وفقد ثقة -كبير جداً - بالقانون الدولي، وبدت لهم حقيقة أن القوى العظمى نفسها لم تعد تلتزم به حين يتعارض مع مصالحها، وهذا السلوك الانتقائي للقوى العظمى، حيث يُطبَّق القانون على الضعفاء ويُعلَّق عند الأقوياء، فتزداد أسهم تعرية النظام الدولي من أي توازن أخلاقي فعلي والتزام حقيقي بالمبادئ، وحوّل القانون الدولي إلى أداة قوة لا مرجعية عدل، فأمام هذا الواقع، يصبح استمرار العرب في التعامل كدول منفردة مجرد مخاطرة إستراتيجية، إذ إن غياب التكتل العائلي الإقليمي يجعل كل دولة عرضة للضغط أو التجاوز، ومن هنا، نجد أنه لا يبدو الحديث عن قدرٍ من الاتحاد العربي أو التنسيق السيادي ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية في عالم لم يعد يعترف إلا بالكتل القادرة على حماية نفسها، لا بالقانون الذي يُنتهك عند أول اختبار للقوة. والتوتر الإقليمي اليوم لا يقتصر على خلافات بين الحلفاء داخل البيت الخليجي، بل يتغذّى أيضًا من مشهد أكثر خطورة يتمثل في ما يجري داخل إيران الآن من اضطرابات ومظاهرات مفتوحة على احتمالات مجهولة للمراقبين كلهم، والسؤال هنا لا يتعلق بتأييد نظام أو معارضة آخر،، ولكن دعونا ننظر بحساب المآلات ونتساءل: هل يخدم سقوط النظام الإيراني مصلحة الخليج فعلًا، أم يفتح فراغًا إستراتيجيًا لا يُعرف من يملؤه؟ أترك الإجابة للقارئ، ولكن يجب أن نتذكر أن في لحظات الانهيار الكبرى، لا يكون البديل دائمًا أفضل، وقد تتحول الفوضى إلى مدخل لتمدّد قوى أخرى، في مقدمتها المدّ الصهيوني، حيث يختلط الشر بالخير وتضيع البوصلة. وتاريخيًا، في أزمنة الاضطراب العالمي، نجد أنه لم تكن الدول الأكثر ضجيجًا وتفاعلاً هي الأقدر على البقاء، بل تلك التي حافظت على هدوئها النسبي واستقرارها المنضبط، وأدارت الخلافات بفعالية عالية، ومن هنا لا يمكن فهم التحرك القطري بوصفه مناورة سياسية، بل كقراءة سياسية واقعية تؤمن بأن تفكك البيت الخليجي سيكون كلفة لا يربح فيها أحد.
219
| 14 يناير 2026
القيم في أصلها عناصر غير قابلة للتسعير أو المساومة، بل وُجدت لتكون مرجعية وبوصلة لسلوكياتنا وأفعالنا وممارساتنا، غير أن الواقع الإداري المعاصر يكشف تحوّلًا هادئًا لكنه عميق الأثر، نجده في انتقال القيم من كونها إطارًا ناظمًا للسلوك، إلى مورد يُعاد تشكيله وتمييعه بما ينسجم مع السوق، وتوقعات الجمهور، وضغوط القبول الاجتماعي والمجاملات، وهذا التحول لا يحدث دفعة واحدة، بل يتسلل عبر قرارات صغيرة يومية، وتنازلات غير مبرَّرة، ولغة إدارية حذِرة تخشى الصدام أكثر مما تخشى فقدان المعنى الجميل. وفي هذا التحول، وحتى نكون صادقين، لا تُلغى القيم صراحة، بل تُعاد صياغتها، فتُختصر، وتُعمّم، وتُجرّد من حدّتها الأخلاقية، حتى لا تُربك الآخرين، ولا تُقلق الشركاء، ولا تُفقد المؤسسة حصتها السوقية أو زبائنها، ويصبح الحديث عن النزاهة، أو العدالة، أو المسؤولية الاجتماعية، حديثًا ناعماً، قابلًا للتأويل، ولا يطالب بثمن حقيقي، و تُذكر القيم في التقارير السنوية، وتُعلّق على الجدران، والحكايات لكنها تغيب عند لحظة القرار الصعب. والإدارة هنا لا تكذب، ولكنها أيضًا لا تقول الحقيقة كاملة، فهي تتبنّى ما يمكن تسميته بـ«القيم القابلة للتمييع والتسييل»، فهي قيم لا تُلزم أكثر مما تسمح، ولا تُعارض الاتجاه السائد مهما كان متقلبًا وسلبياً، وفي سبيل ذلك، تتحول الأخلاق إلى لغة علاقات عامة ناعمة، وليس إلى معيار حقيقي بناء قرار صائب، والمهم ليس ما نؤمن به، بل كيف يمكن تسويق القيم التي نؤمن بها دون إثارة اعتراض أو خسارة رمزية. فالخطر الإداري في تسييل وتمييع القيم لا يكمن فقط في فقدان المصداقية الخارجية، بل في تآكل المعنى الداخلي للمؤسسة سواء كانت اجتماعية أو حكومية، فحين يدرك العاملون أن القيم تتغير بتغير المزاج العام، يتعلمون درسًا ضمنيًا خطيراً جداً: أن المبادئ مؤقتة، والالتزام انتقائي، فعندها، لا يعود الانضباط نابعًا من قناعة، بل من المراقبة، ولا يعود الولاء أخلاقيًا، بل تعاقديًا باردًا بلا قناعة، ويمكن التهرب منه عند أول فرصة أفضل. وتزداد خطورة هذا المسار حين تتحول القيم إلى أداة انتقائية، فتُستدعى حين تخدم المنفعة، وتُهمَّش حين تعيقها، وهنا تفقد المؤسسة قدرتها على بناء سردية قيمية متماسكة، وعند قراءة سير المؤسسات نجد أنه لم تسقط المؤسسات الكبرى بسبب غياب القيم، بل بسبب استخدامها للقيم كـ «مكياج» وأداة للتحسين الشكلي، فالقيمة التي لا تُختبر في لحظة الخسارة، ليست قيمة، بل هي شعار وهمي، والإدارة التي لا تتحمل الكلفة القيمية الأخلاقية عند التعارض مع السوق أو الحياة أو الناس، لا تمارس قيادة فعالة، بل تكيّفًا انتهازيًا قصير النفس لا يغني ولا يسمن من جوع. ومع ذلك، لا يمكن إنكار تعقيد الأمر وصعوبته، فالمؤسسات تعمل داخل مجتمعات متغيرة بشكل سريع، وأسواق بشرية وأذواق لا ترحم في حكمها المتذبذب، لكن الفارق الجوهري يظهر في السؤال الذي يُطرح داخل غرف صناعة القرار: هل نبحث عن صيغة تُنقذ القيم دون أن تعزلنا عن الواقع؟، أم نبحث عن صيغة تُنقذ القبول الاجتماعي ولو على حساب جوهرنا وقيمنا التي نؤمن بها؟ ففي النهاية، تظل القيم التي لا يمكن تمييعها هي وحدها القادرة على الصمود في ظل هذه المعركة، لأنها تمنح المؤسسة معنى يتجاوز اللحظة الآنية إلى قراءة مستقبلها وتثبيته وتحقيق أهدافها، فما الذي يبقى من المؤسسة حين تُصبح مبادئها وقيمها قابلة للتفاوض والتمييع؟
246
| 07 يناير 2026
في تقييمٍ سنويٍّ داخلي لإحدى المؤسسات العربية، سُئل مدير قسم معروف بازدحام يومه واجتماعاته المتواصلة عن أبرز ما أُنجز خلال العام، فصمت قليلًا ثم قال إن العام كان «مليئًا بالانشغال»!، فقدّم بعده أحد الموظفين لا يعرف له ضجيج مؤسسي، قدم ثلاثة إنجازات غيرت مسيرة المؤسسة خلال العام المنصرم، فانتهى الاجتماع عند هذا الحد. لطالما جاءتْنا تكاليف ودعوات أو مهام، سواء طُلبت منّا قانونًا أو فُرضت عرفًا، فكان الردّ الجاهز: نحن مشغولون!، ولكن السؤال الذي نادرًا ما نواجهه بصدق هو: هل نحن مشغولون فعلًا، أم نتشبّث بالمشغولية لأنها آخر ما تبقّى لنا حين يغيب الإنجاز؟ من يتأمّل حياة الأفراد، بل والمؤسسات والمجتمعات، يلاحظ أن تراجع مستوى الإنجاز لا يحدث دائمًا بشكل فجّ أو صادم، فلا ينهار عادةً البناء دفعة واحدة، بل يتآكل ببطء، فيأتي التراجع بالإنجاز صامتًا، ومتخفيًا خلف تكرار أعذار المشغولية، وضيق الوقت، وضغوط العمل، وكأن هذه المبرّرات باتت لغة دفاع جماعية تُستخدم لإخفاء القصور في الإنجازات قبل معالجته، ففي هذه المرحلة، لا يُكذَّب الانشغال، ولا يُختبر صدقه، بل يُمنح شرعية أخلاقية تلقائية لدى المصابين بهذا الداء إن استطعنا وصف المشغولية هنا بالداء. ففي الأصل، كانت المشغولية والانشغال علامة ودليلا على امتلاء الفرد بالمهام ذات المعنى والفائدة، وليست ستارًا للفراغ، لكنها أي «المشغولية « حين تنفصل عن تحقيق النتائج والإنجازات، تتحوّل إلى سلوك اجتماعي نُظهر فيه ادعاء الانشغال وأننا مشغولون ولا نملك الوقت الكافي، لأن السؤال عن الإنجاز أصبح أكثر إزعاجًا من الإرهاق والعمل نفسه. وهكذا، نجد البعض يقيس الانشغال بعدد الساعات، لا بما تغيّر بعدها من إنجازات. والمؤسسات أيضاً كما الإنسان، خصوصًا في هذا الأمر، نجدها تُتقن هذا الادّعاء الغريب، حين تغيب الرؤية التي تسير عليها المؤسسة أو تتآكل الغاية التي توجه مسار المؤسسة، فإنها تبدأ بتضخيم الإجراءات، وتهتم بالشكليات، وتجعل مدد الاجتماعات طويلة وتُعقد لتأكيد الوجود فقط، لا لاتخاذ قرارات جادة مفيدة للعمل والإنجاز، والتقارير تُكتب لتوثيق الجهد، لا لقياس الأثر وتحقيق النتائج، وكلما قلّ الإنجاز الحقيقي، زادت الحاجة إلى إثبات الحركة والتواجد فقط، فتأتي المشغولية وادعاء أنك مشغول فتصبح تعويضًا نفسيًا عن فقدان الاتجاه. لذلك الأفراد ليسوا بمنأى عن هذا السلوك، فالإرهاق يمنح شعورًا زائفًا بالاستحقاق، فيقول أحدهم: أنا متعب، أنا مرهق، إذاً أنا أقوم بما يجب وزيادة!. ومع مرور الوقت، يصبح السؤال عن الإنجاز الفعلي تهديدًا للذات المهنية والكبرياء الوظيفي، فمن يسأل: “ما الذي أُنجز فعلًا؟” يبدو كمن يخلخل توازنًا هشًّا بُني على التكرار لا على التقدّم في الإنجاز، لذلك، يُفضَّل الانشغال المستمر على التوقّف للمراجعة والمحاسبة الصادقة ومعرفة ما تم إنجازه فعلاً خلال الفترة السابقة، فالمراجعة هي الشرط الأول للإصلاح في عمل الفرد والمؤسسة. والأخطر من ذلك أن ثقافة الادّعاء بالمشغولية وأنك مشغول على الدوام تُقصي الممارسات الهادئة والعميقة، فيغلب على مدعي المشغولية عدم الجدية في التفكير، والتخطيط، والتأمل، لأن هذه الأفعال لا تُرى، ولا يصفَّق لها، مع أنها تصنع الفارق الحقيقي بين مدعي الإنجاز والمنجز الحقيقي، لذلك قال أحد رواد علم الإدارة: «إن مجتمع الضجيج الإداري لا يحتمل الصمت المنتج»، وهذه حقيقة. ويبقى السؤال لنا ولكم، هل ندّعي أننا مشغولون لأننا فعلا لا نملك الوقت الكافي، أم أن الإنجاز يطالبنا بجدية في العمل لا نملكها بعد؟.
363
| 31 ديسمبر 2025
من يقرأ في التاريخ العربي، يجد أن بعض القرارات المصيرية اتخذت لتدبير حاضرهم آنذاك، وأخرى يتم اتخاذها لصناعة المستقبل، وبين هذا وذاك، تقف اللغة بوصفها الحدّ الفاصل بين دولة تُدار بالأمزجة المتقلبة، ودولة تفهم ذاتها وقيمتها ومرجعيتها، من هنا لا يمكن قراءة اكتمال «معجم الدوحة التاريخي للغة العربية» بوصفه خبرًا ثقافيًا عابرًا، بل بوصفه امتدادًا هادئًا لسلسلة طويلة من الوعي بالسيادة القطرية العربية وبنائها، حيث أدركت السلطة القطرية أن اللغة العربية ليست زينة الحكم، بل هي حقيقة بنيتها العميقة. ولو رجعنا الى التاريخ، نجد أنه عندما تولّى الخليفة العربي الكبير عبد الملك بن مروان الخلافة، كانت دواوين الدولة الإسلامية تُدار بلغاتٍ غير عربية، كالرومية في الشام، والفارسية في العراق، وكان ذلك مفهومًا ومتقبلاً في زمن التأسيس، حين اقتضت الحكمة السياسية الحفاظ على النظم القائمة ضمانًا للاستقرار المؤقت، إلاّ أن عهد عبد الملك والذي تميز بتبلور نظام الدولة العربية الحديثة وانتقالها من طور الفتح إلى طور التمكين، أدرك عبدالملك أن بقاء اللغة العربية بعيدة عن مراكز اتخاذ القرار وبناء الدولة سيتحوّل إلى خطرٍ بنيوي لا محالة، فالدولة التي تُدار بلغة غيرها، تُدار بنصف سيادة أو سيادة مفقودة. فلم يكن تعريب الدواوين في عهد الخليفة عبدالملك قرارًا لغويًا، بل قرارًا معرفيًا وجودياً سياديًا، فالأمة التي تدير شؤونها بلسان غيرها، تفكر أيضاً بعقل غيرها، مهما رفعت من شعارات الاستقلال، فمنذ تلك اللحظة، خرجت العربية من كونها لغة خطاب ودين، إلى لغة للإدارة وبناء الحضارة، وهي قادرة على أن بناء كل أركان الحياة والوجود، كالاقتصاد، والقانون، والعلوم، وغيرها. والآن بعد مرور قرون عديدة جاءت التجربة القطرية في مشروع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، والذي يوثق تاريخ الألفاظ العربية وتحولاتها الدلالية عبر نحو القرون المتعددة، فملايين الكلمات ليست رقمًا دعائيًا، بل شاهد على جهد طويل النفس تم بذله بعناية قطرية، وعلى دولة تفهم أن المشاريع المتعلقة بلغة الأمة لا تُقاس بالعمر والسنين والتكاليف المالية، بل بحقيقة استخدامها في بناء حضارتها وصناعة منظومة السيادة. واللافت في التجربة القطرية هنا أنها لم تتعامل مع اللغة العربية بوصفها رمزًا وأداة لبناء الهوية فقط، بل بوصفها موردًا معرفيًا استراتيجيًا مستداماً، فرعاية المشروع على أعلى مستوى بالدولة، وإشراف مؤسسي تخصصي، كلها مؤشرات على فهم القيادة القطرية، أن الاستثمار في اللغة هو استثمار في الإنسان، وفي تطوير قدرته على التفكير المثمر، لا مجرد ترف ثقافي. وقطر، في هذا المشروع، لم تدّعِ وصاية على العرب والعربية، بل قدّمت خدمة لها، وللعرب جميعًا، ففتحت المعجم ليكون مرجعًا للمؤسسات، والحكومات والأفراد في شتى الفنون والعلوم. غير أن اكتمال المعجم في قطر، لا يعفينا – كعرب – من تحمل المسؤولية جميعاً، فالفجوة ما تزال قائمة بين ما ننجزه مؤسسيًا، وما نعيشه اجتماعيًا، والواجب علينا جميعا كعرب أن نسدد ونقارب ونقلل هذه الفجوة، فمعجم الدوحة يضع الأداة في أيدينا، لكنه يدعونا إلى تطبيق عملي في سائر ديار العرب، فنحن لا نريد لغة نحتفي بها، بل نريد لغة تدير لنا شؤوننا وترسم لنا خريطة الطريق للمجد، فإن كانت البداية عند عبد الملك بن مروان عندما اختار أن تُدار الدولة بلغتها وهويتها، فقطر اليوم، تكمل المسيرة وتسعى أن تُدار اللغة بمنهج علمي مؤسسي، فالأمم لا تنهض بالشعارات المستوردة، بل بالبُنى المنطلقة من موروثها اللغوي والقيمي.
237
| 24 ديسمبر 2025
في مجتمعاتنا العربية، لا يُقاس النجاح غالبًا بما ننجزه نحن فعليًا، بل بما يبدو للآخرين أنه نجاح، فنمطية الوظيفة، ولقب المنصب ودرجته، وشكل الحياة اليومية وأسلوب المعيشة والعلاقات من حولنا، كلها تتحول إلى معايير جاهزة يُحاسَب الفرد على أساسها ويتم تقييمه من قبل الآخرين، حتى وإن كانت نفسه لا تميل إلى معطيات واختيارات الآخرين، ولا تعبّر عنه، ولا تمنحه أي شعور بالامتلاء والرضا عن الذات. وهكذا، يصبح النجاح مشروعًا للآخرين في حياتنا، وليس تجربة شخصية صادقة تعبر عن اختياراتنا. فمنذ وقت مبكر، تعلمنا بشكل خاطئ أن هناك “طريقًا واحداً ” للنجاح في الحياة.. دراسة محددة، وشهادة في تخصص ما، ووظيفة مرموقة محددة، ونمط عيش متعارف عليه، ثم تكرار النموذج نفسه مع اختلافات شكلية، ومن يخرج عن هذا المسار، يُوصَف بالمغامر أو المتهور، أو غير الجاد، أو «الذي لم يستقر بعد”، أو الفاشل، فالمشكلة لا تكمن في المسارات نفسها، بل في تحويل اختيارات الآخرين إلى معايير للحكم على قيمة الإنسان في أعين البقية. فكثيرون نعرفهم يحققون ما يُسمّى نجاحًا، لكنهم يشعرون داخليًا بالخسارة وعدم الارتياح والرضا عن الذات، فالوظيفة المرموقة بلا شغف، والدخل الجيد بلا طمأنينة، والحضور الاجتماعي بلا معنى، تفقد قيمتها ومضمونها إن لم تكن موافقة لهوى الإنسان نفسه فنجده يبذل قصارى جهده فقط ليثبت للآخرين أنه ناجح بمعاييرهم، فالنجاح حين يُصمَّم لإرضاء الآخرين، يتحول إلى عبء نفسي مرهق طويل الأمد، وتجدهم على منصات التتويج المجتمعي يبتسمون للكاميرا ولكن السؤال الذي يفتت قلوبهم وضمائرهم في خلواتهم هو: هل أنا راضٍ حقًا عمّا أعيشه وحققته؟ ومن نافلة القول إن وسائل التواصل الاجتماعي مع الأسف عمّقت هذه الأزمة، فلم تعد المقارنة بين شخصين في ميدان محدد، بل بين حياة حقيقية وحياة مُفلترة، فالنجاح صار عرضًا مؤقتاً بصريًا، لا مسارًا إنسانيًا مستداماً، وكلما زادت المشاهدات ومراقبة الناس لك، ازدادت لديك وتيرة الضغط النفسي في سباق مع الزمن لتدرك ما يريده الناس فيك لا ما تريده أنت من نفسك فقط.. لإرضائهم. ونأتي الآن إلى الأخطر من ذلك وهو أن البعض قد يتخلى عن أحلامه بهدوء، لا لأنه فشل في طريق تحقيقه لمراده، بل لأنه تعب من التبرير وشرح اختياراته للآخرين، ومن الدفاع عن قناعاته، ومن مقاومة نظرة الشك لكل ما هو مختلف، فيختار الطريق الآمن اجتماعيًا، ولو كان قاسيًا نفسيًا. لذلك يا أصدقائي نجد أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بسرعة الوصول، ولا برضا الآخرين، بل بقدرتك على الاستمرار دون أن تفقد نفسك في الطريق، وأن تنجح كما تريد أنت.. أنت فقط، لا كما يُصفّق لك الآخرون ويختارونه لك، فالحياة التي تُمارس لإرضاء الجميع، غالبًا ما تنتهي بمرارة وحسرة، فرضا الناس غاية لا تدرك، فركز على رضا الله في أفعالك وما يمليه عليه ضميرك.
438
| 17 ديسمبر 2025
لقد كان افتتاح مونديال العرب في الدوحة لحظة عربية مبهرة أعادت إلى الوجدان العربي شيئًا من صورة الأمة حين تجتمع، عرضٌ فني وثقافي قدّمته قطر باحتراف عالٍ جعل العالم يرى العرب بوجههم الأصيل والمتجدد في آنٍ واحد، وما أن انتهت أنوار الحفل حتى اكتمل المشهد بانتصارات منتخبات عربية، فكان أبرزها فوز سوريا الذي لامس مشاعر ملايين العرب من انتصار ثورتها إلى انتصارها في الملاعب، وفوز فلسطين الذي تحوّل إلى لحظة رمزية عميقة، رُفع فيها العلم الفلسطيني في المدرجات بوصفه راية جامعة تتجاوز الرياضة إلى المعنى الوجداني العربي، ولقد بدت هذه الأحداث المتتابعة كأنها تذكير بأن العرب حين يُمنحون مساحة مشتركة، يُظهرون وحدتهم بصورة تلقائية خارجة عن إرادة السياسيين، لكنها راسخة في قلب الشعوب. ولكن نجد هذا السؤال يتجدد كلما رأينا مشهدًا عربيًا موحّدًا: لماذا نستطيع أن نتوحد وجدانيًا في الرياضة والفن، ولا نستطيع أن نفعل الشيء ذاته في السياسة والاقتصاد؟ أجد أن أسباب ذلك تمتد عميقًا في التاريخ الحديث، فإرث التجزئة الذي فرضته القوى الاستعمارية، وهواجس الأمن والحدود بدل طمأنينة مشاريع الوحدة، وإضافة إلى أنظمة اقتصادية اعتمدت على الخارج أكثر من اعتمادها على التكامل الإقليمي، وغيرها جعلت كل دولة عربية تنظر إلى الأخرى بعين القلق لا بعين الشراكة، وهذه التراكمات صنعت واقعًا عربيًا متشتتاً. إلا أن إزالة هذه العوائق ليست حلمًا رومانسيًا، بل مشروعًا واقعيًا يمكن بناؤه إذا توافرت الإرادة العربية، فالبداية من الاعتراف بأن الشعوب العربية تُظهر كلما سنحت الفرصة استعدادًا وحدويًا يفوق التوقعات، وهذا الاستعداد يجب أن يُترجم إلى مبادرات سياسية واقتصادية تضع المصالح المشتركة فوق الخلافات العابرة، فالعالم اليوم تحكمه التكتلات والتحالفات المشتركة، والنجاح الاقتصادي مرهون بسلاسة الانتاج ومرونة التجارة العربية العابرة للحدود، لذلك فإن إزالة العوائق تبدأ بتفعيل مجلس التعاون العربي مهما كان شكله عبر مشاريع عملية، كسوق عربية للطاقة، وربط لوجستي بين الموانئ العربية، وتوحيد سياسات الاستثمار، وبناء منصات بحثية وإعلامية مشتركة، فلا يحتاج العرب إلى وحدة اندماجية، بل إلى وحدة عملية تحمي المصالح وتخلق قوة تفاوضية على المسرح الدولي. فوحدة العرب السياسية ليست معاهدة تُوقّع، بل بيئة تُبنى تدريجيًا، فيبدأ ذلك بتقليل التوترات البينية، واعتماد مبدأ “الربح المشترك” بدل الصراع، ثم يأتي دور الثقافة والإعلام في ترسيخ الوعي بأن العرب كتلة تاريخية وجغرافية واقتصادية واحدة، وأن الخلافات لا تلغي وحدة المصير المشترك. لهذا شعرت بأن لحظة الافتتاح وفوز سوريا وفلسطين لم تكن مجرد فرح رياضي، بل كانت تذكيرًا بأن الوحدة ليست فكرة غائبة بل طاقة عربية كامنة، وإذا استطاعت بطولة كرة قدم أن تجمع الوجدان العربي بهذه القوة، فإن مشروع الوحدة السياسية والاقتصادية ليس بعيدًا، بل ينتظر من يلتقط روح الأمة ويحوّلها إلى إرادة فعلية، فالأمم لا تنهض بالشعارات، بل بالقرارات التي تعرف كيف تُحوّل الشعور إلى واقع عربي ملموس.
372
| 03 ديسمبر 2025
في السودان الجريح، لا تشتعل النيران في أطراف تلك الجغرافيا فحسب، بل تمتد لتأكل الكيان العربي وضميره الخامل، فهذا الوطن العريق الغني بالثروات الطبيعية والبشرية أنهكته الصراعات حتى غدت أجهزته كجسدٍ بلا رأس، تتنازعها الصراعات وتعدد الولاءات وتتقاذفها الأهواء والامزجة، ومن يتأمل المشهد اليوم يدرك أن الأزمة في السودان لم تكن وليدة صدفة، بل نتيجة حتمية لتراكم طويل من الخلل والضعف المنبثق ابتداءً من الصراعات السياسية في القرن العشرين حتى اليوم حيث الصراع بين الشرعية و قوات الدعم السريع. فالأزمة السودانية ليست خلافًا محليًا على سلطة أو موارد، بل هي صورة مكبّرة لأزمة أوسع تضرب الجسد العربي كله، فعلاً هي أزمة في العقل العربي، فما زال بعض الأطراف ذو العلاقة بالأزمة والتأثير الإقليمي يتعامل مع السودان بوصفها غنيمة، لا منظومة عربية تحتاج الى استقرار، فعندما يفشل العقل العربي الجمعي في الترويج والسعي الى بناء مؤسسات عربية حقيقية، نجد أن البعض يُقصي الكفاءات لحساب الولاءات السياسية، ويتّخذ القرار الاستراتيجي من موقع الانفعال والمزاجية والحقد الدفين لا من منطق التخطيط السليم، فإنه بذلك يزرع بذور الفوضى في كل أرض عربية، والسودان اليوم إحدى ثمار تلك البذور. لذلك فإنّ ما يحدث في السودان ليس معزولًا عن السياق العربي العام وصراعاته، بل هو امتداد لنمطٍ مألوف من الإخفاق العربي في احتواء الأزمات والسعي الى بناء الدولة وحماية السلطة والشرعية، فالأزمة هناك ليست صراعًا داخليًا فقط، بل نتاج تداخل إراداتٍ خارجيةٍ تحاول إعادة إنتاج الفوضى في السودان والعالم العربي. فلقد تحوّل السودان، في لحظةٍ مأساوية، إلى ساحة تصفية حساباتٍ إقليمية، يُدفع ثمنها من دم المدنيين وأشلاء الأبرياء، والمدافع تُطلق في السودان، لكن العقول التي تُحرّكها تقيم في عواصم أخرى، تلك التي تملك المال والإعلام والسلاح، وتتوهم أن تفكيك السودان سيمنحها دورًا أكبر في الإقليم الشرق أوسطي. ومع الأسف فإنّ بعض الأنظمة أو الإدارات العربية ما زالت غارقة في تراث الحكم الغريزي الثأري، فلا تفكر بمنطق الدولة الحديثة المبنية على تصدير الايجابي من العلاقات المثمرة مع الدول الأخرى، بل تفكر بمنطق الهيمنة القديمة، فترى في ضعف السودان فرصةً لمرادها، وفي فوضاه مجالًا لتوسيع نفوذها ولو كان ذلك بإشعال نار الفتن، وهنا تكمن المأساة الأكبر حين تتحول بعض الإدارات العربية إلى غرف تحكمٍ لأزمات الآخرين بدل أن تكون منصاتٍ للحلول وإحلال السلام والتآخي، وحين ينسى بعض القادة أن دعم الشرعية في السودان ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي وإنساني لحماية فكرة الدولة العربية نفسها. والمذابح التي يشهدها السودان جريمة ضد الإنسانية، وإن الصمت العربي عنها جريمة ضد الوعي والتاريخ، لأنّ من يترك دولةً عربية تسقط دون أن يساند شرعيتها، يوقّع من حيث لا يدري على سقوط القيم العربية المشتركة. فلتكن نصرة السودان اليوم دفاعًا عن الدولة والضمير الانساني لا عن الأشخاص، ودفاعاً عن الشرعية، وعن العقل العربي الذي آن له أن يخرج من أسر الصراعات والحقد الدفين إلى وعيٍ إداريٍ جديدٍ يؤمن أن قوة الأمة العربية تبدأ من وحدة مؤسساتها لا من هدم البلاد والعباد.
4422
| 05 نوفمبر 2025
في نوادينا اليوم ودواويننا في الخليج العربي، نجد أنه أصبح لكلمة «برستيج» وجود في اللهجة الدارجة اليومية، فتُستخدم في المزاح أحيانًا، وفي الحكم على الناس أحيانًا أخرى، ولكن ما معنى البرستيج أصلًا؟ البرستيج كلمة فرنسية، وفي استخداماتها، تعني الصورة الاجتماعية التي يريد الإنسان أن يظهر بها أمام الآخرين: وهي تقابل معنى الوجاهة، والمهابة، والحضور، وهي محاولة لصياغة الانطباع عن النفس وصناعة الصورة الخارجية، ولكن هل من الممكن أن نعتبر أن الوجاهة هي البرستيج؟ إن بين المصطلحين فرقا مهما: فالوجاهة في معناها العربي القديم كانت مرتبطة بالاعتبار، بالمكانة الحقيقية، باحترام الناس للمرء لأنه يحمل في ذاته كشخص قيمة معنوية كالشرف والكرم وحسن الرأي، أما البرستيج اليوم فغالبًا ما يتعلق بالشكل الخارجي وحده: كالسيارة، والمكتب، والمنزل واللباس، وأسلوب الكلام ناهيك عن المضمون. وهنا يخرج السؤال: هل الوجاهة أو البرستيج مطلب؟ وهل من الخطأ أن يريد الإنسان أن يُحترم؟ من الطبيعي أن يبحث الإنسان عن مكانة له بين الناس، فهذا جزء من حاجته الاجتماعية للاعتراف والاعتبار، ولا حرج في أن يحب المرء أن يُنظر إليه بإعجاب أو احترام، بل في الثقافة العربية والإسلامية القديمة، كان وجود الوجهاء مطلباً حيوياً في المجتمع لأنه كان يعطي ضمانة أخلاقية، فوجود رجل له وجاهة كان يعني وجود شخص يستطيع أن يشفع، أن يحل المعضلات، أن يخدم الناس بسمعته، أي أن للوجاهة وظيفة اجتماعية، لا مجرد لفت نظر. لكن المشكلة تبدأ عندما تنفصل الوجاهة عن القيمة، وتصبح مجرد عرض خارجي بلا جوهر داخلي، فأصبح هناك طريقان لكسب الوجاهة بين الناس، الطريق الأول هو الطريق الصعب المجهد، طريق أصيل بطيء في مكتسباته، ويقوم على العلم، والإتقان، والخلق، وخدمة الناس بصدق، واحترام النفس قبل طلب احترام الناس، فهذه الوجاهة التي تبنى ولا تُشترى، وهي التي تبقى حتى بعد الغياب، ويذكر صاحبها بخير حتى لو لم يعد حاضرًا في أذهان الناس، أما الطريق الثاني: فهو الطريق السريع، وهو طريق الاستعراض، والسعي الحثيث لإظهار ما ليس حقيقيًا، والمبالغة في تضخيم الذات ومن هنا يولد البرستيج الزائف. فالبرستيج الزائف ليس مجرد ذوق مرتفع أو حب للأناقة. لا ليس كذلك، إنما المشكلة هنا أعمق، فالمشكلة أنه يصبح بديلاً عن الإنجاز الحقيقي والتأثير الحقيقي، فبدل أن يتعب الإنسان ليكون مؤثرًا في واقعه، يختار أن يبدو مؤثرًا فقط ويتصنع ذلك، وتظهر خلالها أخطر أمراضنا الاجتماعية المعاصرة: الادعاء. حين يلبس شخص دور «الناجح»، و»المتميز»، قبل أن ينجح فعلاً، فتتحول حياته إلى مسرحية ترتدي الكذب والتزييف أمام الجمهور، ونجد أن الكذب في حياته يفتح على مصراعيه: كذب في السيرة الذاتية، وكذب في حجم العلاقات، وكذب في وصف المنجزات، وكذب في ما يملك وكذب في من يعرف، وهنا يصبح البرستيج سجنًا، لأن صاحبه لا يستطيع التراجع خطوة دون أن يسقط القناع كله. فهذه الثقافة «ثقافة الوجاهة المزيفة أو البرستيج» هي ثقافة خطرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع معًا، ونحن يا أصدقائي لا أدعوكم إلى رفض الذوق الحسن أو المظهر المرتب، ولسنا ضد الأناقة، ولكننا مدعوون لإعادة تعريف معنى الوجاهة، كما كان يفهمها آباؤنا، هي أن تكون مصدر ثقة أخلاقيا وإنسانيا في محيطك المجتمعي، وأن يُشار إليك بالبنان لجهدك وقيمتك الذاتية وليس لشكلك وادعائك الصورة الخارجية، فالتحدي الحقيقي اليوم ليس أن نلغي الوجاهة، بل أن ننتزع الوجاهة من يد الزيف ونردّها ونضعها في يد القيمة الحقيقية.
771
| 29 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية

عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب...
14373
| 08 فبراير 2026

يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة،...
1443
| 10 فبراير 2026
لم يكن الطوفان حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه مع...
801
| 10 فبراير 2026

تعكس الزيارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة العربية...
624
| 05 فبراير 2026

لقد طال الحديث عن التأمين الصحي للمواطنين، ومضت...
585
| 11 فبراير 2026

يشهد الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة حالة مزمنة...
546
| 09 فبراير 2026

منذ إسدال الستار على كأس العالم FIFA قطر...
507
| 11 فبراير 2026

لم يعد هذا الجهاز الذي نحمله، والمسمى سابقاً...
495
| 09 فبراير 2026

لم يكن البناء الحضاري في الإسلام مشروعا سياسيا...
483
| 08 فبراير 2026
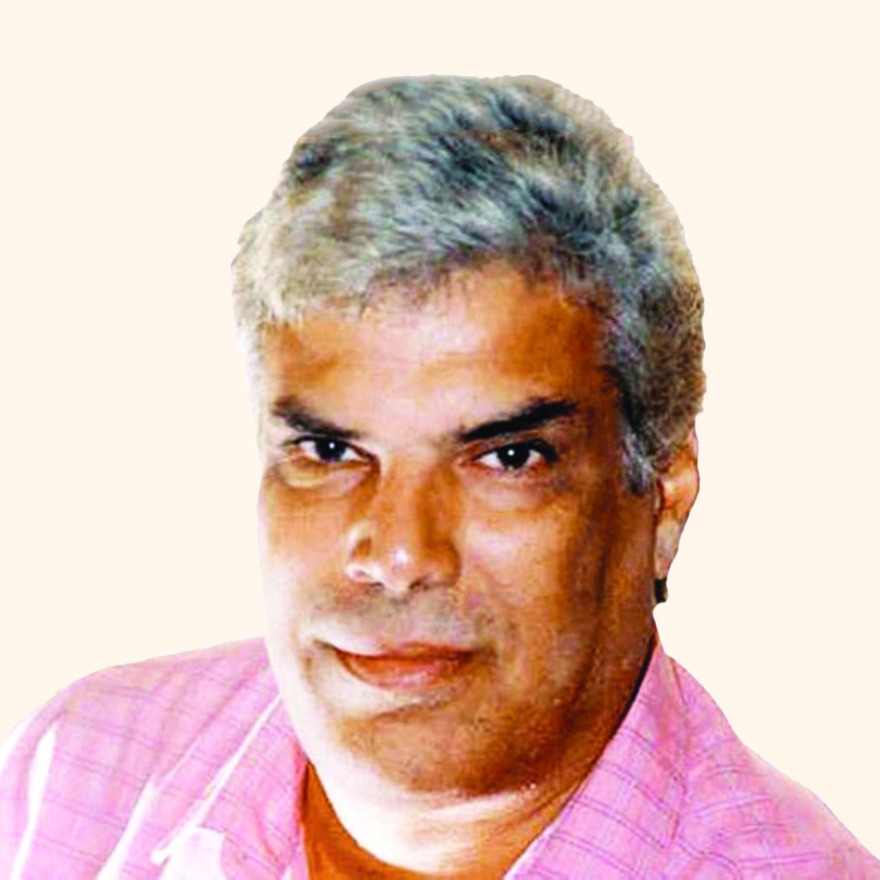
«الآخرة التي يخشاها الجميع ستكون بين يديّ الله،...
447
| 05 فبراير 2026

يستيقظ الجسد في العصر الرقمي داخل شبكة دائمة...
435
| 10 فبراير 2026

الثاني من فبراير 2026م، ليلة النصف من شعبان...
414
| 09 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
د. جاسم الجزاع
* باحث وأكاديمي كويتي
Jassimaljezza@hotmail.com
عدد المقالات 119
عدد المشاهدات 104700

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل





