رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في مشهد سياسي يعكس الواقعية والمسؤولية التاريخية والسياسية، جاءت زيارة الأمير سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق كعلامة فارقة في العلاقات العربية – العربية، إذ مثلت خطوة دبلوماسية متقدمة تجاه سوريا، بعد أكثر من عقد من التوتر الحاصل بفعل النظام المخلوع، فلم تكن هذه الزيارة مجرد لقاء بروتوكولي، بل كانت رسالة قوية تعبر عن رؤية قطرية قائمة على تغليب فلسفة المبادرات الفاعلة على الحياد السياسي. فليست السياسة سوى فن الممكن، وذكاء إدارة المواقف، وصناعة الحلول حين تتعقد الأمور، وهذا هو جوهر فن صناعة المبادرات، الذي يُعد من أبرز سمات الدول ذات الرؤية الإستراتيجية والقادة أصحاب العزم، فالمبادرات ليست مجرد ردود فعل وقتية، بل هي أدوات تغيير تُحدث تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالدول التي تصنع المبادرات لا تنتظر تحولات للواقع، بل تسابق الزمن لرسم ملامح المستقبل، والمبادرات الفعالة تقوم على قراءة دقيقة للواقع، وامتلاك رؤية واضحة للمستقبل، مع الشجاعة والإقدام في اتخاذ الخطوات الحاسمة، ومن يراقب السياسة القطرية، يجد أنها ليست فقط مستجيبة للحدث، بل تصنع الحدث وتتفاعل معه بمبادراتها، وذلك عبر توظيف الدبلوماسية المرنة، والوساطات الذكية، والمشاريع التنموية، والسياسات الاقتصادية الرائدة. والناظر أيضا إلى علم الإدارة العامة والسياسات العامة يجد أن صناعة المبادرات لا تقتصر على السياسة وحدها، بل تمتد إلى الاقتصاد، والثقافة، والتنمية، بل وحتى الحياة اليومية للشعوب والمؤسسات، فالنجاحات الكبرى في التاريخ لم تكن وليدة المصادفة، بل كانت نتيجة مبادرات جريئة قام بها أفراد ودول امتلكوا الشجاعة والقدرة على التفكير خارج الصندوق. لذلك يعد مفكرو الإدارة العامة فلسفة المبادرات كإحدى الركائز الأساسية التي تُمكّن الحكومات والمؤسسات من تحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات المتغيرة، ويُعرّف مفهوم المبادرات على أنها خطوات استباقية وإستراتيجيات مدروسة تتخذها الجهات الإدارية بهدف تحسين الأداء المؤسسي، وزيادة الكفاءة، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات بأنواعها السياسية والاقتصادية وغيرها، بأساليب استثنائية فريدة، فالمبادرات ليست مجرد أفكار وأمنيات، بل هي خطط تنفيذية واقعية محددة الأهداف والزمن والموارد، تهدف إلى إحداث تغييرات إيجابية مستدامة، سواء على مستوى الخدمات العامة أو السياسات الاقتصادية أو الحوكمة المؤسسية، وتعتمد المبادرات الناجحة على التخطيط السليم، والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، والتفاعل السريع مع المتغيرات المحلية والدولية، مما يجعلها أداة فعالة في صياغة السياسات العامة وتحقيق الأهداف الوطنية والقومية والإقليمية. وفي عالم السياسة نجد أن الإبداع السياسي، يتمثل في ذلك القائد أو المسؤول الذي يقدم المبادرات الاستثنائية ويستطيع التعامل مع التحديات السياسية والإستراتيجية بأساليب مبتكرة، وهذا النوع من السياسيين يتميزون بقدرتهم على قراءة المشهد السياسي بذكاء، واتخاذ قرارات استباقية، والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية بطريقة ديناميكية. فالمبدعون السياسيون عبر التاريخ هم من قادوا التحولات الكبرى، وأحدثوا تغييرًا إيجابيًا في مجتمعاتهم، وذلك عبر رؤيتهم الإستراتيجية، وقدرتهم على التفاوض وتقديم مبادرات تاريخية، وإيجاد أرضيات مشتركة بين الأطراف ذات العلاقة، تحقق الاستقرار والتنمية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
888
| 05 فبراير 2025
توطين الوظائف هي قضية تُثير الكثير من النقاشات بين المؤيدين والمتحفظين، حيث يمثل التوطين استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية والوافدة. ومع ذلك، فإن الآراء المتباينة حول هذا المفهوم تبرز الأبعاد المختلفة لهذه القضية وتدعو إلى نقاش متزن، فالمؤيدون يرون أن التوطين يمثل خطوة أساسية نحو الاستقلالية الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة، ومن أبرز مزايا التوطين هو قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة في المجتمع. فالتوطين لا يقتصر فقط على تمكين الأفراد اقتصاديًا، بل يعزز شعورهم بالانتماء الوطني ويجعلهم شركاء في التنمية، ويعتبر المؤيدون أن التوطين يسهم في بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على إدارة المؤسسات وتحقيق التقدم في مختلف القطاعات، فالاستثمار في رأس المال البشري المحلي الوطني هو ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومستدام، مما يجعل التوطين ضرورة وطنية وليس خياراً ومتعلقا بالأمن القومي الوطني. ولكن على الجانب الآخر، هناك من يرى أن التوطين يواجه تحديات كبيرة قد تؤثر سلباً على كفاءة سوق العمل، وأحد تلك الانتقادات الرئيسية هي نقص المهارات المتخصصة بين الكوادر الوطنية وفقرها، خاصة في القطاعات التي تتطلب خبرات تقنية متقدمة قد لا تتوافر بين جموع المواطنين من العاملين، فيرى المتحفظون أن فرض التوطين بالقوة دون مراعاة لمتطلبات الكفاءة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وزيادة التكاليف التشغيلية. ونجد أنه غالباً ما يُثار تساؤل حول القدرة على تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين واستمرار تدفق الكفاءات الأجنبية، ففي بعض الحالات، يكون وجود العمالة الأجنبية ضرورياً لضمان نقل الخبرات وتطوير المهارات المحلية. فعند النظر إلى هذه الآراء، يبدو أن التوطين هو قضية معقدة تتطلب حلاً وسطاً يجمع بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتمكين المواطنين، التحدي الحقيقي الآن يكمن في كيفية تحويل التوطين من مجرد سياسة إدارية إلى رؤية استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي. لذلك قدم العديد من الباحثين في النظم الادارية مجموعة من الحلول ومنها أن يتم التركيز على تطوير برامج تدريبية فعالة تواكب احتياجات السوق وتسد الفجوة بين التعليم الجامعي والمهني وسوق العمل ومتطلباته، كما أن التوطين يجب أن يتم بطريقة تدريجية انسيابية ومدروسة تضمن توظيف الكفاءات المناسبة في الأماكن الصحيحة وليس فقط لأنه ابن البلد، ولا يمنع ذلك الاتجاه من استغلال كل الكفاءات الاجنبية والخارجية وجعلها شريكة في تنمية قدرات الموظفين المحليين سواء الحاليين أو القادمين لسوق العمل، لذلك فالتوطين ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو عملية تنموية شاملة تحتاج إلى رؤية واضحة واستراتيجيات مرنة، ويبقى التوطين مشروعاً يتطلب توازناً دقيقاً بين الطموحات الوطنية الداعمة للموظف المواطن وبين الواقع العملي الذي يراعي نقص المهارات الفنية الاستثنائية في بيئة العمل الوطنية.
909
| 29 يناير 2025
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا.. بهذا البيت العذب عبّر ابن زيدون عن مرارة الفراق وتحوله من قرب الأحبة إلى وحشة البعد، وعن تبدل دفء اللقاءات إلى جفاء يعصف بالقلوب. في زمنه، فكان الفراق نتيجة للظروف الجغرافية أو الأقدار المحتومة، لكننا اليوم نعيش فراقًا من نوع آخر، فراقًا تغذيه التكنولوجيا الحديثة التي كان يُفترض بها أن تقربنا. ففي عالمنا الحديث، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث وعدتنا بتقريب المسافات وتعزيز التواصل بين البشر. ومع ذلك، حملت معها سؤالًا محوريًا: هل نحن اليوم أكثر قربًا أم أكثر عزلة؟ لقد أضحت المنصات الرقمية وسيلة أساسية للتفاعل، لكنها كشفت تدريجيًا عن جوانبها الأخرى، حيث قدّمت لنا فرصًا غير مسبوقة للتواصل، لكنها في الوقت نفسه زرعت بذور العزلة والانزواء خلف الشاشات، وأصبحت العلاقات تُختصر في تعليقات وإعجابات إلكترونية، وفقدنا الكثير من دفء اللقاءات الحقيقية التي تعمق الروابط بين الناس. كم مرة جلسنا في غرفة واحدة ومكان واحد مع أصدقائنا أو أفراد عائلتنا، لكن الصمت كان سيد الموقف، والجميع منشغل بشاشته؟ التكنولوجيا التي كان يُفترض أن تقربنا تحولت في بعض الأحيان إلى حاجز غير مرئي يبعدنا عن التواصل الإنساني الحقيقي. أصبح الناس يتحدثون دون أن يسمعوا بعضهم البعض، ويشاركون دون أن يشعروا بحلاوة المشاركة، وينشغلون بمتابعة حياة الآخرين بدلًا من عيش حياتهم الخاصة بصدق وعمق. لكن مع ذلك لا يمكننا إنكار الجانب الإيجابي للتكنولوجيا. فهي جلبت معها فوائد لا تُقدر بثمن، إذ أصبح بإمكاننا أن نبقى على اتصال بأحبائنا مهما بعدت المسافات، وأن نشارك لحظاتنا ونتعلم ونعمل بطرق لم تكن متاحة من قبل. ومع ذلك، يبقى السؤال: كيف نوازن بين هذه الفوائد وبين التأثيرات السلبية التي تهدد عمق علاقاتنا ودفئها؟ طبيعي جدا أن الحل لا يكمن في التخلي عن التكنولوجيا، بل يكمن في طريقة استخدامها وأن تكون بوعي، فيجب أن نعيد صياغة علاقتنا بها، بحيث نضع حدودًا لاستخدامها ونخصص وقتًا خاليًا من الشاشات، لنعيش اللحظات مع أحبائنا بصدق واهتمام. فاللقاءات الحقيقية، والمحادثات الصادقة، والنظر في عيون من نحب، تعيد الروح إلى العلاقات التي أرهقتها السطحية الرقمية. وفي النهاية، إنقاذ العلاقات الإنسانية بيننا مسؤوليتنا جميعا! أفرادا وجماعات، فالتكنولوجيا أداة قوية إذا أُحسن استخدامها، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن الروابط الحقيقية الشاعرية التي تُبنى على الثقة والاهتمام، فإذا تعلمنا التوازن بين العالم الرقمي والواقعي، يمكننا أن نصنع عالمًا يحتفظ بإنسانيتنا، حيث تصبح التكنولوجيا وسيلة لتعزيز العلاقات، وليس لتحويلها إلى ظلال باهتة لا حياة فيها.
444
| 22 يناير 2025
في عالم يموج بالتحديات النفسية والمشاعر المتناقضة، يصبح السؤال الملح في أذهاننا هو عن اللامبالاة، ذلك الأمر المثير والداعي للتفكير العميق. هل هي فلسفة للراحة النفسية أم مجرد هروب من مسؤوليات الحياة؟ نجد أن اللامبالاة تجذبنا كفكرة إلى مفترق طرق بين التفسيرين، إذ يرى البعض أنها أسلوب حياة يهدف إلى إيجاد التوازن الداخلي بعيداً عن التوترات والمشاعر السلبية، بينما يراها آخرون هروباً من المواجهة الحقيقية مع الواقع، وهي حالة من التجرد من الالتزامات والمشاعر التي تستهلك طاقتنا، فهل هي فعلاً إستراتيجية للتخفيف من الضغوط، أم هي مجرد وسيلة للابتعاد عن التحديات الحقيقية؟ اللامبالاة، في جوهرها، قد تكون رد فعل طبيعي على مشاعر الإحباط أو الاستنزاف النفسي، ففي ظل عالم مليء بالمشكلات الاقتصادية، الاجتماعية، والعاطفية والسياسية، يسعى البعض إلى الانسحاب والتوجه إلى حالة من اللامبالاة كآلية وأداة دفاعية تحميهم من الاضطرابات المستمرة والضيق والتوتر. وهذا الانسحاب، رغم أنه يبدو سلبياً، قد يُفسر في بعض الأحيان على أنه محاولة لإيجاد مسافة صحية من ضغوط الحياة اليومية. حين يتخذ الإنسان من اللامبالاة فلسفة حياة، فإنه يسعى إلى التوازن الذهني، معترفاً أن التفاعل الزائد مع العالم يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق العاطفي. ففي بعض الحالات، تكون اللامبالاة بمثابة حاجز نفسي يحمي الفرد من الانغماس في المشاعر السلبية أو المواقف المؤلمة والعيش في دوامة مغلقة من الآلام. ولكن دعونا نفكر ونتأمل.. فعندما يصبح الشخص غير مكترث بالقضايا الكبرى في الحياة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو شخصية، قد ينطوي هذا على نوع من الفراغ الروحي، والهروب هنا لا يتجسد فقط في تجاهل الأمور التي قد تكون مؤلمة، بل في الهروب فقط دون سعي إلى التغيير أو التأثير في الواقع من حوله. فمن هذا المنظور، تكون اللامبالاة بمثابة عباءة نرتديها لحماية أنفسنا من المواجهات التي تتطلب بكل صراحة شجاعة منا أو تتطلب أن نكون أكثر التزاماً في عالم يتسم بالحركة الدائمة غير المستقرة. فقد يشعر الفرد حينها بأن اللامبالاة هي طريقة للبقاء بعيداً عن الفوضى، لكنها قد تؤدي إلى انفصال عن الذات والآخرين. وبالرغم من الانتقادات التي قد توجه للامبالاة باعتبارها مظهراً من مظاهر الخمول العقلي والروحي، فإنه يمكن أن تكون أداة فعالة لابتكار إستراتيجيات مرنة للتعامل مع القلق والخوف والتفكير الزائد. فعندما نتوقف عن الانخراط في كل التفاصيل الصغيرة التي تزعجنا، قد نجد مساحة للتنفس والتركيز على الأهداف الأكثر أهمية في حياتنا. فاللامبالاة ليست دائماً سلبية، فهي قد تفتح مجالاً للتفكير العميق في ما هو جوهري حقاً، وتساعد على اتخاذ خطوات أعمق وأكثر هدوءاً في حياتنا. إذن، عندما نبحث عن إجابة هذا التساؤل: هل اللامبالاة هي فعل انتقامي تجاه الحياة أم إستراتيجية للبقاء على قيد الحياة؟ فنستطيع أن نقول هي مزيج بين الراحة النفسية وبناء الاستقرار وبين الجبن والهروب من مواجهة مخاطر الحياة إلا أن الجواب الصحيح يظل في يد الفرد، الذي يقرر في النهاية إن كانت اللامبالاة تعني له راحة أم سجنًا من الخيارات المغلقة.
939
| 15 يناير 2025
من يرى التدخل الغربي المشؤوم في سوريا وفرض أجنداتهم على الإدارة السورية بعد سقوط بشار الأسد يجد أن الغرب يمارس بكل بجاحة ازدواجية للمعايير في منطقتنا الشرق أوسطية، فبعد سنوات من الصراع في سوريا والذي أودى بحياة مئات الآلاف ودمر البنية التحتية، يبدو أن تركيز هذه القوى العالمية الغربية لم يكن على تخفيف معاناة الشعب السوري أو تحقيق تطلعاته، بل على ضمان نفوذها ومصالحها في سوريا المستقبل، فبدلاً من تقديم دعم حقيقي لإعادة الإعمار وبناء دولة مستقرة، تعمل القوى الغربية على فرض أجندات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية تخدم مصالحها، ومصالحها فقط، وهذا التدخل ليس هدفه دعم الاستقرار أو تحقيق الديمقراطية كما تدعي، بل السعي لترسيخ النفوذ الغربي في المنطقة ككل، بغض النظر عن احتياجات السوريين الفعلية. وعند الحديث عن ازدواجية المعايير في تعامل القوى الغربية مع العالم العربي نجدها باتت حقيقة لا يمكن إنكارها، حيث تتحول القيم الأخلاقية إلى أداة انتقائية تخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية، ونجد أننا تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان، تفرض علينا تصورات لا تمت لواقعنا العربي وثقافتنا الاسلامية بصلة، في حين تغض أبصارهم عن جرائمهم في حق الشعوب أو جرائم حلفائهم. فالغرب أو القوى الغربية ومن يحالفهم في ديار العرب، والذي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، نجده يختار بعناية القضايا التي يثيرها، ويروج السيناريوهات المشوهة لبلداننا وصورتها وتسعى لإضعافها وإظهارنا بمظهر الضعف والتخلف، بينما يمر الغرب بصمت أمام انتهاكات جسيمة ترتكب داخل حدوده أو من قِبل حلفائه في المنطقة، وهذه الانتقائية الاقصائية تُظهر حقيقة أن القيم التي يدافعون عنها ليست إلا ستارًا لتحقيق مكاسبهم على حساب دولنا وأجيالنا وشعوبنا العربية. ومن أمثلة ازدواجية المعايير في تعامل القوى الغربية مع عالمنا العربي منها: حقوق الإنسان واللاجئين، حيث تنتقد الدول الغربية سجل حقوق الإنسان في العالم العربي، لكنها في الوقت نفسه تتجاهل معاناة اللاجئين الذين نزحوا بسبب الحروب التي كانت القوى الغربية نفسها طرفًا في تأجيجها وإشعالها. ومن أمثلتها تحيز القوى الغربية ضد القضية العربية الفلسطينية، حيث تدافع القوى الغربية عن إسرائيل رغم انتهاكاتها الواضحة لحقوق الفلسطينيين من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والاعتداءات العسكرية، بينما تفرض عقوبات صارمة على دول عربية لانتهاكات بسيطة أقل حجمًا بكثير، مما يكشف عن انحياز فاضح في تطبيق المعايير الدولية في العقوبات، أما اقتصاديًا، فنجد أنه قد تم فرض سياسات اقتصادية ومالية تخدم الشركات الغربية الكبرى تحت ذريعة «تحرير الأسواق»، فتقوم بكل استغلال سلبي لمواردنا الاقتصادية مخلفة في آثرها المزيد من الفقر والبطالة في العالم العربي. فعلى المجتمعات العربية أن تستفيق وتتمسك بهويتها وقيمها، وتواجه هذا التغول السياسي والاقتصادي والثقافي بشجاعة وبسالة، فنحن بحاجة إلى آلة إعلامية قوية ومحترفة تسوق أفكارنا وعروبتنا وقيمنا الأصيلة وهويتنا الفريدة في الداخل والخارج، ونحتاج الى فقه بناء التحالفات السياسية التي تحقق مصالحنا، فعالمنا ليس أحادي اللون، وتنوعنا الثقافي في المنطقة يجب أن يكون مصدر قوة، لا نقطة ضعف يستغلها الغرب للهيمنة علينا، فقد آن الأوان لأمة العرب أن تستفيق.
669
| 08 يناير 2025
يقول أحد المفكرين عن الأخلاق الإنسانية ومنبعها الأجلى: «الأخلاق ليست ما نتعلمه من الآخرين أو ما يُفرض علينا، بل هي صوت العقل الداخلي الذي يوجهنا نحو الخير.» هذه المقولة تعكس رؤية فقهاء الأخلاق باعتبارها نابعة من العقل البشري المستقل الحر المؤمن بالمنفعة العامة للبشرية، وليس من عوامل خارجية مثل سلطة الدولة والجماعة. ولطالما كان النقاش في الأوساط العلمية والشعبية حول دور الدولة والسلطة والقوة القاهرة في تشكيل أخلاقيات المجتمع محط جدل بين الفلاسفة والمفكرين وحتى عامة الناس في تساؤلاتهم. فالدولة، ككيان سياسي منظم يملك القوة القهرية والنظامية، تحمل على عاتقها مسؤولية الحفاظ على النظام وتحقيق العدالة بين الناس. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تتجاوز الدولة دورها التنظيمي لتفرض أخلاقيات معينة ومحددة على المجتمعات ذات التنوع الطائفي والفكري والاجتماعي والديني، أم تقف على الحياد من كل ذلك ؟ لذلك فالدولة، بطبيعتها وممارساتها، ليست كيانًا محايدًا تمامًا ومستقلاً كلياً، فهي تستند إلى قوانين تعكس قيمًا ومؤشرات غالبًا ما تكون مستوحاة من ثقافة المجتمع وعاداته وديانته وتاريخه الاجتماعي. فمثلاَ نجد أن القوانين التي تحظر السرقة، ليست مجرد قواعد تنظيمية عقلية بحتة، بل هي تعبير وانعكاس عن أخلاقيات تحترم حق الملكية بين الناس، كذلك، قوانين العدالة، أو تلك التي تعاقب على التمييز والعنصرية، تعكس تطورًا في وعي المجتمع بقيم العدالة والاحترام. إلا أنه قد تختلف درجة تدخل الدولة في فرض الأخلاقيات باختلاف أنظمتها السياسية والثقافية. ففي بعض الأنظمة السلطوية الحادة، قد تستخدم الدولة أدواتها القمعية للسيطرة على المجتمع، حيث تفرض الدولة تصوراتها الخاصة عن الخير والشر دون مراعاة التنوع الفكري أو الثقافي. أما في الدول الديمقراطية أو التشاركية، فنجد أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تنظيم المجتمع واحترام حرية الأفراد، مما يجعلها أكثر ميلاً إلى الحياد النسبي. إلا أن الحياد الكامل قد يكون ضربًا من الخيال والغير معقول، فحتى عندما تبدو الدولة غير متدخلة ومنزوية، فإنها تساهم بشكل غير مباشر في تشكيل الأخلاقيات من خلال سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، فعلى سبيل المثال، إذا دعمت الدولة نظامًا تعليميًا يعزز قيم التعاون والاحترام، فإنها تساهم في بناء أخلاقيات المجتمع بطرق غير مباشرة. فالدولة ليست مجرد حارس على البوابة، بل هي شريك في تشكيل الهوية الأخلاقية للمجتمع، التحدي يكمن في أن يكون هذا التشكيل متوازنًا، بحيث لا يحد من حرية الأفراد، بل يفتح أمامهم آفاقًا للعيش ضمن إطار قيم يعزز التعايش والاحترام المتبادل. ويجب أن يكون في ذهننا دوما أن الدولة المثالية ليست تلك التي تفرض أخلاقيات معينة بالقوة، ولا تلك التي تقف على الحياد التام، بل هي التي تسلك بين ذلك سبيلاَ متوازنا وتمكّن المجتمع من التطور أخلاقيًا عبر توفير بيئة تحتضن التنوع بين الناس، فتتحول الأخلاقيات إلى كيان ونبض حيّ يتفاعل مع تطلعات الأفراد وآمالهم وطرائق معيشتهم، بدلاً من أن تكون مجرد قوانين جامدة تُفرض على الناس فتسبب نفورهم وابتعادهم.
1098
| 01 يناير 2025
عند النظر إلى مسيرة ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، نجد أنه مثال حي بارز على مفهوم قيادي حديث ألا وهو مفهوم القيادة التحويلية. فمنذ توليه المنصب، قاد تحولًا ثقافيًا داخل الشركة، مشجعًا على الابتكار والتعلم المستمر والتعاون، وقام بالتركيز على تطوير عقلية النمو والتكيف مع التغييرات التكنولوجية السريعة، مما أعاد لمايكروسوفت مكانتها الرائدة في السوق، ومن مقولاته: "إذا كانت أفعالك تُلهم الآخرين للحلم أكثر، والتعلم أكثر، والعمل أكثر، وأن يصبحوا أفضل، فأنت قائد بحق". تظهر أهمية القيادة التحويلية كمنهج فعّال لتحقيق النجاح والإلهام، فالقائد التحويلي ليس مجرد شخص يُصدر الأوامر، بل هو فرد قادر على إحداث تغيير إيجابي عميق في فريقه ومحيطه، فهو القيادي الذي يمتلك رؤية واضحة ويستطيع تحفيز الآخرين لتحقيق هذه الرؤية من خلال الإلهام والتوجيه المستمر. ومن ميزات القائد التحويلي هي قدرته على رؤية المستقبل والتخطيط له، فهو لا يكتفي بمواجهة التحديات اليومية الروتينية، بل يسعى إلى بناء إستراتيجية طويلة الأمد مما يتطلب هذا النوع من القيادة مرونة في التفكير وقدرة على الابتكار، حيث يعمل القائد الذي ينتهج النهج التحويلي على تشجيع فريقه على التفكير خارج الصندوق ومواجهة المشكلات بطرق غير تقليدية، لأنه ببساطة يُقدّر الإبداع ويمنح الأفراد مساحة للتعبير عن أفكارهم وتطوير مهاراتهم. وأيضا من أهم صفات القائد التحويلي هي قدرته على بناء الثقة بينه وبين فريقه، فهو يستمع بإنصات، ويهتم بمشاعر الأفراد واحتياجاتهم، ويظهر تعاطفه معهم. وهذا النوع من التفاعل الشعوري يُشعر الفريق بقيمتهم ويعزز ولاءهم وحماسهم للعمل دائما، ونجد أنه عندما يشعر الأفراد بأن قائدهم يهتم بنجاحهم الشخصي، فإنهم يبذلون جهدًا مضاعفًا لتحقيق أهداف الفريق إرضاء للقائد الذي زرع الثقة فيهم كرد للجميل. أما بالنسبة لخاصية الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، فنجد أن القائد التحويلي لا يخشى المخاطرة عندما يكون ذلك ضروريًا لتحقيق تقدم حقيقي في مؤسسته أو منظمته، وقراراته تأتي بناءً على تحليل دقيق وتفكير عميق، وليس بشكل عشوائي. فهذه الشجاعة الإدارية القيادية، إلى جانب الحكمة الذاتية والتروي، تضمن أن يكون القائد مصدرًا للإلهام والاحترام. وعلاوة على ذلك، يعمل القائد التحويلي على تطوير قادة آخرين داخل فريقه ونقل خبراته لهم، لذلك فهو لا يسعى إلى أن يكون الوحيد المتمكن الذي يقود، بل يسعى إلى تمكين الآخرين وإعدادهم لتحمل المسؤوليات في قابل الأيام، فهذا الأسلوب يخلق بيئة عمل ديناميكية ويضمن استمرارية النجاح المؤسسي حتى في غياب القائد، كما يعزز الإحساس بالمسؤولية الفردية ويشجع الجميع على الإبداع والمبادرة. فالتطور الشخصي والمهني ضروري لمواكبة التحديات الحديثة في أعين القادة التحويليين، فهو يُحفز الفريق على تطوير مهاراتهم واكتساب معرفة جديدة باستمرار، وذلك الأمر جدير بأن يؤدي إلى تحسين الأداء الجماعي ورفع مستوى الإنتاجية. فإذا كنت تسعى لتكون قائدًا تحويليًا، فعليك أن تبدأ بتطوير نفسك أولاً، ثم تسعى لتمكين من حولك وتحفيزهم، كن ذلك الشخص الذي يرى الإمكانيات الكامنة في الآخرين ويساعدهم على تحقيقها، وتذكر أن القائد التحويلي لا يُغيّر فقط نتائج العمل، بل يُغيّر حياة الأفراد نحو الأفضل، ويترك أثرًا دائمًا فيبيئتهومجتمعه.
849
| 25 ديسمبر 2024
لا ينكر عاقل أن الأزمات السياسية تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية العربية، إذ تؤثر على الأداء الإداري والمؤسسي للحكومات العربية، وتنعكس سلبًا على الكفاءة والفعالية داخل هذه المنظمات. وهذه الأزمات تتنوع ما بين صراعات سياسية داخلية، أو تغييرات حكومية متكررة، أو حتى ضغوط خارجية من قبل القوى العالمية المؤثرة في القرارات العربية فتُعطل استقرار العمل الإداري الحكومي، مما يمتد تأثيره ليشمل جميع مستويات الإدارة بدءًا من الموظفين الصغار وصولًا إلى القيادات العليا. ففي أوقات الأزمات السياسية الحادة، تصبح عملية اتخاذ القرار السياسي والإداري بطيئة وغير فعالة، حيث يتردد المسؤولون في المنظمات والمؤسسات العربية في اتخاذ قرارات حاسمة خوفًا من ردود فعل غير متوقعة أو تغييرات قد تهدد مناصبهم أو منافعهم أو وجودهم التنظيمي، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع وتعطيل تقديم الخدمات العامة، وبالتالي تراجع مستوى الخدمة وتقليل ثقة المواطنين في المؤسسة الحكومية. وعلى سبيل المثال، قد يتم تجميد مشروعات البنية التحتية أو تطوير المرافق الصحية والتعليمية بسبب التخوف من التبعات السياسية أو اتهامات بالفساد. كما تُعرِّض هذه الأزمات السياسية الموظفين لحالة من القلق وعدم الاستقرار الوظيفي لغموض الظروف السياسية، حيث يتسبب التغيير المتكرر وغير المنطقي في القيادات في خلق بيئة عمل غير آمنة نفسيًا بالنسبة للموظف العام. وهذا الوضع ينعكس سلبًا على دافعيتهم للعمل ويزيد من معدلات التسرب الوظيفي والإضرابات والاحتجاجات والتسخط الإداري، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وحدوث أخطاء وتخبطات إدارية نتيجة قلة التركيز والضغط النفسي المتزايد على الموظف العام. وبالإضافة إلى ذلك، ينتشر الفساد الإداري بشكل أكبر خلال الأزمات السياسية، حيث تستغل بعض الفئات النافذة الوضع السياسي الهش لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وقد تُمنح العقود والمناقصات لشركات غير مؤهلة أو تفتقد الكفاءة، مما يهدر الموارد المالية ويقوّض جهود التنمية التي تسعى لها الأنظمة العربية. وأيضا نجد أن التوترات السياسية تجعل المؤسسات الحكومية تعاني من صعوبة التخطيط الاستراتيجي وصياغته، حيث تصبح السياسات متغيرة والأهداف غير ثابتة، مما يعوق وضع وتنفيذ خطط طويلة الأمد. وبدلاً من ذلك، ينصب التركيز على إدارة الأزمات الفورية والحالية، مما يحد من الابتكار والإبداع والتطوير الإداري ويجعل المؤسسات العربية غير قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحسين جودة خدماتها ورسم خطوط السياسات العامة. وأيضا تؤدي الانقسامات السياسية إلى خلق صراعات داخلية بين الإدارات الحكومية، خاصة إذا كانت هناك انتماءات سياسية متضاربة أو محسوبيات أو شللية، وهذا يُضعف التعاون المؤسسي ويؤدي إلى تعقيد الإجراءات في المؤسسات ويفشل منظومة العمل الجماعي ويعطل المشروعات المشتركة. فالأزمات السياسية ليست مجرد تحديات عابرة؛ بل هي عوامل معقدة ومتشابكة تؤثر على بنية المؤسسات الحكومية العربية وأدائها اليومي. ومن الضروري أن تعمل الحكومات على تعزيز الاستقرار المؤسسي السياسي، وضمان استقلالية الإدارة عن الصراعات السياسية، وتبني معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة أو الحكم الرشيد، وتوفير بيئة عمل تدعم الابتكار والعدالة، فالتغلب على هذه الأزمات السياسية يُسهم في بناء مؤسسات قوية قادرة على خدمة المواطنين بفعالية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المجتمع في الحكومة ودعم استقرار الدولة وتقدمها.
606
| 18 ديسمبر 2024
صدر لي أول مؤلفاتي، وذلك في معرض الكتاب الدولي في الكويت الأسبوع الماضي والمعنون بالأرغونوميات Ergonomics، والذي لاقى ترحيباً في الأوساط الأكاديمية الإدارية المتعلقة بالدراسات التطويرية لبيئات الأعمال في المؤسسات العامة والخاصة العربية، و أيضا وجدت الكثير من القراء يتساءلون عن مفهومه وعن اسمه بالذات وما تاريخه. فيعود أصل كلمة الأرغونوميات (Ergonomics) إلى اليونانية، حيث تتكون من كلمتي «إيرغون» وتعني «العمل»، و»نومو» وتعني «القانون أو التنظيم»، فقد بدأ الاهتمام بهذا العلم في القرن التاسع عشر مع تطور الثورة الصناعية وزيادة الحاجة لتحسين ظروف العمل. وظهر المفهوم بشكل أكثر تنظيماً خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم استخدامه لتحسين وتصميم بيئات العمل المتخصصة بالآلات العسكرية وتسهيل استخدامها بفعالية أكبر عن طريق تحسين الظروف العمالية والعملية. وبعد الحرب، تطور علم الأرغونوميات ليشمل بيئات العمل المختلفة، ويهدف إلى تعزيز الإنتاجية وسلامة العاملين من خلال تصميم أدوات وأماكن عمل متوافقة مع القدرات البشرية. فالارغونوميات (Ergonomics) هو علم يهدف إلى تصميم بيئات العمل بحيث تتناسب مع قدرات الإنسان واحتياجاته، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الإصابات والإجهاد. ويدمج هذا المجال بين مبادئ الهندسة المعمارية وعلم النفس الإداري وعلوم الصحة والطب، لضمان أن تكون بيئات العمل آمنة وفعالة ومريحة. وتكمن أهمية الأرغونوميات في تعزيز الصحة والسلامة، والحد من المخاطر المرتبطة بالإصابات العضلية والهيكلية مثل آلام الظهر ومتلازمة النفق الرسغي، خاصةً في بيئات تتطلب تكرار الحركات أو الجلوس لفترات طويلة. وتسعى أيضا إلى زيادة الإنتاجية عن طريق تحسين تصميم مكان العمل يؤدي إلى تقليل التعب وزيادة كفاءة الموظفين، مما يؤدي إلى أداء أفضل في المهام. ومن فوائدها تحسين جودة العمل، فعندما يشعر الموظفون بالراحة ويقل تعرضهم للإجهاد البدني، فإنهم يكونون أكثر دقة واهتمامًا بالتفاصيل. ولا ننسى أهميتها في تقليل التكاليف، فتقليل الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل يساهم في خفض التكاليف المتعلقة بالتأمين الطبي وتعويضات العمال. ومن أهميتها النفسية تعزيز الرضا الوظيفي، فعندما تكون بيئة العمل المريحة والمصممة بعناية تعزز من شعور الموظف بالانتماء والرضا، مما ينعكس إيجابيًا على ولائه للمؤسسة. تتضمن ممارسات الأرغونوميات تصميم بيئات العمل بما يحقق الراحة والسلامة للعاملين. ومن تلك الممارسات تصميم أماكن جلوس مناسبة باستخدام كراسي تدعم أسفل الظهر وتسمح بتعديل الارتفاع لضمان وضعية جلوس صحية. وكما يُعد ترتيب محطات العمل أمرًا حيويًا، فمثلا، يجب وضع الشاشات على مستوى العين ولوحات المفاتيح في مستوى الكوع لتقليل التوتر العضلي. وتشجع ممارسات الارغونوميات على الحركة المنتظمة من خلال أخذ فترات راحة قصيرة للوقوف والتحرك، مما يخفف من أضرار الجلوس المستمر. وتركز بعض ممارسات الارغونوميات على الإضاءة المناسبة مما تخلق دورًا في تقليل إجهاد العين وتحسين التركيز، مع مراعاة تجنب الانعكاسات الضارة على الشاشات. ومن تلك الممارسات التدريب والتدرب على الوضعيات الصحيحة في تعزيز استخدام الأدوات بطرق آمنة، مع ضرورة استخدام أدوات مُصممة بعناية، مثل الفأرة المريحة ولوحات المفاتيح القابلة للتعديل، لتقليل الإجهاد الجسدي. فتطبيق هذه الممارسات يساهم في بيئة عمل صحية وأكثر إنتاجية. لذلك نجد أن الارغونوميات تلعب دورًا حيويًا في خلق بيئات عمل تُحسن من صحة العاملين وتزيد من كفاءتهم. وتطبيق ممارساتها يُعزز الإنتاجية ويقلل من المخاطر، مما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسات العربية بطريقة مستدامة وفعالة.
501
| 11 ديسمبر 2024
عندما صعد الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - المنبر لأول مرة بعد مبايعته، ارتج عليه الكلام ولم يستطع الحديث، لكنه واجه الموقف بحكمة وقال عبارته الخالدة: «إنكم إلى خليفة فعول أحوج منكم إلى خليفة قؤول». بهذه الكلمات البسيطة، لخص عثمان بن عفان فلسفة القيادة الحقيقية التي تقوم على الفعل قبل القول، والعمل قبل الخطابة. فهذه العبارة تمثل جوهر القيادة الصامتة، حيث لا تُقاس الإنجازات فيها وفي ممارساتها بكثرة الحديث والتصريح الاعلامي، بل بقوة الأفعال وتأثيرها المستدام. وفي عالم القيادة والادبيات الإدارية العلمية، كثيرًا ما يُعتقد أن النجاح مرتبط بمهارات الخطابة وقوة التأثير بالكلمات، لكن التاريخ أثبت أن هناك قادة عظماء لم يعتمدوا على الخطابة، بل على العمل الصامت المدروس والممارسة الفعلية، وتركوا أفعالهم تصنع التغيير والحدث. من هؤلاء القادة على سبيل المثال الخليفة العربي الاموي عمر بن عبد العزيز، وزعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي. فقد كان عمر بن عبد العزيز قائدًا صامتًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، وبمجرد توليه الخلافة والسلطة السياسية في دمشق، شرع في تنفيذ إصلاحات جذرية بصمت وهدوء، دون الحاجة إلى إثارة الجماهير أو إطلاق الوعود والاستعراض الإعلامي على المنابر. فقد أعاد الحقوق إلى أصحابها، وألغى الضرائب الظالمة التي أثقلت كاهل العامة، وحرص على نشر العدل بين المسلمين وغير المسلمين. فأصبحت قوته الحقيقية لم تكن في كلماته، بل في أفعاله التي عكست حكمته وتواضعه. كان صمته أداة للتفكير العميق واتخاذ قرارات مدروسة جعلت منه رمزًا للقيادة العادلة والفعالة. وحتى إن عصره شهد ازدهارًا اجتماعيًا واقتصاديًا بفضل إصلاحاته، ما جعله نموذجًا يُحتذى به في التاريخ السياسي الإسلامي. أما غاندي، فقد قاد الهند إلى الاستقلال بأسلوب فريد يرتكز على فلسفة «اللاعنف»، فلم يكن غاندي خطيبًا صاخبًا، لكنه استطاع تحفيز الملايين بأفعاله الرمزية والبسيطة. فخلال «مسيرة الملح»، ترك غاندي أفعاله تتحدث عنه، حيث قاد الشعب الهندي بخطوات صامتة لكنها مفعمة بالقوة، وصمته لم يكن غيابًا للكلام، بل كان أداة للتأمل والتخطيط، مما جعله نموذجًا عالميًا للتغيير السلمي. فالصمت في القيادة ليس غيابًا عن التأثير، بل هي وسيلة فعالة للتأمل والتخطيط المدروس. فعثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وغاندي وغيرهم أثبتوا أن القيادة الحقيقية تُبنى على الأفعال لا الأقوال، فهؤلاء القادة ألهموا الأجيال دون حاجة إلى صخب، وأظهروا أن الصمت قوة تُترجم إلى إنجازات ملموسة تغير مسار التاريخ.
696
| 04 ديسمبر 2024
الكتاب الذهبي ليس مجرد كتاب عادي يحتوي صفحات مطبوعة على أرفف مهجورة، بل هو بوابة استثنائية إلى عالم من الأفكار المتكاملة والقيمة، ونستطيع أن نعرف الكتاب الذهبي بذلك الكتاب الذي تختزل قراءته الكثير من الجهد، وتعوض عن الاطلاع على كتب عديدة في نفس مجاله والتي من شأنها ان تكون مشتتة أو مكررة، لذلك نجد أن هذا النوع من الكتب بمثابة جوهرة فكرية، تفيض بمعرفة مركزة تقدم للقراء زبدة الحكمة وخلاصة التجارب بأسلوب عميق وشامل و لا ننسى.. مباشر. فالكتاب الذهبي إذاً يتفرد بخصائص تجعله متفوقًا على غيره. أولاً، أن محتواه ليس عاديًا، فهو نابع من بحث معمق وتحليل مستفيض، مما يجعله مصدرًا غنيًا بالمعرفة الدقيقة. وثانيًا، أن لغته تجمع بين البساطة والعمق، مما يُسهل استيعاب الأفكار دون أن تفقد جاذبيتها أو أثرها الفكري. وأخيرًا، يركز الكتاب الذهبي على موضوع واحد أو مجال محدد بإحكام، يحيط به من كافة الزوايا، مما يحوله إلى مرجع لا غنى عنه لكل من يسعى للمعرفة الدقيقة في ذلك العلم أو الفن. ففوائد الكتاب الذهبي: أبعد من القراءة، فهي تختصر الزمن الذي يتسم بازدحام المهام وتشابك الاهتمامات، فيأتي الكتاب الذهبي كمنقذ لنا، حيث يختصر وقت القارئ الذي قد يضيع بين مئات المصادر المتكررة، ليقدم له أفضل ما يمكن الحصول عليه في صفحات معدودة. ومن فوائده: التعمق في الفهم، فهو يتجاوز هذا النوع من كتب التقديم السطحي للأفكار، ويساعدنا بأن نغوص في جوهر المواضيع والأفكار، إنه فعلاً يمنح القارئ فرصة لفهم الأمور بطريقة شاملة ومن زوايا متعددة. ومن فوائده الجمة أنه يساعد على إيقاظ العقل ونشاطه، بفضل ما يحويه من رؤى أصيلة وأفكار مركزة، فيحفز الكتاب الذهبي عقل القارئ على التفكير النقدي، ويعزز لديه القدرة على تحليل المفاهيم وإعادة صياغتها وفق رؤية شخصية. ومن الأمثلة الخالدة على الكتب الذهبية مثلا في مجال إدارة الأعمال والإدارة الحكومية، هناك كتب تُعد أساسية لكل من يسعى لفهم عميق وشامل لهذا العالم المعقد. ومن أبرزها يأتي كتاب «فن الحرب» لصن تزو، والذي يطرح استراتيجيات مرنة تُستخدم في التخطيط واتخاذ القرارات، متجاوزًا طبيعته العسكرية ليصبح دليلًا لريادة الأعمال، يليه كتاب «من جيد إلى عظيم» لجيم كولينز، والذي يكشف عوامل النجاح للشركات المتميزة، وكتاب «استراتيجية المحيط الأزرق» لدبليو. تشان كيم ورينيه موبورن، والذي يقدم أساليب مبتكرة لخلق أسواق جديدة بعيدًا عن المنافسة التقليدية. وأما في الإدارة الحكومية، يبرز كتاب «إعادة ابتكار الحكومة» لديفيد أوزبورن وتيد جابلر، والذي يناقش كيفية تحويل الحكومات إلى كيانات أكثر مرونة وكفاءة من خلال استراتيجيات القطاع الخاص. إذاً كيف تختار كتابك الذهبي؟ لعله السؤال الذي يتبادر الى ذهن القارئ الآن، إذ ليس كل كتاب يُعتبر ذهبيًا للجميع، فالاختيار يعتمد على احتياجات القارئ وأهدافه ونوع العلم الذي يريد الإبحار فيه، فيمكن العثور على هذا النوع من الكتب عبر التوصيات الموثوقة، أو البحث عن أبرز أعمال المؤلفين المتميزين في المجالات ذات الاهتمام والأهم من ذلك استشارة المتخصصين في كل مجال على حدة.
945
| 27 نوفمبر 2024
لطالما كان الطموح نحو المعالي سمة من سمات العظماء في تراثنا العربي، فالطموح إلى القمم هو ما يميز قادة الأمم وصُنّاع التاريخ، إذ لم يكن الوصول إلى المناصب العليا يومًا مجرد مطلب دنيوي، بل كان طريقًا لتحقيق الإصلاح وترك الأثر. ومن سيرة أصحاب المناصب العليا، نجد أن الإصرار والعمل الجاد كانا مفتاحي الارتقاء. فكما تسلّق الإنسان العربي قمة المجد في الحضارات القديمة بعزيمته، كذلك اليوم لا تزال «المناصب العليا الإدارية» متوقدة في ذهنية أصحاب الطموح الوظيفي. وفي بيئة العمل الخليجية المتسارعة، يبرز الموظفون الذين يتبنون أساليب جديدة ومبتكرة للتميز والارتقاء. وهذا التميز يتطلب مزيجًا من المهارات الشخصية والمهنية التي تجعل منك قائدًا مؤهلاً للوصول إلى تبني المسؤوليات الإدارية. وفي عالم الإدارة، يذكر مفكرو هذه المدرسة أنه لا يكفي أن تكون خبيرًا فنيًا في مجالك، بل يجب أن تمتلك المهارات الناعمة مثل القيادة، والعمل الجماعي، والتواصل الفعال. ويعد الذكاء العاطفي مثلا أحد العناصر الأساسية التي تمكنك من بناء علاقات قوية مع فريقك وزملائك. وتتعلم كيفية فهم مشاعر الآخرين وإدارتها بشكل متوازن يسهم في خلق بيئة عمل منتجة ومتناغمة. فالتعلم المستمر هو المفتاح للبقاء متميزًا في سوق عمل يشهد تغيرات متسارعة، ولم يترك لنا عصر التكنولوجيا وقتا لالتقاط الأنفاس، فيجب أن تسعى لاكتساب مهارات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات وغيرها. وللوصول إلى المناصب الإدارية، عليك تبني عقلية القائد قبل أن تحصل على المنصب. ابدأ بتولي مسؤوليات إضافية والمشاركة في وضع إستراتيجيات تساعد في نجاح فريقك. وتذكر أن المبادرة في العمل وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات دليل على قدرتك على تحمل المسؤوليات الأكبر، وخاصة في بيئة العمل الخليجية التي تعتمد بشكل كبير على التواصل الشخصي. كن حاضرًا في الفعاليات والمؤتمرات المهنية، وابحث عن مرشد إداري وحكيم وظيفي يشاركك خبراته ويوجهك نحو النجاح. وتذكر بأن القادة الناجحين هم الذين يفكرون بطريقة إستراتيجية ويقدمون حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات المؤسسة، وقدم دائمًا أفكارًا جريئة ولا تتردد، ولتكن مدروسة لتثبت قدرتك على تحقيق أهداف المؤسسة بأسلوب مبتكر واستثنائي. وبينما تطمح للوصول إلى المناصب العليا، لا تنس أبدا أن التواضع صفة وسمة بشرية عالية السمو وأساسية لأي قائد يريد أن يسمو بجناحيه، جناح الارتقاء الأخروي وجناح الارتقاء الدنيوي وأن تحقيق العدالة التنظيمية ونشر الخير في بيئة العمل هو من أعمال القياديين الاستثنائيين.
600
| 20 نوفمبر 2024
مساحة إعلانية

عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب...
14373
| 08 فبراير 2026

يطرح اليوم الرياضي إشكالية المفهوم قبل إشكالية الممارسة،...
1443
| 10 فبراير 2026
لم يكن الطوفان حدثًا عابرًا يمكن تجاوزه مع...
801
| 10 فبراير 2026

تعكس الزيارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة العربية...
624
| 05 فبراير 2026

لقد طال الحديث عن التأمين الصحي للمواطنين، ومضت...
585
| 11 فبراير 2026

يشهد الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة حالة مزمنة...
546
| 09 فبراير 2026

منذ إسدال الستار على كأس العالم FIFA قطر...
507
| 11 فبراير 2026

لم يعد هذا الجهاز الذي نحمله، والمسمى سابقاً...
495
| 09 فبراير 2026

لم يكن البناء الحضاري في الإسلام مشروعا سياسيا...
483
| 08 فبراير 2026
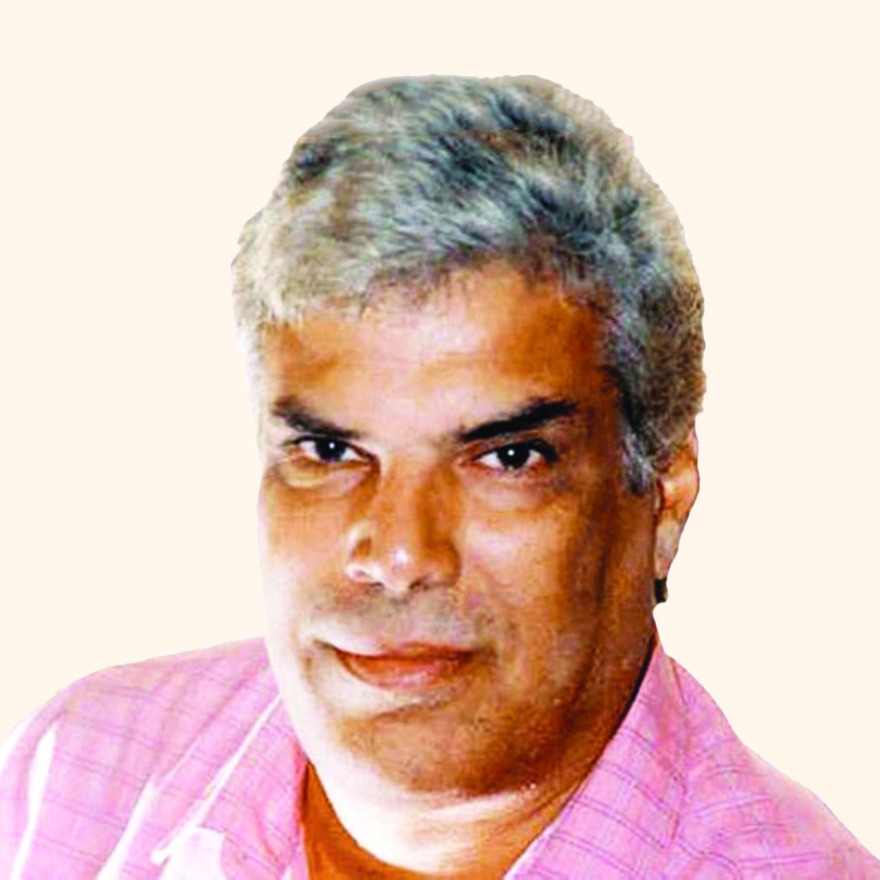
«الآخرة التي يخشاها الجميع ستكون بين يديّ الله،...
447
| 05 فبراير 2026

يستيقظ الجسد في العصر الرقمي داخل شبكة دائمة...
435
| 10 فبراير 2026

الثاني من فبراير 2026م، ليلة النصف من شعبان...
414
| 09 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
د. جاسم الجزاع
* باحث وأكاديمي كويتي
Jassimaljezza@hotmail.com
عدد المقالات 119
عدد المشاهدات 104700

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل





