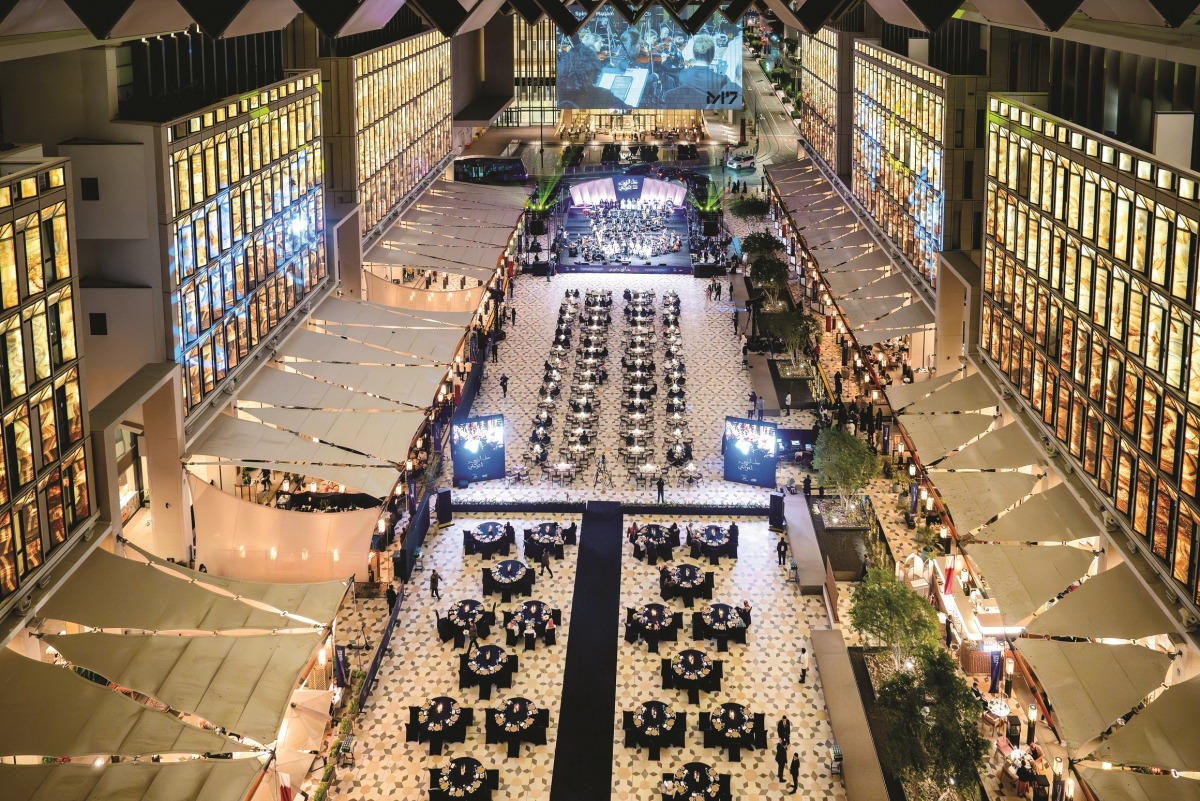رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يحرص التجار على الاهتمام بطريقة عرض البضائع لعلمهم أن العرض الجيد يعمل على جذب المزيد من الزبائن مما ينعكس على زيادة المبيعات، إن طريقة العرض المدروسة والاهتمام بالديكور وموقع المتجر إضافة لما يقوم به مسؤول المبيعات من شرح وإقناع، كل ذلك يضيف قيمة للبضاعة ويضفي عليها بريقًا يكون من الصعب على الزبون تجاوزه قبل أن تتم الصفقة. يروي أحد الأصدقاء تجربته مع أحد محلات الملابس المشهورة فيقول: «كنت كلما قصدت ذلك المتجر لشراء حاجة أجد نفسي أشتري أشياء أخرى لم أخطط لها، فقد تعودت أن يستقبلني البائع بابتسامة عريضة ويطلب لي القهوة قبل أن أفصح عن حاجتي، وبعد أن يلبي طلبي يبدأ باستعراض آخر المنتجات ويرغبني بأسلوبه المميز بالشراء فأجد نفسي قد وقعت في شِرَاكِه وأنا مبتسم، ثم أخرج من المتجر أدفع عربتي المليئة بمختلف المشتريات». ويضيف قائلًا: «المفاجأة هي عندما جاءتني رسالة نصية عن التنزيلات الضخمة التي أعلن عنها ذلك المتجر، عندها ذهبت لأغتنم تلك الفرصة فلم أجد من يستقبلني كما تعودت، ولم أجد البضاعة مرتبة كما كانت تعرض من قبل، بل شاهدت نفس البضاعة التي كنت فخورًا باقتنائها ذات يوم ملقاةً بطريقة عشوائية على منضدة عريضة وقد فقدت قيمتها المعنوية بقدر ما فقدت من سعرها، ورأيت نفس البائع جالس في مكتبه دون اكتراث بالزبائن، وكأن لسان حاله يقول «على الزبون أن يحس بالامتنان لتوفير السلعة له بهذه القيمة»، والحقيقة أن موسم التنزيلات فرصة للتاجر أيضًا كي يتخلص من بضاعته القديمة ليتمكن من عرض منتجاته الجديدة، نعم هناك توفير لبعض المال في التنزيلات ولكن في المقابل هناك هدر للاحترام والمهنية والتقدير». إن أسلوب «البيع في موسم التنزيلات» ليس حكرًا على الممارسات التجارية، بل له أوجه متعددة كذلك في الحياة الاجتماعية والسياسية، فقد يمارسه الأفراد تجاه بعضهم البعض في لحظة فارقة من العلاقة، أو تمارسه مؤسسات الدولة تجاه الموظف بعد خدمة طويلة، أو تمارسه المؤسسات الخدمية تجاه الجمهور، وكذلك قد تمارس ذلك الاسلوب الدول عند منعطف سياسي ما تجاه الأفراد والجماعات والدول الأخرى بعد أن ينتفي الغرض من العلاقة. وعلى أقل تقدير قد نلمس روح «البيع في موسم التنزيلات» في تعاطي موظف جهة خدمية مع المراجعين، أو في نظرته لواجباته ومسؤولياته تجاه الجمهور، فيتصرف وكأنه يقدم خدماته بلا مقابل، وقد نلمس ذلك في تصرف المرشحين لعضوية المجالس المختلفة، فنرى التباين الشاسع بين سلوك المرشح أثناء الحملة الانتخابية وسلوكه بعد أن يصل إلى كرسي العضوية حيث تبدأ عملية التنزيلات أو التنازلات عن الوعود الانتخابية.. وقس على ذلك. وختامًا، قد ينسى أولئك الذين ينتظرون «موسم التنزيلات» بفارغ الصبر أن البضاعة التي يسعون لاقتنائها حين ذاك قد فات موسمها وفقدت بريقها ورونقها، وأنهم سيدفعون مقابلها ثمنًا باهظا من الكرامة واحترام الذات.
1104
| 15 يناير 2025
كثيرا ما يتجادل المهتمون بشؤون الإدارة عن الفرق بين القائد والمدير وحدود الدور الذي يلعبه كل منهما مع العلم ان الفرق بين المهمتين شاسع فليس كل مدير مؤهلا ان يكون قائدًا، ولذلك يتراجع اداء الكثير من المؤسسات عندما يتخذ مجلس الادارة قرارًا بتعيين رئيس للمؤسسة اعتمادًا على سمعته الادارية السابقة دون التأكد من امكانياته القيادية والتي هي اساسًا في نجاح وازدهار المؤسسة. هل امكانيات المدير تكفيه ليتأهل كقائد؟ يقول الدكتور ستيفن كوفي صاحب كتاب العادات السبع: «إن الادارة موجهة لحل المشاكل في حين ان القيادة موجهة لخلق الفرص»، كما يرى بعض المهتمين بشؤون الادارة ان الذي يميز القائد عن المدير هو وجود الرؤية لدى القائد بالإضافة الى اهتمامه ببناء ثقافة المنشأة وسياساتها وقيمها اما المدير فهو المنفذ لأهداف المنشأة والمتابع لتقرير الاداء وقائمة الاولويات وتفاصيل المهمات المناطة بإدارته والتأكد من انجازها في الوقت المناسب. لذا ليس صحيحا ان من ينجح في عمله كمدير سينجح في عمله كقائد، ففي اغلب الاحيان يفشل المدراء الجدد في مهامهم كقادة، حتى لو كانوا مدراء ممتازين، وترجع أسباب ذلك في كثير من الأحيان إلى عدم امتلاكهم المهارات القيادية، إضافة إلى عدم قدرتهم على التخلص من طبيعة عملهم السابق في الدرجات الوظيفية الادنى، سواءً كان مديراً لإدارة او رئيساً لقسم او من كبار الموظفين، فتجد البعض يتعامل مع منصبه الجديد من منظور منصبه القديم لعدم امتلاكه للمهارات المطلوبة والمرونة الكافية والقدرة على التكيف لاستيعاب المهام والمسؤوليات المترتبة على المنصب الجديد، لذا يبدأ بالتركيز على ما تعود على متابعته في منصبه القديم، ويهتم بتفاصيل الامور التي هي من مسؤوليات الموظفين الذين يلونه في الادارة وقد لا يتم او يصعب اكتشاف تخبط المدير مبكرا خصوصا في المؤسسات التي تعاني من انسداد في قنوات المعلومات وتقارير الاداء أو شح في الاجتماعات الدورية مع الادارة العليا لمتابعة مجريات الامور. تقول ليز ويبر – مستشارة القيادة الإستراتيجية: «لا تخسر مديرًا جيدًا بجعله قائدًا سيئًا»، وتضيف قائلةً «إن المدراء الجيدين والقادة الجيدين يشكلون أهمية حيوية لأي منظمة، فكل منهما يساعد المؤسسة على تنفيذ خططها المستقبلية، ومع ذلك، فإن المدراء الجيدين قد لا يكونون بالضرورة قادة جيدين، والقادة الجيدون قد لا يكونون بالضرورة مدراء جيدين».
1182
| 08 يناير 2025
قبل عدة سنوات كنت في زيارة لأحد الأصدقاء الخليجيين، وهو من عشاق كرة القدم، وقد ذاع صيته كأحد أبرز الإداريين في مجال الرياضة، وتصدر النادي الذي يديره قائمة البطولات على مدى أعوام، دار بيننا حديث الأصدقاء عندما يلتقون بعد طول غياب ويتذكرون الأيام الخوالي، صحيح أن الإدارة الرياضية مجال له خصوصيته، إلا أنها تتقاطع مع الإدارة عمومًا في أي مجال من مجالات الحياة، لقد دفعني الفضول والشغف بعلوم الإدارة إلى سؤاله عن سر نجاحه في إدارة فريقه حتى وصل إلى ما وصل إليه، في حين أنه لم يحقق ذات النجاح في إدارته للإدارة التي كان يعمل بها في إحدى وزارات الدولة، ابتسم بكل ثقة والتفت إلي قائلًا: ياصديقي في ملعب كرة القدم أنا أمتلك مساحات كبيرة من الحرية في اتخاذ القرار الذي أراه مناسبًا دون أي تدخل خارجي، وبالتالي أتحمل مسؤولية قراراتي، النجاح في كرة القدم يبدأ بإعطاء صلاحية كاملة لمدير الفريق وينتهي بإختيار اللاعب المناسب في المكان المناسب، أما في العمل الحكومي فإن قواعد اللعبة مختلفة بشكل كبير والملعب مختلف أيضا، لو كانت الأمور تدار في القطاع الحكومي بنفس الطريقة التي تدار بها الأجهزة الرياضية لشهدنا ثورة ونقلة نوعية في أداء القطاعات الحكومية. ثم قال: إن ما يهم القائمين على إدارة الفرق الرياضية هو الفوز والفوز فقط، لأنه الهدف والدافع والمحرك لإدارة النادي الرياضي في جميع قراراتها، فلا مكان في الفريق لغير اللاعب الموهوب المبدع، في المقابل قد يتعرض أي لاعب لعقوبات تصل إلى الفصل من النادي بدون تردد في حال عدم التزامه بالتمرينات الرياضية أو انتهاكه لأخلاقيات اللعب، أو تدني مستواه إلى الحد الذي يؤثر على مكاسب الفريق، ولا يوجد مجال لأي اعتبارات أخرى. وأردف قائلًا: يا صديقي، في عالم الرياضة لا توجد اعتبارات للواسطة أوالمحسوبية في اختيار أعضاء الفريق، فلا يتم اختيار لاعب الهجوم لانه ابن فلان ولا الحارس لانه ابن علاّن، فليس بالضرورة أن اللاعب الموهوب أو المدير الناجح ينجب ابنا ناجحا أو موهوبا، لذلك يجب أن لا يكون النسب والعرق والطائفة معيارًا أبدا في اختيارك لأعضاء فريقك سواء في كرة القدم أو في العمل، ولا معيارًا لإعطاء المسؤولية أو حرمانها، بل يجب أن يكون المعيار هو الكفاءة والأخلاق والولاء لوطنك ومجتمعك، هذا إذا أردت أن يفوز فريقك طبعًا، أما إن أردت اللعب لمجرد اللعب دون تحقيق نتائج فذلك أمرٌ آخر..... انتهى كلامه. لقد كان حديثًا صريحًا وحادًا بعض الشيء، ولكن، اليست المقارنة بين ادارة نادي رياضي وادارة دائرة حكومية مقارنة مجحفة؟، اليس النموذج الرياضي اكثر مرونة؟، اليس القطاع الحكومي مقيدا بلوائح وقوانين وسياج من البيروقراطية؟، مع كل تلك الاعتبارات وغيرها، في المقابل ألا يمكننا كما قدمنا هذا النموذج المشرف في الإدارة الرياضية، وفي أكثر من مناسبة، أن ننقل روح التجربة وبيئتها إلى دهاليز القطاع الحكومي؟!، إذا استطعنا فعل ذلك فلا تسألني... لمن الكأس؟
1335
| 01 يناير 2025
دائمًا ما يكون للبدايات طابعها الخاص وشعورها المميز وتحدياتها الغامضة، فعندما يصبح الفرد على قمة هرم المؤسسة كوزير أو رئيس تنفيذي أو حتى مدير قطاع، وبغض النظر عن كفاءته أو تمكنه من تلك المهمة، يتنامى لديه للوهلة الأولى شعور بالرهبة والخوف من المجهول الذي لا يعرف عنه الكثير في الوقت الذي هو مسؤول عن تحقيق أهدافه وتنفيذ خططه وإبراز إمكانياته لإثبات أنه على قدر المسؤولية التي كُلف بها. قد يحاول البعض القفز على تلك التحديات والمشاعر والخوف من اختلال الصورة الذهنية عنه فيبدأ في التفكير بتحقيق بعض المكاسب السريعة أو ما يسمى بالإنجليزية (Quick wins)، ويتجلى ذلك في إصدار بعض القرارات الشكلية وغير المدروسة، بقصد التعبير عن وجود قيادة جديدة حاسمة، كالتشديد على الالتزام بساعات الدوام الرسمي، أو منع الصحف عن كبار الموظفين أو تقليصها، وأشياء أخرى متعلقة ببعض التفاصيل التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن ذلك أيضًا الاستعجال في الظهور الإعلامي في محاولة لقطف ثمار إنجازات المؤسسة ومشاريعها، فيجيرها لحسابه دون أي ذكر للمسؤول السابق أو فريق العمل الذي أنجزها. لا شك أن الأيام الأولى لتولي المنصب حرجة للغاية في تشكيل الصورة الذهنية عن المسؤول لدى الإدارة العليا والمتوسطة في المؤسسة أو الوزارة، وهنا تبرز ضرورة أن يتمتع المسؤول الأول بالحكمة في ترتيب الأولويات، والديناميكية في عملية صنع القرار، وبُعد النظر في رسم إستراتيجية المؤسسة، وحتى يتم إنجاز ذلك بالصورة الصحيحة، يتطلب التريث لحين التعرف على الفريق الذي يعمل معه، وإمكانات الموارد البشرية التي لديه، الدور المنوط بالمؤسسة، وموقعها الحالي من تنفيذ برامجها ومشاريعها وأهدافها الإستراتيجية، وأسباب تعثر بعض البرامج إن وجد ذلك، وكيفية معالجة الانحرافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطط والمشاريع المختلفة. قد يتطلب التعرف على المؤسسة أو الوزارة بكل أبعادها ونشاطاتها ما يقارب الثلاثة شهور تزيد أو تنقص، عندها يستطيع الوزير، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير رسم تصور للمستقبل مبني على معطيات الواقع وأولويات المرحلة، وأنصح دائمًا كل من يستشيرني في هذا المجال أن يجهز عرضا تقديميا من ثلاث شرائح فقط، يعرضه المسؤول الجديد على أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس الوزراء في حالة الوزير، الشريحة الأولى تبين الوضع الحالي بكل شفافية، وذلك يعطي انطباعًا إيجابيًا لدى المجلس وشعورا بالتمكن من الوضع، والشريحة الثانية تتحدث عما يجب أن يكون عليه الوضع مستقبلًا، وذلك يعزز الشعور لدى الجميع بتبني تلك الأفكار، والشريحة الأخيرة تبرز أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في سبيل تنفيذ خططها المستقبلية ومقترحات لمواجهة تلك التحديات، ومن شأن ذلك أن يعزز الدعم المادي والمعنوي للمؤسسة من أصحاب القرار.
1350
| 25 ديسمبر 2024
ونحن نعيش هذه الأيام المجيدة، ومع اقتراب اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة، قد يتساءل البعض عن دواعي الفرح والابتهاج السنوي بهذه المناسبة!، وعن بعض المفردات التي يكثر تداولها في هذه الأيام كحب الوطن والولاء، فما هو الوطن؟ وكيف ولماذا يكون الولاء له؟، هل الوطن هو الأرض التي ولدت عليها؟ أم هو مكان إقامتك الحالية ورزقك؟ هل هو المجتمع الذي نشأت وترعرعت في كنفه؟ أم هو الدولة التي تحمل جنسيتها حتى لو كنت تعيش مجبرًا في مكان آخر من هذا العالم؟ توجهت بالسؤال عن الوطن إلى أحد تطبيقات «الذكاء الاصطناعي»، فانتظرت طويلًا على غير العادة حتى جاءني هذا الجواب: «الوطن هو المكان الذي يولد فيه الإنسان أو ينتمي إليه، وهو الحيز الجغرافي الذي يحمل تاريخًا وثقافة وقيمًا مشتركة تجمع بين أفراده. الوطن ليس مجرد أرض يعيش عليها الناس، بل هو شعور بالانتماء والهوية المشتركة التي تعبر عن علاقة الإنسان بماضيه ومستقبله». وعندما استعرضت ذلك الجواب الذي يبدو لأول وهلة أنه منطقي جدًّا، لم أجد فيه ما يتسع لأبعاد الوطن الذي نعشقه، أو يصف حقيقته وواقعه الفريد، لقد عجز «الذكاء الاصطناعي» عن أن يقترب من الواقع الذي يعيشه المواطن والمقيم على هذه الأرض. ستجد في هذا العالم المتلاطم الأمواج من يعيش غريبًا وهو في وطنه الأصلي، يحس بالانتماء للأرض والمجتمع وليس للدولة ككيان سياسي، ولا يجد في مواقفها السياسية ما يستحق الفخر أو يعزز الولاء لها حتى لو كان ينعم فيها برغد العيش، وهناك من اضطرته الظروف للعيش خارج وطنه بسبب الظلم والاستبداد، فوجد من يقدر إنسانيته ويراعي شعوره ويكفل حريته، لكنه رغم ذلك يعيش الحنين لوطنه كل يوم ويؤرقه الإحساس بالغربة، فضلًا عن التعرض للممارسات العنصرية أو اضطهاد الأقليات وعدم تقبل الآخر. ولكن، ورغم صغر مساحة قطر إلا أن صدرها يحتضن الجميع، فهنا تعيش أكثر من مائة وثلاثين جنسية مختلفة بأمان ومحبة، هم مغتربون عن أوطانهم ولكنهم لا يعيشون الغربة في قطر، بل يأخذهم الحنين إليها كلما ابتعدوا عنها وكأنهم ولدوا وترعرعوا فيها، فهناك خاصية في المجتمع القطري قد لا تتوفر بنفس القدر في أي مجتمع آخر، وهي القدرة على الاستيعاب والقبول والتعايش السلمي مع الآخر، وقد اتضح ذلك جليًا في الحدث الرياضي الكبير الذي نظمته الدولة في العام 2022م، لقد أبهرنا العالم بسلوكنا وثقافتنا وتفاعلنا الإيجابي مع الجميع دون استثناء. قطر وطن الإنسانية وملاذ المستضعفين وأمان الخائفين وكعبة المضيوم، نتشرف بقيادتها السياسية وبمواقفها المنحازة للإنسانية وللحقوق والحريات رغم التحديات التي تواجهها، كما نتشرف بمؤسساتها التي تعمل على مدار الساعة لتأمين العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، نتشرف برجالها المخلصين الذين ساهموا في تشييد أركانها وحافظوا على نهجها وهويتها، نتشرف بشبابها الذين تحملوا المسؤولية ومضوا على عهد الآباء والأجداد وحافظوا على مكتسبات الوطن... لذلك قطر ليست مجرد وطن.
1002
| 11 ديسمبر 2024
وجد الموظف الجديد أحد الملفات في أدراج مكتبه، يبدو أنه للموظف السابق الذي ترك العمل منذ فترة قصيرة، وقبل أن يرميه في سلة المهملات أراد أن يتأكد بأن محتويات الملف غير مهمة، كان في الملف نسخ من بعض الأوراق والمراسلات المتعلقة باستقالة الموظف السابق، تلك الأوراق أثارت فضول الموظف الجديد فأخذ يتصفحها لعله يجد معلومة مفيدة عن بيئة العمل الجديد وطبيعة العلاقات بين الأفراد. الورقة الأولى كانت نسخة من كتاب الاستقالة جاء فيها: «مديري العزيز... تحية طيبة وبعد، لقد كانت الفترة التي قضيتها معك مليئة بالدروس والمواقف الخصبة بالمعرفة، تلك التجربة الفذة شكلت نقلة نوعية في نمط عملي وطريقة تفكيري، لقد لمست منك النزاهة والحكمة في إدارتك، كنت شفافًا جدًا مع الجميع، وحريصًا جدًا على المصلحة العامة، أنت نعم الرجل المناسب في المكان المناسب، وكما تعلم فإن القاسم المشترك بيننا هو خدمة الوطن وتلبية النداء من أي موقع نجد أنفسنا فيه قادرين على بذل أقصى الجهد والعطاء، ومن هذا المنطلق أتقدم لسعادتكم بطلب استقالتي هذا لأنطلق في فضاء آخر من فضاءات العمل أكتسب معه خبرات جديدة وأنقل معي كل ما تعلمته منك ومن زملائي من مهنية وحرص ومثابرة.... تقبل تحياتي»، وفي الورقة الثانية كان رد المدير على كتاب الاستقالة كما يلي: «أخي العزيز؛ تلقيت ببالغ الأسف طلب استقالتكم من مؤسستنا، لم أكن لأتوقع أن يحدث ذلك يومًا ما، لقد امتلأت مؤسستنا ببصماتك الإبداعية منذ خطواتها الأولى، أعلم بأن مسؤولك المباشر والإخوة في الموارد البشرية لم يألوا جهدًا لثنيك عن هذا القرار ولكن دون جدوى، لقد أبلغت بأنك اتخذت القرار ولا رجعة فيه، ونحن نحترم قرارك لأننا نعرف طريقة تفكيرك، ونعلم جيدًا بأنك درست الخطوة قبل أن تقدم عليها، ولم يتبق لي إلا أن أشكرك على رسالتك الراقية وأتمنى لك التوفيق في عملك الجديد، وأود أن أقول لك بأن الأفكار التي كنت تأتي بها من حين لآخر لتطوير مؤسستنا كانت أبعد من المهمة المطلوبة منك، لقد لمست فيك الشغف بالتطوير والتقدير للمسؤولية، والتعاون مع الزملاء والالتزام بالعمل والحفاظ على السرية، فهنيئًا للمؤسسة التي ستنضم إليها، وإلى لقاء قريب». أغلق الموظف الجديد الملف وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة الرضى على قراره الالتحاق بهذه «المدينة الفاضلة» أعني المؤسسة الفاضلة، وقبل أن يعيد الملف إلى مكانه لاحظ على ظهره تعليقاً بخط اليد كتب فيه: «الغول والعنقاء والخل الوفي... وأشياء أخرى».
2178
| 04 ديسمبر 2024
عندما قدِمَ عديُّ بنُ حاتمٍ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو نصرانيٌّ سمعه يقرأُ هذه الآيةَ: "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ" قال: فقلتُ له: إنَّا لسنا نعبدُهم، قال: أليسَ يحرمونَ ما أحلَّ اللهُ فتحرِّمونَه، ويحلُّونَ ما حرَّمَ اللهُ فتحلُّونَه، قال: قلتُ: بلى، قال: فتلك عبادتُهم. لقد قام النهج الفرعوني على قواعد راسخة في وجدان قومه، أصّل لها أصحاب المصالح والمنتفعون بين الناس كقارون، وتبناها رموزه ووزراؤه كهامان، وروج لها المؤثرون والإعلاميون كسحرة فرعون، فكانوا سدًا منيعًا ضد محاولات الإصلاح، وسيفًا مسلطًا على المصلحين، فكانت أولى تلك القواعد هي: إقناع الناس بأن فرعون ملهَم ولا ينطق عن الهوى فقوله الحق ورؤيته الحق وسبيله صراط مستقيم، قال تعالى: "قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلا سَبِيلَ الرَّشَادِ"، فهو يرى في منهجه الحق والرشد وما خالف نهجه فهو الغي والضلال، ويروج السحرة لهذا الإفك المبين بين أفراد المجتمع. بعد ذلك التمهيد تأتي القاعدة الثانية وهي: أن يُعْبَدْ من دون الله، إما عبادة فعلية مباشرة كعبادة الله، تعالى الله، أو كتلك التي جاءت في الحديث الذي تقدم سرده، قال تعالى: "وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي"، وهذا إستخفاف فج بعقول القوم، لكن العجيب أنهم ولفسقهم المتأصل في تكوينهم أطاعوه فيما أراد "فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ". أما القاعدة الثالثة فهي: حماية الاستبداد بشتى الطرق، ومنها سحق أي مبادرة للإصلاح قال تعالى: "وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه"، ومنها الاستهزاء بدعاة الإصلاح، قال فرعون: "فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ"، ومنها أيضًا التكبر على الحق وعدم الموضوعية ويتجلى ذلك في قوله: "أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ". أما القاعدة الرابعة فهي: إتهام المصلحين بأنهم إنما يريدون تغيير الدين والعبث به قال: "إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ"، تخيّل فرعون يخشى على الدين من موسى عليه السلام، ولكن أي دين؟، ذلك الدين الذي جعل منه إلهًا يعبد من دون الله، الدين الذي يتبع الهوى فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فكانت العاقبة أن أنجى الله المؤمنين المصلحين وأغرق فرعون وجنوده وهم ينظرون "وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا".
2640
| 27 نوفمبر 2024
اجتاح وسائلَ التواصل الاجتماعي مقطعُ فيديو لسعادة السيدة لولوة الخاطر وهي تلقي قصيدة جميلة باللغة العربية الفصحى، قالت عنها إنها من وحي الأحداث في غزة وفلسطين، وقبل أن أتحدث عن تلك القصيدة وعن غزارة معناها وجمال مبناها، أجزم بأن الكثيرين ومنهم محدثكم لم يتوقعوا بأن تلك السيدة التي عرفناها منذ عام 2017م كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية ثم مساعدًا لوزير الخارجية ثم وزيرة دولة للتعاون الدولي قبل أن تصبح مؤخرًا وزيرةً للتربية والتعليم والتعليم العالي قد اجتمعت في شخصيتها الدبلوماسية الرزينة بكل معانيها وأبعادها وهذه الشاعرية المتدفقة. لقد كان واضحًا لكل من يتابع أحداث غزة أن سعادتها كانت من الوجوه الدبلوماسية التي لم تكن لتخفي تفاعلها وتأثرها العميق بما يحدث لإخواننا هناك، بل وجدناها أحيانًا ترافق بعض حملات الإغاثة الإنسانية وتقدم كل الدعم والتشجيع للفرق العاملة على الحدود المصرية الفلسطينية. أما عندما ارتدت سعادتها جبة الشعر جاءت بفريدةٍ من الفرائد فنظمت قصيدة بعنوان «زمان التيه وعصا موسى»، عنوانها ينبئ عن فحواها ومقصدها ومعناها، أما أبياتها فقد تلألأت حروفها وانتظمت بإبداع وإيقاع جميل كعقد صِيغ من لؤلؤ الخليج ليحيط بجيد غزة العزة حتى إن الرائي ليحتار هل يُزيّنها أم تُزَيّنُه. قد لا يتسع المجال لشرح القصيدة التي تماهت في أحداثها ورموزها، ببلاغة ونظم بديع، مع قصة سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل، فعندما قالت «يا سيدي هذي عصاك فألقها» شبهت الشاعرة عصا السنوار التي ألقاها على الطائرة «الدرون» وكشف بها زيف الصهاينة وادعاءاتهم ومن يدور في فلكهم بأنه مختبئ في الأنفاق، شبهتها بذلك الموقف العظيم لسيدنا موسى عندما أمره الله عز وجل بأن يلقي عصاه لتكشف زيف سحرة فرعون وتلقف ما يأفكون. وفي أحد الأبيات تقول: «يا أم موسى لا تخافي ألقه.. فالنصر فرعونٌ يضم ونيل»، وهنا تشبيه جميل لقصة موسى الذي تربى في قصر فرعون ثم وقف ضد طغيانه وجبروته، ترمز الشاعرة إلى قصة السنوار الذي قضى في السجن 23 عامًا اعتقد العدو بأنها كفيلة بأن تنسيه قضيته، وما إن خرج من السجن حتى بدأ نضاله من جديد وقاد المقاومة في المعركة العظمى ضد الصهاينة. وتصف الشاعرة عندما قالت: «ما ضرك الأعداءُ لكن طعنة في الظهر سددها لهم قابيل» تصف الموقف الشائن للبعض ممن يفترض أنهم إخوة في العروبة والدين وكيف أنهم خذلوا إخوانهم في غزة بل أعانوا المعتدي عليهم وشجعوه على إجرامه، وتشبه ذلك الموقف بقتل قابيل لأخيه هابيل. أما الإعلام الساخر من المقاومة، وأولئك المتخاذلون مع المحتل، فقد كانوا يروجون لكل أفاكٍ أثيم وينشرون الأكاذيب لتثبيط الأمة وتركيعها، وقد كان لهم من القصيدة نصيب عندما قالت: «والسامري على المنابر يرتقي... وله تهلل مرجف وذليل». وقبل أن تنهي القصيدة تقول: «لا خضر في الأعراب يرجى أو فتى»، أي لا حكيم في القوم كالخضر يفسر لك ما خفي عنك من الغيب، ولا هناك من يعينك على حاجتك كفتى موسى، لذا تقول له «فاضرب، فأنت النص والتأويل» أي أنت أنت ولا أحد غيرك في الميدان، أنت النص وأنت التأويل. استمعت لتلك القصيدة الرائعة بالأمس وأنا خارج البلاد وأعدت الاستماع لها مرات عديدة على متن الطائرة، ثم قررت أن تكون موضوع مقالي الأسبوعي وفاءً لأهل غزة واحتفاءً بهذه القامة الأدبية فيالها من جبة ولله درك من شاعرة!، وهنيئًا لوزارة التربية والتعليم أن تقودها دبلوماسية شاعرة.
1038
| 20 نوفمبر 2024
خطر على بال الوالي فجأة ان يعلم حماره الكلام، فقرر أن يستدعي جحا لهذه المهمة بعد أن عجز عنها حكماء الولاية، وعندما دخل جحا على الوالي وقدم له التحية قال له الوالي: إذا أعطيتك الآن عشرة آلاف درهم، كم تحتاج من الوقت لتجعل حماري يتكلم؟، أمعن جحا النظر في حمار الوالي وفكر قليلًا ثم قال: سيستغرق تعليم هذا الحمار أربع سنوات ياحضرة الوالي، قال الوالي: خذه معك ولا تأتيني به إلا وهو يتكلم وإلا... قطعت رأسك، قبل جحا بالعرض وخرج يجر خلفه حمار الوالي وعلى ظهره كيس النقود وسط دهشةٍ من الناس، قال له أحد أقربائه هل جننت ياجحا كيف ستعلم الحمار الكلام؟ لقد حكمت على نفسك بالإعدام مقابل عشرة آلاف درهم!، فرد عليه جحا قائلًا: أعلم جيدًا أن الحمار لا يتعلم ولكن المهلة التي أعطاني إياها الوالي كفيلة بأن تغيب أحد الثلاثة، فإما أن تُقبض روحي أو يموت الوالي أو يموت الحمار. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ارتبط رمز الحمار بالحزب الديمقراطي منذ نحو 150 سنة، ويعود الفضل في اختيار رمز «الحمار» للمرشح «أندرو جاكسون» الذي أسس الحزب عام 1828م بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية، أما الفيل فقد بدأ استخدامه كرمز للحزب الجمهوري في أواخر القرن التاسع عشر، ويعود الفضل في ذلك إلى رسام الكاريكاتير «توماس ناست» الذي نشر في عام 1874م رسما كاريكاتوريا في مجلة «هاربرز ويكلي» صور فيه الفيل كممثل للحزب الجمهوري، معبراً عن القوة والصلابة. قد يعيد فوز «الفيل الجمهوري» للذاكرة الكثير من التحديات التي واجهت العالم عمومًا والمنطقة خصوصًا، وقد يحمل فوزه أخبارًا سارة لبعض الأطراف في المنطقة وعلى رأسها «الكيان الصهيوني» الذي احتفى بهذا الفوز حيث علق «النتن ياهو» على فوز ترامب قائلًا: «إنها أعظم عودة في التاريخ»، ومن المعلوم لدى الجميع أن الأربع سنوات القادمة، وهي فترة الحكم الثانية لترامب ، ستكون الفرصة الأخيرة له ليخلد اسمه في التاريخ الأمريكي ويضع بصمته في العالم عمومًا والشرق الأوسط خصوصًا. وفضلًا عن التسارع المتوقع في وتيرة التطبيع لإنجاز مايسمى بـ «صفقة القرن»، فإن على الأطراف المخلصة في المنطقة العمل على إبطاء وتيرة الأجندات المشبوهة والتي لا تعمل لصالح قضايا الأمة المصيرية لا بالمواجهة المباشرة، ولا بالتورط في خصومات حادة، ولكن باحتواء التحديات وكسب الوقت على طريقة إستراتيجية جحا مع حمار الوالي حتى تنقضي الفترة الرئاسية بأقل الأضرار، (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا).
780
| 13 نوفمبر 2024
عندما سقطت تفاحة على رأس إسحق نيوتن، كما هو مشهور عنه، نظر إلى ذلك الحدث على أنه ظاهرة جديرة بالدراسة، وليس مشكلة تريد حلاً، والفرق بين النظرتين شاسع والنتائج كذلك، تخيل لو أن إسحق نيوتن نظر لسقوط التفاح كمشكلة تؤرق المزارعين، وتؤدي إلى خسارة نسبة كبيرة من المحصول، ثم بدأ بالتفكير في الحلول الممكنة لتلك المشكلة لَوَصَلَ إلى منطقة مختلفة تماماً عن تلك التي وصل إليها عندما اكتشف الجاذبية الأرضية، السر في بداية التعاطي مع الحدث.. إنها منهجية التفكير التي صنعت الفرق. فإذا كانت عملية التفكير تهدف إلى اختيار المسار الأنسب للتمكن من تحقيق أفضل النتائج، فإن منهجية التفكير تتعلق باختيار الوجهة في المقام الأول، أي قبل أن نخطو خطوة إلى الأمام، ونبدأ في عملية التفكير، ونستغرق في تفاصيل الحلول الممكنة لما نواجه من تحدٍّ، فإننا بحاجة لأن نخطو خطوة إلى الخلف، لنتأكد من عدم وجود مفترق طرق خلفنا قد قمنا بتجاوزه دون أن نلحظه، وذلك أنه عند مفترق الطرق سنكتشف أننا أمام حزمة أخرى من الخيارات التي قد تكون مختلفة تماماً عن تلك التي تتراءى أمام أعيننا عند مواجهة تحدٍّ ما، لذلك نحن بحاجة لنتأمل ما يصادفنا من تحديات للوصول إلى فهم أعمق، قبل أن ننشغل بإيجاد الحلول، من هنا نجد أن منهجية التفكير أقرب إلى الحكمة منها إلى الذكاء. يقول أحدهم: «عندما كنت أعمل مديراً في إحدى المؤسسات، تقدم للعمل أحد المختصين في «ضبط الجودة»، وكانت سنوات خبرته أقل من متطلبات الوظيفة المعلن عنها، فأرسلت سيرته الذاتية إلى رؤساء الأقسام للإفادة وإبداء الرأي، جاءت الردود من الجميع بالرفض، ما عدا أحدهم، فقد قدم مقترحاً غير متوقع لتوظيف ذلك المرشح، وهنا تتضح أهمية منهجية التفكير، فالذين رفضوا توظيفه كان السبب لديهم واضحا ووجيها وهو نقص سنوات الخبرة المنصوص عليها في الوصف الوظيفي، أما رئيس القسم الوحيد الذي وافق على تعيينه فقد نظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، لقد اتخذ خطوة إلى الوراء إلى حيث الموظفين الأقل درجة، واعتبر أن المرشح من فئة المتدربين، لكنه يتفوق عليهم بسنوات الخبرة، فقدم له عرضاً للعمل كمتدرب، وأعد له برنامجاً محدداً يؤهله بعد مدة قصيرة للقيام بمهام الوظيفة الشاغرة». وهنا نسأل القارئ.. لو كنت مديراً لمدرسة إعدادية، وأخبرك أحد المدرسين بأنه لاحظ أحد الطلاب يرتكب مخالفة ما، ولتكن تدخين السجائر مثلاً، فكيف ستكون ردة فعلك؟، هل ستنفعل وتبدي غضبك الشديد من الطالب، وتطلب من ولي أمره الحضور؟ إذا أظهرت غضبك الشديد، وبدأت بالصراخ على الطالب، ثم طلبت منه أن لا يأتي في الغد إلا بصحبة ولي أمره، ستكون قد تصرفت كما يتصرف أكثر من 90 % من المديرين في هذا الموقف، وتكون قد اخترت منهجك في التفكير، قبل أن تقوم بما يلزم، لقد نظرت إلى ذلك الحدث على أنه مشكلة، واخترت أن تحلها عبر التصعيد والتخويف، ولكن ماذا لو تكرر ذلك مع طالب آخر وآخر وآخر، لتكتشف في نهاية اليوم أنك أنهكت نفسك بالصراخ والغضب، ولم تنتبه إلى أن ما يحدث عبارة عن ظاهرة تريد حلاً جذرياً لا مشكلة فردية معزولة. قد يكون من الأفضل أن تقوم بتقصي الحدث قبل أن تتخذ أي إجراء لتكتشف أنه ظاهرة، وليس مشكلة، ومن ثم تبدأ وبمشاركة بعض عناصر الطاقم الإداري في طرح الحلول المناسبة، واختيار أفضلها، أليس ذلك ما يصنع الفرق؟، لذا... تأمل قبل أن تفكر.
804
| 06 نوفمبر 2024
يقول جبران خليل جبران في إحدى فلسفاته: «في طريقي إلى المدينة المقدَّسة صادفت حاجًّا، فسألته: أهذه هي الطريق إلى المدينة المقدَّسة؟ فأجابني: اتْبعني تصلْ إلى المدينة المقدَّسة بيوم وليلة، فتبعتُه وسرنا أيَّاماً ولياليَ ولم نبلُغ المدينة المقدَّسة!، وأدهشني غضبه مني حين أدرك أنَّه أتاهني»، ولا عجب أن تجد ذلك في الطريق إلى الحق، ستعجب من الحجاج الذين يسلكون الطريق الخطأ ويحسبون أنهم مهتدون، ثم ينصحون الناس باتباعهم اتباعًا أعمى حتى إذا أضلوا مريديهم وأتباعهم وانكشف ستر جهلهم أو نفاقهم ألقوا باللائمة على الضحية وتنصلوا من مسؤولياتهم. إن فساد البيئة المحيطة بالمدينة المقدسة هي أكبر عائق للوصول إليها، وقد اتخذ العدو المتحصن فيها من ذلك الفساد والتيه والتشرذم الذي نعيشه درعًا يُخَذّل كل من أراد الوصول إليها وتحريرها من المعتدي، لقد نسج العنكبوت اللعين خيوطه حول منافذها مستعينًا بأحفاد «أبو رغال» وهم كثر، ولا غَرْوَ فجدهم هو أول من يخون قومه مقابل أجر معلوم ولمصلحته الشخصية فهو الدليل العربي لجيش أبرهة، فما كان الأحباش يعرفون مكان الكعبة أصلًا. لسنا بحاجة لأن نواجه الظلام بالرمح والسيف، كل ما علينا فعله هو إشعال شمعة صغيرة وهي كفيلة بأن تبطل مفعول الليل البهيم الذي خيّم على المؤمنين، علينا أن نصلح ما أفسده العدو في مجتمعاتنا، وما بثه وتبثه قنواتنا من فرقة بيننا، وما أشعله ونشعله من فتن عرقية وطائفية وأحقاد وكراهية تعرفها السياسة وينكرها الدين. سيسقط العدو بلا مواجهة، بمجرد أن نطهر البيئة المحيطة بالمدينة المقدسة من الأضغان والأحقاد والمزايدات، ونكنس الأنانية والنفاق والعمالة، بمجرد أن نتحد على كلمة سواء، ونقاطع المغتصب ونحاصره بكل الوسائل سيذبل ويموت دون أن نطلق رصاصة واحدة، نحن بحاجة لقادة يأخذون على عاتقهم توحيد الأمة لا مواجهة العدو، بحاجة لقادة على استعداد لقليل من التضحية من أجل نهضة الأمة من عثرتها، قادة يطمحون أن يخلدهم التاريخ وتتباهى بذكرهم الأجيال، قادة يصنعون الفرق، ويعبرون بنا القنطرة إلى مصاف الدول الفاعلة في المجتمع الإنساني، فالمصير مشترك والعدو واحد، وللأمة موعد مع النصر آتٍ لا محالة.
675
| 30 أكتوبر 2024
لقد أعجز التفكُر في مَكْنُونْ العَقْل كل من أراد إلى ذلك سبيلاً، فلم يُحِط أحدٌ بِكُنْهِهِ ولا بِمُنْتَهَى قدرته، وقد سار في ذلك المضمار نفرٌ من المتكلمين والفلاسفة، حتى بلغ الحديث عنه والتنظير له مبلغاً كاد أن يُعْجَبْ به مَنْ صاغه، وينتشي له من ابتدعه، حتى وجد نفسه لم يبرح واقفاً على شاطئه يغمس مروده في وشَلِ مُحِيطِه لا يَلوي على شيء من عِلمه، بل الْتَبَسَ على بعضهم كُنْهَهُ ومَكَانَ انْعِقَادِه، فمنهم من نسبه للمادة الموجودة في تجويف الرأس، ومنهم من ادعى أنه في مكان ما خارجه. لا شك أن العقل وإن كان صغيراً في جُرْمِه فهو عجيبٌ في أمره، وأعجب ما يكون في قدرته على التعلم والتدبر والاستنباط واسترجاع الحوادث بصورها وشخوصها وأحاديثها، فضلاً عن تخيل ما لم يحدث، فسبحان الخالق المصور، والفكرُ ثَمَرَةُ العقل وهو يتقلب في ثلاثةِ أحوال، أشرفها وأنفعها للمرء في حالهِ ومآلهِ، هو الانشغال بالتفكر والتدبر، ومنها حال التفكر في الكائنات والجمادات، تفكراً يورث حكمةً وعلماً، ويوصل إلى العبقرية والإبداع، (إنِّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضِ وَاخْتلِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياَتٍ لِأوُلِي الْألَباَبِ). وأوسط أحوال الفكر هو الانشغال بالأخبار على أنواعها وأهميتها، وذلك الغالب في مجالس الناس ولا بأس في ذلك، بل إن بعض تلك الأخبار مرتبط بمعايش الناس، والعلم به خير من الجهل إذا ما قدر بقدره وأخذ من مصادره، وقد كثرت في زماننا وسائله، وغلب غَثَهُ سمينه حتى لم يعد يعرف صحيحه من كذبه، وأصبح مضيعةً للأوقات والطاقات، فضلًا عن إشاعة ما لم يصحْ من الأنباء التي تنتشر انتشار النار في الهشيم بلا حدود ولا قيود، حتى لتجد التافه من الناس يتحدث في الشأن العام ويقتفي ما ليس له به علم. وأدناها وهي الحال الثالثة للفكر، هو الانشغال بالأغيار، والمقصود به الانشغال بالآخرين، حيث لا يجاوز الفكر خاصة الناس، وذلك قد يفضي إلى الغيبة والنميمة التي تورث الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، وفي ذلك فساد الدين والدنيا، فضلاً عن غضب الله سبحانه وتعالى، فلا ينشغل بالناس إلا جاهل بنفسه وحكمة وجوده، خلا جِرابَهُ من العلم وتكاسل عن العمل فَسَيّر فضول وقته فيما لا ينفع. وبذلك نخلص إلى أن أصحاب الفكر هم خلفاء الله في الأرض، وأقدر على عمارتها، يصنعون الحدث ويساهمون في نهضة البشرية وتطورها وينشرون العلم والحكمة، فهم على قلة عددهم مؤثرون في مسيرة الأمم، فلا يخلو من ذكرهم ديوانُ تاريخٍ مضى، ولا كتابُ حاضرٍ نعيشه، ولا صفحاتُ مستقبلٍ نؤمله ونستشرفه، فإن وجدت أمة متخلفة عن باقي الأمم فاعلم أنها لا تقيم لمفكريها وزناً.
726
| 23 أكتوبر 2024
مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة...
1737
| 24 ديسمبر 2025

في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن، الثامن...
1119
| 22 ديسمبر 2025

«فنّ التّأريخ فنّ عزيز المذهب جمّ الفوائد شريف...
690
| 21 ديسمبر 2025

-قطر نظمت فأبدعت.. واستضافت فأبهرت - «كأس العرب»...
663
| 25 ديسمبر 2025

يُعد استشعار التقصير نقطة التحول الكبرى في حياة...
660
| 19 ديسمبر 2025

لماذا تقاعست دول عربية وإسلامية عن إنجاز مثل...
639
| 24 ديسمبر 2025

أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة...
609
| 24 ديسمبر 2025

هنالك قادة ورموز عاشوا على الأرض لا يُمكن...
597
| 19 ديسمبر 2025

-قطر تضيء شعلة اللغة العربيةلتنير مستقبل الأجيال -معجم...
588
| 23 ديسمبر 2025

انتهت الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني بحفل عسكري رمزي...
540
| 23 ديسمبر 2025

في عالم اليوم، يعد التحول الرقمي أحد المحاور...
492
| 23 ديسمبر 2025

لُغَتي وما لُغَتي يُسائلُني الذي لاكَ اللسانَ الأعجميَّ...
435
| 24 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية

حمل تطبيق الشرق
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل