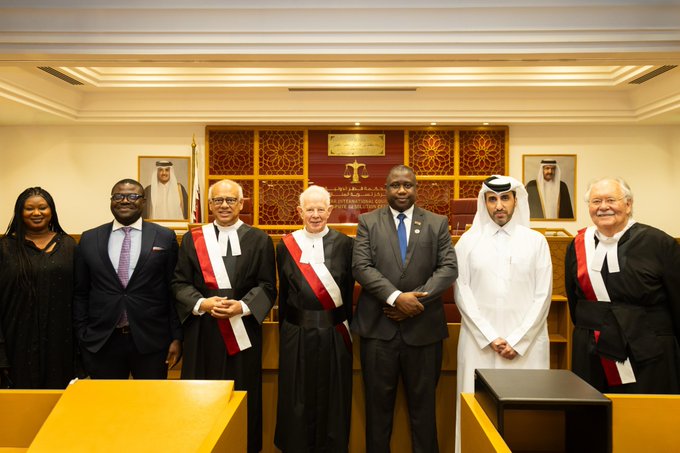رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
وصفت قمة ألاسكا التي جمعت بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين قبيل انعقادها بـ «القمة التاريخية» التي ستنهي الحرب الأوكرانية المعقدة الدائرة منذ أكثر من عامين. بيد أن نتائجها كانت مخيبة صادمة للعالم قبل أوكرانيا وأوروبا أكبر الخاسرين منها. وصفت بالتاريخية، وارتفع سقف التكهنات بإنهائها للحرب، ليس لأنها فقط قد جمعت الزعيمين في قمة استثنائية لأول مرة منذ عودة ترامب للبيت الأبيض، وبعد قطيعة تامة مع روسيا منذ الحرب، أسوة بالقمم التاريخية التي تمخض عنها ترتيبات دولية جذرية جديدة مثل مؤتمر يالطا 1945؛ بل أيضا لأن الزعيمين قد ذهبا إلى القمة للاتفاق على إنهائها من حيث المبدأ، والتفاوض على بعض النقاط الخلافية في سياق الإنهاء. بعبارة أكثر وضوحاً، ذهب ترامب للقمة بعد الاتفاق مع الأوروبيين وأوكرانيا على إلزام روسيا بوقف إطلاق النار كشرط أساسي، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد التفاوض النهائي على صفقة لإنهاء الحرب. وصف الزعيمان القمة في المؤتمر الصحفي الذى انعقد بعدها بالناجحة، الممهدة لمزيد من التواصل والحوار لإنهاء الحرب. لكن كلمة الزعيمين التي عُدت مخرجات القمة التي لم يصدر عنها مقررات أو مخرجات واضحة رغم وصفها بالتاريخية!!، قد خلت تماما من أية إشارة لوقف إطلاق النار وهو ما كان صادما ومخالفا لجميع التوقعات، فالاتفاق على وقف إطلاق النار كان بديهياً لقمة تاريخية لإنهاء الحرب، وليس لهدنة والتي لم تتحقق حتى بعد القمة حيث سرعان ما تم استئناف القتال بين روسيا وأوكرانيا. عجت الصحف العربية والغربية بعناوين تشير بوضوح بانتصار بوتين في القمة، أو باعتباره الفائز الأكبر أو الوحيد من القمة. فالقمة قد فكت العزلة عن بوتين وروسيا، وأرجأت فرض مزيد من العقوبات الأمريكية عليه، لكن ما هو أخطر من ذلك، قد منح تعهداً صريحا من ترامب بالسيادة المطلقة على القرم أو عدم المطالبة بها، وعدم انضمام أوكرانيا للناتو. فضلا على عدم مطالبته أو فشل إقناعه بوقف إطلاق النار، وهو ما يعنى إصرار بوتين على عدم التنازل عن المقاطعات الأربع التي احتلها في أوكرانيا، أو على أقل تقدير شرق أوكرانيا ومنطقة الدونباس وفقا لتسريبات أوروبية. يعنى اختصاراً يريد بوتين تسوية نهائية وفقا لشروطه الخاصة، تتضمن أيضا نصف المعادن النادرة لأوكرانيا، وعدم مطالبته بتعويضات عن الحرب، وحكومة جديدة في أوكرانيا...وغيرها. في تقديرنا، إن أخطر ما تمخض عن القمة، هو اتساع الهوة بين أوروبا وأمريكا، إذ على أقل تقدير تعد تعهدات ترامب لبوتين بعدم انضمام أوكرانيا للناتو، والاعتراف بسيادة موسكو على القرم؛ أمرا عاكساً للرؤية الأمريكية العامة لإنهاء الحرب، وليس بترامب شخصياً، أو أقصى ما يمكن أن تفعله واشنطن لهذه الحرب التي لا تعنيها كثيرا بقدر ما يعنيها الصين والخلافات الشائكة معها خاصة تايوان. وهذا صادم لأوروبا لأنه يعنى تخلي أمريكي ضمني بأمن أوروبا، والتي تصر على ضم أوكرانيا للحلف أو عدم إرجاء الضم بصورة نهائية، وتوفير ضمانات أمنية أمريكية حقيقية لأوكرانيا، وانسحاب روسيا من كامل أوكرانيا بما في ذلك القرم. ولهذا السبب، رافق أكبر قادة أوروبا بقيادة ستارمر رئيس وزراء بريطانيا زيلنسكى في زيارته للبيت الأبيض التي لم تثمر أي شيء، ليس فقط خوفا من تكرار مهزلة اللقاء الأول، بل أيضا خشية من ضغط ترامب عليه للقبول بتنازلات تمس الأمن الأوروبي، إذ تعد أوروبا روسيا بعد الحرب بمثابة تهديد وجودي لها، وعلى يقين أن طموحات بوتين لا تتوقف عند أوكرانيا فقط. في التقدير الأخير، تعد قمة ألاسكا كاشفة تماما لإصرار بوتين على إنهاء الحرب وفقا لشروطه، أي عدم تقديم تنازلات جوهرية، وموقف أمريكي عاجز ومتردد على إنهاء الحرب، بل يريد بدلا من ذلك إنهاءها بما يضمن مكاسب أمريكية بعيدة عن أوكرانيا، وموقف أوروبي عاجز أيضا على إنهاء الحرب دون الولايات المتحدة، لكنها تفسح الطريق أمام مزيد من التوحد والعسكرة الأوروبية للاعتماد على نفسها للتصدي لروسيا. وفى النهاية، فجولات الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن تنتهى في القريب العاجل، بل ستزداد عنفاً.
336
| 26 أغسطس 2025
للمرة الأولى منذ تأسيس حزب الله في ثمانينيات القرن المنصرم، يواجه الحزب إجماعا دوليا وإقليميا وداخليا على نزع سلاحه. ومآرب الأطراف المختلفة حتى الساعية ضمنيا لنزع سلاحه أو لم تعبر علانية، معروفة ومفهومة. وعلى الصعيد الداخلي اللبناني، وبعيداً عن توازنات القوة الداخلية والصراعات والأحقاد الكامنة، فقط ارتأت القيادة اللبنانية الجديدة بقيادة الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام التي أصدرت في الخامس من أغسطس قراراً يعد تاريخياً يقضي بحصر سلاح الحزب بيد الدولة وتحديد جدول زمنى للتسليم؛ باعتبار أن استمرار السلاح بيد الحزب يقوض من سيادة لبنان وقراره السياسي، ويعمق من عزلته، ومبرر لاستمرار الوجود الإسرائيلي في بعض المناطق في الجنوب، وتدخل أطراف خارجية في لبنان خاصة إيران. إذن فالسؤال الأجدى بالإجابة عنه هو هل سيسلم حزب الله سلاحه بسهولة؟ على الرغم من الحملة القوية غير المسبوقة التي يواجهها الحزب لاسيما وأنه في أضعف حالاته على الإطلاق منذ تأسيسه، يبدو أن الحزب عازم بقوة على عدم تسليم سلاحه، ومستعد لتكلفة ذلك. وقد تبدى ذلك تماما خلال الأيام القليلة الماضية بزيارة علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للبنان حيث التقى بقيادات لبنان لتسليم رسالة محددة من طهران مفادها رفضها القاطع لنزع السلاح. وأيضا خطاب السيد نعيم قاسم الأخير الأمين العام للحزب، الذي رفض رفضا قاطعا تسليم السلاح للحكومة اللبنانية، وأن الحزب لا يزال في حالة مقاومة ضد إسرائيل، ومستعد بحسب وصفه إلى خوض معركة «كربلاء مهما كانت التكلفة»، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية أية فتنة واسعة داخل لبنان، ملمحا أيضا بأنها تنفذ مشروعا أو إرادة أمريكية-إسرائيلية. وقد تم تفسير تحذيرات قاسم خاصة من جانب الحكومة اللبنانية على أنها تهديد صريح بإغراق لبنان في حرب أهلية جديدة. وهو في تقديرنا التحدي الأخطر والأصعب الذى يواجه نزع السلاح، وهذا بدوره يطرح سؤالا حاسما، لماذا يصر الحزب على عدم تسليم سلاحه إلى حد الاستعداد للدفع بلبنان المنهك إلى الحرب الأهلية؟ ولعل الأعجب من ذلك أن الحزب كمقاومة ضد إسرائيل تقريبا شبه انتهى أو على الأقل لا يقوى على المواجهة على المدى المتوسط، بعدما تلقى خسائر فادحة وأعلن استلامه ضمنيا بالتوقيع على اتفاق الهدنة مع إسرائيل في نوفمبر الماضي. الحزب لا يملك قراره واقعياً، ويتسلح بسلاح وحيد قابل للتحقيق بين ليلة وضحاها هو إشعال حرب أهلية في لبنان قد تقضي على اليابس والأخضر ولا تعرف مدى زمنيا للتوقف. والحقيقة أن حزب الله لا يزال الطرف الأقوى في لبنان، ليس فقط بسبب امتلاكه للسلاح، ومنه سلاح ثقيل، والمقاتلين ذوي الخبرة الطويلة، بل في حاضنته الشعبية التي تمثل قرابة 30% من اللبنانيين، يعتبرون الحزب القوة الرئيسية التي تمثلهم وتحميهم من التهميش، ومنحهم قوة نسبية امام باقي الفصائل اللبنانية. وعلى إثر ما سبق، يمكن القول إن معركة نزع سلاح الحزب ليست بالسهلة، فقد تمضي للأسف إلى حرب أهلية، أو فتح إسرائيل جبهة قتال جديدة عنيفة ضد الجنوب، أو تفاهمات معقدة تؤدي إلى تقليص قدرات الحزب العسكرية مقابل تسوية، وجميع تلك السيناريوهات واردة ولا يمكن ترجيح أحدها على الآخر.
660
| 18 أغسطس 2025
في الثامن من أغسطس 2025 وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بشكل نهائي على خطة احتلال غزة، وسط انقسامات واعتراضات غير مسبوقة حتى داخل إسرائيل حيث اعترض عليها رئيس الأركان الإسرائيلي، وجميع أحزاب المعارضة في إسرائيل، وخارجيا واجهت الخطة اعتراض الجميع عدا الولايات المتحدة، إذ اعترضت أكثر من ثماني دول أوروبية بينهم إنجلترا علانية على الخطة. وأهداف وتفاصيل الخطة بحسب الرواية الرسمية الإسرائيلية، تتضمن القضاء على حماس ونزع سلاحها، وتحرير الرهائن، وتسليم حكم غزة لإدارة مدنية جديدة لا تتبع حماس أو فتح، وستستغرق الخطة نحو عامين سيتم فيه استدعاء قرابة 250 الفا من الاحتياط، وتعمل على مراحل تشمل احتلال المناطق الخالية من الوجود الإسرائيلي مثل مدينة غزة ودير البلح، مع ترحيل المدنيين نحو الجنوب وتوفير مراكز للمساعدات الإنسانية، انتهاءً باحتلال القطاع بالكامل. تواجه الخطة اعتراضات من مناحٍ متعددة، وعند تفحص كل أوجه اعتراض على حدة نجد أن الخطة في مجملها شديدة الكارثية، بل إن واحدا فقط من تلك الاعتراضات أو التداعيات وهو مثلا الحجم الهائل من عدد القتلى المدنيين في غزة المرتقب نتيجة الاحتلال بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كفيل وحده بجعلها خطة تفوق حد الجنون. لكن الملفت هنا هو اعتراضات الداخل الإسرائيلي التي تجمع على أن الخطة ستؤدى إلى انهاك للجيش الإسرائيلي المنهك بالأساس نتيجة سنتين من الحروب المستمرة على جبهات متعددة منذ طوفان الأقصى، كذلك الإنهاك الشديد للاقتصاد الإسرائيلي المنهك كذلك، فضلا عن عدد كبير من الضحايا في صفوف الجيش الإسرائيلي حيث سيخوض حرب عصابات صعبة مع حماس، إذ وصف عدد كبير من الخبراء العسكريين اليهود الخطة بـ «الفخ». يضاف إلى ذلك، تحذير عدد كبير من الخبراء من قتلى الرهائن نتيجة لتداعيات الحرب المتعددة، وتشويه سمعة إسرائيل الدولية وزيادة العزلة الدولية لها، وضعف المواجهة الإسرائيلية على جبهات أخرى أكثر أهمية في الوقت الراهن خاصة الجبهة الإيرانية التي لم تحسم بعد. والواقع أن هذه الاعتراضات تخفى وراءها حقيقة نادرا ما يعلن عنها بشكل صريح، وهى أن إسرائيل قادرة على تحقيق هذه الأهداف المعلنة دون خطة احتلال كاملة، أي غير مبررة على الإطلاق ولا تستدعى احتلال كامل. إذ من المفارقة في هذا الصدد، أن يجهر عدد من الخبراء والسياسيين في إسرائيل أن حكومة نتنياهو لا تعنيها الرهائن على الإطلاق منذ الطوفان وليس الآن، علاوة على ذلك، من الممكن إضعاف حماس بصورة أكبر عبر تكثيف الضربات والاغتيالات في أماكن تواجدها، كما أنها لم تعد تشكل تهديدا خطيراً لأمن إسرائيل بعد ما تعرضت لها من إنهاك وإضعاف على مدار عامين، وهذه حقيقة. فرض الترحيل كأمر واقع تشي الاعتراضات المتعددة على خطة الاحتلال خاصة الإسرائيلية أن الخطة لها مآرب أخرى غير معلنة، إذ أن مسوغات إسرائيل المعلنة من الخطة غير مقنعة تماما حتى للداخل الإسرائيلي، وتعلم حكومة نتنياهو ذلك أيضا. خطة ترحيل الغزاويين أو إخلاء قطاع غزة، خطة قديمة، ومع حالة التهديد الوجودي التي شعر بها الكيان بقوة منذ طوفان الأقصى، ارتأى الكيان أن الوقت قد حان لتنفيذها -رغم صعوبتها الشديدة- ولا بد من تنفيذها باي شكل كان ومهما كانت التكلفة. وبعد فشل جميع المحاولات القوية خاصة منذ مجيء إدارة ترامب، إذ تم عرض التهجير علانية على مصر والأردن التي رفضتا بشكل قاطع هذا المخطط الشيطاني. تأتى خطة احتلال غزة كمسعى لفرضه كأمر واقع، فخطة احتلال غزة-وفقا للخبراء- التي ستدوم أكثر من سنتين على الأرجح؛ ستجهز على ما تبقى من بنية تحتية محدودة في القطاع تماماً، كما سيسقط فيها مئات الآلاف بين شهداء وجرحى نتيجة للمعارك العسكرية، وصعوبة الحصول على المساعدات الغذائية والإنسانية عن عمد أو غير عمد، باختصار ستحول الخطة غزة إلى واحدة قاحلة غير قابلة للحياة وتحتاج عقودا ومليارات الدولارات للعودة للحياة مجدداً. وهذا-وفقا لتصور حكومة نتنياهو- سيفرض ضغوطا شديدة على المجتمع الدولي والدول المعارضة للترحيل خاصة مصر، للموافقة على استقبال الغزاويين بأعداد كبيرة لحمايتهم من إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ الحديث. إسرائيل ماضية في خطتها بقيادة اليمين المتطرف ونتنياهو الذى يرى في الخطة فرصة سانحة للبقاء أطول فترة ممكنة للهروب من الملاحقات القضائية التي تنتظره. لكن بخلاف تداعياتها الكارثية على الغزاويين؛ فلها تداعيات كارثية على إسرائيل نفسها، إذ من المرجح أن تدفع الخطة إسرائيل لصدام عنيف مع مصر تحديداً سيفضى إلى توتر رهيب في المنطقة كلها، كما ستواجه إسرائيل بعزلة وتشويه دولي غير مسبوق، وربما ستكون خطة الاحتلال مدخلا لفتح جبهات قتال أخرى على إسرائيل، أو تجدد بعضها.
633
| 14 أغسطس 2025
مؤخرا أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين في خطابه بالأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ثم لاحقه رئيس الوزراء البريطاني الذى أعلن عن نية بريطانيا الاعتراف بفلسطين، ثم جاء بعده موقف كندا التي أكدت إمكانية الاعتراف بفلسطين. وفي العامين السابقين اعترفت عدة دول أوروبية رسميا بدولة فلسطين من أبرزها إسبانيا والنرويج وإيرلندا. وتباينت التعليقات حول خطوة فرنسا وبريطانيا لما لهما من مكانة أوروبية ودولية كبيرة، إذ رأى جانب وهو الأوسع أن خطوة الاعتراف-التي لا تزال مجرد إقرارات مبدئية أو شبه تأكيدات يمكن النكوص عنها- لا تعدو كونها خطوة رمزية حال تنفيذها. بينما يرى جانب آخر أن الخطوة شديدة الأهمية وتعكس تحولا جذريا في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية. وينطلق الجانب الذى يرى رمزية الخطوة من عدة منطلقات واقعية من أهمها، أن اعتراف الدولتين بل أوروبا كلها بدولة فلسطين لن يغير من الأمر شيئاً في شأن القضية الفلسطينية خاصة حل الدولتين وردع حرب الإبادة ومخطط التهجير للكيان الصهيوني، لأن زمام الأمر كله في يد الولايات المتحدة، فهي الوحيدة القادرة على تحديد مستوى فعل وطموح للكيان داخل فلسطين. علاوة على ذلك، وهو تأكيدا على ما سبق، أن قرابة 70% من دول العالم تعترف بفلسطين وعلى رأسها روسيا والصين، ولن يؤدى ذلك إلى حلحلة القضية، بل يزداد الكيان توحشا وثقة يوما بعد يوم. يعد توقع حدوث تحول أو حل سريع جذري خاصة في سياق التعاطي مع القضية الفلسطينية-المصنفة كأعقد قضية في التاريخ- أمرا لا يستقيم في السياسة الدولية. إذ بطبيعة الحال، من غير المتوقع أو المرجح مطلقا أن يؤدى الاعتراف الأوروبي ولو برمته بقيادة دوله الكبرى (فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، إيطاليا) إلى حل القضية الفلسطينية بين ليلة وضحاها، بل زد على ذلك، أن أوروبا لوحدها ليس بمقدورها حل القضية، فهي عامل حاسم بالقطع لكن في إطار تكاتف دولي يضم الولايات المتحدة والقوى الكبرى والصاعدة والمؤثرة. هل معنى ذلك أن الاعتراف الأوروبي مجرد خطوة رمزية؟!، بالقطع لا. عندما تقوم دولتان كبريان عضوان في مجلس الأمن، كانتا من أكبر الداعمين المطلقين لإسرائيل، خاصة إنجلترا، بالاعتراف بدولة فلسطين في سياق موجة عالمية بالاعتراف بدولة فلسطين، إذ من المرجح أن تنضم لهما على الأقل أوروبيا كل من هولندا، ومالطا، وكرواتيا، خلال عام؛ فهذا يعنى أن مساحة العزلة الدولية لإسرائيل بدأت في التوسع، مما يعنى مزيدا من الضغط على إسرائيل وأكبر داعميها. إذ أن الاعتراف سيعقبه بالضرورة خطوات أخرى ربما بصورة متدرجة للضغط المستمر على إسرائيل، كتحجيم العلاقات التجارية أو منع تصدير بعض الأسلحة، ولدينا أمثلة أوروبية حية حاليا، إذ أعلنت هولندا مؤخراً منع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها على خلفية الدعوة للتطهير العرقي في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة، وفى العام الماضي علقت ألمانيا في مفارقة لافتة-التي ستكون آخر دولة تعترف بفلسطين، وربما لا تعترف نهائيا-تصدير أية أسلحة لإسرائيل على خلفية حملة الإبادة في غزة. الاعتراف الفرنسي الإنجليزي والأوروبي عامة قد جاء على خلفيتين، الأولى وهى الظاهرية أو غير الحاسمة وهى استمرار حملة الإبادة في غزة التي طورتها إسرائيل بحملة تجويع ممنهجة ومنع دخول المساعدات للقطاع. والثانية الحاسمة، نوايا إسرائيل الواضحة بالهيمنة التامة على الضفة، أي الإجهاز على القضية الفلسطينية كلها، وهو ما تجسد في تصويت الكنيست على قرار-غير ملزم- بضم الضفة ورفض أية خطط لإقامة دولة فلسطينية. وبالنسبة لأوروبا عامة يعد ذلك غير مقبول على الإطلاق، لاعتبارات تاريخية وقانونية، وأخلاقية ناجمة عن ضغوط داخلية، ومصلحية أيضا، إذ تدرك أوروبا كم الفوضى التي ستحل بالمنطقة حال استمرت الحكومة اليمينية الإسرائيلية في مشاريعها الجنونية. ومن هنا، نذهب إلى أهم جانب على الإطلاق من وراء الاعتراف بفلسطين، هو إيقاف نزيف التدهور للقضية، والضغط الشديد على إسرائيل وفلسطين أيضا نحو حل الدولتين. ونجزم أن الاعتراف الأوروبي سيكون عامل ضغط حاسم في إطار ذلك، فهو غير رمزي عندما تتقدمه فرنسا وإنجلترا، وعاكس في الوقت نفسه لسياق دولى جديد تبرز أهم معالمه في رأى عام أوروبي وعالمي أيضا بات أكثر نفورا من إسرائيل، وضاغط بقوة على الحكومات المنحازة لها، وانفصال أوروبي تدريجي عن الولايات المتحدة، أو استقلالية أوروبية ناشئة.
567
| 04 أغسطس 2025
أمست الشراكة الاستراتيجية الوطيدة بين تل أبيب وآسيا الوسطى نموذجاً فريدا أو خاصا أو نادراً أو «غريباً»، للشراكات الاستراتيجية في العلاقات الدولية. إذ أصبحت بعض دول آسيا الوسطى أهم أو أقرب حليف في العالم الإسلامي برمته لتل أبيب، بل رغم تعدد مجالات الشراكة بين الجانبين؛ فقد أصبح مواجهة إيران محور الشراكة الرئيس من الآن وصاعداً. يتنازع في العلاقات الدولية اتجاهان رئيسيان حول تفسير نمط العلاقات في النظام الدولي، الأول التفسيري أو الوضعي في مقدمته المنظور الواقعي، والذى يرتأي أن المصلحة هي المحدد الرئيس للعلاقات. والثاني ما بعد الوضعي وفى مقدمته المنظور البنائي، لا يغفل محدد المصلحة، لكنه يرتأي أن المحددات غير المادية كالهوية والإيديولوجيا حاسمة في تشكيل العلاقات بين الدول. إذ على سبيل المثال، يرى أنصار هذا التيار أن صراع الحرب الباردة المستعر حاليا بين بكين وواشنطن مكمنه الرئيس الاختلاف الإيديولوجي، ومن قبله الحرب الباردة بين واشنطن والاتحاد السوفيتي، والصراع بين إسرائيل وإيران، وروسيا والغرب عموما. والدراسة المتأنية لتلك الأمثلة تظهر صحة هذا المنظور بصورة كبيرة، إذ بالقياس أيضا على دراسة نماذج كثيرة للعلاقات الوثيقة مثل العلاقات الأمريكية الأوروبية، وشبكة التحالفات الأمريكية في المحيط الهادئ؛ تتبين أكثر صحة المنظور. لكن على الرغم من ذلك، فوطأة المصالح في كثير من الأحيان قد تتجاوز حدود التقارب أو الاختلاف الإيديولوجي، بل قد تحول الأعداء إلى حلفاء، والعكس صحيح. والشراكة الاستراتيجية بين بعض دول آسيا الوسطى وتل أبيب مثالاً صارخاً على ذلك. من منطلق الإيديولوجيا، يجادل البعض أن أحد كوامن الشراكة التي تقترب إلى التحالف الاستراتيجي بين الجانبين هو النظام العلماني شديد الانفتاح، وإن كان ذلك صحيحا نسبيا لكنه غير كاف أو مرضٍ-في واقع الأمر- لتفسير شراكة استراتيجية عميقة بين دولة يهودية ودولة من دول آسيا الوسطى. من الصحيح أن العلمانية عميقة وقديمة ؛ لكنها ليس علمانية شاملة (فصل الأرض عن السماء) على غرار الاتحاد السوفيتي سابقاً الذى قيد ممارسة الشعائر الدينية في نطاق محدود للغاية لجميع الطوائف الدينية لجمهوريات الاتحاد، بل كان يدعم ويجذر الإلحاد في جميع أنشطة الحياة العامة بما في ذلك المناهج الدراسية. الشاهد في الأمر أن الشعب كأحد شعوب آسيا الوسطى شعب متدين ينظر إلى إسرائيل كدولة مغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية. تتمتع دول آسيا الوسطى بخصوصية متعددة الجوانب، وفوق كل ذلك، لديها صراعات تاريخية متشعبة الأبعاد، منها ما يتعلق بتقاسم الموارد في بحر قزوين، ومنها ما يتعلق بطبيعة النظام الديني والسياسي؛ إذ أنها ليست علمانية فحسب، بل تعارض بشدة أيضا نظام ولى الفقيه في إيران وتراه «بدعة» وثمة بعد قومي للعداء يتمحور حول الأقليات. وإزاء وطأة جميع تلك المصالح ومع اشتداد التحديات، والطموحات أيضا تطورت العلاقات مع تل أبيب رويدا رويدا إلى شراكة استراتيجية. إذ أصبحت الأخيرة الداعم الرئيس للطموحات الاقتصادية وهو ما يتجلى في التعاون في مجال الطاقة (النفط والغاز والاستكشاف) الذى يتجاوز المليار دولار سنويا. والمساند الرئيس لها في مواجهة التحديات. إذ تعد تل أبيب من أكبر موردي السلاح لبعض عواصم آسيا الوسطى، والوسيط الأساسي عند واشنطن لتوريد أحدث الأسلحة الأمريكية لها. وفى هذا الصدد لا يمكن إغفال المساهمة الإسرائيلية القوية مقابل الدعم القوى-غير الخفي- لتل أبيب في حربها الأخيرة ضد إيران. والجانبان حاليا في تحالف عسكري فعلي لمواجهة إيران-بحسب تقارير استخباراتية عدة- إذ تعمل تل أبيب حاليا على تدريب وتسليح هذه العواصم وتزويدها بالخبرات اللازمة.
327
| 29 يوليو 2025
مؤخرا أعلن إيلون ماسك الغنى عن التعريف عن شروعه في تأسيس حزب جديد تحت مسمى «حزب أمريكا»، إثر خلاف ممتد مع ترامب بلغ ذروته مع تمرير الكونجرس مشروع الميزانية الضخم. وصاغ ماسك ثلاثة مبررات رئيسه لتأسيس الحزب: كسر هيمنة الحزبين (الجمهوري- الديمقراطي) على الحياة السياسية، التعبير عن إرادة الوسط الأمريكي وهى الإرادة الحقيقية وفقا لماسك، إعادة إصلاح الموازنة العامة. وليس مستغربا أن يثير حزب ماسك صخباً وجدلاً واسعاً داخل أمريكا وعالميا أيضا، والذى تشعب إلى مسائل شتى جوهرية وفرعية، من بينها مدى إمكانية تأسيس الحزب على أرض الواقع، ودور رجال الأعمال في الحياة السياسية الأمريكية، وتأثير التكنولوجيا الرقمية، ومدى جديدة الحزب وإمكانية تحديه للحزبين، وما هي أهداف ماسك الحقيقية...وغيرها. وبطبيعة الحال، نال الجدل حول إمكانية تأسيس الحزب من الأساس على نصيب الأسد من الجدل، بسبب النظام الحزبي الأمريكي الشديد التعقيد والصعوبة بشأن تكوين أحزاب جديدة، والقاعدة الانتخابية التي يستحوذ عليها الحزبان بصورة شبه كلية، وبرنامج الحزب وتمايزه عن الحزبين، ومصادر التمويل وحدودها. وخلاصة هذا الجدل، قد أفضت إلى نتيجة واحدة وهى الصعوبة البالغة في تأسيس حزب جديد وذلك من حيث تجاوزه للتحديات القانونية والحزبية. وفى حال تأسيسه على أرض الواقع، سيجابه بتحديات شتى أهمها على الإطلاق صعوبة منافسة الحزبين. وتلك النتيجة قد استندت في جانب كبير منها إلى تجارب سابقة تجسدت في ثلاثة أحزاب تعمل رسميا لكنها تفتقد إلى قاعدة جماهرية راسخة، وهى: حزب الإصلاح، والحزب الليبرالي، وحزب الخضر. ولعل-وهو ما لفت إليه قلة من المراقبين- ثمة تمايز كبير في تجربة حزب ماسك عن التجارب المشابه السابقة، ومنبع التمايز الرئيس هو التوقيت والسياق. إذ يشكل حزب ماسك حتى ولو كان مجرد محاولة نواة لـ (طريق ثالث) في الحياة السياسة الأمريكية. أجرى ماسك على منصته «إكس» استطلاعا للرأي حول الحزب وكان نتيجته أن أكثر من 50% من الأمريكيين يرغبون في حزب ثالث منافس للحزبين، وأجرت مؤسسات أخرى مستقلة استطلاعات وخرجت بنتيجة مشابه، إذ عبر المستطلع آراؤهم خاصة من انصار الحزب الديمقراطي عن اشتياقهم للحزب الجديد بسبب الفشل الذريع للحزبين على أصعدة عدة خاصة الاقتصادية، بجانب تغلغل الفساد والنزاعات الحادة لمفاصل الحزب، واحتكار النخب للمناصب القيادية. وبجانب ذلك وهو الأمر المفصلي والعاكس لمسألة التوقيت والسياق، هو التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عقدين، سواء على صعيد التركيبة السكانية والاجتماعية أو المزاج العام السياسي أو تنامى فئة الشباب غير المتحزب وتنامى ظواهر اجتماعية جديدة مثل النسوية، وهى تطورات-في حقيقة الأمر- بعيدة كليا عن تقاليد وسياسات الحزبين، وليس بمقدورهما استيعابها أيضا. ولن نذهب بعيدا، إذ بروز أوباما في حد ذاته في الساحة السياسية الأمريكية، ثم ترامب والشعبوية، ثم حركات جديدة متعددة مثل ماجا، وحياة السود مهمة، وأخيراً «زهران ممدانى» الاشتراكي المسلم، المرشح الأوفر حظا لعمدة نيويورك؛ ما هي إلا انعكاس حقيقي للتحول العميق داخل الولايات المتحدة، والأهم من ذلك، انعكاس لانفلات الزمام السياسي من يد الحزبين حتى ولو كانت تلك الحركات أو الشخصيات تابعة لاحدهما. فترامب على سبيل المثال، المنتمي رسميا أو اسميا للحزب الجمهوري، لا تعكس سياسته سوى 30% على الأكثر من سياسات الحزب التقليدية الراسخة، بل هو شخصيا قد أثر على توجهات الحزب وأعضائه بصورة لافته. خلاصة القول، قد لا يكتب لحزب ماسك الجديد النجاح، لكنه في واقع الأمر، انعكاس أو صدى لطريق ثالث يشتاق إليه الأمريكيون آخذ في التنامي، قد يفضى على المدى المنظور إلى بروز محاولات متعددة لكسر هيمنة الحزبين، وقد تكون المحاولة من رحم الحزبين نفسها عبر أجنحة مستقلة إصلاحية.
552
| 17 يوليو 2025
تعيش أوروبا منذ الأزمة المالية العالمية 2008 أزمات عاصفة متتالية، فما تلبث أن تخرج من واحدة حتى تصطدم بالأعنف، وقد أدى ذلك إلى ارتباك وضعف أوروبي عام، وانقسام متزايد، وهشاشة على مستوى الوحدة والتضامن. وتعد معضلة أوروبا في موازنة علاقاتها بين الولايات المتحدة شريكها الرئيس التقليدي، وضامن أمنها الوحيد، والصين أكبر شريك اقتصادي لها، أحد أهم المظاهر القوية للضعف والارتباك والانقسام الذي تعيشه أوروبا. منذ تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 2016، بدأت نبرة الاستقلالية الأوروبية-خاصة الأمنية أو العسكرية-في تزايد، بقيادة فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص بسبب النزعة الانعزالية لترامب وتركيز واشنطن التام على الأندو-باسيفك للتصدي للتحدي الصيني على حساب كل المناطق الاستراتيجية التقليدية خاصة أوروبا والشرق الأوسط. والاستقلالية التي ترتئيها أوروبا خاصة الأمنية؛ هي الاعتماد على النفس بصورة كلية خاصة في التصدي للتهديدات الأمنية الخطيرة دون مساعدة الولايات المتحدة وحلف الناتو عند الضرورة. وفى إطار تلك الاستقلالية، تنفصل أوروبا تدريجيا عن انحيازها التام لواشنطن خاصة بشأن الرؤية والتوجه تجاه الصين. فالصين لم تعد فقط أكبر شريك تجاري لأوروبا، حيث تعتمد الأخيرة عليها بصورة كبيرة لاستيراد المنتجات الرخيصة، والتكنولوجيا المتطورة مثل 2G؛ بل أصبحت شريكا في مبادرة الحزام والطريق، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهما أهم أدوات الصين قاطبة لتعزيز قيادتها الدولية. وعلى الرغم من الترابط الاقتصادي القوي بين الجانبين، فإن هذا لا يحول دون مخاوف أوروبية جلية من الصين، لكن بصورة عامة تنظر أوروبا للصين كمنافس خطير، وليس تهديداً استراتيجياً لزعامتها الدولية كما تنظر واشنطن. ولعل هنا تبرز أهم معضلة تواجها أوروبا حول سياسة متوازنة بين واشنطن وبكين. إذ على الرغم من مساعي الاستقلالية، فإن تحقيقها بالكامل أمر مستحيل على الأقل في المديين القصير والمتوسط، وربما مستحيل على المدى البعيد أيضا. والأمر الثاني أن الاستقلالية الأوروبية لا تعني التخلي التام عن واشنطن، ومحورية حلف الناتو في حماية أوروبا، إذ كما تنص الوثائق الأوروبية خاصة البوصلة الاستراتيجية الاعتماد على النفس «عند الضرورة القصوى»، والهدف العام هو التكامل مع الناتو وليس تحديه. وهذا ما تجلى تماما في قيادة واشنطن لأوروبا في أزمة الحرب الأوكرانية، إذ برهنت الأزمة لكثير من الدول الأوروبية بأن مسألة الاستقلالية الأمنية حلم صعب المنال. وعلى إثر هذه الأزمة أيضا، نجح بايدن جزئيا في إحداث شقاق بين أوروبا والصين، حيث علقت أوروبا مفاوضات اتفاق الشراكة مع الصين في 2021، وانضمت دول أوروبا إلى مبادرة «بناء عالم أفضل» الرامية لتقويض مبادرة الحزام والطريق، وانسحبت إيطاليا من الأخيرة. لكن ذلك لم يدفع أوروبا إلى إعادة توجيه رؤيتها للصين من منافس إلى تهديد استراتيجي، ولم تقلص تعاونها الاقتصادي الكبير مع بكين. مع عودة ترامب للبيت الأبيض، تنامى حديث أوروبا حول الاستقلالية بصورة غير مسبوقة، بل اتخذت أوروبا بصورة جماعية سياسات تنم عن مظاهر استقلالية لافتة من أبرزها دعم أوكرانيا بالسلاح بقيادة بريطانيا، الإصرار على تحرير جميع الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها روسيا في أية مفاوضات لإنهاء الحرب، الانتقادات الشديدة غير المسبوقة لإسرائيل حول غزة خاصة في مسالة إدخال المساعدات، رفض التعريفات الجمركية المرتفعة والتلويح بتعزيز التعاون مع الصين.. وغيرها. وتلك السياسات العاكسة للاستقلالية، لن تفضي إلى توتر العلاقات مع واشنطن بصورة غير مسبوقة بالضرورة، ولن تؤدي إلى انفصال استراتيجي بين شركاء الأطلسي. لكنها بالضرورة تدشين لنهج يسعى إلى التوازن بين بكين وواشنطن. ولعل منطلق هذا النهج هو رفض أوروبا الانجرار وراء واشنطن في تسخين الحرب الباردة مع بكين؛ إذ ترفض أوروبا من حيث المبدأ مفردات ومناخ ما يسمى الحرب الباردة على الهيمنة العالمية، ولا ترى في الصين تهديدا استراتيجيا يستدعي حربا باردة. ناهيك عن أن الصين باتت شبه حليف لأوروبا الشرقية. خلاصة القول: مؤخراً صرح الرئيس الفرنسي ماكرون أن على أوروبا أن تسعى إلى استقلالها الاستراتيجي للحد من الاعتماد على الصين والولايات المتحدة، ونجزم أن ما يتمناه فعلاً هو التوازن بين الشريكين، إذ باتت أوروبا في أمس الحاجة إليهما، ولا تستطيع الاستغناء عن أحدهما.
462
| 13 يوليو 2025
مع بلوغ الحرب بين إيران وإسرائيل ذروتها التصعيدية بدخول واشنطن على الخط وضرب المنشآت النووية بقاذفات البى-2، عجت وسائل الإعلام بعناوين عريضة عن التدخل الوشيك لحلفاء طهران وخاصة روسيا والصين في خط المواجهة لحماية حليفهم الرئيس في المنطقة، وعند هذا التدخل الضروري ستكون ساعة الصفر للحرب العالمية الثالثة، وما لبث أن مر فقط 48 ساعة حتى توقفت الحرب، واتضح أن كل تلك العناوين كانت مجرد هراء فارغ. قبل الولوج في موقف الصين، واستحالة الانخراط في هذه الحرب تحت أية ظروف، من الجدير تسليط الضوء على عمل أو منطق التحالفات والحلفاء والذهاب للحروب. التحالفات ومن بينها التحالفات العسكرية جزء أصيل في السياسة الدولية منذ قرون، وتنشأ التحالفات العسكرية لمواجهة تهديد قائم وردعه والدخول معه في حرب في الضرورة، وللتحالفات العسكرية أنماط متعددة، أبرزها النمط التقليدي الجماعي مثل حلف الناتو، ونمط تحالفات الحماية وهو الشائع ويكون بين دولة عظمى أو إقليمية ومجموعة من الدول الصغيرة، أو دولة واحدة ليست قوية، وأبرز مثال على ذلك التحالف الأمريكي مع اليابان، والأمريكي مع فيتنام، والفلبين. الشاهد في الأمر من كل أنماط التحالفات أمران رئيسيان، أولهما أن تجمع مجموعة دول في تحالف عسكري يكون لمواجهة تهديد خطير يهدد مصلحة حيوية مشتركة تجمعهم، وبالتالي فالانجرار للحرب يكون قراراً مصيرياً خطيراً لا بديل غيره لحماية تلك المصلحة. والثاني، أن القوى العظمى في تحالفات الحماية قد مضت في التحالف لحماية مصلحة شديدة الحيوية لها، وبالتالي أيضا لن تنجر في الحرب لأجل حماية حلفائها بل ذلك مجرد ذريعة لتقويض التهديد الخطير لمصلحتها. هذا هو واقع ومنطق التحالفات العسكرية، لا شيء مجاني خاصة إذا تعلق الأمر بالذهاب للحرب، وسوابق التحالفات العسكرية مليئة بتلك المفارقات المصلحية، ففرنسا وألمانيا على سبيل المثال رفضتا مشاركة واشنطن في حرب العراق رغم أنهما عضوان في الناتو، في حين ترددت إدارة أوباما أسابيع قبل التدخل في ليبيا للإطاحة بالقذافي رغم مشاركة الناتو السريعة. وفى مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، قادت واشنطن تحالفا أوروبيا لدعم أوكرانيا عسكريا لأن روسيا أصبحت تهديداً خطيراً للنظام الدولي الليبرالي ذاته وليس أمن أوروبا فقط. في المقام الأول لا ترتبط الصين بأية تحالفات عسكرية أو اتفاقات دفاع مشترك مع طهران، يربط فقط بين الجانبين علاقات استراتيجية واسعة قوامها الاقتصاد وبخاصة النفط، وفي 2021 تم التوقيع على اتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 25 عاما ارتكز على توطيد التعاون الاقتصادي مع توسيع التعاون الأمني. لكن هذا لا يعكس جوهر موقف الصين من الحرب، بقدر ما يعكس موقف الصين العام من الحروب والصراعات، وحساباتها الاستراتيجية الكبرى ومنطق الانخراط في الحروب في إطار هذه الحسابات. ترتكز السياسة الخارجية الصينية على عدة مبادئ رئيسية ومنها الحياد الإيجابي وعدم التدخل في الصراعات، إقامة علاقات متوازنة مع الجميع. ومنذ تولي الرئيس شي جين بينج السلطة عملت الصين على ترسيخ وضعها في النظام الدولي كـ «قوى مسؤولة» تسعى جاهدة لنشر السلام ومنع اندلاع الصراعات وأولوية الدبلوماسية والحلول السلمية. وهذا من حيث المبدأ يبرر انحصار دور الصين في الحرب في الجانب الدبلوماسي ووسط هذا الجانب تبدى الموقف التقليدي الحيادي للصين الداعم لإنهاء الحرب والتعقل ودعوة الأطراف للحوار ونزع جذور الصراع. لأن الصين من موقعها كقوى مسؤولة لا يمكن تصور تبنيها موقفا منحازاً خاصة لإيران رغم أهميتها الاستراتيجية لها، بعكس روسيا التي أطلقت تحذيرات مباشرة لأمريكا وإسرائيل بشان تدمير البرنامج النووي، واغتيال المرشد الأعلى، وهي مجرد تصريحات إعلامية لا أكثر. وعلى الجانب العملي البرجماتي حافظت الصين على الحياد الإيجابي الذي أفاد الصين فوائد جمة، فالصين ترتبط بعلاقات استراتيجية واسعة مع إسرائيل ومعظم خصوم إيران. ما سبق كفيل وحده لتبرير استحالة تدخل الصين في الحرب لمساندة طهران؛ لكن ثمة حسابات استراتيجية أوسع تعكس الصورة كاملة. من حيث المبدأ، إن فكرة انخراط الصين في حرب لصالح طرف آخر أو حليف استراتيجي غير واردة تماما عند الصين، لأن تلك الحروب ستعطل مسيرتها للقيادة الدولية، وتضرب الاقتصاد الصيني في مقتل العمود الفقري لصعودها. علاوة على ذلك، حددت الصين في عقيدتها الاستراتيجية حتمية خوض الحروب في حالات الضرورة القصوى للدفاع عن مصالحها الأساسية وخصوصاً تايوان وبحر الصين الجنوبي، والعدو المحتمل المهدد لتلك المصالح هو واشنطن. وعلى الجانب الآخر، أن سقوط النظام الإيراني على أسوأ افتراض سيضر الصين ومصالحها بلا شك، لكن ذلك ليس مبررا كافيا أو تهديدا خطيرا يستدعي الانجرار في حرب قد تتوسع لحرب عالمية ثالثة.
675
| 29 يونيو 2025
حققت دول مجلس التعاون الخليجي طفرة مذهلة في كافة المجالات خلال العقد الماضي، ومن المنتظر أن تتضاعف هذه الطفرة إلى خمس مرات خاصة على الصعيد الاقتصادي بحلول عام 2030. وأثار هذا بالطبع جدلاً كبيراً خاصة في الغرب حول مكمن السر في هذه الطفرة المذهلة في دول مصنفة غربياً على أنها "غير ديمقراطية"، ولماذا دول الخليج تحديدا إذا كان الأمر ليس ذا صلة بالديمقراطية؟ وكلمة أو مكمن السر هو "الحكم الرشيد" الذي برعت فيه دول الخليج بصورة لا مثيل لها. تعددت تعريفات الحكم الرشيد، وبين هذه التعريفات، تعريف عام شامل مفاده "أسلوب في الحكم أو إدارة الحكم أو الشأن العام يرمى إلى استغلال جميع موارد الدولة أفضل استغلال من أجل تحقيق هدفين رئيسيين: التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية". وبناء على هذا التعريف، تقتضى ممارسة الحكم الرشيد تطبيق أو إرساء عدة معايير أهمها: مكافحة صارمة للفساد، القضاء على البيروقراطية، وبناء مؤسسات مرنة رشيقة، تطبيق الشفافية والرقابة الإدارية، المساءلة الشاملة، حكم القانون، المشاركة في اتخاذ القرار، الاعتماد على الكفاءات والخبرات. عند قراءة رؤى مجلس التعاون الخليج مثل رؤية قطر 2030 على سبيل المثال، نجد أن إرساء تلك المعايير تم التأكيد عليه كأولوية أساسية في كافة المجالات المستهدفة بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وإن كان مرمى الرؤى الرئيسي هو ذلك بالضبط، علاوة على رفع مكانة الدولة كدولة عظمى في النظام الدولي عبر التفوق والمنافسة على المراكز الأولى عالميا في كافة المجالات حتى المجالات التي حقق فيها الغرب اختراقا كبيرا كالفضاء والبيئة والتعليم والرياضة. وهذا يجعلنا نصدق مؤشرات وتوقعات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي المتعلقة بالتنمية في الخليج بحلول 2030 على أقل تقدير. إذ بحسب هذه التقديرات ستحتل قطر المركز الأول عالميا في مؤشر الرفاهية دون منافس، وفى مكافحة الفساد والطاقة النظيفة مع الدول الإسكندنافية، والثالث عالميا في جودة التعليم، والإمارات تتصدر عالمياً في النزاهة الإدارية، والمناخ الجاذب للاستثمار، ومن العشرة الكبار في مجال الفضاء والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، والسعودية الثالث عالميا في جذب الاستثمارات والكفاءة الإدارية، ومن العشرة الكبار في المجال الصحي والرياضي وجودة التعليم والذكاء الاصطناعي. وكل من البحرين والكويت وسلطنة عمان، ستحتل مراكز متقدمة عالميا في مجالات الكفاءة الإدارية ومحاربة الفساد والتجارة البحرية والتعليم. * إن ما تحققه دول الخليج من طفرة مذهلة عبر الحكم الرشيد، يفاقم من الجدل في الغرب خصوصاً حول الديمقراطية في الخليج ومستقبلها، والعلاقة بين الحكم الرشيد والديمقراطية، إذ هناك حالة من الذهول حول كيف تحقق هذه الدول تلك الطفرة المذهلة التي من الصعب تحقيقها دون حكم ديمقراطي، بل تفوقت على كثير من الدول الغربية. والواقع أن هذا الجدل، أو بفضل تجربة الخليج في الحكم الرشيد، قد كشف الكثير من المغالطات المزمنة عن الديمقراطية ذاتها. وتتبدى المغالطة الأولى في تصوير الديمقراطية على أنها أفضل نظام للحكم والطريق الوحيد الذي لا بديل عنه للتنمية والعدالة والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وغيرها، وذلك عبر ممارسات معينة مسلم بها على رأسها التداول السلمي للسلطة، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والفصل بين السلطات خاصة استقلال القضاء. لا جدال بأن الديمقراطية من أفضل نظم الحكم التي عرفها التاريخ، لكنها ليست مثالية، وفى بعض الأحيان تكون مثالبها مدمرة. * أما المغالطة الثانية فتتعلق بإمكانية بل بضرورة تعميم الديمقراطية وآلياتها والمبادئ الليبرالية الحاكمة لها على العالم، دون مراعاة للخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول. وواقع الأمر أن تلك المغالطة تتبدى بجلاء في الدول الغربية ذاتها، فمستوى أو ما يسمى جودة الديمقراطية متباينة بشدة بين الدول الغربية العريقة، ففي بعض البلدان الأوروبية تعانى المرأة أشد معاناة في تولى مناصب قيادية، وفى الولايات المتحدة لا يسمح للمتجنس بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفى فرنسا لا بد أن يكون المرشح للرئاسة فرنسي الجنسية "كاثوليكي المذهب"، ومرجع كل ذلك الخصوصية الثقافية لكل دولة التي لا تسمح على الإطلاق بتطبيق ديمقراطية ليبرالية خالصة. * والمغالطة الثالثة المتعلقة بلب الحكم الرشيد تتعلق بفرضية "لا تنمية اقتصادية دون ديمقراطية"، من حيث المبدأ يمكن القول إن مرتكزات الحكم الرشيد لدول الخليج، لا تعكس فقط مبادئ الديمقراطية السياسة والاقتصادية، بل تتفوق عليها أيضا. لا سيما في مسألة دولة الرفاهية وعدالة التوزيع، فالديمقراطية الاقتصادية ذاتها لا تلبى كليهما بالشكل الكافي أو المرجو، بل أسهم ما بات يطلق عليه "النيوليبرالية المتوحشة" في نفور حاد من الديمقراطية وكراهية شديدة للتجارة الحرة والعولمة انعكست في الصعود الصاروخي لليمين المتطرف. ** خلاصة القول، قدمت أو برهنت دول الخليج للعالم عبر الحكم الرشيد إمكانية تحقيق التنمية والرفاهية والعدالة الاجتماعية لمستويات مذهلة غير محققة في معظم الدول الغربية، في ظل خصوصية اجتماعية وثقافية تتم فيها ممارسة الديمقراطية تعكس هذه الخصوصية.
882
| 08 يونيو 2025
إن تنميط زيارة ترامب التاريخية لكل من السعودية وقطر والإمارات في قالب منفعي أمريكي أحادي الجانب، أو ما بات يشاع من جانب المغردين ومحدودي الفهم والمعروفة بـ «حلب دول الخليج» بعدما ناهزت الصفقات التجارية المتبادلة قرابة الثلاثة تريليونات دولار؛ يعد ضربا واسعا من العبث، وقصوراً خطيراً في فهم منطق السياسة الدولية، وفى إدراك الواقع والمتغيرات والتحديات الكثيرة على كافة الأصعدة. بادئ ذي بدء، يعد اختيار ترامب لدول الخليج كأول زيارة رسمية له منذ عودته للبيت الأبيض، ذات مدلول استراتيجي عميق مؤداه الأساسي الإقرار الأمريكي الصريح بزيادة الأهمية الاستراتيجية المطردة للخليج، فدول الخليج وخاصة ثلاثي الزيارة، نجحت خلال العقد الماضي بفضل سياسات الحكم الرشيد، وقوتها الاقتصادية، واستراتيجيات التنوع الشاملة، ودبلوماسيتها النشطة، والمناورة والاستغلال الحكيم للسياسة الخارجية وملفاتها، نجحت في النهوض بالأهمية الاستراتيجية للخليج إلى مستويات قياسية إقليميا ودوليا. وعلى صعيد العلاقات مع واشنطن، غدت شريكاً استراتيجياً أساسياً، بحيث تحول مسار الشراكة الاستراتيجي بين الجانبين إلى شراكة متوازنة ذات أبعاد متعددة عميقة، لا ترتكن على الجانب الأمني فقط. فالدوحة على سبيل المثال، غدت وسيطاً تعتمد عليه واشنطن بصورة أساسية دائمة في الوساطة والحل في أعقد الصراعات التي عجزت واشنطن عن حلها حتى عبر القوة العسكرية المفرطة. وفي ملفات عدة حاسمة لواشنطن بات الخليج شريكا أساسيا مثل محاربة الإرهاب والتطرف، وضبط أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وتقوية توازنات واشنطن الدولية في مواجهة الصين وروسيا، والتعاون الاقتصادي الشامل. جاء ترامب إلى الخليج وهو واضع نصب عينيه الصفات التجارية والسياسة والأمنية أيضا، ونظير ذلك، وضعت دول الخليج الثلاث نصب أعينها صفقات ومكاسب استراتيجية عميقة طويلة الأمد. في المقام الأول، تساهم صفقات الخليج التريليونية في إنعاش الاقتصاد الأمريكي المتراجع ودفعه خطوات قوية للأمام بلا أدنى شك. لكن في مقابل ذلك، يتبدى من نوعية الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة أو تحديدا تركيزها في مجالات محددة خاصة المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ مدى المردود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الهائل لدول الخليج على المدى الطويل، فالقطاع التكنولوجي خاصة التكنولوجيا الفائقة وأشباه الموصلات بات القاطرة المحركة لكل شيء تقريبا، وفي ضوء استراتيجيات ورؤى الخليج الجديدة مثل «رؤية قطر 2030» باتت التكنولوجيا الفائقة العامل المحرك للتحديث الاقتصادي والاجتماعي الشامل وفقا لتلك الرؤى خاصة الاعتماد على الطاقة البديلة ووجوب توديع عصر النفط. والشيء الجدير بالذكر والمغفل عن غير عمد أو عمداً، هو النفوذ الواسع الذي ستتمتع به دول الخليج في الولايات المتحدة جراء هذه الاستثمارات الضخمة، مما يعنى أموراً كثيرة أهمها التأثير على القرار الأمريكي تجاه مصالح الخليج والعرب عموما، لاسيما تقليص الانحياز المفرط للكيان الصهيوني. ولعل عدم زيارة ترامب للكيان أثناء زيارته الخليجية-في سابقة غير معهودة- دليل قاطع على إيلاء ترامب أهمية استراتيجية للخليج تفوق أهمية الكيان. يتبدى من زيارة ترامب للخليج أنه بات يراهن بصورة تامة على نفوذ الخليج وقوته ورؤيته الخاصة في حلحلة العديد من أزمات الشرق الأوسط، فالحرب في غزة، والوضع في سوريا كانا على رأس أولويات تلك الزيارة. بالنسبة لسوريا والتي كانت أهم مفاجآت الزيارة، قابل ترامب أحمد الشرع وأشاد به وأعلن عن رفع كافة العقوبات عن سوريا، متخطيا الشروط القاسية الست التي شرطها لرفع العقوبات. وهذا ينم عن اقتناع ترامب بالرؤية الخليجية حول واقع ومستقبل جديد واعد في سوريا تحت القيادة الجديدة، وفي طيات ذلك أيضا إرضاء للخليج خاصة السعودية هذا لا يمكن إغفاله بالقطع، لكنه مبشر لإنهاء قريب لحرب الإبادة في غزة بضغط خليجي خاصة قطري، إذ أدلى ترامب خلال الزيارة وبعدها بتصريحات تشي برغبته القوية في إنهاء الحرب، واعتراضه على كثير من سياسات وتصورات حكومة نتنياهو بشأن مستقبل غزة. وفي محصلة ذلك، خرج الخليج بأهم مصلحة استراتيجية له، وهي إعادة الالتزام الأمريكي بحماية أمن الخليج بصورة قاطعة لا لبس فيها، ومن المرجح أن تتطور إلى معاهدات دفاع مشتركة مكتوبة ملزمة للولايات المتحدة. إذ على الرغم من تنوع الشراكات الأمنية للخليج خلال العقد الماضي مع جميع القوى الدولية الكبرى وتحديدا روسيا والهند والصين؛ فإن الولايات المتحدة لا تزال القوى العسكرية الأقوى والأكبر في الخليج، ويتبدى أن جميع القوى ذات المصلحة القوية في الخليج خاصة الصين لا ترغب في لعب دور أمني عسكري مواز للدور الأمريكي، كما أنها ترتبط بشراكات استراتيجية مع خصوم الخليج. دول الخليج عموما- وهذا واقع لا يمكن إنكاره- ليست قوى عسكرية كبرى تحت وطأة محدودية السكان والمساحة والعمق الاستراتيجي، محاطة بجيران أقوياء، ومحيط شديد الاضطراب مفرغ للتطرف والإرهاب والمليشيات شبه النظامية. وبالتالي، دون ضمانات حماية قوية ستصبح دول الخليج على محك عدم الاستقرار والفوضى دائما، وبفضل الدور الاستراتيجي القوى الذي باتت تلعبه للمصالح الأمريكية، أصبحت حماية الخليج مصلحة أساسية لواشنطن قبل الخليج
648
| 22 مايو 2025
انتهجت إدارة ترامب نهجاً حذراً تجاه سوريا الجديدة بقيادة أحمد الشرع، حيث لم تعترف رسميا بحكومة الشرع، لكنها قد أبدت إمكانية للانفتاح مشروط بأفعال إيجابية على الأرض من جانب الحكومة الجديدة، ومؤخراً قامت إدارة ترامب بخطوة نحو الانفتاح على سوريا اقترنت بقائمة شروط بعضها شديد الصعوبة لرفع العقوبات، والتي تعد عائقاً هائلا نحو تيسير التجارة الدولية لسوريا خاصة صادرات النفط، وتدفق الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية لسوريا، وتسهيل المعاملات المالية لسوريا في العالم، وفك العزلة الدولية عن سوريا، وطالما ما نادت حكومة الشرع برفعها. وتضمنت الشروط: التعاون الفعال في مكافحة الجماعات الإرهابية ومنع المقاتلين الأجانب من تولي مناصب حكومية رفيعة، ومساعدة الحكومة الأمريكية في تحديد أماكن المواطنين الأمريكيين المفقودين وإعادتهم لأمريكا خاصة الصحفي أوستن تايس، وتصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني رسميا ككيان إرهابي، وتدمير ما لدى سوريا من أسلحة كيماوية، وتنفيذ إصلاحات دستورية واسعة مع بدء حوار وطني وتأسيس برلمان تمثيلي. وتلك الشروط تبين أهدافا أمريكية واضحة ومتوقعة، وأهدافا أخرى غامضة بعض الشيء وتم التلميح لبعضها، الواضحة تتلخص في الإجهاز التام على النفوذ الإيراني في سوريا، بل وتحويل سوريا إلى جبهة لمقاومة إيران، ونزع أية أوراق ضغط أو أسلحة قوية قد تشكل تهديدا لإسرائيل، وقطع النظام الجديد أية صلة له بالجماعات الإرهابية خاصة القاعدة وداعش. أما الغامضة يمكن تصورها من خلال بعض الشروط صعبة التحقيق، وكذلك التي لا تشكل أهمية بالغة للولايات المتحدة عموما، وإدارة ترامب على وجه الخصوص مثل التحول الديمقراطي، وهى تحديداً منع المقاتلين الأجانب من تولى مناصب رفيعة وهذا ربما يمتد لعناصر سورية كانت أعضاء في القاعدة وداعش سابقاً مع شرط قطع الصلة مع الجماعات الإرهابية، وتنفيذ إصلاحات دستورية وتحويل سوريا إلى نظام ديمقراطي تام. ولعل الأهداف الأمريكية من وراء تلك الشروط الصعبة هو الضغط على حكومة الشرع إلى أقصى درجة ممكنة لأجل تحويل سوريا إلى تابع ضمن محور الدول التابعة لها في المنطقة، والسماح لإسرائيل بتمديد حضورها العسكرى لما وراء هضبة الجولان، والهدف الأصعب الأخير هو التطبيع بين سوريا وإسرائيل. وفى خطوة استباقية للأمام، أعلنت حكومة الشرع على لسان أسعد الشيباني وزير الخارجية أنها على استعداد لتلبية العديد من المطالب الأمريكية، كما أحرزت تقدما في بعضها مثل تتبع مقاتلي داعش واعتقال عدد منهم، والتعاون مع المفتشين الدوليين لتدمير الأسلحة الكيماوية، كما تبذل جهودا كبيرة لتحديد أماكن المفقودين الأمريكيين، والإعلان قريبا عن إصلاحات دستورية واسعة وتمثيل واسع للأقليات في الحكومة. ورغم هذا التقدم المحرز العاكس عن رغبة حكومة الشرع في تخطى أكبر تحد وهو العقوبات الأمريكية، وتعزيز شرعيتها الداخلية والخارجية؛ فإن تلبية جميع الشروط الأمريكية لايزال تحدياً كبيراً مع علم واشنطن بذلك. تعد مسألة قطع حكومة الشرع صلتها تماماً بجميع الجماعات المسلحة والتي منها هيئة تحرير الشام التي لاتزال مصنفة كإرهابية لدى واشنطن؛ مسألة في غاية الصعوبة والتعقيد لحكومة الشرع حتى إذا كانت تريد ذلك بصدق، فحكومة الشرع وأعضاؤها هم قادة هيئة تحرير الشام، وأعضاء سابقون في داعش والقاعدة. ومن ثم، لا يزال أغلبيتهم مرتبطين فكريا وتنظيما أو لديهم صلات قوية بتلك الجماعات علانية وسراً، وبعض منهم يتولون مناصب سيادية في سوريا الجديدة، وبالتالي فهم من منظور إدارة ترامب إرهابيون. يضاف إلى ذلك، أن قوة وشرعية أحمد الشرع نفسه مستمدة من تلك الجماعات وأعضائها، ومن ثم ففتح جبهة عداء معهم بصورة سريعة سيمثل خطراً شديدا على مستقبل الشرع، بل سيحول سوريا إلى جبهة اقتتال داخلي عنيفة. وأيضا، يعد تحويل سوريا إلى نظام ديمقراطي تمثيلي حقيقي في وقت سريع أمراً لا يمكن تصوره في ظل الظروف الانتقالية عامة خاصة وأن سوريا تتمتع بتنوع طائفي واسع وبنية مدمرة ومؤسسات هشة، ونزاعات انفصالية، وفى ظل وجود حكومة إسلامية تسعى إلى الاعتدال، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتجربة واسعة لتأسيس نظام ديمقراطي كامل أقرب إلى نظام علماني. إن سرعة واستعداد حكومة الشرع لتلبية الشروط الأمريكية يعكس عزما قويا على إزالة عائق العقوبات، لكن على الأرجح لن يكون بمقدورها تلبية جميع الشروط، أو تلبيتها بالسرعة الكافية، علاوة على التحديات والتداعيات الكبيرة لتلبية بعض الشروط. وبالتالي يبدو لدينا أن الشروط الأمريكية التي يمكن وصفها بالتعجيزية الغرض منها إخضاع سوريا تماما، وضمان هيمنة أبدية لإسرائيل على الجولان، واستمرار الضغط حتى تقبل سوريا التطبيع مع إسرائيل، وهذا في حد ذاته رغم الأقاويل المتضاربة بشأنه أمر من الصعب للغاية تصوره. لكن هذا لا يحول أيضا دون إمكانية رفع جزئي تدريجي للعقوبات عن سوريا لتشجيع سوريا على المضي في تلبية جميع الشروط، خاصة في ضوء موقف عالمي خاصة أوروبي مؤيد لإزالة العقوبات ودعم الشرع.
1464
| 06 مايو 2025
لم تكن تتوقع إدارة ترامب أن تتحدى الصين التعريفات الجمركية وتدخل بحسم منقطع النظير في تحدى الحرب التجارية الذي وصل إلى قرابة 145% تعريفات متبادلة بين البلدين في آخر تصعيد. إذ اعتقد ترامب أن رفع التعريفة الجمركية على الواردات الصينية إلى هذا المستوى الجنوني في إطار سياسة «الضغط الأقصى»؛ سيجبر الصين على الفور على الدخول في اتفاق تجاري جديد مع واشنطن. تعد السوق الأمريكية من الأسواق الرئيسية للصين حيث تجني منه قرابة النصف مليار سنويا. فضلا عن ذلك، تشكل الحرب التجارية خطراً على ديناميكية وحركة التجارة العالمية التي تعد الصين أكبر المستفيدين منها باعتبارها أكبر منتج ومصدر للعالم. ومن ثم، يعكس التحدي الصيني القوي لتعريفات ترامب متغيرات على مستوى التفكير والقوة الصينية، وأيضا على مستوى الواقع العالمي والداخل الأمريكي. * الصراع الأمريكي الصيني له خصوصية عن باقي صراعات العالم، فهو صراع على الهيمنة العالمية وهو أهم واخطر صراع عالمي بالتأكيد. وبالتالي، فأي صراع جزئي بين القوتين يدور في رحاب صراع الهيمنة، من جانب واشنطن يعد البعد الاستراتيجي الأبعد من الحرب التجارية التي أصبحت سياسة راسخة لا تقتصر على ترامب فقط، هو إضعاف القوة الاقتصادية للصين التي جعلت الصين القطب الثاني عالمياً. وبعيداً عن أضرار الصين من الحرب التجارية؛ فتحدي الصين الحاسم لها هو رسالة مباشرة للعالم قبل واشنطن بأن الصين أصبحت قوى عالمية قادرة على القيادة وتحدى الهيمنة الأمريكية بل وانتزاع الهيمنة منها. وما أدل على ذلك من التحدي الصيني الحاسم المتصاعد في جميع الخلافات الكثيرة التي تطرأ بصورة متوالية بين الجانبين، وتحديداً في تايوان. قبل عقد مضى لم يكن التحدي الصيني لواشنطن بذلك القوة والحسم، فهو يسير بشكل مطرد. وهذا الحسم المطرد لا ينبع من فراغ حيث تتسم الصين بالصبر والحكمة، بل نابع من تنام شديد لقوة الصين الشاملة، نظير تراجع للقوة الأمريكية. والواقع أن تلك القوة خاصة الاقتصادية تجعل الصين في مركز قوة رئيسي أمام ترامب، إذ أن اقتصادها الرهيب قادر على الصمود أطول فترة ممكنة في تلك الحرب. نظير ذلك، الاقتصاد الأمريكي الغير قادر-وفقا لإجماع الخبراء- على الصمود طويلاً أمام حرب تعريفات ترامب. إذ يكفى القول بمستويات التضخم الرهيبة المرتقبة في الولايات المتحدة جراء تلك التعريفات، فالولايات المتحدة تستورد ما يقرب من 70% من احتياجاتها بما في ذلك سلع حساسة كالأغذية والدواء ومستلزمات الإنتاج خاصة من أكثر الدول المستهدفة بالتعريفات وعلى رأسها الصين. وبفضل قوة الصين الرهيبة عالميا سياسيا واقتصادياً، فهي قادرة على تعويض خسائر السوق الأمريكي عبر زيادة الصادرات مع تخفيض قيمة العملة إلى مستويات أدنى. فالصين حاليا توصف بزعيمة كتلة الجنوب العالمي التي تشهد في المقابل تراجع حاد للنفوذ الأمريكي. * من منطلق استراتيجي آخر يعكس تطور لافت في التفكير الاستراتيجي للصين؛ ترى الصين أن الحرب التجارية المتهورة لترامب؛ إنما هي فرصة ذهبية للصين لتوسيع نفوذها وقوتها الدولية. فترامب بتلك الحرب يعادي أو يتحدى العالم حتى أقرب حلفائه؛ وهذا بدوره يمنح الصين فرصة لاستيعاب دول العالم حتى الحلفاء إلى فلكها الخاص خاصة الاقتصادي، لا سيما وأن جميع دول العالم باتت تعتمد على الصين اقتصادياً بصورة رئيسية. دول أوروبية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا قد ألمحت إلى تعميق شراكات اقتصادية مع الصين، بعدما نجح بايدن في إحداث قدر من النفور في العلاقات الأوروبية الصينية. كما تدور أقاويل عن شراكة اقتصادية شاملة تضم اليابان وكوريا الجنوبية والصين. ** خلاصة القول، في كل أزمة جديدة بين واشنطن وبكين، تبرهن الأخيرة على أنها لم تعد تخاف الهيمنة الأمريكية، بل متحد قوي لها. علاوة على أنها تكون كاشفة بجلاء لتراجع القوة الأمريكية، وتخبط السياسة الأمريكية أيضا خاصة تجاه الصين. ومن ثم، فعلى الأرجح سيضطر ترامب للتراجع في حربه التجارية مع الصين في القريب العاجل-مثلما تراجع في معظم سياساته العامة حتى الآن- ويقبل بإبرام اتفاق مع الصين غالبا سيتضمن تخفيض التعريفة إلى أقصى حد ممكن؛ لاسيما أيضا وأن حربه التجارية المتهورة تواجه بكم واسع من الانتقادات الداخلية الحادة حتى من أقرب داعميه في الحزب الجمهوري بسبب تبعاتها الخطيرة اقتصاديا وسياسيا. فهي ستعزل أمريكا عن العالم، وستخسر بسببه جميع حلفائها.
1074
| 21 أبريل 2025
مساحة إعلانية

في الساعات المبكرة من صباح السبت، ومع أول...
4242
| 05 ديسمبر 2025

-«المتنبي» حاضراً في افتتاح «كأس العرب» - «أبو...
1977
| 07 ديسمبر 2025

فجعت محافل العلم والتعليم في بلاد الحرمين الشريفين...
1773
| 04 ديسمبر 2025

لم يدخل المنتخب الفلسطيني الميدان كفريق عابر، بل...
1428
| 06 ديسمبر 2025

تتجه أنظار الجماهير القطرية والعربية إلى استاد خليفة...
1164
| 04 ديسمبر 2025

مواجهات مثيرة تنطلق اليوم ضمن منافسات كأس العرب،...
1149
| 03 ديسمبر 2025
لم تعد الدوحة مجرد مدينة عربية عادية، بل...
909
| 03 ديسمبر 2025

عندما يصل شاب إلى منصب قيادي مبكرًا، فهذا...
741
| 09 ديسمبر 2025

أحياناً نمر بأسابيع تبدو عادية جداً، نكرر فيها...
663
| 05 ديسمبر 2025

تشهد الساحة الدولية اليوم تصاعدًا لافتًا في الخطابات...
639
| 04 ديسمبر 2025

حسناً.. الجاهل لا يخدع، ولا يلبس أثواب الحكمة،...
570
| 08 ديسمبر 2025

شهدت قطر مع بداية شهر ديسمبر الحالي 2025...
564
| 07 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية